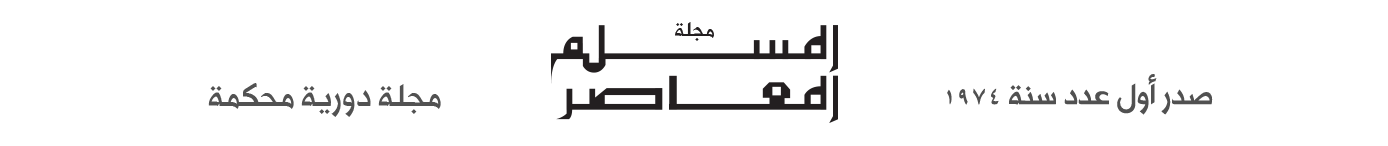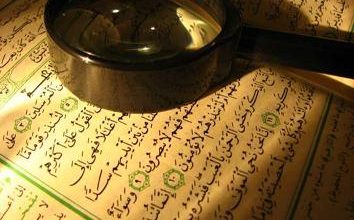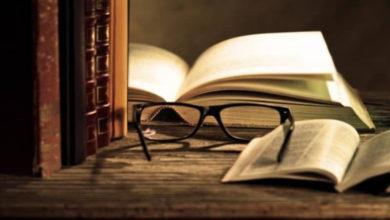مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، فما أحوج العالم اليوم في اصطراعه واضطرابه وبلبلته واعوجاج خطاه وحيرة قادته وثورة شعوبه إلى قبس من شعلة شريعة الله تعالى الخالدة يبدد به الظلمة،
وما أحوجنا في مشكلاتنا الاجتماعية التي تتعقد يوما بعد يوم ويأخذ بعضـها برقاب بعض إلى أن نعرف أحكام الشريعة فيها، لنتبين وجه الصواب في علاجها وسلامة المبادئ التي ترد إليها الحلول القويمة مع رعاية الظروف، وما استجد في الحياة من مطالب.
لقد تناولت تعاليم الإسلام حياة الإنسان في جميع أحواله، فوضعت له أسمى المبادئ وأقوم القواعد التي تحقق سعادة الفرد والجماعة ومصلحتها، دون أن تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، ولا مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
وفرض الكفاية في الإسلام منهج تربوي لتقويم الخلق والسلوك، يتربى أفراد الأمة من خلاله على سمو النفس ورفعتها، فينطلق المسلم بعزم وثبات في ظل نكران الذات عاملا فاعلا في مجتمعه، يحرص على إسعاد المجتمع حرصه على إسعاد نفسه، والمجتمع من حوله يشاركه ويبادله التحية بأحسن منها في تلاحم وتعاون وتكافل.
ومحاولة مني في إبراز أهمية فرض الكفاية الكبرى في التشريع الإسلامي وجمع شتاته في بحث مستقل لتسهل الإفادة منه عزمت على بحث هذا الموضوع من خلال المسائل الآتية:
تعريف الواجب – أقسام الواجب – تعريف فرض الكفاية – الفرق بين الفرض والواجب – الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين – ضابط تحقيق فرض الكفاية – أيهما أفضل القيام بفرض العين أم القيام بفرض الكفاية؟ – هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أم بالبعض؟ – الحكم فيما إذا فعل الجميع فرض الكفاية – الحكم فيما إذا ترك الجميع فرض الكفاية – إناطة التكليف بفرض الكفاية – شرط من يسقط بهم فرض الكفاية – هل لفرض الكفاية عدد معين؟ – سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة والجن – هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه.
الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث ثم فهرس المراجع.
هذا وإن أكن قد أصبت التوفيق فهذا من عظيم فضل الله عليّ ولله المنة في الأولى والآخرة، وإن كانت الأخرى فحسبي أني لم أقصر، والله تعالى أسأل أن يعم النفع به إنه نعم المولى ونعم النصير.
تعريف الواجب:
الواجب في اللغة: يطلق على عدة معان من أهمها:
اللازم: يقال وجب الشيء يجب وجوبا، أي لزم.
الحق: يقال أوجبه الله واستوجبه، أي استحقه.
الساقط: يقال وجب الحائط يجب وجبا ووجوبا إذا سقط، ومنه قوله تعالى: ]فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا[ (سورة الحـج :36).
والمعنى الثالث هو الأصل في الوجوب قال ابن منظور: وأصل الوجوب السقوط والوقوع(1).
الواجب اصطلاحا: للواجب عند الأصوليين عدة تعريفات مختلفة لكن معناها واحد، وهو أن الواجب مالا تتحقق الطاعة ولا تحصل السلامة من المطالبة بعهدته إلا بالإتيان به والانصياع له.
فقد عرفه الإمام الباقلاني بقوله: “ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك له” وهذا التعريف ارتضاه الإمام الغزالي وقال عنه الصفي الهندي: وارتضاه جمهور الأصحاب (2).
وعرفه الإمام الآمدي بقوله: والحق في ذلك أن يقال: الوجوب الشرعي عبارة خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما (3).
وعرفه الإمام الطوفي بقوله : والمختار في حد الواجب أنه: ما ذُم شرعا تاركه مطلقا”(4).
وأقرب هذه التعريفات إلى الصحة ما عرفه به البيضاوي بقوله: الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا(5).
شرح التعريف:
قوله “الذي” اسم موصول صفة لموصوف محذوف تقديره الفعل لما هو معلوم من أن الواجب هو الفعل الذي تعلق به الإيجاب والمراد به فعل المكلف؛ لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين والمقصود بفعل المكلف هو ما صدر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد؛ لأن كلا من هذه الأمور الثلاثة يتعلق بها الإيجاب وبذلك يصير التقدير: الواجب فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ففعل المكلف جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ويخرج عنه ما ليس فعلا للمكلف فلا يتعلق به حكم من الأحكام التكليفية ولا يوصف به وصف من الأوصاف السابقة .
“الذي يذم تاركه” أخرج المندوب والحرام والمكروه والمباح؛ لأن هذه الأقسام لا ذم فيها على الترك، وعادة الأصوليين يقولون “الذي يذم” يخرج المندوب والمكروه والمباح وتاركه يخرج الحرام، يقول الإمام السبكي: وأنا لا أختار هذا؛ لأن “الذي يذم” وحده لا يصلح أن يكون فصلا، ألا ترى أنك لو قلت “الفعل الذي يذم” لم يكن جنسا للمجدود ولا مفيدا للمقصود.
وتاركه اسم فاعل مشتق من الترك ، والترك يطلق بإطلاقين: أحدهما: عدم الإتيان بالفعل سواء توجهت النفس إلى الإتيان به قبل ذلك أم لم تتوجه إليه، وثانيهما: عدم الإتيان بالفعل بعد توجه النفس إليه وهو ما يعبر عنه بكف النفس عن الفعل بعد التوجه إليه، والترك بالمعنى الثاني لا يكون إلا عن قصد بخلافه بالإطلاق الأول فإنه قد يكون عن قصد وقد يكون عن غير قصد والإمام البيضاوي قصد به كما يقول الشيخ زهير الإطلاق الأول لأنه أتى بقوله قصدا بعد ذلك.
وقوله “شرعا” إشارة إلى أن الذم لا يثبت إلا بالشرع، لا بالعقل، كما قرره المعتزلة، فإن العقل وإن كان يدرك في الأشياء الحسن والقبح عندهم إلا أن الذم الذي يصاحبه العقاب، وكذلك المدح الذي يصاحبه الثواب موقوف على الشرع فلا ينازعه العقل في ذلك.
وقدم شرعا على تاركه حتى يتبين أن انتصابه عن يذم.
وقوله “قصدا” أي عمدًا، وهو صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره، تركا قصدا أي مقصودا، فالقصد راجع إلى الترك، وفائدة الإتيان به إدخال بعض الواجبات التي تركت سهوا أو لنوم فإنه لا يذم ولا يخرجه ذلك عن الواجب، فمثلا من دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من الإتيان بها ، فقد وجبت عليه الصلاة وجوبا موسعا، فإذا غفل عن الإتيان بها حتى خرج وقتها أو نام معتقدا أنه سيستيقظ قبل خروج الوقت فغلبه النوم حتى خرج الوقت يصدق عليه أنه ترك واجبا لكن لا يذم على ترك هذا الواجب لوجود العذر، فيكون هذا الواجب خارجا عن التعريف فيكون التعريف غير جامع، فأتى البيضاوي بقوله قصدا ليبين أن خاصة الواجب هي الذم على الترك قصدا، ولا شك أن هذا الواجب الذي ترك سهوا أو لنوم لو تركه قصدا ولغير عذر فإنه يذم على هذا اترك، وبذلك يكون التعريف شاملا له.
وقوله “مطلقا” عائد إلى الترك أيضا، وتقرير ذلك: أن الواجب قد يكون مضيقا كالصوم، وقد يكون موسعا كالصلاة، وقد يكون مخيرا كخصال كفارة اليمين وقد يكون كفائيا كصلاة الجنازة.
فأما الواجب المضيق فإنه يتعين بمجرد دخول وقته، فمن ترك إيقاع العبادة فيه ولا عذر شرعي له في ذلك، لحقه الذم بالترك.
وأما الواجب الموسع فإن المكلف إذا ترك الصلاة في أول وقتها صادق عليه أنه ترك واجبا، إذ الصلاة تجب بأول الوقت، ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت، ويذم إذا أخرجها عن جميع الوقت، فالذم فيها على الترك ليس مضافا إلى بعض أجزاء وقتها، بل إلى جميع أجزاء وقتها.
وكذلك إذا ترك إحدى خصال الكفارة، فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب، ومع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره، بل يتوجه إليه الذم في حالة ما إذا ترك جميع الخصال تركا مطلقا.
وتارك صلاة الجنازة تارك لما هو واجب عليه، ومع ذلك لا يذم على تركها إذا فعلها غيره، أما إن لم يفعلها غيره وغلب على ظنه ذلك، فلم يفعل، لحقه الذم لترك الواجب مطلقا(6).
وبذلك يكون هذا التعريف جامعا للواجب بجميع أنواعه، مانعا من دخول غيره فيه.
وهذا التعريف بينه وبين المعاني اللغوية للواجب مناسبة، فإنه ما ذم على تركه إلا لكونه حقا لازما، سقطت حتمية المطالبة به على المكلفين فلا تبرأ ذممهم من فعله إلا بالقيام به على وجهه الشرعي الصحيح.
أقسام الواجب:
الواجب ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:
فهو ينقسم باعتبار ذاته إلى:
واجب معين: وهو الذي طلب الشارع إيقاعه بعينه على سبيل الإلزام، كالصلاة والزكاة والصيام والحج.
وواجب مخير: وهو الذي أمر الشارع فيه بواحد مبهم من أشياء محصورة معينة بالنوع، وذلك كخصال كفارة اليمين وهي الإطعام والكسوة والإعتاق الواردة في قوله تعالى: ]فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة[ٍ (المائدة:89).
وينقسم باعتبار وقته إلى:
واجب مضيق: وهو ما كان الوقت فيه على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص مثل صوم رمضان.
وواجب موسع: وهو ما كان الوقت فيه أزيد من الفعل، كأوقات الصلوات الخمس.
وينقسم باعتبار فاعله إلى:
واجب عيني: وهو ما توجه فيه الأمر إلى كل فرد بعينه، كالصلاة والزكاة والصوم والحج.
وواجب على الكفاية، أو فرض العين وفرض الكفاية(7).
قال الإمام القرافي: الأفعال قسمان، منها ما يتكرر مصلحته بتكرره، ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكررها.
فالقسم الأول شرعه صاحب الشرع على الأعيان تكثيرًا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل، كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه، وهذه المصالح تتكرر كلما كررت الصلاة.
والقسم الثاني كإنقاذ الغريق، فإنه إذا انتشل من البحر فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك كسوة العريان وإطعام الجوعان ونحوهما فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال إذ لا فائدة في الأعيان بالنسبة لها(8).
وعلى ذلك يكون الواجب العيني، ما يطلب فعله شرعا من كل فرد من المكلفين بعينه، ولا يكتفي فيه بقيام الآخرين به، وذلك كأركان الإسلام الخمس، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وإنما سمي عينيا لأن كل مكلف يتوجه إليه بعينه الخطاب ولا تبرأ ذمته إلا بفعله، فلو أدته الأمة جميعها دونه لما سقط عنه التكليف به.
أما الواجب الكفائي فهو ما يطلب فعله شرعا من مجموع المكلفين لا من كل فرد على حدة، وذلك كفريضة الجهاد في سبيل الله ما لم يتطلب الموقف دفاع كل قادر، والصلاة على الموتى، والإفتاء، ورد السلام، والشهادة إذا توقف عليها ظهور الحق وكانت شهادة البعض كافية في إظهاره، وما إلى ذلك من كل واجب يتحقق الغرض منه بقيام بعض المكلفين به، وإنما سمي واجبا كفائيا لأنه يكفي في حصول المأمور به قيام بعض المكلفين بفعله دون البعض، ولهذا فإن ذمة من لم يفعل هذا الواجب تبرأ بفعل غيره، وإن لم يقم به أحد مطلقا فإن الإثم يقع على الجميع.
وفروض الكفايات تشمل الأمور الدينية والدنيوية، قال الزركشي في المنثور: ينقسم إلى ديني ودنيوي، الأول الديني، وهو ضربان:
ما يتعلق بأصول الدين وفروعه، فالأول القيام بإقامة الحجج والبراهين القاطعة على إثبات الصانع وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه، وإثبات النبوات ودفع الشبه والمشكلات.
والثاني كالاشتغال بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه والتبحر في ذلك، جاء في الحديث “طلب العلم فريضة على كل مسلم”(9) قال الحافظ المزي” له طرق يبلغ بها درجة الحسن، وتصنيف الكتب لمن منحه الله تعالى فهما واطلاعا.
وعد الإمام الشهرستاني في كتاب الملل والنحل الاجتهاد من فروض الكفايات قال: حتى لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وإن قصّر فيه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد تَرَتُّبْ المسبَّب على السب ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة، والآراء كلها متماثلة، فلا بد إذن من مجتهد.
ومنه القضاء والفتوى، قال الغزالي في كتاب نهج الشريعة: ولا يُستغني عن الفقيه المفتي المنصوب في الناحية بالقاضي، فإن القاضي ملزم من رفع إليه عند التنازع، والمفتي يرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة …..، وتحمل الشهادة وأداؤها، وتولي الإمامة العظمى، والجهاد حيث الكفار مستقرون في بلادهم، أما إذا ديست أرض الإسلام ففرض عين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يختص بأرباب الولايات، ودفع ضرر المحاويج من المسلمين من كسوة وطعام إذا لم تندفع بزكاة أو بيت مال، ومثله محاويج أهل الذمة، وإغاثة المستغيثين في النائبات، وإقامة الجماعة والآذان والإقامة، وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم، والتقاط المنبوذ، ورد السلام حيث سلّم المسلم عليه جماعة، وجهاد النفس ليرقى بجهاده في درجات الطاعات، ويظهر ما استطاع من الصفات ليقوم بكل إقليم رجل من علماء أهل الباطن كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل منهما يفيد المسترشد على ما هو بصدده ، فالعالم يقتدى به والعارف يهتدى به، وهذا ما لم يستول على النفس طغيانها وانهماكها في عصيانها، فإن كان كذلك صار جهادها فرض عين بكل ما استطاع، فإن عجز عنها استعان عليها بمن يحصل له المقصود من علماء الظاهر والباطن بحسب الحاجة، وهو أكبر الجهادين إلى أن ينصره الله تعالى.
الثاني الدنيوي: كالحرف والصناعات وما به قوام المعاش كالبيع والشراء والحراثة، ومالا بد منه حتى الحجامة والكنس، ومن لطف الله عز وجل جبلت النفوس على القيام بها.
ولو فرض امتناع الخلق منها أثموا، ولم يحك الرافعي والنووي فيه خلافاً وقد صار الإمام الغزالي إلى أنها لا تعد من فروض الكفايات محتجا بأن الطبع يحث عليها فأغنى من حث الشرع بالإيجاب، واستشكل الأول بقولهم إن أصحاب الحرف الدنية لا تقبل شهادتهم، فكيف لا يقبل بفعلهم فرضا، وعد الغزالي في الوسيط من فروض الكفايات المناكحات، وهو مشكل على طريقه في الصنائع، لأن الطبع يحث عليها(10).
وهذه الأمثلة التي ذكرها العلماء إنما هي على سبيل المثال، وهي ما يناسب حاجات مجتمعاتهم، وبالإمكان أن نضبف إليها بعض الأمثلة مما استجد من حاجات في عصرنا، ومعظمها مما يقع في القسم الدنيوي، أما في القسم الديني فلا تعدو الإضافات أن تكون صورا جديدة من المصالح الدينية التي نص عليها العلماء قديما.
ففي القسم الديني:
التركيز على دفع الشبهات التي تثيرها المذاهب الفكرية المعاصرة.
التجديد في وسائل إقامة الحجج والبراهين وفقا لمنطق العصر وعلومه.
الاشتغال بعلوم الشرع من منطلق تطبيقها على الحياة المعاصرة.
تصنيف الكتب وفقا لمخطط يسد الثغرات الناشئة عن توقف الحياة الفكرية بسد باب الاجتهاد لعدة قرون.
استخدام مختلف الوسائل في تيسير وصول القرآن والحديث والعلوم الشرعية إلى الناس من موسوعات ومعاجم وفهارس وأدمغة الكترونية ووسائل الاتصال الأخرى.
إقامة مؤسسات الاجتهاد الجماعي، ومؤسسات إعداد المجتهدين بما يكفل ازدهارالاجتهاد وأداء وظيفته.
إقامة مؤسسة الإمامة بما يكفل وحدة المسلمين وتعاونهم وتطبيق مبدأ الشورى.
الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحربية بما يكفل القيام بواجب الإعداد دون اعتماد على غير المسلمين.
تعميم الإعداد والتعبئة الشاملة للأمة بما يكفل دفع العدوان عنها وحماية السلام العادل.
إقامة مؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أنظمة متخصصة متطورة تكفل تحقيق الوظيفة دون تعسف في الفهم أو إساءة في الممارسة، ومع بقاء دور الأفراد كاملا غير منقوص وكفالة، وتنظيم قيامهم بهذا الواجب.
وضع النظم وإقامة المؤسسات الكفيلة بتأمين ضرورات المعيشة من غذاء وكساء ومسكن وصحة وتعليم مجانا لغير القادرين وتنظيم التأمينات الاجتماعية بكافة صورها لجميع المواطنين.
وفي القسم الدنيوي:
تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات الاقتصادية بدءا بالضروريات من زراعة وصناعات لمتطلبات الغذاء والملبس والمسكن والصحة والتعليم بما يكفل الاستقلال الاقتصادي للأمة الإسلامية، وتيسير هذه الضروريات مجانا لغير القادرين وبأسعار معقولة للقادرين.
إقامة المعاهد التعليمية ومؤسسات البحث العلمي، والنظم التدريبية الكفيلة بتقدم الأمة في جميع المجالات، وتكوين العناصر المتخصصة المدربة اللازمة لتغطية هذه المجالات.
إقامة المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية في إطار الشريعة ووفق مبادئها(11).
والتقسيم إلى الكفاية والأعيان كما يكون في الواجبات يكون في المندوبات، كالآذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية.
وقد جمع بعض العلماء سنن الكفاية في قوله:
آذان وتشميت وفعل بميت
إذا كان مندوبا وللأكل بسملة
وأضحية من أهل بيت تعددوا
وبدء سلام والإقامة فاعقلا
فذي سبعة إن جاء بها البعض يكتفى
ويسقط لوم عن سواه تكملا
وعلى الأعيان كالوتر عند غير الحنفية، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك، والصدقات.
وقد تكون الجزئية الواحدة فرض عين في حالة وفرض كفاية في حالة أخرى، فإذا تعيّن لإظهار الحق فرض ذاته كان أداء الواجب عينا؛ فإذا لم يكن في الجهة إلا طبيب واحد لا يحصل علاج المريض بدونه، كان قيامه بهذا العلاج فرضا عينيا، وكذا بالنسبة للإفتاء والإرشاد والأمر بالمعروف، فالمناط في اعتباره كفائيا أو عينيا هو إمكان تحقق المصلحة أو المطلوب الشرعي بغيره أو تعينه هو، ومع صيرورته واجبا عينيا فإن أصله واجب كفائي؛ إذ يسقط عنه التكليف بفعل الغير ولم يطلب فعله من كل فرد أصلا.
تعريف فرض الكفاية:
تعريفه لغة:
الفرض في اللغة: يطلق على عدة معان منها:
الواجب، وإنما سمي الواجب فرضا لأن له معالم وحدودا، ومن ذلك قوله تعالى: ]فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ[ (سورة البقرة: 197) أي أوجبه على نفسه بإحرامه.
التوقيت: وكل واجب مؤقت فهو مفروض.
القراءة: يقال: فرضت جزئي، أي قرأته.
البيان: ومنه قوله تعالى: ]سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا[ (سورة النــور:1) أي بيّنا ما فيها من الحلال والحرام والحدود، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ]قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ[ (سورة التحريم: 2) أي بيّنها.
الحز: يقال فرض مسواكه فهو يفرضه فرضا، إذا حزه بأسنانه، ومن ذلك الحز الذي في القوس، فإنه يسمى فرضا وفرضة.
الهبة: يقال ما أعطاني فرضا ولا قرضا، أي ما أعطاني هبة(12).
الكفاية في اللغة: تطلق على عدة معان منها:
القيام بالأمر، يقال كفى يكفي كفاية، إذا قام بالأمر، ويقال استكفيته أمرا فكفانيه، أي قام به دوني.
الاستغناء: ومنه قوله r: “من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه” (13) أي أغنتاه عن قيام الليل.
الاتقاء: وقد فسر العلماء قوله r في الحديث السابق “كفتاه” بمعنى تكفيان الشر وتقيان من المكروه(14).
والمعنى الأول هو الأصل، فإن من قام بالأمر عن غيره يكون بذلك قد أغناه عن نفسه ووقاه أعباء المهمة، وإذا اعتبرنا المعنى الأول من معاني الفرض، وهو الواجب الأصل للمعاني الذي يطلق عليها لفظ الفرض فإننا بذلك نصل إلى القول بأن فرض الكفاية في اللغة هو: الواجب الذي قام به الإنسان نيابة عن غيره.
تعريفه اصطلاحا:
سمي فرض كفاية لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع في وجود الفعل، ويكفي في سقوط الإثم عن الباقين(15).
عرفه ابن السبكي بقوله: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله(16). أصل هذا التعريف للإمام الغزالي في الوجيز، إلا أنه قال كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله(17). قال الإمام الرافعي فيما نقله عنه السيوطي: ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية يتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فقصد الشارع تحصيلها، ولم يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها بخلاف فروض الأعيان، فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها(18).
وعرفه الإسنوي بأنه: طلب إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، حيث قال: وإن كان المقصود من الواجب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية(19).
وعرفه أمير بادشاه بقوله: مهم متحتم قُصد حصوله من غير نظر إلى فاعله(20).
وهذه التعريفات الثلاثة تتفق في المعنى وهو: أن المقصود من فرض الكفاية، وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود وقوع الفعل مع النظر إلى الفاعل ذاته.
على أن الإمام الزركشي اعترض على هذا المعنى فقال: الحق أن فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله، بدليل الثواب والعقاب(21).
أي أنه لو قطع النظر عن فاعل الفرض الكفائي لما استحق ذلك الفاعل الثواب على فعله أو العقاب على تركه، فكونه يكون محلا للثواب والعقاب دليل على أنه مراعى من حيث النظر.
ومن الممكن أن يكون الخلاف في كون الفاعل داخلا في دائرة النظر أو خارجا عنها ليس له ثمرة عملية، فهو خلاف لفظي لاتفاقهم على أن الفاعل وإن لم ينظر إليه أصالة فهو منظور إليه تبعا، ضرورة أن الفعل لا يحصل بدون فاعل، وبحكم هذا النظر فهو مثاب أو معاقب.
وهذه التعريفات مع كونها متفقة في المعنى إلا أنه يلاحظ أن ابن السبكي لم يقيد قصد الحصول بالحتمية وهي الجزم، وإنما اكتفى بقوله “مهم يقصد حصوله” وهذا بخلاف ما فعله صاحب تيسير التحرير فإنه قيد الحصول بالحتمية حيث قال “مهم محتم” ثم ذكر فائدة هذا القيد بقوله “فخرج المسنون لأنه غير محتم”(22).
والظاهر أن التقييد بالحتمية لا ضرورة له في التعريف، ،ذلك لأن فرض الكفاية يخرج تلقائيا المسنون لأنه ليس فرضا، وأيضا فإن الغرض هنا تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، فلا وجود لسنة الكفاية بينهما، وفي ذلك يقول المحلي في شرحه لتعريف ابن السبكي: “ولم يقيد قيد الحصول بالجزم احترازا عن السنة، لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وذلك حاصل بما ذكر(23).
شرح التعريف:
قولهم: “مهم” أي أمر يهتم به، وهو جنس في التعريف يشمل فرض العين وفرض الكفاية، فكلاهما موضع الرعاية والاهتمام، والمهم قسمان: مهم لا بد من حصوله، ومهم يشرع حصوله، وقيده الإمام الغزالي بقوله ديني، وحذفه ابن السبكي لأن فرض الكفاية يكون في الحرف والصناعات وما يقوم به معاش الخلق وليست دينية.
وقولهم: “يقصد حصوله” أي من قبل الشرع.
وقولهم: “من غير نظر إلى فاعله” فصل يخرج به فرض العين إذ قصد الفاعل فيه ذاتي فيكون محلا للنظر، وهذا النظر إما خصوص شخصه كالمفروض على النبي r دون أمته، وإما كل واحد من المكلفين(24).
العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية لتعريف فرض الكفاية:
العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية لتعريف فرض الكفاية وثيقة جدا وذلك من وجهين:
الأول: أن هذا المهم الذي قصد الشارع حصوله هو ذلك الفعل الذي قام به الإنسان فردا أو جماعة بحيث تحققت الكفاية بفعله أو بفعلهم عن غيرهم من المكلفين.
الثاني: أن هذا المهم الذي قصد الشارع حصوله تنطبق عليه المعاني اللغوية الستة الذي ذكرها أهل اللغة تفسيرا لكلمة الفرض، وإذا اعتبرنا المعنى القائل بأن الفرض “الحز” القاسم المشترك الأعظم الذي يجمع تلك المعاني، فإن هذا المعنى واضح غاية الوضوح في المعنى الأول وهو الواجب، إذ سبق أن معناه في اللغة “الساقط” ولا شك أن في السقوط تأثيرا بالغا يحز في نفس المسقط عليه، والتأثير في الواجب يمكن في التكليف به الذي تصاحبه المشقة، وهي وإن كانت في محيط الوسع والقدرة والإمكان إلا أنها ثقيلة على النفس، ولا يعدم الشعور بهذا الثقل إلا المؤمن الحق الذي سمت نفسه وزكت جوارحه، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى في شأن الصلاة التي هي فرض عين ]وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ[ (سورة البقرة: 45).
وكذلك الشأن بالنسبة لفرض الكفاية، فإن المسلم المعظم لشعائر الله تعالى يرى حاله وكأنه المسؤول الأول عن تنفيذ ذلك الفرض، فيجاهد نفسه على فعله وإيجاده.
والحز ظاهر في المعنى الثاني وهو “التوقيت” فإن المؤمن يظل قلبه معلقا بتحري وقت العبادة، ويكون فكره مشغولا بذلك لا يهدأ باله حتى يؤدي تلك العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، وهذا ما يدل عليه قوله r: “سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله” وذكر “ورجل قلبه معلق بالمساجد”(25).
وإذا كان يحز في قلبه ترك الفرض العيني فإنه يحز في نفسه كذلك التساهل في القيام بالفرض الكفائي.
وهو متحقق في المعنى الثالث وهو “القراءة” فإن الفروض والواجبات الشرعية قد ثبتت بخطاب الشارع لوقفها عليه دون غيره، وقراءة ذلك الخطاب تثير في المكلف جانب الانصياع والامتثال للقيام بأداء ما أمره الشارع به وكف النفس عما نهاه الشارع عنه.
والفرض الشرعي حين يؤدى على وجهه الصحيح يحز في النفس، بمعنى أنه يترك فيها أثر الصلاح والاستقامة، وهو بذلك يقطع عن النفس سبل الوقوع في الضلالة والغواية، قال تعالى: ]وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[ (سورة الأنعام: 153).
وهو بارز في المعنى الرابع وهو “البيان” فإن المبين يحز في المبين بإزالة ما قد يصاحبه من غموض، سواء كان ذلك في اللفظ من جهة الدلالة أو في العبادة من جهة الكيفية، وهذا من شأنه أن يجعل المكلف على بينة من أمره
وهو أيضا متأكد في المعنى السادس وهو “الهبة” فإن لها تأثيرا عجيبا في ترابط القلوب، وهذا ما أرشد إليه النبي r بقوله: “تهادوا تحابوا”(26).
والفروض والواجبات الشرعية هي في حقيقتها هبة ربانية ومنحة إلهية امتن الله تعالى بها على عباده لاستصلاح نفوسهم وتهذيب سلوكهم وتقويم أخلاقهم، ومن وعى هذه الحقيقة تعلق قلبه بربه حبا وإجلالا لعظمته وشكرا لمزيد إحسانه وجزيل امتنانه(27).
الفرق بين الفرض والواجب:
الفرض والواجب لا يختلف مفهومهما من حيث المدلول الاصطلاحي عند جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة، بل إن الفرض والواجب عندهم مترادفان، أي اسمان لمسمى واحد.
قال الإمام الباقلاني:”قولنا واجب وفرض ولازم وحتم واحد”(28).
وقال المرداوي: الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر أن الفرض والواجب لفظان مترادفان، أي متحدان مفهوما، لقوله تعالى: ]فمن فرض فيهن الحج[ (البقرة: 197) أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره، نفيا للمجاز والاشتراك (29) وقال الزركشي: ولا فرق عندنا بين الفرض والواجب شرعا، وإن كانا مختلفين في اللغة، إذ الفرض في اللغة التقدير، ومنه فرض القاضي النفقة، والوجوب في اللغة الثبوت(30).
واستدلوا على ذلك: بقوله r للأعرابي لما قال: “هل عليّ غيرها؟ قال: لا ، إلا أن تطوع شيئا”(31) فإن النبي r لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات، ولو كان واسطة لبينها.
واستدلوا أيضا: بأنهما استويا في الحد، أي أن كلا منهما يذم تاركه شرعا، فوجب أن يستويا في الحقيقة، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر(32).
وخالف في ذلك الحنفية حيث فرقوا بين الفرض والواجب، فجعلوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي يوجب العلم والعمل لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا(33).
قال الإمام السرخسي: فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، وفي الاسم ما يدل على ذلك كله، فإن الفرض لغة التقدير، قال الله تعالى: ]فنصف ما فرضتم[ (البقرة: 237) أي قدرتم بالتسمية، وقال تعالى: ]سورة أنزلناها وفرضناها[ (النور: 1) أي قطعنا الأحكام قطعا، وفي هذا الاسم ما ينبئ عن التخفيف لأنه مقدر متناه كيلا يصعب علينا أداؤه…. فأما الواجب فهو ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة والاسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط، قال الله تعالى: ]فإذا وجبت جنوبها[ (الحج: 36) أي سقطت على الأرض، فما يكون ساقطا عملا بلزومه إياه من غير أن يكون موجبا للعلم قطعا يسمى واجبا، أو هو ساقط في حق الاعتقاد قطعا وإن كان ثابتا في حق لزوم الأداء عملا، والفرض والواجب كل واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر، ومنه سمي الحز في الخشبة فرضا لبقاء أثره على كل حال، ويسمى السقوط على الأرض وجوبا لأنه قد لا يبقى أثره في الباقي، فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا لبقاء أثره وهو العلم به أدّى أولم يؤدّ، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجبا(34).
وهذا الخلاف خلاف لفظي لا معنوي، إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا، هل يسمى واجبا؟ وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا؟(35).
قال الإمام الغزالي: فإن قيل: فهل من فرق بين الفرض والواجب؟ قلنا: لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم، وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه، وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني(36).
وقال ابن قدامة: ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى(37).
وقال الآمدي بعد أن حكى الخلاف: وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض المقطوع به، فمن باب التحكم، حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا كان مقطوعا به أو مظنونا، فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا، وبالجملة فالمسألة لفظية(38).
وقال ابن نظام الدين الأنصاري الحنفي: فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في المعنى، إلى أن قال: ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوي في الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل؟ فقد غلط، كيف وأن النصوص كلها كانت قطعية في زمن الرسول r والظن إنما نشأ من بعد ذلك الزمان، ومن البين أن إطلاق الافتراض في لسان الشرع ليس إلا على الإلزام لا غير والذي أوقعه فيهذا الغلط ما بيّن القاضي الإمام أبو زيد في وجه التسمية بالافتراض(39).
تنبيه: الذي نصره أكثر الأصوليين أن الواجب مرادف للفرض، لكن أحكام الفرع قد بنيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء من الشافعية وغيرهم قد ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان، وحكمهما مختلف من وجهين : أحدهما: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب . والثاني:أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته حيث جبرت بالدم دون الأركان(40).
الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين:
فرض الكفاية هل هناك فرق بينه وبين فرض العين؟
اختلف الأصوليون في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه ليس هناك فرق في الحقيقة بين فرض الكفاية وفرض العين، وممن قال بذلك ابن برهان والآمدي وصفي الدين الهندي.
قال ابن برهان: لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية خلافا لبعض العلماء(41).
وقال الآمدي: لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهما خلافا لبعض الناس، مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالاختلاف في طريق الثبوت(42).
وقال الإمام صفي الدين الهندي: لا فرق عند الأكثرين بين الواجب على الكفاية وبين واجب العين في حقيقة الوجوب، فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك المعنوي(43).
القول الثاني: أن فرض الكفاية يفارق فرض العين، وممن قال بذلك القرافي والمرداوي والطوفي والإسنوي والزركشي.
قال القرافي: الفعل على قسمين، منه ما تتكرر مصلحته بتكرره، كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة، وفرض الكفاية: ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، كإنقاذ الغريق، فإنه إذا شيل من البحر فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجائع، وكذلك كسوة العريان وقتل الكفار، فالقسم الأول جعله الشارع على الأعيان تكثيرا للمصلحة، والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان.
هذه القاعدة هي سر ما يشرع على الكفاية وما يشرع على الأعيان، تكرار المصلحة وعدم تكررها، فمن علم ذلك علم ما هو الذي يكون على الكفاية وما هو الذي يكون على الأعيان في الشريعة(44).
وقال المرداوي: ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداءً يعني على القول بأنه واجب على الجميع وإنما يفترقان في ثاني الحال وهو فرق حكمي(45).
وقال الإمام الطوفي: واعلم أن التعبد والمصلحة مشتركان بين فرض الكفاية والعين، أعني أن كل واحد منهما عبادة يتضمن مصلحة، فالجهاد عبادة، بمعنى أن الله تعالى أمر به وطاعته فيه واجبة،والانقياد إلى امتثال أمره فيه لازم، ومصلحته ظاهرة، والمصلحة في الحج ونحوه من العبادات، هو طاعة الله تعالى بفعلها تعظيما لأمره، ولما يترتب عليها للمكلفين من الفوائد الأخروية، والتعبد فيه ظاهر، وإذا كان التعبد والمصلحة موجودين في فرض الكفاية والعين فالفرق بينهما: أن المقصود في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها، وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله(46).
وقال الإسنوي: وسُمي، أي فرض الكفاية، بذلك؛ لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين مع كونه واجبا على الجميع، بخلاف فرض العين فإنه يجب إيقاعه من كل عين، أو من عين معينة(47).
وقال الزركشي: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة بل يباينه بالنوع؛ لأن كلا منهما لا بد من وقوعه، غير أن الأول شمل جميع المكلفين، والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض؛ لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة، فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي على الأصح(48).
واستدل أصحاب القول الأول على نفي الفارق بينهما: بأن كلا من فرض الكفاية وفرض العين قد استويا من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهما فوجب أن يستويا من جهة الحقيقة، فإنه يتعرض للعقاب بترك كل واحد منهما(49).
قال الهندي: والحق هو ما اختاره الجمهور، لأن حد الواجب يشملهما على السواء والاختلاف في طريق الإسقاط اختلاف في العوارض وذلك لا يوجب اختلاف الماهية فيكون اللفظ متواطئا(50).
واستدل أصحاب القول الثاني على إثبات الفرق بينهما بدليلين:
الأول: أن فرض العين لا يسقط عن المكلف بفعل غيره، وفرض الكفاية يسقط عنه بفعل غيره، فإن الجهاد والأذان والصلاة على الميت إذا قام به البعض سقط عن الباقين لأنه فرض على الكفاية، والصلوات الخمس إذا قام بها بعض المكلفين فإنها لا تسقط عن الباقين لأنها فرض عين(51).
الدليل الثاني: أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس وغيرها، فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه، وهذه الآداب تتكرر كلما كررت الصلاة، وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحتها بتكرره كإنجاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها، فظهر من ذلك أنهما متباينان تباين النوعين خلافا للمعتزلة في قولهم: تباين الجنسين، إذ الواجب أو المندوب صادق على الأمرين بالتواطؤ من حيث إن كلا منهما لا بد من وقوعه، أو وقوعه محصل لما يترتب عليه من الثواب(52).
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من وجود الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، وذلك لأن انتفاء الفرق بينهما من جهة الوجوب كما ذكر أصحاب القول الأول في دليلهم هو محل اتفاق بين جميع الأصوليين، إذ كل منهما واجب شرعي؛ إلا أن الوجوب في فرض العين متعلق بكل فرد بعينه، والوجوب في فرض الكفاية متعلق بمجموع الأمة حتى يقوم به البعض فتسقط عهدة المطالبة به عن الباقين، وإذا كان حد الواجب شاملا لهما باتفاق الأصوليين فإن ما ذكره أصحاب القول الأول خارج عن محل النزاع.
ولكن كون وجود الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين هو الراجح لا يعني بحال أن الفرق بينهما يفضي إلى تباينهما بالجنس كما قرر المعتزلة، وإنما يفضي إلى تباينهما بالنوع، وهذا ما عبر عنه المرداوي بقوله: فهما متباينان تباين النوعين، خلافا للمعتزلة في قولهم: تباين الجنسين(53)؛ وعبر عنه الزركشي بقوله: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة بل يباينه بالنوع؛ لأن كلا منهما لا بد من وقوعه غير أن الأول شمل جميع المكلفين والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك، لكنه يسقط بفعل البعض، لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة، فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي على الأصح(54).
ولا يعني أيضا كون الراجح قول القائلين بوجود الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن الخلاف في هذه المسألة له ثمرة، بل هو خلاف صوري، وذلك لأن كلا الفريقين يتفق مع الآخر على أن فرض الكفاية وفرض العين مشتركان في الوجوب، كما أنهما متفقان على سقوط فرض الكفاية بفعل البعض، وإنما اختلفوا في هذا السقوط من حيث المسقط، هل هو الغير نيابة عنهم أو هو انتفاء حكمة الوجوب؟
فذهب بعضهم إلى أن المسقط هو فعل الغير نيابة عنهم، كما صرح بذلك الإمام الشافعي حيث قال: كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم(55).
وذهب بعضهم إلى أن المسقط هو انتفاء حكمة الوجوب كما صرح بذلك القرافي حيث قال: سؤال: إذا تقرر الوجوب على جملة الطوائف في فرض الكفاية فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره، مع أن الفعل البدني كصلاة الجنازة والجهاد مثلا لا يجزئ فيه فعل أحد عن أحد؟ فكيف يسوي الشارع بين من فعل ومن لم يفعل.
جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف، واختلف السبب، فسبب سقوطه عن الفاعل فعله، وعن غير الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته.
لا يلزم من حصول المساواة في أصل السقوط حصول المساواة مطلقا في الثواب وغيره، بل حصل التساوي في أصل السقوط، لأن الغريق إذا شيل من البحر يبقى التكليف بعد ذلك بنزول البحر لا فائدة فيه، فلا تكليف حينئذ فيحصل التساوي في أصل السقوط، ويمتاز الفاعل بالثواب على فعله إن فعله تقربا(56).
وخلافهم في هذا لا ينهض خلافًا في معنى بعد اتفاقهم على أنه لا يحصل فعل من غير فاعل.
قال الزركشي: قولهم: ويسقط بفعل البعض فيه تجوز، فإن علة السقوط بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب لا فعل البعض، لكن لما كان فعل البعض سببا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط إليه تجوزا(57).
ضابط تحقق فرض الكفاية:
قال الإمام صفي الدين الهندي موضحا ضابط فرض الكفاية:
والضابط فيه أن كل ما يكون المقصود منه حاصلا ولو بفعل البعض، فإذا أوجبه الشارع كان ذلك واجبا على الكفاية كدفن الميت، فإن المقصود منه ستره بالتراب وهو حاصل بفعل البعض، وكذلك الجهاد فإن المقصود منه إذلال العدو وقهره، وهو أيضا قد يحصل بفعل البعض، فلا جرم كان وجوبهما على الكفاية، وأما ما لا يكون كذلك فإنه يكون واجبا على العين(58).
ومعنى هذا الضابط كما يقول د. على الضويحي(59) أن فرض الكفاية ليس محكوما بالعدد بقدر ما هو محكوم بتحقق المصلحة فهو يدور مع المصلحة وجودا وعدما، فإذا تحققت المصلحة بفعل الواحد كالصلاة على الميت مثلا كان فعل ذلك الواحد كافيا في سقوط الفرض عن الآخرين؛ لتأهل ذلك الفعل لإنجاز الحكمة التي من أجلها أمر الشارع الحكيم بهذا الفرض.
وإذا لم تتحقق المصلحة بفعل الواحد لم يسقط الفرض عنه ولا عن الآخرين، حتى يتوافر العدد المؤهل للقيام بتلك المصلحة، وإذا حققوا بفعلهم مصلحة الفرض سقط عن الباقين لحصول الاكتفاء بهؤلاء عن غيرهم ممن لم يباشروا الفعل بأنفسهم.
فإذا كان البلد مزدحما بالعدد الكبير من الناس، والأمراض محدقة بهم، وهو بأمس الحاجة إلى أطباء، ولا يوجد إلا طبيب واحد، فإن حد الكفاية لا يتحقق بهذا الطبيب الواحد، فلا بد للأمة أن تحث أبنائها على تعلم مهنة الطب ممن لديهم الميول لتعلم هذه المهنة حتى يصبح لديها من الأطباء من تقوم بهم الكفاية لمعالجة المرضى والقضاء على الأمراض.
وكذلك الشأن بالنسبة للحدادة والزراعة والصناعة وغيرها من سائر الحرف والتخصصات التي تمس حاجة الناس إليها.
وكذلك من وجد في نفسه القدرة على دراسة العلم الشرعي والتفقه فيه، وجب عليه الإقبال على ذلك سدا لحاجة الأمة في القضاء والإمامة والخطابة والإفتاء ونحوها.
والمسئولية في ذلك لا تقع على كاهل الفرد دون الأمة ولا الأمة دون الفرد، وإنما هي مسئولية مشتركة بين الجميع أفرادا وجماعات، فالفرد الذي يجد في نفسه القدرة على التعلم أو القدرة على اكتساب حرفة وجب عليه أن يمسك بزمام المبادرة إلى التعلم والاكتساب دون تكاسل أو تباطؤ، ودون انتظار دفع من أحد، فإن لم يبادر إلى ذلك وأهمل في استثمار ما لديه من طاقات وقدرات وإمكانات وجب على الأمة أن تحمله على ذلك حملا، حفظا لمصلحتها من الضياع وصونا لكرامتها من المهانة، حتى لا تكون عالة على أعدائها المتربصين.
وخلاصة القول في ذلك: أن الله تبارك وتعالى كلف الأمة بفرض الكفاية لتحقيق مصلحة أرادها لهم من جلب مصلحة أو دفع ضرر، وهذه المصلحة لا بد من إيجادها، فإذا وجدت حصل المراد وتحققت الكفاية.
بمعنى أن فرض الكفاية منظور فيه إلى تحقق المصلحة بصرف النظر عن الفاعل واحدا كان أو أكثر.
قال العز بن عبد السلام: واعلم أن المقصود بفرض الكفاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء الأعيان بتكليفه(60).
ويرى الإمام الطوفي أن المقصود في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها، حيث قال: فرض الكفاية، ما مقصود الشرع فعله، لتضمنه مصلحة، لا تعبد أعيان المكلفين به، كصلاة الجنازة والجهاد، لا الجمعة والحج، فإن صلاة الجنازة والجهاد مقصود الشرع فعلهما، لما تضمناه من مصلحة الشفاعة للميت، وحماية بلاد الإسلام من استباحة العدو لها، ولم يرد بها تعبد أعيان المكلفين، بخلاف الجمعة والحج، فإن المقصود بهما تعبد أعيان المكلفين ممن وجدت فيه شروط وجوبهما، ثم قال: واعلم أن التعبد والمصلحة مشتركان بين فرض الكفاية والعين، أعني أن كل واحد منهما عبادة يتضمن مصلحة، فالجهاد عبادة بمعنى أن الله عز وجل أمر به وطاعته فيه واجبة، والانقياد إلى امتثال أمره فيه لازم ومصلحته ظاهرة، والمصلحة في الحج ونحوه من العبادات هو طاعة الله تعالى بفعلها، تعظيما لأمره ولما يترتب عليها للمكلفين من الفوائد الأخروية، والتعبد فيه ظاهر، وإذا كان التعبد والمصلحة موجودين في فرض الكفاية والعين، فالفرق بينهما أن المصلحة في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله(61).
أيهما أفضل القيام بفرض العين أم القيام بفرض الكفاية؟
اختلف العلماء في أيهما أفضل القيام بفرض العين أم القيام بفرض الكفاية على قولين:
القول الأول: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين وممن ذهب إلى هذا القول أبو إسحاق الإسفراييني وأبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين(62).
واستدلوا على ذلك: بأن فرض الكفاية إذا قام به الإنسان فإنه بذلك يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، وهذا بخلاف فرض العين، فإنه إن قام به فلا يسقط الفرض بذلك إلا عن نفسه فقط، وما ترتب عليه الإسقاط العام أولى مما ترتب عليه الإسقاط الخاص، لكون النفع في الأول متعديا وفي الثاني قاصرا، وما كان نفعه أكثر فهو مقدم على ما كان نفعه أقل(63).
قال إمام الحرمين: ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات، وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان، فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام، اختص المأثم به، ولو أقامه فهو المثاب، ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات فالقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب، وآمِل أفضل الثواب، ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدين(64).
قال الزركشي: قال في الروضة: للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين، من حيث إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين.
قلت: وهذه العبارة أولى وأحسن من قول إمام الحرمين فإنه لا يلزم من المزية الأفضلية، فقد يختص المفضول بأمر ويفضله الفاضل بأمور.
أما عبارة إمام الحرمين فقد أخذها الناس منه مسلمة تقليدا، ولا ينبغي ذلك، فإنه إن كان المراد إذا ازدحما في وقت واحد ولا يسع الزمن إلا أحدهما، فلا شك في تقديم فرض العين إلا أن يكون له بدل، كما في سقوط الجمعة ممن له قريب ممرض بل قالوا: لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة، على المذهب، وقال أبو محمد الجنازة، لأن للجمعة بدلا، وإن كان الوقت متسعا لهما، فتقديم فرض الكفاية لا يقتضي أفضليته، ألا ترى أنه لو اجتمع كسوف وفرض ولم يخف فوات الفرض، قدم الكسوف كيلا يفوت مع أن الكسوف سنة فلم يكن تقديمه حكما بأفضليته.
ولو كان في طواف الفرض وحصلت له جنازة، كره له قطع الطواف قاله الرافعي إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية .
ويدل لما ذكرنا أيضا أن الشروع في فرض العين يلزم به حتى لو خرج منه كان قضاء، وإن وقع في الوقت، وفي الشروع في فرض الكفاية خلاف،والظاهر أن القائلين بتفضيل الكفاية على العين أرادوا به الجنس على الجنس وهو منازع بقوله r: “لن يتقرب المتقربون إلا بمثل أداء ما افترضت عليهم” (65) مع أن في تعلق فرض الكفاية بالجميع خلافا.
وأما الشبهة التي استند إليها هذا القائل فمبنية على أن العمل المتعدي أفضل من القاصر وليست بقاعدة مطردة، وبتقدير التسليم فلا شك في تخصيصه بمن سبق إليه أولا، أما مَن فعله ثانيا فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين، وإن قلنا يقع فرضا؛ لأن السقوط حصل بالأول، وتسمية الثاني فرضا إنما هو لحصول ثواب الفرض. اهـ (66).
وقد أورد الإمام السيوطي هذه المسألة وذكر أن إمام الحرمين ووالده والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يرون أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وحكاه أبو علي السنجي عن أهل التحقيق، قال السيوطي: والمتبادر إلى الأذهان خلافه(67).
القول الثاني: وهو قول جمهور العلماء: أن القيام بفرض العين أفضل من القيام بفرض الكفاية(68).
قال الإمام الغزالي في الإحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف: أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرع من فروض الأعيان، قال: ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض الكفاية وزعم أن مقصده الحق فهو كذاب، ومثاله: من ترك الصلاة في نفسه وتبحر في تحصيل الثياب ونسجها، ويقول: غرضي أستر عورة من يصلي عريانا. أهـ (69).
قال الإمام القرافي: وبقدم فرض الأعيان على الكفاية، لأن طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي أرجحية على ما طلب من البعض فقط(70).
وقال ابن النجار: وفرض العين أفضل من فرض الكفاية ، لأن فرض العين أهم، ولأجل ذلك وجب على الأعيان. وبعد أن قرر أفضلية العيني على الكفائي ذكر أن تفضيل العيني هو قول أكثر العلماء(71).
وقال الإمام جلال الدين المحلي: والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب(72).
واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة كلها عقلية:
منها: إن النصوص الشرعية قدمت فرض العين على فرض الكفاية، من ذلك تقديم بر الوالدين وهو فرض عين على الجهاد في سبيل الله وهو فرض كفاية.
ومنها: اعتناء الشارع في طلب حصول فروض الأعيان من المكلف أكبر من اعتنائه بفروض الكفاية، أي أن فرض العين آكد من فرض الكفاية بدليل أن الشارع طلب تحصيل فروض الأعيان من آحاد المكلفين ، أما الفروض الكفائية فقد اكتفى بطلب تحصيلها من بعضهم.
ومنها: إن المصلحة في الفرض العيني تتكرر بتكرر الفعل بخلاف الفرض الكفائي فإن المصلحة فيه لا تتكرر لأنه لا يتكرر، والفعل الذي تتكرر مصلحته أقوى في استلزام المصلحة(73).
والراجح في هذه المسألة: أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية.
ومما يدل على ذلك قول النبي r: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله(74). حيث رتب النبي r عصمة الدم والمال على القيام بفروض الأعيان دون فروض الكفايات، وهذه ميزة شرعية تجعل للفرض العيني الأولوية على الفرض الكفائي.
على أنه يمكن الجمع بين القولين بما ذكره الشيخ الزملكاني وحكاه عنه الزركشي حيث قال: ما ذكر من تفضيل فرض الكفاية على فرض العين محمول على ما إذا تعارضا في حق شخص واحد، ولا يكون ذلك إلا عند تعينهما، وحينئذ هما فرض عين، وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى وأما إذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقا بشخص وفرض الكفاية له من يقوم به، ففرض العين أولى(75).
وبيان ما ذكره الشيخ الزملكاني هو أن يهاجم، مثلا، العدو بلدا للمسلمين في نهار رمضان، فيندب الإمام بعض الناس لصد ذلك العدوان، ويكون من بينهم شخص قد أرهقه الصيام بحيث لم يبق له خيار إلا الإفطار أو ترك الجهاد، فيتعارض لديه الفرضان، الصوم وهو فرض عين بحكم الأصل، والجهاد الذي تعين عليه بتكليف الإمام له بالقتال، فحينئذ يكون القيام بالجهاد في حقه أفضل من الصيام فيفطر ليواصل؛ لأن مصلحة الجهاد أكبر من مصلحة الصيام.
أما إذا لم يتعارضا في حقه كأن يتصدى لذلك العدو من تحصل بهم الكفاية دونه، فالأولى أن يقدم الصيام على الجهاد، إذ أن مصلحة الجهاد تحققت بغيره.
ولعل ثمرة الخلاف تكون في المفاضلة في الثواب، فمن ذهب إلى أن القيام بفرض الكفاية أفضل جعل المشتغل بالقيام به أعظم ثوابا من المشتغل بفرض العين، ومن ذهب إلى أن القيام بفرض العين أفضل جعل المشتغل بالقيام به أعظم ثوابا من المشتغل بفرض الكفاية.
هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو بالبعض؟
أولا: اتفق الأصوليون على أن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض.
ثانيا: اختلف الأصوليون في فرض الكفاية هل يتعلق بالكل ثم يسقط بفعل البعض، أو بالبعض المبهم، أو بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا،أو بالبعض المعين على أقوال أربعة :
القول الأول: الجمهور على أن فرض الكفاية يتعلق بالجميع لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول، فإنه ممكن كالكفارة، وهو ما عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة نقله عنهم ابن مفلح وغيره(76) ونص عليه الشافعي في مواضع من الأم منها:
قوله: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى، وهو كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه، وإذا انتدب منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم، والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنهم(77).
وقال في باب السلف فيمن حضر كتاب حق بين رجلين: ولو ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا بل لا أراهم يخرجون من الإثم وأيهم قام به أجزأ عنهم(78) ، وذكر مثله في الشهود إذا دعوا للأداء وجرى عليه الأصحاب في طرقهم وإليه ذهب من الأصوليين الإمام الصيرفي والباقلاني والشيرازي والغزالي وابن الحاجب وابن قدامة وغيرهم(79).
وقال الإمام أحمد: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم(80)(81).
القول الثاني: أن الواجب الكفائي يتعلق بالبعض المبهم، وممن ذهب إلى هذا القول من الأصوليين ابن السبكي والببيضاوي وغيرهما وهو منسوب إلى المعتزلة(82).
وقد نسب ابن السبكي والإسنوي هذا القول إلى الإمام فخر الدين الرازي، إلا أن ابن السبكي لم ينص على أن الرازي ذكر ذلك في المحصول، وإنما قال: وهو على البعض وفاقا للإمام(83). وبناء على ذلك فلعل الإمام الرازي ذكر هذا القول في غير المحصول من كتبه وهذا لا إشكال فيه.
في حين أن الإسنوي قد نص صراحة على أنه مقتضى كلامه في المحصول، حيث قال: وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول(84). وقال المرداوي: وهو مقتضى كلام الرازي في المحصول، قال البرماوي: اختار الرازي وأتباعه أنه على البعض(85). على أن الإمام الرازي ذكر في المحصول ما نصه: الأمر إذا تناول جماعة فإما أن يتناولهم على سبيل الجمع أو لا على سبيل الجمع، فإن تناولهم على سبيل الجمع فقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة، وقد لا يكون كذلك كما في قوله تعالى: ]وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ[ (سورة البقرة: 43).
أما إذا تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات، وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشئ حاصلا بفعل البعض كالجهاد، الذي الغرض منه حراسة المسلمين وإذلال العدو، فمتى حصل ذلك بالبعض لم يلزم الباقين(86).
فقوله: أما إذا تناول الجميع…الخ، صريح في أن الأمر توجه إلى الجماعة وتناولهم لا على سبيل الجمع، أي لا على سبيل الكل المجموعي، بل على سبيل الكل الإفرادي فيكون الخطاب موجها إلى الكل كذلك، وبذلك يكون الوجوب على الجميع لا من حيث كل واحد، وهذا هو عين مذهب الجمهور، فليس مقتضى كلام الإمام في المحصول أن المخاطب البعض، بل مقتضاه أن المخاطب الكل، وأنه متى حصل الغرض من الشئ المطلوب بفعل البعض سقط الطلب عن الباقين(87).
القول الثالث: أن الواجب الكفائي يتعلق بواحد مبهم عندنا معين عند الله تعالى.
القول الرابع: أن الواجب الكفائي يتعلق بالبعض المعين، وهم المشاهدون للشئ كصلاة الجنازة(88).
وأقرب هذه الأقوال قولان الأول القائل: أنفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض، والقول الثاني القائل: أن فرض الكفاية يتعلق بالبعض المبهم، وذلك لأن القول الثالث القائل: أن فرض الكفاية يتعلق بواحد مبهم عندنا معين عند الله تعالى، قول ساقط مهجور لم يصدر ممن يعتد به، وبطلانه بيِّن فإنه يلزم ألا يكون المكلف عالما بما كلف به، ولا يصح من أحد نية أداء الواجب(89).
أما القول الرابع القائل: أن فرض الكفاية يتعلق بالبعض المعين، وهم المشاهدون للشيء كصلاة الجنازة، فهو شرح لقول الجمهور، فإنهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد؛ لأنه تكليف بما لا يطاق(90).
قال الإمام الشافعي: الصلاة على الجنازة ودفنها، لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها، ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها(91).
وبذلك نخلص أن في المسألة قولين، هما الأول والثاني، ولذلك سنقتصر عليهما في الاستدلال.
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور القائلون بأن الواجب الكفائي يتعلق بالجميع بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ]كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ[ (سورة البقرة: 216)، وقوله تعالى: ]قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر[ (التوبة: 29)، وقوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة[ (التوبة: 123) والقتال من فروض الكفايات، ومع ذلك فقد وجه الله تعالى الأمر فيه لجميع الأمة، حيث خاطبهم الله تعالى بقوله: “عليكم” في الآية الأولى وبقوله: “قاتلوا” في الثانية والثالثة. قال الإمام الشافعي في مثل هذه الآيات: فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة(92).
الدليل الثاني: قوله r: “طلب العلم فريضة على كل مسلم”(93) فهذا خطاب يعم جميع الأمة في مطلوب هو من فروض الكفايات فيما زاد على فرض العين.
الدليل الثالث: لو كان الوجوب متعلقا بالبعض لما أثم الكل عند الترك، لكن التالي باطل فبطل المقدم وهو تعلقه بالبعض وثبت نقيضه وهو عدم تعلقه به فيكون متعلقا بالكل وهو المطلوب.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن الواجب الكفائي يتعلق بالبعض المبهم بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ]فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ[ (سورة التوبة: 122).
قالوا: إن الله تعالى أمر البعض المبهم بالخروج للتفقه أو الجهاد، وكل منهما فرض على الكفاية، وكلمة “لولا” في الآية تدل على اللوم والتنديم، وذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فأفاد هذا التوجيه أن هذه الطائفة تركت واجبا عليها متعلقا بها فقط.
وحينئذ يكون الخطاب في فرض الكفاية موجها إلى بعض غير معين، وهو المطلوب.
ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهور فقالوا: إن هذه الآية الكريمة ليس فيها ما يدل على خروج بعضهم لتحصل لهم فائدة التفقه.
ولو سلمنا أنها تفيد ما ذكرتموه لكانت معارضة لغيرها من الآيات الدالة على توجه الخطاب في فرض الكفاية إلى الجميع، وحينئذ لا بد من حمل هذه الآية على سقوط التكليف عن الجميع بفعل البعض جمعا للأدلة التي ظاهرها التعارض.
الدليل الثاني: أن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض، ولو كان واجبا على الكل لما سقط بفعل البعض كسائر العبادات.
ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهور فقالوا: أنتم جعلتم سقوط التكليف عن الجميع بفعل بعضهم في فرض الكفاية ملزوما لتوجه الخطاب به إلى البعض المبهم، ونحن لا نسلم بهذه الملازمة؛ إذ المقصود في فرض الكفاية إيجاد الفعل في الواقع وقد وجد، فلم تبق علة الوجوب فسقط، وذلك كسقوط ما على الكفيلين بأداء أحدهما؛ لتحقق المقصود وهو حصول حق الدائن.
الدليل الثالث: إن الإبهام في المكلف كالإبهام في المكلف به، والتكليف بالمكلف به المبهم صحيح، فكذا على المكلف المبهم لحصول المصلحة، ومعنى هذا أنه كما يجوز الأمر بواحد مبهم كما هو الشأن في الواجب التخييري، فكذلك يجوز أن يكون المأمور مبهما في الواجب الكفائي.
ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهور من وجهين:
الأول: أن ما ذكرتموه قياس في مقابلة النصوص فلا يُسمع؛ إذ النصوص قاضية بالوجوب على الكل.
الثاني: أن ما ذكرتموه قياس مع الفارق، إذ تكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به فإنه معقول، وهذا فارق مؤثر.
ومعنى هذا الوجه أن تكليف واحد، أو تكليف بعض غير معين كقوله: أوجبت على أحد هذين، غير معقول، بخلاف التكليف ببعض غير معين كقوله: أوجبت إحدى هذه الخصال، فإنه معقول.
ووجه تأثير هذا الفرق: أن الأول يفضي إلى تعطيل المأمور به بالكلية، لأن كل واحد من المأمورين سيتكل على الآخر في القيام بفعل المطلوب، أما الثاني فإنه لا يفضي إلى ذلك ضرورة أن المكلف إن ترك أحد الخصال فسوف يستعيض عنها بالخصلة الأخرى(94).
الترجيح:
بعد العرض والمناقشة تبين لنا أن الراجح في هذه المسألة قول الجمهور القائلين بأن الواجب الكفائي يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض، وذلك لأن هذا القول يفضي إلى دفع أفراد الأمة للاحتفاء بهذا الفرض من كان أهلا للقيام به ومن لم يكن أهلا لذلك، فمن وجد في نفسه الأهلية وجبت عليه المبادرة إلى الفعل، ومن لم يجد في نفسه الأهلية وجب عليه حث المؤهلين للقيام به، وبذلك يتفاعل الجميع للنهوض بأعباء هذا الفرض بالمباشرة الفعلية من قبل أصحاب القدرات، وبالحث والتشجيع من الآخرين الذين فقدوا القدرة على مباشرة الفرض بأنفسهم.
يقول الإمام الشاطبي : … لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها، فالقادر إذاً مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة، من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب(95).
ثمرة الخلاف في هذه المسألة:
الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له، وذلك أن كل واحد من أصحاب هذين القولين نظر إلى فرض الكفاية من زاوية غير التي نظر منها الآخر.
فمن قال: أن الواجب على البعض المبهم، نظر إلى أن فرض الكفاية يسقط بفعل أي بعض كان طالما أنه من المكلفين، ولا شك أن القائل بالوجوب على الجميع لا يخالفه في ذلك.
ومن قال: بالوجوب على الجميع، نظر إلى أن كل واحد من المكلفين يأثم إثم تارك الفرض إذا تركوه جميعا ولم يحصل مقصود الشارع من فرض الكفاية، ولا شك أن القائل بالوجوب على البعض المبهم لا يخالفه في هذا، فظهر أن الخلاف لفظي(96).
الحكم إذا فعل الجميع فرض الكفاية:
إذا فعل الجميع فرض الكفاية فلا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: أن يفعلوه جميعا دفعة واحدة.
الثانية: أن يفعلوه جميعا بالتعاقب.
أما الحالة الأولى: فقد اتفق الأصوليون على أن الجميع إذا فعلوا فرض الكفاية دفعة واحدة، سقط الفرض عنهم وحصل ثوابه لهم.
ولكن اختلفوا بعد ذلك في وقوع الفعل منهم، هل يقع فرضا لجميعهم أو يقع فرضا لبعضهم ونفلا للبعض الآخر؟ على قولين:
أحدهما: وقوع الفعل لبعضهم فرضا وللبعض الآخر نفلا.
ثانيهما: وقوع الفعل فرضا لجميعهم، وهذا ما صرح به الغزالي، حيث قال: الصحيح من هذه الأقسام الأول وهو عموم الفرضية فإن سقوط الفرض دون الأداء يمكن إما بالنسخ أو بسبب آخر ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض وإن امتنعوا عم الحرج الجميع، ولو خلا بعضهم عن الوجوب لا نفك عن الإثم(97).
وقال المرداوي : وإن فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا، لعدم التمييز، لكن رأيت لإمام الحرمين احتمالا أن يجعل كمسح الرأس في الوضوء دفعة، هل الفرض الكل أو ما يقع عليه الاسم؟ ثم قال: وقد يقول الفطن: رتبة الفرضية فوق السنية، وكل مصل من الجميع ينبغي أن لا يحرم الفرضية، وقد قام بما أمر به، وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح. اهـ(98).
وقال الزركشي: إذا أتى به دفعة جميع من خوطب سقط الفرض عنهم، وحصل ثوابه لهم ويقع فعل كل فرضا إذ ليس بعضهم أولى بوصفه بالقيام بالفرض من البعض فوجب الحكم بالفرضية للجميع(99).
والراجح أن الفعل يقع منهم جميعا على وجه الفرضية وذلك لسببين:
الأول: أنهم فعلوا ما وجه الخطاب فيه إلى عموم الأمة من فرض الكفاية، فكانوا بذلك قائمين بما أمروا به فلا يقع تفلا وقد كان في الأصل فرضا.
الثاني: ليس بعضهم أولى بوصفه بالقيام بالفرض من البعض الآخر فوجب الحكم بالفرضية للجميع(100).
ثمرة الخلاف:
تظهر ثمرة الخلاف في التساوي في درجة الثواب وعدمه، فعند القائلين: أن الفعل يقع فرضا من الجميع، يثابون ثواب الفرض، وعند القائلين: أن الفعل يقع فرضا لبعضهم ونفلا للبعض الآخر، يثاب بعضهم ثواب فرض، والآخر ثواب نفل.
أما الحالة الثانية: وهي فعلهم لفرض الكفاية على التعاقب، فمعنى ذلك أن يقوم من يستقل بفرض الكفاية بفعله ثم يلحق بهم آخرون بعد ذلك، وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:
الأول: أن يلحقوا بهم قبل تحصيل مصلحة فرض الكفاية.
الثاني: أن يلحقوا بهم بعد تحصيل مصلحة فرض الكفاية.
فإن لحقوا بهم قبل تحصيل مصلحته وقع ما فعلوه فرضا مع حصول الكفاية بفعل الأولين، كأن يخرج إلى العدو من يستقل بدفعهم، ثم يلحق بهم آخرون قبل انقضاء القتال، فيكتب لهم أجر الفرض؛ لأن المصلحة لم تكتمل بعد وما حصلت إلا بفعل الجميع، فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا، لأن الواجب يتبع المصالح(101).
قال العز بن عبد السلام: فإذا خاض في فرض الكفاية من يستقل به ثم لحقه آخرون قبل تحصيل مصلحته كان ما فعلوه فرضا وإن حصلت الكفاية بغيرهم؛ لأن مصلحته لم تحصل بعد، وذكر له أمثلة:
أحدها: أن يخرج إلى العدو من يستقل بدفعهم ثم يلحق بهم آخرون قبل انقضاء القتال فيكتب لهم أجر الفرض وإن تفاوتت رتبهم في الثواب بقلة العمل وكثرته.
المثال الثاني أن يقوم بغسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو حمله أو دفنه من تحصل به الكفاية، ثم يلحقهم من يشاركهم في ذلك، فيكون له أجر فرض الكفاية على قدر عمله.
المثال الثالث: أن يشتغل بعلم الشرع من تحصل به الكفاية الواجبة، ثم يلحق بهم من يشتغل به فيكون مفترضا لأن المصلحة لم تكمل بعد(102).
وقد أورد الإمام القرافي سؤالا يثير إشكالا في هذه المسألة فقال: سؤال: هذه المسألة نقض كبير على حد الواجب بأي حد حددتموه؟ فإن هذا اللاحق بالمجاهدين أو غيرهم كان له الترك إجماعا من غير ذم ولا لوم ولا استحقاق عقاب، ومع ذلك فقد وصفتم فعله بالوجوب، فقد اجتمع الواجب وعدم الذم على تركه، وذلك يناقض حدود الواجب كلها، وهذا سؤال صعب فيلزم: إما بطلان تلك الحدود أو بطلان هذه القاعدة والكل صعب جدا.
ثم أجاب عن هذا السؤال فقال: والجواب عن هذا السؤال أن نقول: الوجوب في هذه الصور مشروط بالاتصال والاجتماع مع الفاعلين، فلا جرم إن ترك مع الاجتماع أثم، والترك مع الاجتماع لا يتصور إلا إذا ترك الجميع والعقاب حينئذ متحقق، والقاعدة أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردا عنهم يكون شرط الوجوب مفقودا فيذهب الوجوب، ولا عجب أن يكون الوجوب مشروطا بشرط الاتصال ومفقودا عند الانفصال، كما تقول لزيد: إن اتصلت بعصمة امرأتك أو بقرابة وجبت عليك النفقة، وإن انفصلت منها لا تجب النفقة، فإن عاودتها وجبت، وإن فارقتها سقطت، كذلك أيضا هاهنا متى اجتمع مع القوم الخارجين للجهاد تقرر الواجب، فإذا أراد أن يفارقهم قلنا: لك ذلك، فإذا فارقهم بطل الوجوب كذلك أبدا، فاندفع السؤال، فتأمل ذلك فالسؤال جيد والجواب جيد(103).
وإن لحقوا بهم بعد تحصيل مصلحته فإن المستحق لثواب الفرض من تحققت المصلحة على أيديهم، وهم السابقون دون اللاحقين فإنهم لا يستحقون ثواب الفرض، بل يثابون على فعلهم ثواب الندب.
قال الإمام القرافي: الوجوب يتبع المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة بقي الخطاب بالواجب، ومن أوقع مصلحة الوجوب استحق ثواب الواجب، والجميع موقع لمصلحة الوجوب، فوجب اشتراكهم في ثواب الواجب، والكلام حيث لم تتحقق المصلحة، أما من جاء بعد تحققها فلا(104).
الحكم إذا ترك الجميع فرض الكفاية:
اتفق الأصوليون فيما بينهم على أن الكل إذا تركوا القيام بفعل فرض الكفاية أثموا جميعا(105).
قال الإمام الشافعي: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه معاً خفت ألا يخرج واحد منهم مطبق فيه من المأثم، بل أشك إن شاء الله لقوله تعالى: ]إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً[ (سورة التوبة: 39)(106).
وقال الغزالي: وإن امتنعوا جميعا عم الحرج الجميع(107).
وقال النووي: ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم(108).
وذلك أن تعطيل فرض الكفاية من الجميع بمنزلة تعطيل الفرد فرض العين، فكما أن الفرد يأثم بترك فرض العين، فكذلك الجماعة يلحقهم الإثم بتركهم فرض الكفاية، بل لو اتفقوا على تركه قوتلوا جميعا(109).
قال ابن قدامة: ولو امتنعوا عم الإثم الجميع، ويقاتلهم الإمام على تركه(110).
إناطة التكليف بفرض الكفاية:
التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن الغالب لا بالتحقيق، فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض، وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد، وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله، وإن أدى ذلك إلى أن يفعله الجميع، هكذا قرره الأصوليون في كتبهم لأن الظن الغالب يجد المكلف بفرض الكفاية السبيل إليه، بخلاف العلم القاطع، فقد يكون لا سبيل له إلى ذلك(111).
قال الإمام الرازي في المحصول: واعلم أن التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها، وإن غلب على ظنهم أن غيرهم لا يقوم به وجب عليهم، وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به، وجب على كل طائفة القيام به، وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة من تلك الطوائف، وإن كان يلزم منه أن لا يقوم به أحد؛ لأن تحصيل العلم بأن غيري هل فعل هذا الفعل أم لا، غير ممكن، إنما الممكن تحصيل الظن(112).
يقول الإمام الزركشي: ولك أن تقول: الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم وليس منه تكليف بما لا يمكن؛ لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم، ثم نقول: إنما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره، لأنه قال: لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك، ويكون قوله”سقط” أي في الظاهر، أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي(113).
وقال الإمام القرافي: يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفاعل وقوعه تحقيقا، فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك، وإذا غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الأخرى سقط الفعل عنهما(114).
وقال الإمام الطوفي: لا يشترط في الخروج من عهدة فرض الكفاية تحقق وقوعه من بعض الطوائف بل أي طائفة غلب على ظنها أن غيرها قام به سقط وإن غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط به عن الجميع عملا بموجب الظن لأنه كما صلح الظن مثبتا للتكاليف صلح مسقطا لها(115).
وقال المرداوي: قال أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وذلك لأن الظن مناط التعبد(116).
ولا يعكر على هذا أن الأصل في التكاليف ألا تكون إلا بعلم كما في قوله تعالى: ]وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[ (سورة الإسراء: 36).
وقوله تعالى: ]وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[ (سورة النجم: 28).
فهذا صحيح فيما لا يتعذر حصول العلم فيه، أما ما يتعذر حصول العلم فيه فقد أقام الشرع الظن مقامه لغلبة صوابه وندرة خطئه، ولذلك أنيطت به التكاليف رحمة من الحق بالخلق ودفعا للمشقة عنهم، فكما صلح الظن مثبتا للتكاليف صلح مسقطا لها(117).
شرط من يسقط بهم فرض الكفاية:
بعد أن بيّنا أن التكليف بفرض الكفاية يدور مع غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قد قام به سقطت المطالبة به عنها.
لكن يرد هنا سؤال: هل كل طائفة من الناس يقع فعلهم موقع الإجزاء عن غيرهم في الفرض الكفائي، سواء أكانوا مكلفين أم غير مكلفين، أو أن تلك الطائفة لا تحصل الكفاية بفعلها عمن تخلفوا عن القيام بذلك الفرض إلا إذا كانت مكلفة؟
بمعنى: هل شروط أهلية التكليف لا بد من أن تكون متحققة فيها، أو أنه لا يلزم ذلك؟
الصحيح أنه يشترط فيمن يسقط بهم فرض الكفاية أن يكونوا من المكلفين الذين تحققت بهم شروط التكليف، لأن غير المكلفين لا يسقط بفعلهم شيء من التكاليف الشرعية إلا ما استثناه الفقهاء من المسائل الفقهية كسقوط صلاة الجنازة عن الرجل بصلاة الصبيان الذكور المميزين ، وحصول الفرض بآذان الصبي على القول القائل بأن الآذان فرض كفاية(118).
وذلك أن المكلفين أحرى من غيرهم في استحضار نية الفرض والحرص على الدقة في أدائه على الوجه المطلوب لتقديرهم عواقب الأمور.
وهذا الشرط إنما هو في الأمور الشرعية التي تحتاج في إجرائها إلى نية صحيحة، أما غيرها من فروض الكفايات كإنقاذ الغريق مثلا، فإن الكفاية تحصل فيه بمن قام به عن غيره، وإن لم يستحضر نية العبادة في ذلك، فالمجنون لو تولى بنفسه مهمة الإنقاذ لحصلت الكفاية بفعله عن المكلفين.
هل لفرض الكفاية عدد معين؟
إذا ثبت أن فرض الكفاية إنما سمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين، فهل يشترط لهذا البعض عدد معين بحيث لا تتحقق الكفاية إلا بتوافره؟
يجدر بنا قبل الإجابة عن هذا السؤال أن نبين أن فروض الكفايات تتنوع إلى نوعين، فروض دينية، وفروض دنيوية كما سبق.
والفروض الدينية منها ما نص فيه الفقهاء على عدد معين، على اختلاف بينهم في ذلك، ومنها ما لم ينصوا فيه على عدد معين بل أطلقوا فيه القول تاركين تحديد عدده لمقتضيات الظروف والأحوال.
ومن فروض الكفايات الدينية عند الفقهاء التي نصوا فيها على اعتبار العدد، على اختلاف بينهم، صلاة العيد، قال ابن قدامة: وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام(119).
وقال ابن مفلح: وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها(120).
وصلاة العيد باعتبارها فرض كفاية اختلف الفقهاء في اشتراط العدد له، فمنهم من اشترطه ومنهم من لم يشترطه.
قال مجد الدين بن تيمية: وهي فرض كفاية، وعنه سنة، وهل من شرطها الاستيطان والعدد؟ على روايتين(121).
وقال ابن قدامة: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم(122).
ومن فروض الكفايات الدينية التي نصوا فيها على اعتبار العدد على اختلاف بينهم أيضا، صلاة الجنازة، قال النووي: وفي ما يسقط فرض الكفاية في هذه الصلاة قولان ووجهان: أحد القولين بثلاثة، والثاني بواحد، وأحد الوجهين باثنين، والثاني بأربعة، والأظهر عند الروياني وغيره: سقوطه بواحد.
ومن اعتبر العدد قال: سواء صلوا فرادى أو جماعة، وإن بان حدثُ الإمام أو بعض المأمومين، فإن بقي العدد المعتبر سقط الفرض، وإلا فلا(123).
ومن فروض الكفايات الدينية التي لم ينصوا فيها على عدد معين، الجهاد في سبيل الله تعالى، حيث اشترطوا له شروطا لم يكن للعدد نصيب منها، قال ابن قدامة: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر عاقل مستطيع(124).
فالإمام ابن قدامة قد قيد وجوب الجهاد بشرط الذكورية والحرية والبلوغ والاستطاعة، ولكنه أطلقه من شرط العدد، شأنه في ذلك شأن سائر الفقهاء.
وبناء على هذا فالجهاد وهو فرض كفاية ليس له عدد معين بحيث إذا توافر هذا العدد سقطت بهم الكفاية، وإذا لم يتوافر لم تسقط بهم الكفاية، وإنما تقدير ذلك العدد قد يكون موكولا لنظر الإمام بحسب ما يراه محققا لمصلحة المسلمين، إلا أنه يندب كثرة عدد المجاهدين في سبيل الله تعالى، فذلك أرهب للعدو، وأوقع للهيبة، وأعظم للقوة.
وأما فروض الكفايات الدنيوية كالحرف والصناعات، فلم يشترط الفقهاء عددا محددا لمن تتحقق بهم الكفاية، وإنما تركوا ذلك أيضا لتقدير الأمة نفسها حسب ظروف كل مجتمع واحتياجاته، غير أنه يجب على الأمة أن تعد أهل الكفاءات ممن يملكون القدرات على القيام بتلك الحرف والصناعات بقدر ما يحقق ضرورات حياتها.
ومن هنا نستطيع أن نقول: أن فرض الكفاية ليس له في الحقيقة عدد معين لا فيما يتعلق بالأمور الدينية ولا الدنيوية، والذين اشترطوا العدد لصلاة العيد، وحددوه بالأربعين إنما هو من قبيل إلحاقها بصلاة الجمعة، وليس ذلك بمسلم عند بعض الفقهاء، بل حتى الجمعة نفسها، وهي فرض عين لم يسلم اشتراط العدد لها من وجود خلاف، وكذلك الذين اشترطوا العدد في صلاة الجنازة لم يسلم اشتراطهم من منازع، قال الإسنوي: إذا صلى على الجنازة واحد ذكر كفى على الصحيح(125).
وهذا ما رجحه النووي حيث قال: ويسقط فرضها بواحد(126).
ومعنى هذا عدم اعتبار العدد شرطا لصلاة الجنازة، إلا أن هذا لا يعني بحال من الأحوال الاستخفاف بفروض الكفايات وعدم المبالاة بها، فهذا شأن الغافلين عن ذكر الله تعالى، بل الأولى في حق المسلم المعظم لشعائر الله تعالى أن يحرص على إقامة هذه الشعائر التي ينال بها الأجر الكبير.
سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة والجن
قال الإمام الزركشي: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الملائكة؟ لم أر من تعرض لهذه المسألة غير الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في “تذكرة الخلاف” في مسألة “تغسيل الشهيد الجنب” فقال: غسل الملائكة لا يسقط ما تعبد به الآدمي في حق الميت، وقياس سائر فروض الكفاية كذلك، ومثله هل يسقط بفعل الجن؟ لم أر فيه تصريحا، وينبغي تخريجه على الخلاف في تكليفهم بالفروع(127).
والراجح في ذلك سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة، عليهم السلام، إن قُدّر أنهم نابوا عن الآدميين فيما هو من فروض الكفايات، وذلك لسببين:
الأول: أن النبي r لم يأمر الصحابة الكرامy، بتغسيل حنظلة بن أبي عامر الأنصاري y من الجنابة اكتفاءً بتغسيل الملائكة، عليهم السلام، وإنما أمرهم بسؤال زوجته عن سبب ذلك فقال: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، فلما سألوها قالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة.
فأخبروا النبي r بقولها فقال: بذلك تغسله الملائكة(128).
ولو كان فعلهم غير مجزئ عن الآدميين لأمر النبي r الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بإعادة تغسيله، لما تقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
الثاني: أن الملائكة عليهم السلام، لا يصدرون في جميع أحوالهم إلا عن أمر الله تبارك وتعالى، وأصدق برهان على ذلك قوله تعالى في حقهم: ]بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ[ (سورة الأنبياء: 26-27) وإذا صدروا في ذلك عن أمر الله تبارك وتعالى كان فعلهم مجزئا عن الآدميين، إذ لو لم يكن مجزئا لما أمرهم الله تعالى به عنهم.
وكذلك الحال بالنسبة للجن إن قدر منهم فعل عن الآدميين فيما هو من فروض الكفايات فإنه يكون مجزئا عنهم، إذ الصواب تكليف الجن بما كلف به الآدميون لشمول الرسالة المحمدية لهم.
هل يلزم فرض الكفاية بالشرع فيه؟
اختلف الأصوليون في تعين فرض الكفاية لمن شرع فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يتعين فرض الكفاية بالشروع ، فيكون لازما لمن شرع في فرض الكفاية أن يتمه، وممن قال بهذا القول ابن الرفعة في المطلب كما نقله عنه الزركشي وابن السبكي وجزم بأنه الأصح، حيث قال: ويتعين بالشروع على الأصح(129).
القول الثاني: لا يتعين فرض الكفاية بالشروع مطلقا، فلا يلزم لمن شرع فيه إتمامه، بل إن أتمه فحسن، وإن لم يتمه فلا حرج، وممن ذهب إلى هذا القول القفال الشاشي، حيث قال: لا يليق بأصل الشافعي تعين الحكم بالشروع، فإن الشروع لا يغير حقيقة المشروع فيه(130).
القول الثالث: لا يتعين بالشروع من فرض الكفاية إلا الجهاد وصلاة الجنازة، وممن قال بهذا القول الإمام الغزالي كما نقله عنه الجلال المحلي، (131) وقال القاضي البارزي في التمييز كما حكاه عنه الزركشي في التشنيف والبحر والمرداوي في التحبير: ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة(132).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولا: أنه بالشرع تعلق به حق الغير، وهو انعقاد سبب براءة ذمته من التكليف بفرض الكفاية، وخروجه عن عهدته، فلا يجوز له إبطال ما تعلق به حق غيره، كما لو أقر بحق لم يجز له الرجوع عنه.
ثانيا: أن من شرع في فرض الكفاية فقد تلبس به، فيلزمه إتمامه قياسا على فرض العين، بجامع الفريضة في كل(133).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أولا: أن مالا يجب بالشروع فيه لا يجب إتمامه في غير الحج قياسا على التطوع في الصوم والصلاة، فكما أن من شرع في التطوع لا يلزمه إتمامه، فكذلك الحال فيمن شرع في فرض الكفاية لا يلزمه إتمامه(134).
ثانيا: أنه لو تعين فرض الكفاية بالشروع لما جاز للقاضي أن يعزل نفسه، لكنه جائز باتفاق
وقد أجيب عن هذا بأن فرض الكفاية له حظ في الوجوب بالجملة، بل هو واجب على التحقيق كما تقرر، بخلاف صوم النفل فإنه لا حظ له في الوجوب أصلا، مع أن بعض العلماء أوجب إتمامه، فيلتزم على قوله فلا يصح القياس عليه.
وأما القاضي فإن لم يوجد من يقوم مقامه؛ لم يجز له عزل نفسه، لأنه يضر بالناس، وإن وجد غيره جاز له عزل نفسه، لا من جهة كونه متلبسا بفرض الكفاية، ولكن من جهة كونه وكيل الإمام ونائبه، والوكيل له عزل نفسه(135).
واستدل أصحاب القول الثالث على عدم تعين فرض الكفاية بالشروع فيما عدا الجهاد وصلاة الجنازة بما استدل به أصحاب القول الثاني، وهو القياس على التطوع، وجواز عزل القاضي نفسه.
واستدلوا على تعينه بالشروع في الجهاد وصلاة الجنازة: بأن في الانصراف من ميدان الجهاد كسرا لقلب الجند مما قد يؤدي إلى هزيمتهم كما أن في قطع صلاة الجنازة هتكا لحرمة الميت(136).
والراجح من هذه الأقوال الثلاثة والله أعلم القول الأخير المبني على التفرقة بين أنواع فروض الكفايات، فإن منها مالا يحصل ضرر بترك الاستمرار فيه، كمن شرع في تعلم حرفة ثم انقطع، إذا كان في الأمة من يكفي للقيام بمهام هذه الحرفة، بخلاف ما إذا شرع في صلاة الجنازة ثم انصرف منها قبل إتمامها بدون عذر، فإن في ذلك استخفافا بالميت، وقد يؤدي انصرافه منها قبل الإتمام إلى إفساد الوئام بينه وبين من رآه من أقارب ذلك الميت، وهذا ضرر عظيم، وكذلك الانسحاب من ميدان القتال يفت في عضد المجاهدين ويضعف تماسكهم ويخل بوحدتهم وفي هذا من الضرر ما فيه.
أما القول الأول: فإنه مبني على قياس فرض الكفاية على فرض العين، وهو قياس مع الفرق، والقياس مع الفارق باطل، وقد ظهر وجه الفرق بينهما في الأمور التي ذكرت سابقا.
وأما القول الثاني: فهو وإن كان يلتقي مع القول الثالث من جهة تعين الفرض الكفائي بالشروع فيه، إلا أن أصحابه افتقدوا النظرة التوازنية التي ارتآها أصحاب القول الثالث مراعاة منهم لتحقيق مصلحة الأمة وسلامة وحدتها وكيانها.
مبنى الخلاف في المسألة:
ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب ثم قال: … ويشبه أن يكون الخلاف ملتفتا على الخلاف في أن فرض الكفاية يتعلق بكل مكلف، أو يتعلق ببعض مبهم، فمن قال: يتعلق بالجميع، قال: يلزم بالشروع كفروض الأعيان، ومن قال: يتعلق بالبعض لم يلزم إذ لم يرتق إلى مرتبة العين، وقد يقال يلزم (137).
خلاصة واستنتاج:
اتضح لنا جليا مما سبق أن الفقهاء أثبتوا من خلال المفهوم الشرعي لفرض الكفاية مسئولية الأمة شرعا عن بعض الفروض التي تسمى بفروض الكفاية إذ أن العلماء عرفوا فرض الكفاية بأنه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فهو واجب على الأمة في مجموعها ،إذا قام به بعض أفرادها بحيث يكفون حاجة الأمة، سقط هذا الواجب عن جميع أفرادها، أما إذا لم يقم به أحد أو قاموا به بقدر لا يسد حاجة الأمة أثم جميع أفرادها، بقدر ما قصروا في هذا الواجب الشرعي المطلوب حصوله.
وعرفنا فيما سبق أن فرض الكفاية إنما سمي بذلك لأن فعل البعض يكفي في سقوط الإثم عن الباقين، وهذا يصدق على فروض الكفايات التي منها القضاء والإفتاء والتفقه في الدين والجهاد في سبيل الله وأداء الشهادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة وإعداد القوة بأنواعها وغير ذلك مما سنذكره قريبا .
يقول الإمام الشاطبي موضحا هذا المعنى ومفصلا له تفصيلا دقيقا: “طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع ، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب، وأما من جهة جزئيه ففيه تفصيل وينقسم أقساما، وربما تشعب تشعبا طويلا، ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض، ولا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما”(138).
ثم أورد عددا من الأدلة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله r وما ثبت من القواعد الشرعية القطعية وفتاوى العلماء وتقريراتهم ما يؤيد تقريره السابق،ثم بعد ذلك زاد الأمر وضوحا بقوله: “وبالجملة فالأمر في هذه المسألة واضح وباقي البحث في المسألة موكول إلى علم الأصول، لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها على الجملة فبعضهم هو قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر (139).
أيضا اتضح لنا أن فروض الكفايات تشمل الأمور الدينية والدنيوية:
والأمور الدينية قسمان:
– منها ما يتعلق بأصول الدين وفروعه، فالأول القيام بإقامة الحجج والبراهين القاطعة على إثبات الصانع، وهو الله تعالى، وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه، وإثبات النبوات ودفع الشبه والمشكلات.
والثاني كالاشتغال بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه والتبحر في ذلك، وتصنيف الكتب لمن منحه الله تعالى فهما واطلاعا.
وعد الإمام الشهرستاني في كتاب الملل والنحل الاجتهاد من فروض الكفايات قال: حتى لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وإن قصّر فيه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد تَرَتُّبْ المسبَّب على السبب ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة، والآراء كلها متماثلة، فلا بد إذن من مجتهد.
– ومنه القضاء والفتوى، كما قال بذلك الإمام الغزالي في كتاب نهج الشريعة: ولا يُستغني عن الفقيه المفتي المنصوب في الناحية بالقاضي، فإن القاضي ملزم من رفع إليه عند التنازع، والمفتي يرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة …..، وتحمل الشهادة وأداؤها، وتولي الإمامة العظمى، والجهاد حيث الكفار مستقرون في بلادهم، أما إذا ديست أرض الإسلام فيكون الجهاد فرض عين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يختص بأرباب الولايات، ودفع ضرر المحتاجين من المسلمين من كسوة وطعام إذا لم تندفع حاجات المسلمين بزكاة أو بيت مال، ومثله المحتاجون من أهل الذمة، وإغاثة المستغيثين في النائبات، وإقامة الجماعة والآذان والإقامة، وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم، والتقاط المنبوذ، ورد السلام حيث سلّم المسلم عليه جماعة، وجهاد النفس ليرقى بجهاده في درجات الطاعات، ويظهر ما استطاع من الصفات ليقوم بكل إقليم رجل من علماء أهل الباطن كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل منهما يفيد المسترشد على ما هو بصدده ، فالعالم يقتدى به والعارف يهتدى به، وهذا ما لم يستول على النفس طغيانها وانهماكها في عصيانها، فإن كان كذلك صار جهادها فرض عين بكل ما استطاع، فإن عجز عنها استعان عليها بمن يحصل له المقصود من علماء الظاهر والباطن بحسب الحاجة، وهو أكبر الجهادين إلى أن ينصره الله تعالى.
الثاني الدنيوي:
كالحرف والصناعات وما به قوام المعاش كالبيع والشراء والزراعة، ومالا بد منه حتى الحجامة والكنس، ومن لطف الله عز وجل جبلت النفوس على القيام بها.
وهذه الأمثلة التي ذكرها العلماء إنما هي على سبيل المثال، وهي ما يناسب حاجات مجتمعاتهم، وبالإمكان أن نضيف إليها بعض الأمثلة مما استجد من حاجات في عصرنا، ومعظمها مما يقع في القسم الدنيوي، أما في القسم الديني فلا تعدو الإضافات أن تكون صورا جديدة من المصالح الدينية التي نص عليها العلماء قديما، ومنها:
* التركيز على دفع الشبهات التي تثيرها المذاهب الفكرية المعاصرة.
* التجديد في وسائل إقامة الحجج والبراهين وفقا لمنطق العصر وعلومه.
* الاشتغال بعلوم الشرع من منطلق تطبيقها على الحياة المعاصرة.
* تصنيف الكتب وفقا لمخطط يسد الثغرات الناشئة عن توقف الحياة الفكرية بسد باب الاجتهاد لعدة قرون.
* استخدام مختلف الوسائل في تيسير وصول القرآن والحديث والعلوم الشرعية إلى الناس من موسوعات ومعاجم وفهارس وأدمغة الكترونية ووسائل الاتصال الأخرى.
* إقامة مؤسسات الاجتهاد الجماعي، ومؤسسات إعداد المجتهدين بما يكفل ازدهار الاجتهاد وأداء وظيفته.
* إقامة مؤسسة الإمامة بما يكفل وحدة المسلمين وتعاونهم وتطبيق مبدأ الشورى.
* الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحربية بما يكفل القيام بواجب الإعداد دون اعتماد على غير المسلمين.
* تعميم الإعداد والتعبئة الشاملة للأمة بما يكفل دفع العدوان عنها وحماية السلام العادل.
* إقامة مؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أنظمة متخصصة متطورة تكفل تحقيق الوظيفة دون تعسف في الفهم أو إساءة في الممارسة، ومع بقاء دور الأفراد كاملا غير منقوص وكفالة، وتنظيم قيامهم بهذا الواجب.
وضع النظم وإقامة المؤسسات الكفيلة بتأمين ضرورات المعيشة من غذاء وكساء ومسكن وصحة وتعليم مجانا لغير القادرين وتنظيم التأمينات الاجتماعية بكافة صورها لجميع المواطنين.
* تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات الاقتصادية بدءا بالضروريات من زراعة وصناعات لمتطلبات الغذاء والملبس والمسكن والصحة والتعليم بما يكفل الاستقلال الاقتصادي للأمة الإسلامية، وتيسير هذه الضروريات مجانا لغير القادرين وبأسعار معقولة للقادرين.
* إقامة المعاهد التعليمية ومؤسسات البحث العلمي، والنظم التدريبية الكفيلة بتقدم الأمة في جميع المجالات، وتكوين العناصر المتخصصة المدربة اللازمة لتغطية هذه المجالات.
* إقامة المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية في إطار الشريعة ووفق مبادئها(140).
أيضا اتضح لنا أنه يجب أن نهتم بالواجب الكفائي كما نهتم بالواجب العيني لا فرق بينهما، فلا نهمل الفروض الكفائية لحساب الفروض العينية، وعندما وقع التقصير في فروض الكفاية وقع للأمة انحطاط وتخلف في كثير من الميادين، فالانحطاط والتخلف كان نتيجة لإهمال المسلمين إلى حد كبير فروض الكفاية المتعلقة بمجموع الأمة كالتفوق العلمي والصناعي والحربي وكذلك الاجتهاد في الفقه واستنباط الأحكام ونشر الدعوة الإسلامية، ، فالمفروض على كل مسلم إن يقوم بإحياء الفروض الكفائية في نفسه، وذلك بحمل الهم حولها؛ لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وكذلك يجب على مسلم أن يقوم بالإحسان والإتقان وعدم الغش وعدم الإهمال فيما يسند إلينا من أعمال ومهام أيا كان نوعها تعليمية أو إدارية أو غيرها.
ويجدر بنا أن نذكر بعضا من فروض الكفاية التي نحتاج إليها في واقعنا المعاش منها:
* الاجتهاد فرض كفاية ؛ إذ لا بد للمسلمين من استخراج الأحكام لما يحدث من الأمور، ويتعين الاجتهاد ، أي يصير فرض عين، على من هو أهله إن سئل عن حادثة وقعت فعلا، ولم يكن غيره، وضاق الوقت بحيث يخاف من وقعت به فواتها إن لم يجتهد من هو أهل لتحصيل الحكم فيها.
* تولية إمام عام على المسلمين يفصل في أمورهم ويسوسهم، فرض كفاية مخاطب به أهل والعقد من العلماء ووجوه الناس حتى يختاروا الإمام.
* القضاء والإفتاء والتفقه في الدين فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين.
* التجارة والصناعة والزراعة وغير ذلك مما لا تستقيم أمور حياة الناس بدونها، فرض كفاية على العموم لاحتياج الناس إليها وعدم استغنائهم عنها.
* تحمل الشهادة، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة، في غير الحدود كالنكاح والإقرار بأنواعه، فرض كفاية، فرض كفاية،ذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن تعين بحيث لا يوجد غيره كان فرضا عليه.
* أداء الشهادة، فرض كفاية لقوله تعالى: ]وأقيموا الشهادة لله[ (الطلاق من الآية /2) فإذا تحملها جماعة وقام بأدائها منهم من فيه كفاية سقط الأداء عن الباقين؛ لأن المقصود حفظ الحقوق، وذلك يحصل ببعضهم، وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع بهم الكفاية.
* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة فرض كفاية؛ لقوله تعالى: ]ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر[ (آل عمران: 104 ).
* حفظ الشريعة، فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين.
* إحياء البيت الحرام بالحج، فرض كفاية، كل عام على المسلمين في الجملة؛ إذ المقصود الأعظم ببناء الكعبة هو الحج، فكان به إحياؤها.
* بناء وعمارة المساجد في الأمصار والقرى والمحال حسب الحاجة، وتزيينها بالفرش وإنارتها، وإدامة العبادة ودرس العلم فيها، وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا، فرض كفاية، إن قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين.
* إحياء السنة المماتة مطلوب شرعا على سبيل فرض الكفاية.
* دفع ضرر المسلمين ككسوة عام وإطعام جائع وكفالة يتيم، وإيواء محتاج، فرض كفاية على الموسرين.
* إنقاذ المسلم من الهلاك، أيا كان نوعه، فرض كفاية.
* التمريض، وهو حسن القيام على المريض، فرض كفاية، فيقوم به القريب ثم الصاحب ثم الجار ثم سائر الناس.
* تجهيز الميت إن لم يكن له مال، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء وجب تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد، فإن لم يوجد أو كان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية.
* دفن المسلم، فرض كفاية إجماعا إن أمكن بدليل توارث الناس ذلك من لدن آدم عليه السلام، إلى يومنا مع الإنكار على تاركه.
* رد السلام، فرض كفاية، فإن سلم واحد أو جماعة على جماعة فالرد في حقهم فرض كفاية، فإن رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين، وإن ردوا الجميع كانوا مؤدين للفرض، فإن امتنعوا كلهم أثموا.
* تعلم كل علم لا يستغنىعنه في قيام أمور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث وما شابه ذلك، فرض كفاية.
* الاشتغال بعلم التجويد، فرض كفاية.
* الجدل الممدوح شرعا، وهو الذي قصد به تأييد الحق أو إبطال الباطل، أو أفضى إلى ذلك بطريق صحيح، قد يكون فرض كفاية، وذلك بأن يكون في الأمة من يدافع عن الحق بالأسلوب السليم.
* معرفة شعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين، رواية ودراية، فرض كفاية عند فقهاء الإسلام؛ لأن به تثبت قواعد اللغة العربية التي بها يعلم الكتاب والسنة المتوقف على معرفتهما الأحكام التي يتميز بها الحلال من الحرام، وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في المعاني، فلا يجوز الخطأ في الألفاظ وتركيب المباني.
الخاتمة في أهم نتائج البحث:
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وسار على نهجه إلى يوم الدين.
وبعد هذا التطواف مع فرض الكفاية نستطيع أن نستخلص النتائج التالية:
* تبين لنا أنه لا خلاف بين جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة في عدم وجود فارق بين الفرض والواجب فهما مترادفان، أي اسمان لمسمى واحد.
وخالف في ذلك الحنفية حيث فرقوا بينهما فخصوا الفرض بما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة كالقياس وخبر الواحد.
*تبين لنا أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في ترادف الفرض والواجب أو تباينهما خلاف لفظي في مجرد التسمية وليس له ثمرة عملية
*تبين لنا أن الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، فباعتبار الذات ينقسم معين ومخير، وباعتبار الوقت ينقسم إلى مضيق وموسع، وباعتبار الفاعل ينقسم إلى عيني وكفائي.
*تبين لنا أن الراجح القول بأن فرض الكفاية يفارق فرض العين، ومن الفروق بينهما: أن فرض العين يقتصر الإثم في تركه أو الثواب في فعله على فاعله فقط، وفرض الكفاية يشمل الإثم بتركه جميع المكلفين إذا كانوا قادرين على أدائه أو تحقيق وجوده، كما يشمل ثواب فعله جميع القائمين به والساعين لأجله.
*تبين لنا أن القيام بفرض العين أفضل من القيام بفرض الكفاية، لأن فرض العين آكد الوجوب، ولذلك خوطب به كل فرد بعينه، وثمرة الخلاف تظهر في المفاضلة في الثواب.
*تبين لنا أن الخلاف قائم بين الأصوليون في تعلق فرض الكفاية بالجميع أو بالبعض المبهم، وأن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن فرض الكفاية يتعلق بالجميع، لأن قولهم يفضي إلى تفعيل كافة أفراد الأمة للقيام بهذا الفرض.
*تبين لنا أنه إذا فعل الجميع فرض الكفاية دفعة واحدة فالاتفاق قائم على سقوط الفرض عنهم وحصول الثواب لهم، ولكن الاختلاف حاصل في وقوع الفعل منهم، هل يقع فرضا لجميعهم، أو يقع فرضا لبعضهم ونفلا للبعض الآخر؟ والراجح: وقوعه فرضا للجميع لاشتراكهم في القيام بأداء ما أمروا به، وليس بعضهم بأولى بثواب الفرض من الآخر.
*تبين لنا أنه إذا فعل الجميع فرض الكفاية على التعاقب، فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن يكون اللاحقون قد لحقوا بالسابقين قبل تحصيل المصلحة أو بعدها، فإن لحقوا بهم قبل تحصيلها وقع فعل الجميع فرضا مع حصول الكفاية بفعل السابقين، وإن لحقوا بهم بعد تحصيلها وقع فعل السابقين فرضا لتحقق اكتمال المصلحة بهم، ووقع فعل اللاحقين نفلا.
*تبين لنا أن الأصوليين اتفقوا على تأثيم الكل إذا تركوا القيام بفرض الكفاية.
*تبين لنا أن التكليف بفرض الكفاية من حيث الثبوت والسقوط منوط بالظن الغالب لا بالعلم القاطع، إذ قد يكون العلم القاطع متعذرا.
* تبين لنا أنه يشترط فيمن يسقط بهم فرض الكفاية في الأمور الشرعية التي تفتقر إلى استحضار نية صحيحة، أن يكونوا ممن تحققت فيهم شروط التكليف، لأن المكلفين أحرى من غيرهم في استحضار تلك النية، والحرص على الدقة في أداء الفرض على الوجه المطلوب.
*تبين لنا أن فرض الكفاية ليس له في الحقيقة عدد معين بحيث لا تتحقق بهم الكفاية إلا بتوافره؛ وذلك لأنه مقصود به تحقق المصلحة بصرف النظر عن الفاعل.
*تبين لنا أنه يسقط فرض الكفاية عن الآدميين بفعل الملائكة عليهم السلام، لأنهم لا يصدرون في جميع أحوالهم إلا عن أمر الله تعالى، ولأن النبي r اكتفى بتغسيل الملائكة لحنظلة بن أبي عامر الأنصاري t من الجنابة بعد استشهاده في غزوة أحد، حيث لم يأمر الصحابة بإعادة تغسيله، ولو كان فعلهم ذلك غير مجزئ عن الآدميين لأمرهم بإعادة تغسيله، لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
*تبين لنا أنه يسقط فرض الكفاية عن الآدميين بفعل الجن، لأنهم مكلفون على الأصح بما كلف به الآدميون لشمول الرسالة المحمدية لهم.
*تبين لنا أنه لا يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه إلا الجهاد؛ لئلا تنكسر قلوب الجند فيفضي ذلك إلى هزيمتهم، وكذلك صلاة الجنازة لعظم حرمة الميت.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فهرس المراجع
*الإبهاج في شرح المنهاج، للإمام تاج الدين السبكي المتوفى 771هـ ت: أ.د. شعبان محمد إسماعيل. ط مكتبة الكليات الأزهرية1401هـ.
*الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن محمد الآمدي المتوفى 631هـ ت د.سيد الجميلي ط دار الكتاب العربي1400هـ.
*أصول السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي المتوفى 490هـ لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن الهند تحقيق أبي الوفا الأفغاني.
*أصول الفقه، للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى 763هـ ت: د. فهد بن محمد السدحان ط مكتبة العبيكان بالرياض ط أولى 1420هـ.
*الأم، للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى204هـ ط دار المعرفة ـ بيروت ط ثانية 1393هـ.
*البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى 794هـ ط وزارة الأوقاف بالكويت 1409هـ.
*التحبير شرح التحرير، للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى 885 هـ ت: د.عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ط مكتبة الرشد بالرياض ط أولى 1421هـ.
*التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ت: د عبدالحميد ابو زنيد ط أولى مؤسسة الرسالة .
*تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى794هـ ت: د.عبدالله ربيع ، د.سيد عبدالعزيز ط مؤسسة قرطبة1419هـ.
*التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى 772هـ. مؤسسة الرسالة ط ثالثة 1404هـ ت: د. محمد حسن هيتو.
*تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاة ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1350هـ.
*جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي المتوفى771هـ مع حاشية جاد الله البناني ط دار الكتب العربية بالقاهرة.
*حاشية العطار على شرح المحلي، حسن العطار المتوفى 1250هـ ط دار الكتب العلمية بيروت.
*الرسالة، للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى204هـ ت: أحمد محمد شاكر ط 1358هـ1939م.
*روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى620هـ ت: د. عبدالكريم بن علي النملة ط مكتبة الرشد بالرياض ط خامسة 1417هـ.
*سلاسل الذهب، الإمام بدر الدين الزركشي المتوفى 794هـ ط مكتبة ابن تيمية القاهرة 1411هـ ت د.محمد المختار الشنقيطي.
*سنن البيهقي – السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى 458هـ ط حيدر آباد الدكن الهند 1355هـ.
*سنن ابن ماجة، أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المتوفى275هـ ت: محمد فؤاد عبدالباقي ط دار إحياء الكتب العربية1372هـ.
*شرح تنقيح الفصول، للإمام أحمد بن إدريس القرافي المتوفى684هـ ت: طه عبدالرءوف سعد، نشرمكتبة الكليات الأزهرية 1393هـ.
*شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، للقاضي عضدالدين الإيجي المتوفى 756هـ نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة1393هـ.
*شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، للإمام جلال الدين اعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 911هـ ت: أ.د. محمد إبراهيم الحفناوي ط دار السلام بالقاهرة ط أولى 1426هـ.
*شرح الكوكب المنير، لابن النجار المتوفى 972هـ ت: د.محمد الزحيلي و د. نزيه حماد ط مركز البحث العلمي جامعة أم القرى مكة المكرمة.
*شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي المتوفى716هـ ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي ط مؤسسة الرسالة 1410هـ 1990م.
* الغياثي، غياث الأمم في التياس الظلم، عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى 478هـ ت د. عبدالعظيم الديب، الطبعة الثالثة.
*فرض الكفاية وأحكامه عند الأصوليين، د. علي بن سعد الضويحي ، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود العدد 23 رجب 1419هـ.
*فواتح الرحموت شرح مسلم، الثبوت لعبد لعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري مطبوع مع المستصفى للغزالي المطبعة الأميرية1322هـ .
*الفروع، محمد بن مفلح المتوفى 763 هـ ط دار مصر للطباعة ط ثانية .
*الفروق، أحمد بن إدرييس القرافي المتوفى 648هـ ط عالم الكتب بيروت.
*القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزابادي المتوفى 817 هـ ط دار الفكر بيروت 1398 هـ.
*قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي المتوفى 660 هـ مراجعة طه عبد الرؤوف سعد ط مكتبة الكليات الأزهرية 1414هـ .
*القواعد والفوائد الأصولية، علي بن عباس البعلي، ابن اللحام، المتوفى 803 هـ ط دار الكتب العلمية بيروت ط أولى 1403هـ ت: محمد حامد الفقي.
*كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبدالعزيز البخاري المتوفى 730هـ ط دار سعاد ت 1308هـ.
*لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوفى 711هـ ط دار صادربيروت.
*المحصول في أصول الفقه، للإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفى 606هـ ت: د.طه جابر العلواني ط جامعة الإمام محمد بن سعود الطبعة الأولى 1400هـ.
*المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ عبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران ط إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة بدون تاريخ.
*المستصفى من علم الأصول، للإمام محمد بن محمد الغزالي المتوفى505 هـ ت: محمد عبد السلام عبد الشافي ط دار الكتب العلمية ط أولى 1413 هـ وطبعة بولاق 1322هـ.
*المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري المتوفى436هـ ط دار الكتب العلمية بيروت 1403هـ.
*المغني، عبدالله بن أحمد بن قدامة المتوفى 620 هـ ط هجر للطباعة والنشر بالقاهرة، ط أولى 1406 هـ ت د. عبدالله التركي والشيخ عبدالفتاح الحلو.
*منهاج الطالبين، يحي بن شرف النووي المتوفى 676 هـ ومعه شرحه، مغني المحتاج للشربيني ط دار الفكر.
*نهاية السول شرح منهاج الوصول، للبيضاوي تأليف عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى772هـ ط محمد علي صبيح بدون تاريخ.
*نهاية الوصول في دراية الأصول، محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي المتوفى 715 هـ ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ت: د. صالح اليوسف، و د سعد السويح.
*الوصول إلى الأصول، أحمد بن علي بن برهان البغدادي المتوفى 518 هـ ط مكتبة المعارف بالرياض، 1403 هـ ت: د. عبدالحميد أبو زنيد.
الهوامش
(1) انظر لسان العرب لابن منظور 1/793-794 القاموس المحيط 1/136 .
(2) انظر التقريب والإرشاد للباقلاني 1/293 المستصفى للغزالي 1/66 نهاية الوصول للهندي 2/513 .
(3) انظر الإحكام للآمدي 1/138 .
(4) انظر شرح مختر الروضة للطوفي 1/272 .
(5) انظر منهاج الوصول مع نهاية السول 1/73 .
(6) انظر نهاية السول للإسنوي 1/73-75 الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 1/52 أصول الفقه لشيخنا الدكتور محمد أبو النور زهير 1/51 وما بعدها.
(7) انظر نهاية السول مع سلم الوصول للمطيعي 1/133 الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 1/84 البحر المحيط للزركشي 1/186 .
(8) انظر شرح تنقيح الفصول صـ 157 الفروق للإمام القرافي الفرق الثالث عشر .
(9) الحديث رواه ابن ماجة في سننه 1/81 .
(10) انظر المنثور في القواعد للزركشي 3/33-38 الأشباه والنظائر للسيوطي صـ410.
(11) انظر النظرية العامة للشريعة الإسلامية د. جمال الدين عطية صـ 183 وما بعدها.
(12) انظر لسان العرب 7/202-206 القاموس المحيط 2/339-340 .
(13) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن عن ابن مسعود _ انظر صحيح البخاري 6/104 .
(14) انظر لسان العرب 15/255 .
(15) انظر التمهيد للإسنوي ص74 .
(16) انظر جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/251.
(17) انظر الوجيز للإمام الغزالي 2/187 .
(18) انظر شرح الكوكب الساطع للسيوطي تحقيق شيخنا الدكتور محمد إبراهيم الحناوي 1/111 وانظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/874 .
(19) انظر التمهيد للإسنوي صـ 74 .
(20) انظر تيسير التحرير2/213.
(21) انظر البحر المحيط للزركشي 1/242 .
(22) انظر تيسير التحرير 2/213 .
(23) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني 1/183 .
(24) انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 1/100 شرح المحلي مع حاشية البناني 1/183 البحر المحيطللزركشي 1/242 شرح الكوكب المنير 1/375 تيسير التحرير 2/213 شرح الكوكب الساطع للسسيوطي 1/111 .
(25) الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة انظر صحيح البخاري 2/116 .
(26) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه صـ 87.
(27) انظر فرض الكفاية وأحكامه عند الأصوليين د. على الضويحي ص 107 وما بعدها .
(28) انظر التقريب والإرشاد للباقلاني 1/294.
(29) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/836 .
(30) انظر البحر المحيط للزركشي 1/181 .
(31) الحديث رواه البخاري ومسلم، انظر صحيح البخاري 1/17 صحيح مسلم 1/41 .
(32) انظر المستصفى للغزالي 1/66 المحصول للإمام الرازي 1/1/119 الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/78 الإحكام للآمدي 1/99 التحصيل من المحصول 1/173 روضة الناظر لابن قدامة 1/153 البحر المحيط للزركشي 1/181 تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 1/165 التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/837 شرح الكوكب المنير 1/352 شرح المحلي مع حاشية البناني 1/88.
(33) انظر أصول السرخسي 1/111 كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2/549.
(34) انظر أصول السرخسي 1/110،111.
(35) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني 1/88 القواعد والفوائد الأصولية صـ 64.
(36) انظر المستصفى للغزالي1/66 .
(37) انظر روضة الناظر لابن قدامة 1/155 .
(38) انظر الإحكام للآمدي 1/141.
(39) انظر فواتح الرحموت 1/58 .
(40) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي 1/277 .
(41) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/80 .
(42) انظر الإحكام للآمدي 1/141، 142 .
(43) انظر نهاية الوصول للهندي 2/572.
(44) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ 157.
(45) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/882 .
(46) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي 2/404 .
(47) انظر التمهيد للإسنوي صـ 74.
(48) انظر البحر المحيط للزركشي 1/242 .
(49) انظر الإحكام للآمدي 1/100 الوصول إلى الأصول 1/81.
(50) انظر نهاية الوصول للهندي 2/574 .
(51) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ 157 التمهيد للإسنوي صـ 74 التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/874البحر المحيط للزركشي 1/242 شرح الكوكب المنير 1/374 .
(52) انظر الإحكام للآمدي 1/100 .
(53) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/874.
(54) انظر البحر المحيط للزركشي 1/242 .
(55) انظر الرسالة للإمام الشافعي صـ 336 .
(56) انظر شرح تنقيح الفصول صـ 157.
(57) انظر البحر المحيط للزركشي 1/244.
(58) انظر نهاية الوصول للهندي 2/572.
(59) انظر فرض الكفاية وأحكامه عند الأصوليين د. علي بن سعد الضويحي بحث منشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود العدد 23 ص 115 وما بعدها .
(60) انظر قواعد الأخكام للعز بن عبدالسلام 1/43-44 .
(61) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي2/404.
(62) انظر الغياثي لإمام الحرمين صـ 358 التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/882 التمهيد للإسنوي صـ 75 البحر المحيط 1/251 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1/252 القواعد والفوائد الأصولية صـ 188 فرض الكفاية د. علي الضويحي ص 117
(63) انظرالبحر المحيط 1/251 شرح مختصر الروضة للطوفي 2/410 .
(64) انظر الغياثي لإمام الحرمين صـ 358-359 .
(65) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 1/336 – 337 وفي الأحاديث القدسية بلفظ “وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه” انظر الأحاديث القدسية ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1/81
(66) انظر المنثور في القواعد للزركشي 3/39-41 .
(67) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 410-411 .
(68) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/883 البحر المحيط للزركشي 1/252 شرح مختصر الروضة للطوفي 2/410 القواعد والفوائد الأصولية صـ 188 .
(69) انظر إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 1/43 البحر المحيط للزركشي 1/252.
(70) انظر الفروق للإمام القرافي 2/203.
(71) انظر شرح الكوكب المنير 1/377 .
(72) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/97 .
(73) انظر الفروق للإمام القرافي 2/203 شرح مختصر الروضة 2/410 القواعد والفوائد الأصولية صـ 188 شرح الكوكب المنير 1/377 .
(74) الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه 1/11-12 .
(75) انظر البحر المحيط للزركشي 1/252 .
(76) انظر أصول ابن مفلح 1/198 التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/876 .
(77) انظر الأم للإمام الشافعي 1/274 .
(78) انظر الأم للإمام الشافعي 3/91 .
(79) انظر شرح اللمع للشيرازي 1/284 المستصفى للغزالي 2/15 التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/876 روضة الناظر لابن قدامة2/635 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 1/234 الإبهاج لابن السبكي 1/100 نهاية السول 1/185 البحر المحيط 1/243 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1/254 شرح الكوكب المنير 1/375 تيسير التحرير 2/213 فواتح الرحموت 1/63 .
(80) انظر أصول ابن مفلح 1/198 التحبير شرح التحرير للمرداوي2/876 شرح الكوكب المنير1/376المسودة صـ 30 .
(81) فائدة: قال المرداوي: إذا قلنا إنه تعلق بالجميع، فهل معناه أنه تعلق بكل واحد أو بالجميع من حيث هو جميع؟ مقتضى كلام الباقلاني الأول، وظاهر كلام الأكثرين الثاني، فمعنى الأول أن كل مكلف مخاطب به، فإذا قام به بعض سقط رخصة وتخفيفا لحصول المقصود، ومعنى الثاني أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم، من أي فاعل فعله، ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره؛ لأنا نقول: كلفوا بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم، وذلك مقدور تحصيله منهم؛ لأن كلا قادر عليه، ولو لم يفعله غيره، وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه. انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/877
(82) انظر جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/254 منهاج الوصول مع نهاية السول 1/185 التمهيد للإسنوي صـ 75 القواعد والفوائد الأصولية صـ 187.
(83) انظر جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/254 .
(84) انظر نهاية السول للإسنوي 1/194-195 التمهيد للإسنوي صـ 75.
(85) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/878 .
(86) انظر المحصول للإمام الرازي 1/2/310-311 .
(87) انظر سلم الوصول للمطيعي 1/195 .
(88) انظر فواتح الرحموت 1/63 .
(89) انظر المستصفى 2/15 روضة الناظر2/636 فواتح الرحموت 1/63 .
(90) انظر فواتح الرحموت 1/63 .
(91) انظر الرسالة للإمام الشافعي صـ 367.
(92) انظر الرسالة للإمام الشافعي صـ 364 .
(93) الحديث رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك _1/81 .
(94) انظر المستصفى للغزالي 2/15 شرح تنقيح الفصول صـ 155 الإحكام للآمدي 1/141-142 شرح العضد على ابن الحاجب 1/234 شرح مختصر الروضة للطوفي 2/408 الإبهاج لابن السبكي 1/100 نهاية السول 1/197 البحرالمحيط للزركشي 1/243-244تشنيف المسامع 1/255 تيسير التحرير 2/213 التقرير والتحبير 2/136 فواتح الرحموت 1/63-64 فرض الكفاية وأحكامه د. علي الضويحي ص 119وما بعدها .
(95) انظر الموافقات للإمام الشاطبي 1/176-179.
(96) انظر سلم الوصول للمطيعي 1/196 .
(97) انظر المستصفى للغزالي 2/15.
(98) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/879 .
(99) انظر البحر المحيط للزركشي 1/247.
(100) انظر روضة الناظر لابن قدامة 2/625 التمهيد للإسنوي صـ 77 البحر المحيط للزركشي 1/247 شرح الكوكب المنير 1/377 فرض الكفاية وأحكامه د. علي الضويحي ص 127 وما بعدها.
(101) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ 158 البحر المحيط للزركشي 1/248.
(102) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 1/51 البحر المحيط للزركشي 1/248 .
(103) انظر الفروق للإمام القرافي 1/117-118 .
(104) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ 158 .
(105) انظر المستصفى للغزالي 2/15 روضة التاظر لابن قدامة 2/625 جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/255 نهاية السول للإسنوي 1/191 شرح تنقيح الفصول صـ 155 البحر المحيط للزركشي 1/246 تيسير التحرير 2/213 فواتح الرحموت 1/63
(106) انظر الرسالة للإمام الشافعي صـ 366.
(107) انظر المستصفى للغزالي 2/15.
(108) انظر المجموع شرح المهذب 5/128.
(109) انظر البحر المحيط للزركشي 1/246.
(110) انظر روضة الناظر لابن قدامة 2/625 .
(111) انظر المعتمد للبصري 1/138 المحصول للإمام الرازي 1/2/311 الفروق للإمام القرافي 1/117 شرح تنقيح الفصول صـ 156 الإبهاج لابن السبكي 1/100 البحر المحيط للزركشي 1/246 القواعد والفوائد الأصولية صـ 189 .
(112) انظر المحصول للإمام الرازي 1/2/311-312 .
(113) انظر البحر المحيط للزركشي 1/246، 247.
(114) انظر الفروق للإمام القرافي 1/117 .
(115) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي 2/409 المدخل لابن بدران ص 104 .
(116) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/879 .
(117) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ 156 شرح مختصر الروضة للطوفي 2/409 .
(118) انظر روضة الطالبين للنووي 2/129 مغني المحتاج للشربيني 1/345 التمهيد للإسنوي صـ 77 البحر المحيط للزركشي 1/249 حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع 1/240 فرض الكفاية وأحكامه د. علي الضويحي ص 131.
(119) انظر المغني لابن قدامة 3/253 .
(120) انظر الفروع لابن مفلح 2/137.
(121) انظر المحرر في الفقه لابن تيمية 1/161 .
(122) انظر العمدة في فقه الإمام أحمد صـ 110.
(123) انظر روضة الطالبين للإمام النووي 2/129 .
(124) انظر العمدة في فقه الإمام أحمد صـ 582-583 .
(125) انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي صـ 77.
(126) انظر منهاج الطالبين للنووي 1/345 .
(127) انظر البحر المحيط للزركشي 1/249 .
(128) الحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة 2/45 وابن عساكر في تاريخ دمشق 2/296 وقال عنه هذا حديث حسن وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/15 وحكم عليه بالإرسال والضعف وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك. انظر المستدرك مع التلخيص 3/204 .
(129) انظر جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/256 .
(130) حكاه عنه الزر كشي في البحر المحيط 1/250.
(131) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 1/186 .
(132) انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1/256-257 التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/885 فرض الكفاية وأحكامه د. علي الضويحي ص 136 وما بعدها .
(133) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي 2/410 البحر المحيط للزركشي 1/250 .
(134) انظر البحر المحيط للزركشي 1/250.
(135) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي 2/410 .
(136) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 1/186 .
(137) انظر سلاسل الذهب للزركشي صـ 116.
(138) انظر الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي 1/119.
(139) انظر الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي 1/121.
(140) انظر النظرية العامة للشريعة الإسلامية د. جمال الدين عطية صـ 183 وما بعدها.