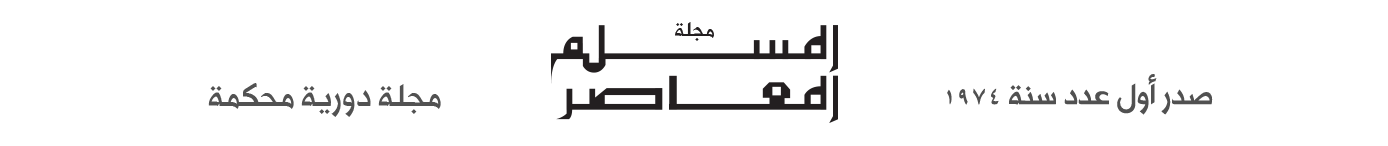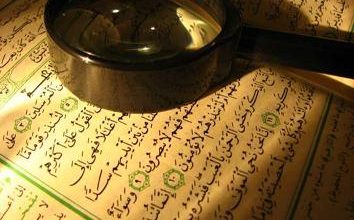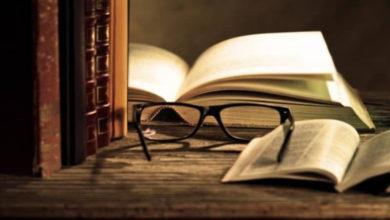مقدمة:
قضية الحرية في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر, تستحق الدراسة والتوقف أمامها بتفحص وعناية, وذلك على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر؛
وذلك لأنها مؤشر هام على تطور الفكر الإسلامي وواقعيته من ناحية, وعلى قدرته على التجدد الذاتي ومواجهة التحديات من جهة ثانية، كما أنها مؤشر على أن تقدم المجتمع مرتبط بقضية الحرية برباط وثيق.
وبناء عليه فسوف نرصد قضية الحرية في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر ومراحل تطورها، من خلال مجموعة أعلام ساهموا بقوة في بلورة مفهوم حديث للحرية لا يتقاطع مع الواقع ومقتضياته، ولا يتناقض مع أصول الفكر الاسلامى، وحقيقة الأمر, فهذا المفهوم لم يكن قاصراً على مجال دون آخر, ولكنه شمل جميع المجالات التي تتصل بقضية الحرية سواء كانت خاصة بالفرد أو المجتمع.
فمنذ رفاعة الطهطاوي حدث تطور ملموس في تناول قضية الحرية في فكرنا الحديث والمعاصر, تطور نابع من تجربة الرجل التي تعد فاصلة بين مرحلتين في تاريخنا, تجربة تفصل _ وكأنها جدار عازل _ ما بين العصور الوسطي والعصر الحديث، وذلك من خلال:
– مؤلفاته التي تؤصل لفكر إسلامي حديث متصل بالعصر كمشروع حضاري، وتعد قضية الحرية عصب هذا المشروع، ومن ثم تناولها بالتفصيل في جميع أعماله.
_ ومن جهة أخرى من خلال دوره في المجتمع، الذي ترجم فيه أفكاره وطموحاته في بناء دعائم النهضة في مجتمع حديث، يسعى للانفلات من ربقة العصور الوسطي بهمة لا تفتر، وعزيمة لا تلين نحو تحقيق ذاته وتعويض ما فاته في فترة الجمود والركود.
وقد تابع مسيرة رفاعة الطهطاوي مجموعة من الرجال، الذين نهلوا من فكره وعزموا على أن يكملوا مسيرته الفكرية، في تحرير المجتمع والإنسان المصري من كل عوائق الجمود والتخلف, وكان كل واحد منهم يعد معلمًا من معالم النهضة, وأحد ركائز الحرية في فكرنا الحديث والمعاصر، ساهم كل منهم في تطوير مفهوم الحرية بصورة أو أخرى.
ورغم كثرة الرجال الذين ساهموا بقوة من خلال جهودهم في تطوير قضية الحرية في فكرنا الحديث والمعاصر, وخصوصًا في مصر, إلا أننا نخص بالذكر الشيخ حسين المرصفى خصوصًا في كتابه (الكلم الثمان), الذي تناول فيه مجموعة مصطلحات حديثة من بينها مصطلح الحرية بالشرح والتحليل. ومنهم الإمام محمد عبده الذي يعد مرحلة فاصلة جديدة في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر, وساهم مساهمة فاعلة في إعلاء قيمة الحرية وتطوير مضمونها.
وأخبرًا رأى عبد المتعال الصعيدي أحد تلاميذ مدرسة محمد عبده الذي دافع بقوة عن الحرية الفكرية والدينية باعتبارها حقوقاً أكد عليها الإسلام كمبدأ ومنهج.
وقد وقفنا بالتفصيل عند قضية الحرية من خلال شخصيتين ساهم كل منهما في بلورة وتطوير تلك القضية في فكرنا الحديث والمعاصر :
أولهما: رائد الفكر الحديث في مصر والعالم العربي الشيخ رفاعة الطهطاوي.
والثاني: الشيخ عبد المتعال الصعيدي الذي أولي عناية خاصة لقضية الحرية الفكرية والدينية.
كما تتضح قضية الحرية من خلال مجموعة قضايا ومفاهيم أخرى, سوف نتناولها من خلال تحليل قضية الحرية في فكرنا الإسلامي الحديث والمعاصر. ومن ثم سوف يكون حديثنا عن قضية الحرية من خلال محورين :
المحور الأول: تناول قضية الحرية من خلال مجموعة أعلام في فكرنا الإسلامي و الحديث ساهموا في تطوير مدلول الحرية وتثبيت معناها وتكريس دعائمها في المجتمع0 وهذا ما عالجناه من خلال مدخل تناولنا فيه تاريخ قضية الحرية في مصر الحديثة و المعاصرة، من خلال مجموعة من أعلام الفكر.
المحور الثاني: من خلال تحليل قضيه الحرية وتطوير مدلولها في فكرنا الحديث والمعاصر؛ من أجل التعامل بواقعية مع قضايا العصر مثل قضية الحرية الدينية والفكرية، وقضية حرية المرأة والحرية السياسية، وغيرها من القضايا التي سوف نتناولها في مظنها من البحث.
وقد مهدنا للبحث بمدخل عن الحرية والوعي بالذات.
مدخـل
الحرية والوعي بالذات:
الحرية هي لحظة وعي بالذات ينتج عنها تغيير حقيقي في حياة الإنسان فردًا كان أو مجتمعاً وقد تحققت في فكرنا الحديث مرتين:
الأولى: علي يد محمد علي والي مصر الذي استطاع نتيجة إدراكه لقيمة الحرية كإرادة واختيار أن يؤسس مجتمعًا حديثاً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بغض النظر عن كونه كان مؤمنًا بالحرية كفرد، أم كان حاكمًا مستبدًا، يرى أن المجتمع الجاهل غير مؤهل بعد للحرية وهو يرسف في أغلال الجهل والمرض والتخلف، وبالتالي لا يعي معنى الحرية ولا يمكنه ممارستها علي النحو الصحيح إلا في ظل مجتمع حديث تتحقق له شروط السيادة والقوة، ولا بد له من الانكفاء علي ذاته في عملية تحديث مستمرة حتى يحقق قاعدة بيانات (Data Base) تمكنه من البناء عليها في مسيرته نحو التقدم والازدهار.
والثانية : علي يد محمد عبده الذي آمن بحرية الإنسان في العدل والمساواة، وفي الحقوق والواجبات، وأولى هذه الحقوق حق المعرفة للخروج من حالة التخلف الحضاري، وامتلاك أدوات العلم والمعرفة، باعتبارها شروطًا أولية للحرية لا تتحقق إلا بها. ومن هنا آمن بحرية الإنسان في التعبير عن نفسه وفي اختياره، كطريق لا بد منه في عملية تحديث شاملة، تهدف لإحياء المجتمع والخروج به من حالة الجمود والتخلف، عن طريق الإيمان بالفرد كأساس للمجتمع السليم والحديث، وهو ما يعرف حالياً بالتنمية البشرية في أدبيات الفكر المعاصر.
في اللحظة الأولى كان المجتمع بحاجة ضرورية للتواصل الحضاري، لتكوين نواة معرفة يبنى عليها تقدمه خصوصاً في مجال العلوم والتكنولوجيا، فأرسل محمد علي الوفود لجامعات أوربا لدراسة هذه العلوم العملية، ومن حسن الطالع كان لزاماً من وجود مرشد ديني يرافق هؤلاء الطلاب، فيصلي بهم ويوجههم في شئون دينهم، لكن عاد محمد علي وألحق هذا المرشد بالبعثة الرسمية كموفد ضمن طلاب البعثة.
فكان الشيخ رفاعة الطهطاوي إمام البعثة، واحد أفرادها، الذي انبهر بالمجتمع الغربي، وما شاهده في المجتمع الفرنسي قلعة الحرية والتقدم في أوربا، فكان هو العقل الواعي الذي نقل لنا وهو تحت لحظة الانبهار، طبيعة المجتمع الفرنسي حسب كتابه الرائد في أدب الرحلات – تخليص الإبريز في تلخيص باريز – وهو يحدثنا عن مجتمع ليبرالي حر، يقوم علي العدل والمساواة، كنموذج ينشد تحقيقه في مجتمعه الذي يعاني من الجمود والتخلف، ولا يرى ما يمنع من تحقيق ذلك بالاستفادة من التجربة الفرنسية في عمومها، ولا يرى أن الشريعة الإسلامية التي علمت الدنيا تمنع من هذه الإفادة.
وكان الشيخ رفاعة دون مبالغة هو العقل الواعي، لتجربة محمد علي في التحديث الفكري والاجتماعي، واضطلع بدور رائد التحديث العربي دون منازع، ومن هنا كان لابد من معرفة مفهوم الحرية لدى رفاعة الطهطاوي كنموذج فكري في تجربة محمد علي صاحب لحظة الوعي الأولى في مجتمنعا الحديث، فقد أكد منذ البداية وبوضوح لا يقبل الشك، علي معني الحرية، ووضح أقسامها، وأكد علي أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق السعادة للفرد والمجتمع علي السواء.
كان رفاعة في حديثه كمشاهد منبهر – لكنه منبهر غير فاقد لذاته ولا لهويته – بالمجتمع الباريسي، يرى فيه النموذج الذي يجب أن يحتذي في العدل والحرية والمساواة، وهي أمور يجب أن نتفهمها حسب ظروف الزمان والمكان، وطبيعة التجربة في تلك المرحلة الباكرة من عملية التحديث العربية، والتواصل الحضاري التي يغلب عليها عملية النقل والترجمة، ولا تخضع للنقد والمراجعة بالقدر الكافي.
وذلك لأن عملية النقد والمراجعة تحتاج مزيداً من الوقت، للتأمل والمراجعة والنظر للتجربة من بعيد، وهي غير متوفرة بالتأكيد في مرحلة التواصل والتكوين، التي تحتاج للتلاحم والالتصاق، وهي أمور لا تسمح للنقد والفرز بالقدر الكافي، ورغم هذا لا نعدم روح النقد عند الشيخ رفاعة لبعض العادات والتقاليد الغربية، وخصوصا في المجتمع الباريسي، مثل اعتمادهم المطلق علي العقل، وعدم تمسكهم بالدين، وغيرها من الأمور التي نبه عليها في كتابه (تخليص الإبريز في تلخيص باريز).
لكن نموذج الحرية عند الشيخ رفاعة كنموذج عملي تطبيقي، يتضح أكثر من خلال حديثه عن التمدن في كتابه (مناهج الألباب) الذي يري فيه أن مصر بتاريخها الثقافي والحضاري العظيم والضارب في أعماق التاريخ بجذور راسخة، وبطبيعة أهلها، مؤهلة للتقدم بشقيه المادي والمعنوي، هذا التقدم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق حرية الوطن والمواطن.
كما كان كتابه المرشد الأمين في تربية البنات والبنين، عامل رائد ليس فقط في مجال الفكر التربوي، لكن في رؤيته الفكرية العميقة، وتحليله النفسي المميز لشخصية المرأة ومميزاتها، ومؤهلاتها للمشاركة والمساهمة في تنمية ذاتها ومجتمعها، وهذا ما يعكس بعد إنساني وحضاري راق عند الطهطاوي، كانسان ينظر للمرأة نظرة حضارية سامية، ويتحدث عن حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة، وعلي تلمس جوانب نفسية وإنسانية في شخصيتها كالرقة والعاطفة والحب، يؤكد أنها مميزات وليست عوامل ضعف كما يظن الكثيرون، ومن حقها التعبير عنها،والشعور بها.
وقد أثمرت جهود الشيخ رفاعة في المجتمع المصري في مجال التنمية الفكرية والاجتماعية آثارا عظيمة، فدعا إلى تعليم البنات، وكان عضوًا في لجنة إنشاء المدارس لنشر نور العلم والمدنية، كأهم شروط الحرية، ودعا إلى ما يمكن أن نسميه حوار الحضارات، وضرورة النظر للآخر من منطلق جديد، بنظرة تقوم علي معيار التقدم والتمدن، بدلاً من منطلق الإيمان والكفر، تلك الرؤية التي سادت العالم القديم في الشرق والغرب علي السواء، وما زالت توجد جحافل قوية علي الجانبين تسير حسب الرؤية القديمة، والذي كان الدافع لها الحروب الصليبية الطويلة والممتدة، التي صبغت علاقات الشرق الإسلامي، بالغرب المسيحي عبر القرون.
وإذا كانت لحظة الوعي الأولى ممثلة في عقلها الواعي الشيخ رفاعة – الحرية في أحد تعريفاتها هي حكم العقل – وهي بصدد لحظات التكوين، تؤسس لمجتمع جديد، ليس لديها الوقت الكافي للوقوف عند المصطلحات، والنظر لها نظرة تقويم وتحديد، لأن ذلك يحتاج لرصيد ثقافي وحضاري في المجتمع، ومرحلة نضج لم تكن متوفرة زمن الشيخ رفاعة، فإن تلميذه الشيخ حسين المرصفى، أحد أهم المثقفين المصريين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اضطلع بهذا الدور الهام في تحديد معاني المصطلحات الجديدة في رسالته بالغة الأهمية في تاريخ الثقافة العربية والإسلامية الحديثة ( الكلم الثمان)، استكمالاً لجهد أسلافه في ضبط المصطلحات وبيان مضامينها، وهو ما عرف لدى أسلافنا بالحدود، مثل عمل التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون والجرجاني التعريفات وغيرها.
وقد رصد الشيخ المرصفى بثاقب وعيه النفاذ – وهو الكفيف البصر – المصطلحات الجديدة المعنى والمدلول في الثقافة العربية المعاصرة، مثل مصطلحات: الأمة والوطن والحكومة والعدل والظلم والسياسة والحرية والتربية، وكان من ثمار وجهود الشيخ المرصفى الأستاذ في مدرسة دار العلوم في المجتمع المصري، ثلة من ألمع التلاميذ منهم من تتلمذ له مباشرة في دار العلوم، ومنهم من تأثر بفكره ومنهجه، من أمثال: محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وعبد الله فكري ومحمد عبده وحمزة فتح الله وحفني ناصف وحسن توفيق العدل وحسين الجسر اللبناني. وكلهم منارات سامقة علي طريق الحرية، وغرس من ثمار الشيخ المرصفى(1).
وإذا كان الشيخ الطهطاوي قد غرس البذرة بقوة في لحظة الوعي الأولى، فإن تلميذه الشيخ المرصفى بجهوده الفكرية والثقافية، كان يمهد للحظة الوعي الثانية التي انبثقت من خلال تلاميذه، وعلي رأسهم الشيخ الإمام محمد عبده الذي جسد الحرية بفكره وسلوكه، وعلي يديه تجسدت قيمة الحرية في لحظة وعي هامة، عبرت عن نفسها في جميع مجالات الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية.
لقد جسد الإمام الشيخ محمد عبده رائد التجديد الديني والاجتماعي في مصر القرن العشرين، الحرية كقيمة بفكره وسلوكه، لإيمانه العميق أن الإسلام دين يؤمن بالتعددية الدينية والثقافية وبالاختلاف كحكمة إلهية ضرورية لاستمرار الحياة، كما في قوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ وأنه سبحانه وتعالى لم يجبر الجمادات علي الاعتراف به كخالق بل منحها حق الاختيار، فقال تعالى في سورة فصلت ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾.
وإذا كان الاختيار في حق الجمادات محمودًا, فما ظنكم به في حق الإنسان، الذي أكد سبحانه وتعالى على حقه في الاختيار الحر، في أن يكون مؤمنًا بالله أوكافرًا به مشدد على عدم الإكراه في الدين, الذي يتنافى مع طبيعة الحرية والاختيار, وهذا ما جاء في قوله تعالى في سورة يونس: ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾. وفي قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. وهذه إحدى الآيات الدالة على أن الإسلام لم يبتن على السيف والدم، ولم يفت بالإكراه أو العنوة على خلاف ما زعمه عدة من الباحثين أن الإسلام دين السيف استدلوا عليه: بالجهاد الذي هو أحد أركان هذا الدين.
وقد تقدم الجواب عنه في ضمن البحث عن آيات القتال، وذكرنا هناك أن القتال الذي ندب إليه الإسلام، ليس لغاية إحراز التقدم وبسط الدين بالقوة والإكراه، بل لإحياء الحق والدفاع عن أنفس متابعة للفطرة وهو التوحيد، وأما بعد انبساط التوحيد بين الناس فخضوعهم لدين النبوة ولو بالتهود والتنصر، فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال، فالإشكال ناشئ عن عدم التدبر .
ويظهر مما تقدم أن الآية أعني قوله ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ غير منسوخة بآية السيف كما ذكر بعضهم، ومن الشواهد على أن الآية غير منسوخة التعليل الذي فيها، أعني قوله: ﴿قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ فإن الناسخ ما لم ينسخ علة الحكم لم ينسخ نفس الحكم، فإن الحكم باق ببقاء سببه، ومعلوم أن تبين الرشد من الغي في أمر الإسلام أمر غير قابل للارتفاع بمثل آية السيف، فإن قوله: ﴿اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ مثلاً، أو قوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ لا يؤثران في ظهور حقية الدين شيئًا حتى ينسخا حكمًا معلولاً لهذا الظهور، وبعبارة أخرى الآية تعلل قوله: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ بظهور الحق: وهو معنى لا يختلف حاله قبل نزول حكم القتال وبعد نزوله، فهو ثابت على كل حال، فهو غير منسوخ(2).
وإذا كانت الشعوب تحتاج للإبداع الذاتي بعد فترة التكوين الأولى التي تستلزم التواصل والنقل – مرحلة الطهطاوي – قبل أن تأتي مرحلة النقد والإضافة – مرحلة محمد عبده – فقد كانت جهود الشيخ عبد المتعال الصعيدي تمثل بحق مرحلة إبداع ذاتي غير متأثر بفكر غربي وافد، وفي تأصيل فكري جديد لقضية الحرية الفكرية والحرية الدينية في الإسلام – وهما عنوانا كتابين له – تعد تأسيسًًا للحظة انطلاق جديدة في الوعي بالذات، أرى إرهاصاتها تلوح في الأفق.
ويجب أن تكون الشيخ الصعيدي عن الحرية الفكرية والدينية، كرؤية رحبة تعتمد على تأصيل القضية بعيدًا عن المواقف المسبقة، كما أنها ليست تكرارًا لآراء سابقة، أو ترديدًا دون وعي لما هو مألوف وثابت لدى أسلافنا، حول قضية حرية الفكر والاعتقاد، ولو كان فكر الشيخ عن الحرية، قد لقى ما تنتج سوى مزيدًا من تمزيق وحدة الصف، والتراشق اللفظي المسف، والتجاذبات والخلافات التي استنفدت جهودًا، وسالت من أجلها دماء غير ذكية، وتطايرت على آثارها شظايا الوهم في كل اتجاه.
وهذا ما يعكس حيرة مجتمع ممزق، أكثر مما يعكس حيوية فكرية ورؤى محددة، تجلت بوضوح في مجموعة من الأحداث المؤسفة، مثل قضية نصر حامد أبو زيد، ورواية وليمة لأعشاب البحر، وغيرها من الموضوعات التي سودت حولها عشرات الأطنان من الورق لم تستحق مع الأسف ثمن الورق الذي سود فيها، ولا الأحبار التي سالت عليها، ولم يكن أحد ممن أثار غبار هذه المعارك يبغون وجه الله ولا مصلحة المجتمع، ولا خدمة البحث العلمي، وإنما كانت مواقف أيديولوجية وعصبية قبلية أولاً وقبل كل شيء، حتى وإن حسنت نوايا بعض من شارك في تلك المعارك، لأن كثيراً من النوايا الحسنة، أضرت ولم تصلح، فالدبة التي قتلت صاحبها كانت تريد له نوماً هادئاً بعيداً عن طن الذباب!
لقد ذهب الشيخ الصعيدي إلى حق الإنسان في الإيمان بالله وفي حقه في النقوص عن هذا الإيمان، دون أدنى مسئولية جنائية ولا اجتماعية تلحقه نتيجة ذلك ، فكان جريئا في مناقشة قضية الردة التي انتهى فيها لرأي واضح ، وهي أن الجزاء فيها ديني فقط، أمره لله – سبحانه وتعالى- وأن ما جاء في القرآن عن الردة لا يستوجب القتل ، وفنّد الآراء المخالفة، وانتهى إلى أن جزاء المرتد يكون أخروي فقط، أما في الدنيا فيدعى للإسلام غير المسلم وفقط، كما أكد على أن الحرية والمساواة حق لجميع أبناء الوطن بغض النظر عن دينه أو اعتقاده.
وذهب إلى أن الإسلام جاء ليؤكد على الحرية، التي حولها بعض الحكام لاستبداد، وذهب علماء السوء لتبرير هذا الاستبداد، الذي يتناقض صراحة مع جوهر الإسلام، الذي جاء لتحرير الإنسان من القيود التي تعوق مسيرته وحريته، كمخلوق حر له حريته الكاملة في التعبير عن رأيه وفكره، وفي حريته في اختيار دينه، كما له حريته في اختيار حاكمه وفي نقده ومعارضته متى ثبت له خطأ الحاكم أو من يمثله، دون قيد أو شرط يهدد حياة الإنسان.
ونتناول رؤية الطهطاوي لقضية الحرية بالتفصيل، وهذا هو موضوع الصفحات التالية:
قضيه الحرية عند الطهطاوي
اكتسب مفهوم الحرية عند رفاعة الطهطاوي معنى جديدًا لم تعهده الثقافة العربية من قبل, ولا يمكن أن نفصل بين هذا المفهوم الجديد للحربة عند الطهطاوي، وبين التطورات التي شهدها المجتمع المصري مع قدوم الحملة الفرنسية عام1798م ورحيله عام 1801م، ثم إدراك المجتمع المصري حاجته للتغيير وضرورة الخروج من أقبية العصور الوسطي, وهذا لن يتم إلا إذا استعاد الشعب حريته كمجتمع في تحديد مصيره، وفي اختيار حاكمه، وهذا ما عبر عنه أحد رموز هذه المرحلة الفكرية وأستاذ رفاعة الشيخ حسن العطار, بقوله: (إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها, ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها)(3).
وذلك أن الحملة الفرنسية أحدثت ما يشبه الصدمة للمجتمع المصري من خلال عدة أمور, على رأسها القوة العسكرية التي تستخدم أسلحة حديثة لم يكن للمصرين عهد بها، ثم من خلال المعهد العلمي الذي ضم نخبة من العلماء الفرنسيين المرافقين للحملة. وقد تردد على هذا المعهد عددا من رجال الفكر المصريين، كالمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي الذي يقف مشدوهًا فاغرًا فاه مما رآه من تجارب داخل هذا المعهد على يد علمائه0 كما كان الشيخ حسن العطار يتردد على المعهد وعلى علاقة بعلمائه وشاهد فيه من العلوم الحديثة التي لم يكن للمصريين عهد بها من قبل، وقد أدرك هؤلاء المصريون ضرورة مواكبة التقدم الحديث في مجال العلوم، حتى يلحقوا بركب العصر الحديث في الغرب, والذي فتحت الحملة الفرنسية أعينهم عليه.
وبناء عليه فمفهوم الحرية عند الطهطاوي, لم يكن بحال من الأحوال بعيدًا عن هذا الجو العام في مصر، الذي أدرك ضرورة التحديث من خلال الواقع الجديد الذي فرض نفسه آنذاك، والذي كان من ثماره ممارسة الحرية السياسية, وانتخاب أول حاكم بإرادة المصريين في العصر الحديث هو الألباني محمد على، الذي سعى جاهدا بهمة وإرادة، إلى بناء مجتمع حر متطور غير منقطع الصلة بالتقدم الغربي و المنجزات الغربية الحديثة، فاخذ يرسل البعثات والوفود لأوربا لدراسة العلوم الحديثة، خصوصًا في مجال العلوم العلمية والتطبيقية الذي يحتاج إليها في بناء مجتمع حديث، يحتاج لإدارة حديثة تواكب التطورات المعاصرة، وبناء جيش حديث متطور يحمى المجتمع المصري.
كل هذه التطورات لم تكن بعيدة عن حديث الطهطاوي عن الحرية، وذلك باعتباره كان جزءًا من تلك التجربة الحية، وأبرز ملامحها، وأفضل من عبر عنها قولاً وفعلاً، ومن خلال تجربته في فرنسا كطالب بعثة يرصد ملامح التجربة الفرنسية عن قرب، من خلال المهام التي أوكلت إليه في مصر، والمناصب التي تقلدها، والدور الذي مارسه في تاريخ مصر الحديث.
فقد كان الطهطاوي أول عين عربية تأملت في وعى عميق، ومن موقع المحب الناقد، حضارة الغرب الحديثة، ممثلة في حضارة الفرنسيين، وذلك لان الفرق كان شاسعا بين واقع وطنه وبين واقع فرنسا, تخلف هنا و ازدهار هناك، فحاول الرجل الذي ذهب إلى باريس سنة 1826م بزيه الشرقي وتصوراته الإسلامية أن يصنع لوطنه صنيع الذين نقلوا إلى العرب الأقدمين فكر اليونان وعلومهم, وتراث الفرس وفنهم, وفلسفه الهند وحكمتها… وكما أدخل هؤلاء الأسلاف أمة العرب في مركز التأثير الإنساني، وجعلوها تعطى الحضارة الإنسانية عطاءها الفني السخي، فإن رفاعة عزم أن يعيد أمته مرة ثانية إلى القيام بدورها هذا.
من أجل هذا ناضل الطهطاوي في سبيل وصل الخيوط بين وطنه، وبين مراكز الحضارة الحديثة في أي مكان، ووقف موقف العداء من دعوات العزلة وعقد النقص التي تسلم إلى الانغلاق على الذات، فأخذ يدعو قومه إلى الانفتاح على المجتمعات ويسفه من دعاة العزلة، ويرى أن هذه المخالطة بين المصريين وغيرهم من أهل الحضارة الغربية، من أهم إنجازات محمد على؛ لأنها الداء الشافي والعلاج المعافى للداء الذي عانى منه العرب لعدة قرون(4).
فالحرية عند الطهطاوي لازمة أساسية لبناء مجتمع حديث، وذلك على اعتبار أن التمدن حسب تعبيره يبنى على ركيزتين أساسيتين هما: العدل والحرية.
يتحدث الطهطاوي في مناهج الألباب عن التمدن في مصر منذ قديم الزمان، وتفردها عن غيرها من الأمم في الفنون والمعارف، وأنه قد عاد لها مجدها من جديد بفضل محمد على وخلفائه الذين بفضلهم تعزز الوطن بالعلوم والمعارف وصارت فيه قواعد التمدن واستقامت الأمور بتحري العدل, فاعتدلت مصالح الجمهور، وبهذا أحرزت مصر بين الممالك المتمدنة أسني الرتب، وصارت بين بلاد الشرق أفضل الأقطار.
ولا يجحد تمدنها ورقيها في ترسيخ مفهوم الوطنية؛ وبناء عليه يؤكد على ضرورة التواصل مع الحضارة الغربية، لأنها وسيلة عظمى لرقى الوطن كما أنها وسيلة لترسيخ روابط الألفة والحوار بين الشعوب(5).
فمصر تحقق لها اسمها المتعارف عليه وذلك بمسير الناس إليها واجتماعهم فيها، وذلك من أجل تحقيق منافعهم ومكاسبهم أكثر من غيرها من البلاد0 وذلك لحسن موقعها الذي كان له دور في تمدنها و تقدمها العمراني والإنساني. كما كان لهذا الموقع أثره في أخلاق أهلها وتهذيب طباعهم. علاوة على ذلك فإنهم من خلال مخالطتهم لغيرهم من الأمم والشعوب عرفوا أهميه الحوار وتبادل الخبرات.
ويلعب الدين دورا أساسيًّا، كأحد أسباب التمدن والعمران في مصر منذ قديم الزمان . فالمصريون يؤمنون بالأديان وعرف ملوكها وحكماؤها التوحيد , وهكذا حاذوا أسباب التقدم عن طريق: تهذيب الأخلاق بالآداب الدينية والفضائل الإنسانية، وأهميتها في حفظ السلوك الإنساني من الرذائل والموبقات, من أجل هذا كان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا و استقامتها، وهو زمام للإنسان , لأنه ملاك العدل والإحسان.
فالدين الصحيح هو الذي عليه مدار العمل في التعديل والتجريح, فحقيق على العاقل أن يتمسك به, ويحافظ عليه متعبدًا, فأدب الشريعة ما أدى الغرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض, وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان, وعمارة البلدان, لان من ترك الغرض فقد ظلم نفسه, ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره، واظلم بالإساءة أمسه(6).
والدين أصل ضروري في عملية التمدن والعمران, ويلاحظ تأثر الطهطاوي بابن خلدون في حديثه عن التمدن والعمران في مقدمته. كما يلاحظ إيثاره للمصطلح الإسلامي في هذا المجال على غيره من المصطلحات، فمصطلح التمدن والعمران مصطلح إسلامي، وقد كان للشيخ رفاعة فضل نشر مقدمة ابن خلدون في مطبعة بولاق بالقاهرة سنة 1857م بإيعاز من المستشرق الفرنسي دوساسى(7).
من اجل ذلك يقسم التمدن إلى نوعين :
– معنوي.
-ومادي.
أما المعنوي وهو التمدن في الأخلاق والعادات والآداب، وهو التمدن في الدين والشريعة، وبهذا القسم قوام الأمة المتمدنة التي تسمى باسم دينها وجنسها كالأمة العربية الإسلامية, وذلك لتميزها عن غيرها, فمن أراد أن يقطع عن ملة تدينها بدينها, أو يعارضها في حفظ ملتها، (المخفورة الذمة شرعًا)، فهو في الحقيقة معترض على مولاه. فقد قضت الحكمة الإلهية أن تتصف تلك الأمة بهذا الدين، فمن يستطيع معارضة المشيئة الإلهية ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (8).
ويؤكد على الحرية الدينية، وحق الفرد في اختيار دينه، حتى ولو خالف دين الدولة التي يعيش فيها شريطة ألا يؤدي ذلك لضرر على نظام الدولة التي يعيش فيها فيقول:
(أما وقد اتسع نطاق الإسلام، فكل امرئ وما يختار، فبهذا كانت رخصة التمسك بالأديان المختلفة جارية عند كافة الملل، ولو خالف دين المملكة المقيمة بها، بشرط أن لا يعود منها على نظام المملكة أدنى خلل، كما هو مقرر في حقوق الدول والملل)(9).
ورغم إعجاب الطهطاوي بالنموذج الفرنسي في الحرية إلا أنه ينتقدهم في اعتمادهم المطلق على العقل وبعدهم عن الدين. وهو ما أبرزه في تلخيص الإبريز في قوله:
(وقد أسلفنا أن الفرنساوية من الفرق التي تعتبر التحسين والتقبيح العقليين، وأقول هنا: أنهم ينكرون خوارق العادات، ويعتقدون أنه لا يمكن تخلف الأمور الطبيعية أصلا، وأن الأديان إنما جاءت لتدل الإنسان على فعل الخير واجتناب ضده، وأن عمارة البلاد وتطرق الناس وتقدمهم في الآداب والظرافية تسد مسد الأديان، وأن الممالك العامرة تصنع فيها الأمور السياسية كالأمور الشرعية، ومن عقائدهم القبيحة قولهم: إن عقول حكمائهم وطبائعييهم – يقصد علماء الطبيعة – أعظم من عقول الأنبياء وأذكى منها. ولهم كثير من العقائد الشنيعة، كإنكار بعض القضاء والقدر)(10).
وينتقد تحررهم من الدين فإنهم نصارى بالاسم فقط، فلا يقنعون بما حرمه دينهم أو أوجبه أو نحو ذلك، ويرون أن العبادات التي لا تعرف حكمتها من قبيل البدع والأوهام. وينتقد عدم زواج القساوسة ويعد ذلك نقيصة تزيدهم فسقا، كما ينتقد ما يسمى بالاعتراف بالذنوب من العامة أمام القساوسة فيغفر له القس ذنوبه.
ولأمانته يذكر الطهطاوي نقد دي ساسي وتعقيبه علي قوله بتحرر الفرنسيين من الدين، فيذكر دي ساسي أن كلام الطهطاوي يصدق على أهل باريس وكثير من الفرنسيين ممن يهتمون بشئون الدنيا فقط، لكن في مقابل ذلك يوجد من يقيم دين آبائه ويؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل الصالحات من كل صنف وفئة من الرجال والنساء(11).
وأما التمدن المادي، وهو التقدم في ما يحتاجه المجتمع في سائر شئون الفنون مما يسميه (المنافع العمومية ) كالزراعة والتجارة والصناعة، وهي تختلف من بلد إلى آخر قوة وضعفا، طبقا للممارسة وهو أمر لا غنى عنه في عملية التقدم والتمدن(12).
واضح تأثر الطهطاوي في حديثه عن المنافع العمومية بالأصوليين في حديثهم عن المقاصد الشرعية، وكيفية تحقيقها للمصالح العامة في حياة الفرد والمجتمع، على النحو الذي فصله الشاطبي في حديثه عن الكليات الخمس في كتابه (الموافقات)، مهتديا بجهود السابقين عليه وخصوصا الغزالي في (المستصفى)، الذي تأثر فيه بأستاذه الجويني في البرهان(13).
والسنن الكونية تؤكد أن الأيام دوال، وكل أمة تأخذ حظها من التمدن فترة من الزمن، ولكن هذا لا يتحقق إلا بعزيمة أصحابها وحبهم لأوطانهم، لدرجة أنه يشبه حب الأوطان بحرارة تسري في أبدان أهلها، وأنها تغلب على حرارتهم الغريزية، وتغلب على القوة الأولية، وبهذا تتحقق للوطن أمانيه من التمدن الحقيقي، بشقيه المعنوي والمادي.
جملة القول أن عوامل التمدن اجتمعت في مصر وهذا ما يؤكد عليه فيقول:
(فقد أجمع المؤرخون على أن مصر، دون غيرها من الممالك، عظم تمدنها، وبلغ أهلها درجة عالية في الفنون والمنافع العمومية، فكيف لا وأن آثار التمدن وأماراته وعلاماته مكثت بمصر نحو ثلاثة وأربعين قرنا يشاهدها الوارد والمتردد، ويعجب من حسنها الوافد والمتفرج، مع تنوعها كل التنوع، فجميع المباني التي تدل على عظم ملوكها وسلاطينها هي من أقوى دلائل العظمة الملوكية وبراهينها)(14).
ويضرب مثل بالأمة الفرنسية على تمدنها وبلوغها درجة عالية من الحضارة بالمعرفة والآداب التي تجلب الأنس وتزين العمران، والبلاد الأوربية عموما مشحونة بأنواع المعارف، لكن فرنسا تمتاز عن غيرها من بلاد أوروبا بكثرة تعلقها بالفنون والمعارف، فهي أعظم أدبًا وعمرانًا(15).
وعلامات التمدن ودلائل العظمة تقوم على ثلاثة ركائز هي:
– حسن الإدارة الملكية (السلطة السياسية).
– السياسة العسكرية (القوة التي تحمي الدول وتحفظ لها سيادتها).
– معرفة الألوهية (الدين الذي ينظم حياة الناس على أسس من العدل والشورى).
وهذه الأسس الثلاثة للتمدن كانت موجودة في مصر منذ القدم، وبلغت درجة عظيمة واستمرت عبر القرون(16)، ويتحدث عن تجربة يوسف u في مصر، والتي يستفاد منها ( أنه كان بمصر إذ ذاك أحكام عادلة، وقوانين مرتبة، وحدود مشروعة خالية من الأغراض والنفسانيات وهي نتيجة التمدن التام)(17)،
والسياسي الماهر هو الذي لا يضيق على شعبه، ويسير بينهم بالعدل، ويحترم حريتهم الدينية، وعاداتهم الاجتماعية ويستشهد بسيرة الإسكندر الأكبر وحنكته في تعامله مع الأمم والشعوب التي أخضعها لسيطرته، فلم يضيق على حرياتهم، ولم يتدخل في أفكارهم ولا معتقداتهم(18).
واضح مما تقدم أن الطهطاوي يريد إبراز دور مصر كدولة مؤهلة تاريخيا للتمدن والتقدم واستيعاب التجارب الحديثة في الحرية لدى الأمم المتقدمة وهو ما ركز عليه في كتاب (مناهج الألباب).
ويقسم الطهطاوي الحرية إلى خمسة أقسام على النحو التالي :
الأول: الحرية الطبيعية: وهي التي خلقت مع الإنسان، وانطبع عليها كالأكل والشرب … مما لا ضرر فيه على الإنسان نفسه ولا على إخوانه .
الثاني: الحرية السلوكية: التي هي حسن السلوك ومكارم الأخلاق … وهي الوصف اللازم لكل فرد من أفراد الجمعية – المجتمع – المستنتج من حكم العقل، بما تقتضية ذمة الإنسان وتطمئن إليه نفسه في سلوكه في نفسه، وحسن أخلاقه مع غيره.
والثالث: الحرية الدينية: وهي حرية العقيدة والمذهب، بشرط أن لا تخرج عن أصل الدين، كآراء الأشاعرة والماتريدية في العقائد، وآراء أرباب المذاهب المجتهدين في الفروع.
ومثل ذلك حرية المذاهب السياسية، وآراء أرباب الإدارات الملكية في إجراء أصولهم وقوانينهم وأحكامهم على مقتضى شرائع بلادهم، فإن ملوك الممالك ووزرائهم مرخصون – أي أحرار – في طرق الإجراءات السياسية بأوجه مختلفة، ترجع إلى مرجع واحد وهو حسن السياسة والعدل …
والرابع: الحرية المدنية: وهي حقوق العباد والأهالي الموجودين في مدينة، بعضهم على بعض، فكأن الهيئة الاجتماعية المؤلفة من أهالي المملكة تضامنت وتواطأت على أداء حقوق بعضهم لبعض، وان كل فرد من أفرادهم ضمن للباقين أن يساعدهم على فعل كل شيء لا يخالف شريعة البلاد – قانونها – وأن لا يعارضوه، وأن ينكروا جميعا على من يعارضه في إجراء حريته، بشرط أن لا يتعدى حدود الأحكام.
والخامس: الحرية السياسية: أي الدولية – نسبة إلى الدولة– وهي تأمين الدولة لكل أحد من أهاليها على أملاكه الشرعية المرعية، وإجراء حريته الطبيعية بدون أن تتعدى عليه في شيء منها، فبهذا يباح لكل فرد أن يتصرف فيما يملكه جميع التصرفات الشرعية(19).
واضح في حديث الطهطاوي السابق عن أقسام الحرية تأثره الواضح بفكر التنوير الفرنسي، ففي حديثه عن الحرية السياسية مثلا يتضح في حديثه عن العقل باعتباره مصدر للحرية والفعل. كما أن حديثه عن النوع الخامس وهو ما سماه الحرية السياسية قصد بها حرية سياسة الإنسان لنفسه في تصرفه في شئونه الخاصة. وهي ما يمكن أن نسميها حريته في تدبير شئونه الاقتصادية(20).
يؤكد الطهطاوي – بعد هذا العرض لأقسام الحرية الخمس – على أن الحرية بهذا المفهوم الواسع والممتد الذي يتضمن هذه المعاني، هي الوسيلة العظمى لسعادة أهل البلاد، لان الحرية التي تستند على قوانين عادلة، هي أعظم وسيلة لتحقيق الاستقرار والسعادة بين المواطنين، وسبب لتعلقهم بوطنهم وحبهم له.
ويلاحظ أن هذه الأقسام الخمسة وكأنها محاولة من الطهطاوي للتوافق مع الكليات الخمسة للشريعة كما هو لدى الأصوليين في أن هذه الكليات الخمسة هي حفظ النفس والعقل والمال والعرض والدين، وترتيب المقاصد بين ضرورية وحاجية وتحسينية، حسب الحاجة والمصلحة(21).
ويحق لكل مواطن أن يمارس حقوقه في إطار القانون، دون إكراه على مخالفة النظام؛ وذلك لأن من حق كل مواطن أن يتمتع بحريته في نطاق الشرع والقانون، وذلك حيث يعد حرمانه من هذا الحق تضييقًا عليه واعتداء على حريته دون وجه حق، ويعد ذلك اعتداء على حقوق المواطن المخولة له شرعا وقانونا، لان حرية المواطنين في ظل نظام عادل قوي لا يخشى منه على الدولة، ولكن معرفة حق المواطن وحق الحاكم واحترام كل طرف للثاني دون اعتداء من طرف على الآخر من أهم أسباب قوة الدولة واستقرارها وحفظ حقوق الحاكم والمحكوم(22).
والقانون هو أساس العدل ومعياره، ويضرب على ذلك مثلا بما هو كائن عند الفرنسيين فكان ذلك (من أسباب تعمير الممالك وكثرة معارفهم، وتراكم غناهم، وارتاحت نفوسهم، فلا تسمع فيهم من يشكوا ظلما أبدا، والعدل أساس العمران(23).
وتعد الحرية أمرًا فطريًّا كرم الله بها الإنسان وفضله على جميع المخلوقات، وبناء عليه يجب عليه أن يتمتع بحريته في إعزاز وطنه وإخوانه ورؤسائه. كما يعد التزام الفرد بقوانين الدولة وقيامه بواجباته تجاه وطنه كالجهاد والعمل تعديا على حقوقه، لأن هذا يعد واجبًا وطنيًّا. فعلى سبيل المثال يعد الدفاع عن الوطن ضد أعدائه دفاعا عن الحرية. والحرية تستلزم العلم، ومحاربة الجهل، ومعرفة حقوق المواطن، من اجل تحقيق التقدم والمدنية.
والحرية تستلزم المساواة بين المواطنين في جميع الحقوق والواجبات، لكن ليس معنى هذا أن يأخذ الإنسان ما لا يستحقه فكل إنسان حسب قدراته وإمكانياته، فالمساواة تدعم الحرية بين أفراد المجتمع. وبناء عليه (فإن حريتهم توضع على أساس متين، وتكون مملكتهم راسخة القواعد، لا يعتريها الخلل من بين يديها ولا من خلفها)(24).
ولم يقتصر حديث الطهطاوي عن الحرية، على الدعوة والتنظير الفكري المجرد، ولكنه سعى لتطبيق هذه الأفكار وتجسيدها في الواقع العملي، من خلال حديثه عن حرية المرأة ودفاعه المستميت عن حقها في التعليم والمشاركة، فكان رائدًا في هذا المجال، الذي لم يطرقه أحد من قبل في الشرق في العصر الحديث. كما كان رائدًا للفكر العربي والإسلامي الحديث عن جدارة واستحقاق، وهذا ما سنناقشه في الصفحات التالية.
حرية المرأة عند الطهطاوي:
يعد رفاعة الطهطاوي بحق الرائد الأول لقضية تحرير المرأة في الشرق العربي و الإسلامي، وأول من سعي لتحريرها من قيود العصور الوسطي وعمل علي تطبيق أفكاره في الواقع العملي، فسعي إلي تعليمها حتى تحظي بحقوقها كإنسان مثلها مثل الرجل في الحقوق والواجبات، فكان عضواً بلجنة تنظيم التعليم التي اقترحت سنة 1836م العمل علي تعليم البنات .
وجاء حديث الطهطاوي عن تحرير المرأة في سياق حديثه العام عن ضرورة تحرير المجتمع المصري، والعمل علي نهضته وتقدمه، علي اعتبار أن المرأة ركناً من أركان المجتمع لا تقوم نهضته الحقيقية بدون مشاركتها وتمتعها بحريتها، كإنسان له حقوق وواجبات اجتماعية وإنسانية . وقد ضمن هذا كتابه (المرشد الأمين في تربية البنات والبنين).
يبدأ حديثه عن التربية كتنمية حسية ومعنوية للأطفال، عن طريق تربية الجسد وتربية الروح، وتشترك في هذه التنمية ثلاثة أنواع من الغذاء:
الأولى : تنمية المرضع للأطفال بالألبان .
الثانية : تغذيتهم بإرشاد المرشد بتأديبه الأولي للأطفال وتهذيب أخلاقهم، وتعويدهم التطبع بالطباع الحميدة، والآداب والأخلاق .
الثالثة : تغذية عقولهم بتعليم المعارف والكمالات، وهذه وظيفة الأستاذ المربي.
وهذه الأنواع الثلاثة، وإن كانت تبدو سهلة إلا أنها عملية شاقة وعسيرة تحتاج لأصول وقواعد، بالإضافة إلي محبة الأطفال من كل من يتعامل معهم من مرضعين ومربين وأساتذة.
وتهدف لتهذيب الجنس البشري ذكراً كان أو أنثى، حتى يستفيد منها الصبي هيئة ثابتة يتبعها ويتخذها عادة وتصير له دأباً وشاناً وملكة. وبناء عليه فالتربية المعنوية هي (فن تشكيل العقول البشرية، وتكييفها بكيفية حسنة مألوفة ، وغايتها إيجاد ملكة راسخة في الصغير تحمله علي التخلق بحسن الأخلاق حسب الإمكان، بحيث تحصل من هيئة تربيته الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً بسهولة ويسر، كطلاقة الوجه، والحلم والشفقة ….)(25).
وحديث الطهطاوي علي أن التربية تهدف لتكوين ملكة راسخة في الصغير تحمله علي التخلق بالأخلاق الحسنة حتى يصير ذلك طبعاً وسجية، أمر مألوف في تراثنا ولدي المعنيين من أسلافنا(26).
وتربية أفراد المجتمع ذكوراًٍ وإناثا، يترتب عليه حسن تربية المجتمع بكامل هيئته، والأمة التي أحسنت تربية أبنائها، واستعدوا لنفع أوطانهم هي أمة سعيدة، فعن طريق التربية السليمة تصل إلي السعادة ويصبح أبناؤها سبب رفعتها وعزتها. والأمة التي تتقدم فيها التربية يتقدم فيها أيضاً التقدم والتمدن علي وجه تكون به أهلاً للحصول علي حريتها(27).
قضية التربية والتعليم واجب في حق أبناء الأمة ذكوراً وإناثاً. وقد أولاها الإسلام عناية خاصة بصورة لم تعهدها الأمم السابقة، وهذا ما يفهم من الخطاب القرآني، الذي أمر بالقراءة في جميع المجالات باعتبارها سر التقدم ومفتاح المعرفة. فكان أول ما نزل من التنزيل هي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وهو دليل علي أن الإسلام يدشن عهداً جديداً ومرحلة جديدة ودستوراً جديداً لم تعهده الأمم السابقة، ولا حتى الرسالات التي سبقت الإسلام. فرسالة الإسلام تقوم علي العلم والمعرفة كركائز أساسية في بناء أمة جديدة، وأكد علي ذلك بقوله تعالي في سورة الزمر: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾.
وجعل الإسلام ذلك الأمر فرضا علي المسلمين لا فرق بين رجل أو امرأة في هذا الأمر بنص الحديث النبوي: (طلب العلم فريضة علي كل مسلم)، وأيضاً قوله r: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلي الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم علي العابد كفضل القمر علي سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)(28).
ولا يظنن أحد أن لفظ مسلم في الحديث خاص بالرجل دون المرأة، علي اعتبار أن لفظ مسلم مذكر، وردنا علي هذا نقول أن الكلمة تطلق في اللغة علي التغليب، لكنها تشتمل الرجل و المرأة علي السواء كما هو معهود في لغة العرب.
وتناول علماء المسلمين قضية طلب العلم وفضله في التراث بعناية وأولوه اهتمامهم وهذا كله لم يكن بعيداً عن وعي الطهطاوي وهو يناقش قضية حق المرأة في التعليم، فيري أن الأمم منذ القدم اهتمت بتربية كل ما ينفع الإنسان من الحيوانات الأليفة كالخيول والببغاوات والصقور والنحل ودود القز وهو أمر أفاض فيه الجاحظ من قبل في حديثه عن الحيوانات وكيف يروضها الإنسان و يستأنسها(29).
ولا يعقل أن الأمم التي تهتم بتربية وترويض الحيوانات المفيدة للإنسان ستهمل تربية وتعليم نصف المجتمع وهي المرأة، فقد عهدت الأمم المتمدنة منذ القدم من أيام اليونان علي تربية المرأة وتعليمها، وقد اختلف موقف الأمم والشعوب من قضية تعليم المرأة حتى جاء الإسلام فاحتلت قضية المرأة أهمية خاصة في الدين الجديد وحصلت علي حقوق لم تعرفها البشرية من قبل.
وذلك لأن الأصل في الخطاب الديني قرآنا وسنة أنه موجه للرجال والنساء علي السواء، بدءا من تقرير الكرامة الإنسانية إلي تقرير المسئولية الجنائية، وعلي الرغم من وجود فوارق محدودة، فإن الأصل هو المساواة، والفوارق استثناء من هذا الأصل، وأنه لمن الخطأ والعدوان علي شرع الله أن يضيع هذا الأصل(30).
فالأصل في الخلقة المساواة في الفطرة والكرامة الإنسانية، والأصل في الخطاب القرآني المساواة التامة في التكاليف والواجبات بين الرجل والمرأة أي في المسئولية، وبعض الفروق التي وردت كفروق بين الذكورة والأنوثة هي للترتيب والتنظيم بين الجنسين ومراعاة الواقع، ومسئولية كل طرف تجاه الآخر من جهة، وتجاه المجتمع من جهة أخرى.
ويتحدث الطهطاوي عن التكامل بين الرجل و المرأة، فقد خلق الله المرأة للرجل ليبلغ كل منهما من الآخر أمله، ويقتسم معه عمله، وجعل المرأة تلطف لزوجها أتراحه، وتضاعف أفراحه، وتحسن أمر معاشه، فهي من أعظم صنع الله القدير، وقرينة الرجل في الخلقة. فالمرأة مثل الرجل سواء بسواء، في الأعضاء والحواس والصفات، وتناسب الحركات والأعضاء، ولا توجد فروق بينهما إلا من حيث الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما.
أما عن الفروق الجسدية بين الرجل و المرأة، فإن المرأة تتميز بصفات جسدية عن الرجل (فإن قامتها في الغالب دون قامة الرجل، وخاصرتها أنحف من خاصرته وأرشق منها، ورأسها بالنسبة لبدنها أقل حجماً من رأسه بالنسبة لبدنه، وسعة صدرها دون سعة صدره، وبدنها أشد بريقاً من بدنه وأنعم وأنور، وفيها من اللطف والرخاوة ما ليس فيه، وكتفاها وثدياها وجميع أعضائها علي العموم تلين وتنعطف وفيها استدارة جميلة، وبالجملة فالمرأة ألطف شكلاً من الرجل)(31).
وتتميز المرأة بصفات رقيقة ترغب فيها الرجال تنسجم مع طبيعتها كأنثى كالرقة والنعومة ورخامة الصوت والحياء والدلال، هذا مع ضعف يوجب الرفقة بها والحنان والعطف عليها.وربما لهذا السبب كان من أخر ما أوصي به الرسول r في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيراً(32).
ورغم هذا فالمرأة تبلغ مرحلة النضج قبل الرجل، وتستكمل درجة النمو في زمن أقل مما ينمو فيه الرجل. ولما كان النساء مقصورات علي الشفقة والرحمة والحنان والرفق واللين كن غالباً مستعدات لأن تفرج عن العوائد الخشنة والأخلاق الغليظة والصفات المذمومة المجتمعة في أمزجة الرجال، كالغضب والحقد والبغضاء والشقاق، لكن أعظم ما فيهن الغيرة التي لا تكاد تخلو منها واحدة(33).
وتتصف المرأة إلي جانب الصفات الجسدية بصفات معنوية أخري، مثل قوة الصفات العقلية، وحدة الإحساس والإدراك علي وجه قوي قويم، وذلك ناشئ عن نسيج بنيتها الضعيفة، فتري قوة إحساس المرأة وزيادة إدراكها تظهر في الأشياء التي يظن أنها غريبة عنها، مثل إدراكها ما يوافق ذوقها وما يليق بها ويناسب طبعها. مما لا يفهمه الرجل بسهولة، فيجب عليه موافقتها في هذا الجانب؛ لأن المرأة أبرع في فهم فن المؤانسة والسرور وما يتصل بموضوع الحب والوداد، وكذلك دقة الفهم والبداهة(34).
ويسترسل في وصف مناقب النساء كالحياء والرقة والدلال، وقدرتها علي إخفاء مشاعرها، بعكس الرجل مستشهداً علي كلامه بأبيات من الشعر في خصائص المرأة. وينجح في تحويل ما يظن بعض الرجال أنه نقاط ضعف لدي المرأة، لنقاط قوة وخصائص تميز المرأة، وهذا ما أكد عليه عمارة في قوله:
(ويسلم الطهطاوي بأن الأنوثة ربما نشأ عنها ضعف في بنية المرأة … ولكنه يقدم لهذا الأمر نتائج هي علي العكس تماماً من تلك التي قدمها ويقدمها أعداء المساواة بين الرجال والنساء … فهم يرون في هذا الضعف في البنية سببا يفضي إلي ضعف في القدرات العقلية والإمكانات اللازمة لتولي بعض الأعمال .. أما الرجل فإنه يرى العكس، حيث أن هذا الضعف في البنية يعوضه، بل ينشأ عنه لدي المرأة قوة في هذه القدرات والإمكانيات)(35).
وتستطيع المرأة منافسة الرجل في العلوم والفنون وكافة مجالات الحياة، ويحاول تفسير سبب حرمانها من هذا الحق – التعليم – في عصره وما سبقه، بدافع الخوف عليها من مخالطة الرجال وتعرضها للقيل و القال، مما دفعها للتعود علي الخمول والكسل والجلوس في البيت.
ورغم ذلك فالمرأة لها قدرة علي أسر قلب الرجل واستعباده، بالحب والرقة والأخلاق الفاضلة، أما المرأة التي تتصف بسرعة الغضب وسوء الخلق، فإنها تسقط من عينيه بذلك، وينقص حبه لها ووده، ولا يكون لها تأثير علي قلبه، وينفر منها كما تنفر الرعية من الحاكم الظالم. فالحلم من النساء وحسن معاشرتهن مع الرجل أول مزية، أما المرأة السيئة فهي تهرم الرجل قبل هرمه، وتذهب بكرمه (فلا يتم أمر الرجل إلا بحرة شفيقة عفيفة رفيقة، حسنة الأخلاق، عذبة المذاق)(36).
جملة القول أنه يجب تربية المرأة علي تحمل الرجل وحسن معاشرته، والاستعداد للصفح عن زلاته فتسلك معه مسلك الحلم واللين والرفق وحسن الخلق، وذلك لأن هذا يعود عليها بالمنفعة، أكثر مما يعود عليه. وذلك لأن سوء خلق المرأة وعنادها يجلب لها التعب، وينتج عنه إساءة معاشرة الرجل(37).
ويحتاج الإنسان إلي تنمية ملكاته المعنوية والعقلية، كحاجته لتنمية ملكاته المادية والحسية مما يتطلبه جسم الإنسان وبدنه، ومن هنا فحاجة الإنسان للتربية والتعليم أمر ضروري حيث أن الإنسان مجبول علي التأنس والعيشة مع أمثاله، لذا وجب عليه تحسين خلقه، وترويض طبعه، وذلك باكتساب العادات الحسنة واجتناب العادات السيئة حتى يصير ذلك له طبعاً وعادة عن طريق ترويض نفسه وتدريبها علي ذلك(38).
ويرى الطهطاوي أن تعليم المرأة مما يزيدها أدباً وعقلاً، ويجعلها أهلاً للمعارف، تصلح لمشاركة الرجل في الكلام والرأي فتعظم مكانتها عنده. كما يمكنها التعليم من مزاولة العمل كالرجل سواء بسواء، بحسب قدرتها وطاقتها، وهذا أفضل لها من البطالة فتنشغل بالأباطيل والثرثرة حول سيرة الناس. وهذا ما ينقلنا للحديث عن النقطة التالية وهي عمل المرأة وموقف الطهطاوي منها.
حق المرأة في العمل:
ويتعرض الطهطاوي في ذلك الوقت المبكر من تاريخ نهضتنا العربية، لقضية شائكة لم تكن مقبولة حينذاك بحال من الأحوال في المجتمع المصري، ولا في غيره من المجتمعات العربية والإسلامية، وهي قضية عمل المرأة، فيؤكد علي حق المرأة في التعليم والعمل، ولا يجد ما يحول بينها وبين ذلك شرعاً، ويحاول أن يؤصل تاريخيًّا وشرعيًّا هذا الحق بالأدلة الشرعية.
وقد أشار إلي ذلك الموقف أحد الباحثين بقوله: (وقضية العمل بالنسبة للمرأة، وقف الطهطاوي منها موقفاً متقدماً، بل وثورياً بالنسبة لعصره، فالرجل لم يحدد لتعليم المرأة آفاقاً تحدد دائرة حياتها بالمنزل والأولاد والزوج فقط … بل ربط العلم عندها بالعمل الذي يمكن أن تتعاطاه)(39).
فصرف الهمة نحو تعليم البنات أمر واجب وحسن في حقها، لما يعود عليها وعلي المجتمع بالنفع، فالتعليم سيزيدها أدباً وعقلاً، ويجعلها أهلاً للمعرفة، ويجعلها أهلاً لمشاركة الرجال في الكلام والرأي، فتعظم مكانتها عنده، كما سيمكنها من حسن معاشرة زوجها، لأنها بطبيعة الحال أفضل من معاشرة المرأة الجاهلة، فالعلم سيهذب عقل المرأة ويزيل ما به من سخافة وطيش.
وعلاوة علي ذلك فإن التعليم سيمكن المرأة (عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال، علي قدر قوتها وطاقتها، فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن، وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة، فإن فراغ أيديهن عن العمل يشغل ألسنتهن بالأباطيل، وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل، فالعمل يصون المرأة عما لا يليق، ويقربها من الفضيلة، وإذا كانت البطالة مذمومة في حق الرجال فهي مذمة عظيمة في حق النساء. فإن المرأة التي لا عمل لها تقضي الزمن خائضة في حديث جيرانها)(40).
واضح في حديث الطهطاوي السابق، أنه لا يقرر فقط وجهة نظره حول حق المرأة في العمل، ولكنه في الوقت نفسه يرد علي من ينكر عليها ذلك، ويبين ما يترتب علي جهل المرأة من مفاسد عظيمة في حقها كإنسان، وفي حق من حولها كالخوض في سيرة الجيران، وفي حق المجتمع الذي تنتسب إليه أيضاً.
والجدير بالذكر أن الطهطاوي يذكر بإجمال وجهة نظر الخصوم الذين ينكرون علي المرأة حقها في التعليم، بحجة أن التعليم قد يكون وسيلة لفساد المرأة، لأن من طبعها الدهاء والمكر، كما أنها بطبعها ناقصة العقل والأهلية، وأنهن خلقن فقط للمتاع وملاذ الرجال وحفظ النسل.
لكن يبدو أن الناس لكثرة ما ألفوا حرمان المرأة من هذه الحقوق، كالتعليم والعمل، ظنوا أن ذلك هو الصواب، وأنه لمن الفساد أن تحصل علي هذه الحقوق فأخذوا يتشبثون بأفكار واهية، ويرددون حجج ضعيفة لا تصمد للنقد ولا للمناقشة، وذلك في مجمل تقريره لحقها الواجب في هذا الشأن.
ويرد الطهطاوي علي هؤلاء بالأدلة الشرعية، التي تؤكد حق المرأة في التعليم والعمل مستشهداً ببعض زوجات الرسول r اللائي كن يكتبن ويقرأن، كحفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر y ، و غيرهما من النساء في كل زمان ومكان ممن كن يمتهن المهن كالتطريز والتمريض والمشاركة في الحروب.
فيذكر بنات شعيب u وكيف وافق وهو النبي المرسل لابنتيه بسقي الماشية، دون أن يقدح ذلك في حقه بشيء، حيث لا يعد ذلك مفسدة. ولم يكن التعليم والأدب والمعارف، وسيلة لابتذال النساء، وفي المقابل ضل كثير من الرجال نتيجة توغلهم في العلوم والمعارف كالخوارج والمعتزلة(41).
ويعد ذلك الموقف المعادي لحقوق المرأة من العادات الاجتماعية السيئة المنتشرة في المجتمعات الجاهلة، هذا بخلاف المجتمعات المتمدنة التي من أبرز سماتها احترام النساء، وذلك لأنه ( كلما كثر احترام النساء عند قوم كثر أدبهم و ظرافتهم، فعدم توفية النساء حقوقهن، فيما ينبغي لهن الحرية فيه، دليل علي الطبيعة المتبربرة)(42).
ويلمح الطهطاوي إلي جانب نفسي مهم في حرمان المرأة من حقها في التعليم وهو الغيرة من جانب الرجل في أن تظهر مواهب المرأة وخصائصها. وقد جاهد كثيراً في رد أفكار أنصار الفكر المغلق نحو حق المرأة في التعليم والعمل، متأثرين بالعادات والتقاليد التي سيطرت وترسخت في المجتمع المصري في العصرين المملوكي والعثماني، ونسبت زورًا وبهتانًا إلى الإسلام، فوضح أن تلك الأفكار نتيجة لعادات جاهلية غير إسلامية، وهذا ما يؤكد عليه في قوله:
(وليس مرجع التشدد في حرمان البنات من الكتابة إلا التغالي في الغيرة عليهن من إبراز محمود صفاتهن أيا ما كانت في ميدان الرجال، تبعا للعوائد المحلية المشوبة بحمية جاهلية، ولو جرب خلاف هذه العادة لصحت التجربة، فإننا لو فرضنا أن إنسانًا أخذ بنتاً صغيرة السن مميزة وعلمها القراءة والكتابة والحساب، وبعض ما يليق بالبنات أن يتعلمنه من الصنائع، كالخياطة والتطريز، إلي أن تبلغ خمسة عشرة سنة، ثم زوجها لإنسان حسن الخلق كامل التربية مثلها، فلا يصح أنها لا تحسن العشرة معه، أو لا تكون له أمينة، ومثل ذلك سائر البنات، فإن تعليمهن في الأمر عبارة عن تنوير عقولهن بمصباح المعارف المرشد لهن، فلا شك أن حصول النساء علي ملكة القراءة والكتابة، وعلي التخلق بالأخلاق الحميدة، والاطلاع علي المعارف المفيدة، وهو أجمل صفات الكمال)(43).
ويتعرض الطهطاوي لقضية تولي المرأة لمنصب رياسة الدولة أو ما يسميه السياسة العليا. وهذا ما سنناقشه فيما يلي:
المرأة والسياسة العليا:
ويناقش الطهطاوي قضية مهمة جداً وهي حق المرأة في الاشتغال بالسياسة العليا، أو ما يعرف برياسة الدولة، أو الملك، فيقرر ابتداء أن هذا الحق كما قضت الشريعة المحمدية، وقوانين أغلب الأمم مقصور علي الرجال دون النساء. والنساء بطبعهن لا يتحملن أعباء الحكم لما فطرن عليه من ضعف(44).
لكنه يعود ويذكر رأي بعض السياسيين الذين لا يوافقون علي هذا الرأي، ويرون أن الضعف في النساء ليس مطلقاً ولكنه أغلبي فيهم، ويؤكدون علي أحقية المرأة في تولي منصب الحكم ويضرب مثل بمجموعة من النساء أصبحن حاكمات وملكات عبر التاريخ ضربن المثل في الحزم والتدبير كأفضل الرجال (فكلهن أحرزن حسن التدبير والإدارة، وأقمن البراهين علي لياقة النساء لمنصب السلطنة)(45).
ويستطرد في سرد أخبارهن وكأنه لا يمانع في قبول حكم أمثال هؤلاء النسوة اللائي ضربن المثل في الحزم والحسم في تدبير شئون الحكم والممالك التي تقلدوها بعزيمة لا تفتر وإرادة لا تلين، فيتحدث عن بلقيس ملكة سبأ، و الزباء بنت عمر ملكة اشتهرت بالقوة والحزم عند العرب قبل الإسلام، وكليوباترا ملكة مصر، وشجرة الدر التي حكمت مصر وغيرهن من النساء عبر الأمم(46).
ويبدو أن رفاعة الطهطاوي كانت لديه قناعة شخصية بقدرة المرأة علي تولي الحكم، رغم معارضته لذلك امتثالا لأمر الشرع الذي نهي من ذلك كما “اقتضت الشريعة المحمدية”، وهذا ما يستشف في سرده المطول لأخبارهن، بصورة تظهر إعجابه، وحرصه علي معرفة الأجيال التي ستتربى علي عمله هذا، وخصوصاً من الفتيات اللائي يتعلمن في المدارس، باتخاذ أمثال هؤلاء النساء مثلاً وقدوة.
وإذا كانت هذه القضية الشائكة حتى وقتنا الراهن محل خلاف بين العلماء والفقهاء المعارضين لها لتولي منصب الرئاسة، والذين خلصوا إلي أن نهي الرسول عن ذلك في قوله r: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(47)، مرتبط بحدث معين وحادثة خاصة، وبالتالي لا ينسحب علي جميع الحالات، ومن ثم لم يجدوا حرجاً في القول بجواز إسناد منصب الحكم للمرأة.
ويلاحظ أنه بعد أن ينتهي من الحديث بإعجاب عن هذه النماذج من النساء اللائي تقلدن السلطة وسلكن مسالك الشجعان، إلا أنهن سيئات العواقب، وقل أن خلت إحداهن في بعض الأفعال من نقصان. فإذا كان حالهن كذلك، فكيف يجوز وراثتهن للخلافة والسلطنة، ومن تقلد منهن السلطنة وأفلح فيها فلم يكمل لها الفلاح، وإذا كمل فهو من النادر الذي لا حكم له، فحديث: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” صادق بالمضمون، مؤيد بالتجارب، وتولية شجرة الدر، التي لم تسبق في الإسلام سلطنة لغيرها، كانت من قبيل الضرورة التي تبيح المحظور(48).
لكنه بعد ذلك مباشرة يعقب بقول لأحد الحكماء من أنصار التقبيح والتحسين العقليين ممن لا يتبعون النص الشرعي – وعلي ما يبدو أنه أحد أصدقاءه من الأجانب، لأنه يصف الفرنسيين بأنهم من أنصار التقبيح والتحسين العقليين ، بأن النساء من قديم الأزل في مصر رئيسات منازلهن، يسسن أمور المنزل دون مشاركة الرجل من تدبير شئون البيت إلى تربية الأبناء، رغم أن العقل والطبع لا يوافقان علي ذلك لما فيها من ضعف، فيكتسب الأولاد منهن قلة الشهامة وعدم التعود علي الشجاعة.
لكن العقل والطبع لا يمنعان المرأة من تولي الحكم والرئاسة، لأن ما فيهن من ضعف، هو الذي يكسبهن الرفق والرحمة والحلم وكل ما يليق برتبة الحكم والرئاسة من خصائص تقوم علي الرأفة والشفقة بالرعية، وهي أمور لصيقة بطبع المرأة، بعكس الرجل الذي يتصف بالشدة والعنف والجبروت وغيرها من الأخلاق الجافية التي هي لصيقة بالرجل، وهى صفات لا تليق بالملوك في تأليف قلوب الرعية، ومن ثم فلا موجب لحرمان النساء إذن من توليها نظام الحكم والرئاسة، خصوصاً وقد أثبت كثير منهن حكمة ونجاحاً في حكمها وتميزن بمآثر و أحسنت في حكمها.
ثم يعقب الطهطاوي علي هذا الرأي بقوله قد فهمت رده، ويظل يطرح الحجة الشرعية ويثبت عكسها بحكم الواقع، فمثلاً يتحدث عن سعة أبواب الشريعة والسياسة التي تخص الملوك وكيف أنها لا تطيقها عقول النساء، لتعذر مخالطتهن بصفة مستمرة للموظفين المتصلين بشئون الحكم من المدنيين والعسكريين.
غير أنه يؤكد مرة أخرى، علي أن النساء لا يعدمن القدرة علي ممارسة هذه المهام السلطانية، فإن السيدة عائشة – علي سبيل المثال – استجمعت من الأمور الشرعية والسياسية كفاءة الخلافة. ويروي ما يؤكد مثل هذا الكلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه(49).
وكأن الطهطاوي في صراع نفسي حول أحقية المرأة في الحكم والخلافة، فيري أن مؤهلاتها من حيث هي إنسان لا تمنع، لكن المحاذير الشرعية تحول دون ذلك، فيبسط وجهتي النظر بحياد وتجرد، دون تعصب ولا تسفيه لوجهة نظر. ويبدو أنه كان يتناقش حول هذا الأمر مع أحد من أصدقائه الغربيين، الذي لا يرى مانع من تقلد المرأة لهذا المنصب – رئاسة الدولة – ويستمع لوجهة نظره، ثم يقرر رأي الشرع في المنع وعلة ذلك.
لكنه في ختام هذا الفصل ينتهي لرأي حاسم في هذا الموضوع، يفهم منه أنه مع الرأي الشرعي بالمنع، حينما يقرر بوضوح أن من أجاز لها هذا الأمر هم أنصار التقبيح والتحسين العقليين ممن لا يلتزمون بالشريعة، ويقصد بهم الغرب، حيث كانت توجد مجموعة دول غربية تتبع النظام الملكي وتتولي الملكية فيها نساء.
ورأي الطهطاوي في هذا الموضوع الذي ختم به هذه المناقشة، مما يعد بمثابة نتيجة تلخص مجمل رأيه بشكل قاطع هو قوله:
(وأما السلطنة الرسمية علي الرعية – يقصد للنساء – فهي لا تكون إلا في البلاد التي قوانينها محض سياسة وضعية بشرية، لأن قوانين مثل هذه الممالك، تنتج اختلاط الرجال بالنساء، بناء علي قانون الحرية المؤسس عليه تمدن تلك البلاد، و إلا فتمدن الممالك الإسلامية مؤسس علي التحليل والتحريم الشرعيين، بدون مدخل للعقل تحسيناً وتقبيحاً في ذلك، حيث لا حسن ولا قبيح إلا بالشرع).
ولا يسوغ لمتولي الأحكام أن يحكم في التحريم والتحليل بما يلائم مزاجه، مما يخالف الأوضاع الشرعية المنقولة عن الأئمة المجتهدين، ولا عبرة بالاستكراه النفساني، والاستحسان الطبيعي، والأخذ بالرأي من غير دليل شرعي، بل يعتمد متولي الأحكام علي فتاوى العلماء وأقوال المجتهدين في الدين، فإن الإمامة إنما تخلف النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا(50).
وهذا يعد خلاصة رأيه في القضية وهو رأي حاسم في هذا الباب، في أنه كان يقف مع الشرع في منع المرأة من ولاية الحكم، ولا يمكن أن نحمل الطهطاوي في هذا الوقت المبكر من تاريخ فكرنا الحديث والمعاصر بأكثر مما يحتمل.
وحقيقة الأمر أن موقف رجال الفكر والدعوة المعاصرين مازال متوافقاً مع رؤية الطهطاوي، من حيث منع المرأة من منصب الحكم، فسعيد رمضان البوطي يؤكد علي (إننا إذا استثنينا رئاسة الدولة التي كان يعبر عنها بالخلافة عن رسول الله r، فإن سائر الرتب والأنشطة السياسية الأخرى، تعد في الشريعة الإسلامية، مجالات متسعة لكل من الرجل والمرأة)(51).
ويستدل بحديث الرسول (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) علي المنع وهو ما استدل به جمهور علماء الشريعة علي حرمة إسناد مهام الخلافة أو رياسة الدولة إلي المرأة أيا كانت، ولا يجوز أن تعقد لها البيعة شرعاً.
والحكمة من وراء ذلك، أن قسما كبيرا من مهام الخليفة أو من يحل محله مهام دينية محضة، وليست مجرد سياسة، ومنها جمع الناس لصلاة الجمعة وخطبتها، والمرأة غير مكلفة بذلك ولا حتى بالحضور كما لا يجوز أن توكل من يقوم بذلك طبقاً للقاعدة الشرعية: لا تصح الوكالة إلا ممن يستوي مع الوكيل في المطالبة بذلك الحكم وشرائط صحته وانعقاده. ومن مهام الخليفة إعلان الحرب وقيادة الجيش في القتال، والمرأة غير مكلفة بذلك إلا في حالة النفير العام عند مداهمة العدو دار الإسلام، وغير ذلك من القضايا التي نقتضي عدم الزج بالمرأة في هذه المواقف المحرجة، التي لا ضرورة لها(52).
وممن تعرض لقضية الحرية برؤية جديدة في تاريخنا الفكري المعاصر، عبد المتعال الصعيدي، الذي تناول بوضوح وصراحة حرية الفكر والعقيدة، بصورة غير معهودة من قبل في ثقافتنا الدينية الحديثة والمعاصرة، خصوصاً وأن رأيه كان اجتهادا فكرياً متكأ علي التراث، حتى وهو ينفرد برؤى جديدة أثارت عليه أنصار الرؤى التقليدية. وقد جاء رأيه بعيداً عن التأثيرات الأيديولوجية، أو بدافع هوي شخصي يهدف إلي حب الشهرة أو الخروج علي المألوف، أو يهدف للمعارضة من أجل العارضة. وهذا ما سنناقشه في الصفحات التالية.
قضية الحرية عند الصعيدي:
هل الحرية في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر تجاوزت نطاق التأصيل النظري، والدفاع عن النفس في تبديد التهم التي توجه إلي الإسلام بأنه يقيد الحرية؟ وهلا فعلاً الواقع العملي في حياتنا لا يبدد هذه التهمة؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها الباحثون المعاصرون في الفكر الإسلامي، وهذا ما أكد عليه احدهم في قوله:
( أعتقد أننا مازلنا ندور في حلقة التأصيل مأخوذين بالحالة الدفاعية التي تحاول أن تنفي عن الإسلام تهمة تقييد الحرية الفكرية. فيما الواقع العملي لا يبدد هذه التهمة. والسبب في ذلك عدم وضوح الحدود التي ترسم سقف الممارسة العملية، ويعود الأمر إلي تخلف الفقه السياسي بالقياس إلي فروع الفقه الأخرى)(53).
في واقع الأمر فإن الدفاع عن الإسلام، بالتركيز علي عيوب الليبرالية غير مجدي شيئاً للإسلام، وذلك لأن المعركة تكون قد جرت علي أرض الإسلام، وبما أن نموذج الليبرالية قائم بالفعل وله أنصاره ومؤيدوه، فمن الأولى التركيز علي أن الإسلام له رؤيته الخاصة، فيما يتصل بقضية الحرية ويضع حدوداً علي ممارستها والتعبير عنها، ويرفض الحرية المطلقة، فلا يسمح بأدب خليع، ولا بفكر يعادي الغيب والتوحيد والإيمان، أو يشكك في أساسيات الدين، بدعوى العقل والعلم .
وهذا الواقع يعبر عن نفسه كلما صودر كتاب أو رواية تتضمن تشهيراً بالثوابت والقيم الدينية من قبل العلمانيين والأيديولوجيين الذين يتدثرون بشعار حرية الفكر للتهجم علي الإسلام بحجة معاداته لحرية الفكر والرأي، وهو ما تكرر كثيراً وفى كل مرة تشتعل الهجمة علي الإسلام وقيمه وضيقه بالرأي الآخر، وهي هجمات مصطنعة تهدف من وراء هذا الهجوم المتكرر، إلي وضع الإسلاميين في موقف حرج، ويحشرهم في زاوية المدافع بصفة دائمة.
ومن ثم فالأجدى فتح الأبواب لكل صاحب رأي، يعبر عن نفسه بحرية، فالرأي الفاسد سوف يزوي ويضمحل، فما أكثر ما اندثر من أفكار ومذاهب وفرق ضالة ذهبت أدراج الرياح. إن التضييق علي الفكر ومقارعته بغير الفكر والبرهان، دليل علي توجس وخوف، والإسلام أقوي من كل هذا، وأكبر من أن تنال منه فكرة باطلة أو رأي فاسد، لكن المشكلة في الذين ينصبون أنفسهم حماة الإسلام فيضعوا القيود والحدود، ويلجموا الناس عن التعبير عن أنفسهم بحرية وصراحة(54).
هذه المقدمة تمثل تعبيراً حقيقيًّا عن واقع الحال المأزوم في واقعنا المعاصر في العالم العربي والإسلامي، الذي لا تهدأ فيه غبار المعارك الوهمية حول حرية الفكر والتعبير، ومن ثم كانت رؤية عبد المتعال الصعيدي حول قضية حرية الفكر والمعتقد في الإسلام، أكبر رد عملي حول هذه القضية الشائكة .
لقد جاهد الصعيدي من اجل تحرير الفكر الإسلامي مما لحق به عبر العصور من أفكار ورؤى شابت مسيرته، وحادت به عن جادة الصواب، وحالت دون بلوغ الهدف المنشود، من اجل هذا سعي ما وسعه الجهد لإثبات أن حرية الفكر والعقيدة حق ثابت ومقرر في ينابيع الإسلام الأولى، قبل أن يكدرها جمود الفكر فيه، ويبتعد به عن صفائه، ليفهم دينه كما أنزل علي رسوله، وكما يجب أن يفهم في عصرنا عصر التحرر الفكري .
وكان دافعه من وراء هذا الاجتهاد الديني الأصيل، باعتباره احد أبناء المؤسسة الدينية الشرعية، تلقي أصول الفكر الشرعي، واستقي قواعده ومناهجه وفق الأصول المقررة، فلم يكن دخيلا علي هذا الفكر، ولا مدعيا صاحب رؤية إيديولوجية تسعي لتبرير رؤية معينة لخدمة أهداف محددة. فقد ألزم نفسه السير في طريق العلماء الأحرار؛ لأنه حسب تعبيره (آثر التجديد على الجمود، ورجح الاجتهاد على التقليد)(55).
وقد أولى الصعيدي قضية التجديد عناية خاصة، فتتبعها عبر التاريخ الإسلامي في كتاب خاص تحت عنوان (المجددون في الإسلام)، وفيه يرى أن التجديد امتد لمضامين أوسع من حصره في مجال الخطاب الديني فشمل مجالات السياسة، فعد من قبيل المجددين بعض الحكام كعمر بن عبد العزيز وقادة الجيوش كصلاح الدين الأيوبي(56)، وبناء عليه لم يقتصر التجديد علي رجال الفكر والدعوة الذي حاول بعضهم زج اسمه في زمرة هؤلاء كما فعل السيوطي وغبر ذلك شعراً بقوله:
الحمد لله العظيم المنة
المانح الفضل لأهل السنة
ثم الصلاة والسلام نلتمس
علي نبي دينه لا يندرس
لقد أتي في خبر مشتهر
رواه كل حافظ معتبر
بأن في رأس كل مائة
يبعث ربنا لهذي الأمة
منا عليها عالما يجدد
دين الهدى لأنه مجدد
وبعد أن يذكر أسماء المجددين عبر القرون منذ القرن الأول، يتمني أن يكون هو المجدد الموعود، فيقول:
وهذه تاسعة المئين قد
أتت ولا يخلف ما الهادي وعد
وقد رجوت أنني المجدد
فيها ففضل الله ليس يجحد(57)
والصعيدي كما يتضح من أعماله تلميذ أصيل في مدرسة محمد عبده، سار علي نهجه في تجديد الفكر الإسلامي الحديث، وفى مواجهة تحديات الواقع العملي، غير عابئ بالصعوبات ولا التهم التي توجه إليه من قبل خصومه الذين أنكروا عليه حقه في الاجتهاد، وكان من نتيجة تلك المواجهة مصادرة كتبه ومنعها من التداول، ظنًّا أن في ذلك تعتيم علي فكره وجهوده.
وهذا ما قرره أحد أساتذة الأزهر الكبار الذي كتب تقرير إجازة نشر كتاب الصعيدي (الحرية الدينية في الإسلام) يقول محمد رجب البيومي:
(فرق كبير بين كتاب يؤلفه غير متخصص، وغير خبير بمسائل الفقه والأصول والعقيدة، وكتاب يؤلفه عالم كبير قضي عمره الطويل في رحاب الأزهر طالبًا نابهًا، كان الأول علي فرقته في امتحان العالمية ومدرسًا بالمعاهد والكليات، وكاتبًا في المجلات الإسلامية وأرقاها مجلة الأزهر الشريف.! فهذا الأستاذ إذا جاء برأي جديد، ذكر أدلته ومنازعه الأصولية، فلنا حينئذ أن نستمع إليه، وأن نعارض ما يتجه إليه إذا اتضحت أسباب المعارضة! دون مصادرة ما)(58).
ومدرسة محمد عبده الذي كان الصعيدي أحد رجالها المميزين سعت إلي التوفيق بين أصول الإسلام وبين الواقع، وبالتالي أفسحت الباب أمام العقل لكي يتعامل بحرية مع النص الديني، وتجاوزت أفق الفكر الضيق المحدود الذي سيطر علي الفكر الإسلامي منذ القرن العاشر الهجري حيث سيطرت الشروح والمتون والحواشي، وخف صوت الإبداع والإضافة الحقيقية والتجديد الصحيح وسادت مقولة: إغلاق باب الاجتهاد.
وهي مدرسة مستقلة بالفكر والنظر، ثم بالعمل في مجال الإصلاح، وهذا ما يميزها بمذهب بين مدارس الفلسفة الإسلامية، فلا يتيسر ضمها إلي طائفة منها تسمي باسمها، وبذلك تنفصل هذه المدرسة عن سائر المدارس في تراثنا(59).
جملة القول إنها مدرسة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معني، وذلك حيث حرص رواد هذه المدرسة علي احترام حقوق الإنسان باعتباره خليفة في الأرض، فأعلوا من شأن العقل وجعلوا أحكامه مقدمة علي النص الديني في حالة التعارض، وسعوا إلي تقديم رؤية إنسانية حضارية للإسلام لا تتناقض مع العقلانية والحرية حتى اتهم بأنه (قد تحيف من حق النصوص وبالغ في تقدير قيمة العقل)(60).
ويتناول الصعيدي قضيتي حرية الفكر والحرية الدينية في الإسلام، وكل منهما عنوان كتاب من كتبه. وسوف نعرض لهاتين القضيتين كل علي حدة، ونبدأ الحديث عن حرية الفكر في الإسلام.
1- حرية الفكر :
يبدأ الصعيدي حديثه بالتفريق بين حرية الفكر والحرية الدينية، وذلك أن حرية الفكر أوسع من الحرية الدينية لان حرية الفكر تشمل ثلاثة أنواع من الحريات على النحو التالي:
– الحرية العلمية.
– الحرية السياسية.
– الحرية الدينية.
وكل نوع من هذه الحريات له مجاله الخاص الذي يشاركه فيها نوع آخر، ويعرف كل نوع منها علي النحو التالي:
الحرية العلمية: عبارة عن إطلاق سلطان العلم فوق كل سلطان، لأنه يعتمد في سلطانه علي العقل، وقد خلق الله العقل ليميزنا به علي جميع مخلوقاته، فإذا أهملنا الاعتماد عليه لم يكن هناك معني لخلقه فينا. وفعل الله سبحانه يتنـزه عن العبث، فكل ما خلقه له حكمته التي لابد من استعماله فيها، تحقيقًا لمعني هذه الحكمة، وتنـزيهًا لفعله تعالى عن العبث.
وبناء عليه، فانه لابد من المواءمة بين العلم والدين، ليعيش كل منهما بجانب الأخر مطلق الحرية موفور السلطان، ويتعاونا علي سعادة الإنسان في دنياه وأخراه بدلا من أن يتعارضا، فيقف كل منهما في سبيل الآخر. فيشقي الإنسان باختلافهما وتضطرب حياته بينهما.
وهي قضية قديمة في التراث الإسلامي ناقشها الفلاسفة والمتكلمون فكتب ابن رشد رسالته المشهورة (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) وكتب ابن تيمية موسوعته الضخمة (درء تعارض العقل والنقل).
الحرية السياسية: هي عبارة عن احترام رأي الفرد في التعبير عن ذاته، بحيث لا تضيع شخصيته في شخصية الحاكم، بل يكون لرأيه سلطان فيما يراه ولو تعلق بشخص الحاكم نفسه، فيكون له الحق في معارضة اختياره ابتداء في إسناد الحكم إليه، وفى نقد أعماله بالوسائل النـزيهة في النقد.
ويجب أن يبرز سلطان الدين أيضًا، فيقف بجانب الفرد في هذا الحق، حتى لا يكون للحاكم عنده سلطان فوق كل سلطان، بل يكون شأنه في ذلك شأن كل فرد، حتى لا يستبد وحده بالسلطان، وحتى لا يسير في الحكم بالظلم والطغيان.
الحرية الدينية: هي عبارة عن حق الإنسان في اختيار عقيدته الدينية, فلا سلطان لأحد من الناس عليه فيما يعتقده, فهو حر في أن يعتقد ما يشاء أو لا يعتقد في شيء أصلاً, كما أن له الحرية في إذا اعتقد في شيء أن يرجع عن اعتقاده, و له أن يدعو من يشاء إلى اعتقاد ما يعتقده في حدود ما تبيحه حرية الاعتقاد من الدعوة إلى ما يعتقده بالتي هي أحسن.
فليس لأحد الحق في استعمال القوة معه في دعوته إلى عقيدته, ولا حق استعمال القوة معه في إرجاعه إلى عقيدته إذا ارتد عنها, وإنما هي الدعوة بالتي هي أحسن في كل الحالات. وإذا لم يكن لأحد حق استعمال القوة معه, فليس له أيضًا حق استعمال القوة مع غيره, حتى يتكافأ الناس في هذا الحق, ولا يمتاز فيه واحد بشيء دون الآخر, وإنما هي حرية مطلقة لكل الأشخاص, وحرية مطلقة لكل الأديان, وحرية مطلقة في جميع الحالات على السواء(61).
وقريب من هذا الكلام عن الحرية, يأتي تعريف احد أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة للحرية, في قوله: (والحرية هي مادة الحياة التي تصنعها أولاً بطلاقة النظر والشعور الباطن رأيًا يطرأ ظنًّا وميلاً, أو يرسخ فيبلغ اليقين والطمأنينة, وتاليًا بحرية التعبير المنفتح والفعل الظاهر قولاً باللسان و القلم, أو عملا بحركة أو سكون)(62).
والحرية الفكرية في مأمن من العقاب الدنيوي, مالم يصل إلى شيء من التعسف والإعنات, وذلك أن الجزاء الدنيوي الطبيعي الذي سنته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية شرعت العقاب الدنيوي لردع الجرائم التي تفسد المجتمع كالقتل والسرقة لتطهير المجتمع منها, وتقليل الشرور بفرض عقوبات دنيوية رادعة.
ومن ثم فالحرية الفكرية بكافة أنواعها في مأمن من العقاب الدنيوي, لأنة يجب فتحه على مصرعيه، أمام رواد الخير ليصلوا بأفكارهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة, فلا خوف منه على المجتمع, لأنهم إذا أصابوا فبفضل الله, وإذا وقعوا في خطأ كانوا معذورين فيه, فلا يصح عقابهم بشيء.
فلا يجوز لحاكم أن يتعسف بالتضييق على الناس في باب الحرية الفكرية, لان الدين برئ من هذا التعسف, الذي يضعه الحكام في شكل قوانين لحماية استبدادهم وطغيانهم, ويمنعوا الناس من نقد الظلم و الاستبداد.
لأن الدين رحمة من الله بعباده ولا يتصور فيه مشقة ولا صعوبة, ولا يمكن أن يكون مصدر خوف علي حرية الفكر, لان حرية الفكر لا تمثل تهديدًا ولا يوجد فيها شيء يؤخذ عليها, كما أنها لا تحمى استبدادًا ولا تنصر ظالـمًا أو طاغية. فالحاكم حسب الدين مجرد فرد من الناس, يصيب و يخطئ و لكل فرد من الناس حق إرشاده وتقويمه, ولا حرج عليه إذا قام بهذا الحق, ولا عقاب عليه فيه من حاكم أو غيره.
ولا يؤثر الجزاء الأخروي في الحرية الفكرية, لأن حرية الفكر في حقيقة الأمر مرتبطة بالجزاء الدنيوي, حيث أن الجزاء الأخروي ليس إلا مجرد ترغيب في الثوابت, و تحذير من العقاب, فلا إلزام فيه, ولا إكراه بعقاب دنيوي. وعلاوة على هذا, فإن الإسلام لا يغلق باب الاجتهاد على الناس, و المجتهد لا إثم عليه, حتى وإن اخطأ طريق الصواب, فللمجتهد أجران إذا أصاب, واجر واحد إذا اخطأ، فلا يعاقب على خطأه بل يعذر فيه.
لكن المشكلة أن المجتهد إذا وصل خطؤه لحد الكفر بإنكار اصل من الأصول الدينية المعلومة بالضرورة كالإيمان بالله من العقائد, أو وجوب الصلاة من الفروع العملية لا يعذر عند الجمهور.
وتبدو سعة أفق الصعيدي وانفتاحه على جميع المذاهب والمدارس الإسلامية, دون موقف مسبق, حينما يستشهد برأي الجاحظ والعنبري من المعتزلة, بأنه لا إثم على المجتهد مطلقًا, وإنما الإثم على المعاند الذي يعرف الحق ولا يؤمن به استكبارًا, فالمجتهد المخطئ غير آثم عند هذا الفريق من المعتزلة حتى لو أداه اجتهاده إلى الكفر الصريح.
وذلك لأن تكليفه بنقيض اجتهاده يعد تكليفًا بما لا يطاق, وهو ممتنع عقلاً وشرعًا, وهو أقرب إلى روح الشرع من موقف الجمهور الذي يرى إمكانية التكليف بما لا يطاق عقلاً وشرعًا, فموقف هذا الفريق من المعتزلة منسجم مع قوله تعالى في سورة البقرة آية 286: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾(63)، فالتكليف بما لا يطاق ممتنع عقلاً وشرعًا بنص الآية.
ومذهب هذا الفريق من المعتزلة ظاهر في نفى الإثم مطلقًا عن المجتهد المخطئ بمقتضى دليلهم السابق, ولكن بعض المتكلفين حاول ربط هذا الرأي وتقييده، بالمسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية, مثل نفى رؤية الباري تعالى, ومثل القول بخلق القرآن, فلا يدخل فيه ما هو من الكفر الصريح, ولكن هذا خلاف مذهب هذا الفريق كما هو ظاهر(64).
وقد استدل الجمهور لمذهبهم بإجماع المسلمين قبل ظهور هذا الفريق من المعتزلة, على وجوب قتل الكفار مطلقا, وعلى أنهم من أهل النار مطلقًا, وهذا دون تفرقة بين المعاند و غير المعاند, ولو كانوا غير آثمين لما جاز قتالهم, ولما كانوا من أهل النار. ودليل الجمهور مبنى على شقين:
الشق الأول: مبنى على مذهبهم في وجوب قتال الكفار على كفرهم, وهذا المذهب باطل لقوله تعالى في سورة البقرة آية 256: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾(65)، وكل آيات القتال في القرآن ظاهر في أن قتالنا للكفار مسبوق بقتالهم لنا, فنحن ندافع عن أنفسنا فنقاتلهم على قتالهم لنا, ولا نقاتلهم على كفرهم.
أما الشق الثاني: من دليل الجمهور فيه مصادرة على المطلوب, لان اصل النزاع بين هذا الجمهور وهذا الفريق من المعتزلة, في كون الكفار غير المعاندين آثمين ومن أهل النار, أو غير آثمين ولا من أهل النار, ودعوى الإجماع في هذا لا قيمة لها, لأنه لا يستند على دليل, و الدليل قائم عند هذا الفريق من المعتزلة, على أن الكفار غير المعاندين غير آثمين, وهذا علاوة على إنكار بعضهم للاحتجاج به(66).
وقد نقل شلتوت موقف هذا الفريق من المعتزلة في هذا الصدد في كتابه الإسلام عقيدة و شريعة, ويأخذ على شلتوت تأثره بموقفهم مع إغفال ذكرهم. و يبدو أنه يشير إلى موقف شلتوت عند حديثه عن عقوبة المرتد في قوله: (وقد يتغير وجه النظر في هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد, وأن الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم, وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين, والعدوان عليهم, ومحاولة فتنتهم عن دينهم)(67).
وذلك لأن رأيهم مشهور ومعلوم في كتب أصول الفقه يدرسه طلاب الأزهر, وهو رأى مهم لا يلقى العناية الكافية من قبل الجامدين رغم انه يظهر سماحه الإسلام.
ويكتسب رأى هذا الفريق من رجال المعتزلة, انه أصلح الآراء لقضية السلام العالمي, وهى أهم أهداف الشعوب, لأنها تريد أن تتخلص من الحروب التي تهدد وجود البشرية ذاته، ويقضى على ما فيها من خيرات وحضارات .
ويعد مثل هذا الرأي مهمًا في قضية حوار الحضارات والتقريب بين الشعوب على اختلاف أديانها, ويجعل الخلاف في أصول الأديان كالخلاف في فروعها, إذ يعذر فيه من لا يعاند في الفروع, فينجو كل منهم من عذاب الآخرة لعذره في خلافه, وبهذا تتغير نظرة أهل كل دين إلى غيرهم تغيرًا تامًا. وذلك حيث ينظر كل منهم للآخر, كما ينظر أهل كل دين إلى أنفسهم عند اختلافهم في الفروع.
وهذا يدعم نظرية الحوار والتقريب بين الشعوب على اختلاف أديانها, ويذلل اكبر عقبة تعترض السلام بين الشعوب, وتقف حجرة في تناسى أحقادهم, وتبادل الود والمحبة فيما بينهم. وهذا الاجتهاد الديني الأصيل, يعد أساسا إسلاميا لتقارب ديني عام, وسلام عالمي بين الشعوب والأديان(68).
يتناول الصعيدي قضية أساسية من قضايا الفكر الكلامي وهى أن العقل أصل في قضية الإيمان. و هذا ما سنناقشه في الصفحات التالية.
العقل أصل في الإيمان:
يتعرض الصعيدي لقضية شغلت حيزا كبيرًا عند المتكلمين وهى قضية العقل و الإيمان، ويسير على درب رائد التجديد الفكري الإمام محمد عبده، في التأكيد على مكانة العقل في تقرير قضايا الإيمان.
وهذا ما عرف في تراثنا ولدى المعنيين من أسلافنا بأن النظر العقلي هو أول واجب على المكلف؛ لأنه وسيلة الإيمان الصحيح, ولمكانة العقل في الإسلام ذهب بعض أهل السنة إلى (أن الذي يستقصى جهده في الوصول إلى الحق, ثم لم يصل إليه ومات طالبا غير واقف عند الظن فهو ناج)(69)، هذا النظر العقلي واجب شرعًا وعقلاً عند أسلافنا, فالأشاعرة ذهبوا إلى أن وجوبه النقل, وذهب المعتزلة إلى أن وجوبه العقل(70).
وقد عبر القدماء عن هذا النظر العقلي الواجب الإلتفات إليه بدليل النفس و الآفاق(71).
وهذا ما نجده في حديث الصعيدي حول هذا الموضوع فيقول:
(إن الإسلام يعتمد في دعوته على تفكر العقل, لان في الكون نظاما عجيبا يدل على وجود خالق له, فيكون الإيمان به عن اقتناع بوجود هذا النظام العجيب في الكون, وعن اقتناع بوجوب إسناده إلى خالق عالم مريد قادر على خلقه, وإذا كان هذا هو الأصل في الدعوة الإسلامية, فإنه لابد أن يعطى العقل حرية كاملة في هذا التفكر, ليصل فيه إلى ما يصل في حرية واختيار, ولا يصح أن نقيده بطريق معين من تفكيره وبنتيجة معينه يصل إليها منه, لأنا إذا قيدناه بهذا كان مجبورًا عليه, ولم يكن له حرية واختيار فيه)(72).
من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإسلام بصفته خاتم الأديان, يقوم في حجيته على الناس على النظر العقلي والتفكر, وليس على المعجزة الحسية التي أتى بها الأنبياء السابقون, و لكن جعل الإيمان قائمًا على العقل والنظر والتدبر والتفكر, حتى وإن أدى هذا الفكر إلى الكفر والضلال, لأن طريق الإيمان لا يتحقق إلا بهذا المقصد, وهو التفكر الذي لا يتحقق الإيمان بدونه. حتى وإن نتج عن هذا الطريق ضلال للبعض في طريقه للوصول إلى الحقيقة، فلأن الضلال راجع لخلل ما, وليس لطبيعة التفكر أو العقل.
وهذا الطريق هو ما سلكه أبو الأنبياء إبراهيم u في طريق الإيمان كما حدثنا القرآن الكريم كما في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (78)﴾(73).
هذا الكلام نجده عند الإمام محمد عبده الذي أعلى من شأن العقل وعَوّل عليه في كل ما كتب, وذلك لإيمانه أن الإسلام هو دين العقل, وإنه بهذا يتميز عن غيره من الكتب السماوية السابقة, ففي تعريفه للتوحيد في بداية رسالته المسماة بهذا الاسم يعرف معناه، و الأسماء التي عرف بها ومنها علم الكلام, الذي مبناه هو الدليل العقلي الذي به تقرر الأصول الأولى, وبعد ذلك يرجع إلى النقل في قضايا فرعية. فالعقل في هذا العلم – التوحيد – هو الأصل للنقل.
فالقرآن حدثنا عن نبوة النبـي, وتناول مقام الألوهية بما أذن الله لنا وما أوجب علينا ان نعلم, ورغم هذا لم يطالبنا بالتسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته, لكنه (ادعى وبرهن, وحكى مذاهب المخالفين وكر عليها بالحجة, وخاطب العقل, واستنهض الفكر, وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام و الإتقان على أنظار العقول, و طالبها بالإمعان فيها, لتصل بذلك إلى اليقين لصحة ما ادعاه ودعا إليه)(74).
و الحقيقة أن هذه القضية خلافية, ولا يمكن أن يكون هذا هو الطريق الوحيد لمعرفة الله والإيمان به, وذلك لأن من جعل طريق الإيمان قاصر على العقل فقط ضيق رحمة الله الواسعة, وحكم على السواد الأعظم من جمهور المؤمنين ممن يقوم إيمانهم على التسليم والتقليد من غير نظر عقلي بالخلل وعدم التيقن، كما أنه يلغى طرق أخرى كالتجربة الروحية ودورها وطريق الإيمان القلبي كما حدثنا أبو حامد الغزالي في المنقذ من الضلال عن النور الذي يقذفه الله في القلب.
ويشير الصعيدي إلى أن هناك من يسلك طرقا أخري في الوصول, كالصوفية التي تسلك طريق العبادة والرياضات الروحية, وهى طرق خاصة بهم , ولا يصح أن يعول عليها مثل طريق التفكير الممهد للناس كلهم(75).
وكلام الصعيدي السابق لا يخلو من تناقض فعلى حين يهتم برأي شاذ لاثنين من المعتزلة حول حرية المجتهد في أنه لا إثم عليه مطلقًا فيما أخطأ فيه, بينما يحاول أن يقلل من شأن طريق الصوفية في الوصول للإيمان .
ويتعرض الصعيدي لقضية وثيقة الصلة بالعقل وهى مكانة العلم في الإسلام, وهذا هو موضوع الصفحات التالية.
الإسلام والعلم :
من الطبيعي أن يدعو الإسلام، الذي تقوم دعوته فى الأساس على التفكر والنظر العقلي، إلى العلم, وذلك لأن التفكر نتيجة طبيعية للعلم و المعرفة. والغرض الذي من اجله يدعو الإسلام إلى العلم هو نفس الغرض الذي يدعو للتفكر, كما أن الغاية واحدة من الاثنين, فالعلم يطلب لأنه يوصل إلى الإيمان بالله تعالى, والعلماء هم الذين يصلون به للإيمان وليس الجهلاء .
وبناء عليه فالعلم كالتفكر مطلوب لذاته, سواء أوصل الإنسان إلى الإيمان بالله أم لا, و الإيمان عن طريقه يتم بحرية واختيار, وهما شرط فى صحة الإيمان. والحرية والاختيار لا يتحققا إلا إذا أخذ العلم طريقًا مطلقًا, وسار فيه الإنسان على هدى العلم ومنهجه فقط, فإذا وصل الإنسان من خلاله إلى الإيمان بالله فبتوفيق الله, وإذا لم يصل فيه إلى شيء فإنه أدى المطلوب منه, ولا يصح إكراهه على شيء لأن الإكراه عكس الحرية والاختيار كشروط أساسية فى العلم.
والإسلام لا يقيد العلم بطريق معين ولا نتيجة معينة, لأن طلب العلم هدف فى حد ذاته سواء وصل إلى الإيمان أم لا. كما أن الإسلام لم يقيد العلم بأنه ديني أم لا, ولكن جعله مطلقًا دينيًّا أو دنيويًّا, لأن كل منهما يكمل الآخر حسب الرؤية الإسلامية, رغم أن أنصار العلم الدنيوي لا يرون التكامل بين العلم الدينى والدنيوي, ولا يعترفون إلا بالدنيوي فقط.
ورغم هذا فالإسلام لا يقيدهم برؤيته, لأن العلوم الدنيوية لا سلطان للإسلام فيها, وإنما السلطان للعقل فقط, حتى لا يكون هناك وسيلة لرجال الدين للوقوف فى سبيلها باسم الإسلام, فيعوقها عن التقدم والنهوض, أو يفرض نفسه على رجالها بغير حق, لأنه لا شأن له بهم, فله مجاله ولهم مجالهم. ويستدل على ذلك بقصة تأبير النخل لما نهى عنه الرسول ثم عاد ووافق عليه بقوله: أنتم أعلم بشئون دنياكم .
عن عائشة : (أنً الًنبىً r سَمِعَ أصْوَاتًا فَقَالَ مَا هَذْا الًصوْتُ قَالَوا الًنْخُل يُؤَبُرُونَهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلحَ فٌلْم يُؤَبًرُوا عَامَئِذٍ فصَارَ شيِصًا فَذَكَرُوا لِلًنبىً r فَقَالَ إنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَاْنُكُمْ بهِ وَإنْ كَانَ مَنْ اُمُورِ دِيِنِكُمْ فَإلىً)(76).
ويضرب مثل آخر بالحارث بن كلدة الذى تعلم الطب فى بلاد فارس, وعاد إلى الطائف واشتغل بالطب, وكان النبي يأمر أصحابه إذا مرضوا بالذهاب إليه, وفيه اعتراف بقيمة العلم(77).
ويستلزم من هذا أن تكون دعوة الإسلام إلى العلم و التفكر والحرية العلمية مطلقة بلا قيود, حتى لا يكون هناك سلطان لغير العقل والعلم, و لا يخشى بأس حاكم أو رجل دين لأنه مجتهد مطلق السراح حتى ينهض بأمته في أى فروع العلم شاء دينيًّا كان أو دنيويًّا، ويكون قادرًا على الإبداع والتجديد.
ومن هنا فلا يصح (أن يخشى الإسلام التفكر وهو يدعو إليه, ولا أن يخشى العلم وهو يدعو إليه أيضًا, إذ ليس فيه شيء يناقض العقل حتى يخشى التفكر, ولا شيء يناقض العلم حتى يخشى العلم, وإنما هو دين العلم والعقل, فليكن للعقل فيه سلطانه المطلق, وليكن للعلم فيه سلطانه المطلق أيضا, وليعلن خضوعه لسلطانهما من غير خوف منهما, ليتفق الثلاثة على إسعاد المجتمع الانسانى فى دنياه و أخراه, ولا يناوئ واحد منهما الآخر فى ذلك, لأن هذا مما لا يصح المناوأة فيه, ومتى اتفقت غاية الثلاثة فيه أمكن الجمع بينهما في كل ما يشبه فيه الأمر بينها, أو يكون فى ظاهره خلاف يوهم تنافيها, ما أسهل الجمع في ذلك عند خلوص النية, وعند المرونة الدينية والعلمية)(78).
سلطان العقل على النقل :
وعلى نهج علماء الكلام فى تقديم العقل على النقل عند التعارض وخصوصا المعتزلة ومن تابعهم على ذلك كمحمد عبده(79) الذي يسير الصعيدي على دربه, يؤكد أن الإسلام فتح باب الاجتهاد في الدين, فأعطى للعقل سلطانه على دليل النقل, يستنبط منه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة, ويدخل فيه ما شاء من التأويل, ويخصص منه ما شاء أو يعمم, وكذلك من التقييد والإطلاق, وغيرها من ضروب الاجتهاد, حتى يهيئه للحكم الذي يؤدى إلى ما اتفقا فيه من الغاية, وهو سعادة الناس فى دنياهم وأخراهم, حتى لا يكون على الناس حرج فى الدين, لأن الدين يسر, وليس بعسر, ولا تسهيل فيه ولا إعنات, وتسهيل وليس بإعنات واسعاد وليس بشقاء(80).
والحقيقة أن هذه القضية تعد من قبيل القضايا الهامة التي تناولها علم الكلام وأفاضوا فيها سواء عند حديثهم عن العقل وأصل التكليف, أو عند حديثهم عن التأويل, وهى قضايا ركز عليها الإمام محمد عبده فى رسالة التوحيد وأولاها عناية خاصة, والصعيدى كتلميذ أصيل ومجتهد فى مدرسة محمد عبده الفكرية يسير على نفس النهج من الاهتمام بالعقل وإبراز دوره كملكة إلهية ميز بها الإنسان عن سائر الكائنات وجعله مناط التكليف وأصل الإيمان.
ويتناول موقف الفرق فى قضية التأويل وموقفها من الآيات الموهمة للتشبيه، كقوله تعالى : فى سورة طه آية (5): ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، وقوله عز وجل فى سورة الفتح آية (10): ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾، وقوله جل شأنه فى سورة ق آية (16): ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾. فالمجسمة اعتقدوا فى ذاته تعالي أنها جسم يجلس علي العرش مثل جلوسنا، وله يد مثل أيدينا، وقربه منا قرب مكاني كقرب جسم من جسم آخر قريب منه.
وفريق آخر من السلف كالإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل ومن سار علي نهجهم، وتورع عن التشبيه كالمجسمة لكنهم توقفوا عند ظواهر النصوص، فأنكروا تأويلها كما فعل الإمام مالك فى موقفه المشهور حينما سئل عن الاستواء علي العرش فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله تعالي، وهو علي نحو لا يؤدي إلى التجسيم، ويقول هذا الفريق من قدماء أهل السنة والجماعة عن الآية الثانية عن اليد: له يد لا كالأيدي. وفى الثالثة كما قال في آية الاستواء.
أما المعتزلة فكانوا واضحين في منهجهم المخالف لغيرهم من الفرق كالمجسمة وأهل السنة، فذهبوا إلي تأويل الآيات وصرفوها عن ظواهرها، فجمعوا بذلك بين الدليلين العقلي والنقلي معًا، فأولوا معني استوى باستولى، وأولوا اليد بالقدرة، وقالوا أن القرب المقصود في الآية قرب علمي لا مكاني.
فالزمخشري من المعتزلة يفسر استوى علي العرش بمعني ملك العرش وليس بالضرورة الجلوس عليه كالقول فلان يده مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعني الجود والبخل، وقوله يد الله فوق أيديهم أي العقد والميثاق(81).
وظل النـزاع قائمًا من أهل السنة والمعتزلة إلى أن جاء الأشعري بخلفيته الاعتزالية فجمع بين الفريقين فلم يتحرج من التأويل كأهل السنة القدماء، ولم يسرف كإسراف المعتزلة في التأويل، فيذهب إلى التأويل إذا لم يكن منه بد، وذلك عند قيام الدليل العقلي القاطع علي عدم إرادة ظاهر النص، وإذا لم يوجد الدليل العقلي القاطع لم يذهب إلى التأويل، ويبقي علي ظاهر النص، لأنه الأولى في هذه الحالة، وذلك أن الظن العقلي لا يغني من العلم شيئًا.
جملة القول: (أن إخضاع دليل النقل لدليل العقل، فيه من الحرية العلمية كل ما تسعه هذه الكلمة من معني، وما يعطي العلماء سلطة واسعة أمام الجامدين من رجال الدين، فلا يكون لأولئك الجامدين سلطان عليهم أصلا، ولا يكون لهم أن يسلكوا سبيل التعسف معهم، وإنما هو قرع الدليل بالدليل، وما اضعف دليل الجمود أمام دليل التجديد)(82).
وأمام هذه الحرية العلمية لا يمكن الخوف علي الدين الحنيف التي أطلق لها العنان. كما لا يخشى علي الدين من تغير المسائل العلمية، فالربط بينهما لا ينزع قداسة الدين – كما يتوهم بعض المجددين – لآن الربط بين المسائل الدينية والمسائل العلمية، لا يكون إلا في المسائل العلمية قطعية الثبوت واليقين، والتي لا تتغير بتغير الزمن، بخلاف المسائل العلمية المبنية علي الظن.
ولا يوافق الصعيدي علي رأي متأخري الأشاعرة الذي يصفهم بالجامدين(83) في قولهم: إن التأويل إذا كان أعلم فان تركه أسلم؛ لأن التأويل إذا كان أعلم فهو أسلم؛ لأن السلامة مع العلم دائمًا.
وقد تناول الصعيدي قضية الحرية السياسية، كركن أصيل من أركان الحرية الفكرية، وحاول الربط بين الإسلام وقضايا الفكر السياسي والقانوني المعاصر، مثل أن الأمة مصدر السلطات، وحق الفرد في الاعتراض علي الحكم، وحق الأقلية في المعارضة، برؤية عميقة وتوفيق غير مخل بين هذه الأفكار الحديثة والإسلام، بما ينبئ عن عمق ثقافته الإسلامية ووضوحها. وعن استيعابه للتحديات المعاصرة التي تحتاج إلي مزيد من الاجتهاد والمثابرة.
وهذا ما مكنه من عرض أفكاره بيسر وسلاسة تخلو من التعقيد، كما تخلو من الإسراف وهو ما يقع فيه الكثيرين ممن يسيرون علي درب الصعيدي، وينسجون علي نفس المنوال، سواء من السابقين عليه أو اللاحقين به، ممن لم يتيسر لهم ثقافته الإسلامية العميقة ورؤيته الثاقبة ومنهجه الواضح في تناول القضايا ومعالجتها بصدق وإخلاص بعيدا عن التحزب والدعائية، أو الارتباط الأيديولوجي بفكر ما أو مذهب معين، كما يفعل الكثيرون من أدعياء التجديد في عصرنا الراهن. وسوف نتناول حديثه عن الحرية السياسية في الصفحات التالية .
2- الحرية السياسية في الإسلام :
لقد شغلت قضية الحرية السياسية في الإسلام المجددين منذ مطلع العصر الحديث، فشخصوا الاستبداد كمرض خطير يحول بين الأمة وبين حقوقها، وقد تأثر هؤلاء المجددون بالحرية السياسية في الغرب، وهو ما نلمسه عند الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده وغيرهم من المجددين .
كما أن كتاب (طبائع الاستبداد) للكواكبي كان رد فعل للحرية السياسية في الغرب باعتبارها احد أهم أسس التقدم في المجتمع الغربي، علي حين وقف الاستبداد عائقا مهماً في سبيل نهضة الشرق.
وقد ذهب العقاد إلى أن فكرة الديمقراطية بمضمونها الحقيقي التي أنشأها الإسلام لأول مرة، علي غير مثال سابق هي الديمقراطية الإنسانية، وهي الديمقراطية التي يكسبها الإنسان؛ لأنها حق له يخوله أن يختار حكومته، وليست حيلة من حيل الحكم لاتقاء شر أو حسم فتنة، ولا هي إجراء من إجراءات التدبير تعمد إليها الحكومات لتيسير الطاعة والانتفاع بخدمات العاملين وأصحاب الأجور كما هو الشأن في الديمقراطيات الأخرى. وتقوم الديمقراطية الإسلامية بهذه الصفة، علي أربعة أسس لا تقوم ديمقراطية كائنة ما كانت علي غيرها، وهي:
– المسئولية الفردية.
– عموم الحقوق وتساويها بين الناس.
– وجوب الشورى علي ولاة الأمر.
– التضامن بين الرعية علي اختلاف الطوائف والطبقات.
هذه الأسس ظاهرة في القرآن الكريم وسنة رسوله r، وفى التقاليد المأثورة عن الخلفاء الراشدين(84).
وفى ضوء هذا التراث الفكري لعملية التجديد عند هؤلاء المفكرين المعاصرين جاء فكر الصعيدي امتدادا لهذه الجهود ويبدأ حديثه عن قضية الأمة وهل هي مصدر السلطات؟ وهل الإسلام يؤيد ذلك، وما هو نصيب كل فرد من الأمة في الحرية السياسية؟ ويستعرض وجهة نظره في هذا الصدد، وهذا هو موضوعنا التالي.
الأمة مصدر السلطات :
لقد بدأ الشيخ الصعيدي حديثه عن الحرية السياسية بسؤال علي النحو التالي: هل الأمة مصدر السلطات في الإسلام؟ ويؤكد أن الجواب علي هذا السؤال يتوقف عليه نصيب الأمة ونصيب كل فرد من أفرادها في الحرية السياسية.
ويرد بثقة وثبات بأن الأمة هي مصدر السلطات في الإسلام، ولها حق الاشتراك في تنصيب الحاكم الذي تريده، كما لها اختيار شكل الحكم الذي تريده جمهوريا كان أو ملكيا، وحق الأمة في هذا الحق لجميع أفرادها.
ويترتب علي هذا أنه إذا كانت الأمة هي مصدر السلطات كان حاكمها تحت سلطانها، ولم تكن هي تحت سلطانه، وتكون لها حريتها السياسية بأكمل معانيها، لآن هذا الحق في هذه الحرية كفله لها الإسلام. ولم تأخذه منحة من الحاكم لأنه لو منحة من الحاكم لم يكن حقاً صحيحاً حيث من حقه استرداد هذه الحرية إذا كان له حق منحها.
من أجل هذا أراد الإسلام أن يجعل حق الأمة في حريتها السياسية حقاً طبيعيًّاً لا تستمده من حاكم إنما تستمده من كونها مصدر السلطات في الحكم وبهذا يصبح الحاكم تحت سلطتها وليس العكس. وعلى هذا الأساس قام الحكم الإسلامي في عهد النبي r وفى عهد الخلفاء الراشدين من بعده.
وتمثل تلك الفترة الحكم الصحيح في القرون القديمة للإسلام قبل استيلاء بنى أمية على الحكم ومن تلاهم من بنى العباس وغيرهم فإنها لم تكن حكماً إسلامياً صحيحاً ولم تكن الأمة فيها مصدر السلطات، وإنما كان الحاكم المستبد هو كل شىء فى الدولة وبيده وحده سلطاته كلها، ولم يكن للأمة معه حق في حريتها السياسية(85).
وهذا ما عبر عنه أحد المفكرين المعاصرين بأن أصول السلطة المباشرة للشعب استفتاء وقرار وإجماع مباشر، أو ما هو أيسر وأكثر وقوعاً، بأن يوكل الشعب سلطته لنواب ينتخبهم يكونون هيئة تشريعية تضع الأحكام العامة قانونا والسياسات توجيها وتراقب من ينفذها(86).
وربما نلمس شيئاً قريبا من هذا عبر عنه العقاد فى حديثه عن مبدأ السيادة بقوله: (والذي يبدو لنا أن أقرب الأقوال إلى سند السيادة في الإسلام هو الرأي القائل بأنها عقد بين الله والخلق من جهة، وعقد بين الراعي والرعية من جهة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)(87).
ومما يؤكد أن الأمة مصدر السلطات فى الإسلام القاعدة المجمع عليها عند أهل السنة على أنه يجب خلع الإمام متى جرحت عدالته بفسق، أو عجزه بعلة ولا يرجى صلاحها، لأنه يستحيل استمرار مقاصد الإمامة(88).
ويستشهد على كون الأمة مصدر السلطات، فى فترة الحكم الرشيد التى شملت عهد النبوة والخلفاء الراشدين من بعده، بمشاورة الرسول r لأصحابه فى الغزوات وفى كافة شئون الحياة السياسية، واستمر الأمر على ذلك المنوال فى عهد الخلفاء الراشدين، فقام نظام الحكم على المشورة حتى عهد على -t- وخروج معاوية ومن معه من أهل الشام عليه، فيما لا يطعن فى إمامته لأنه كانوا قلة وكان مؤيداً بموافقة الأغلبية عليه.
وجاء مقتل على -t-بيد أحد الخوارج وهو يصلى الفجر، فأخلى (أولئك الخوارج الجو لمعاوية بجهلهم حتى أخذ الحكم بالسيف، بعد أن كان يؤخذ باختيار الأمة، ويقوم على أساس أنها مصدر السلطات كلها، وقد سن هذه السنة لمن أتى بعده من ملوك المسلمين، وكان عليه تبعتها بسنه لها فيهم)(89).
ويترتب على هذا الحق باعتبار أن الأمة مصدر السلطات، حق الفرد في الاعتراض على الحاكم، وهذا ما سنناقشه في الصفحات التالية.
حق الفرد فى الاعتراض على الحاكم :
يترتب على أن الأمة هى مصدر السلطات، أن كل فرد من أفرادها له الحق فى هذه السلطة، فيؤخذ رأيه فى تنصيب الحاكم، ويكون له حق الإعتراض على ما يرى الاعتراض عليه من نظام الحكم بحرية تامة، سواء كان مصيباً فى اعتراضه أو مخطئاً، لأنه غير معصوم من الخطأ، فإن أصاب فهو مأجور، وإن أخطأ فهو معذور، استناد إلى حديث الرسول :r (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(90).
وذلك على اعتبار أن (الدستور عقد اجتماعي أعم وأخطر وأقوى وأثبت من سائر العقود، يدوم بجملة نصوصه. وإنما العقد الدائم فى الحياة هو الأساس الأول لها تتفرع منه وتتأسس عليه وتستند على تعاليمه وترجع إليه حكماً، هو عقد الإيمان عقيدة التوحيد بين الإنسان المؤمن وربه الأعلى ينظم كل الحياة عبادة، وكل مصيرها خيراً مرضياً)(91).
وكان حق الفرد فى الإعتراض على الحاكم قائماً حتى فى عهد النبوة، رغم اتصاله بالوحي السماوي، وكون أغلب الأحكام منتقاة عنها، لدرجة أن الاعتراض على النبى r فى بعض أحكامه كان يتجاوز أحياناً حق الإعتراض المقبول، ويجاوزه إلى الاتهام والطعن فى الذمة، فلا يكون رد فعل النبى r إلا إظهار ألمه من هذا الطعن فى ذمته، ولا يتجاوز إلى أخذ الطاعن بعقوبة دنيوية ترهب غيره أن يقع فى مثله، وذلك لأن أخذ الناس بالإرهاب يزرع فى نفوسهم الجبن، ولا يجرئهم على نقد الحكام، ومن ثم يستنيمون لظلم حاكمهم، فيحصل ما يحصل من الفساد فى الحكم.
ومن النماذج العملية على هذا الحق فى عهد النبى r إعتراض بعض الصحابة على توزيعه كما حدث فى أديم مقروظ لم تحصل من ترابها، فقسمها النبى r بين أربعة نفر: بين عيينا بن بدر، وأقرع بن حارس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة، وإما عامر بن الطفيل، وقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق من هذا من هؤلاء.
فلما سمع النبى r ذلك قال: ألا تؤمنوننى وأنا أمين من فى السماء، يأتنى خبر السماء صباحاً ومساءاً. فقام رجلا غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشذ الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال يا رسول الله: أتقى الله، فقال له r ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال له: لا، لعله أن يكون يصلى. فقال خالد: وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس فى قلبه. فقال له: إنى لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم.
فهذا رجل قد تجاوز حقه السياسى فى الإعتراض المقبول، إلى إتهام النبى r بالخيانة، ومحاباة أولئك الأربعة من صناديد العرب، وكانوا حديثوا عهد بالإسلام، وكان عطائه لهم تأليفاً لقلوبهم، وتقوية لإيمانهم، لما كان لهم من طمع قديم فى المال، وهذا من حسن السياسة فى الدنيا، ليكون شوكة للإسلام لا شوك عليه.
وقد جاز الإعتراض على النبى r كحاكم من قبل الإفراد رغم إتصال الوحى به لأن النبى كان مجتهداً فى بعض الأمور الذى لم ينـزل عليه فيها وحى، وهذا الحق بالإجتهاد يشمل أمور دينية ودنيوية معاً، وأنه r – وهو المعصوم – يجوز عليه الخطأ فيما يجتهد فيه، ولو كان أمور الدين.
فإذا كان خطؤه فى الاجتهاد فى بعض أمور الدين، وجب التنبيه عليه. وأما إذا كان خطؤه فى الإجتهاد فى بعض أمور الدنيا لم يجب التنبيه إلى الخطأ، لأنه يمكن العلم به من غير طريق الوحى. فيجوز من الأفراد الاعتراض على بعض أحكامه، اعتماداً على أنه يجوز أن يكون من اجتهاده لا من طريق الوحى، وعلى أنه يجوز أن يكون أخطأ فيه، فيكون لهم حق تنبيههه إليه.
ويكون لهم فى هذا الحق من الحرية، ما يكونون فيه قدوة حسنة لمن بعدهم من المسلمين، لتكون أمة حرية لا عبودية، وتسن سنة حسنة فى وجه الطغيان والإستبداد حيثما كان، لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين(92).
وقد أكد أسلافنا على ضرورة حماية الحرية الفقهية، وعدم التدخل فى حرية الاجتهاد فعلى هذا درج السلف الصالح، كما أن اختلافهم فى المباحثة عن أدلة الشرع منة من الله ونعمة(93).
وفى ذلك تنشيط للحياة الثقافية والدينية، وتدريب لملكات العقل على التأمل والاستنباط. كما فيه احترام للعلماء وإغراء لهم على بذل أقصى ما فى وسعهم لممارسة الحرية الدينية، وتطوير الفكر وتجديده.
ويترتب على حق الفرد فى الاعتراض على الحاكم باعتبار أن الأمة هى مصدر السلطات، حق الأقلية فى معارضة الأكثرية، وهذا هو موضوع الصفحات التالية.
حق الأقلية فى معارضة الأكثرية :
للأقلية الحرية التامة فى حق الاعتراض على الأكثرية المناصرة للحكم القائم، وهذا الحق مثل حق الفرد فى الاعتراض على الحاكم سواء بسواء، فالفرد اكتسب هذا الحق باعتباره أن الأمة مصدر السلطات فى الإسلام، فله نصيب من ذلك مما لها فى ذلك لأنه فرد منها، وكذلك الأقلية أفراد من الأمة فيجب أن يكون لهم نصيب فى ذلك أيضاً.
وقد وجدت هذه الأقلية الممثلة للمعارضة فى الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول، فجماعة عبد الله بن أبى بن سلول من الأوس والخزرج، الذين كانوا مخلصين له وتظاهروا بالدخول فى الإسلام على أن يمثلوا دور المعارضة،كلما سنحت الفرصة لذلك، لعلهم يستطيعون التأثير فى الأغلبية فيرجعون لوضعهم القديم.
وعرفت تلك المجموعة بالمنافقين، حيث كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وكانت تبدو منهم معارضة سافرة للحكم، وحينما تفشل نتيجة كياسة النبى وإخلاص أصحابه يتبرأ هؤلاء المنافقون من أفعالهم، فيقبل النبى منهم ذلك، ولا يؤاخذهم على شىء من معارضتهم، لإيمانه بحق المعارضة فى الحكم، حتى لو لم يكن مخلصاً. لأن ذلك أفضل من أخذ الناس بالكبت والقهر.
وذلك لأن (الحرية السياسية حق من الحقوق التى يجب الإيمان بها، وهى تفيد الحكم ولا تضره. وتربى الناس تربية حرة كريمة، تقطع الطريق أمام من تسول نفسه له أن يسلك سبيل الطغيان فى الحكم. فيستبد بالناس فى حكمه. ولا يجعل لهم حقا فى استعمال الحرية السياسية معه)(94).
وحينما طلب عمر -t- بقتل بن أبى سلول رفض النبى قائلاً: كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟. هذه هى الحرية الحقة أن يغض النبى r كحاكم عن تآمرهم، وأن يبقى على اسم الصحبة لهم ليمضوا فى ظلها أحرارا يعارضون ولا يضيق صدره بمعارضتهم، ولم يقف فى سبيل حريتهم، ويتركهم ينفسون بحرية عما فى صدورهم، لأن الضغط يولد الانفجار، ويزيد فى العداوة والبغضاء. وقد استمر هذا الحال فى عهد الصحابة y.
وفى عهد الراشدين مضى المسلمون فى الفتوحات التى شغلتهم يدا واحدة على عهد أبى بكر وعمر وفى صدر خلافة عثمان، إلى أن ظهر المعارضون له فى الحكم، فلم يضق بمعارضتهم، لأن هذا حق مقرر فى الإسلام، ولهذا ظل يطاولهم وينظر فى شكاويهم ومطالبهم ويحقق فيما يعترضون عليه، وذلك على الرغم من أن معارضتهم كانت خارجة عن الحدود المقبولة، وكانت تأخذ شكل ثورة لا شكل معارضة.
ونفس الموقف تكرر مع على t حينما عارضوه فى قبول التحكيم مع معاوية، رغم أن معارضتهم كانت خارجة عن حدود المقبول كمعارضة إلى حد الثورة المسلحة، فلم ينكر معارضتهم ولا إصرارهم عليها، وقال فى بعض خطبه: إن لكم عندنا ثلاثاُ ما صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا.
ومن ثم (أطلق لهم الحرية فى معارضة حكمه، ولم يمنعهم من الإصرار على معارضتهم فيما أنكروه عليه، لأن هذه المعارضة حق من حقوقهم، ولهم حريتهم أن يعارضوا فى حدود المعارضة المقبولة، فلا تمنعهم من حقوقهم فى الدولة شيئاً، ولا تحرمهم أن يعيشوا فيها إخواناً لمن يعارضونهم من الكثرة المناصرة للحكم، وهذا هو منتهى الحرية فى الدول، وهى حرية لم تكن معروفة فى ذلك الوقت، وإنما كان ملوكه يحكمون فيه على أنهم آلهة أو أشباه آلهة، فلا حق لأحد فى معارضتهم، ولا حرية لرعايتهم لأنهم عبيد لهم)(95).
وللأسف الشديد أن هذه الرؤية لمفهوم الحرية بأبعادها المختلفة فكرية وعلمية ودينية وسياسية ملتبسة على المسلمين اليوم لأن الغالب على فقه المسلمين جواز طغيان السلطان، واعتبار أن كل طعن فيه فتنة، وكل حركة لتنشيط حق الشورى والمعارضة له خروج، لأنه يتصور أن من حقه كحاكم أن يقتحم حرمات الناس وحرياتهم قتلاً ونفياً وسجناً(96).
وذلك راجع لأن الثقافة الإسلامية الراسبة فى حياة المسلمين وفى سلوكهم الآن بحاجة لنهضة جديدة تحيى شعاب الإيمان وتقومها من العلل الموروثة، وتصلح أخلاق الإسلام وتعمرها، وتقيم حكم الإسلام وترشده، وكذلك بحاجه إلى تجديد أصول التدين والفقه والعرف والحكم الإسلامى، حتى يتأسس لهم من جديد نهضة تصون حرمات الإنسان وحرياته واستوائه، طبقاً لقواعد الإسلام وأصوله.
فى ضوء هذه الحرية الفكرية والسياسية ناقش الصعيدى قضية الردة من خلال زاوية الحرية الدينية، وكان لرأيه رد فعل لدى المتخصصين وهذا ما سنناقشه فى الصفحات التالية.
3- قضية الردة :
قضية الردة من القضايا المثارة بقوة فى فكرنا الحديث والمعاصر وتتراوح الآراء فيها بين وجوب قتل المرتد وهو الرأي السائد فى الفقه الإسلامى، وهو ما يؤكده يوسف القرضاوى ويؤكد على أنه رأي أئمة المذاهب الثمانية. وذهب محمد سليم العوا إلى أن عقوبة المرتد هى التعزير وليس الحد (99)، على حين يؤكد جمال البنا على أن آيات القرآن صريحة فى الإشارة إلى عدم وجود عقاب دنيوى للمرتد(100)، هذه مجمل الآراء حول قضية الردة.
وقد تناول الصعيدى موضوع الردة فى كتاب خاص تناول فيه قضية الحرية الدينية، الذى صودر من قبل الأزهر فى أول الأمر ثم عاد مجمع البحوث الإسلامية فأجازه، وقد كتب تقرير الإجازة الدكتور محمد رجب البيومي من أعلام الأزهر المعاصرين الذى أكد على حق الصعيدى فى الاجتهاد، باعتباره أحد المؤهلين له بحكم تعليمه فى الأزهر وتفوقه وخبرته أستاذا وكاتبا، بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الخلاف معه فى الرأى حول ما انتهى إليه اجتهاده(101).
ولا جدال أن رأيه كان يعد اجتهادا متقدماً فى حينه فلم يكن الوقت يسمح بتقبل مثل هذا الرأي المخالف لرأى الجمهور بضرورة معاقبة المرتد، لكن يبدو أن رأى الصعيدى حول هذا الموضوع وجد من يعاضده ويسانده من الفقهاء والمفكرين المعاصرين.
لقد استعرض الآيات الواردة فى مجال الإيمان والحرية الدينية، وذهب مدعما رأيه بالأدلة على أنها غير منسوخة ويستعرض مختلف الآراء فى قضية حكم المرتد ثم يعقب عليها بقوله:
(ولا شك أن القول بأن المرتد يستتاب أبداً ولا يقتل أنسب من غيره بما جاء به الإسلام من الحرية الدينية، وأنسب منه ما ذهبنا إليه من أن المرتد لا يكره على الإسلام بقتل ولا بسجن ولا بنحوهما من وسائل الإكراه، وإنما يدعى إلى العودة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، كما يدعى غيره ممن لم يسبق له إسلام بهذه الوسيلة أيضاً، فإن أجاب فبها، وإلا لم يكن جزاؤه إلا العقاب على ردته فى الآخرة)(102).
ويؤكد على أن القرآن الكريم قد نفى الإكراه على الدين نفيا عاما وصريحاً فى قوله تعالى ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾(103)، وقوله عز وجل: ﴿َقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾(104)، فهذا نفى مطلق للإكراه فى الدين، فيجب أن يدخل فيه من أسلم ثم ارتد، كما يدخل فيه من لم يسلم أصلاً(105).
والحقيقة أن رأى الصعيدى ليس بجديد فهو مسبوق برأى الشيخ شلتوت فى هذا الشأن حيث أكد فى حديثه عن عقوبة المرتد بقوله: (وقد يتغير وجه النظر فى هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم ، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين، والعدوان عليهم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم)(106).
وما زال الجدل محتدما حول هذه القضية حتى وقتنا هذا فحسن الترابى يؤكد على أن (لو اجتهد المرء فارتد – حفظه الله – دفع فى وجهه حد الاستتابة أو القتل (من بدل دينه فاقتلوه ، لا يحل دم امرء مسلم إلا… التارك لدينه المفارق للجماعة) وما هى إلا أحاديث تهدى سنن العمل بياناً للقرآن لا تنسخه، ولكن وردت لتشرح صدور المسلمين، وهم يرون المسلم الحرام دمه إلا قصاصاً، يرتد يفارق الجماعة ويقاتل فى صف الكفر، لكنهم يعزون دمه، فيبين لهم الرسول r كيف يرتد هذا، يفارق إخوانه وينقلب خارجاً مقاتلاً يحل إهدار دمه دفاعاً. والآيات محكمة واضحة لا إكراه فى الدين كما سبق البيان لأصول الحرية)(107).
وبعد تفسيره لآيات القتال فى سورة التوبة على أنها مدافعة يؤكد على أن تلك العقيدة فى حرية وسلام إلا من عدا وقاتل يدفع ويقاتل. أما الرأى السياسى فهو حر بل هو تكليف دينى أمراً بالمعروف ونهيا عن المنكر نصحاً وشورى. و(الحق أن يجاوب ويرد الباطل المرتد والفاسق بكلمة اللسان والقلم، بما يدفعه مثله، إلا إذا عبر عنه صاحبه فعلاً ونفذه غدرة وعدوة ليست بالحق المشروع على سلطة الحكم القائمة على الشورى والعهد فعندئذ ترد بمثلها)(108).
جملة القول أن الشيخ الصعيدى اهتم بقضية الحرية بجميع جوانبها على اعتبار أنها حق إلهى للإنسان لا يحق لأحد أن يصادر حريته فى الفكر والتعبيير، ولا أن يكرهه على اعتقاد أو رأى، ولا أن يصادر حقه فى الاعتراض والنقد.
ويتضح مما سبق أن قضية الحرية احتلت مكاناً بارزاً فى الفكر الإسلامى المعاصر، حيث أيقن المفكرون والعلماء أن قضية الحرية تعد بمختلف جوانبها الاجتماعية والفكرية والدينية والسياسية الأساس الأول لنهضة المسلمين الحقيقية مما لحق بهم من جمود وتخلف، نتيجة لسيادة رؤية أصحاب النقل والاجترار على رؤية أهل الاجتهاد والعودة للأصول الأولى ممثلة فى القرآن الكريم وسنة رسوله r.
وهو ما جاهد فى سبيله رجال من أمثال رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وعبد المتعال الصعيدى وغيرهم من أهل الاجتهاد تحقيقاً للمصلحة العامة للأمة وفقاً للكليات الخمسة فى الشريعة تنزيلا لفقه النوازل على حسب الوقت ومنفعة الجماعة، وما تقتضيه متغيرات الزمن مرونة فى التطبيقات على ضوء الثوابت والقواعد الكلية فى الشريعة.
وفى ضوء هذه الرؤية عرضنا بالتفصيل لقضية الحرية عند اثنين من هؤلاء الأعلام هما رفاعة الطهطاوى كمؤسس لفكرنا الحديث والمعاصر وكيف تعامل بمعيار وقته وعصره مع قضية الحرية، وكيف جاهد من أجل نهضة بلاده فى جميع مجالات الحياة.
ورغم ما يفصلنا عن الطهطـاوى بما يزيد عن قرن ونصف من الزمان إلا أن آراءه ما زالت تحتفظ بقوتها وقيمتها خصوصاً فيما يتصل بقضية الحرية التى ما زالت همًّا يؤرق المخلصين من أبناء الأمة فى كل وقت
وحين، لإدراكهم أنه بدون حرية فلا نهضة ولا تقدم فى أى مجال من مجالات الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية.
وهذا كان هو الشاغل الكبير لعبد المتعال الصعيدى أحد المجتهدين فى مدرسة محمد عبده الذى تصدى بقوة وشجاعة لقضية الحرية الفكرية والدينية والسياسية غير عابىء بموقف خصومه من أنصار الفكر التقليدى وأعداء الاجتهاد، وأعمل العقل فى ضوء الأصول المقررة فى الشريعة الإسلامية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الهوامش
(1) خالد زيادة مقدمة الكلم الثمان5-8 دار الطليعة بيروت الطبعة الاولى1982.
(2) العلامة محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن – موجود على الإنتر نت.
(3) محمد عمارة: الأعمال الكاملة للطهطاوى – 1/19 – المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت الطبعة الأولي 1973م.
(4) عمارة : الأعمال الكاملة 193.
(5) مناهج الألباب 1 /245 وما بعدها.
(6) السابق 1/250.
(7) خالد زيادة: مقدمة كتاب الكلام الثمان ص12.
(8) سورة هود 18.
(9) مناهج الألباب 1/251.
(10) تلخيص الإبريز 2/79.
(11) السابق 2/155 وما بعدها.
(12) مناهج الألباب 1/251.
(13) رضوان السيد: حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر ص 1 وما بعدها بحث على الإنترنت.
(14) مناهج الألباب 1/383.
(15) تلخيص الإبريز 2/107.
(16) مناهج الألباب 1/383 – 386.
(17) السابق 1/390.
(18) السابق 1/399 – 404.
(19) المرشد الأمين للبنات والبنين 2/473 وما بعدها.
(20) انظر عمارة: الأعمال الكاملة 1/168-170م.
(21) الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة ص 80 إلي 83 الدار التونسية للنشر.
وقارن علي حسب الله: مقاصد الشريعة 299 دار المعارف مصر.
(22) المرشد الأمين 2/475.
(23) تلخيص الإبريز 2/95.
(24) المرشد الأمين 2/477.
(25) السابق 2/277 وما بعدها.
(26) انظر أحمد القاضي: الفكر التربوي عند المتكلمين المسلمين 65-79 الهيئة العامة للكتاب 2005م.
(27) المرشد الأمين 2/278 وما بعدها.
(28) سنن ابن ماجة.
(29) رسائل الجاحظ 3/32 القسم الأول اختيار عبد الله بن حسان، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولي1979م.
(30) انظر عبد الحليم أبو شقة: تحرير المرأة في عصر الرسالة 1/70 وما بعدها 302-304 دار القلم الكويت طبعة أولى 1990م.
(31) المرشد الأمين 2/356.
(32) البخاري الوصاة بالنساء.
(33) المرشد الأمين 2/357.
(34) السابق 2/359 وما بعدها.
(35) الأعمال الكاملة للطهطاوي 1/205.
(36) المرشد الأمين 2/375.
(37) السابق 2/377 وما بعدها.
(38) المرشد الأمين 2/381 وما بعدها.
(39) الأعمال الكاملة للطهطاوي 1/210 .
(40) المرشد الأمين 2/393.
(41) انظر مناهج الألباب 1/363-365 والمرشد الأمين 2/393 وما بعدها.
(42) الأعمال الكاملة 1/203.
(43) المرشد الأمين 2/394.
(44) السابق 2/447.
(45) السابق 2/449.
(46) السابق 2/449 – 465.
(47) رواه البخاري وأحمد والنسائي و الترمذي بإسناد حسن.
(48) المرشد الأمين 2/462.
(49) السابق 2/463 – 465.
(50) السابق 2/467.
(51) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ص 69 دار الفكر سوريا ودار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى 1996 وقارن عمارة: التحرير الإسلامي للمرأة ص 101 – 110 دار الشروق الطبعة الثانية 2002م.
(52) البوطي: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني 69-71.
(53) إبراهيم العبادي : الحرية الفكرية فى الإسلام بين القبول والرفض بحث على شبكة الإنترنت.
(54) السابق .
(55) حرية الفكر فى الإسلام ص 5 .
(56) الصعيدي : المجددون فى الإسلام – ص 11 – 19 – الطبيعة الاولي القاهرة 1960م .
(57) السابق 11 وما بعدها.
(58) مقدمة كتاب الحرية الدينية في الإسلام ص 5 دار المعارف القاهرة 2000م.
(59) العقاد: عبقري الإصلاح والتعليم الإمام محمد عبده ص 166 – دار نهضة مصر – القاهرة 1987م.
(60) انظر سليمان دنيا: محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين ص 26- مقدمة تحقيقية لتعليق محمد عبده على شرح الدواني للعقائد العضدية- عيسي الحلبي – القاهرة 1958م.
(61) حرية الفكر 6 – 8 دار الفكر العربى الطبعة الثانية – القاهرة.
(62) حسن الترابى: السياسة والحكم والنظم السياسية بين الأصول وسنن الواقع ص 193 دار الساقى الطبعة الثانية بيروت 2004 م.
(63) سورة البقرة آية 286.
(64) حرية الفكر ص 11- 13.
(65) سورة البقرة ص 256 .
(66) حرية الفكر 13 وما بعدها
(67) انظر شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص 281 الطبعة الثانية عشر دار الشروق مصر 1983م.
(68) حرية الفكر ص 15وما بعدها.
(69) محمد عبده: الأعمال الكاملة 3/282 تحقيق محمد عمارة دار الشروق مصر.
(70) نفس المصدر والصفحة.
(71) انظر الأشعري: رسالة أهل الثغر ص 34 وما بعدها تحقيق الجليند. وقارن القاضى عبد الجبار: المحيط بالتكليف 26 – 32 .
(72) حرية الفكر ص 18.
(73) سورة الأنعام الآيات 75- 78.
(74) محمد عبده: رسالة التوحيد ص 22- تحقيق محمود أبو رية – دار المعارف – الطبعة الاولى القاهرة. وشلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص 21 .
(75) حرية الفكر ص 20.
(76) سنن ابن ماجة ومسند أحمد.
(77) حرية الفكر 22 – 26 .
(78) السابق ص 26 وما بعدها.
(79) محمد عبده: الأعمال الكاملة 3/282 وما بعدها.
(80) حرية الفكر ص 27.
(81) الزمخشري: الكشاف تفسير سورة طه آية 5 وسورة الفتح آية 10.
(82) حرية الفكر ص29.
(83) نفس المصدر والصفحة .
(84) العقاد: الديمقراطية فى الإسلام ص 43 دار معارف الطبعة السادسة مصدر 1981م .
(85) حرية الفكر ص 30 وما بعدها.
(86) حسن الترابى: السياسة والحكم ص101 وما بعدها.
(87) العقاد: الديمقراطية فى الإسلام ص60.
(88) الجوينى: غياث الأمم ص75 – 95 تحقيق فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمى دار الدعوة الأسكندرية 1978م والماوردى: الأحكام السلطانية ص17-20 طبعة عيسى الحلبى القاهرة.
(89) حرية الفكر ص45.
(90) سنن ابن ماجه.
(91) حسن الترابى: السياسة والحكم ص94.
(92) حرية الفكر ص47 وما بعدها.
(93) الجوينى: غياث الأمم 139.
(94) حرية الفكر 50.
(95) السابق 56.
(96) حسن الترابى السياسة والحكم ص 172.
(97) السابق 174.
(98) يوسف القرضاوى: خطورة الردة ومواجهة الفتنة ص2 بحث على الإنترنت موقع إسلام أون لاين.
(99) محمد سليم العوا: عقوبة المرتد تعزيراً لا حدًّا ص9-12 بحث على الإنترنت موقع إسلام أون لاين.
(100) جمال البنا: لا عقوبة للردة وحرية الاعتقاد عماد الإسلام ص1 وما بعدها بحث على الإنترنت موقع إسلام أون لاين.
(101) رجب البيومى: مقدمة كتاب الحرية الدينية فى الإسلام 5-8 طبعة دار المعارف 2001م.
(102) الصعيدي: الحرية الدينية ص69 طبعة دار المعارف 2001م.
(103) سورة البقرة آية 256 .
(104) سورة الكهف آية 29.
(105) الصعيدى الحرية الدينية 69 .
(106) انظر شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص281 الطبعة الثانية عشرة دار الشروق مصر 1983م.
(107) حسن الترابي: السياسة والحكم ص176 وما بعدها.
(108) السابق 179.
المراجع
- إبراهيم العبادى: الحرية الفكرية فى الإسلام بين القبول والرفض – بحث على شبكة الإنترنت.
- أحمد القاضى: الفكر التربوى عند المتكلمين المسلمين – الهيئة العامة للكتاب – القاهرة 2005م.
- الأشعرى: رسالة أهل الثغر – تحقيق الجليند – مطبعة التقدم طبعة أولى 1987.
- الجاحظ: رسائل الجاحظ – القسم الأول اختيار عبد الله بن حسان – مكتبة الخانجى – الطبعة الأولى 1979م.
- جمال البنا: لا عقوبة للردة وحرية الاعتقاد عماد الإسلام – بحث على الإنترنت موقع إسلام أون لاين.
- الجوينى: غياث الأمم – تحقيق فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمى – دار الدعوة الإسكندرية 1978م.
- حسن الترابى: السياسة والحكم والنظم السياسية بين الأصول وسنن الواقع – دار الساقى الطبعة الثانية بيروت2004م.
- خالد زيادة: مقدمة كتاب الكلم الثمان – دار الطبعة بيروت الطبعة الأولى 1982م.
- رضوان السيد: حقوق الإنسان فى الفكر الإسلامى المعاصر – بحث على الإنترنت.
- رفاعة الطهطاوى: المرشد الأمين للبنات والبنين – الأعمال الكاملة.
- رفاعة الطهطاوى: تلخيص الإبريز – الأعمال الكاملة.
- رفاعة الطهطاوى: مناهج الألباب – الأعمال الكاملة.
- الزمخشرى: الكشاف.
- · سليمان دنيا: محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين – مقدمة تحقيقه لتعليق محمد عبده على شرح الدوائى للعقائد العضدية – عيسى الحلبى – القاهرة 1958م.
- الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة – الدار التونسية للنشر.
- عبد الحليم أبو شقة: تحرير المرأة فى عصر الرسالة – دار القلم – الكويت – طبعة أولى 1990م.
- عبد المتعال الصعيدى: الحرية الدينية – طبعة دار المعارف 2001م.
- عبد المتعال الصعيدى: المجددون فى الإسلام – الطبعة الأولى القاهرة 1960م.
- عبد المتعال الصعيدى:حرية الفكر فى الإسلام – دار الفكر العربى – الطبعة الثانية القاهرة .
- العقاد: الديموقراطية فى الإسلام – دار المعارف الطبعة السادسة مصر 1981م.
- العقاد: عبقرى الإصلاح والتعليم الإمام محمد عبده – دار النهضة مصر – القاهرة 1987م.
- على حسب الله: مقاصد الشريعة – دار المعارف مصر.
- القاضى عبد الجبار: المحيط بالتكليف – تحقيق عمر سيد عزمى – الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- الماوردي: الأحكام السلطانية – طبعة عيسى الحلبى القاهرة.
- محمد حسين الطباطبائى: الميزان فى تفسير القرآن – بحث على الإنترنت.
- محمد رجب البيومى: مقدمة كتاب الحرية الدينية فى الإسلام – دار المعارف – القاهرة 2000م.
- · محمد سعيد رمضان البوطى: المرأة بين طغيان النظام الغربى ولطائف التشريع الربانى – دار الفكر سوريا ودار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى 1996.
- محمد سليم العوا: عقوبة المرتد تعزيرًا لا حدًّا – بحث على الإنترنت موقع إسلام أون لاين.
- محمد عبده: الأعمال الكاملة – تحقيق محمد عمارة – دار الشروق مصر.
- محمد عبده: رسالة التوحيد – تحقيق محمود أبو رية – دار المعارف – الطبعة الأولى – القاهرة.
- محمد عبده: شرح الدوائى للعقائد العضدية – تحقيق سليمان دنيا – عيسى الحلبى – القاهرة 1958م.
- محمد عمارة: الأعمال الكاملة للطهطاوي – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت الطبعة الأولى 1973م.
- محمد عمارة: التحرير الإسلامى للمرأة – دار الشروق الطبعة الثانية 2002م.
- محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة – الطبعة الثانية عشر دار الشروق مصر 1983م.
- يوسف القرضاوى: خطورة الردة ومواجهة الفتنة – بحث على الإنترنت موقع إسلام أون لاين.