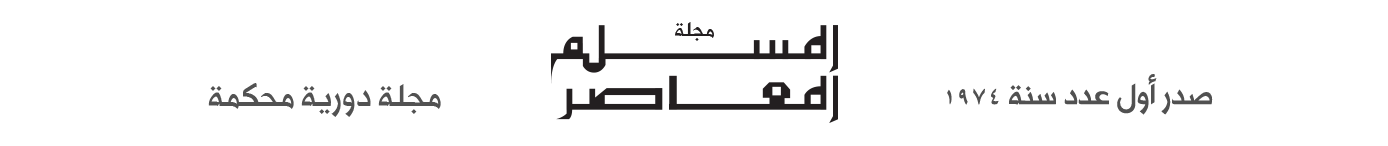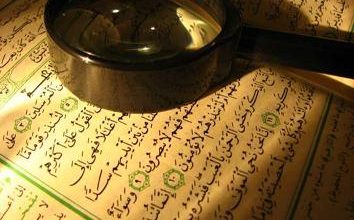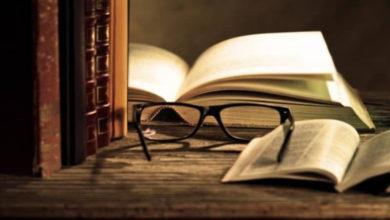(1)
إعجاز القرآن الكريم، وثيق الصلة بالتقدم العلمي، بكافة أنواعه وسائر آفاقه، وكل أحواله.
وأقرب لمحة لبيان هذه الحقيقة، تجدها في نظم القرآن وترتيب آياته.
فنظم القرآن وترتيب آياته هو أهم حقائق إعجازه
والترتيب هو أعم حقائق العلوم كلها، وأكثرها ارتباطا بسائر المعارف الإنسانية.
فنحن لا نستطيع معرفة حقيقة علمية، إلا إذا رتبناها بين غيرها من الحقائق، ورددنا كل جزء من أجزائها إلى أصوله العامة التي تنتمي إليها.
وسنرى أن كل كلمة من كلمات القرآن، ترتبط بترتيب عام، حين نجدها متصلة بموضعها من آية قرآنية بذاتها، بينما هي ترتبط كذلك بترتيب تفصيلي، حين نتدبرها بمواضعها المتفرقة في ثنايا العديد من الآيات والسور.
وسنرى في الوقت نفسه، أن هذا النظم القرآني المعجز، يحمل معه منهج الترتيب في السموات والأرض وما بينهما فأنت لا تقع عيناك على مشهد من مشاهد الكون والحياة، إلا أعطاك ترتيبا، عاما، من حيث ارتباط أجزائه له ترتيبه التفصيلي، الذي يربطه بمواضع تنوعه وتكاثره، على تفرق هذه المواضع، وامتدادها في الزمان والمكان.
بل إننا سنجد – مع ذلك – أن السنة النبوية بكل مكوناتها من أقوال النبي وأعماله وإقراراته، منسجمة مع هذا النظم القرآني، كما يقول الشاطبي في الموافقات «ترك القرآن موضعا للسنة، وتركت السنة موضعا للقرآن(1)».
ولقد تنوعت بحوث الرواد الأوائل في نظم القرآن، فمنهم من تكلم عن الحروف في اجتماعها وتفرقها، ومنهم من تكلم عن الكلمات، ومنهم من تكلم عن الجمل، وقليل منهم ربط بين هذه التراكيب وبين السنن النبوية، والسنن الكونية (2).
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد علم صحابته الأبرار، الفرق الواضح بين ترتيب آيات القرآن، وبين فهم معانيها والعمل بمضامينها، حيث لم يكونوا ينتقلون من آية إلى غيرها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
فحيثما نزلت آيات القرآن متفرقة، كان لنزولها ترتيب موافق لبناء الحياة الإسلامية، بكافة مقوماتها، السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والعملية، وغير ذلك.
ثم جاء بعد ذلك، ترتيب الجمع الذي يقول عنه الله تعالى «إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه»
17 – 18 : القيامة
كما اقترن بذلك ترتيب السنة في اتباعها للقرآن، وعملها بمقتضاه، كما يقول الله تعالى «ثم إن علينا بيانه» «كلا بل تحبون العاجلة» «وتذرون الآخرة»
19 – 20 – 21 : القيامة
فاتباع النبي للقرآن، فيه اتباع لترتيبه من جهة، واتباع لمعانيه، من جهة أخرى، وتحويل هذين معا إلى بناء علمي وعملي جامع، له حركة ممتدة من الدنيا إلى الآخرة، كما رأينا في هذه الآيات السابقة.
ولقد جعل الله للسنة نصيبها الأوفى في تريب آيات القرآن في سورها، ثم ترتيب السور على النحو الذي عمل الصحابة بمقتضاه، حين جمعوا القرآن في المصحف.
ففي حديث عثمان بن أبي العاص قال: «كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شخص بصره، ثم صوبه، ثم قال : أتاني جبريل آنفا فأمرني أن أضع هذه الآية، بهذا الموضع، من هذه السورة. (3) (4)»
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى»
90 : النحل
فهذا كله، مما يبين عمق ارتباط السنة بتركيب القرآن وترتيبه، على هذا النحو الذي يقوم إعجازه، على الوصل بين الجوانب اللغوية والكمية، في حقيقة واحدة جامعة.
فالجانب اللغوي يقوم على التحكم في الوصل والفصل، لكل ما في القرآن من حروف وكلمات وجمل، وهي كل مكونات الكلام، ويقابلها تكوين المجتمع من أفراده، والأفراد من أجزائها، في آيات الله الكونية.
والجانب الكمي، يقوم على تقدير عدد المواضع التي تخص كل حرف أو كلمة أو جملة في ارتباطه بآية، أو تفرقة بمواضع متعددة في الآيات والسور.
والسنن الكونية، وثيقة الصلة بهذا الترابط، بين الحقائق الوصفية والحقائق الكمية، فكل شيء عند الله تعالى بمقدار، وعلى التقدير الكمي، تظهر لنا صفات كل شيء، وتتجلى حقائقه العلمية، ومنافعه العملية.
السبع المثاني مفاتيح كل العلوم
والذي يواصل التدبر لهذا النظم القرآني، يجده يقوم على سبعة من التراكيب، هي أساس السبع المثاني، كما جاء ذكرها في القرآن والسنة.
وهذا بيانها على سبيل الإجمال.
ثم يأتي في نهاية هذا البحث، بعون الله، شرح مجالات تأثيرها العلمي والعملي، في كل العلوم، وسائر أنواع الحقائق.
- الآية القرآنية في الموضع الواحد
مثل قوله تعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين» 5: الفاتحة
وقوله : «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين»2 : البقرة
- الآية القرآنية في المواضع المتعددة
مثل قوله تعالى : «فبأي آلاء ربكما تكذبان» سورة الرحمن
- الجملة القرآنية في المواضع المتعددة
مثل قوله تعالى 1- «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 82 : النساء
وقوله 2- «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» 24 : محمد
- الكلمة القرآنية في الموضع الواحد مثل قوله تعالى : «فمنهم شقي وسعيد» 105 : هود
فقد جاءت كلمة (شقي) بموضع واحد في القرآن كله، ومثلها كلمة (سعيد) وسنرى (بعد ذلك) أن تعدد المواضع أو تفردها، له شأن العظم في نظم آيات الله القرآنية، ثم نظم آيات الله الكونية.
- الكلمة القرآنية في المواضع المتعددة
مثل قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» 87 : الحجر
وقوله : «وبنينا فرقكم سبعا شدادا»
12 : النبأ
فكلمة (سبعا) كلمة واحدة من حيث نصها، ولكن لها ارتباطها بمشهد جديد، مع كل موضع من موضعيها.
- الحرف القرآني في الموضع الواحد
مثل حرف الصاد بقوله تعالى : «ق والقرآن المجيد»
1 : ق
وقوله تعالى : «ن والقلم وما يسطرون» 1 : القلم
وستأتي تفصيلات كثيرة، فيما يخص هذه الحروف، في ثنايا هذا البحث.
- الحرف القرآني في المواضع المتعددة
مثل واو العطف بالآيات الأوائل، من سورة (ص) وسورة (ق) وسورة القلم.
هذه هي التراكيب السبعة التي يظهر معها نظم القرآن الكريم.
وستجد مع مواصلة قراءتنا لهذا البحث، أن كل ما في القرآن من جملة على مستوى آية أو أقل من آية، أو كلمة، أو حرف، لها في تعدد مواضعها أو تفردها، حكمة بالغة، تنطوي على كل قوانين البحث العلمي، في آيات الله الكونية وتراكيبها وتراتيب أجزائها.
ونخص بالذكر هنا ثلاث قواعد أساسية، أولها: ثبات المكونات الأساسية، في نصوص القرآن كما سبق بيانها، ثم ثبات المكونات الأساسية لآيات الله الكونية، سواء نظرنا إلى المجتمعات وكيف تتكون من أفرادها، أو نظرنا إلى الأفراد وكيف تتكون من أفرادها، أو نظرنا إلى الأفراد وكيف يتكون كل نوع منها من أجزائه.
والمقصود بالثبات، نفي التبديل والتغيير.
وثانيهما: اقتران الحركة لأي نص قرآني، يتجدد المشاهد، وزيادة وجوه العلم، على قدر عدد المواضع.
وكذلك الشأن في كل نوع من أنواع آيات الله الكونية، فالماء واحد من حيث ثباته على نوعه وتركيبه، وترتيب مكوناته، ولكنه في تجمعه وتفرقه، تتجدد منافعه وتزداد، على قدر مواضع حركته في آفاق الوجود.
وثالثها: ترتيب أي نص قرآني، من حيث توالي حركته، في مواضعه على قدر تعددها.
وكذلك نجد أنواع الخلق يتوسط بعضها بعضا، ويتفرق بعضها في ثنايا بعض، ولكل نوع منها مع ذلك، ترتيب وجوده الذاتي، كما يتوالى في الزمان والمكان(5).
ثم أن هذه التراكيب السبعة، لها دليلها النقلي، في القرآن والسننة.
يقول الله تعالى : «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» 87 : الحجر ويقول سبحانه:
«الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني» 23 : الزمر
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول : السبع المثاني، فاتحة الكتاب (6).
وأخرج بن جرير عن ابن عباس أنه قال : المثاني ما ثنى من القرآن (6) ألم تسمع لقول الله «الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني» 23 : الزمر
وأخرج بن جرير عن الضحاك أنه قال : المثاني القرآن يذكر القصة الواحدة مرارا (7).
إننا حين ننظر إلى الموضعين القرآنين، اللذين جاءت فيهما كلمة «المثاني» وكلمة «المثاني»، نجد كل موضع منهما قد وصلنا في سياقه، بحقيقة خاصة به.
فسورة الحجر أشارت بطريقة مجملة، إلى أن فاتحة الكتاب هي «السبع المثاني»، وهكذا ارتبط الحديث النبوي الذي مر بنا آنفا، بهذه الحقيقة القرآنية المجملة، ففسرها بما يؤكد أن الفاتحة، هي السبع المثاني أما الآية التي جاءت بها كلمة (مثاني) في سورة الزمر، فقد وصلتنا بحقيقة جديدة، هي أن المواضع المتعددة، لكل آية وأجزائها في القرآن، تتشابه علينا، ولكنها لا تتكر هذا التكرار الجامد الذي نعهده في كلامنا البشري، بل عي تتجدد معها تراكيب النص الواحد وتراتيبه، بحيث يتسلسل بها ترتيب تفصيلي يخصها ويصلها بألوان من العلم، بعدد مواضعها في القرآن كله.
وقد أكدت السنة المطهرة هذه الحقيقة، التي يجدها في القرآن، كله من تدبره تدبيرا، عمليا، حيث أشار ابن عباس، إلى أن المثاني، هي ما ثنى من القرآن، أي ما تعددت مواضعه، ثم استشهد بآية سورة الزمر.
فهناك تنوع مترابط لبيان الحقيقة الواحدة، حين نجدها في القرآن، ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في كلام صحابي مثل ابن عباس، ثم يتصل هذا التنوع، حتى نجد الضحاك يبين لنا أن المثاني هي القصة الواحدة، يذكرها القرآن مراراً.
إن هذا التأير العلمي القرآني المتجدد، يحمل الحقيقة الواحدة، فيضعها في مواضع متوالية من المكان والزمان، والرؤى والمشاهد، والمجتمعات والأفراد، فإذا الحقيقة في داتها لها شأنها، وإذ حركتها وتفاعلها العلمي، بالمجالات المناسبة لذلك، زيادات لها حسابها ولها تقديرها، ولها دورها البناء في الحياة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة، فيسعد المتبعون للقرآن، ويشقى المخالفون له (8) (9).
من هنا كان علينا، أن ننظر في نصوص القرآن في ذاتها، ثم ننظر في نصوص القرآن من حيث ارتباطها بمواضعها المتعددة في القرآن كله، لنتلقى هذا الدور القرآني، العملي، فنتعلم كيف نبحث في الحقائق الذاتية لكل أشياء الوجود من الذرة إلى المجرة، وكيف نعرف كل شيء في ذاته، ثم نعرفه في ارتباطه بغيره، حيث تتنوع التراكيب والتراتيب، والنتائج التي تحققها هذه الحركة الدائبة، في هذه المخلوقات الكثيرة، التي أبدعها الله رب العالمين (10).
والفوائد التي نحصل عليها من هذه الحقائق، التي يدور عليها هذا البحث فوائد كثيرة، أهما ترسيخ عقيدة التوحيد، وبيانها للعقول والقلوب، المتعطشة إليها في العالم كله.
ويكفي أن ننظر في كلام عالم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية الأمريكي، وولتر أوسكار لندبرج ح. حيث يقول : «في جميع المنظمات الدينية المسيحية، تبذل المحاولات لجعل الناس يعتقدون منذ طفولتهم في إله هو على صورة إنسان» ويواصل هذا العالم كلامه، فيبين أن تركيب الكون المادي الذي نعيش فيه وترتيب أجزائه، يشهد بوجود إله واحد لا شريك له. (11)
ثم إن عالم الرياضيات والفيزياء إيرل تشستر ريكس يقول : إن الظواهر العديدة التي تدل على وحدة الغرض، في هذا الكون، وتشير إلى نشأته والسيطرة عليه، تبين كذلك، انه لابد أن يتم هذا كله، على يد إله واحد لا آلهة متعددة. (12)
فما بالنا إذا أوضحنا لأمثال هذين العالمين الكبيرين، وهم كثيرون جدا بين علماء العالم كله، أن تركيب الكون المادي، قائم على منهج التركيب والترتيب لآيات القرآن وأجزائها مع استقلال كل منها بحقيقته الخاصة به، وأن السنن النبوية هي أداة الوصل بين معرفتنا نحن البشر ووجودنا، وبين هذا المنهج العلمي العملي الواحد في آيات الله القرآنية، وآياته الكونية إننا حينئذ لن نجد تفرقة بين الماديات والأخلاقيات، ولا بين العلم النظري، والتطبيق العملي، وسنعود جميعا إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها.
بل إن المسلمين أنفسهم، سيتعلمون كيف يحتكمون إلى كتاب ربهم، وسنة نبيهم في كل مشكلاتهم مهما تختلف هذه المشكلات.
والله ولي التوفيق.
مواضع تعريف الإعجاز الإلهي في آيات القرآن وسوره
- عجز الإنسان في معرفته ووجوده ما لم يتهد بهدى الله
جاءت الكلمات الدالة على الإعجاز الإلهي، في القرآن كله، حاملة معها حقيقة العجز في إمكانات المخلوقين، أن يتحدوا إرادة خالقهم أو أقواله وأفعاله.
- ونجد أول موضع يصلنا بأهم وجوه هذا التعريف القرآني حيث يقول تعالى : «قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي»31 – المائدة
فالقرآن يبدأ ببيان عجز الإنسان أن ينتصر على دوافع الشر في نفسه، كلما تخلى عن طاعة الله سبحانه.
وهكذا قتل قابيل أخاه هابيل، ثم عجز أن يواري سوأته.
وهذا متعلق بمعرفة الإنسان، ولا مخرج للإنسان من هذا العجز، إلا بالخضوع للأحكام التي جاء بها دين الله، مع البراءة من كل ما يخالفها.
- عجز الإنسان أن يخرج من حدود المكان والزمان
ثم نمضي إلى موضع قرآني آخر يبين لنا عجز الإنسان، أن يخرج من حدود وجوده في المكان والزمان، فمهما – معا – حجاب من الغيب يجعلنا بحاجة دائمة إلى الإيمان، بما جاء به دين الله، من حقائق الوحي في القرآن والسنة.
«إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين»134 – الأنعام
فالمستقبل علمه عند الله، والماضي ننسى منه ما ننسى، ونذكر ما نذكر.
- حتمية انتصار الإسلام في الدنيا والآخرة
أما الموضع القرآني الثالث، الذي يبين لنا حقيقة جديدة من حقائق الإعجاز الإلهي، وأسباب العجز البشري، فهو حيث يقول الله تعالى :
«ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون»
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»59 – 60 – الأنفال
فحيث سبق في الموضع الأول أن الإنسان عاجز عن حفظ نوعه، منساق وراء دوافع الشر، حتى أنه ليقتل أخاه لو لم يكن له رادع من أوامر الله، ونواهيه.
وحيث جاء في الموضع الثاني، حتمية الإيمان بكل ما جاء من عند الله، عن حقائق وجودنا ومصيرنا، وانتهينا في الموضع الثالث إلى أن الذين يأبون أن يؤمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر، ستكون لهم معارك ضد المؤمنين، وسيكون لهم سباق في التسلح، ودعاوى غير صحيحة في السبق الحضاري، فكذبهم الله وبين أنهم لا يعجزون الله الذي خلقهم ثم أمر عباده المؤمنين أن يعدوا لهم، ما استطاعوا من قوة وأن لا يظنوا أن الآخرة تغنيهم عن طلب النصر في الدنيا والأخذ بأسباب التقدم فيها.
- عجز المشركين أن يقاوموا القوة الإسلامية
ونصل إلى الموضع الرابع حيث قول الله سبحانه
«وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم».
3 – التوبة
وهنا نجد الإعجاز الإلهي، يبين لنا عجز المشركين أن يدفعوا عن نفسهم عذاب الله لهم في الدنيا بمحاربة النبي لهم بمن معه من المؤنين، حتى يتوبوا عن الشرك أو يقتلوا وهو مشركون، فيكون عذابهم في الآخرة أشد من غذابهم في الدنيا.
- عجز المشركين أن يخرجوا من العذاب الأبدي
ثم نجد في الموضع الخامس قوله تعالى :
«ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين».52 – 53 : يونس
وهنا نجد الإعجاز الإلهي مبينا للمشركين أنهم خالدون في العذاب يوم القيامة، لا مفر لهم من ذلك وأن دين الله الحق لا ريب فيه، وأنهم عاجزون عن الفرار من مصيرهم، إذا ماتوا على الشرك.
ففي الموضع الرابع جاء ذكر العذاب عاما.
«وبشر الذين كفروا بعذاب أليم»
أما في الموضع الخامس فقد ذكر العذاب خاصا بما يلقى المشركون يوم القيامة «ذوقوا عذاب الخلد»
- وفي الموضع السادس نجد قوله تعالى :
«أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون»20 : هود
إن أوامر الله ترقى بالبشر من مستويات عجزهم إلى آفاق التقدم بكل أنواعه.
أما الذي ينهى الله عنه فهو حماية لنا من مفتريات أهل الباطل، ومن موالاة أهل الشر.
فمن أطاع الله في كل ما أمر به ثم اجتنب كل ما نهى عنه فهو الذي انتفع بما يسره الله له من نعمة السمع والبصر.
أما الذي لم يأتمر بما أمر الله به، ولم ينته عما نهى الله عنه، فهو من الذين «ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون»
وهكذا ندرك أن الإعجاز الإلهي، إنما هو ظاهر دائما في كل نعم الله على عباده وأن عجزهم عن طاعة الله، هو أول ما يكشف عن استحقاقهم للعجز وتخلفهم في كل أمورهم ابتداء عن عدم استطاعتهم أن ينتفعوا بأقرب نعم الله منهم، فهم لا يستطيعون أن يسمعوا أو يبصروا مع وجود آذانهم وأعينهم.
ولعلنا نلحظ عظمة الترتيب القرآني، حيث جاء ببيان العذاب الدنيوي والأخروي بوجه عام، في الموضع الرابع، ثم جاء بعده الموضع الخامس بعذاب الآخرة خاصة –ثم جاء الموضع السادس بشيء جديد، ولكنه متعلق بالموضعين السابقين، وهو مضعفة – العذاب لنوع من العصاة، الذين صاحبوا رفقاء السوء، وعجزوا عن انتفاعهم بنعم الله عليهم، في وحي الله حيث أمرهم ونهاهم، فلم يستجيبوا، وفي خلق الله، حيث منحهم سمعا وبصرا، فلم ينتفعوا بهما (12).
- وهكذا جاء الموضع السابع بقوله تعالى :
«قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين * قال إنما يأتيكم به الله إن شاء الله وما أنتم بمعجزين».32 – 33 : هود
لقد جاءت هذه النقلة القرآنية الجديدة، حاملة معها مشهدا تاريخيا يتبين لنا معه، حدود قدرة الأنبياء وإطلاق القدرة الإلهية.
فالله هو القادر وحده على أن يأتي بما شاء فيما يشاء من الزمان والمكان.
ولقد رأينا في الموضع السادس عجز العصاة عن انتفاعهم بنعم الله عليهم لا في وحي الله، ولا في خاصة أنفسهم، حيث نعمة السمع، ونعمة البصر.
فها نحن في الموضع السابع نشهد عناد البشر إذ يؤثرون هلاكهم، على تصديقهم بالحق الذي جاء من عند الله.
وقد كان الطوفان هو الجزاء الذي استحقوه، فإذا الماء الذي تقوم عليه حياتهم هو سبب غرقهم، وهلاكهم، فقد عجز البشر – أولا – أن ينتفعوا بنعمتين في أجسامهم، هما السمع والبصر، ثم عجزوا – ثانيا – أن ينتفعوا بنعم الله المتصلة بالكون الذي يعيشون فيه.
- كل ما في العالم من النعم فهو من الله وحده لا شريك له.
- وفي الموضع الثامن نجد قول الله تعالى :
«قالت ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا»72 – هود
وهكذا تتصل حلقات الإعجاز الإلهي، حتى نجد حفظ السلالة الإنسانية وتكاثرها، تاليا من حيث ترتيب هذا النوع من الكلمات في القرآن لحادث الطوفان، الذي أهلك الله به قوم نوح.
فكأن الله يذكرنا بأنه هو القادر على خلق الإنسان، وتكثير ذرية البشر، ولو كانت الأم عجوزا طاعنة في السن، وكان زوجها شيخا فانيا.
وكلمة (عجوز) تنتسب من حيث أصولها في اللغة، إلى العجز، الذي يزول من وجودنا البشري بمقدار ما يمنحنا الله من أنواع نعمه الدالة على الإعجاز الإلهي.
- وتتصل هذه الحقائق المترابطة بالموضع التاسع لهذا النوع من كلمات القرآن، حيث نصل إلى قوله تعالى:
«أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون * أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين * أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم»45 -46 -47 : النحل
لقد وصلنا – هنا – إلى أصحاب المذاهب الإلحادية الفاسدة وذوي المناهج الباطلة، فالله تعالى يبين لهم عجزهم أن يتحكموا في الأرض التي أسكنهم الله فيها، وعجزهم أن ينتفعوا بأنواع نشاطهم، الذي يظنون أن فيه من التقدم، ما يجعلهم في حل من العمل بدين الله والنزول على حكمه.
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، مفسرا قوله تعالى «أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين»
(تقلبهم ) أي اختلافهم (13)
والمقصود اختلاف حركتهم وأنواع نشاطهم في الدنيا، مزهوين بما استحدثوا من البدع الصارفة لهم، عن الدين الذي أمرهم الله باتباعه، والاحتكام إليه.
ونلحظ الترتيب المعجز حيث جاء التكاثر في النوع البشري، في الموضع الثامن، بينما جاء في الموضع التاسع، النهي عن التكبر، بما يستكثر الإنسان، من متاع الدنيا، حتى يصرفه عن طاعة ربه.
- وحي الله في القرآن مرتبط به وحيه في السنة:
وفي الموضع العاشر ثم نصل إلى قوله تعالى :
«قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم * والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم»49 – 51 : الحج
إن آيات الله تشمل آيات القرآن، وما بينهما لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تشمل آيات الله الكونية، وبذلك يعلم البشر أنهم عاجزون عن تبديل شيء مما قدر الله لهم في دنياهم وآخرتهم، فالجنة لمن أطاع الله والنار لمن عصاه. (14)
ولذلك اجتمع في هذا الموضع ذكر السنة مجملة – في بيان النبي لما أوحى الله إليه.
«إإنما أنا لكم نذير مبين» وقد أنذر النبي الناس بالقرآن والسنة كذلك.
ثم تبع ذلك، ذكر الجنة للصالحين من عباد الله، وذكر النار للذين سعوا في آيات الله معاجزين، أي واهمين أنهم سيغلبون الحق بأباطيلهم ! وهذا لا يكون أبدا.
ونلحظ الإعجاز في الترتيب، حيث جاء الموضع الثامن عن كثرة النوع الإنساني، ثم جاء الموضع التاسع ببيان استكثار الكافرين من طيبات الدنيا واستكباهم بما يجمعون، وبعدهم عن جادة الحق، بينما الموضع العاشر جاء مبينا أن الناس جميعا في هذه القضية فريقان، فمنهم الصالحون، ومنهم غير ذلك.
- العمل بالقرآن والسنة وحتمية انتصار المسلمين والتمكين لهم في الأرض :
وفي الموضع الحادي عشر نصل إلى قوله تعالى :
«وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» إلى قوله سبحانه «لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض»55 – 57 : النور
إن النتائج الكبرى، لكل ما تقدم في المواضع السابقة، هي مجملة في استخلاف الله للمؤمنين في الأرض، يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
ولابد حينئذ من عجز الكافرين، أن ينالوا من المؤمنين شيئا وقد بدل الله ضعفهم قوة، وخوفهم أمنا.
والواقع العملي، يبين لنا أن الفتوحات الإسلامية، ظلت موجودة دائما، تحقيقا لوعد الله رغم كل ما ذهب منها.
وفي السنة المطهرة تفصيل ذلك (15)
- الإعجاز القرآني في السبق إلى حقائق العلوم
وفي الموضع الثاني عشر نصل إلى قوله تعالى:
«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير»20 – 21 – 22 : العنكبوت
ها هنا يتصل الإعجاز الإلهي، بقضية جديدة، ولكنها وثيقة الاتصال، بما جاء في المواضع السابقة إذ أن الجديد هنا هو بيان السير في الأرض للنظر في أحوال السابقين من البشر، ثم بيان أن البشر ليسوا معجزين في الأرض ولا في السماء.
فالكلام عن عجز البشر أن يحيطوا بحقائق الأرض والسماء، مما يظهر معه التطور الحديث في حياتهم، وهو أمر لم يكن معروفا أيام نزول القرآن، وإنما تحقق بعد ذلك بزمن طويل حيث عرفنا نحن المعاصرين صناعة الطيران، وما يسمى عصر الفضاء، والأقمار الصناعية أو الصواريخ (16)
- وهكذا نصل لقوله تعالى :
«وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين».
«والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم».3 – 5 : سبأ
ومن الجديد هنا لبيان الإعجاز الإلهي، في الإحاطة بكل ما هو أكبر وأصغر في خلق الله، مع إنذار الناس بيوم القيامة.
بعد ما سبق من بيان عجز البشر عم معرفة كل حقائق الأرض والسماء وبيان أن القرآن قد سبق بكشف وصولهم إلى الفضاء قبل أن يصلوا إليه فواجبهم – إذن – أن يؤمنوا بيوم القيامة – قبل أن يأتي هذا اليوم.
ونلحظ الترتيب المعجز حيث جاء الكلام عن الفضاء في الموضع الثاني عشر بينما جاء الكلام عن يوم القيامة في الموضع الثالث عشر، إذا الوصول إلى الفضاء غاية ما يتطلع إليه الإنسان، في الدنيا.
- الإعجاز الإلهي في كل النواحي الاقتصادية :
وفي الموضع الرابع عشر نصل إلة قوله تعالى :
«وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون * والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون»37 – 38 : سبأ
ومن الجديد هنا بيان الجانب الاقتصادي بين نعم الله على الإنسان وأن الذين يستغلون هذه النعمة – في غير ما أمر الله به ولا يبتعدون عما نهى الله عنه ليسوا بمنجاة من عقاب الله لهم.
- الإعجاز الإلهي وتقويمه لعلوم البشر:
وفي الموضع الخامس عشر نصل إلى قوله تعالى :
«وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم» إلى قوله تعالى «والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين»49 – 51 : الزمر
ومن الجديد هنا بيان جهل الكثير من الناس بحقائق الإعجاز الإلهي في كل ما يصيب الناس من ضر أو نعمة فهم يضرعون إلى الله بالدعاء إذا أصابهم الضر ثم يغترون بالنعمة إذا رزقهم الله بها ظانين أنها جاءتهم بما لديهم من العلم.
ونلحظ الترتيب المعجز، حيث جاء الكلام عن المال في الموضع الرابع عشر وجاء بيان عن جهل الإنسان بحقيقة نعم الله في الموضع الخامس عشر. وواضح أن الإنسان لا يفكر في هذه الأمور إلا بعد تحقيقها فذلك سبق ذكر المال ثم تبعه من حيث الترتيب الكلام عن معرفة نعم الله.
- الإعجاز الإلهي وتأديب العصاة:
وفي الموضع السادس عشر نصل إلى قوله تعالى :
«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير * وما أنتم بمعجزين في الأرض»30 – 31 : الشورى
ومن الجديد هنا بيان مسئولية الإنسان عما يصيبه من المصائب وأن الله يعفو مع ذلك عن كثير من ذنوب البشر مع كونهم غير معجزين في الأرض، وإنما الإعجاز الإلهي هو الغالب عليهم، وقد جاء في الموضع السابق ليكون تفصيلا له وبيان لمسئولية الإنسان عن أفعاله.
- حتمية العمل بالقرآن لمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة:
وفي الموضع السابع عشر نصل إلى قوله تعالى:
«ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض»32 : الأحقاف
وفي هذا الموضع إشارة إلى اجتماع القرآن والسنة، على حمل دعوة الله إلى الناس كافة ليدخلوا في دين الله وهو الإسلام.
فمن أبى أن يجيب داعي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من عند الله فليس بمعجز في الأرض، وإنما هو خاضع لحكم الله عليه في الدنيا والآخرة.
ولا ريب في أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا الناس بالقرآن، والسنة معاً.
وواضح أن ترتيب هذه المواضع بعد كل ما سبق، مناسب لجعل الدعوة قائمة في الناس إلى يوم القيامة.
- واخيرًا ننتهي إلى قوله تعالى، حكاية عن الجن «وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا» 12 – الجن
وهذا الموضع الأخير من المواضع القرآنية التي جاء بها ذكر الإعجاز الإلهي قد تفرد بمعجز الجن عن الهرب من الله تعالى.
فلما كان هذا النوع من الخلق، مع ما خصه الله به، من القدرة على التشكل والتحول، عاجزا عن الهرب، فإن البشر أظهر عجزا، عن مثل ذلك.
ومع بعض ما جاء في السنة عن هذه الحقائق نواصل النظر، والتدبر
- الإعجاز الإلهي وحتمية الايمان بالقدر
الحديث الأول : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس (17)
وهذا الحديث يربط بين العجز والكيس وبين القدر.
والقدر حق وعدل لأسباب كثيرة، منها أنه يقوم على علم الله بما سيفعله كل إنسان، بعد أن يخيره الله بين الطاعة أو العصيان.
يقول الله تعالى :
- «إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا»
3 : الإنسان
ويقول الله تعالى :
«ألم نجعل له عينين * ولسانا وشفتين * وهديناه النجدين»
10 : البلد
وكذلك فإن هذا الحديث يبين لنا الحدود الفاصلة بين العجز وأهمية تفريط الإنسان في طاعة ربه – وبين الكيس وأهمية قيام الإنسان بحق الله عليه فيكون مطيعا له عاملا بأوامره، مجتنبا نواهيه.
- الإعجاز الإلهي والحث على الإنفاق :
الحديث الثاني :
يقول الله تعالى : «يا ابن آدم، أني تعجزني وقد خلقت من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت (18) بين بردين، وللأرض منك وتد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق، وأني أوان الصدقة»
ومن الجديد هنا أن الله يبين لنا (19) في هذا الحديث القدسي، أصل خلق الإنسان في رحم أمه، وكيف يرعاه الله فيكبر ويملكه الله من الأموال، فيبخل ولا يتصدق، ولا يفكر في ذلك إلا بعد فوات الأوان.
- الإعجاز الإلهي والتيسير على الناس
الحديث الثالث :
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم – في جوف الليل، فصلى في المسجد فثاب رجال فصلوا معه بصلاته، فلوا أصبح الناس وتحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد خرج فصلى في المسجد من جوف اليل فاجتمع الليلة – المقبلة – أكثر منهم.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل من جوف الليل فصلى وصلوا معه بصلاته ثم أصبح فتحدثوا بذلك فاجتمع الليلة – الثالثة – ناس كثير، حتى كثر أهل المسجد.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، فصلى فصلوا معه فلما كانت الليلة الرابعة، اجتمع الناس حتى كاد المسجد أن يعجز عن أهله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج حتى سمع ناسا منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما صلى صلاة الفجر، سلم ثم قام في الناس فتشهد ثم قال : «أما بعد فإنه لم يخفف عن شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»
وفي الحديث (20) بيان أنواع العجز في المخلوقات، فالمسجد يعجز عن أهله لضيق مساحته.
والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض صلاة الليل على المسلمين فيعجزوا عنها !!
فالعلاقات بين الأسباب وغاياتها، قد أحاط الله بعلمها، وجعل سبحانه لكل شيء قدرا.
وكل شيء خرج عن حدوده التي وضعه الله فيها، فهو باطل.
- الإعجاز الإلهي ومحو أسباب الرزق
الحديث الرابع:
أيما عبد كوتب ثم عجز فهو رقيق (21)
وهذا الحديث يقدم لنا قضية جديدة وهي قضية المنهج ال؟إسلامي في تخليص الإنسان من دوافع العجز، والخضوع للقهر في نفسه.
فالرقيق أما في فرصة العمل، ليتخلص من رقه، الذي يكون من أسبابه في أغلب الأحوال، الميل للكسل، والعجز عن مطالب الحرية، والعظمة في الحياة.
فالتغلب على الرق بالعمل الكثير، فيه تدريب على بلوغ آفاق العظمة، ومراتب القوة، كما يريدها الله لعباده جميعا، ولهذا جعل عجزهم هو نقطة الانطلاق نحو الكيس بمعناه السابق.
- الإعجاز الإلهي وبيان نسبية العجز بين المخلوقين:
الحديث الخامس:
جاء فيه أن امرأة ركبت العضباء ونجت عليها من مختطفيها، فجاء في الحديث (فطلبوها فأجزتهم)
ثم إن المرأة نذرت لئن أنجاها الله على هذه الناقة لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
والجديد هنا (22) أن الإنسان ليس مطلق الإرادة في كل ما يقول ويفعل، وإنما هو عاجز أن ينذر في معصية لله، وفيما لا يملك البشر.
ومن الجديد هنا كذلك – أن العجز يكون في التسابق وبه يظهر العجز على من لم يلحق بما يطلبه.
- الإعجاز الإلهي وبيان أن الاستعانة – بالله تنقذ الإنسان من عجزه
الحديث السادس:
المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
وإن أصابك شيء فلا تقل، لو أني فعلت كذا لكان كذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
من الحقائق الجديدة هنا (23) في تعريف الحقائق التي نحن بصددها ان الله جعل الاستعانة به طريقا أمام الإنسان، يتمكن بها من مفارقة العجز، والوصول إلى الكيس، والتقدم نحو الخير والسعادة والقوة التي جاء معرضها في أول الحديث.
والحديث ينهى عن التردد ويأمر بالمواصلة في طلب الخير ومحاولة الوصول للقوة.
وهذه معان عملية، لابد من معرفتها، للوصول إلى فهم حقائق القرآن التي سبقت في تعريفه للإعجاز الإلهي والعجز البشري.
- الإعجاز الإلهي والتوجه بالدعاء إلى الله وحده
الحديث السابع :
«اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن وضلع الدين، وغلبة الرجال»
وما يزدنا تعريفا (24) بالإعجاز الإلهي والعجز البشري، أن هذا الدعاء يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة الإنسان إلى الله تعالى ليعينه على دفع الهم والحزن، وهما يدلان على فساد الأحوال، واختلاف النظم، بعد انصراف المسلمين عن العمل بما جاء به دين الله في كثير من أمورهم.
فإذا كان ذلك ركن الضعفاء من الناس إلى العجز والكسل.
فإذا كان ذلك، أمسكوا عن الإنفاق، وبخلوا، فأصابهم الجبن.
فإذا كان ذلك، وقعوا فريسة للفقر والدين، الذي لا يجد أحدهم له وفاء.
فإذا كان ذلك، كان هناك قهر وانهيار وتسلط.
فلهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء النبوي باستعاذته بالله من غلبة الرجال وهو معنى يتسع لأنواع كثيرة من الاحباط والهزائم منها، هو خاص بالنفس البشرية، فيما يخص الفرد الواحد أو هو خاص بانهيار المجتمع ووقوع أفراده، بعضهم تحت ظلم البعض.
فإذا كان ذلك عز النصر على الأعداء وتعطلت الدعوة إلى الحق وكثر الترويج للباطل.
الحديث الثامن:
«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، والهرم والقسوة والغفلة والعيلة، والذلة، والمسكنة».
«وأعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق، والنفاق والسمعة والرياء»
«وأعوذ بك من الصم، والبكم، والجنون، والجذام، والبرص، وسيء الأسقام»
وهذا الحديث (25)وثيق الصلة بالحديث الذي قبله بل هو امتداد له يبدأ بالاستعاذة بالله تعالى، من العجز والكسل، ثم الاستعاذة به سبحانه من أنواع القهر، وما يتبعه من أهوال.
وتأتي بعد الاستعاذة بالله، من أنواع الفقر البادي، والأخلاقي، والعلمي والاستعاذة بالله من أنواع الأمراض.
الحديث التاسع:
اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر وفتنة الدجال.
اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.(26)
وهذا الحديث امتداد للحديثين السابقين، ابتداء من الاستعاذة بالله من العجز والكسل، ثم يأتي الجديد هنا في الاستعاذة من عذاب القبر، وفتنة الدجال.
قدم عذاب القبر لأنه أشد على من استحقه، من فتنة الدجال وأن كانت هذه الأخيرة، أسبق في التسلسل الزمني.
ولهذا الترتيب حكمته القائمة على النظر للأحداث من حيث خطرها وشدتها، وترتيبها تبعا لذلك.
ثم دعا النبي ربه عز وجل، أن يؤتي نفس الإنسان تقواها ويزكيها مع الإقرار بأن الله هو الولي وهو المولى، الذي لا ملجأ منه إلا إليه.
ثم استعاذ النبي بربه جل وشأنه من أربعة أمور، الأول : هو العلم الذي لا ينفع، إذ النفع مقترن بالعلم، ولولاه لتعطلت آثار العلم.
والثاني:هو القلب الذي لا يخشع لله تعالى، لأنه يكون قلبا غير مود لأهم وظائفه.
والثالث: هو النفس التي لا تشبع، لأن العلم إذا كان مؤديا إلى الرياء، والكبر، لم يكن نافعا وكان ضارا فيقسو القلب ولا يخشع لله ولا يحب عباد الله تقربا إليه، فتكون النفس شرهة، قاسية، جامدة.
وهذا ليس بسبب العلم، وإنما بسبب تعطيل العمل به.
والرابع: هو الدعاء الذي لا يستجيب الله له.
وهذا نتيجة لكل ما سبق، لأن الله إنما يستجيب لمن دعاه وهو تقي، نقي. تدرج في ترتيب مما هو سابق زمانا، إلى ما هو لاحق.
فإذا نظرنا نظرا أعم، وجدنا هذا التسلسل الواقعي محتويا على ترتيب عام قائم على تقديم العذاب، لعظمة المصاب فيه.
على فتنة المحيا، والممات مع أن فيها الاختبار الذي يكون أولا، ثم تتبعه العذاب.
فبذلك يكون الترتيب في أجراء الحديث واقعيا من حيث التسلسل الزماني.
بينما هو متضمن من الناحية الموضوعية، ترتيبا مراعيا لأحوال الإنسان، وما يصيبه من الكوارث التي لا منجى منها إلا باللجوء إلى الله، فقدم النتيجة لأنها أشد وقعا وألما على المقدمة المؤدية إليها.
وقد رأينا أن الترتيب القرآني أعظم من ذلك كثيرا، ثم يتبعه كلام النبوة، الذي لا يدخل في كلام البشر، وإنما هو وحي الهي خص الله به عبده وخاتم رسله، وأجراه على لسانه.
الحديث العاشر:
«اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن ، والبخل، والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار»
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات (27) هذا الحديث، امتداد للأحاديث السابقة التي دارت كلها حول الاستعاذة بالله من العجز والكسل، ومن المآسي التي تتفرع من هذين الأصلين.
ومن الجديد هنا – الاستعاذة بالله، من عذاب القبر وعذاب النار. وفيه تدرج في الترتيب من العذاب الأدنى إلى العذاب الأكبر.
ثم عاد إلى أسباب ذلك كله فاستعاذ بالله من فتنة المحيا والممات.
- الإعجاز الإلهي وقبول شفاعة النبي يوم القيامة:
الحديث الحادي عشر :
حديث طويل عن أهوال القيامة.
وقد جاء في نهايته قول النبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب سلم سلم
حتى تعجز أعمال العباد (28)
وهذا الحديث يبين لنا أن أعمالنا الصالحة انما هي طريق إلى رحمة الله وليست وفاء بحقوق الله علينا (29)
وعجز أعمالنا الصالحة عن القيام بكل ما يجب علينا الله تعالى، معنى جاءت به السنة وتفردت به ولكنه وثيق الصلة بالحقائق التي سبقت بها آيات القرآن واستخلصت منها التعريف للإعجاز الإلهي في الخلق والوحي. ثم جاءت الأحاديث السابقة بوجه من العلم، يكتمل بها فهمنا وتتم بها معرفتنا لجملة – الحقائق الخاصة بذلك.
ولقد جاء في هذا الحديث، بيان لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن استحق شفاعته يوم القيامة.
وهذه الشفاعة تكون بإذن من ربه عز وجل.
وهذا أمر له مغزاه في بيان الإعجاز الإلهي والعجر البشري.
هذه كلها أصول أجمل الوحي الإلهي فيها الحدود الفاصلة بين ما جعله الله، مناطا لقوة الإنسان ومجالا للتقدم في العلم النافع والعمل الصالح، وبين ما جعله الله سبحانه سببا في عجز الإنسان وتخلفه، فطاعة الله معها التقدم والتعلم والنجاح والفلاح، وعصيان الله معه دائما الخسران المبين والعجز الأليم.
من أصول الإعجاز العلمي
عند طائفة من العلماء السابقين
سننظر – بعون الله – إلى ما سبق به الرواد الأوائل، ممن كتبوا عن الإعجاز، ابتداء من الخطابي في القرن الرابع الهجري، وانتهاء بالسيوطي في القرن التاسع الهجري.
ثم نختم هذا العرض، بمثل واحد من العلماء المعاصرين، هو العلامة الراحل، الدكتور الغمراوي.
- مع الخطابي وكلامه عن المنهجين المعنوي والتركيبي:
القرآن الكريم، يحمل معه علوما بعدد كلماته، وعدد تراكيبها، وتراتتيبها.
والخطابي يركز اهتمامه على منهجين اثنين، يستخلصهما من سور القرآن وآياته (30).
فأما المنهج الأول: فهو المنهج المعنوي، وأساسه أن يستخلص كل من يقرأ القرآن، ما يتيسر له من معانيه، لتكون فرقانا يعرف به الحق من الباطل، والهدى من الضلال.
ذلك أن معاني القرآن حق خالص، ويقين دائم، ومهما تكن الفترة التاريخية، لكل أمة من الأمم، التي تحيا في نوره، فإن كل أمة تأخذ منه ما يناسب عصرها، ومبلغها من العلم، ومع ذلك فإن الذي يقف عند النور القرآني، لا يتعداه بأوهامه، وظنونه، لا يزال في حصن حصين من عثرات الفكر، وسقطات الضلال، وسيئات الأقوال والأعمال.
يقول الله تعالى :
«الشمس والقمر بحسبان»
5 : الرحمن
فأهل العلم القدامى قالوا عن قوله تعالى «بحسبان»، أي بحساب فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عن مقادير الزكاة، (ولا يفرق أبل عن حسبانها) (31)أي حسابها.
وعن أبي مالك رضي الله عنه.. «الشمس والقمر بحسبان» قال عليهما حساب وأجل كأجل الناس، فإذا جاء أجلهما هلكا (32).
ومجاهد من كبار التابعين، وتلميذ الصحابي الجليل ابن عباس، فسر لنا هذه الكلمة بقوله أي بحسبان كحسبان الوحي، وزاد القرطبي : يعني يدوران في مثل القطب (33).
حتى إذا وصلنا إلى الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 503 هـ وجدناه يقول عن قوله تعالى «بحسبان» أي ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه (34).
أما في القرن الثامن الهجري فإن ابن كثير المتوفى سنة 774 يقول عن قوله تعالى «بحسبان» أي يجريان متعاقبين، وبحساب مقنن، لا يختلف ولا يضطرب.
والمعاصرون من أهل العلم، يربطون بين هذا كله في تنوع لا تناقض فيه، ليؤكد لهم ما وصلوا إليه من الحقائق الدالة على أن لكل ذرة فما فوقها، حسابا خاصا بها.
فهذا التنوع الذي يتسع لكل درجات الفهم للحقيقة الواحدة، ليصلها جميعا باليقين من وجوه كثيرة، لا يقدر البشر أن يحققوه لمعانيهم بحال من الأحوال.
والقرآن مهما تتنوع الصيغ في كلماته، فهي دائما تصلنا بمدلولاتها العملية في الوجود كله، وصلا دائما لا انقطاع له، لأنه قائم على الحق الذي لا يختلف، واليقين الذي لا يزول.
وانظر – مثلا – إلى قول الراغب الأصفهاني عن قوله تعالى «وهم من كل حدب ينسلون»
96 : الأنبياء
الأصل في الحدب حدب الظهر، يقال ناقة حدباء، ثم شبه به ارتفاع من الأرض.
فكأن الراغب، نظر إلى أن قوله تعالى «من كل حدب» أي من كل مكان مرتفع (35).
ولكن أهل العلم من المعاصرين يعلمون يقينا أن الأرض كروية الشكل، فكلمة حدب تتسع لكل مكان من الأرض، وقوله تعالى ينسلون يتسع، لكل مشاهد النزول من أعلى إلى أدنى، وهذا هو شأن الزحام حين نشاهده، من بعيد.
ولوجاء هذا المشهد في كتاب البشرى، يحدثنا اليوم عن كروية الأرض ما التفت صاحبه إلى تضمين هذا المعنى في كلمة واحدة هي كلمة (حدب) فربما قال من كل صوب، أو من كل سبيل، ولم يذكر الحدب، على وجه التحديد.
وتتنوع الكلمة في مثل هذا الشأن حيث يقول الله تعالى :
«يأتين من كل فج عميق»
27 : الحج
فأنت ترى أن كلمة عميق بعد كلمة فج أفادت معنى التكور، على نحو من الوجوه، العمق تصحبه الاستدارة تعني الانثناء والانحناء ولهذا قالو:
الفجاج جمع فج منها الظليم أي ذكر النعام، يبيض بيضة واحدة، وجاء في شعرهم
بيضاء مثل بيض الفجاج
وقالوا حافر مفج مقبب
وقالوا واد أفجيج أي عميق وربما سمي به التثني في الجبل (36)
فها نحن نرى أن حقيقة استدارة الأرض، لم تفارق أي كلمة من الكلمات التي لم تأت أصلا في هذا الشأن، وإنما جاءت في أمور أخرى، وفي صيغ لغوية شديدة التنوع، مما كان يحتمل معه أن لا تتسع لمثل هذه الحقائق البعيدة عن سياقها وقصدها.
انه كلام الله وكفى.
وإعجازه يحمل معه، دفعا متواصلا لكل حقائق التقدم العلمي.
أما المنهج الثاني: فهو المنهج التركيبي، الذي ننظر من خلاله، إلى عدد المواضع الذي يخص كل قدر من الكلام في القرآن كله، فمهما تكثر مواضع كلمة قرآنية فهي واحدة في نصها، ولما كانت كثرة مواضعها، مما يظن معه الاختلاف أو التناقض، فهي في هذه الحالة تتصل بوجوه متجددة، ولكنها مترابطة في حركة واحدة لا تنقطع، مع الترتيب المعجز في مقاصدها (37).
وهذا وجه آخر من وجوه التقدم العلمي المتواصل الذي يحمله معه إعجاز القرآن.
- والخطابي يصف المنهج المعنوي حيث يقول:
في إعجاز القرآن، وجه آخر، ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم.
وذلك صنيعه بالقلوب، وتأثيره في النفوس، فإنك تسمع كلاما غير القرآن، منظوما أومنثورا، إذا قرع السمع، وخلص له إلى القلب، من اللذة والحلاوة، في حال، ومن الروعة والمهابة، في أخرى، ما يخلص منه إليه.
- ثم يتجه إلى المنهج التركيبي فيقول:
إنما يقول الكلام، بهذه الأشياء الثلاثة فقط:
لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لها ناظم.
وإذا تأملت القرآن، وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ، أفصح ولا أجزل، ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظاما أحسن تأليفا، وأشد تلاؤما، وتشاكلا من نظمه.
- تم يربط بين المنهج المعنوي، والمنهج التركيبي – معا – فيقول :
وأما المعاني فلا خفاء على أي عاقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها، والترقي إلى أعلى درجات الفضل في نعومتها، وصفاتها (38).
ومعاني القرآن زاجرة بحقائق العلم، التي تفتح الطريق دائما أمام التقدم في آفاقها.
ثم يبين الخطابي أن الأصول الثلاثة وهي اللفظ الحامل، والمعنى، الذي يقوم به، والرباط الذي ينظمه، لا تأتي بتمامها إلا في كلام الله، الذي أحصى كل شيء عددا، وأحاط بالكلام كله علما (39).
والخطابي في هذا القدر من كلامه، ربط بين الوحي القرآني في معانيه وتراكيبه، وبين وقائع الوجود كله، وبهذا جاءت السنة ضمن وقائع الوجود.
ولكن السنة أصل تشريعي، مصاحب للأصل الأول وهو القرآن، فلو خصها بالذكر، وبحث في تركيبها بالنسبة لآياته وسوره، لزادنا بيانا، على بيان، وتم هذا الكلام القيم من كل وجوهه.
فلعله جاء بهذا الطلب في موضع آخر من كلامه، ولم أطلع عليه.
ولعله أكتفى بالاجمال حيث كنا نحتاج إلى التفصيل.
ومهما يكن من أمر، فإننا بحاجة إلى كلام الخطابي، في عصورنا هذه المتأخرة، أكثر مما احتاج إليه المتقدمون.
وهذا من روعة هذا الكلام، وكثرة وجوه العلم فيه.
- مع الباقلاني ورأيه في الإعجاز بين القرآن والسنة:
إن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في الفصل الوصل، والعلو والنزول، والتقريب والتبعيد، وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم، ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع.
أما القرآن فهو على اختلاف فنونه، وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة، والطرق المختلفة فهو يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناسب، والمتنافر في الإفراد إلى حد الآحاد.
وهذا أمر عجيب، وتبين به الفصاحة، وتظهر به البلاغة، ويخرج معه الكلام، عن حد العادة، ويتجاوز العرف (40).
ونقف عند قول الباقلاني (إن القرآن يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناسب، والمتنافر في الإفراد إلى حد الآحاد).
ومن معاني هذا الكلام للباقلاني رحمه الله، أن القرآن كله، في جملته وتفصيله، متجدد في صلاته، فلكل قدر من كلماته، تفرد في مبناه ومعناه، وحركة دائبة في مواضعه، من الآيات والسور، فلا ينبغي أن يؤمن الناس ببعض منه ويكفروا ببعض، وإنما كلام الله، وما يفسره، ويطبقه، من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ملزمان للناس كافة، بوجوب العمل بهما معا، إلى يوم القيامة.
ولكن الباقلاني، جاء يخطب من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب من كتبه إلى ملوك العالم، وقال : (قد بينا أنّا إذا وازنا بين خطبه ورسائله وكلامه، وبين نظم القرآن، تبين من البون بينهما، مثل ما بين كلام الله عز وجل، وبين كلام الناس).
فلا معنى لقول من ادعى، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة وإن كان دون القرآن في الإعجاز (41).
وهذا الكلام يقتضينا أن نتبين معا أن السنة القولية والعملية والتقريرية، ليست داخلة في كلام البشر، ولا أفعالهم، ولا تقريرهم، وإلا كان الإلزام بهذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم، كالإلزام بما صدر من غيره من سائر الناس، سواء بسواء.
وما كان لمؤمن بالله ورسوله، أن يدعي هذا أو يعتقده، بحال من الأحوال.
«قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» 88 : الإسراء
وكيف يتصور أحد ذلك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قراه) (43).
فالآية السابقة من سورة الإسراء، جاءت ببيان عجز البشر أن يأتوا بمثل القرآن.
أما الحديث النبوي السابق، فقد جاء ببيان عجز البشر أن يأتوا بمثل السنة، لأنها تتضمن حقائق تشريعية جديدة بالنسبة، للحقائق التشريعية في القرآن.
فهكذا نعلم أن عجز البشر، أن يأتوا من عند أنفسهم بمثل كلام الله، كعجزهم أن يأتوا من عند أنفسهم بمثل السنة، التي خص الله بها نبيه من بين عباده جميعا.
عن أبي إمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي، مثل الحيين ربيعة ومضر، وإنما أقول ما أقَوَّلُ) (44).
إن هذه الكلمة الجامعة في هذا الحديث النبوي «إنما أقول ما أقَوَّلُ» ترد الإعجاز في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الفعل الإلهي، في نطاق الله تعالى، لعبده وخاتم رسله بما انطقه به.
يقول الله تعالى : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». 3 – 4 : النجم
ولكن الباقلاني – رحمه الله – وقف عند خوفه من أوهام الملحدين، أن يدعوا أن القرآن، من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا وزن لهم، ولا ينبغي أن نسكت عن الحق من أجلهم.
ولقائل أن يقول بعد ذلك أن – الباقلاني رحمه الله –نظر إلى ما تفرد به القرآن من الفصاحة التي لا ينبغي أن تجدها في أي كلام غيره.
والحق مع الباقلاني في ذلك، ولكن الله تعالى، جعل للإعجاز القرآني، آثارا، بكل مقوماتها القولية، والعملية، والتقريرية.
ولهذا جاءت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، متصلة بأصول قرآنية، ولكنها منفصلة في الحديث تفصيلا لم يأت بنصه في القرآن.
فقوله تعالى : «يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» 157 : الأعراف
يتسع لكل المعاني السابقة، من حقيقة الإلزام الإلهي، بالقرآن زالسنة معا، كما يتسع لقوله صلى الله عليه وسلم (ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي).
فقد شاء الله أن يحرم، كل الخبائث إجمالا كما جاء في القرآن، وأن يحرم رسوله بما علمه الله، وبما أذن له، أكل لحم الحمار الأهلي، كما جاء هذا التفصيل في السنة.
وبذلك نظل ملتزمين بالوحي الإلهي، من قرآن وسنة، التزاما دائما.
هذه الأمور لم يتحدث عنها الباقلاني، ولو تحدث عنها، وهو أهل لذلك، لما وقف عند حد الخوف، مما يدعيه الملحدون، بل لغلبهم على أمرهم، بهذا التنسيق المعجز، بين معاني القرآن، ومعاني السنة، وهو أمر لا يقدر على أن يأتي من شاء من عباده، ويجعله ملزما للناس كافة، إلا الله وحده.
فهذا كله يؤكد لنا أن الإعجاز في حقيقته الأساسية، إنما هو في كل أفعال الله، أقواله، وإحاطته بكل شيء، من خلقه ووحيه.
ثم إن الباقلاني – رحمه الله – حيث وقف من الناحية اللغوية وحدها، بما هو متعلق بها من الفصاحة، والبلاغة، لم ينفذ إلى المضمون المعجز الذي جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ذلك أن الباقلاني، ضمن كتابه، عددا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، محاولا بها أن يؤيد رأيه في أن الفرق، بين القرآن، والحديث النبوي هو كالفرق، بين كلام الله، وكلام سائر الناس (45).
ثم ذكر الباقلاني أنه يخشى أن يقول إن السنة غير كلام سائر الناس، حتى لا يظن الملحدون أن القرآن نفسه، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم !!
وفي الحقيقة أن كلام الله تعالى، له من الفضل على سائر الكلام، ما ليس لغيره.
ولكن الله شاء جلت حكمته، أن يلزمنا بوحيه القرآني، ثم بوحيه في الحديث النبوي، الزاما واحدا، لا اختلاف فيه، من حيث وجوب اتباعه، والاحتكام إليه، والتسليم له.
فهكذا نعلم، أن الحديث النبوي، مع سائر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريراته، كل هذا له حظه من الإعجاز، بمعنى أنه لا يقدر أحد غير خاتم رسل الله، أن ينطق به، أو يكلفنا بالأعمال المستفادة منه.
ولو كان كلام النبوة، بالنسبة لكلام الله، مثل كلام سائر الناس، لاستطاع مسيلمة الكذاب، وسجاج، والأسود العنسي، أن يؤيدوا دعواهم الكاذبة، بألوف القصائد الرائعة، والخطب الفصيحة، ولو انتحلوها، انتحالا، وأعانهم عليها، أتباع كثيرون.
ولكن صلة السنة النبوية، بكلام الله، وهي صلة عقدها الله تعالى، هي مناط الإعجاز في السنة.
ولولا ذلك لكانت الدنيا بأسرها، بوسائل اعلامها الحديثة، ومطابعها ومكتباتها، وفلاسفتها، وعلامائها، قادرة أن تلزمنا بهذا كله، أو بشيء منه، أو تقنعنا بأنه كلام لا ريب فيه، ولا مجال لأي خطأ فيه، ولكن هيهات هيهات، ان كلام الله وسنة رسوله، مصدران تشريعيان لا خطأ فيهما البتة، وهذا هو الجانب العملي في إلزامهما للناس كافة، إلزاما يقوم على الاقناع بلا قهر ولا تسلط، لأنه هو الحق الذي لا باطل فيه، وهذا هو سر تغلغلهما في القلوب، ورسوخ حبهما الدائم في النفوس.
أما كل النظريات الفلسفية، فهي تختلف عن شروحها، ويعارضها الكثير من تفسيراتها، بوعي من المفسرين،أو بغير وعي منهم، لأن كل الناس يكتشفون فيهما الخطأ بعد الخطأ، والتناقض مع حقائق الوجود، بعد التهافت.
وبذلك ندرك الأصل العملي، للحدود الفاصلة بين الإعجاز في كلام الله وسنة رسوله، وبين نظريات البشر، وما يتداعى عليها من شروحها القولية، وتطبيقاتها العملية، وسائر ما يقر عليه أصحابها بعضهم بعضا، من أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم.
ولننظر في خطبة أيام التشريق، التي ضمنها الباقلاني كتابه، ليبني عليها وعلى غيرها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأيه الذي ناقشناه – معا – في هذا السياق.
(يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم.
قالوا : في يوم حرام، وشهر حرام، ويلد حرام.
قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم رحام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه.
ثم قال : اسمعوا مني تعيشوا (ألا لا تظالموا، ألا لا تظالموا، ألا لا تظالموا)
ألا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة، كانت في الجاهلية، تحت قدمي هذه، إلى يوم القيامة، وان أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا، في بني ليث، فقتله هذيل.
ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وان الله عز وجل، قضى أن أول ربا يوضع، ربا العباس بن عبد المطلب.
لكم رؤوس أموالكم، لا تُظلمون ولا تَظلمون.
ألا وإن الزمان، قد استدار كهيئته، يوم خلق الله السموات والأرض، قم قرأ «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم».
36 : التوبة
ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
إلا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكنه في التحريش بينكم.
فاتقوا الله عز وجل في النساء، فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وان لهن عليكم، ولكم عليهن حقا، أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن، فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، ضربا غير مبرح.
ولهن رزقهن، وكسوتهن، بالمعروف، وإنما اخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن، بكلمة الله عز وجل.
ومن كانت عنده أمانة، فليؤدها إلى من أئتمنه عليها.
وبسط يديه فقال : ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت ثم قال : ليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ أسعد من سامع (46).
إن الباقلاني – رحمه الله – نظر إلى ناحية الفصاحة اللغوية وحدها، كما يفهمها هو ومعاصروه، في القرن الرابع الهجري، وكل ما فيها هو فخامة الديباجة، واختيار الغريب من الألفاظ، وإظهار البراعة في سبك المعاني، وحسن صياغتها.
ولو نظر إلى صلة التي عقدها الله تعالى، بين القرآن والسنة، لفتحت أمامه، كنوز الحقائق، التي لا سبيل إليها في غير الوحي الإلهي.
لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، عن المكان والزمان، وعن الحلال والحرام، وصلتهما بما يهتم به الناس، من دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
ثم بين حقائق العدل، حيث نهى عن الظلم، وبين حرية الإنسان في أن يحتفظ بأمواله، فلا يأخذها أحد، عن غير طيب نفس منه.
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أمره أن يضع دماء الجاهلية، وربا الجاهلية، وأمره أن يخص بالذكر دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا العباس بن عبد المطلب.
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن رؤوس الأموال، هي الأصول التي أمر الله أن يحتفظ بها أصحابها، ليستقبلوا بها أيامهم المقبلة، في الحياة الإسلامية.
وهنا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن الزمان قد استدار، كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض.
واستدارة الزمان، شيء يعرفه في تاريخنا المعاصر، كبار العلماء الذين يعرفون تكوين أجزاء السموات والأرض وما بينهما، ومكوناتهما الدقيقة، على مستوى الذرة، والخلية، وصلة كل شيء من ذلك بالزمان والمكان.
وهؤلاء العلماء، هم الذين يدركون سر العظمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الزمان استدار).
وقد تكون الاستدارة بمعنى الحركة، التي علمنا أخيرا أنها دائرية، كما أن مكونات كل شيء في خلق الله دائرية الشكل، والهيئة، وبذلك ندرك سر العظمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، (إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض).
وهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة.
وهذه الآية تأتي من حيث الترتيب في المصحف، في بداية الترتيب لأربعة آيات، جاء فيها كلها، قوله تعالى : «ذلك الدين القيم» موصولا بباب جديد من أبواب العلم في القرآن كله، مع كل آية بذاتها، من بين هذه الآيات الأربع.
- إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا إلى قوله تعالى : «ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» 36 : التوبة
إن الزمان من أهم حقائق الغيب الذي يواجهه الإنسان، منذ شعوره بذاته، فوق الأرض، وتحت السماء.
- «ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 40 : يوسف
فلما تم بيان علاقة الإنسان بالزمان، في آية التوبة، جاء في الآية السابقة من سورة يوسف، بيان أول ما يحتاج الإنسان من أعلى أنواع المعرفة، وهو معرفته لإلهة الحق، وهو الله لا إله غيره.
- «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 30 : الروم
لقد جاءت هذه الآية في ترتيبها بين الآيات الأربع التي نجد فيها قوله تعالى «ذلك الدين القيم» لأنها بينت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، مكلف من ربه أن يتبع دين الله الذي فطر الله عليه كل المجتمعات الصالحة، فيما خلا من التاريخ قبله، وفطر عليه السماوات والأرض، وسائر خلق الله الذي لا تبديل له.
فها هنا يظهر لنا النظم الإلهي للزمان والمكان، في حقيقة جامعة.
- «فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله» 43 : الروم
إن هذه الأيات الأربع، بترتيبها القرآني، العظيم في إعجازه، قد انتهت بنا مع آخر آية فيها، إلى يوم القيامة، وبينت بنا مع آخر آية فيها، إلى يوم القيامة، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم، مكلف أن يستمر على العمل بدين الله، لا لنفسه وحده، وإنما لكل الناس، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
فلهذا وجدنا خطبة أيام التشريق، قد أخذت بعد قراءة الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة، الطريق المنتهي إلى بيان النبي عن الحرب بين المسلمين بعضهم بعضا، وبيان أن الشيطان قد يئس أن يعبده المسلمون، بعد أن أسلموا، ولكنه يحرش بينهم، أي يوقع بينهم العداوة والبغضاء.
ولأن المسلمين يتكاثر عددهم، منذ عهد النبي إلى قيام الساعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله في النساء، ثم بين حقوق الرجال على النساء، وحقوق النساء على الرجال، ثم أمر بالأمانة، حتى أنهى خطبته بقوله : ألا هل بلغت (ثلاثا)، وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أسعد من سامع.
إن هذه الخطبة، تقوم على ترابط وثيق بين قضايا كل مكان وزمان، كما جاءت مجملة في القرآن، وكما فصلتها هذه الخطبة في السنة أو أن حاولنا – معا – أن نصيب بعض الحقيقة أكثر من ذلك، فإننا نقول : (إن معاني القرآن والسنة، كما ظهرت معجزاتهما معا، في الآيات الأربع التي فتحت لنا هذه الخطبة أبوابها، وكذلك في الخطبة ذاتها، إنما هما متفاعلان تفاعلا لا يقدر على تنسيق أجزائه، وربطه بتأثيراته الدائمة، في جملة الحقائق الخاصة به، في كل زمان ومكان، إلا الله وحده لا شريك له).
وهذه الحقائق لا تخفى على الباقلاني الذي تعلمنا منه، كيف نفكر في الإعجاز.
ولكنه كان يتحدث عن النص القرآني في ذاته، لا عن تأثيره العملي في الحياة، وهو معجز بنصه وتطبيقاته العملية معا، غير أن هذه الأخيرة لا يتم الكلام عنها، إلا مع الكلام عن السنة.
فلا ريب في أن التقدم العلمي، بكل أنواعه، يجد آفاقه الرحيبة، في الربط بين القرآن، والسنة النبوية، والسنة الكونية، بما يتفق مع كل قضية بذاتها من قضايا العلوم.
- مع الخطيب الإسكافي في بيانه للآيات المتشابهات:
في كتاب (درة التنزيل وغرة التأويل، في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز) يحدثنا الخطيب الإسكافي (47) عن التركيب القرآني، المتجدد المقاصد، مهما تتشابه آيات القرآن.
وننظر إلى ثلاث آيات متشابهات لنرى كيف تحدث عنها الخطيب الاسكافي.
- «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 62 : البقرة
- «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 69: المائدة
- آية سورة الحج وفيها قول الله تعالى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة» 17 : الحج
يقول الاسكافي – رحمه الله – للسائل أن يسأل فيقول : هل في اختلاف هذه الآيات، بتقديم الفرق وتأخيرها ورفع الصابئين في آية، ونصبها في أخرى، غرض يقتضي ذلك؟
والجواب أنه (لابد من حكمة هناك تطلب، فإذا أدركتموها فقد ظفرتم، وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك بل جهلتم)(48).
- ونلخص ما قاله الاسكافي عن ذلك فنجده يبين لنا أن ترتيب المقاصد لآية البقرة قد تم على أساس الفترات التاريخية التي جاءت فيها الكتب السابقة بحسب فترة كل كتاب منها.
أما الصابئون فهم قوم يتقلبون من دين إلى آخر، ولهذا جاء ذكرهم بعد ذكر أهل الكتابين.
- أما الترتيب في آية المائدة فقد تم على أساس كل أمة من هذه الأمم فالصائبون وجدوا قبل النصارى، ولهذه ذكروا قبلهم، وقد جاءت الصابئون مرفوعة على أن النية فيه التأخير بعد خبر ان وتقديره ولا هم يحزنون والصابئون كذلك فهو مبتدأ والخبر محذوف (49).
- أما آية الحج فقد ذكرت فيها هذه الأمم، وفق أزمنتها كذلك، مع تأخير الذين أشركوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم، وجاءهم بالدعوة الخاتمة إلى دين الله تعالى.
وبانتهاء ملحوظات الاسكافي، رحمه الله يتبين لما أن هذه الآيات الثلاث قد جاء في أولها ترتيبا وهي آية البقرة قوله تعالى :
«فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».
بينما آية المائدة وهي الثانية، في ترتيب المصحف، قد جاء فيها قوله تعالى:
«فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ولم نجد فيها «فلهم أجرهم عند ربهم»
فتبين بذلك أن آية البقرة لمن بقى على دينه منهم ولم يمت سواء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه، أو لم يدركه، وإنما كانت مؤمنا به، ومات على ذلك قبل بعثته، على أساس انه قرأ عنه في التوراة والإنجيل.
وبذلك تكون الآيات قد صورتا حالة هؤلاء جميعا، في حال موتهم أو حياتهم ما داموا كما قال الله عنهم «من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا».
والإيمان بالله واليوم الآخر، يقتضي أن يكونوا أهل توحيده، وأن يكونو مؤمنين ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم على هذا الاعتقاد سواء أدركوه فآمنوا به أو ماتوا قبله مؤمنين، بأنه مبعوث لا محالة.
ومن الدليل على ذلك أن الآية الأخيرة، في ترتيب المصحف، وهي الآية الحج جاء بها قوله تعالى :
«إن الله يفصل بينهم»
ولم نرى بها تأمينهم من الخوف والحزن، كما جاء في آية البقرة وآية المآئدة.
فهذا يدل على أن آية الحج، تخص المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء جميعا.
ومع أن هذا الفهم يقوم على مجرد الاجتهاد في الرأي إلا أن النصوص هذه الآيات المتشابهات، تؤكد ثلاثتها ما ذهبنا إليه والعلم كله عنده تعالى.
ثم ان مما يؤكد هذا أيضا، هذا الحديث الذي يبين لنا، سبب نزول آية البقرة.
فقد روى مجاهد قال : قال سليمان الفارسي رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، قلت يا رسول الله : كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك تبعث بيننا، فأنزل الله هذه الآية (50).
وهكذا نفهم ان ما جاء في هذه الآية إنما هو أمر مخصوص، يخص حالة بعينها هي حالة الذين آمنوا بالكتب الإلهية السابقة وعملوا بها، وعرفوا منها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به ثم ماتوا قبل بعثته.
وهكذا نعلم أن السنة تضع لنا أي حقيقة قرآنية، في صيغة مترابطة مع الواقع العملي للحياة المتجددة وهذا المنهج يفتح آفاق التقدم العلمي، حيث يعلمنا كيف ترتب أحداث التاريخ ونترقب، ما هة غيب منها حتى يجئ أوانه.
ولكن الاسكافي – رحمه الله – لم يربط اجتهاده في فهم الآيات المتشابهات بما يفسرها من السنة.
ولو فعل الاسكافي ذلك، لكان كتابه أكثر نفعا، وأوضح بيانا، ولكل درجات مما عملوا.
والحمد لله رب العالمين.
- مع تاج القراء الكرماني في نفس التكرار عن القرآن
التكرار في كلام البشر، هو استعمال قدر من الكلام، مرات كثيرة، حيث تكفي مرة واحدة.
أما القرآن فإنه كل صلة بين الكثير والقليل من كلماته، دائمة التجدد، موصولة التفرد.
وكلام هذا شأنه، لا مكان فيه التكرار وإنما هو الإحكام والتفصيل، الذي لا يقدر على مثله إلا الله وحده.
ولقد بين تاج القراء الكرماني بعض الأصول التي يقوم عليها هذا النظم، الذي لا تكرار فيه، مهما تتعدد، مواضع الآيات ومواضع أجزائها في جملة القرآن وتفصيله (51).
فمما بين الكرماني، أنه ينفي التكرار عن الكلمة القرآنية المتعددة المواضع، انه نظر في قوله تعالى :
«صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين»
7 : الفاتحة
ثم قال :
إن كلمة (عليهم) لا تكرار فيها، لأن كل واحد من موضعيها متصل بفعل غير الآخر، وهو الانعام والغضب.
فإذا نظرنا إلى الأسس التركيبية، التي تقوم عليها هذه الحقيقة، التي تحدث عنها الكرماني، فإننا نعود – معا – إلى القواعد الثلاث التي تحدثنا عنها من قبل.
1-فكلمة (عليهم) ثابتة على نصها مهما تهدد مواضعها.
2-وهذه الكلمة متصلة بجديد من المقاصد، مع كل موضع نجدها به.
3-وهناك إعجاز في ترتيب هذه المقاصد لأن قوله تعالى :
«صراط الذين أنعمت عليهم»
قد اتصلت فيه كلمة عليهم (بالإنعام) وهو موضعها الأول في سورة الفاتحة.
أما قوله تعالى :
«غير المغضوب عليهم ولا الضالين»
فقد اتصلت فيه كلمة عليهم بالغضب والضلال
ولقد جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي (52)
فبذلك ندرك سر الإعجاز في ترتيب الإنعام قبل الغضب.
والنظر في ترتيب كل كلمة قرآنية متعددة المواضع، يعلمنا البحث العلمي، في مكونات السموات والأرض، وكيف نجد كل نوع من أنواع الخلق، ثابتا على نوعه شكلا ومضمونا، ثم نجده متجدد الصلة بكل موضع من مواضعه في الوجود ثم نجده مرتبا في مجتمع يخصه.
ويتحدث الكرماني عن مواضع قوله تعالى «من شر» كما نجدها في سورة الفلق، حيث ارتبطت في الآية الثانية بالشر كله حيث قال تعالى «من شر ما خلق».
ثم تبع ذلك ما هو أصغر مما قبله وأكبر مما بعده، حيث جاء ذكر القبر إذا أظلم. «ومن شر غاسق إذا وقب» ثم تبعه أصغر منه وأكبر مما بعده حيث جاء ذكر الساحرات وهن يجمعن بين الحمد، وبين عمل من الأعمال الناتجة منه وهو السحر.
«من شر النفاثات في العقد»
وأخيرا جاء ذكر الحاسد إذا حسد، لأنه لم يبلغ ما بلغته النفاثات في العقدإذ جمعن بين الحسد والعمل به، بينما هذه الآية الأخيرة جاء فيها الاستعاذة بالله من الحاسد إذا حسد، فهذا أخف لأنه فيه شرطا إذا وقع فعلا، فقد سبقته الاستعاذة منه، وكهذا تأخير ترتيبه، حيث ختمت هذه السورة بقوله تعالى : «ومن شر حاسد إذا حسد»
أما الذي جعلنا نفهم أن الغاسق إذا وقب هو القمر إذا دخل في الظلام، فهو حديث نبوي صحيح الاسناد.
عن عائشة رضي الله عنها قالت، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر لما طلع فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب (54).
فهذا تفسير لمعنى من معاني الشر وبيان لسر من أسرار الخلق، هو أن في كثير من المخلوقات خير من وجه وشره من وجه آخر.
فالقمر إذا هو منير فهذا مما أودع الله فيه من الخير، بينما هو إذا ذهب نوره، كما هو شأنه عند قيام الساعة، فهذا شر على الكافرين.
ولو ربط الكرماني بين تفسيره لنظم القرآن وما فيه من نفي التكرار، عما تتعدد مواضعه من آياته وأجزائها، وبين ما يفسر من السنة لزادنا بيانا كما رأينا.
أما أصول التقدم العلمي، التي يقدمها لنا إعجاز القرآن، وما يفسره من السنن النبوية، والسنن الكونية، فهي – هنا – في هذا الترابط بين الحقائق العلمية المتنوعة، التي نجدها في علوم بشرية مختلفة، مثل الفلسفة التي تخص بالبحث في الخير والشر، ومثل الفلك الذي هو علمي كوني مستقل بذاته، ومثل الحسد الذي يستقل به علم الاخلاق.
فالربط بين هذه العلوم كلها، في علاقات مترابطة، نوع من أنواع الإعجاز القرآني، الذي يعيد التفكير العلمي إلى فطرته الأصلية من الوحدة الجامعة، حيث لا مكان للتناقض بين الحقائق، وإن تفرقت بها الاختصاصات العلمية المختلفة.
- مع عبد القاهر الجرجاني، ونظريته في نظم القرآن
تتلخص نظرية عبد القاهر الجرجاني في الإعجاز القرآني، يعود في جملة وتفصيله إلى النظم (55).
والنظم كما تبينه عبد القاهر الجرجاني في آيات القرآن وسوره، تجتمع فيه كل وجوه الإعجاز، بحيث لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، مع أن البشر أنفسهم لا تقاس بمثله، مع أن البشر أنفسهم لا تقاس بلاغتهم إلا من خلال نظمهم لكلامهم فهيهات أن يأتي المخلوقون بمثل نظم الخالق لكلامه !!
يقول عبد القاهر الجرجاني رحمه الله معلوم ان ليس النظم سوي تعلق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض.
والكلمة ثلاث، اسم وفعل وحرف، وللتعلق فيما بينها، طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام:
- تعلق اسم باسم.
- تعلق اسم بفعل.
- تعلق حرف بهما.
ثم يسهب عبد القاهر – رحمه الله – في بيان نظريته، مبينا أن أسبابها هو حسن التصرف في وجوه النحو.
ويصل عبد القاهر رحمه الله، بين وجوب نظرنا للمعاني المرجدة للكلمات، مع نظرنا للنواحي التركيبية، في نظم الكلام، فيقرر أن المزية للكلام إنما هي في نظمه باعتبار ملاءمة معنى اللفظية التي تليها، وليس الفضل والمزية في الكلام أن ننظر في مجرد معناه (56).
وخلاصة ما يقرره عبد القاهر.
- انه لا فصل بين الكلام ومعناه، ولا بين الصورة والمحتوى.
- ان البلاغة في النظم لا في الكلمة المفردة ولا في مجرد المعاني.
- ان النظم هو توخي معاني النحو، وأحكامه وفروقه فيما بين معاني الكلم.
- ولذلك أخذ عبد القاهر يعرض لوجوه تركيب الكلام، وفق أحكام النحو، مستنبطا الفروق بينها، عارضا لأسرار المزية والحسن والبلاغة فيها (57).
ولقد اعترض طائفة من العلماء المعاصرين له، على أساس أن النحو لا بد منه في كلام الله، ثم في كلام البشر.
ولكن الجرجاني بين لهم انه لا يرى مجالا للنظر في النظم، إلا فيما يتعلق بالنحو كما سبق في كلامه من قبل، واحتج بأن عمل النحو في الكلام المعجز وغير المعجز لا يغير حقيقة كل منهما.
ثم نجد الجرجاني رحمه الله ينظر في قول الله تعالى :
«وقيل ي أرض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي وغيص الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين».
ثم يقول ما معناه ان الإعجاز يتجلى في ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض.
ثم يقول انظر في كلمة (ابلعي) واعتبرها وحدها من غير أن ننظر في ما قبلها وما بعدها، في السياق والنظم حتى تظهر البلاغة، ويتجلى الإعجاز ونقول – معا – في أثناء عرضنا لكلام الجرجاني، وإن كلمة ابلعي معجزة في ذاتها، لأنها تدلنا على حقيقة المياه الجوفية، قبل اكتشافها أخيرا.
والجرجاني لا ينفي الإعجاز في كلمات القرآن وهي فرادى، وإنما يقول إن الإعجاز يزداد أثره، وتظهر مزاياه كاملة في النظم والترتيب.
فهو يقول:
هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي بمكانها من الآية (58).
والحق مع الجرجاني في ذلك، فالنظم يزيد وجوه الإعجاز، لأنه يجمعهما كلها في صعيد واحد.
ولكن الحقيقة، ان جوه النظم في القرآن، تظهر في الكلمات وهي فرادى كما تزداد في الكلمات وهي متصل بعضها ببعض، ثم إذا أمعنت النظر في أجزاء الكلام من أحرف وجملة – صغيرة أو كبيرة وجدنا في كل شيء من ذلك – وجوها من الإعجاز يدل بعضها على بعض.
ولقد لخص الفخر الرازي كتاب دلائل الإعجاز تحت عنوان جديد هو نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز.
فحذا حذو الجرجاني في قوله
النظم عبارة عن توخي معاني النحو بين الكلم (59).
ثم ختم كتابه هذا بفصول بين فيها أن القرآن لا تكرار فيه (60).
وهنا نعود إلى مناقشة عبد القاهر الجرجاني، في اتخاذه علم النحو سببا أساسيا في تحقيق الإعجاز في نظم القرآن.
ان ما وصل إليه الفخر الرازي في نهاية تلخيصه، لنظرية النظم للجرجاني وهو نفيه للتكرار في القرآن، هو الباب الذي ندخل منه إلى سر الإعجاز في نظم القرآن.
وسنرى أن هذا السر، هو مواضع الكلم.
ذلك أن معاني النحو وتراكيب الصرف في كلام البشر يعملان معا –على توزيع حروف اللغة، في مواضعها المتجددة من الكلمات، وجمع بعضها هنا بينما هي متفرقة هناك.
وبذلك نجد حروف الأبجدية العربية وهي بضع وعشرون حرفا هي التي تتكون منها مئات الألوف من الكلمات.
فالنحو يربط المعاني.
والصرف يتولى وضع كل حرف بموضعه وترتيبه في كل كلمة – ثم تتخذ كل كلمة موضعها – كذلك – بين الكلمات وبذلك يتفاضل كلام البشر بمقدار مناسبة كل كلمة لموضعها بين الكلام وحسن نظمها فيه.
فإذا خلا الكلام البشر من الحشو كان بعيدا عن التنافر في موضع كلماته، فهذا مجال الفضل بين أي كلام بشري وغيره من سائر كلام البشر (61).
غير أن البشر، لا يستطيعون أن يجعلوا كل كلمة – من كلماته، ثابتة على مبناها ومعناها، وهذا أول عائق يحول بينهم وبين التحكم الكامل، في نظم كلماتهم فيما بينها، على نفس مستوى نظم الكلمات، من الحروف، التي تتكون منها.
ونستطيع أن نفهم ذلك، بأن نعلم أن الله جعل الكلام كله، من حيث النظم على ثلاثة أحوال.
أولا: كلام الله تعالى، وفيه تتحرك الحروف بمواضعها من الكلمات، ثم تتحرك الكلمات بمواضعها فيما بينها، بيث لو مضينا مع كل كلمة قرآنية واحدة وقد جاءت بمواضع كثيرة، فإنها تكون ثابتة على نصها الواحد، ثم تكون متجددة الارتباطات بكل موضع وأخيرا تكون مرتبة فيما تقدم لنا من المعلومات، التي تبين لنا ترتيبها، ما يتصل به من حقائق الوجود كله.
وهذه شروط معجزة لا ينبغي أن نجد مثلها في كلام البشر.
ثانيا: كلام النبوة، في كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، من كلمات الوحي التالي للقرآن، وهو السنة، وهذا النوع من الكلام ليس من الكلام العادي لعامة البشر، ولكنه هو كلام النبوة، الذي أنطق الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، بوصفه خاتم أنبيائه ورسله.
ومن معجزات كلام النبوة، من حيث التركيب أن أي كلمة جاءت في القرآن ثم جاء ما يماثلها في السنة، فإنها تربط بين ما يتصل بها من مقاصد القرآن والسنة، برباط يظهر معه التنوع في كل منهما، مع وحدة – الأصول – المعلقة بمعانيها معا، بحيث يظل الناس بحاجة دائمة إليها معا.
ولننظر إلى كلمة – الجار – بقوله تعالى :
- «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل»
36 : النساء
- «وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إن برئ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب»
48 : الأنفال
فلهذه المواضع القرآنية الثلاثة، التي جاءت بها كلمة الجار وكلمة جار، قد أجملت لنا حقوق الجيران الصالحين، ونفرتنا من جوار الشيطان لعنه الله.
ثم جاءت السنة، بتفصيل هذه المعاني المجملة، كما نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم.
- عز جارك وجل ثناؤك.
- لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره.
- الجار أحق بالجوار.
وقوله صلى الله عليه وسلم
- الحار أحق بسبقه (62)
وقوله صلى الله عليه وسلم
- الجار أحق بشفعة جاره
وقوله صلى الله عليه وسلم
- جار الدار أحق بالدار
وقوله صلى الله عليه وسلم
- من سعادة المرء الجار الصالح (63)
فلقد تفرد كل حديث من هذه الأحاديث، بإضافة حقيقة جديدة متصلة بحق الجار، وبذلك جاء في السنة، تفصيل ما أجمل في القرآن.
وهذا الترابط والتجدد، والتفاعل بين كلمات القرآن والسنة يجعل لحقيقة النظم القرآني امتدادا عمليا في السنة باعتبارها تفسيرا للقرآن ووحيا مصاحبا له.
ثالثا: كلام البشر نعمة من الله على عباده، ولكن الله حد له حدودا لا ينبغي له أن يتعداها.
وتلك الحدود، لا ينبغي النظم فيها، أن يعلو عن مجرد الحركة للحروف بمواضعها من الكلمات.
أما أن يكون للكلمات البشرية، مواضع متجددة الصلات، مرتبة الأهداف، على قدر ورود كل كلمة منها وتفرقها في ثنايا الكلام، فليس من ذلك شيء، وإنما هو وجه من وجوه الإعجاز القرآني، كما رأينا، من قبل,
وأما أن يكون للكلمات البشرية، امتداد متجدد في شروحها، فليس لها من ذلك شيء، وإنما هو شيء خص الله به السنة، باعتبارها تفسيرا لكلام الله تعالى.
هذه طائفة من أسس التركيب للوحي كله من قرآن وسنة، وهي تقوم على مواضع الكلمة بما فيها من صرف ونحو، وتقدير كمي وكيفي معا، لحركة الكثير والقليل من النصوص القرآنية، وتأثيرها العظيم في السنة، وفي صياغتها لنواحي العظمة في الحياة الإسلامية، على عهد النبي والذين معه.
ولقد فتح لنا الجرجاني هذه الأبواب جميعا، مع أنه وقف بنا قريبا من بدايتها.
وكلام الجرجاني عن النظم، يفتح للعلماء مجالات التقدم في اللغة العلمية، لأنه يعلمهم، كيف يتخلصون من الصعوبات التي تواجههم في الاتفاق على مصطلحات العلوم، التي تتغاير على قدر الاختلاف في مستويات الوصول إلى حقائق كل علم بين الباحثين فيه بسائر دول العالم.
بالإعجاز في نظم القرآن، وترتيب كلماته يقدم للعلماء دروسا لا يستطيعون الاحاطة بها، أو الوصول إلى مثلها، في تدوين مصطلحاتهم العلمية.
ولكن حسب هؤلاء العلماء، أن يتعلموا من القرآن كيف يفكرون في ترقيم مرات استعمال كل مصطلح علمي، وأن يرمزوا لكل مرة من هذه المرات، بما يفيد في بيان درجتها ونوعها من حيث الظن والافتراض أو اليقين العلمي وبذلك يكون لكل مصطلح علمي تاريخ مسلسل يستطيع الباحثون في مختلف فترات التاريخ أن يقفوا عنده، ويفيدوا منه.
وهذا قليل من كثير، يمكن أن يفيده العلماء، من الإعجاز في نظم القرآن، وترتيب كلماته، فضلا عن شروحه في السنة، ومما فيها من الترابط الكلي والجزئي، مع آياته البينات.
6-ابن حزم الأندلسي
وكلامه في القدر المعجز من القرآن
لقد كان لابن حزم رحمه الله موقف راجح في قضية القدر المعجز، من القرآن وسنعرض لهذه القضية، بشيء من البيان، ثم نعود إلى موقف ابن حزم منها (64).
والقدر المعجز من القرآن قضية مرتبطة بآيات التحدي التي جاءت لبيان عجز البشر، عن الاتيان بمثل كلام الخالق سبحانه وتعالى.
ومن ذلك قول الله تعالى :
«قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا»
88 : الإسراء
وهذه الآية تحمل معها الحكم القاطع في القدر المعجز من القرآن ذلك أن كلمة القرآن تطلق على الكثير والقليل من الآيات والسور.
يقول الله تعالى :
«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون»
204 : الأعراف
ويقول سبحانه :
«وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه»
61 : يونس
وهكذا نفهم أن أي قدر من القرآن يسمعى قرآنا
ويقول الله تعالى :
«وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله»
37 : يونس
وهكذا نعلم أن اسم القرآن، يطلق على القرآن كله، كما رأينا أنه يطلق على أي قدر منه.
فهذه قضية واضحة لا لبس فيها.
ولكن المتكلمين كعادتهم، جعلوها مجالا للجدل، الذي لا خير فيه.
ومما جاء عن هذه القضية، بكتاب البرهان في علوم القرآن، للزركشي أنه قال: قال القاضي أبو بكر : ذهب عامة أصحابنا، وهو قول أبي الحسن الأشعري في كتبه، إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن، السورة قصيرة كانت أو طويلة، أو كان بقدرها.
قال : فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة، وان كانت كسورة الكوثر فذلك معجز.
قال : ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة، في أقل من هذا القدر.
وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهي معجزة. (65)
ولقد ثار – ابن حزم – رحمه الله – على هذه الآراء المتعارضة في هذه القضية التي لا تحتمل المراء فقال :
لا يختلف اثنان، في أن كل شيء من القرآن، معجز.
ثم يشعر ابن حزم، بأن الإعجاز في حقيقته، مرتبط بنظم القرآن وتركيبه، وترتيب كلماته في آياته وآياته في سوره وسوره في المصحف.
ولكن هذا الشعور لا يظهر في كلامه، مرتبطا بقضية النظم، الا على وجه الإجمال، لا التفصيل.
لذلك فهو يتوجه إلى الذين قالوا إن القدر المعجز من القرآن، هو ما كان مثل أقصر سورة وهي سورة الكوثر فيقول لهم : إن سورة الكوثر عشر كلمات اثنان وأربعون حرفا.
وقد قال الله تعالى : «وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان»
163 : النساء
اثنا عشر كلمة، اثنان وسيعون حرفا.
وأن اقتصرنا على الأسماء فقط، كانت عشر كلمات اثنين وستين حرفا، فهذا أكثر كلمات وحروفا من سورة الكوثر.
فينبغي أن يكون هذا معجزا عندكم ويكون «ولكم في القصاص حياة»
179 : البقرة
غير معجز ….
ثم يقول ابن حزم، عن الآية التي جاء فيها أسماء الرسل صلوات الله عليهم فإن قالوا إن هذا غير معجز تركوا قولهم في إعجاز، مقدار أقل من سورة في عدد الكلمات وعدد الحروف.
وإن قالوا بل هو معجز تركوا قولهم في أنه في أعلى درج البلاغة.
وفي موضع آخر يتساءل ابن حزم عن الآية نفسها فيقول:
فإن قالوا ليس معجزا كفروا.
وإن قالوا انه معجز صدقوا وسئلوا : هل على شروطكم في أعلى درج البلاغة؟
وفي موضع آخر يتساءل ابن حزم عن الآية نفسها فيقول :
فإن قالوا نعم، كابروا وكفوا مؤونتهم لأنها أسماء رجال فقط، وليس هذا على شرطهم في البلاغة.
وينتهي كلام ابن حزم هنا، حيث يتبين لنا أنه لم يصل إلى سر النظم، وأصل التركيب والترتيب لكلمات القرآن فإذا هو يقول :
وأيضا فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة، لكان بمنزلة كلام الحسن أو سهل ابن هارون والجاحظ وشعر امرئ القيس.
ومعاذ الله من هذا لأن كل ما يسبق في طبيعته لم يؤمن من أن يأتي من يماثله ضرورة، فلا بد لهم من هذه الخطة، أو من المصير إلى قولنا : إن الله تعالى منع من معارضته فقط !!
ويعلق على كلام ابن حزم هنا، العالم المعاصر الأستاذ / أحمد عز الدين عبد الله خلف الله في كتابه القيم (القران يتحدى) فيقول :
كان ابن حزم يذهب في الإعجاز، مذهب المعتزلة في الصرفة (66).
هكذا يعلق هذا العلم المعاصر، على موقف ابن حزم كما ظهر لنا في هذا السياق ولكني قد أرى ان ابن حزم، لم يرد بكلامه هذا الصرفه بمعناها المعروف عند النظام (67) وغيره من المعتزلة، وإنما أراد أن في نظم القرآن سرا لم يصل هو إليه !! ولذلك يقول ابن حزم في موضع آخر عن قولهم إن القرآن في أعلى درج البلاغة.
إن كنتم تريدون أن الله بلغ ما أراد فنعم، وإن كنتم تريدون أن القرآن في أعلى درج البلاغة في كلام المخلوقين فلا، لأنه ليس من نوع كلام المخلوقين، لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه (68).
وينتهي هذا القدر من كلام ابن حزم لنقول معا :
ان كلام ابن حزم عن مجانبة القرآن لكلام المخلوقين، من أعلاه وأدناه وأوسطه يصل بنا مباشرة إلى إعجاز التركيب والترتيب، في كل كلمات القرآن، وإن لم يشاهده ابن حزم مشاهدة ويعاينه معاينة.
انظر معي أيها القارئ العزيز، إلى أي كلمة من قوله تعالى :
«وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان»
لقد اخترت أول كلمة متوسطة بين كلمتين هي قوله تعالى (وأيوب) فلننظر في مواضعها القرآنية، لنكشف معا، بعض أسس الإعجاز الإلهي، في نظم القرآن وتركيبه وترتيب كلماته.
إن كلمة (أيوب) أربعة مواضع، في القرآن كله، كما هو مرتب في المصحف.
بقوله تعالى :
- «وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان»
163 : النساء
لقد جمع الله هؤلاء الرسل والأنبياء في هذه الآية، ونحن نعجز أن نكشف بعض أسرار الإعجاز في النظم والتركيب والترتيب، طالما نحن في هذه الكثرة من الأسماء، حيث لا نستطع النفاذ إلى ما يخص كل اسم بذاته، في موضعه وترتيبه.
ولكننا حين نذهب إلى الموضع التالي لكلمة (أيوب) يتبين لنا ما لم نكن نعلمه من قبل.
- «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين»
83 – 84 : الأنعام
لقد تبينت لنا ملامح جديدة تحدد لنا نسب أيوب وصلته بآبائه وأجداده، وفي هذا زيادة واضحة، على ما سبق في سورة النساء بالآية 163.
ونذهب إلى لموضع الثالث لكلمة أيوب.
- «وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين»
83 – 84 : الأنبياء
لقد جاء في الموضع الثالث لكلمة أيوب بصلة جديدة، بقضية مشهورة في حياته وهي قصة مرضه.
ولقد جاء المرض هنا مجملا، حيث قوله الله تعالى حكاية عن أيوب عليه السلام.
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
ثم يبين السياق أن الله شفاه وعوضه ما فقده من أهل ومال، وزاده، وضاعف له في الخير، ليكون في هذا ذكرى للعابدين.
وهكذا نتجه إلى الموضع الرابع والأخير لكلمة – أيوب –
- «واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب»
41 – 43 : ص
لقد زاد الله، المسافة الزمنية المكانية، وضوحا وظهورا، بين عهد أيوب وعهد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله تعالى :
«وذكر عبدنا أيوب»
ثم بين الله سبحانه حقيقة الداء والدواء فقال حكاية عن عبده أيوب عليه السلام «أني مسني الشيطان بنصب وعذاب»
أي أن المرض كان مرضا له أسباب عضوية أحاطط الله بعلمها وبأسبابها وبدوائها حيث قال : «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب»
وبعد أن كانت الذكرى للعابدين، في سورة الأنبياء، أصبحت الذكرى لأولي الألباب في سورة (ص).
لقد سرنا مع الحركة الدائبة والصلات المتجددة، بين كلمة أيوب لقد ظهر لنا هذا التسلسل المترابط، المتزايد في الفعل، والتأثير، والتشخيص لتطور الحياة الإنسانية، من حيث الزمان والمكان، مع ثبات القيم الأصلية، والتكاليف الشرعية وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وكلها في اللجوء إلى الله، وإفراده بالحب والعبادة والضراعة والدعاء.
ولقد كان هذا كله، خاصة بأربعة مواضع لكلمة قرآنية واحدة.
وهذا يدلنا أن في كل كلمة من كلمات القرآن، مع كثرة المواضع من حيث الكم والكيف والمبنى والمعنى والترتيب الجديد، ما يخصها من وجوه الإعجاز وبذلك نرى بأعيننا أن القرآن معجز إعجازا متجددا، على قدر عدد كلماته فلكل كلمة إعجازها في ذاتها، وإعجازها في تعلقها بغيرها.
لقد أوشك ابن حزم رحمه الله أن يعاين هذه المعاينة، ويشهد هذه الشهادة ولكنه وقف عند الوصف العام فقال :
إن كلام الله من أعلاه وأدناه وأوسطه ليس كمثله كلام المخلوقين.
ومثل هذا البيان لا ينبغي أن يتفق معه أن ابن حزم تورط مع النظام في القول بالصرفة، وإنما هو أراد أن القرآن معجز في كثيره وقليله، ولكنه أي ابن حزم، لم يصل إلى أساس هذا النظم القرآني الذي حاولنا معا أن نراه الآن لننفذ منه إلى وحدة نظام التركيبي في خلق الله ووحيه، مع استقلال كل من الخلق والوحي بحقائقه الذاتية.
وهذا كله يفيد العلماء، حيث يفتح أمامهم آفاق التقدم العلمي، وهو يعلمهم أن حقائق وحي الله، لا ينبغي أبدا أن تنفصل عن حقائق خلقه.
فالتقدم العلمي لا يتم في حدود العلوم المادية وحدها.
بل لا بد من الربط بين الإعجاز الإلهي في وحي الله، والإعجاز الإلهي في خلق الله وبذلك تتكامل منافع التقدم العلمي، ويتعلم العلماء أن الفصل بين علوم الدين وعلوم الدنيا، ينطوي على تأخر في أنواع الاستفادة بحقائق العلوم والحقيقة أن الإعجاز القرآني، يعلمنا كيف نصل بين ما ينفع الإنسان من علوم الدنيا، وبين ما ينفعه من علوم الآخرة وبين ما ينفع الإنسان من حقائق المادة والطاقة وغيرهما، مع اتصال هذا كله، بحقائق الأخلاق الفاضلة، والسياسة الرشيدة، للحياة الإنسانية في كل مجالات الحياة.
7-مع ابن برجان وبيانه لمعاضدة السنة للقرآن :
أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتبع الوحي، الذي أوحاه إليه وخصه بإبلاغه للناس كافة.
وجاء هذا الأمر، في آيات كثيرة، منها قوله تعالى :
«اتبع ما أوحىي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين»
106 : الأنعام
والوحي هو القرآن والسنة
وتتصل الآيات حتى يقول الله للأمة
«وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم»
121 : الأنعام
والجدل في كلام البشر، اختلاف لا خير فيه
ثم تتصل الآيات إلى قوله تعالى :
«وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثلما أوتى رسل الله والله أعلم حيث يجعل رسالته»
124 : الأنعام
حول هذه الحقائق تحدث ابن برجان فقال :
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، فهو في القرآن وفيه أصله قرب أو بعد فهمه، وعمه من عمه عنه (69).
ويقول الزركشي عند تقديمه لابن برجان في كتابه البرهان :
اعلم أن القرآن والحديث أبدا متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج الحكمة، حتى إن كل واحد منهما يخصص عموم الآخر ويبين إجماله (70).
ألا تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجم
لأقضين بينكما بكتاب الله
وليس في نص كتاب الله الرجم.
ويقول ابن برجان
وقد أقسم النبي ليقضين بينهما بكتاب الله
ثم يقول ولكن الرجم في تعريض مجمل في قوله تعالى :
«ويدرأ عنها العذاب»
8 : النور
وأما تعيين الرجم من عموم ذكر العذاب، وتفسير هذا المجمل فهو مبين بحكم الرسول وبأمره به، وموجود في عموم قول الله تعالى :
«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»
7 : الحشر
وقوله :
«من يطع الرسول فقد أطاع الله»
80 : النساء
معاضدة السنة للقرآن بالقول والفعل والتقرير :
وينتهي هذا القدر من بيان ابن برجان – رحمه الله – لنقول – معا – إن في هذا البيان نوعا من أنواع معاضدة السنة للقرآن هو تفسير كلمة قرآنية مجملة، بأقول وأعمال وتقريرات مخصوصة، لا مصدر لها إلا السنة – بكل أقسامها من قول النبي، وفعله، وتقريره.
وفي هذه القضية، التي أثارها ابن برجان بيان لأنواع السنة جميعا، وهي أقوال النبي، وأفعاله، وتقريراته.
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوليدة وبمائة شاه، ثم أخبروني أهل العلم أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فاقض بيننا بكتاب الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله
أما الفتى والوليدة فرد عليك
وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام
ثم قال لرجل من أسلم : يقال له أنيس قم يا أنيس فاسأل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها(71).
إن هذا الحديث السابق يبين لنا أنواع السنة الثلاثة وهي :
- السنة القولية
- السنة العملية
- السنة التقريرية
فأما السنة القولية فمنها ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث حيث قال :
- والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله
فعلمنا من ذلك أن الذي جاء مجملا في قوله تعالى : «ويدرأ عنها العذاب»
قد جاء بيانه مفصلا في هذا الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم
- أما الفتى والوليدة فرد عليك
وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وقد جاء الجلد مجملا في قوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده»
أما تغريب عام، فهو زيادة خص الله بها السنة، لنظل بحاجة إليها مع القرآن لا يفترقان أبدا، في إلزامنا بهما.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم
- قم يا أنيس فاسأل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
وأما السنة العملية، فمنها ما تضمنه هذا الحديث، من الأعمال المترتبة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم:
أولا :رد الغنم والوليدة إلى الوالد.
ثانيا : جلد الزاني غير المحصن وتغريبه عاما
ثالثا : اشتراط الاعتراف، لإقامة حد الرجم على الزانية المحصنة، ما لم يكن هناك أربعة شهود عدول.
ومن عظمة الإسلام، أنه إذا اعترف أحد أنه زنى بامرأة، فأنكرت هي ذلك، ولم تعترف به، فإنه يقام عليه الحد لاعترافه، ولا يقام عليها لعدم اعترافها.
فقد روى سهل بن سعد، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انه قد زنى بامرأة سماها فأرسل النبي إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت، فحده وتركها (72).
رابعا :تعددت مفاهيم الحد الخاص بالزاني المحصن من جهة جلده ورجمه، أو رجمه فقط والحديث السابق، حجة للذين لا يرون الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي (73).
وأما السنة التقريرية، فمنها ما تضمنه هذا الحديث، من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجوه.
- أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العلم، الذين قالوا لوالد الشاب الزاني، إن على ابنه جلد مائة وتغريب عام.
وهذا الإقرار لا يمنع كون هذا حكم، قد جاء أصلا من عند الله، وليس رأيا جاء به أهل العلم من عند أنفسهم.
فالإقرار هنا بمثابة التصديق لهم، أنهم أصابوا حكم الله.
- قال أهل العلم لوالد الزاني ان على المرأة المحصنة الرجم.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على هذه الفتوى، إلا بشرط هام جدا هو اعترافها فقال : «فإن اعترفت فارجمها»
وهكذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر كل ما يصدر من صحابته على إطلاقه وإنما قد يكون تقريره موافقا لهم، أو يكون فيه اتمام لأمر لم يدركوه.
والتقرير له أنواع أهمها نوعان هما :
- التقرير على الأقوال مثل ما روى أحمد في قصة ماعز انه اعترف بالزنى، أمام النبي ثلاثا، كل ذلك يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر إنك إن اعترفت الرابعة – رجمك سول الله صلى الله عليه وسلم احتج به الحنفية والحنابلة، على أن العدد معتبر في الإقرار بالزنا من جهتين
الأولى : أن ذلك مما علمه أبو بكر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثانية : أن النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ذلك ولم يخطئ قائله.
- الإقرار على الأفعال ومنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل لحم الضب، ومن الإقرار على الأفعال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ترك، كما نقل أن عمرو بن العاص تيمم من الجنابة في ليلة باردة، وصلى بأصحابه فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال له : صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال : ذكرت قول الله تعالى :
«ولا تقتلوا أنفسكم انه كان بكم رحيما» فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، فكان في ذلك إقرار منه على ترك الإعادة (74).
وينتهي هذا الكلام لنقول – معا – انه إذا كان هذا التصنيف، قد فرق بين الإقرار على القول، والإقرار على الفعل، ثم جعل للإقرار على الفعل وجهين، هما الإقرار على الفعل المعمول به، والإقرار على ترك الفعل، فإننا مع ذلك نلحظ في قصة عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أقره على الاجتهاد في فهمه للآية السابقة – من سورة النساء :
«ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما»
29 : النساء
ولو كانت هذه المحاولة من عمرو، في تطبيق بعض معاني غير صائبة، ما رضي منه النبي بذلك.
ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله من البداية قائلا (صليت بأصحابك وأنت جنب) فلما ذكر عمرو ما كان من اجتهاده في فهم آية من القرآن، وانه تيمم بناء على هذا الفهم، أقراه على أمور كثيرة منها الاجتهاد في التيمم بناء على ذلك، وترك إعادة الصلاة نتيجة لكل ما تقدم.
فلهذا وغيره، كما سبق في حديث خالد الجهني، ما يبين لنا أن الإقرار له أحوال كثيرة تفهم من نصوص متعددة من الرقآن والسنة جميعا.
وانه ربما جمعت واقعة واحدة بين الإقرار على القول أو الفعل أو بعضها، أو الإقرار على ترك شيء أو فعل غيره، مما لا يفهم إلا بإكثار النظر في القرآن والسنة معا.
كلمات القرآن والسنة ذات الأصول اللغوية الواحدة:
ويتصل بما سبق نوع جديد، من أنواع معاضدة السنة والقرآن، أساسه أن نجد لكلمة – في السنة، أصولا قرآنية فإذا نظرنا في مواضع الكلمة الواحدة، في القرآن ثم نظرنا بمواضعها في السنة، وصلتنا فيهما معا بمسيرة واحدة، متصلة الفصول، متجددة المقاصد، تزيدنا علما كلما زدناها نظرا.
يقول ابن برجان:
أن قول النبي صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (75)
أصله في قوله تعالى
«هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين»
24 – الذاريات
ونقول – معا – انه مما يزيد هذه الحقيقة بيانا اننا نجد القرآن بمواضع كلماته الخاصة بإكرام الضيف، يبين أن البشر لو وكلوا إلى أنفسهم، لأفسدوا هذه السنة الحسنة.
ففي الموضع الأول، الذي جاء عن الضيف، في ترتيب المصحف، نجد قول الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام.
- «فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجلا رشيد»
78 : هود
أما الموضع الثاني فهو بقوله تعالى :
- «ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون»
«قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم»
51 – 53 : الحجر
ثم نجد الموضع الثالث : بقوله تعالى حكاية عن آل لوط مع قومه
- «قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون»
68 : الحجر
ثم نجد الموضع الرابع بقوله تعالى :
- «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه»
77 : الكهف
والموضع الخامس : بقوله تعالى :
- «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين»
24 : الذاريات
والموضع السادس : بقوله تعالى :
- «ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر»
37 : القمر
فهذا آخر المواضع وفيه نهاية قوم لوط، بعد أن تصاعد موقفهم في إيذاء لوط وضيفه.
وإننا لنجد إبراهيم نفسه، لم يبدأ بإكرام الضيف منذ بداية ما جاء عن ذلك في سورة الحجر، وإنما جاء إكرامه لهم أخيرا في سورة الذاريات.
(فهذا مما يبين أن إبراهيم لم يخترع إكرام الضيف من عنده، وإنما هي سنة أوحاها الله إليه).
ثم نجد الخضر عليه السلام، يكرم أهل القرية، مع جهلهم بوجوب إكرام الضيف فهذا عمل يقتضي الله تعالى لعباده جميعا، في الدنيا، فالله تعالى يرزق البر والفاجر، في هذه الدنيا، ويطعم المؤمن والكافر، حتى تقوم الساعة، فهناك يجزي كل نفس بما عملت.
هذه الوجوه الكثيرة، والمقاصد المتجددة، التي نجدها في القرآن، بهذا الترتيب المعجز لها تتمات في السنة، لا عن نقص في كلام الله وحاشا لله، أن يحتاج كلامه إلى تكملة من غيره، ولكن عن قلة فهمنا البشري، لما جاء مجملا في القرآن، فجعل الله السنة مبينة له حاجتنا إلى التنقل بين أنواع كثيرة من البيان، حتى نتدرج في فهم الحقائق.
ومن أنواع البيان، لما جاء مجملا في القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف (76)
فهكذا تبين لنا السنة أصل إكرام الضيف، ومتى ألقى الله معانيه الجميلة، في وقائع الحياة الإنسانية.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :
الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة (77)
وهكذا تحدد السنة مدة إكرام الضيف.
وهذه أمور فرعية، جعل الله بيانها من الوحي الآخر، وهو السنة على مقتضى نظرة الله فينا، وهي حبنا للتنقل، للتواتر أممنا المشاهد فيؤكد بعضها بعضا، ويذكر بعضها ببعض.
فمن أهم العلوم التي يتقدم فيها الإنسان، إذا نظر إلى معاضدة السنة للقرآن، هذه العلوم الإنسانية، التي تبين لنا مناهج التراحم بين الناس، وأصول المعاملات بينهم، وحقوق بعضهم على بعض، والقصاص العادل، وكيف يقع على من استحقه منهم.
8-مع ابن تيمية
«مقدمة» في أصول التفسير
يبين العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية أن أصح طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع، قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان، فقد بسط في مكان آخر.
فإن أعياك ذلك، فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له.
ثم يقول ابن تيمية : (78)
«يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى : «لتبين للناس ما أنزل إليهم».
44 : النحل
يتناول هذا وهذا.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة (79).
ثم يبين لنا ابن تيمية رحمه الله – أن الاختلاف بين الصحابة – على التفسير قليل جدا، وأنه اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد.
وذلك مثل تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه فقول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث على الذي رواه الترمزي، ورواه أبو نعيم من طرق متعددة (هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم) (80) والذي نلحظه من هذه الأصول العلمية، التي أوردها ابن تيمية – رحمه الله – أن الوحي من قرآن وسنة، في تكوينه لروح الأمة الإسلامية – يؤدي دوره في نظام مماثل للحقيقة التي تؤكد لنا دائما أن كل صلة بين الجزء والكل، في خلق أو بين الجزء والكل في وحي الله، لا بد أن تتضمن بابا جديدا من أبواب العلم، يحمل معه تفسيرا خاصا بالحقائق المتصلة به، في أي شيء من ذلك.
فالتفاعلات المتجددة، التي تنتج من أي تركيب جديد، لأي قدر من عناصر المادة، تفسر لأصحاب التخصصات العلمية المختلفة، وجوها من التفاسير لحقائق علمية كثيرة ولكنها متنوعة. وتنوع الأعمال المرتبطة بها عند كل أحد منهم.
ولولا الثبات في حقيقة كل جزء من أجزاء الخلق، مع تجدد بصلاته بمواضعه التي قدرها الله له في الكون والحياة، ما استطاع العلماء أن يتفقوا على حقيقة علمية واحدة، وان تنوعت أهدافهم المنعقدة عليها، بحكم اختلاف اتجاهاتهم العلمية.
وقد تبين لنا من قبل، أن القرآن في تركيبه المعجز، يقوم على الثبات في نصوصه سواء كانت هذه النصوص حرفا أو كلمة أو جملة، مع تجدد الحركة دائما بين أي نص من ذلك، وبين مواضعه التي قدرها الله له في الآيات والسور، ثم في معاني السنة التي هي امتداد للقرآن، وتطبيق عملي له في واقع الحياة.
فهكذا ندرك، أن هذا التنوع في أقوال الصحابة وتفسيرهم لحقائق الوحي المتصلة بوقائع الحياة، إنما هي نتيجة عملية لتركيب الوحي من قرآن وسنة، وتركيب المجتمع البشري، باعتباره جزءا من خلق الله. (81)
فقد اهتم ابن تيمية القول في هذه الحقيقة، وبين أن فيها أنواعا من وجوه العلم.
- فهناك التفرع القائم على التعبير عن المراد، بصيغ لغوية، تدل على معان متنوعة ولكن لها أصلا واحدا.
- وهناك التفرع، الذي يظهر عند ذكر أمر خاص، له أشباه تتصل معه، بأصله العام.
كما في قوله تعالى :
«ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات».
32 : فاطر
ويقول ابن تيمية رحمه الله
فمعلوم أن الظالم لنفسه، يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات.
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات، وتارك المحرمات.
والسابق، يدخل فيه من سبق، فتقرب بالحسنات الواجبات.
- ومعرفة سبب النزول، يعين على فهم الآيات، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
ولهذا كان أصح قول للفقهاء، أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها (82).
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة، أنه سبب النزول، ويراد به تارة، أن هذا دخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول : عني بهذه الآية .. كذا (83)
- ومما يتصل بالتنوع في التفسير ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة، الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد (84)
ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
- ومما يظن به الاختلاف بين الصحابة والتابعين، في التفسير، وليس كذلك أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في كلمات القرآن، فهو إما نادر، أو أو غير موجود، وهذا من إعجاز القرآن. (85)
وكلام ابن تيمية هنا يذكرنا بالتفرد الدائم، والتجدد المستمر، أي قدر من النصوص القرآنية، في ذاته، أو في صلاته بمواضعه.
وهذا يذكرنا بفوائد علمية لا نحيط بكثرتها، أوهمها النظر في كل حقيقة علمية من جهتين الجهة الأولى : هي الحقيقة في ذاتها.
والجهة الثانية هي الحقيقة في وجوه العلم بها، والفوائد المترتبة عليها
ويضرب ابن تيمية أمثالا لذلك فيقول : إذا قيل (ذلك الكتاب) هو القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه، وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور، غير الإشارة بجهة البعد.
ولفظ الكتاب، يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا، ما لا يتضمنه اقرآن من كونه مقروءا.
فهذه الفروق موجوده في القرآن.
70 : الأنعام
وكذلك إذا قال أحدهم (ان تبسل) أي تحبس، وقال الآخر، ترتهن، ونحو ذلك لم يكن من اختلاف القضاء، وان كان المحبوس قد يكون مرتهنا أو لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم(86).
ونقول – معا – إن هذا كله، هو الأساس الجامع لربط الإسلام بين العلم والنفع، وبينهما معا وبين كل قول صادق، وعمل صالح، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فلا مكان في الإسلام، للعلم الذي يقف عند حدود الترف الفكري وحده.
ثم يربط ابن تيمية رحمه الله، بين نفيه للاختلاف من تفسير الصحابة والتابعين وبين النقل وطرق الاستدلال.
وهنا يتحدث عن النقل والاستدلال فيقول :
العلم أما نقل مصدق، أو استدلال محقق
والمنقول إما عن المعصوم أو غيره
وهكذا يربط ابن تيمية، بين التفسير وبي السنة، ويدعونا إلى النظر في إسنادها وشرطه.
ثم يحثنا على الاستدلال، بنصوص الوحي، لا بالرأي البعيد عنها.
ويقول ابن تيمية، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي، فحرام
ويروي أحاديث في ذلك، أهمها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار (87).
وهكذا ننتهي – معا إلى أن الإعجاز الإلهي في الخلق والوحي، قائم في أهم وجوهه على هذا الترابط والتكامل، بين وجوه الحقائق جميعا، في كل أجزاء الوحي من جهة، وكل أجزاء الخلق من جهة، فكل شيء من ذلك فيه تصديق للآخر وتفسير له، وتوثيق متجدد، لحقائقه العلمية والعملية، بكل مكان وزمان.
*********
الهوامش
(1) الموافقات للشاطبي 4/17
(3) (4) الفتح الرباني لمسند الإمام احمد ترتيب العلامة أحمد عبد الرحمن البنا 18/190 ولزيادة التوسع في الموضوع انظر البرهان للزركشي 1/ 260
(5) راجع موسوعة الثقافة العلمية مادة الروابط وأنواعها ص 167 وما بعدها.
(6) صحيح الجامع الصغير 3575
(7) الدر المنثور للسيوطي 4/105
(8) انظر الاعتصام للشاطبي 1/237
(9) وللتوسع في دحض المفتريات الحديثة ضد القرآن والسنة راجع السنة المفترى عليها للأستاذ سالم البهنساوي.
(10) للتوسع في بيان أنواع الترابط والتراتيب في القرآن ثم في السنة، وتأثير ذلك في الوجود الإنساني راجع كتاب مقدمة في تفسير الرسول للقرآن الكريم لمحمد عفيفي.
(11) الله يتجلى في عصر العلم ص 32.
(12) المصدر السابق ص 109.
(13) انظر معجم غريب القرآن، مستخرجا من صحيح البخاري – باب القاف ص 172 تأليف: محمد فؤاد عبد الباقي.
(14) وانظر كذلك كتاب العمل والعمال، بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة، للدكتور سعد المرصفي ص 77 وما بعدها.
(15) عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها قالوا : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال أجل إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة، سألته يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها.
الترمزي ج 4 ص 471 الحديث 2175.
وفي أحاديث أخرى، بيان مهعنى أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، ان عدوهم لا يستطيع القضاء عليهم أجمعين، وان ذهب ببعض ما في أيديهم، جزاء على بعض ذنوبهم.
(16) راجع لسان العرب لأبن منظور ج 2 ص 691 مادة (عجز) حيث عجب العلامة بن منظور من قوله تعالى (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) وأورد في ذلك أقوالا كثيرة، لعدد من المفسرين القدامى لم يعرفوا الطائرات أو الصواريخ فقال الفراء : ما هم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء بمعجزين فيها، وقول الفراء بعيد كما نرى لأن الله قال (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء)فتفسير ذلك لا يظهر بتمامه إلا بعد وصولنا إلى عصر الفضاء، وما يأتي بعده.
(17) انظر كنز العمال ج 1 ص 108 الحديث 499 وقد جاء في هامشه انه حديث رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه.
(2) راجع معترك الأقران 27/1 ، 32 ،54.
(18) جء في مسند أحمد ج 4 ان النبي صلى الله عليه وسلم تفل في كفه ثم أشار بإصبعه إلى ذلك وذكر الحديث، ومعنى قول الله تعالى (من مثل هذا أي من مثل ما تفل النبي صلى الله عليه وسلم)
(19) انظر كذلك في صحيح الجامع الصغير للسيوطي ج 6 ص 355 برقم 8000 وهو صحيح الاسناد كما يقول محققه ناصر الدين الألباني.
(20) سند أحمد ج 6 ص 169.
(21) انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ج 4 ص 136 وهذا جزء من حديث جاء في صحيح البخاري 29 وصحيح مسلم 78 (مسافرين)
(22) مسند أحمد ج 4 ص 434 وصحيح مسلم نذر 8.
(23) كنز العمال ج 4 ص 115 الحديث 540 وجاء فيه انه رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
(24) صحيح الجامع الصغير ج 1 ص 4-6 الحديث 1296.
(25) صحيح الجامع الصغير ج 1 ص 406 الحديث 1296.
(26) صحيح الجامع الصغير ج 1 ص 407 الحديث 1297 وجاء فيه انه رواه مسلم في صحيحه 81/8 – 82.
(27) المصدر السابق ج 1 ص 406 وهو صحيح الاسناد وجاء فيه انه رواه البخاري ومسلم وغيرهم.
(28) صحيح مسلم ج 1 ص 186 (الحديث 329) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(29) وهناك حديث آخر يزيدنا فهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم (حتى لا تعجز أعمال العباد) فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار، ولا انا إلا برحمة الله)
(30) الخطابي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان، شارح سنن أبي داود ومؤلف كتاب اعجاز القرآن توفي سنة 388 هو ترجمته عند ابن خلكان 1 : 166 انظر ذيل الاتقان للسيوطي ج 3 ص 88.
(31) سنن أبي داود ج 2 ص 233 برقم 1575 وانظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ج 1 ص 465
(32) الدر المنثور للسيوطي ج 6
(33) تفسير مجاهد تحقيق السورتي ج 2 ص 639
(34) معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص 115
(35) معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص 108
(36) لسان الرب لابن منظور ص 1053
(37) ارجع إلى المدخل التفصيلي، وانظر في السبع المثاني.
(38) الخطابي (اعجاز القرآن ص 26، 27، 70 وهذا القدر من كلامه منقول عن عالم معاصر هو الأستاذ المحقق أحمد عز الدين عبد الله خلف الله وذلك في كتابه (القرآن يتحدى) ص 170 – 171)
(39) المصد السابق، وهذا يذكرنا بقوله بما جاء بكتاب (القرآن يتحدى) ص 178 – 179 – نقلا عن المخطوطة 68 بالمكتبة الأزهرية.
(40) إعجاز القرآن للباقلاني ص 38 – والباقلاني هو أبو بكر محمد بن الطيب المتوفى سنة 403 هـ
(41) إعجاز القرآن للباقلاني ص 291
(42)
(43) انظر كتاب (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) وقال الألباني هذا الحديث رواه أبو داود والترمزي والحاكم وصححه، أحمد بسند صحيح.
(44) صحيح الجامع الصغير للسيوطي، تحقيق الألباني، ج 5 ص 84 الحديث 5239.
(45) انظر ما سبق من كلام الباقلاني وهو في كتابه اعجاز القرآن ص 291
(46) انظر هذه الخطبة النبوية، بكتاب اعجاز القرآن للباقلاني ص 130 – 131 وعزاها محققة الأستاذ السيد أحمد صقر إلى العقد الفريد 75/4، والبيان والتبين 31/2. قلت : كتب الأدب ليست هي مصادر الأحاديث النبوية، إنما مصدرها كتب السنن، فانظر مسند الإمام احمد بن حنبل ج 5 ص 72 – 73 وقد جاء فيه هذه الخطبة وهي صحيحة الإسناد كما جاء بكتاب الفتح الرباني : للعلامة أحمد عبد الرحمن البنا ج 12 ص 226 – 227 قال هذه الخطبة اسنادها صحيح وأوردها الهيثمي، ولم يقف عليها في غير مسند الإمام أحمد.
(47) الخطيب الاسكافي هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله المعروف بالخطيب الاسكافي – كان اسكافا ثم نبغ في العلم وولي الخطابة بالري وتوفى سنة 420 هـ.
(48) درة التنزيل ص 20 – 21.
(49) هذا القول ذكره العكبري 538 هـ – 616 في كتابه املاء ما من به الرحمن ص 221 وعزاه إلى سيبويه وكذلك صنع الاسكافي إذ جاء بهذا القول وعزاه إلى صاحبه ص 21 درة التنزيل.
(50) أسباب النزول للواحدي ص 14، أسباب النزول للسيوطي ص 19، أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 13.
(51) تاج القراء الكرمان هو محمد بن حمزة بن نصر الكرماني من علماء القرن الخامس الهجري وليس هو الكرماني شارح صحيح البخاري – انظر ص 11 – 17 من كتاب (أسرار في القرآن) للكرماني تحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا.
(52) كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني المتوفي في سنة 1162 هـ ج 1 ص 263 برقم 697 وقد جاء في هذا الحديث في الصحيحين فهو حديث متفق عليه.
(53) انظر تفسير بن كثير ج 4 ص 73
(54)سنن الترمزي كتاب التفسير ورقم الحديث 3366 وقال أبو عباس حديث حسن صحيح وانظر كذلك تفسير فتح البيان للعلامة حسن خان ج 10 ص 491.
(55) الجرجاني هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الشيخ أبو بكر الجرجاني النحوي المتكلم على مذهب الأشعري الفقيه على مذهب الشافعي توفى عام 471 هـ.
انظر تعريفه في الصفحات 5، 6، 7، 8 من بداية كتاب دلائل الاعجاز وكذلك في بقية الاماة للسيوطي ص 310، 311 كما جاء في المرجع السابق.
(56) انظر تقديم محمد عبد المنعم خفاجي لكتاب دلائل الإعجاز للجرجاني ص 26 وما بعدها.
(57) المصدر السابق والحقيقة ان هناك تعمية لمسألة النحو على حقائق النظم وهي كثيرة منها ما يتصل بعدد مواضع كل كلمة قرآنية وصلاتها المتجددة بسياقها من كل موضع وترتيب كل كلمة بين غيرها من كلمات القرآن.
(58) المصدر السابق ص 89
(59) انظر ص 105 من نهاية الإيجاز المطبوع بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 1317 هـ.
(60) نهاية الإيجاز للفخر الرازي هو المفسر المعروف محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606.
(61) اقرأ كتاب الفيلسوف والعلم تأليف جون جيمني ترجمة أمين الشريف، لتقف على الصعوبات التي تواجه العلماء في تدوينهم لمصطلحات العلوم، وكيف أنهم بحاجة إلى أن يفيدوا من الهدي القرآني في ذلك.
(62) كلمة سيقه معناها قرية من جاره – انظر النهاية لابن الأثير الجرزي ج 2 ص 377.
(63) انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ج 1 ص 407.
(64) ابن حزم هو الإمام العلامة أبو محمد علي ابن أحمد أبو سعيد بن حزم بن غالب المتوفى سنة 475 هـ
(65) البرهان في علوم القرآن للزركشي ج 2 ص 108.
والزركشي هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر – أحد علماء مصر في القرن الثامن انظر مقدمة – البرهان ج 1 ص 5.
(66) القرآن يتحدى ص 182.
(67) انظر المصدر السابق 173 لبيان كلام النظام عن المعرفة أي أن القرآن – الله تعالى قد صرف الناس عن معارضة القرآن ومذاهب كل ما في الإعجاز ونقول – معا –ان الكلام النظام وهم وافتراء.
(68) ابن الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 3 ص 17 – 19 وقد جاء هذا المصدر في المصدر السابق ص 184.
(69) ابن برجا هو الإمام عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام الأشبلي المعروف بابن برجان أحد أئمة اللغة والنحو في زمانه ذكره السيوطي في بغية الدعاة 306 (وهذا التعريف من حاشية الصفحة 129 ج 2 لكتاب البرهان لعلوم القرآن للزركشي تحقيق محم أبو الفضل إبراهيم، وفي طبقات المفسرين للداودي ج 1 ص 300 قال توفى سنة 536 هـ)
(70) الزركشي هو الإمام محمد بن بهادر الزركشي أحد علماء مصر الاثبات في القرن الثامن وتوفى بمصر سنة 794 هـ وانظر حاشية ج1 ص 5 من كتاب البرهان ط عيسى البابي الحلبي.
(71) مسند أحمد ج 4 ص 115.
(72) فقهالسنة للشيخ سيد سابق ج 9 ص 115 – 116 دار البيان وقال عن هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود.
(73) انظر أحكام القرآن للشافعي ج 1 ص 305 وقد احتج الشافعي بهذا الحديث على عدم الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن فيكتفي عنده بالرجم فقط.
(74) ما بين القوسين من كتاب أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر ج 2 ص 123 – 124 وعزا المؤلف قصة ما عز الى نيل الأوطار 7/100 وما جاء عن خالد وعمر الى نيل الأوطار 1/280.
(75) انظر صحيح مسلم 1 : 31 كتاب الإيمان.
(76) الموطأ صفة النبي (4)
(77) البخاري أدب 31، 35، 85 ومسلم لقطة 14، 15.
(78) مقدمة – في أصول التفسير (93) لا بن تيمية وهو العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 661 – 728 هـ
(79) يقول الدكتور عدنان زرزور – محقق الكتاب – ص 36 (راجع تفسير الطبري) 1/80 وقارن بالقرطبي 1/الله 3 ولابن تيمية – رحمه الله – استشهاد بالحديث من وجه آخر انظر مجموعة الرسائل الكبرى 2/31.
أما عبد الرحمن السلمي فهو عبد الله بن حبيب الكوفي المقرئ من كبار التابعين – ثبت ولاية صحبه (انظر تقريب التقريب) لابن حجر 1/408.
(80) ويقول الدكتور عدنان زرزور محقق الكتاب انظر – حول الحديث : الطبري 1/171/173 بتخريج الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله.
(81) انظر الفصل الثالث.
(82) المقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 38 – 47.
(83) المصدر نفسه ص 48.
(84) انظر تعليق الدكتور زرزور حيث قال في حاشية 48 من هذا الكتاب : ان ابن فنية يقول ان فورة بن القر وهو القهر والأسد يقهر السباع وعن بعضهم أنه النيل كذلك راجع الطبري 29/168.
(85) تلخيص لما أورده ابن تيمية في المصدر السابق ص 51.
(86) المصدر السابق ص 53).
(87) جاء في كلام الدكتور زرزور عن تخريج هذا الحديث انه رواه الترميذي وقال حديث حسن صحيح من الترمذي 8/146 وشرح أبي داود 5/249.