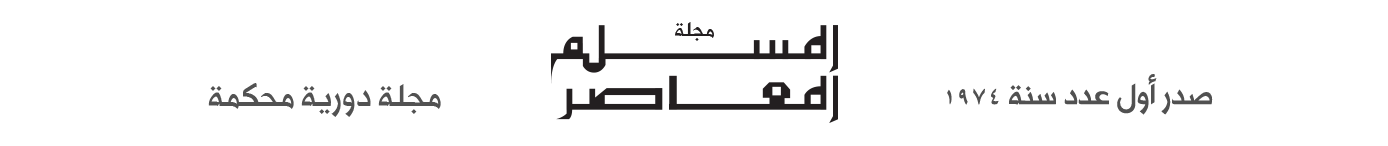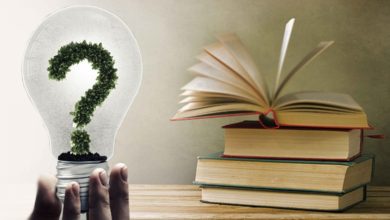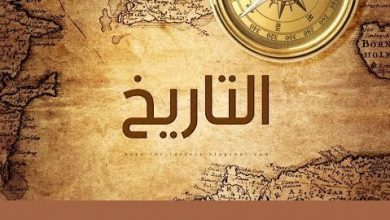إن “الاجتهاد المعرفي” هو كل ما يستهدف جلاء الفكرة الإسلامية لإخراج المسلمين من التقليد والجمود أو الاستلاب إلى طور حضاري جديد.
وتهتم الدراسة الحالية بإدراك الإشعاع الفكري الذي حققته مجلة “المسلم المعاصر” في مسار الاجتهاد المعرفي الذي بدأ مع حركة الإصلاح المعرفي الحديث وأسهمت المجلة في تأسيسه وتطويره وإعداد الكوادر المؤهلة له، وإبداع مجالات البحث والدرس المعرفي: اجتهادًا وتنظيرًا لبناء منظور حضاري لمجالات البحث والدرس العلمي والتعليمي.
وتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:
1- الوقوف على مفهوم “الاجتهاد المعرفي” وأطره الأساسية لدى مجلة “المسلم المعاصر”.
2- إدراك جوانب منهجية التعامل مع مصادر الاجتهاد لدى مجلة “المسلم المعاصر”.
3- الوقوف على المجالات البحثية والعلمية كتطبيقات لمفهوم الاجتهاد المعرفي في مجلة المسلم المعاصر.
4- التعرف على أبعاد المنظور الحضاري لتجديد العلوم الإنسانية لدى مجلة “المسلم المعاصر”.
واستخدمت الدراسة منهج تحليل المضمون- وذلك لتحقيق غرضين بحثيين أساسيين هما:
أولاً: استخراج أهم البحوث والدراسات التي تناولت مفهوم “الاجتهاد المعرفي” والمجالات العلمية والمعرفية المرتبطة به.
ثانيًا: اكتشاف المضامين المعرفية التي تقف خلف هذه المواد المنشورة واتجاهات القائمين بها؛ ومدى إسهامها في تأسيس مفهوم “الاجتهاد المعرفي” ومجالاته البحثية.
وتغطى الدراسة فترة صدور المجلة من يناير 1974م (العدد الافتتاحي) حتى العدد (159) مارس 2016م.
المحور الأول
الإطار الفكري لمفهوم “الاجتهاد المعرفي”
أعلنت مجلة “المسلم المعاصر” بدءًا من العدد الافتتاحي على صدر غلافها ميدان عملها المعرفي ووصفت نفسها بأنها “مجلة فكرية تعالج شؤون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية”، ثم عدلت هذا الوصف في العددان (51 – 52) إلى أنها “مجلة فكرية ثقافية تعالج قضايا الاجتهاد المعاصر في ضوء الأصالة الإسلامية”، وفي العدد (49) تعلن المجلة عن قواعد النشر وأشارت إلى أن “قضيتها الأساسية هي: “المعاصرة” وهذه القضية ذات مداخل ثلاثة هي: الاجتهاد، والتنظير، وإسلامية المعرفة”.
من خلال هذا التوصيف الذاتي يمكن أن نحدد مجالين أساسيين لعمل المجلة وانشغالها الفكري وهما: مجال الاجتهاد، والثاني مجال المعرفة أو ما أسمته المجلة بـ”التنظير” والذى عرفته بعد ذلك بأنه: “بلورة نظرية عامة للإسلام تؤدي إلى أغراض ثلاثة: أولها، أن تكون نقطة البداية لنظريات خاصة في كل فرع من فروع المعرفة، وثانيها: أن تكون بيانًا لتعريف غير المسلمين بكلياته، وثالثها: أن تكون ميثاقًا للمسلمين ينطلقون من مبادئه المتفق عليها لبناء حضارتهم المعاصرة”(1).
فالمجال الاستراتيجي لعمل مجلة “المسلم المعاصر” وفقًا لما أعلنته هو: “الاجتهاد المعرفي” من أجل الوصول إلى نظرية إسلامية في مجالات العلوم والمعارف الإنسانية تكون نواة للانطلاق الحضاري في عالم المسلمين المعاصر، وتستكمل به طريق الأمة الحضاري، وحركة الإصلاح المعرفي.
وسوف نتناول في هذا المحور مفهوم “الاجتهاد المعرفي” وأطره الفكرية أو كما وصفته المجلة “رسم معالم ومناهج الاجتهاد المعاصر”(2)، وذلك في العناصر التالية:
أولاً: “الاجتهاد المعرفي”، طبيعته
تحدد المجلة إطارها الفكري في العدد الافتتاحي من حيث أنها تعني أول ما تعني بالنشاط الفكري القائم على الاجتهاد بمعناه المعروف؛ بل تتجاوزه لفتح أفاق جديدة في الفكر الإسلامي في البحث والدرس” إنها مجلة فكرية… لا تتسع لكل بحث علمي، ولا تهتم بكل مادة علمية إنما تنتقي من هذا وذاك ما كان طابعه فكريًا يناقش الاتجاه والمنهج والأصول… وتهتم بعرض تراث الفقه الإسلامي عرضًا جديدًا ومقارنة أفكاره ومبادئه بالأفكار والمبادئ القانونية المعاصرة وتأصيل المبادئ القانونية الإسلامية “وتنظيرها”… ولكنها لا تقف عند هذا الحد، ذلك أنها مجلة الاجتهاد… الاجتهاد بمعناه المعروف في أصول الفقه.. تنطلق من ضرورة الاجتهاد وتتخذه طريقًا فكريًا، ولا تكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب الاجتهاد في فروع الفقه بل تتعداه إلى بحوث الاجتهاد في أصول الفقه، وتنطلق في طريق الاجتهاد باحثة عن المنهج والآفاق الجديدة التي يستأنف منها الفكر الإسلامي سيره الذي تجمد في الوقت الذي انطلقت فيه حضارة الثورة الصناعية الأولى حتى وصلت بنا إلى عصر الذرة والفضاء والثورة الصناعية الثانية”(3).
إن فكرة الاجتهاد في ذاتها تحمل بعُدين أساسيين هما: بُعْد الثبات، وبُعْد التغير أو المعاصرة، وهو ما أشارت إليه المجلة في صدر غلافها بهذه المقولة المعرفية التي تبرز هوية ذلك النشاط الفكري لها بأنها “فصلية فكرية تعالج شؤون الحياة المعاصرة على ضوء الشريعة الإسلامية”، ثم تفسر وتبين طبيعة ذلك الاجتهاد الذي تسعى إلى تحقيقه المجلة وتدعو إليه “فالاجتهاد الذي تدعو المجلة إلى ممارسته يتجاوز التراث مرتين: يتجاوزه مرة التجاوز الواعي الدارس المستفيد من التراث إلى أصول الهدى الإلهي الذي أنـزله الله، ويستتبع ذلك أن يكون اعتماده على المنابع الأولى: الكتاب والسنة، يستلهمهما المقاصد والأهداف ويستوحيهما المبادئ والأصول،… ويتجاوز الاجتهاد – الذي تدعو المجلة إلى ممارسته – التراث مرة أخرى واعيًا دارسًا مستفيدًا أيضًا ليلتحم بالعصر ناهلاً من علومه ومتفاعلاً مع قضاياه ومتفهمًالمشكلاته، ثم رائدًا متطلعًا لمستقبل أفضل”(4).
ومن ناحية أخرى فإن أهم مشاكل العصر الحديث لا تحل عن طريق سبل الاجتهاد المعروفة لأنها لا تصلح لها، وعدم الصلاحية لا يرجع هنا إلى نوعية الطرق، بل نوعية المشاكل التي يواجهها العصر الحديث. فمن جهة إن المسلم المعاصر سواء أكان من المتخرجين من الجامعة المتشربين لتعاليمها الغربية أو من أهالي المدن الذين تخلقوا بأخلاق المستغرِب، لم يعد يدين بالولاء لأي مذهب فقهي. ومن جهة أخرى: المشكلات التي تعترضه يتطلب حلها الخوض لا في الفروع بل في أمهات المبادئ التي يعتبر الاجتهاد فيها اجتهادًا مطلقًا. والاجتهاد المطلق اليوم بلا قواعد أحكم تنسيقها وتقديمها حسب ما تقتضيه المنهجيات الحديثة، فالمطلوب اليوم هو تنظير القيم الإسلامية أو المبادئ الأولى، أي ربطها ببعضها البعض بحيث تؤلف في مجموعها هرمًا يتسلسل فيه الفكر، بمنطق الضرورة، من طبقة إلى طبقة. وهذا يتطلب تحديد المبدأ الأول في الإسلام، ثم استنباط ما يحويه من مبادئ وتحديد أولوياتها وتفاضلها، بحيث يكون الهرم مقياسًا لما نريد أن نقيس عليه من مسائل العصر(5).
وتضيف المجلة بأن حركة “الاجتهاد المعرفي” في الأمة تساوق لحركة الإبداع وتحقق غاية الإسلام في الكون “إن الاجتهاد ظاهرة الفكر الحي والتأمل المبدع والوعي بالمسائل الجديدة وأحوال الحياة المتغيرة، وهو – أيضًا – ظاهرة لحركة في الوعي تنشد الشمول والعمق في تطبيق التوحيد – أي في تجسيمه في التاريخ- ولا معنى قط جدير بالاعتبار غير هذا لما أراد تعالى من “جعل كلمة الله هي العليا”(6).
سعت المجلة -أيضًا- في بنائها لمفهوم “الاجتهاد المعرفي” إلى تجاوز المفهوم التقليدي للاجتهاد عند السلف الذي انحصر في “عملية استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية أو مصادرها الأصولية. حيث أخذ المسلمون هذه العملية مأخذ التخصص القضائي، ففهموها على أنها لا تتعدى المحاكم الشرعية فيما يؤول إليها من مسائل”(7)، وانتقدت في نفس الوقت غياب تساؤلات الواقع الفكري الإسلامي عن العقل المسلم في علاقات الإسلام بذلك الواقع وردوده ومعالجته له”… فلم يتساءل المسلمون عن علاقة الإسلام بالآداب والعلوم والفنون التي بقت خارج تلك المسائل، ولا بالتجارة والزراعة والصناعة، ولا سبل العيش الأخرى من سياسية وعسكرية واجتماعية إلا ما اتصل منها بالقوانين والمحاكم، ثم فاق المسلمون من هذا السبات فوجدوا أن الأثاث في بيوتهم فرنجي، والملابس فرنجية، والعمارات فرنجية، وأن أدبنا أخذ في التفرنج مثل بقية فنوننا المرئية. بل إن لغة التخاطب عندنا كثيرًا ما تعتريها المصطلحات الفرنجية”(8).
ثانيًا: “الاجتهاد المعرفي”، الضرورة الحضارية
وقعت الأمة على المستوى الحضاري بين أمرين متناقضين أديا إلى حالة التراجع الحضاري التي تعيشه، أحدهما داخلي: تمثل في الجمود والتقليد اللذين نتج عنهما توقف فعالية الإسلام في الوجود الحضاري، والثاني خارجي: تمثل في المشروع التغريبـي الذي حاول استلاب الإسلام من نفوس المسلمين وواقعهم الاجتماعي، ومن هنا كان “الاجتهاد المعرفي” الذي أطلقته المجلة يهدف إلى “حماية الإسلام من اثنتين: التيبس والتسيب…”(9).
و”الاجتهاد المعرفي” في هذا الإطار الحضاري يعمل على “تنفيذ مهمة مزدوجة: الحفاظ على هندسة الإسلام نفسه، من جهة، وتحقيق انطباقه الباهر على الواقع التاريخي – من جهة أخرى – أي على بعدى الزمن والمكان.. ولن يكون ذلك إلا لصالح (الإنسان) ومكانته المتفردة في العالم”(10).
أوضحت المجلة – أيضًا – أن الأمة اليوم بحاجة إلى ما أسمته “فقه جديد” يمكن من خلاله الإسهام في حل إشكالية “الوعي” ومواجهة “الجمود والتقليد” الحادثين في حركة الأمة. وتشير في ذلك إلى معنى جديد لمفهوم “الفقه” “فليس المراد بالفقه: العلم المعروف الذي اصطلح على تسميته (فقهًا) والذي يعني: معرفة الأحكام الشرعية الجزئية من أدلتها التفصيلية، من مثل أحكام الطهارة والنجاسة والعبادات والمعاملات وأحكام الزواج والطلاق وغيرها… وإنما نقصد بالفقه [الذي تحتاجه الأمة اليوم]: المعرفة البصيرة بسنن الله في الأنفس والآفاق وسنن الله في خلقه، وعقوباته لمن انحرف عن صراطه. مثل قوله r:“من يرد الله به خيرًا يفقهه” في الدين”،والمعنى أن ينير الله بصيرته فيتعمق في فهم حقائق الدين، وأسراره ومقاصده، ولا يقف عند ألفاظه وظواهره”(11).
وتطالعنا المجلة بطرح مفهوم “فقه الحياة” تحت عنوان “فقه الحياة: نحو اجتهاد معاصر” وأشارت في توضيح المقصود بهذا المفهوم ومضامينه المعرفية إلى أن فقه الحياة “ليس قاصرًا [من ناحية الشكل] على مجرد العلاقة الخطية البسيطة بين عناصر المنظومة [منظومة فقه الحياة]، فليس أمر الشرع مجرد ثنائية مكونة من “الفعل” و”الحكمة”، ولكنها حركة متكاملة بين مجموعة المفردات المكونة للمنظومة (منظومة فقه الحياة المقترحة والتي تستند إلى خمسة عناصر وهي: المقاصد الشرعية، والقيم الإنسانية العليا، والسنن الحاكمة، والغيب بقسميه: المطلق والنسبي والأحكام الشرعية أو الإطار التشريعي الحاكم لفعل المسلم) والتي تؤدي إلى تبني مواقف نابعة من مَعين الرؤية الإسلامية الشاملة، ليس على أساس الاكتفاء بمعرفة الحكم أو الفتوى فقط، ولكن على أساس من استلهام النموذج ومعرفة المقصد وتشرب القيم، التي عبَّرت وتعبر عنها شريعة الإسلام بكل ما تحمله من اتساق وكمال ورحمة بالعالمين”(12).
وفقه الحياة – أيضًا – أداة تجديد معرفي للأمة: وذلك بما يقدمه من إمكانيات لقراءات جديدة للتراث والمعاصرة، قراءات بأدوات من جوهر الإسلام نفسه، متسقة مع معدن التراث، وذات قابليات عالية لاستيعاب المستجدات، وإخراج المسلم والأمة من حال الحرج إلى حال السعة…كما تتوفر من فقه الحياة أداة تجديد معرفي بمعنى الإبداع في مجالات المعرفة الحديثة بالوقوف على نظريات ومداخل جديدة في العلوم الاجتماعية والإنسانية مصدرها المرجعية الإسلامية، وتجيب عن مطالب الواقع الحالي(13).
وتتمثل الضرورة الحضارية للاجتهاد المعرفي في تحقيق ما يلي:
أ. تشكيل أوضاع المجتمع بما يلائم أصول العقيدة والإسلام.
ب. وضع الاجتهادات بما يتلاءم مع مصالح الجماعة وإشاعة العدل.
ج. إدراك وجوه التحديات الحقيقية التي تواجه الجماعة، ويعمل اجتهاداته بما يحقق الاستجابة السليمة لهذه التحديات بما يتجه إلى نفع الأمة، ويربط بين الحلول الفكرية المستخلصة والوظائف الاجتماعية المتطلبة(14).
الضرورة الحضارية التي يقدمها “الاجتهاد المعرفي” تحمل في مضمونها التجديد المعرفي، وتطبيق الإسلام على الواقع الاجتماعي المعاصر، وتحقيق المشاركة الحضارية، وبعث الفعالية الإسلامية، والحفز العقلي لإدراك المسلمين للسنن الكونية في قيام الحضارات وقوانين السقوط، والاعتبار لمقاصد الدين حاكمة للنشاط الفكري والاجتماعي في واقع المسلمين.
ثالثًا: “الاجتهاد المعرفي”، مصادره
يسعى “الاجتهاد المعرفي” إلى بناء مداخل علوم إسلامية تكون بمثابة نظرية أو مقدمات منهجية لتجديد العلوم الإنسانية، وفي هذا الصدد حددت المجلة مصادر هذه المداخل وتلك المنهجيات، وهناك بالطبع مصادر أصلية هي العقل والوحي ومصادر فرعية مثل الواقع والتراث.
وتُبَيِّن المجلة اختصاصات العقل والوحي كمصدرين أصليين للمعرفة في الإسلام وحدود العلاقة بينهما، فالعقل واختصاصه النظر في ملكوت الله في السموات والأرض أي في الكون وحوادثه. ويعين العقل الحواس من السمع والبصر والتجربة، ودليل مرشد للمصدر الثاني وللتحقق من صحته وسلامته. والمصدر الثاني هو الوحي إلى الأنبياء الذين اختارهم الله، والعقل- أيضًا- هو الطريق لإثبات نبوة النبي الصادق، ورد نبوة المتنبئ الكاذب. ودليل ذلك استعمال الأدلة في القرآن لإثبات نبوة الأنبياء جميعًا وخاصة خاتم الأنبياء. أما الوحي فهو مصدر مباشر للحقائق من مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الإخبار الإلهي المباشر للأنبياء بطريق لا مجال كذلك للعقل ليعرف كنهها ولكنه يستطيع معرفة جزأ منها وآثارها(15).
وفيما يتعلق بحدود كل من الوحي والعقل نلاحظ “أنه يدخل في اختصاص الوحي تحديد العبادات التي أمر الله عباده بها، وكل ما ورد عن طريق الوحي ودل عليه النص دلالة قاطعة، لا مجال فيها للتفسير والتأويل- ولو كان من اختصاص العقل- فالوحي أولى به. لكنه الطريق الأوثق والأكثر دلالة على اليقين الذي لا خطأ فيه.. وهناك مواطن يشترك فيها الوحي والعقل معًا. فالوحي يضع معالمها الأساسية وخطوطها الكبرى وقواعدها العامة، ويتـرك للعقل تفصيلها، أو يذكر حكمًا ويتـرك للعقل القياس عليه”(16)، وتضيف المجلة أيضًا ثلاثة مصادر أخرى هي: “التراث بمختلف فروعه، والحضارة الحديثة، وواقع العالم الإسلامي، إمكاناته وتطلعاته ومعوقات انطلاقه”(17)، كل هذه المصادر ينبغي أن تشكل معينًا ومنبعًا للاجتهاد المعرفي.
رابعًا: “الاجتهاد المعرفي”، تحدياته وتساؤلاته المركزية
يواجه “الاجتهاد المعرفي” ثلاثة تحديات أساسية هي تحدي البقاء وتحدي البناء وتحدي النماء، وهي تحديات حضارية تواجه الأمة، ولا يمكن تحقيق التطور الحضاري المنشود إلا بمواجهة تلك التحديات، وهذا جانب توعوي لحركة الاجتهاد التي قادتها المجلة منذ نشأتها،”… وتحدي البناء ينصرف لعمليتين مهمتين (بناء الدولة ومؤسساتها) (وبناء الأمة وعلاقاتها)، أما تحدي البقاء فهو يعني الحفاظ على أصل الوجود الفعال والقدرة على التمكين له، ولا شك أن هذا التحدي ينصرف لعمليات تتعلق بالشروط الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكفيلة بإحداث واستمرار القدرة على فن البقاء الفعال. أما تحدي النماء، فإنه نتاج للتفاعل بين القدرة على البناء والقدرة على البقاء معًا، بما يحقق أطرًا لتعظيم الفاعلية والقدرة والتمكين، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات لإعادة البناء، والقدرة على التصحيح الذاتي، والقدرة على إحداث حالة من التنظيم والتعظيم”(18).
ويمكن الإشارة إلى خمسة قضايا أساسية يحاول “الاجتهاد المعرفي” أن يجيب عنها وهي:(19)
أ. البناء الدعوى والبناء التربوي.
ب. فهم الإسلام: فهناك خلل واضح في فهم كثيرين للإسلام وقصور واضح في الوعي بتعاليمه، ومراتبها، وأيهما الأهم وأيهما المهم، وأيهما غير المهم.
ج. معرفة الواقع: فهناك عجز في المعرفة بالحاضر المعيش والواقع المعاصر.
د. معرفة الآخر: فهناك جهل بالآخرين، نقع فيه بين التهويل والتهوين… مع أن الآخرين يعرفون عنا كل شيء.
هـ. معرفة الذات: وهناك جهل بأنفسنا، فنحن إلى اليوم لا نعرف حقيقة مواطن القوة فينا ولا نقاط الضعف لدينا.
خامسًا: “الاجتهاد المعرفي”، منطلقاته
يمكن استخلاص عدد من المنطلقات الأساسية للاجتهاد المعرفي لدى مجلة “المسلم المعاصر” وهي:
1- استحضار القوة الوجدانية الحضارية الذاتية: تنطلق المجلة في تأسيسها لمفهوم “الاجتهاد المعرفي” من: استحضار القوة الوجدانية الحضارية في التعامل مع الواقع ومع الآخر ومع الذات، وهي تمثل بذلك المرحلة الثالثة لحالة الفكر الإصلاحي الإسلامي في العصر الحديث، والذي بدأ بمرحلة “ردود الأفعال” على حالة النهضة/ الحضارة الغربية المعاصرة والتي اتسمت بالتعبئة العاطفية في الكتابات آنذاك والانكفاء على الذات خوفًا ورهبة، ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة “المقارنات والمقاربات” بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي (صاحب النهضة الحضارية المعاصرة) ومحاولة إثبات تفوق الذات للحفز النفسي حتى وإن كان مع غياب الرؤية العلمية والمنهجية العلمية، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة استحضار القوة الوجدانية الحضارية في التعامل مع الفكر الغربي من ناحية وواقع الأمة من ناحية ثانية، وتراثها من ناحية ثالثة، ومستقبلها من ناحية رابعة.
وهنا تؤكد المجلة أنها تسعى “إلى تخطى مرحلة رد الفعل الدفاعية… إلى مرحلة الإنتاج الإيجابي المبدع الخلاق المستقل عن مؤثرات الاستعمار والتخلف وردود الفعل الأولى سواء منها ما تقوقع مدافعًا عن تراث الماضي أو ما انطلق في تيار التغريب… لذلك تحاول المجلة تعرف الهوية الحقيقية لهذه الأمة وأفكارها في هذا الزمان بكل ظروفه وأبعاده، تعرفًا واعيًا إيجابيًا مبدعًا خلاقًا مستقلاً “(20).
2- طبيعة الإسلام ذاته: إن الدين الإسلامي وهو دين الله الخالد، دين شامل يتناول حياة الإنسان (كفرد وكجماعة) من كل جوانبها، ويربط بين الحياة الدنيا والآخرة (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) (القصص:77). ولذلك فهو لا يقتصر على العبادات والعقائد بل يشمل – أيضًا – حياة الإنسان الصحية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والإبداعية والفكرية والأخلاقية والوطنية والدولية… إلخ. وهذا يتطلب حركة اجتهاد ترشد وتوجه الإنسان المسلم في شؤون حياته كلها.
3- إقرار الإسلام بسنة التغير والتطور الاجتماعي: فالتغير هو سنة الحياة والكون، وهو ما يلزم حركة الاجتهاد في الإسلام أن تلم بتغير الظروف وتقدر نتائجها وتراعى الثابت والمتغير في الشريعة للمشاركة في التطور الاجتماعي والحضاري.
4- دمج النظرة إلى العلوم: فلا يصح تقسيم العلوم إلى دينية ودنيوية، فالعلوم كلها دينية والتقنيات كلها دينية، وآيات الله تتجلى في علوم الدين والدنيا على السواء. وعلى هذا فعالِم الدين مؤهل لأن يدرس علوم الدنيا والدين على السواء، كما أن العالمين بعلوم الدنيا في وسعهم أن يدرسوا العلوم الدينية. فكل العلوم وكل الفنون والمخترعات هي منح إلهية للإنسان فهي دينية(21).
5- الرؤية الشاملة للإسلام: الاجتهاد في حقيقته الإحيائية التي تسعى المجلة إلى بعثها من جديد هو “رؤية عامة شاملة لجميع مرافق الحياة تؤثر في كل عمل وكل دقيقة من حياة المسلم… وهذا يتطلب: تعميم الاجتهاد وتوسعته لأنه سبيلنا إلى ذلك لاستحضار – أي جعل الإسلام حاضرًا في كل مناهج الحياة – والتنشيط أي جعله مؤثرًا في حياتنا… والمجتهد المعاصر [المنشود] يعتقد أن الشمول صفة الإسلام، وبالتالي لفقه الإسلام وهو لا يريد أن تكون الإطارات غير الفقهية خارجة عن نطاق الفقه… فقد برهن العصر الحديث على أن لهذه الإطارات أهمية كبيرة، فإذا لم نعن بتطويعها لمنطق الإسلام وحكمه وقيمه فإنها لا شك مطوعة لخدمة الحضارة الغربية. فمن منا لا يرى اليوم ضرورة “أسلمة” الأدب؟ وأسلمة العلوم الحديثة؟ من علم تربية إلى علم اجتماع إلى علم نفس إلى علم تاريخ؟ أسلمة الفنون المرئية والسمعية من عمارة وتزيين ورسم وموسيقى؟ أسلمة مواد الترفيه من راديو وتلفزيون ومسرح وسينما؟ أسلمة مدارسنا وجامعتنا التي لا تزال تبث سموم الاستغراب والعلمنة؟ أسلمة الكثير من عاداتنا الاجتماعية المستوحاة من “الاستغراب” و”المستغرب” “مثال الحضارة”؟(22)
سادسًا: “الاجتهاد المعرفي”، وظائفه
تتمثل وظائف “الاجتهاد المعرفي” كما تناولتها المجلة فيما يلي:
1- الإحياء والتجديد: الهدف من الاجتهاد اليوم هو إحياء الشريعة والقيم الإسلامية والخروج من التخلف العلمي والضعف المادي، فإن المنهج الاجتهادي يجمع حتميًا بين العمل لتثبيت الإسلام رسالة وكيانًا وشريعة ونظامًا، والعمل لترقية المجتمع الإسلامي علميًا وحضاريًا. وهذا المنهج لا يتحقق إلا في الصلة العملية المتينة بين الخبرة العلمية التشريعية والخبرة العلمية والتقنية الحديثة(23).
2- تقديم البديل الملائم للعصر: يقوم “الاجتهاد المعرفي”- أيضًا – على قراءة واقعية للحاضر لاسيما حاضر النهضة الغربية، ويكون ذلك على مستويين، الأول: المستوى النقدي لها ولآثارها في واقع الإنسانية، والمستوى الثاني: هو تقديم البديل الذي يغني عنها وعن آثارها السلبية للإنسانية، ومن ثم فإن “الاجتهاد المعرفي” في المنظور الإسلامي “يجابه واقع الحياة المادية الطاغية الباغية، ويعالج ما فيها من قصور وخلل وظلم للبشر وعبادة للمادة وبُعْد عن الدين والقيم المعنوية السليمة والقواعد الأخلاقية الفطرية، أن انتقاد هذه الحضارة يبقى عبث لا طائل تحته بل هو هزل لا جد فيه حتى تأتي ببديل ذي دليل قاطع في صحته واستقامته، دليل يقبله المنطق البشري الحديث القائم على البحث العلمي التجريبـي والمعتمد على الاستقرار والاستنباط”(24).
3- التأصيــل: والتأصيل كعملية معرفية ضرورية للتجديد والإحياء الإسلامي في مجالات العلوم الإنسانية يتطلب “فهم سليم للتراث الإسلامي وعرض جديد له حتى يُفهم على ضوء ما نعيش فيه من بيئات جديدة منبتة عن الماضي، ثم تؤصل الأفكار والأحكام وتوضع النظريات العلمية على أسسها المقررة الحديثة وإن قامت في واقع الأمر على المنطق القديم من استقراء واستنباط وبديهة أولية. ثم إنه لابد للاجتهاد من أسانيد راسخة يقوم عليها، سواء أكان ذلك اجتهادًا في الفقه ذاته أم في “أصوله”(25)، حيث “تبدو الحاجة شديدة إلى إخراج “المثالية” الإسلامية في ثوب جديد يتماشى مع روح العصر وأسلوبه في القول والعمل”(26).
4- تنـزيل القيم الإسلامية على الواقع المعاصر: جوهر “الاجتهاد المعرفي” هو عملية التنـزيل القيمي على الواقع الاجتماعي في عالم المسلمين اليوم “يجب – أيضًا – أن ينـزل الفعل الإسلامي المتفرد المتميز، إلى العالم، في إيقاع متوحد، وتوافق منظور، وتناغم شامل بين كل جزيئات الفعل وأطرافه..فإن لم يعن الفعل الاجتهادي على تحقيق هذا التوحد والتوافق والتناغم بين المعطيات والتعابير الإسلامية، وبينها وبين العالم، فمن يتولى هذه المهمة؟”(27)، “… إن الإسلام حركة باتجاه (التوافق) مع سنن الوجود والعالم، وإيقاع الكون والطبيعة، فأحرى به أن يكون متحققًا بالوفاق مع نفسه…أي بعبارة أدق: أن يكون كل تعبير إسلامي، في هذا الجانب أو ذاك من الحياة، وإزاء هذه القضية أو تلك من قضايا الوجود والعالم… يحمل إيقاعه المتوحد مع سائر التعابير عن الجوانب الأخرى من الحياة، والقضايا المتنوعة من الوجودوالعالم”(28).
5- بناء المنظور الحضاري: يسعى “الاجتهاد المعرفي” – أيضًا – إلى بناء منظور حضاري يمكن من خلاله تفسير الظواهر الاجتماعية والثقافية والسياسية المختلفة وهذا يتطلب:
– تقديم رؤية الفكر في الماضي بتمييز الكتاب والسنة عن آراء العلماء وتطبيقات التاريخ، وبلورة ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من مقاصد وأهداف.
– تقديم رؤية الفكر في الحاضر بالمحافظة على نقاء الأصول من التيارات الوضعية بين الشرق والغرب.
– تقديم رؤية الفكر في المستقبل بالاهتداء بالأصول في حل مشاكل العصر ودفع عجلة الحضارة نحو السلام والعدل والإحسان.
– تقديم رؤية لواقع المسلمين وواقع الناس حولهم.
– تقديم رؤية الطريق – وهي تالية لرؤية الفكر ورؤية الواقع.
إن بناء هذا المنظور الحضاري يتطلب بدوره تحديد المنهج والمنهاجية التي تساهم في بناء هذه الرؤية وهذا المنظور، إذ بدونهما يكون السير أقرب إلى العشوائية ولا يحقق انتظامًا فكريًا “والطريق [المنهج] خط يصل بين نقطة الواقع ونقطة الهدف، فإذا تعذرت رؤية كلا النقطتين كان طبيعيًا أن نخبط في أي اتجاه أو ندور حول أنفسنا ونعود من حيث بدأنا… وتقديم رؤية الطريق تتطلب: دراسة طريق نهضة الأمة ووضع مخططاته ومعرفة مراحل سير الأمة وما يلزم الطريق من زاد”(29).
6- التخلية والتحلية المعرفية: إن عملية التجديد و”الاجتهاد المعرفي” التي تسعى المجلة إلى تحقيقها تتطلب القيام بعمليتين ضروريتين هما (التخلية والتحلية)، التخلية لكل ما أصاب العقل والأمة المسلمة من تشوه في رؤاها وجمود أو تغريب في منهجية تفكيرها خلال القرون الماضية، وهذا يتطلب أن يقوم “الاجتهاد المعرفي” بثلاث عمليات معرفية مهمة هي كالتالي:(30)
العملية الأولى: إعادة اكتشاف الإسلام، أو إعادة التحرر من آثار التشويه والانحراف الذي أصاب الإسلام في فهم المسلمين له، وكانت له نتائج سيئة، حيث أدى هذا التشويه الفكري النظري إلى التخلف والضعف. وكانت نتائجه – لدى فئة أخرى اتصلت بالثقافة الأوروبية الحديثة- الابتعاد عن الإسلام، وسوء الرأي فيه ظنا منهم أن هذه الصورة المشوهة الموروثة هو الإسلام.
العملية الثانية: التحرر من نقائص الحضارة الأوروبية الحديثة، الفلسفية الفكرية والعملية السلوكية، مع استبقاء مكاسبها الصالحة النظرية والعملية.
العملية الثالثة: إحلال الإسلام – باعتباره نظامًا عقائديًا كاملاً – أي بعقيدته ونظمه المتفرعة عنها محل الثقافتين: ثقافة العصور الوسطى الإسلامية المتجمدة والمشتملة على انحرافات، وثقافة الغرب القائمة على الفلسفة المادية والأهداف المادية… وتنطلق مقابلة هذه النظم العقائدية والأيديولوجية القائمة بنظام عقائدي إسلامي ينطلق من المضمون الأساسي للنظرة القرآنية، ومن المشكلات المعاصرة، ومن الأزمات الماثلة في الأنظمة الحديثة، بغية حلها في ضوء تلك النظرة… محتفظًا في إطاره بمنجزات الحضارة الحديثة ومكاسبها في ميدان العلوم وفي ميدان الصناعة، مادامت قابلة للدخول في أطر الإسلام العقائدية والأخلاقية.
سابعًا: “الاجتهاد المعرفي”، مرتكزاته ومبادئه
حددت المجلة عددًا من المرتكزات والمبادئ التي يقوم عليها الاجتهاد المعرفي وهي كالتالي:
1- التوحيد: تتمحور منهجية “الاجتهاد المعرفي” حول المبدأ الأساسي للإسلام والنواة المركزية فيه وهي “التوحيد” والذي من خلاله يمكن معالجة قضايا “الاجتهاد المعرفي” المعاصر، وتطرح المجلة في عددها التاسع جملة تساؤلات من شأنها المساعدة في طرح منهجية لتلك المعالجة “… فإذا صح، تبيَّنت لنا ماهية التوحيد وهو فحوى الإسلام، استطعنا أن نطرح السؤال التالي وهو: ما علاقة التوحيد بالمسألة التي نواجهها؟ أو بالحقل النشاطي الذي نحن بصدده؟ كيف فَهَم سلفنا هذه العلاقة – وهو الجانب التاريخي – ثم كيف نتفهمها اليوم- وهو الجانب التنظيري – لفكرنا الحديث وموقفنا في الحياة”(31)، “إن المنهجية الاجتهادية منهجية توحيدية قوامها أولاً الشمول والإحاطة بأبعاد الوجود الكوني، وبالبشر أجمعين، وبالأمة قاطبة ثم بالحياة بشتى جوانبها ووجوهها أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما اتصل منها بشأن السلطان أو ما لم يعن إلا خويصة النفس. وقوام المنهجية الإسلامية ثانيًا العدل والاستقامة والقصد والتوازن بلا إفراط أو غلو أو شطط في الاستقطاب بين الفرد والمجتمع أو المجتمع والسلطان. وبين الإجمال والتفصيل أو التنظير والتطبيق أو القطعية أو المرانة، وبين الظاهر والباطن أو الغيب والشهادة أو الوحي والعقل وبين الطلاقة والنظام أو الشكل والجوهر ونحو ذلك مما يبدو متباينًا في نظر الإنسان ومما يهدد بأن يفرق حياته ويشقها”(32).
2- المقاصد: ومن مرتكزات بناء مفهوم “الاجتهاد المعرفي” مقاصد الشريعة ومقاصد العلوم ، كل العلوم الإنسانية، ويتطلب ذلك اكتشاف تلك المقاصد وإعادة بناء العلوم والمعارف في ضوئها ، ويتطلب ذلك –أيضا- “استخراج الكليات والمقاصد الشرعية من الفرعيات والأحكام التفصيلية ومحاولة استخلاص نظرة الإسلام العامة في كل فرع من فروع العلم، وعقد المقارنات بينها وبين الفلسفات والآراء الوضعية… ولا تقتصر الحاجة إلى ذلك على العلوم الشرعية بمفهومها التقليدي بل تمتد لتشمل الاقتصاد والاجتماع والتاريخ والتربية، بل تتعدى العلوم الإنسانية إلى العلوم الطبيعية، فهي كذلك بحاجة إلى إعادة كتابتها من وجهة نظر إسلامية”(33)، وهذا يعني أيضًا العناية بالكليات والمبادئ أي “تجاوز الوقوف والاختلافات على الجزئيات والتفاصيل الدقيقة، وجعل الاهتمام ينصب على الكليات ذات الطابع النمطي الذي يمكن أن يقاس عليه أو يشابهه من تفاصيل وجزئيات”(34).
3- الإسلاميــة: وهي فهم مقاصد الشريعة الحضارية وإرادة تحقيقها والولاء لها. ويمكن تبرير ذلك بحجتين، الأولى إرادية، والثانية تفهمية، تقول الأولى: أن “الإسلامية” شرط سابق لشروط الاجتهاد المذكورة [في كتب السلف] ذلك أن شروط الاجتهاد السلفية شروط مصنفة للاجتهاد بينما شرط “الإسلامية” هذا شرط موحد، فالمجتهد العالِم بطرق استنباط الأحكام المتبحر في اللغة والملم بمناهج الجرح والتعديل أعلم من غيره بالاجتهاد، ولكنه إذ لم يتصف بالإسلامية يكون مناقضًا لنفسه، أما الحجة الثانية وهي – التفهمية المنهجية – فتقول: أن للأحكام التي ينشدها المجتهد مقاصد تعلو عليها، فلابد من تفهم تلك المقاصد أولاً. لكن المقصد النهائي الذي لا مقصد بعده لحكم ما هو القيمة، والقيمة لا تفهم إلا بتحبيذها [أي تقديرها وجدانيًا] فعلاً بينما انتفاء الإسلامية يعني انتفاء تحبيذها قيم الإسلام(35).
4- الحرية: تؤطر المجلة مفهوم “الاجتهاد المعرفي” بإطار مبدئية “الحرية”، وتعتبره مرتكز أساس لهذا المفهوم، وتحدد المقصود منه بأنه “الحرية من القيود المذهبية القديمة، والحرية من الالتزامات الحركية الحديثة، وحرية الكلمة عمومًا بكل ما تحمل من مظاهر وخصائص… وبحكم هذا الطابع تعالج المسائل من وجهة موضوعية منطلقة من وحدة الأمة الإسلامية لا من زاوية أحد مذاهبها الفقهية أو جماعاتها الحركية”(36).
5- الانفتاح الفكري: طرحت المجلة – أيضًا – في عددها الافتتاحي المؤسس لاتجاه المجلة الفكري، خاصية “العالمية” فيما يتعلق بمحتواها البحثي النظري والتطبيقي “فالأبحاث التطبيقية إلى جانب الأبحاث النظرية، لا تقتصر على النطاق المحلي بل يمتد إلى العالم الإسلامي بل العالم الإنساني كله، إذ أن التأثير المتبادل بين مختلف أرجاء المعمورة وأجناس البشر يزداد يومًا بعد يوم حتى ليكاد يصبح العالم كيانًا واحدًا… وهذه النظرة العالمية التي [سوف] تنتهجها المجلة تستتبع احتكاكًا علميًا على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، كما تستتبع متابعة الدراسات الاستشرافية في كافة صورها التقليدية والحديثة… ومن هذا وذاك تستشرف المجلة آفاقًا عالمية واضحة، وتسهم في إقامة جسور الحوار بين الفكر الإسلامي وغيره من الأفكار والمبادئ والتيارات”(37).
6- الإدراك القيمي للإسلام: أكدت -المجلة- أيضًا على ضرورة الإدراك القيمي للإسلام فيمن يقوم بعملية “الاجتهاد المعرفي” لأنها الجانب الأعلى في الإسلام وهو المراد تنـزيله إلى الواقع الاجتماعي للناس “… لابد للمجتهد المعاصر من إدراك قيم الإسلام بهيكلها الهرمي، إذ القيمة هي ما يجب أن يكون أما الحكم فليس إلا وسيلة من وسائل تحقيقها، ومن المحال أن تتعارض الوسيلة مع المقصد الرامية إليه، فإن فعلت فهي وسيلة لغيره لا له. ومن ثم يصبح من المحال أن يؤدي الاجتهاد إلى تعطيل الحكم ويسمى اجتهادًا لأن التعطيل مضاد للعلاقة بين الوسيلة والقصد. هذا بالإضافة إلى أن القيمة – كما يبين علم النفس الحديث – لا تعرف ولا تفهم إلا بشئ من التحبيذ لها. ففهم القيمة ليس مهمًا نظريًا صرفًا كفهم المعاملة الحسابية، بل يشارك فيه الحدس العاطفي والعقل النظري وهذا لا يتوفر إلا بالإسلامية”(38).
7- التجريد والواقع: يعالج هذا المبدأ الانفصال الذي يمكن أن يحدث بين النظر والواقع أو بين الفكرة والتطبيق بدعوى تباين هذين الطرفين، أو عدم القدرة على تحقيق التوازن بينهما، ويؤكد هذا المبدأ على ضرورة التقاء “الفكر والواقع” في ذهن المجتهد أو ما يعرف بخاصية “التوازن”. “فلابد من توازن في منهج فهم الفقيه للنصوص. يوحدها إلى واقعها عند التنـزيل ولا يلتمس معناها في المدلول اللغوي والسياق النحوي وحده بل في السياق الظرفي والنفسي… إن الحياة مادة أحكام السلوك البشري ومنها غذاؤها، فأيما قطيعة بين الفقه والواقع لا تكون إلا على حساب ثراء الفقه وجدواه، لاسيما بالنظر إلى فقه ديني لا ينفصل عن الواقع النفسي لأطرافه البشرية والواقع الاجتماعي لحيثياته وآثاره، لأنه موصول بالعقيدة والآخرة والأزل وبكل نظم الحياة ومغازيها”(39).
8- الوحدة والتوازن: يقوم هذا المبدأ على فرضية الاتساق والانسجام بين مكونات الخلق والكون، ونفي مبدأ الصراع أو التناقض، وهي من خصائص التصور الإسلامي المستقيم والشخصية الإسلامية السوية “إن منهج الوحدة يتجلى في الخلق وفي الأمر كله. فسنن الله اللازمة في الطبيعة تتسق مع سنن الله التكليفية في الشريعة، ولذلك كانت فطرة الإنسان – وجدانًا عاطفيًا وتفكرًا عقليًا – مناسبة للوحي، فكل ذلك من الله، وخطاب الله للفرد المعين تكليفًا وحسابًا فرديًا يتسق مع خطاب الله للجماعة، ويتحد تدين المؤمن من حيث هو فذ مع حركة المؤمنين من حيث هم جماعة في معادلة متوازنة”(40)، والتوازن أيضا يعني التوازن بين النظرية والتطبيق بمعنى “تحقيق قدر من الوفاق المرن بين النظرية والتطبيق، أي بين تقديم حلول جاهزة للعمل على أرض الواقع، وأخرى تنتظر التجربة على هذه الأرضية”(41).
9- سلم الأولويات: ويعني هذا المبدأ مراعاة طبيعة التحديات المعاصرة على المستويات كافة من خلال سلم أولويات يتقدم فيه الأهم على المهم على الأقل أهمية، وتتولى أمره لجان عمل دائمة أو مؤسسات تكون مهمتها – كذلك – ملاحقة المستجدات وإدراجها وفق صيغتها النمطية على الخارطة التى يتوجب أن تظل مفتوحة لتقبل المتابعات الجديدة(42).
10- البعد العملي: ويقصد به طرح برنامج عمل مرحلي لتنفيذ الاجتهاد المعرفي على عدد محدد من المسائل الملحة التي تقتضي حلولاً، من مثل طرح تصور اجتهادي لما يتوجب أن يكون عليه المجتمع المسلم في نهاية القرن العشرين، وذلك بتحديد مدروس لكافة أنماط العلاقات الاجتماعية، بما فيه الموقف من الأنشطة والمؤسسات المالية والاقتصادية… وغيرها مما يدخل في أولويات العمل الاجتهادي.
ثامنًا: “الاجتهاد المعرفي”، متطلباته وشروطه
يحتاج “الاجتهاد المعرفي” إلى عدة متطلبات أهمها المتطلبات البشرية بتوفر الكوادر العاملة والمتخصصة في الفروع العلمية المختلفة، وقد أشارت المجلة إلى نوعين من المتطلبات الأساسية لتحقيق “الاجتهاد المعرفي” والإسهام في تحقيق مضامينه الحضارية وهي المتطلبات العلمية والفكرية: وتعني الشروط العلمية التي ينبغي أن تتوافر في إعداد “المجتهد معرفيًا”، وهذه الشروط حققتها المجلة في قسمين: الأول: الشروط / المتطلبات العلمية التقليدية الموجودة في كتب إعداد المجتهدين في التراث الإسلامي، والثاني: الشروط / المتطلبات العلمية الحديثة بما يتوافق مع طبيعة مفهوم “الاجتهاد المعرفي” ووظائفه الحضارية المعاصرة. والنوع الثاني، المتطلبات المؤسسية: وتعني مأْسَسَة “الاجتهاد المعرفي” وتطوير أداءه من الفردية والتناثر إلى الجماعية والتكامل. ومن هذه المتطلبات والشروط التي أكدت عليها المجلة لتحقيق “الاجتهاد المعرفي” ما يلي:
1- متطلبات علمية تقليدية: أشارت المجلة إلى جملة من الشروط التي ينبغي أن توفر فيمن يتصدى للاجتهاد المعرفي وهــي:(43)
– العلم بالقرآن والسنة وعلومهما.
– فقه روح التشريع ومبادئه العامة والمقاصد التي جاء الإسلام لتحقيقها، وأن يستقرئ العلل التي بني عليها التشريع، والأصول التشريعية العامة التي وردت صريحة أو ضمنية في القرآن والسنة.
– العلم بلسان العربية وعلومها.
– العلم بأصول الفقه وعلومه.
– العلم بأحوال البيئة التي يعيش فيها.
2- التخصص العلمي: قد بلغت البحوث العلمية والتطبيقية من الضبط والدقة والتوسع والتفرع حدًا لم يعد معه في وسع أي إنسان أن يلم بأكثر من فرع من العلوم، وهذا يستدعي إعداد المجتهد من خلال نوعين من الدراسة: الأولى دراسة عامة واسعة في العلوم لرؤية الكل، ثم الشروع في التخصص في المرحلة الثانية. ويستحسن أن يقترن اختصاص المجتهد في العلوم الدينية باختصاص آخر كالرياضيات أو العلوم أو التاريخ إلى غير ذلك، أو بمهنة كالطب أو الفلاحة أو الاقتصاد أو غير ذلك(44).
3- التواصل الحضاري: على طالب الاجتهاد أن يكون منفتحًا على العالم ولاسيما فيما يتعلق باختصاصه في العلوم الدينية أو العلوم الدقيقة: فيتعرف على النشاط الذي يمارسه أبناء سائر الأقطار الإسلامية. وهذا يتطلب إتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل إلى جانب إتقان العربية(45).
4- معرفة أحوال الأمة: على المجتهد – أيضًا – أن يكون عالمًـا بأحوال أمته وما تحويه من إمكانات، وما تعاني منه من جوانب جهل وتخلف وفساد واستبداد من جهة أخرى(46).
5- معرفة المدنيات الأخرى: على المجتهد – أيضًا- أن يتعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف في المدنيات الأخرى، وذلك من أجل تحديد الموقف السليم منهما، وإدراك كيفية المساهمة في تقديم حلول للمشكلات العالمية المعاصرة، وما ينبغي اكتسابه من عوامل القوة من المدنية القائمة(47).
6- حصر الطاقات الفكرية وتوظيفها: وهذا الاعتبار يتطلب درس الجغرافيا الفكرية لعالم الإسلام، من أجل حصر كافة الطاقات الإسلامية، وتوزيع المهمات عليها وفق توجهاتها واختصاصاتها ونقاط تألقها وعطائها… وذلك لتجنب خطيئة النظرة أحادية الجانب، وجعل كافة المذاهب الاجتهادية تدلي بدلوها في مجرى العطاء التاريخي(48).
7- مأْسَسَة “الاجتهاد المعرفي”: من المتطلبات الأساسية التي أشارت إليها –المجلة- هو إقامة مؤسسة علمية تهدف إلى معالجة آثار إشكالية الازدواجية الفكرية والثقافية التي وقعت فيها الأمة إبان النهضة الأوروبية وما صاحبها من تراجع حضاري إسلامي “فينبغي أن تكون هناك محاولة جادة لتخطي الأثر السيئ لازدواج الثقافتين الشرعية والعصرية والذي يتركز في تخريج فئة دارسة للعلوم الشرعية وغير ملمة بمشاكل العصر وعلومه وفئة أخرى غير ملمة بالعلوم الشرعية… وهنا تبدو الحاجة ماسة إلى معهد عالٍ لمن أتموا تخصصاتهم سواء منها الشرعية أو العصرية على أعلى المستويات كي يكمل كل منهم ما ينقصه من العلوم الأخرى وفي نطاق تخصصه فقط (اهتداء بشروط المجتهد الخاص لا العام) حتى تتكون من خريجي هذا المعهد وحدات متخصصة في كل فرع تجمع في كل فرد من أفرادها – لا بالتكامل بين أفرادها فحسب – بين الثقافتينالعصرية والشرعية ممتزجة متفاعلة، وتكون هذه الوحدات المتخصصة هي معقد الأمل في الاجتهاد المعاصر ضمن إطار مجمع علمي إسلامي… ورسم منهج الاجتهاد المعاصر وأساس الإنتاج المنشود لهذا المجتمع العلمي”(49).
8- الاجتهاد الجماعي: نظرًا لتعقد الحياة المعاصرة وتنوع المشاكل واتساع العلوم وتطبيقاتها على الحياة أصبح من الضروري أن يتخصص المجتهد في حقل واحد من حقول المعرفة. وأن يتنوع المجتهدون وفق الاختصاص وأن يصبح الاجتهاد عملاً تعاونيًا بعد أن كان فرديًا، وأن تؤسس مجالس اجتهاد يحضرها مجتهدون من شتى الاختصاصات، فلم يعد في وسع المجتهد الواحد أن يلم بكل علوم الدين والدنيا وإيجاد الحلول لكل مشاكل الإنسان في هذا العصر(50).
أوضحت المجلة – أيضًا- أهمية الاجتهاد الجماعي من عدة وجوه أهمها أنه ضرورة وجودية للأمة “فما فتئ الواقع الإسلامي الراهن يؤكد يومًا بعد يوم ضرورة الانتقال من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد الجماعة في التعامل مع النوازل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوجود الإسلامي المعاصر، فحجم التحديثات والنوازل أكبر من أن يُتصدى لها باجتهادات فردية متسمة بالمحدودية والجزئية”(51).
وتضيف – المجلة – أيضًا – عددًا من دواعي الاجتهاد الجماعي وهي:(52)
*طبيعة النصوص الشرعية التي عنيت بالأصول العامة والمبادئ الأساسية أكثر من عنايتها بالتفاصيل والجزيئات الخاصة.
*ظهور النوازل الجديدة والقضايا المستجدة.
*نشوء التخصص المنفرد في ضوء الثورة العلمية والمعلوماتية المعاصرة والتطورات العميقة في المجالات المتعددة.
*تعذر تحقق الاجتهاد المطلق.
*تيسر وسائل الاجتهاد الجماعي وسبل تحقيقه.
*إظهار صلاحية الشريعة ومرونتها على المستوى الحضاري.
أما غايات الاجتهاد الجماعي -الذي هو شكل الاجتهاد المعرفي وصورته- فهي:(53)
*وسيلة لاستمرار وإحياء عملية الاجتهاد التي توقفت وجمدت في عالم المسلمين.
*وسيلة الانتقال من فقه الفرد إلى فقه الأمة.
*وسيلة لملاحقة التطورات المعاصرة وإغناء الفقه الإسلامي بالاجتهادات المعاصرة.
*تحقيق مبدأ الشورى، وهو المبدأ العام في حركة الأمة الإسلامية.
*تحقيق مبدأ “التكامل” بين المجتهدين، بما يجعله الأقدر على معالجة قضايا الأمة بخبرات مختلفة ومتعددة.
تاسعًا: “الاجتهاد المعرفي”، مجالاته
حددت المجلة بعض من مجالات “الاجتهاد المعرفي” ودعت إلى تأسيس “مجلس شورى المجتهدين”(54) لتحقيقها، ومن هذه المجالات ما يلي:(55)
– العلوم الدينية.
– الاقتصاد والسياسة والإدارة.
– الشؤون الدولية والدفاعية.
– التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع.
– نظم العدالة الضريبية والتأمينات الاجتماعية، والخدمات العامة التي تتسابق الدول في تطويرها وبسط ظلالها.
– أزمة النقد العالمية ومشكلة الديون الدولية والفوائض النفطية.
– قضايا المرأة المعاصرة والطفولة والشباب، ومتابعة لحركات الإصلاح أو الإفساد في هذه المجالات.
– التيارات الفكرية الوضعية: الإلحادية، الوجودية، الماركسية التي تغزو العقول، والاهتمام ببحثها ومتابعة حركتها وانتشارها.
– ما استحدث من عقود للمعاملات والجرائم والعقوبات ونظم الرقابة الإدارية والمحاكم الدستورية والقضاء… من باب المصالح المرسلة وتغير الأحكام بتغير الزمان.
– فنون الدعاية والإعلام الحديثة ووسائل الاتصال الجماعية وإمكانات شراء أو تأجير محطات تلفزيونية وإذاعية حرة (غير حكومية)، والوعي بأساليب الصحافة والنشر المتطورة.
– قضايا العالم المعاصرة: مثل نـزع السلاح وغزو الفضاء وتلوث البيئة والانفجار السكاني والمجاعات والحروب والثورات والانقلابات…. إلخ.
المحور الثاني
منهجية التعامل مع مصادر “الاجتهاد المعرفي” وأدواته
انشغلت- مجلة “المسلم المعاصر”- بمسألة الاجتهاد وتجديد أدواته ومفهومه كما سبق وأشرنا في المحور الأول، ومن القضايا الأساسية التي انشغلت بها في بناء منهجية للتعامل مع مصادر الاجتهاد وأدواته كانت قضية “التجديد الفقهي” على اعتبار أن الفقه هو وعاء عملية الاجتهاد ومفرزها الأساسي، وحددت في العدد الافتتاحي عنوان هذه القضية وهي “الاجتهاد في أصول الفقه” فإنها “لا تكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب الاجتهاد في فروع الفقه، بل تتعداه إلى بحوث الاجتهاد في أصول الفقه”(57)، ومصادر هذا الاجتهاد هي “المنابع الأولى الكتاب والسنة، يستلهمهما المقاصد والأهداف ويستوحيهما المبادئ والأصول”(58).
وفي هذا الصدد عنيت -المجلة -في بواكير أعدادها بتناول موضوعات “علم أصول الفقه” “والاجتهاد والتقليد”، و”الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد”، ويطالعنا العدد (90) بطرح جديد لملامح “التجديد الفقهي” الذي يستند إلى التمييز في عملية التجديد على جانبين، جانب يتعلق بالشكل، والثاني: يتعلق بالموضوع. وتعني المجلة بالنوع الثاني “الموضوعاتي” لتجديد الفقه، وتطرح في هذا المجال العناصر والمفاهيم والمحددات التالية:(59)
1- وثاقة العلاقة بين التجديد في “الفقه” وبين التجديد في “أصول الفقه”، فالتجديد في الفقه يقوم على التجديد في أصول الفقه، بمعنى أنه إذا كان تجديد في أصول الفقه فإنه ينبني عليه – بطبيعة الحال – تجديد في الفقه واجتهاد جديد وفقًا للمناهج الجديدة التي توضع لأصول الفقه وسوف يكون لهذا أثره في المادة الفقهية.
2- ضرورة تقديم اجتهادات جديدة في المسائل القديمة بما يتفق مع تغير الظروف، فالاجتهاد يتغير بتغير الظروف الزمانية والمكانية وهو ما حدث كثيرًا في تاريخ الفقه الإسلامي.
3- الاحتياج إلى تقديم اجتهادات جديدة في المسائل الجديدة والمستحدثة، وهذا أمر أصبح مقبولاً من الناحية الإسلامية.
4- ضرورة التوسع في مفهوم الفقه بحيث نعود إلى المفهوم اللغوي له أو نقترب منه، ونعني بالمفهوم اللغوي للفقه الاستعمال القرآني لكلمة “الفقه” والتي كانت تطلق على مجموع العقائد والأخلاق إلى جانب العمل والمعاملات.
5- أن توضع العلوم الاجتماعية التي لم يكن الفقهاء يتحدثون فيها من قبل تحت مظلة الفقه، ولا نعني بالعلوم الاجتماعية هنا ما يتصل بالدراسات الميدانية والنظرية، وإنما نعني بها الأحكام الشرعية الضابطة للنشاط الإنساني في مجالات العلوم الاجتماعية المختلفة، كعلم النفس، وعلم التربية، وعلم الاقتصاد، وغيرها من العلوم.
6- فيما يتعلق بمصادر المادة الفقهية: فإن كتب الفقه ومراجعه وكذلك كتب السياسة الشرعية موجودة ومعروفة. ولكن بالإضافة إلى هذه الكتب فإن في التراث الإسلامي مجموعات من المؤلفات التي تحمل عناوين متعددة مثل: النوازل والفتاوى والأقضية، وترجع أهمية تلك المؤلفات إلى اتصالها بالواقع أكثر مما تتصل به الكتابات الفقهية التقليدية … ويضاف إلى هذه المصادر – أيضًا- كتب المجامع الفقهية والرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه والبحوث والدراسات في الدوريات العلمية المتخصصة.
وبيَّنت المجلة أهم مسارات التجديد في علم أصول الفقه ومنها:(60)
المسار الأول: إبراز الترادف بين مفهومي الاجتهاد والتجديد. وهذا يستدعي التنظير لموضوع “التجديد” كمفهوم أصولي تشريعي وتضمينه هذا العلم في “باب الاجتهاد” باعتبار أن التجديد يمثل أحد أنواعه ووجهًا من وجوهه، بل هما وجهان لعملة واحدة في علم الشريعة عمومًا وعلم أصول الفقه على وجه أخص.
المسار الثاني: تحديد وضبط المدلول الاصطلاحي لأصول الفقه، وذلك لما يؤديه من نتائج في توجيه وتصويب وتجديد المفاهيم والأحكام التي تطلق على هذا العلم وما يتعلق بها من قضايا الاجتهاد والتجديد.
المسار الثالث: توحيد المصطلحات الأصولية ذات المفاهيم الواحدة.
المسار الرابع: رصد البحوث الجزئية المعاصرة وتضمين إضافتها العلمية بُنية العلم ودور المؤسسات العلمية في ذلك.
المسار الخامس: التكامل المعرفي بين أصول الفقه والعلوم الإنسانية.
ومن الميادين التي أولتها المجلة عناية خاصة في قضية “التجديد الفقهي”:
*أصول الفقه ومسألة المنهج(61).
*علم أصول الفقه والعلوم الاجتماعية(62).
*الاستفادة من مناهج العلوم الشرعية في العلوم الإنسانية(63).
*أصول الفقه العلاقة بين نص الوحي والفقيه(64).
*إعادة صياغة علم أصول الفقه(65).
*التجديد في أصول الفقه “مشروعيته وتاريخه”(66).
*تصفية علم الأصول من الدخيل(67).
مصادر الاجتهاد:
حددت المجلة عدة مصادر للاجتهاد وصنفتها ما بين مصادر أولية (الوحي) وثانوية (ما يتعلق بالإنتاج الفكري للعقل البشري مثل التراث والنظريات العلمية، والواقع..). وطرحت في ذات الوقت منهجية مقترحة للتعامل مع هذه المصادر جاءت تحت عنوان -كيف نتعامل..؟- بما يحقق غايات الاجتهاد المعرفي وأهدافه.
أولاً: القرآن الكريم
طرحت المجلة فيما يتعلق بالقرآن الكريم بوصفه مصدرًا أوليًا للاجتهاد المعرفي سؤالاً حاولت أن تجيب عليه معرفيًا وهو: كيف نتعامل مع القرآن؟ وفي هذا الصدد اهتمت المجلة بمنهاج التعامل مع القرآن، وانشغلت بمنهجية “التفسير الموضوعي” الذي رأت فيه تلبية للضرورة الحضارية لواقع الأمة، كما رأت ضرورة تجاوز التفاسير التراثية التي ركزت على جوانب جزئية في القرآن، سواء ما ارتبط بالبعد التاريخي، أو اللغوي أو التشريعي بمفهومه الضيق. وأشارت إلى عدة فوائد حضارية واجتماعية وثقافية لهذا النوع من التفسير ومنها:(68)
1- أنه – أي التفسير الموضوعي – يضع حدًا للاختلاف بين العلماء في فهم كثير من المفاهيم والحقائق القرآنية، ذلك أن آراءهم وتصوراتهم عن حقائق القرآن يعتريها التجزيئية وعدم الشمول.
2- كما أن موضوعات القرآن لم تقتصر على الجوانب التي برع فيها علماء الشريعة أي: التشريع والأحكام الفقهية واللغة والبلاغة..بل تتضمن أُسسًا في علوم السياسة والاقتصاد وعلم النفس والاجتماع والتربية… وبهذا يتطلب التفسير الموضوعي مشاركة شريحة واسعة من علماء الأمة على اختلاف تخصصاتهم في فهم القرآن والكشف عن جوانب هدايته.
3- إن معرفة التفسير الموضوعي تؤدي إلى معرفة الحقائق القرآنية في مسائل الكون والمجتمع والحياة والإنسان، مما يجعل إمكانية استنباط نظريات متكاملة فيها قائمة.
4- تحقيق الوحدة في منهج تفسير القرآن وفهمه، فإن شأن المؤسسات التعليمية أن تفصل في مساقاتها الدراسية بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي، وترى فيهما نمطين منهجيين مختلفين، في حين أن المنهجين يتحدان في تجلية حقائق القرآن وبلورتها، فالتفصيل والتفريع يتم في إطار وحدة الموضوع الذي يتعامل معه المفسر، وبذا يتم التخلص من التجزيئية في فهم القرآن.
5- يهتم التفسير الموضوعي – أيضًا – بقضايا الواقع ومعضلاتها ويعمل على تقديم حلول لها من النصوص القرآنية … وهذا يتطلب أن يقوم كل مفسر على تأصيل حقائق القرآن في واقع عصره وواقع مجتمعه مما يدفع إلى الاجتهاد والتفكير الحر والعمل المنضبط وفق الأسس المعتمدة في فهم القرآن والتفسير.
تحدد – أيضًا – المجلة عددًا من القواعد الأساسية والمنهجية في التعامل مع النص القرآني وتفسيره منها: (69)
*الجمع بين الرواية والدراية.
*تفسير القرآن بالقرآن.
*تفسير القرآن بالسنة.
*الانتفاع بتفسير الصحابة والتابعين.
*الأخذ بمنطق اللغة.
*مراعاة السياق.
*الوعي بأسباب النـزول والاستيثاق من وجود العموم.
*اعتبار القرآن أصلاً يُرجع إليه.
ومنها – أيضاً:(70)
*تحقق أهلية المؤوِّل للاجتهاد، والتأويل [للقرآن] نوع اجتهاد، بل هو أحد أكبر ميادينه – باستجماعه شروط المجتهد.
*قابلية النص للاجتهاد: بألا يكون من أمور الغيب – وهي بطبيعتها مما لا قدرة للعقل البشري على الخوض فيها أو في كنهها.
*أن يرجع المؤَوَّل به إلى معنى صحيح في الاعتبار، أي موافق لوضع اللغة، أو عرف الشارع، أو عرف الاستعمال وقت نـزول القرآن.
*أن يكون الدليل المعضدُ/المرجِّحُ حجًة راجحًا في نفسه وهذا الدليل هو القرينة.
*أن يكون التأويل الذي يصار إليه منسجمًا وملتئمًا ومتماشيًا مع السياق الذي ورد فيه النص موضع التأويل؛ إذ قد يكون المعنى المؤَوَّل إليه صحيحًا في نفسه ولكن النص بسياقه – أي بنظمه وعموده – لا يدل عليه.
ومن المسارات الفكرية التجديدية التي أسست لها المجلة معرفيًا هي “المرجعية المعرفية للقرآن الكريم”، والتي يقصد بها اعتبار القرآن مصدرًا لاكتشاف التصورات القرآنية والمفاهيم والقيم لبناء منظور حضاري يعمل على إعادة إنتاج العلوم والمعارف الإنسانية من ناحية، ومعيارًا وتقويمًا للعلوم والمعارف الإنسانية الغربية عند التعامل معها وتلقيها من ناحية أخرى.
وفي هذا المجال تحدد المجلة “وظائف الوحي” لبيان مساحته التداخلية في بناء العلوم الإنسانية ودوائر عمله وتشير في ذلك إلى ما يلي:(71)
1- يستقل الوحي بتقديم معرفة جاهزة حول قضايا معينة بحيث يكون دور الإنسان فيها هو التلقي والفهم دون تدخل في تحديد عناصر هذه المعرفة أو اختيار موضوعها أو التعديل فيها بالزيادة والنقصان…مثل المعارف المتعلقة بموضوع “عالم الغيب”.
2- يستقل الوحي – كذلك – ببيان مجموعة من المعارف التي تتصل بتنظيم حياة الإنسان من الناحية الأخلاقية والتشريعية، وتقدَم له في صيغة مجموعة من المبادئ والأوامر والنواهي مثل تلك الأحكام المتعلقة بالأحكام الشرعية التي تكفَّل الوحي ببيانها، ودور الإنسان هنا التلقي للامتثال لا غير.
3- قد لا يكون للوحي هذه السلطة المطلقة في تقديم معرفة في شكل أحكام تشريعية نهائية، ولكنه يظل سلطة مرجعية يهتدي به في تحديد قواعد السلوك فيما لم يأت فيه نص صريح، وذلك من باب الاجتهاد وفق القواعد المقررة.
وفيما يتضح من علاقة الوحي بالعلوم الإنسانية تؤكد المجلة على الجوانب المعرفية التالية:(72)
1- الوحي والعلوم الإنسانية كليهما يعالج موضوعًا مشتركًا هو عالم الإنسان بكل أبعاده المادية والنفسية والتنظيمية والأخلاقية… تتحدد طبيعة هذه العلاقة في اتجاهين، الأول: يخص بعض التوجهات والقيود المنهجية التي يفرضها الوحي؛ لتقترب هذه العلوم من الصواب. والثاني: يخص المعلومات الجاهزة التي يكشف عنها الوحي والتي من شأنها أن تعين هذه البحوث.
2- إن شمولية الوحي واستيعابه لمختلف النشاطات المادية منها والروحية من شأنه أن يفتح أفاقًا واسعة أمام العلوم الإنسانية؛ لتخرجها من إطارها المادي الضيق الذي وجدت فيه والذي انتهت معه إلى اختزال الإنسان في جوانبه المادية مع إغفال جوانبه الروحية والنفسية والعناصر الجمالية فيه.
3- إعادة الاعتبار للأنساق المعرفية التي تعيد الاعتبار للقيم وتعتمد الدين مصدرًا معرفيًا. وهذا يعني تغير الصورة التقليدية لمفهوم العلمية في هذه العلوم، وتتحرر العلمية من سلطة النـزعة التجريبية كما تمارس في العلوم الطبيعية والفيزيائية البحتة.
4- في أفق التوحيد – أيضًا – الذي يفرضه الوحي تتحول العلوم الإنسانية من مهمة تبرير مشروعية التصورات المادية حول الإنسان والمجتمع… إلى العمل على اكتشاف القدرة الإلهية المبدعة في الإنسان والمجتمع والحياة.
5- إن تعاليم الوحي يمكن أن تقوم بدور أساسي في إنقاذ العلوم الإنسانية من التوجهات الإيديولوجية، حيث تحولت هذه العلوم عن وظيفتها العلمية إلى تكريس نتائجها لخدمة مصالح طبقية وقومية واستعمارية.
ثانيًا: السنة النبوية
وفيما يتعلق بالسنة النبوية بيَّنت –المجلة- أنواع السنة: التشريعية وغير التشريعية، واهتمت بالدرس المعرفي لتصرفات النبي rوصنفتها في ضوء ما هو سنة لازمة الاتباع أو ما عرف بـ”السنة التشريعية”، وما هو غير ذلك أي “سنة غير تشريعية”، وصنفت أفعاله rإلى ما يلي:(73)
1- التصرفات الجبلية.
2- التصرفات التي ثبت بالدليل الصحيح أنها من خصوصياته r.
3- التصرفات التي صدرت عنه rبوصف كونه رئيس دولة.
4- التصرفات التي صدرت عنه rبوصف كونه قاضيًا بين الناس.
5- التصرفات التي صدرت عنه rبوصف كونه نبيًا يبلغ الوحي عن الله.
وتؤكد – أيضًا – عبر سرد عدد من الدلائل أهمها قوله r:”إنما أنا بشر فإذا أمرتكم بأمر دينكم فاقبلوه، وإذا أمرتكم بشئ من دنياكم فإنما أنا بشر”. وبيَّنت – المجلة- أن “أفعال النبي rالدنيوية ليست تشريعًا”(74).
مما لا شك فيه أن البحث في تصنيف السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية من شأنه أن يزيل اللبس لدى العقل المسلم بين تصرفات الرسول بالنبوة والرسالة التي تهدي إلى أوامر الوحي ونواهيه، وبين ما فعله بالإمامة أو بحكم العادة والجبلة البشرية، وبين ما كان خاصًا به rوليس لأحد من المسلمين وهو ما يفتح الباب لاجتهاد المجتهدين في ميادين الفكر والحياة والعمل الذي يعد المناط فيه الإباحة، وممارسة الخبرة لأهل الذكر في الفنون والعلوم.
كما طرحت المجلة معالم لمنهج فهم السنة والتعامل معها من أجل الاستعانة بها في تحقيق نهضة معرفية حضارية، وتوظيفها في عملية “النهوض الحضاري” و”بناء النموذج الحضاري” للأمة الإسلامية. وتتمثل معالم هذا المنهج فيما يلي:(75)
1- العمل العقلي والاجتهادي من أجل فهم نصوص السنة وتحديد معناها… بكل ما ينطوي عليه التفسير من “اجتهاد”.
2- معرفة المناسبات التي قيلت فيها السنة، والإطار الذي دارت فيه، وذلك لتحديد نطاق عملها وتطبيقها.
3- الوعي بأن النصوص [السنة] ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسائل لتحقيق مقاصد، وأن معرفة هذه المقاصد العامة هي الخطوة البنائية الأولى في كل منهج للإصلاح.
4- أن تكون لدى الباحث رؤية محددة للوظائف الاجتماعية والثقافية التي يراد للسنة أن تكون طريقًا وأداة لتزكيتها وتثبيتها، وهذه مهمة إصلاحية ترتبط بالواقع الاجتماعي للمسلمين، وتقييم ذلك الواقع، وتحقيق صورة التغيير الذي يراد تحققه… وهذه المهمة الإصلاحية تمر بمراحل ثلاث، الأولى: تحديد المقاصد العامة والغايات الكبرى للحياة والمجتمعات الإنسانية في ظل الإسلام، وهو تحديد تؤدي فيه النصوص القرآنية والنبوية الدور الأساسي، والثانية: تحديد الحاجات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة في المجتمع الإسلامي في زمان ومكان معين، والثالثة: الاستعانة بمضامين النصوص القرآنية والنبوية في تحقيق “التغير الاجتماعي” المتجه إلى النهضة والتقدم.
5- النظرة الوظيفية للإسلام، وذلك باستخدام السنة النبوية والقيم التي اشتملت عليها في تحقيق تغيرات أساسية في النظام الاجتماعي والسياسي عن طريق توجيه تلك القيم للقرارات السياسية والاجتماعية، ولتحقيق ذلك لابد أن يتم النظر للإسلام في إطار “رؤية وظيفية ومجتمعية” أي باعتباره مجموعة مبادئ معيارية تهدف إلى تحقيق ورعاية عدد من المصالح الأساسية للناس. بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والتي تجعل من “الالتزام الديني” “فضيلة أخلاقية” و”عبادة دينية” بالمعنى الخاص للعبادة في الإسلام.
ثالثًا: التراث
التراث هو المصدر الثالث للاجتهاد المعرفي، كما تناولته المضامين الفكرية للمجلة، وفي هذا المصدر حددت المجلة المقصود بالتراث، وكيفية التعامل معه، والاستفادة منه في تحقيق مآلات “الاجتهاد المعرفي” ومقاصده.
والتراث –كما حددته المجلة- هو: مجموع الإنتاج الفكري والأدبي والمادي… الذي أنتجه المسلمون في تفاعلهم مع أصول الإسلام(76)، وهو أيضًا “ما أنشأه الأسلاف بعقولهم(77).
وتستبعد المجلة فكرة أن يكون “الوحي” أو “أصول الإسلام” من بين التراث الذي نتعرض له بالدرس والنقد، “إن تراث أمتنا ليس الإسلام، أو أن الإسلام ليس تراث أمتنا بالشكل الرياضي الصارم كتطابق مثلثين تناظرت زواياهما… إنما يجئ التراث نتاج تفاعل، بالسلب أو الإيجاب، مع الإسلام بالدرجة الأولى، ومع عدد آخر من المبادئ والأديان والمذاهب بالدرجة الثانية، فهو إذن – أي التراث – حشد من المعطيات تتمخض عن طبيعة التجربة التي أحدثتها مواقف آبائنا وأجدادنا من الإسلام… معطيات شتى فيها الخطأ والصواب والأبيض والأسود، والمنعرج والمستقيم، والظالم والعادل… وهو ما يوضح الفارق بين الإسلام كفكرة وعقيدة ومنهاج وممارسات أخلاقية وشعائرية، وبين تراث أمة أثَّر فيها هذا الإسلام في سلوكها وعطائها بدرجة أو بأخرى تأثيرًا متغايرًا كما ونوعًا”(78).
كما أشارت المجلة أيضًا إلى عدد من منطلقات البحث في التراث وهي:(79)
1- التمييز بين ما هو أصيل نابع من روح الإسلام ومنبثق عن توجيهاته وتعاليمه، وما هو دخيل فيه ولا يعبر عن مضمونه.
2- النظرة النقدية: نظرتنا إلى التراث لن تكون نظرة إعجاب وتقديس لكل ما يتصل بتاريخنا الثقافي، بل نظرة نقدية واعية ومتفحصة لمضامينه، إذ ليس كل ثقافة نمت وارتبطت بالمسيرة الحضارية الإسلامية وتاريخها الثقافي تعتبر بالضرورة ثقافة إسلامية محسوبة على الإسلام، بكل ما يمكن أن تحمله من مضامين مناقضة ومتعارضة مع روح الإسلام ومذهبيته.
3- الانطلاق من القيم الجمالية والأدبية والخلقية التي يقررها الإسلام، واستحضار مجموع السمات الإيمانية والدينية التي يحددها، ولا يمكن أن نفهم هذا التراث فهمًا سليمًا واعيًا ونميز محاسنه من مساوئه وخطأه من صوابه وقوته من ضعفه… إلا إذا احتكمنا إلى الأصول التي انطلق منها، وهي الكتاب والسنة.
وضعت المجلة أيضًا عددًا من المعايير النقدية للتراث وهي:
1- معيار صلاحيته للعصر: النقد الذي يوجه إلى تقديس التراث، لن ينصب على علاقة التراث بمشكلات عصره العقلية والخلقية، إنما ينصب على مدى صلاحيته لموقفنا اليوم الذي قد تغير كثيرًا… ويتجلى هذا الاختلاف سواء في المجالات العلمية أو الاجتماعية والاقتصادية أو في نظم الحكم والعلاقات الدولية. وعلى ذلك فالدعوة إلى النقد والتجاوز والتجديد لا يمكن أن تعني الحط من قدر التراث بل هي دليل على التقدير الواجب للواقع وما يمليه من اعتبارات…وهو نفس التقدير الذي أعطاه السلف لواقعهم(80).
2- تأسيس منهج نقدي يتسم بالعدل: منهج عدل يتعامل مع معطيات الأجداد بروح علمية مخلصة فيتقبل ما يمكن تقبله ويرفض ما لا يحتمل القبول، ويقدر عطاء الأجداد حق قدره دون أن يثنيه ذلك عن متابعة آخر المعطيات المنهجية التي يطلع علينا بها العصر…موقف وسطى يرفض الاستسلام للرواية القديمة ويأبي إلغاءها المجاني من الحساب.
3- رؤية موضوعية (تحري الموضوعية): أي استحضار (البيئة) التي تخلقت وقائع التاريخ الإسلامي فيها، وتعتمد في الوقت نفسه معطيات العلوم المساعدة كافة: إنسانية وصرفة وتطبيقية من أجل كشف إضاءة لهذه البيئة وفهم أعمق لوقائعها وأحداثها(81).
خصصت المجلة –أيضًا- باب “التعريف بالتراث”، واهتم هذا الباب بالتعريف بالكتابات التراثية وتقريبها إلى ذهن القارئ والباحث العلمي، وتقديم إضاءات حول الكتابات التراثية التي كان لها تأثير في حركة الفكر الإسلامي، والإسهام الحضاري.
ومن مجالات التراث التي عرضت لها المجلة وتناولت أبعادها المعرفية ما يلي:
*مجال التراث السياسي.
*مجال التراث العلمي.
*مجال التراث الاقتصادي.
*مجال التراث الاجتماعي.
*مجال التراث الفقهي.
*مجال التراث الفلسفي.
*مجال التراث الإداري.
*مجال التراث التربوي.
*مجال التراث الأدبي واللغوي.
أما عن منهجية المجلة في تناول موضوعات ومجالات التراث فإنه يمكن استخلاصها فيما يلي:
*البحث في الإفادة من التراث في قضية التغيير الاجتماعي، ومعالجة إصابات وأمراض الواقع الإسلامي القائم سواء كانت تلك الإفادة: فكرة أو وسيلة أو طريقة أو منهجًا ومبادئ.
*تأصيل للمفاهيم في مجال الإصلاح المعرفي المعاصر.
*البحث عن معالم أو مبادئ لمداخل أو نظريات علمية لمجالات العلوم والمعارف الحديثة مثل علم النفس، والاقتصاد، والسياسة، والاجتماع.
*إحياء التراث الإسلامي في المجالات المختلفة العلمية والفكرية والفلسفية عن طريق نشر نصوصه وتناول أعلامه.
*محاولة التقعيد المنهجي للتعامل مع التراث وكيفية الإفادة منه في تشخيص واقعنا ومعالجته.
*الدرس المقارن بين العطاء الإسلامي في مجال الحضارة الإنسانية والعطاء الغربي.
*الوعي بمفهوم التراث وتأسيس ذاكرة بحثية تهتم بهذا الوعي وتفيد منه.
*تقديم جوانب من النظم الإسلامية في مجالات السياسة والإدارة والتعليم.
رابعًا: فقه الواقع
يُعد “الواقع” أحد المصادر الأساسية للتفكير الإسلامي، فالإسلام مشروع هداية وتوحيد وتزكية وعمران، وهذا لا يتم إلا في الواقع المحدد بزمان ومكان معينين، فلا تتم رسالة الإسلام في فراغ أو في العدم، وبما أن الواقع يتغير بتغير عنصريه “الزمان” و”المكان”، فقد أوجب الإسلام “الاجتهاد” ومراعاة “التغير” لهذا “الواقع”. والواقع يشمل من حيث الزمن ثلاثة أبعاد هي “الماضي” و”الحاضر” و”المستقبل”. ولهذا حددت المجلة قضيتها الأساسية في “المعاصرة” والتي تضم في جوانبها هذه الأبعاد الثلاثة، و”المعاصرة” التي حددتها -المجلة- في صدر صفحاتها لتكون تعريفًا لهويتها وعنوانًا لمضمونها المعرفي هي المرتكز الأساسي والمحوري الذي يدور عليه “الاجتهاد المعرفي” في الإنتاج الفكري للمجلة ومشاريعها العلمية والتي حددتها بثلاثة مسارات معرفية أساسية هي: “الاجتهاد، والتنظير، وإسلامية المعرفة”(82).
وقد اهتمت –المجلة- بالإجابة على سؤال مهم في هذا المجال وهو “كيف نتعامل مع الواقع؟” ودارت البحوث والدراسات حول جانبين للإجابة على هذا التساؤل: الأول الجانب التنظيري بطرح القواعد المنهجية لهذا التعامل والمستمدة من الأصول الشرعية والفكرية الإسلامية، الثاني: الجانب الميداني والذي اهتم بالبحث التطبيقي لطرح الأفكار الاجتهادية في قضايا وإشكالات واقعية، لم يجب عنها من قبل الفكر الإسلامي في مراحله الزمنية السابقة.
لذا فقد حددت المجلة نطاق عملها في البحث عن “كيفية أن يعيش المسلمون الإسلام في واقع حياتهم لا أن ينتظروا لذلك قيام المدينة الفاضلة…ولذلك لا تنغلق المجلة في مباحث “أكاديمية” نظرية بعيدة عن واقع الحياة والناس والمجتمعات… ذلك أن المجلة تنطلق من مبدأ “الواقعية” بمعني أنها تحاول معالجة المشاكل التي يحياها الناس اليوم… ومعالجة الواقع العملي على ضوء هذه المبادئ والنظريات”(83).
أما اهتمام المجلة بفقه الواقع فجاء على النحو التالي:
*تعريف الواقع ومستوياته وطرائق التعرف عليه.
*تحديد مهمة “الاجتهاد المعرفي” في التعامل مع الواقع.
* تأصيل مشروعية “الواقع” كأحد مصادر “الاجتهاد المعرفي”.
* العلاقة بين مطلب “التجديد” والوعي بـ”فقه الواقع”.
* الدراسات المستقبلية التي تتناول واقع المسلمين وإمكاناته وقضاياه الأساسية، واعتبار المستقبل جزءًا أساسيًا من هذا الواقع.
*تقويم الماضي البعيد والقريب من أجل الإدراك الشامل للحاضر المعاصر.
*تقويم العلاقة بين الفقه والواقع وتطويرها.
*إضافة “فقه الواقع” للعلوم الإسلامية كي تشكل استجابة ملائمة للعلاقة بين الإسلام وحاجات المجتمع الإسلامي المعاصرة.
*تأسيس علوم المستقبل أو “المستقبليات الإسلامية”.
*الدعوة إلى فقه الحياة الذي يجعل الواقع مرتكزًا ومحورًا وموضوعًا.
* الوعي بالسنن الاجتماعية والكونية كأحد أهم الطرق للتعرف على “الواقع”.
* طرح بعض التطبيقات العملية في مجالات الاقتصاد والاجتماع عند استجابة التفكير الاجتهادي لمشكلات الواقع.
المحور الثالث
بناء منظور حضاري إسلامي لتجديد العلوم الإنسانية المعاصرة
تمثل العلوم الإنسانية محورًا مهمًا من محاور النهضة العلمية والمعرفية لأي أمة، لأنها تشكل الأساس في بناء الإنسان وفي تكوينه الثقافي والاجتماعي، والإنسان بدوره مرتكز البناء الحضاري. وقد توقف نمو هذه العلوم وتطورها في العالم الإسلامي منذ قرون، واستيقظ العقل المسلم إبان النهضة الغربية الحديثة على بناء متكامل للعلوم الإنسانية صدر عن النموذج المعرفي الغربي المادي. وفي إطار “المشروع التغريبـي” الاستعماري في عالمنا الإسلامي انتقلت هذه العلوم بمضامينها ونموذجها وفلسفتها وإشكالاتها الغربية إلى العقل المسلم، وكان بعض “الناقلين” يعتقد أن هذه العلوم بنموذجها المعرفي هي السبيل إلى التقدم والنهضة في عالمنا الإسلامي.
إلا أن الذي حدث عكس ذلك إذ مثلت هذه العلوم عائقًا للوعي الإسلامي، وأحدثت تشويهًا لتصوراته الأصيلة ومفاهيمه القويمة. فهذه العلوم التي نبتت في الغرب وقامت على تصوراته وقيمه ومفاهيمه، وكانت نتاجًا لظروف تاريخية واجتماعية خاصة تختلف في شكلها ومضمونها عن الظروف والمتغيرات في الواقع الإسلامي، وكذلك عن التصورات والمفاهيم الأساسية التي تشكل ثقافة وعقيدة المسلم، وهو ما أوجد تمزقًا وحيرة لدى البعض، واستلابًا وتسليمًا لهذه العلوم لدى البعض الآخر، وهو ما من شأنه أن أوجد شقًا كبيرًا في المشهد الفكري والثقافي والمعرفي الإسلامي.
إن العلوم الإنسانية المعاصرة في نسختها الغربية اعتمدت على محورية المادة، وفي نفس الوقت استبعدت القيم والدين كعناصر لازمة في بناء الإنسان وما تبع ذلك في الجوانب المنهجية والإجرائية من انحرافات فكرية ومعرفية أسهمت بدورها في تشكيل صورة مغايرة للإنسان عن تلك التي فُطر عليها.
إن بناء منظور حضاري إسلامي للعلوم الإنسانية كان الدافع الرئيس لتأسيس مجلة المسلم المعاصر، حيث اهتمت المجلة ببناء المفاهيم والقيم والتصورات المستمدة من الوحي والتراث الإسلامي من أجل التأسيس لعلوم إنسانية جديدة تنطلق من ذاتيتنا الثقافية والحضارية، وجاءت الموضوعات في هذا المجال تحت عناوين متعددة منها: “أسلمة المعرفة”، و”التأصيل”، و”المداخل الإسلامية للعلوم”، و”المنظور الإسلامي”.
لماذا استخدام مفهوم “المنظور الحضاري”؟ في دراسة نشرتها المسلم المعاصر بعنوان “نظرات في الأسلمة والتأصيل” ناقشت فيها الدراسة المصطلحات والمفاهيم المختلفة التي جاءت في بحوث ودراسات المجلة والتي تعبر عن الحركة الإصلاحية المعرفية للمجلة مثل:(84)
*إضافة لفظ الإسلامي لأي من العلوم (علم النفس الإسلامي أو علم الاجتماع الإسلامي).
*أسلمة العلوم الإنسانية أو إسلامية العلوم الإنسانية.
*التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية.
*التوجيه الإسلامي للعلوم الإنسانية.
*التفسير الإسلامي.
وخلصت الدراسة إلى ترجيح كلمة “منظور” على ما تقدم، وذلك “لأن كلمة منظور أدق من سابقاتها، وأن الدارس للعلوم الإنسانية ينظر إليها بمنظار إسلامي، لأن دراسة أي مشكلة من المشكلات يقتضي بالضرورة أن يمتلك الباحث رؤية، أو منظورًا منهجيًا، يتصور من خلاله المسألة، ويحلل في ضوئه الفرضيات والإشكاليات المطروحة على بساط البحث، ودراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية المتصلة بالواقع الإنساني في كل مستوياته: العقلية، والنفسية أو السلوكية، والعمرانية، الفردية والجماعية، بحاجة إلى مدخل منهجي، يتيح للباحث فرصة دراستها بشكل مستوعب يؤدي إلى فهمها، واستخراج قوانينها، وسننها، وإدراك منطقها، ومنهجها الاستدلالي”(85).
كما أن “المنظور” يمثل ناظمًا أكثر اتساعًا للجماعات البحثية العاملة تحت مظلة الفكرة الإسلامية في المجالات العلمية المتعددة، وهو ما يعطي مساحة أكبر لتمدد الفكرة الإسلامية لدى قطاعات علمية عاملة ضاقت ذرعًا بالإطار المرجعي الغربي، كما أن استخدام لفظة “المنظور” من شأنه أن يتخطى حواجز واعتراضات البعض على ألفاظ مثل “أسلمة” و”تأصيل” وغيرهما، فالمنظور أكثر اتساعًا في الرؤية والتصور، كما أنه يحمل نفس المضامين المعرفية التي تقصدها حركة الإصلاح المعرفي ونفس الأصول التي تقوم عليها.
أما “الحضاري” فيقصد به الكلية في الأبعاد السياسية والاقتصادية وغيرها، والشمول في الرؤية بين التاريخ، والراهن، والمستقبل، والتعدد في المستويات ما بين الجزئي والكلي، والجمع وليس التضاد بين الثنائيات (الوحي والعقل، القيمة والواقع، الثابت والمتغير،…). وهذا المفهوم عن الحضاري هو تجسيد للرؤية الكونية الإسلامية. فهذه الرؤية الكونية الإسلامية كرؤية من رؤى العالم هي مدخل مجمع للمجالات المعرفية، وهي رؤية تعارفية حضارية عكستها رؤى ومنظومة أفكار العديد من مفكري الإسلام ورموزه في العصور المختلفة(86).
ومن ناحية أخرى فإن مشروع إسلامية المعرفة يعد أداة للمنظور الحضاري الذي يتشكل من قلب الرؤية الإسلامية ومبادئها وأصولها المعرفية، وذلك من عدة جوانب:
*فإسلامية المعرفة تعني في أحد مضامينها: “ممارسة النشاط المعرفي كشفًا وتجميعًا وتركيبًا وتوصيلاً ونشرًا من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان”(87).
*إن قطبي التعامل: الإنسان والعالم، هما من صنع الله الذي أتقن كل شيء.. فمن الطبيعي أن تتشكل مفردات هذا التعامل من منظور الإيمان بالله خالق الكون والحياة والإنسان… وكان من الطبيعي أن تسلم المعرفة بهذه الحقيقة الكبرى أن تكون “إسلامية” بهذا المعنى الواسع الذي يضع الأمر في نصابه في نطاق الملكوت الإلهي وسننه ونواميسه(88). إن معرفة كهذه، أريد لها أن تنفذ أحد المقومات الأساسية للمنظور الإسلامي، لابد أن تتشكل في دائرة الإيمان، أو أن يعاد تركيبها ثانية من منظور إيماني(89).
*كما تهدف إسلامية المعرفة – أيضًا- إلى “إعادة بناء العالم بالمعرفة المتبصرة بالإيمان المستمد من هدى الله…(90).
*إن أسلمة المعرفة تعني – أيضًا – منح النشاط العلمي، على مستوى الكم والنوع وقودًا جديدًا يدفعه للمزيد من التألق للكشف عن الحقائق… وإضاءة السنن والنواميس… واستخراج مصادر القوة والطاقات المذخورة(91).
ويمكن ملاحظة اهتمام المجلة ببناء المنظور الحضاري الإسلامي لتجديد العلوم الإنسانية المعاصرة من خلال منهجية معرفية قامت على الخطوات التالية:
أولاً: نقد المنظور الحضاري الغربي ونموذجه المعرفي في العلوم الإنسانية المعاصرة.
ثانيًا: الكليات المعرفية لبناء المنظور الحضاري الإسلامي.
ثالثًا: بناء مداخل نظرية لمجالات العلوم الإنسانية المعاصرة.
ونتناول فيما يلي نتائج التحليل الخاصة بهذه الجوانب:
أولاً: نقد المنظور الحضاري الغربي ونموذجه المعرفي في العلوم الإنسانية المعاصرة
أكدت – المجلة – على أن مرتكز بناء منظور حضاري إسلامي ينطلق من نقد النموذج / المنظور الحضاري الغربي وما يحمله من قيم وتصورات ومفاهيم، وما نتج عنها من مناهج أصيبت بالانحراف في التعامل مع الظاهرة الإنسانية. وهذا النقد يتطلب الوعي بمعارف هذا المنظور وأصوله الفكرية ومناهجه ووسائله. ولهذا خصصت المجلة بابًا فكريًا بعنوان “نقد الفكر الغربي” جاء في صدر التعريف به ما يلي: “إن استيعاب المعارف الحديثة أمر ضروري لتحقيق إسلامية المعرفة. وليس المقصود بالاستيعاب أخذ هذه العلوم والمعارف والتنظيمات مجزأة وعلى علاتها دون تمحيص ولا غربلة ولا إدراك لما يخالطها من غايات وقيم ومفاهيم تتعلق بأصحاب تلك المعارف وقيمهم وغاياتهم وتكوينهم النفسي، إنما المقصود بالاستيعاب الهضم وتمثل الطاقات المبدعة بشكل سليم، ولا يكون ذلك دون التزود بالفهم الشمولي والدراسة النقدية الموضوعية للحضارة الغربية أصلاً ومنبعًا وغاية وفلسفة وإنجازًا”(92).
وجاء نقد المجلة للمنظور الحضاري الغربي على النحو التالي:
1- بيان قصور المناهج الغربية في معالجة الظاهرة الإنسانية.
2- المقارنة بين المنهجية الإسلامية والمنهجية الغربية في معالجة قضايا الظاهرة الإنسانية.
3- الوعي بأزمات المنهج الغربي في التعامل مع العلوم الإنسانية المعاصرة، وجوانب تلك الأزمات المنهجية والمعرفية.
4- الوعي بإشكالات العلوم الإنسانية المعاصرة في ضوء التصور الغربي.
5- إدراك التحيزات في التصور الغربي في معالجة قضايا الإنسان.
6- الدرس المقارن للمفاهيم التأسيسية التي تقوم عليها العلوم الإنسانية بين المنظورين الغربي والإسلامي.
وجاءت عناوين البحوث والدراسات تحمل عناوين مثل: “قصور المناهج الغربية في معالجة قضايا الإنسان”، و”أزمة المنهج في العلوم الإنسانية”، و”مشكلات علم النفس في ضوء التصور الغربي للإنسان” و”الانحياز الحضاري الغربي في النماذج الرياضية” و”نقد مناهج العلوم الإنسانية من منظور إسلامي” و”منهجية التعامل مع الفكر الغربي المعاصر”.
وأشارت المجلة إلى جملة من أوجه النقد للمنظور الحضاري الغربي ومنطلقاته الفكرية في العلوم الإنسانية ومنها:(93)
1- تضخم العقائدية العلمية أو تحويل العلم إلى موقف عقائدي.
2- اختزال المنهج العلمي في عناصره التجريبية الحسية.
3- اختزال الحقيقة الإنسانية في جوانبها المادية.
4- تعميم المنهج الوضعي في دراسة الجوانب الميتافيزيقية للعلوم الإنسانية.
5- التوظيف الإيديولوجي لنتائج الأبحاث في المجالات: السياسية، والاقتصادية والعسكرية الاستعمارية.
6- تعميم مبدأ النسبية في مجال الثوابت.
7- الفصل بين العلم والقيم وتحرير البحث العلمي من التوجيه الأخلاقي.
8- خلخلة البنية الفكرية وتعميق نـزعة الشك.
كما بيَّنت -المجلة- الأفكار والتيارات والاتجاهات الفكرية التي تأسست في ظل النموذج الغربي وحرفت الإنسان عن الفطرة والهداية، وأسهمت بشكل واضح في إنتاج أزمات للإنسان مولدة لم يستطع حلها ولا الخروج منها، ومن هذه الاتجاهات والتيارات الفكرية:(94)
*نـزعة تأليه الإنسان.
*الفردانية.
*الشيوعية والرأسمالية.
*النـزعة الشكوكية.
*فلسفة النفعية والنسبية المطلقة.
*العلمانية الشاملة.
*الفوضوية.
ثانيًا: الكليات المعرفية الأساسية لبناء المنظور الحضاري الإسلامي
نتناول هنا الكليات المعرفية الأساسية لبناء المنظور الحضاري لتجديد العلوم الإنسانية المعاصرة كما تناولتها مجلة المسلم المعاصر.
*المنطلقات: فيما يتعلق بالمنطلقات المعرفية لبناء المنظور الحضاري أكدت المجلة على ما يلي فيما يتعلق بطبيعة البحوث والدراسات والتصور المطلوب للإنسان وطبيعة المنهج:(95)
1- يجب على جميع البحوث والدراسات، سواء كانت تتعلق بالفرد أو الجماعة، بالإنسان أو الطبيعة، بالدين أو بالعلم، أن تعيد تنظيم نفسها تحت لواء مبدأ التوحيد، أي أن الله Iموجود وهو واحد، فهو هدف وغاية كل شيء في الوجود، وأن جميع المعرفة الموضوعية عن العالم تعد بمثابة معرفة لإرادته، وتدبيره، وحكمته.
2- العلوم التي تدرس الإنسان وعلاقاته مع البشر يجب أن تُقر أن الإنسان يحيا في ملكوت يحكمه الله في كل من الناحيتين الغيبية والقيمية؛ وتتضمن تلك العلوم التاريخ الإنساني – أي المجال الذي نستطيع أن ندرك فيه المستويات العليا من النمط الإلهي – ويجب أن تعني تلك العلوم بمسألة خلافة الإنسان على الأرض.
3- العلوم التي تقوم بدراسة “خلافة الإنسان” على الأرض يجب أن تسمى بعلوم الأمة. فالدراسة الإسلامية ترفض الاعتراف بتشعب العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية؛ بل إنها تتطلب إعادة تصنيف فروع الدراسة وتقسيمها إلى العلوم الطبيعية التي تتناول الطبيعة، والعلوم الخاصة بالأمة التي تتناول الإنسان والمجتمع.
4- العلوم الخاصة بالأمة لا يجب إهدار مكانتها بواسطة العلوم الطبيعية، فإن كليهما يحوز على نفس المرتبة في الخطة الخاصة بالمعرفة الإنسانية، والفارق الوحيد بينهما يكمن في موضوع الدراسة، وليس في الميثودولوجيا، وكلاهما يهدف إلى اكتشاف وفهم النمط الإلهي: أحدهما يعمل على استكشافه في نطاق الأشياء المادية، والآخر في نطاق الشؤون البشرية.
*المتطلبات المعرفية:أوضحت المجلة عدد من المتطلبات لبناء المنظور الحضاري مثل: الانطلاق من التصور الإسلامي، واستيعاب العلم الحديث وامتلاك الرؤية النقدية لدى الباحثين، واستعادة مكانة الوحي في بناء المنظور الحضاري البديل، ومن هذه المتطلبات:(96).
1- الانطلاق من إدراك واضح لأبعاد “التصور الإسلامي” للإنسان والمجتمع والكون المنبثق من الكتاب والسنة، إضافة إلى ما يتضمنه تراث الإسلام مما يرتبط بالتخصص، مع نظرة نقدية لإسهامات علماء المسلمين حول قضاياه.
2- استيعاب “العلوم الحديثة” في أرقى صورها، مع القدرة على نقدها، والاستفادة منها، وتجاوزها بشكل بناء كلما اقتضى الأمر ذلك.
3- إيجاد “تكامل حقيقي” بين معطيات التصور الإسلامي من جانب، وبين إسهامات العلوم الحديثة من جانب آخر، وليس مجرد الجمع أو التجاوز المكاني أو حتى المزج بينهما دون وحدة حقيقية.
4- إعادة الاعتبار للوحي كمصدر معرفي في مجال علوم الإنسان.
5- اعتبار التوحيد أساسًا نظريًا ومنهجيًا في تأطير البحوث العلمية.
6- تحرير مفهوم “العلمية” من صيغتها الحسية الضيقة.
7- تحقيق الالتزام العلمي وتحرير البحث العلمي من الانحياز الأيديولوجي.
8- إعادة الاعتبار للعنصر الأخلاقي في البحث العلمي.
9- التمييز بين الثوابت والمتغيرات في مجال الدراسات الإنسانية.
*المنهجية:تتحدد منهجية المنظور الحضاري من خلال تحديد الغاية والتوجه العام للمنظور والنظام المعرفي الذي يستند إليه، والمنهجية العلمية التي يعتمدها في عمله داخل النشاط المعرفي للمعارف والعلوم، ومن هذه الجوانب المنهجية أشارت المجلة إلى ما يلي:
1- تحديد الغاية من العلم والنشاط العلمي بصفة عامة، وارتباطها بالغاية من وجود الإنسان ذاته.
2- التوجه العام للعالِم في سلوكه البحثي أو في بحثه عن المعرفة وفي نظرته لنفسه وتكييفه لعلاقته بربه وخالقه.
3- نظرية المعرفة التي ينطلق منها وافتراضاتها المعرفية خصوصًا ينبغي أن تتصل بما يلي:
*مصادر المعرفة، وخصوصًا قضايا العلاقة بين الوحي والعقل والحواس.
*مجال المعرفة ونطاقها وخصوصًا فيما يتصل بمدى شمولها لعالم الشهادة وعالم الغيب.
4- منهج البحث العلمي وأسسه من الناحية الميثودولوجية.
5- التنظير وتفسير نتائج البحوث.
6- تطبيق نتائج العلم والاستفادة منها في حياة الناس (الجانب التقني أو التكنولوجي).
7- من أهم المبادئ المنهجية للمنظور الحضاري والتي يجب تفهمها وتمثلها ومراعاتها إطارًا ومنطلقًا وأساسًا لهذا المنظور : التوحيد وتضميناته: وحدة الخلق (النظام الكوني – الخليقة – تسخير الخليقة للإنسان) – المعرفة ووحدة الحقيقة – وحدة الحياة – الأمانة الإلهية – الخلافة – الشمولية) – وحدة الإنسانية – تكامل الوحي والعقل – الشمولية في المنهج والوسائل)(97).
8- بناء المفاهيم الإسلامية والتأصيل المنهجي: ما من عمل منهجي إلا ويكون قوامه عملية التأصيل للمفاهيم… ويعد بناء المفاهيم الإسلامية ضرورة منهجية على المستويين التنظيري والحركي في آن واحد – انطلاقًا من أن الإسلام بوصفه منهج حياة شامل يؤدي دورًا جوهريًا في حركة الإنسان الحضارية. وترجع هذه الضرورة إلى كون المنهج – في جوهره – مجموعة من المفاهيم يوظفها الباحث في معالجة موضوعه، ويستعين بها على تتبعه وتحليله وتفسيره بل وتقويمه(98).
*القيم:من المباحث المهمة المؤَسِسة لبناء المنظور الحضاري لتجديد العلوم الإنسانية هو “مبحث القيم”، وفي هذا الإطار أكدت المجلة على أن القيم تقع في صميم البنية المعرفية الإسلامية وسارية في البنيان المعرفي للرؤية الإسلامية، وهي علاقة لا يمكن إنكارها… هذه القيم ينبغي أن ننظر إليها باعتبارها فعلاً حضاريًا ورؤية حضارية كلية تتفاعل فيها أصول الوعي مع سنن السعي في إطار عمليات تأسيس وتأصيل وتفعيل وتشغيل وتمكين”. وقد ناقشت المجلة مبحث القيم من خلال الجوانب التالية:(99)
*البعد الحضاري للقيم.
*القيم كمدخل منهاجي.
*القيم كإطار مرجعي.
*القيم تأسيس لرؤية كلية للعالم ونموذج إرشادي.
*القيم نسق قياسي.
*إسلامية المعرفة:توضح المجلة أن أحد أبعاد مجالات عملها الثلاثية ” إسلامية المعرفة” وموضوعها كما تذكر “إصلاح كل المعارف التي تندرج في نطاق العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، إلا أن دلالتها بالنسبة للعلوم الطبيعية تختلف كثيرًا عنها بالنسبة للعلوم الاجتماعية، ففي حين تنصرف جهود إسلامية المعرفة في نطاق العلوم الطبيعية إلى إصلاح الأطر التصورية (التنظير) وتوجيه التطبيقات (التكنولوجيا) فإن دلالتها بالنسبة للعلوم الاجتماعية لا تتوقف عند هذه الجهود وحدها وإنما تنصرف فيما وراء ذلك إلى إصلاح المنهج وإلى إعادة النظر في موضوع الدراسة ذاته: إن إسلامية المعرفة تنصرف أساسًا إلى إصلاح العلوم الاجتماعية”(100).
وعلى هذا الأساس ينبني المنظور الحضاري على رؤية إصلاحية للعلوم والمعارف الإنسانية القائمة، من خلال تجديد بناء المناهج والتصورات والمفاهيم المشكِّلة لهذه العلوم، وتجديد النظرة للإنسان وقضاياه ومشكلاته من منظور يقوم على الجمع بين مكونات الإنسان، وتجديد غاياته، واستعادة مركزه الاستخلافي في الأرض، وهي مقومات أساسية في المنظور الحضاري الإسلامي.
*محددات، من أهم المحددات التي تضمنتها المجلة لبناء منظور حضاري إسلامي ما يلي:
1- التوحيد: يُعد التوحيد محور الارتكاز لنظرية المعرفة في المنظور الحضاري الإسلامي، وينبثق منه أبعاد معرفية مهمة تساهم في التأسيس لهذا المنظور، فالتوحيد هو الخاصية المميزة للمنظور الإسلامي بين النماذج الإرشادية العالمية الأخرى. ولهذا اهتمت المجلة بمركزية التوحيد وإبراز أهم أبعاده المعرفية الأخرى، فاهتمت بتناول الموضوعات والأبعاد التالية:(101).
*البعد القيمي والغيبـي للتوحيد.
*المتضمنات التاريخية للتوحيد.
*متضمنات التوحيد بالنسبة للنظرية الاجتماعية (الأمة).
*المتضمنات الخاصة بالنظرية السياسية (الخلافة).
ويقوم التوحيد على خمسة مبادئ معرفية أساسية هي:
2- الثنائية: فالحقيقة عالمان. عالم الله وعالم الخلق. ينفرد بعالم الله موجود واحد لا شريك له، هو الله Y. هو الخالق الوحيد المنـزه الصمد. أما عالم الخلق فهو عالم الزمان والمكان لكل ما احتوياه من موجودات وحوادث… ثنائية الحقيقة نهائية قاطعة… ينفصل العالمان عن بعضهما انفصالاً تامًا كونيًا ووجوديًا ولا يمكن للخالق أن يتحد أو يتصل وجوديًا أو يحل أو يتجسد في المخلوق، أو أن يتحد المخلوق أو يتصل وجوديًا في الخالق أو يسمو بنفسه إلى مرتبة خالقه.
3- التعقل: لا صلة بين الخالق والإنسان المخلوق إلا بقوة العقل، وهي قوة فطرية تؤهل المخلوق لإدراك إرادة الخالق وحيًا أو تعقلاً. وحيًا إن أنـزل الله كلامه المعبر عن إرادته، وتعقلاً إن أمعن النظر في المخلوقات فاكتشف سننها وهي إرادة الله سبحانه.
4- الغائية: لعالم الخلق غاية من وجوده، هي تحقيق إرادة الخالق، فالله لم يخلق عبثًا، ولم يخلق باطلاً، بل سوى كل شيء خلقه وقدره تقديرًا. فإرادة الله في خلقه – ما عدا الإنسان- تتحقق بالضرورة وذلك بأن الله وضع تلك الإرادة سنة أو فطرة في جبلة المخلوق. أما في الإنسان، فإرادة الله تتحقق باختياره فضلاً عن تحققها بالضرورة في جبلته. للإرادة الإلهية التي تتحقق باختيار الإنسان مرتبة أعلى من مرتبة الإرادة المحققة بالضرورة.
5- القدرة: طالما أن الخلق خلق لغاية فلابد أنه قادر على تحقيقها. ففي الإنسان قوة على تغيير نفسه وتغيير مجتمعه وتغيير الطبيعة المحيطة به، وفي نفس الإنسان ومجتمعه ومحيطه الطبيعي قوة على تقبل فعل الإنسان. فالخلق كله عجين يقوي الإنسان على تكييفه، على جعله يحقق إرادة الله كما فهمها، على إعادة تخريجه كما ينبغي وتحويله إلى ما يجب أن يكون.
6- المسؤولية: إذا كان الإنسان مكلفًا بتحقيق أوامر الخالق وقادرًا على القيام بها، حق عليه الحساب، إذ بدونه تسقط جدية التكليف، فالحساب قائم في التاريخ وبعده. يؤتي المستجيب للأمر المحقق له فلاحًا وسعادة ويسرًا، ويؤتي العاصي للأمر، عذابًا وإخفاقًا وضيقًا… التعقل – أيضًا – يتألف من ثلاثة جوانب أساسية، الأول: رفض ما يخالف الحقيقة. الثاني: رفض استمرار المتناقضين. والثالث الانفتاح وتقبل الدليل المخالف(102).
*التكامل المعرفي: من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الطرح الفكري للمنظور الحضاري فكرة “التكامل المعرفي”، وهو مقابل للازدواجية المعرفية التي سقط فيها العقل المسلم جراء إشكالاته الداخلية (الجمود والتقليد) والخارجية (التغريب والاستلاب) .. وهو ما جعله ينظر للحقيقة على أنها اثنين حقيقة عقلية وحقيقة شرعية ويعتبرهما متناقضتين لأبعد حدود، أما مبدأية “التكامل المعرفي” فإنها تعيد للحقيقة وحدتها المتفرقة والمتمزقة في واقعنا المعرفي وفي واقع النموذج المعرفي الغربي الذي تقوم عليه العلوم الإنسانية المعاصرة.
ويقصد بالتكامل المعرفي، التكامل بين علوم الوحي وعلوم الكون. ويقصد بعلوم الوحي “تلك العلوم الناظرة في النصوص الشرعية أي الوحي سواء كان قرآنًا أو سنة، ونتجت عنها علوم متعددة لصيقة بها كعلم الفقه والأصول والحديث والتفسير والكلام وما على شاكلتها من العلوم…أما علوم الكون فيقصد بها العلوم الباحثة في الظواهر الخاصة بالكون بما فيها الإنسان وغيره من المخلوقات وكذا الطبيعة، أي العلوم الطبيعية والنفسية والاجتماعية بكل أصنافها دون تحديد معين، بما في ذلك علم التاريخ أو العمران أو علم الاجتماع أو البسيولوجيا بأنواعها، الاجتماع البشري أو الاجتماع السياسي أو علم النفس سواء التربوي أو الإنساني”(103).
ومن تمثلات التكامل المعرفي وتجلياته –كما تناولتها المجلة- ما يلي:(104)
1- التكامل المنهجي: حيث تحاول علوم الوحي أن تقتسم مع العلوم الاجتماعية بعض مناهجها، وهذا لا يعني بالضرورة أنها لم تستثمر فيها تلك المسالك المنهجية… بل إن التعويل هنا على هذه الآليات باعتبارها أساليب في فقه الظواهر الاجتماعية والنفسية خصوصًا لتيسير فهم الواقع وفقه النصوص الشرعية على ضوء تلك الوقائع، لأن النص صامت في أصله من حيث التنـزيل حتى تستنطقه الوقائع والقضايا وتحركه.
2- التكامل الموضوعي: حيث تتقاطع علوم كثيرة على مستوى موضوعاتها ومجالاتها والأمر يتطلب استحضارها، واستدعاء أساليبها ونتائجها العلمية لتيسير مهمات الاجتهاد الفقهي، ومن تجليات ذلك التقاطع أو التكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية تنتج موضوعات مثل: فقه نفس الإنسان، وفقه الظواهر الاجتماعية، ورصد منظومة القيم، وفقه الأعراف والتقاليد.
3- التكامل الغائي: في هذا الجانب ينبغي الاهتمام بتحصيل الغايات الكبرى للعلوم، ولو على اختلاف مناهجها، واستثمار ذلك في التأسيس لقواعد علمية أو لأحكام اجتهادية أو قانونية تخدم الإنسان في مستقبل حاضره ومن ثم يمكن البحث في: فقه مستقبل المكلف، وتعليل الأحداث والظواهر، والإصلاح والتغيير.
ثالثًا: بناء مداخل نظرية لمجالات العلوم الإنسانية من منظور حضاري إسلامي.
نتناول هنا بالتحليل أهم المداخل المعرفية والمنهجية التي تناولتها –مجلة المسلم المعاصر- في إطار بناء المنظور الحضاري البديل لتجديد العلوم الإنسانية المعاصرة، انطلاقًا من الرؤية الإسلامية والقيم والتصورات الأساسية في الإنسان والكون والطبيعة والوجود. وقد حددت المجلة عددًا من المداخل المعرفية لبناء العلوم الإنسانية مثل: علم التربية، والفلسفة، والإدارة ، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، والأدب، والفنون، وحقوق الإنسان، وعلم النفس، علم البيئة، علم السياسة، علم التاريخ.
الخلاصة أن المنظور الحضاري البديل يقوم على:
1- مبدئية فكرة التوحيد وتضميناتها في: الاجتماع، والاقتصاد، والسياسة،.. وهكذا.
2- مبدئية المقاصد الشرعية: أي رعاية المصلحة الإنسانية والكونية في بناء هذه العلوم.
3- استعادة مكانة الإنسان في الكون، كل الإنسان ونفي التمييز والطبقية والتعصب العنصري الكائن في مضامين هذه العلوم الإنسانية في نسختها المعاصرة.
4- استعادة وظيفة الإنسان الاستخلافية ومتطلباتها الإعمارية والأخلاقية والإصلاحية.
5- تضمين مبحث “القيم” كمرتكز أساس في قلب منهجية العلوم الإنسانية بعد استبعاده من المنظور الحضاري الغربي.
والله من وراء القصد،
* * *
هوامش الدراسة
1) جمال الدين عطية: “المسلم المعاصر في عشر سنوات”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (40)، السنة العاشرة، أكتوبر 1984، ص7.
2) جمال الدين عطية: “ردود الفعل”، مجلة المسلم المعاصر، العددان (1 ، 2)، السنة الأولى، إبريل 1975، ص7.
3) جمال الدين عطية: “هذه المجلة”، مجلة المسلم المعاصر، العدد الافتتاحي، السنة الأولى، نوفمبر 1974، ص7.
4) المرجع السابق، ص7 – 8.
5) إسماعيل الفاروقي: “الاجتهاد والإجماع كطرفي الديناميكية في الإسلام”، مجلة المسلم المعاصر ، العدد (9)، السنة الثالثة، مارس 1977م، ص12.
6) إسماعيل الفاروقي: “الاجتهاد والإجماع كطرفي الديناميكية في الإسلام”، مرجع سابق، ص17.
7) المرجع السابق، ص10.
8) المرجع السابق، ص10.
9) عماد الدين خليل: “حول الاجتهاد الضرورات والحوافز ووسائل التحقيق”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (47)، السنة الثانية عشرة ديسمبر 1977، ص8.
10) المرجع السابق ص8.
11) يوسف القرضاوي: “الحركة الإسلامية في مجال الفكر والعلم”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (57)، السنة الخامسة عشر، أكتوبر 1990م، ص9.
12) مهجة مشهور: “فقه الحياة: نحو اجتهاد معاصر”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (131)، السنة الثالثة والثلاثون، مارس 2009، ص 33.
13) المرجع السابق، ص29- 56.
14) طارق البشري: “الإسلام والعصر”، مجلة المسلم المعاصر، العددان (75 – 76)، السنة التاسعة عشرة، يوليو 1990، ص8.
15) محمد المبارك: “المصادر الأصلية للمعرفة في الإسلام العقل والوحي”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (13)، السنة الرابعة، مارس 1978م، ص53.
16) المرجع السابق، 54.
17) جمال الدين عطية: “العمل العلمي المنشود”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (3)، السنة الأولى، يوليو 1975م، ص6.
18) سيف الدين عبد الفتاح: “تحديات كبيرة واستجابات عليلة في عالم العرب والمسلمين”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (131)، السنة الثالثة والثلاثون، مارس 2009م، ص8.
19) يوسف القرضاوي: “الحركة الإسلامية في مجال الفكر والعلم”، مرجع سابق، ص7.
20) جمال الدين عطية: “هذه المجلة”، مرجع سابق، ص10.
21) محمد فاضل الجمالي: “رأي في تكوين المجتهد في عصرنا هذا”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (39)، السنة العاشرة، يوليو 1984م، ص132.
22) إسماعيل الفاروقي:” الاجتهاد والإجماع كطرفي الديناميكية للإسلام”، مرجع سابق، ص11.
23) أحمد عروة: “الخبرة العلمية الحديثة وصلتها بالاجتهاد”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (41)، السنة الحادية عشرة، يناير 1985، ص43.
24) محمود أبو السعود: “منهاج هذه المجلة”، مرجع سابق، ص 120.
25) المرجع السابق، ص123.
26) المرجع السابق، ص125.
27) عماد الدين خليل: “الاجتهاد الضرورات والحوافز ووسائل التحقيق”، مرجع سابق، ص8.
28) المرجع السابق، ص8.
29) جمال الدين عطية: “ماذا ينقص المسلمين”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (29)، السنة الثامنة، مارس 1982، ص5 – 6.
30) محمد المبارك: “نظام الإسلام العقائدي(1) في العصر الحديث، مجلة المسلم المعاصر، العدد (14)، السنة الرابعة، يونيو 1978، ص13-14.
31) إسماعيل الفاروقي: “الاجتهاد والإجماع كطرفي الديناميكية في الإسلام”، مرجع سابق، ص12.
32) حسن الترابي: “منهجية التشريع الإسلامي”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (48)، السنة الثانية عشر، أغسطس 1987م، ص12.
33) جمال الدين عطية: “العمل العلمي المنشود”، مرجع سابق، ص 7.
34) عماد الدين خليل: “حول الاجتهاد الضرورات والحوافز ووسائل التحقيق”، مرجع سابق، ص27.
35) إسماعيل الفاروقي: “الاجتهاد والإجماع كطرفي الديناميكية”، مرجع سابق، ص9.
36) جمال الدين عطية: “هذه المجلة”، مرجع سابق، ص10.
37) المرجع السابق، ص9.
38) إسماعيل الفاروقي: “الاجتهاد والإجماع كطرفي الديناميكية”، مرجع سابق، ص9.
39) حسن الترابي: “منهجية التشريع الإسلامي”، مرجع سابق، ص17.
40) المرجع السابق، ص21.
41) عماد الدين خليل: “حول الاجتهاد الضرورات والحوافز ووسائل التحقيق”، مرجع سابق، ص27.
42) المرجع السابق، ص27.
43) جمال الدين عطية: “شروط المجتهد وأدوات الاجتهاد”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (7)، السنة الثانية، سبتمبر 1976، ص6.
44) محمد فاضل الجمالي: “رأي في تكوين المجتهد في عصرنا”، مرجع سابق، ص132.
45) المرجع السابق، ص132.
46) المرجع السابق، ص132.
47) المرجع السابق، ص132 – 133.
48) عماد الدين خليل: “حول الاجتهاد الضرورات والحوافز ووسائل التحقيق”، مرجع سابق، ص27.
49) جمال الدين عطية: “العمل العلمي المنشود”، مرجع سابق، ص7-8.
50) محمد فاضل الجمالي: “رأي في تكوين المجتهد في عصرنا”، مرجع سابق، ص133.
51) زهور أبو مهدي: “الاجتهاد الجماعي وضرورته في العصر الحاضر”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (159)، السنة (40)، مارس 2016، ص96.
52) المرجع السابق، ص99 – 106 (باختصار).
53) زهور أبو مهدي: “الاجتهاد الجماعي وضرورته في العصر الحاضر”، مرجع سابق، ص107 – 111. (باختصار).
54) محمد فاضل الجمالي: “رأي في تكوين المجتهد”، مرجع سابق، ص136.
55) جمال الدين عطية: “تلسكوب أو ..نفق”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (35)، السن التاسعة، يوليو 1983،ص6-7.
56) مهجة مشهور: “أربعة وثلاثون عامًا من عمر المجلة”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (136)، السنة الرابعة والثلاثون، يونيو 2010م، ص5.
57) جمال الدين عطية: “هذه المجلة”، مرجع سابق، ص7.
58) المرجع السابق ص8.
59) جمال الدين عطية: “ملامح التجديد الفقهي”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (90)، السنة الثالثة والعشرون، يناير 1999، ص151 – 177 (باختصار).
60) غالية بوهدة: “مجالات تجديد علم أصول الفقه”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (118)، السنة ديسمبر 2005، ص21 – 54 (باختصار).
61) زكي الميلاد: “أصول الفقه ومسألة المنهج”، مجلة المسلم المعاصر، العددان (145 – 146)، السنة السابعة والثلاثون، ديسمبر 2012، ص19 – 44.
62) جمال الدين عطية: “علم أصول الفقه والعلوم الاجتماعية”، المرجع السابق، ص159 – 198.
63) جمال الدين عطية: “الاستفادة من مناهج العلوم الشريعة في العلوم الإنسانية”، المرجع السابق، ص199- 216.
64) معتز عبد اللطيف الخطيب: “أصول الفقه وجدلية العلاقة بين نص الوحي والفقيه”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (101)، السنة السادسة والعشرون، سبتمبر 2001، ص157 – 170.
65) نعمان جغيم: “إعادة صياغة علم أصول الفقه: اتجاهات ومقترحات”، مجلة المسلم المعاصر، العددان (125 – 126) السنة الثانية والثلاثون، سبتمبر 2007.
66) خليفة بابكر حسن: “التجديد في أصول الفقه : مشروعيته وتاريخه وإرهاصات المعاصرة”، المرجع السابق، ص87 -180، جميلة بوخاتم: “التجديد في أصول الفقه”، المرجع السابق، ص53 – 86.
67) أسامة محمد عبد العظيم: “السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل”، المرجع السابق، ص219- 263.
68) زياد خليل: “تفسير القرآن إشكالية المفهوم والمنهج”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (81)، السنة الحادية والعشرون، أكتوبر 1996ـ ص34-36 (بتصرف).
69) يوسف القرضاوي: “المنهج الأمثل في التفسير معالم وضوابط”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (83)، السنة الحادية والعشرون، إبريل 1997، ص11 – 48.
70) يحيي جاد: “ضوابط التأويل لنصوص القرآن والسنة”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (150)، السنة الثامنة والثلاثون، ديسمبر 2013، ص46 – 49 (باختصار).
71) محمد أمزيان: “أصول المنهج المعرفي من القرآن والسنة”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (87)، السنة الثانية والعشرون، ابريل 1998، ص78 – 82.
72) محمد أمزيان: ” أصول المنهج المعرفي من القرآن والسنة”، مجلة المسلم المعاصر، مرجع سابق، ص78 – 82.
73) محمد سعيد رمضان البوطي: “السنة مصدرًا للتشريع ومنهج الاحتجاج بها”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (58)، السنة الخامسة عشر، يناير 19991، ص11 – 12.
74) محمد سليمان الأشقر: “أفعال الرسول rفي الأمور الدنيوية”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (13)، السنة الرابعة، مارس 1978، ص64. وانظر – أيضاً : محمد سليم العوا: “السنة التشريعية وغير التشريعية”، مجلة المسلم المعاصر، العدد الافتتاحي، نوفمبر 1974، ص29 – 49.
75) أحمد كمال أبو المجد: “الاستعانة بالسنة النبوية لتحقيق نهضة حضارية”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (61)، السنة السادسة عشرة، أكتوبر1991، ص23 – 44 (باختصار).
76) محمد أمزيان: “أصول المنهج المعرفي في القرآن والسنة”، مرجع سابق، ص135..
77) محمد عبد الحليم أبو شقة: “خواطر حول أزمة العقل المسلم المعاصر”، مجلة المسلم المعاصر، العدد الافتتاحي، مرجع سابق، ص17.
78) عماد الدين خليل: “موقف إزاء التراث”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (9)، السنة الثالثة، مارس 1977، ص46.
79) محمد أمزيان: “أصول المنهج المعرفي من القرآن والسنة”، مجلة المسلم المعاصر، مرجع سابق، ص132 – 133.
80) محمد عبد الحليم أبو شقة: “خواطر حول أزمة العقل المسلم المعاصر”، مرج سابق، ص18.
81) عماد الدين خليل: “دعوة إلى رفض الاستسلام لمصادرنا التاريخية”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (30)، السنة الثامنة، يونيو 1982، ص25.
82) انظر: قواعد النشر بالمجلة.
83) جمال الدين عطية: “هذه المجلة”، مرجع سابق، ص8، جاء ذلك في مقابلة الباحث مع مؤسس مجلة المسلم المعاصر الدكتور جمال الدين عطية أثناء إعداد البحث.
84) علي سلطاني العاتري: “نظرات في الأسلمة والتأصيل”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (149) السنة الثامنة والثلاثون، سبتمبر 2013، ص 67.
85) المرجع السابق، ص77.
86) نادية محمود مصطفى: “العلاقات الدولية في الإسلام..نحو تأصيل من منظور الفقه الحضاري”، مجلة المسلم المعاصر، العددان (133 – 134)، السنة الرابعة والثلاثون، ديسمبر 2009، ص30.
87) عماد الدين خليل: “حول إسلامية المعرفة”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (53)، السنة الرابعة عشرة، نوفمبر 1988، ص5.
88) عماد الدين خليل: “حول إسلامية المعرفة”، مجلة المسلم المعاصر، مرجع سابق، ص6.
89) المرجع السابق ، ص7.
90) المرجع السابق، ص9.
91) المرجع السابق، ص 10.
92) هيئة التحرير: نقد الفكر الغربي، مجلة المسلم المعاصر، العددان (55 – 56)، السنة الرابعة عشر، يونيو 1990، ص113.
93) محمد أمزيان: “نقد مناهج العلوم الإنسانية من منظور إسلامي وخطوات صياغة مناهج إسلامية للعلوم الإنسانية”، مجلة المسلم المعاصر، العددان (71-72)، السنة الثامنة عشرة، ص102 – 121(باختصار).
94) انظر: إسماعيل الفاروقي: “التحرك الفلسفي الإسلامي في العصر الحديث”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (39)، السنة العاشرة، ص11-24 (باختصار).
95) إسماعيل الفاروقي: “صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (20)، السنة الخامسة، ديسمبر 1979، ص34-35.
96) انظر: إبراهيم عبد الرحمن رجب: “مداخل التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (63)، السنة السادسة عشرة، ص53، محمد أمزيان: “نقد مناهج للعلوم الإنسانية من منظور إسلامي وخطوات صياغة مناهج إسلامية للعلوم الإنسانية”، مرجع سابق، ص122 وما بعدها.
97) سيف الدين عبد الفتاح: “حول المنهجية الإسلامية: مقدمات وتطبيقات”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (100) السنة الخامسة والعشرون، يونيو 2001، ص67.
98) المرجع السابق ،ص 68.
99) سيف الدين عبد الفتاح: “مدخل القيم: الإشكالية والتأصيل”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (89)، السنة الثالثة والعشرون، أكتوبر 1998، ص19-50.
100) إبراهيم عبد الرحمن رجب: “إسلامية المعرفة: الماضي والحاضر والمستقبل”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (98)، السنة الثامنة والعشرون، ديسمبر 2001، ص130.
101) انظر : إسماعيل راجي الفاروقي: “إعادة البناء الإسلامي والسلطة السياسية”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (22)، السنة السادسة، يونيو 1980، ص37 – 72.
102) إسماعيل راجي الفاروقي: “جوهر الحضارة الإسلامية”، مجلة المسلة المعاصر، العدد (27)، السنة السابعة، سبتمبر 1981، ص11-12
103) الحسان شهيد: “التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون.. مقاربة منهجية”، مجلة المسلم المعاصر، العدد (150)، السنة الثامنة والثلاثون، ديسمبر 2013، ص155-199 (اختصار).
104) المرجع السابق، ص155-199 (اختصار).