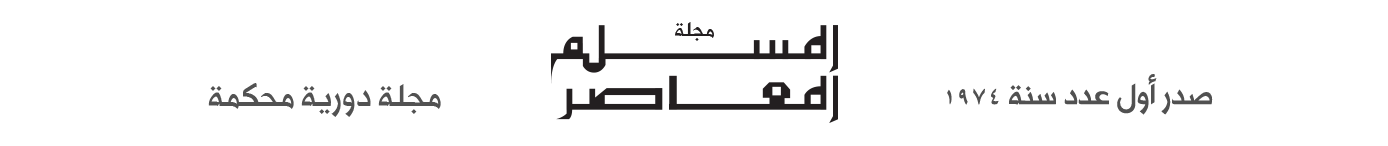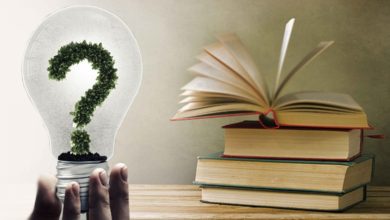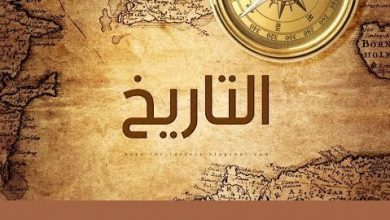مقدمة :
مرت قبل نحو ثلاث سنوات مائة سنة بحساب التقويم الهجري (العربي) على وفاة الأستاذ الإمام محمد عبده، وذلك يوم السابع من جمادي الأول سنة 1423 هـ؛ إذا كانت وفاته يوم السابع من الشهر نفسه سنة 1323 هـ. وفي الحادي عشر من يوليو 2005 اكتمل قرن من الزمان بحساب التقويم الميلادي (الإفرنجي) على وفاته التي وافقت الحادي عشر من يوليو سنة 1905.
ولم تنتبه الهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا الفكر الإسلامي، أو بشؤون الثقافة والإصلاح الاجتماعي عامة إلى اكتمال المائة الهجرية على وفاته، ومرت مناسبة هذه المائة في صمت نشطت بمناسبتها أكثر من جهة حكومية وغير حكومية للاحتفاء بذكرى رحيل الأستاذ الإمام، وحاولت تنشيط الذاكرة الجماعية بالقضايا التي انشغل بها وشغلته، وبالأفكار التي عبر عنها ودعا إليها، والاجتهادات والفتارى التي قال بها وسعى من خلالها إلى إصلاح المجتمع وإنهاض الأمة.
ولسنا نقصد هنا الإشارة إلى فوات فرصة تنظيم ندوة أو مؤتمر أو احتفالية أو أكثر في مناسبة المائة الهجرية لوفاته، أسوة بما جرى بمناسبة المائة الميلادية. فالمائة سنة في حد ذاتها – هجرية كانت أم ميلادية – ليست لها دلالة خاصة في تاريخ الفكر والثقافة بحيث يكون لاختلاف التقويم أثر بالغ مثلا في تقدير قيمة أي منهما أو صلاحيته، وإنما القصد هو التنبيه إلى الدلالة الرمزية للزمن الهجري، وللتقويم الهجري في النظر إلى ما قدمه الأستاذ الإمام ومراجعته.
فالزمن الهجري هو زمن الفكر الإسلامي وتراثه عبر مراحله التاريخية المختلفة بما شهدته تلك المراحل من عوامل القوة والضعف، والازدهار والتدهور، وقد انطلق الأستاذ الإمام من معطيات هذا الزمن، وكانت قضيته الكبرى التي شغلته طول حياته هي قضية التجديد والإصلاح، وكان في ذلك أحد كبار مفكري الإسلام الذين لم يكن انتسابهم للدين انتسابا إرثياً أو جغرافياً أو حضارياً عاماً؛ بل كان معتقداً أن الإسلام من شأنه أن كان معتقداً أن الإسلام من شأنه أن يصلح أحوال الفرد والمجتمع، وأن يأخذ بيده على طريق التقدم والنهضة، وقدم في هذا السياق اجتهاداته وأفصح عن أفكاره، وجهر بآرائه، بإيجابياتها وسلبياتها، وتحمل تبعة ما آمن به ودعا إليه. لقد كان هم حياته هو إصلاح الزمن الإسلامي انطلاقاً من صميم التكوين العقدي والحضاري لهذا الزمن، ووقف حياته من أجل «تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى».
ومن هنا كانت المائة الهجرية أَوْلَى بمثل «الأستاذ الإمام»، وكان هو أولى بها، كونه أحد «المجددين» الذين ربما عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ..». وما كنا نود التوقف عند مسألة حساب المائة سنة لولا أن الانحياز للتقويم الإفرنجي في مثل حالة الإمام محمد عبده هو أحد المظاهر الرمزية الدالة على استمرار حالة الاستلاب الحضاري، والاغتراب عن الذات، الغفلة حتى عن الموازين الخاصة بتقويم الزمن بعدد السنين والحساب.
وإذا كان أغلب الناس يأتون إلى هذه الدنيا ويغادرونها ولا يشعر بهم سوى عشرات – في أفضل الحالات – من المحيطين بهم من الأهل والأقارب والأصدقاء؛ فإن قلة هم أولئك الذين ينشغل أغلب الناس بهم في حياتهم ومن بعد مماتهم، وعلى رأسهم دعاة الإصلاح والتجديد من رواد الفكر وقادة الرأي وزعماء السياسة الذين يناط بهم افتتاح عهود جديدة في تاريخ أممهم؛ فأمثال هؤلاء لا يغادرون الحياة إلا بعد أن يحدثوا فيها من الحوادث، ويتركوا فيها من الانجازات الفكرية والمادية ما يكون سبباً في خلود ذكرهم، وتوفر مادة لاختلاف الناس في أمرهم جيل؛ بين فريق ينصر ويشايع، وآخر ينقض ويعارض، وهؤلاء الأنصار وأولئك المعارضون يوجدون عادة في أكثر من مصر، ولا يقع عددهم غالباً تحت الحصر.
وتدلنا سِيَرُ كثير من المصلحين والمجددين – والقادة والزعماء عامة – على أن مرور الزمن عنصر بالغ الأهمية في تقدير إنجازاتهم، وفي الحكم على ما قدموه بالنجاح أو الإخفاق، وكذلك في تحديد مواقف المختلفين بشأن جهودهم في التجديد والإصلاح بشكل عام. فمواقف المعاصرين لهذا المصلح أو ذاك المجدد غالبا ما تشوبها اعتبارات المصالح الآنية، أو المنافسات الشخصية، وقد يشوهها نقص المعرفة عن جانب أو أكثر من جوانب شخصية المصلح أو المجدد، أو عدم وضوح ملامح صورته الكلية في نظر القريبين منه ومعاصريه، وكلها من مصادر التحيز والابتعاد عن جادة الرؤية المتجردة من الهوى. وبدلا من أن تكون المعاصرة عاملا مساعدا للنظر بعين العدالة والإنصاف، نجد في أغلب الأحيان أن المعاصرة «حجاب» يحول دون النظر الموضوعي. ولكن مرور الزمن بعد انقضاء حياة المصلح أو المجدد من شأنه أن يجفف أكثر منابع التحيز ضده أو معه، وكلما طالت المدة التي تفصلنا عنه، خفت حدة المواقف والرؤى المتحيزة؛ إذ يقضي مرور السنين بانقطاع أكثر أسباب المصلحة والمنافسة الشخصية، ويؤدي تغير الواقع الاجتماعي والسياسي إلى كشف الجوانب الغامضة من السيرة الذاتية والمسيرة العملية، وتصبح المكونات الأساسية للشخصية مكتملة أو قريبة من الاكتمال، وتكون مصادر التعرف عليها أو أغلبها على الأقل في متناول الباحثين والكتاب.
والأستاذ الإمام هو واحد من كبار أولئك العلماء المجتهدين، والدعاة المصلحين، ليس في مصر وحدها، بل في تاريخ الإسلام الحديث. وقصدنا في هذا البحث هو تحليل أصوله الاجتماعية، وبيان مصادر تكوينه الفكري والثقافي، باعتبار أن ذلك شرط ضروري، يوصي به منهج السيرة الحياتية الذي يضرب بجذوره في التراث الديني الإسلامي والأدبي العربي، وجرى تطويره في سياق تطور العلوم الاجتماعية المعاصرة، ومنها على وجه الخصوص علم اجتماع المعرفة. ومن شأن الأخذ بهذا المنهج أن يساعدنا في الوصول إلى فهم أفضل للاجتهادات الفكرية والرؤى الإصلاحية والتجديدية التي قدمها طول حياته. صحيح أن حياته كانت قصيرة بعدد السنين والحساب (سبعة وخمسين عاماً)، ولكنها كانت طويلة وعريضة وعميقة بما أنجز خلالها من أعمال متنوعة ومهمة، وبما أثارته تلك الأعمال من جدل واسع إبان حياته في دوائر الفكر والثقافة والسياسة والتربية والإصلاح، ولا تزال تثير مثل هذا الجدل، وتوفر مادة بالغة الثراء لكثير من البحوث والدراسات والمطارحات الفكرية حتى اليوم.
وعلى أي حال فليس من مهمتنا هنا البحث في مضامين أعماله الفكرية، أو مواقفه العلميةـ، ولا التطرق كذلك إلى الرؤى وأفكار الأستاذ الإمام بشأن قضايا محددة من القضايا التي انشغل بها؛ فمثل هذه الموضوعات تخرج عن نطاق الهدف من هذا البحث، اللهم إلا بالقدر الذي يقتضيه سياق الحديث عن خلفياته الاجتماعية وكيف أثرت على مواقفه العلمية، وعلاقاته بمحيطه الاجتماعي والسياسي العام الذي عاش فيه، أو بالقدر الذي يقتضيه بيان مصادر تكوينه الثقافي والفكري وانعكاس تلك المصادر على آرائه واجتهاداته الفكرية.
وفي سبيل إدراك هدفنا من هذا البحث سنقوم بعملية تنسيب مزدوجة على النحو الآتي :
1- التنسيب الاجتماعي لشخصية الأستاذ الإمام؛ ونقصد بذلك أمرين: أولهما يتعلق بنسبه العائلي والأسري، مع بيان ما لذلك من أثر في تكوينه النفسي والوجداني، وربما تكوينه الفكري أيضاً. ويتعلق ثانيهما بانتسابه إلى المحيط الاجتماعي الأوسع الذي نشأ فيه، وعاش في إطاره، وانخرط في شبكة العلاقات الاجتماعية بكل تعقيداتها وتفاصيلها اليومية.
2- التنسيب الفكري والثقافي؛ وذلك من حيث المصادر التي استقى منها وانفعل بها عندما كان لا يزال في مرحلة التكوين الأولى في مطلع حياته، وكذلك من حيث علاقته بالتيارات الفكرية والسياسية الرئيسية تاتي عاصرها، ورؤيته لها، وموقفه العام منها، وكيف استقبلته الأوساط العلمية والفكرية والثقافية التي كانت قائمة آنذاك.
وتعني عملية التنسيب الاجتماعي والفكري على النحو المذكور أننا سنستخدم ما يعرف في علم اجتماع المعرفة بمنهج «السيرة»، أو منهج «التأريخ الشخصي»، الذي نجد جذوره في تراثنا الديني الإسلامي والأدبي العربي. والسيرة النبوية لابن هشام هي النموذج الأكثر شهرة في هذا الميدان، إلى جانب كثير من النماذج التي نجدها في أعمال أخرى تجلت فيها هذه المنهجية مثر كتب الطبقات والأعلام والتراجم والمغازي والسير الملحمية. ولم يكن من اليسير فهم كثير من وقائع الاجتماع الإسلامي بمعزل عن تلك الأعمال العلمية التي ركزت على البناء الفردي وصلته بالبناء الاجتماعي المحيط به، انطلاقاً من رؤية معرفية كانت تؤكد على أن علم الاجتماع الحقيقي (أو العمران بحسب ابن خلدون) هو حصيلة التقاء التاريخ العام بالسير الذاتية. ومن أسف أن نماذج السير الحياتية والتراجم الذاتية التراثية لم تنل شيئا يذكر من اهتمام علماء الاجتماع وباحثيه في بلادنا العربية والإسلامية، وظلت القواعد المنهجية التي انطوت عليها مبعثرة في بطون الكتب، وانطمرت فوائدها المعرفية أو كادت بمضي الزمن وبفعل التغيرات الاجتماعية المتوالية.
حدث ذلك في الوقت الذي شهد فيه علم الاجتماع الحديث في أوربا وأمريكا اهتماماً لافتاً بالمنهج البيوجرافي Biograghy، والأوتوبيوجرافي Autobiographyوبالعربية «السيرة» و «السيرة الذاتية»- والفرق الأساسي بينهما هو أن السيرة الذاتية يقوم صاحبها بكتابة وقائعها وربما بتحليلها بإرادته هو، بينما السيرة، أو الترجمة يقوم بكتابتها آخر أو آخرون اعتمادا على المصادر الوثائقية المتاحة، بما في ذلك المعلومات التي تتضمنها السيرة الذاتية للشخص محل الاهتمام. ومثل هذه المنهجية آخذة في الازدهار في مجالات العلوم الاجتماعية بمعناها الواسع، بما فيها علم الاجتماع، وذلك بعد أن كان هذا العلم يركز في مراحل سابقة على كل ما هو «اجتماعي»، مغفلاً ما هو «فردي» ودوره في تشكيل الواقع الاجتماعي، معتبرا أن السير الفردية أمر ثانوي لا يصلح للتحليل الاجتماعي المتعمق. وهذه المسألة المنهجية تحتاج إلى مزيد من التأمل، وبخاصة فيما يتعلق بمعزوف الجماعة الأكاديمية المشتغلة بالعلوم الاجتماعية في الجامعات ومراكز البحوث العربية عن الاهتمام بتطبيق منهجية السيرة الذاتية أو الحياتية، إلا في حالات نادرة ومتناثرة، لا تشكل في مجموعها خطاً منهجياً واضح المعالم والأهداف، وهذا موضوع بحث آخر مستقل لا يتسع له المجال هنا.
وفي ضوء الملاحظة المنهجية السابق ذكرها، تتضح أهمية البحث في سيرة الأستاذ الإمام – موضوع اهتمامنا هنا – ليس بوصفها مرآة تعكس ذاته الفردية وتكشف دخائلها على طريقة حكايات التحليل النفسي، وإنما باعتبارها نافذة تسمح بتفسير جوانب من الوقائع الاجتماعية والسياسية التي عاصرها الأستاذ الإمام، وتساعد في تجسير الفجوة بين تجربته الفردية ومحيطه الاجتماعي، وتبين كيف قرأ واقعه وكيف تعامل مع أنظمته القيمية والمؤسسية الموروثة، وتلك الوافدة. فإذا نجحنا في إدراك ذلك – أو في بعضه على الأقل – أمكننا تجنب إخفاقاته وتجديد نجاحاته، وأمكننا قبل هذا وذاك فهم تراثه الفكري على نحو أكثر دقة وعمقاً. ومن أهم المصادر التي سنعتمد عليها في بحثنا: الجزء الذي كتبه الإمام عن سيرته الذاتية ولكنه لم يكمله قبل فوات العمر، ونشره تلميذه الشيخ رشيد رضا في «تاريخ الأستاذ الإمام»، ونشره طاهر الطناجي بعد ذلك أيضاً. كما سنعتمد على عدد من الدراسات والكتابات الرصينة التي تناولت شخصية الإمام، وطبقت في تناولها أو حاولت تطبيق منهجية البحث البيوجرافي، أو السيرة الحياتية،، ومنها مثلاً – وربما من أهمها – كتاب عباس العقاد بعنوان «محمد عبده»، وكتاب محمد عمارة بعنوان “الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين”. ووفقا لما يوصي به المنهج المذكور فإن المعلومات الخاصة ببيئته التي نشأ فيها، وبالجماعات المرجعية الأولية التي احتك بها (الأسرة، والأقارب، والأصحاب، والأساتذة) ستكون ذات قيمة كبيرة في هذا السياق. وكنا نود لو أننا تمكنا من الاطلاع على ملف خدمته في الجهات الحكومية التي عمل بها، وعلى ملفه الصحي، ومحضر التحقيق معه إبان الثورة العرابية، ولكن تعذر ذلك لأسباب كثيرة. وعلى أية حال فإننا لا نهدف إلى الإحاطة بكا أبعاد سيرته في هذا البحث الموجز، بل سنقتصر – كما قدمنا – على جانبين فقط هما : أصوله الاجتماعية، ومصادر تكوينه الفكري والثقافي.
أولا: الأصول الاجتماعية والنشأة الريفية :
ينتسب محمد عبده إلى «بيت خير الله»، وهو أحد العائلات الممتدة في دلتا النيل. وكانت كثيرة العدد من الرجال والنساء. حالتها متوسطة بين الغنى والفقر، ومكانتها الاجتماعية أعلى من مستواها الاقتصادي، وصلتها بالتدين وبالسياسة كانت أسبق من علاقتها بالعلم والأدب. كان جده لأبيه فلاحا من أهالي قرية «محلة نصر» من قرى مركز شبراخيت بإقليم البحيرة، اسمه «حسن خير الله» وهو الذي بقى من بيت خير الله مع ابن أخيه إبراهيم بعد أن عسف الحكام من أسرة محمد علي بسائر أهله، بحجة أنهم ممن يحملون السلاح ويقفون في وجه الحكام وأعوانهم عند تنفيذ المظالم(1).
ولا تمدنا المصادر بمعلومات أخرى ذات شأن عن جده لأبيه. وتصمت تماما عن جدته من جهة أمه ومن جهة أبيه أيضا، اللهم إلا القول بأنها من بني عدي في صعيد مصر، وأنها تنتمي إلى قبيلة عربية ترقى إلى عمر بن الخطاب، وعندما سئل الأستاذ الإمام عن صحة هذا النسب قال«إنها روايات متوارثة لا يمكن إقامة الدليل عليها»(2). وربما كان هذا الصمت عن سيرة الجدات بالذات أثراً من آثار إهمال ذكر المرأة في المجتمع آنذاك عامة، وفي الريف خاصة، واعتبار ذلك مما لا يليق حسبما جرى به الإلف، وأكدته العادة في عهود سابقة. وفيما بعد كانت قضية المرأة من بين أهم القضايا التي اهتم بها الأستاذ الإمام وسعى لفكها من أسر قيود التقليد التي لا تمت للإسلام بصلة.
ولا تمدنا المصادر المتوافرة – أبضاً – بأي شيء يذكر عن مساحة الأرض التي كان يزرعها جده في محلة نصر التي أقام فيها، ولا عن أصل لقب «التركماني» الذي أشتهر به بيته، حتى إن الأستاذ الإمام نفسه كان يسمع المزَّاحين من أهل البلدة يلقبونه به وهو لا يفقه معناه، ولكنه سأل عنه والده فقال له: «إن نسبنا ينتهي إلى جد تركماني جاء من بلاده في جماعة من أهله سكنوا الخيام مدة من الزمن»(3). ويرى العقاد أن هذه الرواية تشير إلى أن لقب التركماني لم تكن تتحدث به الأسرة وتدعيه لنفسها مفاخرة به، كما كان يفعل بعض المنتسبين إلى أصول غير مصرية في عهود الطغيان الأجنبي، وبعد الرجوع إلى أخبار التركمان في مصر يستنتج العقاد أيضا – دون الاستناد إلى معلومات موثقة – أن هذا اللقب يحتمل فرضين: أحدهما أن الأسرة لقبت به عدة قرون بغير معنى وبغير سبب. وفي رأينا أن هذا الفرض مستبعد؛ إذ من غير المعقول أن يستمر عبر عدة قرون، دون أن يكون له ظل من الحقيقة، فضلا عن وجود فرائن أخرى تفنده، كما يتضح من الفرض الثاني، وهو أن الاتفاق في التسمية ومن سكنى الأسرة الخيام ومن نشأتها على الفروسية وحمل السلاح الذي كان بقية منقولة من أزمنة سابقة، يجوز أن نفهم «أن جداً قديماً للأسرة وفد إلى مصر قبل نحو ثمانية قرون، واختار المقام في إقليم البحيرة لموافقة في ذلك العهد على الخصوص لسكنى البادية، ويرجح أن مقدم هذا الجد إلى مصر كان على أيام صلاح الدين لأنه كان يستكثر من جنود الأكراد وجيرانهم التركمان، وكان شديد العناية بإقليم البحيرة وكل ما جاور ميناء الإسكندرية إلى الغرب، أو طريق الصحراء الغربية؛ من حيث وفد الفاطميون أسلافه في حكم مصر، ولم يزل على حذر من جانب هذا الطريق بعد إسقاط الدولة الفاطمية بعدة سنين؛ فلا جرم أن يختص بإقطاعه أقرب الناس إليه، وينشر فيه جنده التركمان والأكراد، ليقيموا فيه مقام الأهل، ويحرسوه حراسة العسكر مع مقامهم فيه»(4).
ويؤيد هذا الفرض ما اشتهرت به عائلة الإمام من الفروسية، وحمل السلاح، ومهارة استخدامه، وكان ذلك بعض ما ورثه هو، وحرص على ممارسته في مطلع حياته، وذكر ذلك عن نفسه فقال: «كنت معروفً بالفروسية واللعب بالسلاح». وورد في وصف غيره له بأنه «شيخ حسن البزة، جهير، يمتطي فرساً عربياً كميتاً، جميلاً..»(5).
أمضى الجد «حسن خير الله» حياته فلاحاً لم يبرح قريته «محلة نصر» شأن الأغلبية الساحقة من فلاحي مصر على طول الزمن، إلى أن مات بالطاعون الذي فتك بكثير من سكان القطر في منتصف القرن التاسع عشر. ولكن الوالد «عبده حسن خير الله» – الذي ولد في تلك المحلة، ولكن لا يعرف له تاريخ ميلاد ولا وفاة – لم تكن حياته مستقرة؛ إذا اعتقل في عهد عباس الأول مدة، واضطر لمغادرة قريته والعيش بعيداً عنها خمسة عشرة عاماً تحت ضغط المضايقات الحكومية بعد أن جدد الواشون وشايتهم به عند السلطات بنفس الحجة القديمة التي ابتلى بها أكثر رجال العائلة؛ وهي حمل السلاح ومقاومة الظلم. انتقل الوالد أول الأمر إلى قرية «حصة شبشير» التابعة لمركز السنطة – آنذاك – على مقربة من طنطا، وهناك تزوج بالسيدة «جنينة بنت عمر عثمان»، عميد أكبر بيوت القرية، وكانت تقيم مع والدها وهي أيم لها ولد اسمه مجاهد، هو الأخ غير الشقيق للأستا الإمام(6). وقد وصف الأستاذ والدته بأنها «كانت ترحم المساكين، وتعطف على الضعفاء، وتعد ذلك مجداً وطاعة لله وحمداً… ويقول إن منزلتها بين نساء القرية لم تكن تقل عن منزلة أبيه بين رجالها»(7).
ولما كانت عيون السلطة تجد في طلب والده «عبده خير الله»؛ إذا لم يكف هو عما اعتبرته شغباً عليها، فإنه سرعان ما ترك حصة شبشير، وقصد هو زوجته وأخيه (عم الإمام) «طوخ مزيد» التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية أيضاً؛ إذا كان أصهاره فيها، وله أقارب في بعض القرى المجاورة لها، وكان معهم – كما يقول الأستاذ في تاريخه – قدر من المال يسمح باستئجار أطيان يعملون فيها بأيديهم، ومعونة شركائهم»(8).
ولقي ترحيباً من أهل تلك القرية، ولكنه آثر الإقامة في قرية مجاورة لها تسمى «شنّرا»، وحصل على فدان من الأرض بالإيجار من عمدة شنرا(9). واشتهر بين أهالي القرية بالفتوة والبراعة في الصيد بالسلاح، فأحبه لذلك مصطفى أفندي المنشاوي ومحمد أخوه، وكانا موظفين في دائرة الخديو إسماعيل: أولهما يعمل في وظيفة مفتش زراعة، والثاني في وظيفة ناظر، وطابت له صحبتهما، فعدوه كأنه واحد من أهلهما، ودام ذلك مدة سنين»(10).
وفي سنة غير معلومة لنا عاد الوالد «عبده خير الله» إلى بيته في مسقط رأسه محلة نصر. ويذكر العقاد أنه كان بيتاً كبيراً بغير باب تعيش فيه أكثر من أسرة صغيرة من أسر عائلة خيرا الله الكبيرة. وترك الدار بغير باب في الريف علامة في وقت واحد على الكرم الذي لا يرد قاصداً ضيفاً أو غريباً. والمنعة التي لا تغري مهاجماً مستبيحاً. ومن ذكريات الأستاذ الإمام في طفولته أنه «كان قبل أن يدرك معنى الكرم والمنعة يرى أن الكبراء من زوار القرية ينزلون في بيت العمدة وهو أغنى من أبيه وأقرب إلى مقام الرئاسة في الحكومة، وكان أبوه يأكل مع الضيوف ولا يأكل مع أهل الدار، فإذا خلا البيت من الضيوف تناول طعامه وحده على حكم العادة، فكان – محمد عبده وهو طفل صغير – يضيف هذا الانفراد إلى سمت الوقار الذي يرعاه لأبيه، ويحسبه أكبر رجل في الدنيا»(11).
وإذا كانت شيمة الكرم في عادات أهل الريف معروفة، وكانت خصلة الأنفة في سلوكيات بعضهم مألوفة، فمن النادر أن تجد منهم من يجرؤ على تحدي السلطة، أو يجاهر بمعارضتها، منها إذا طلبته، أو يغترب عن بلدته حتى لا تصل إليه يد الحكومة. وفي أواخر العصر العثماني الذي عاشه آباء محمد عبده وأجداده، وأدرك هو جانباً منه، «كان الفلاحون من الملتزمين أذل من العبد المشترى، فربما كان العبد يهرب من سيده، أما الفلاح فلا يمكن أن يترك وطنه وأولاده ويهرب، وإذا هرب إلى قرية أخرى واستعلم أستاذه مكانه أحضره قهراً وازداد ذلاً ومقتاً. وإذا آن وقت الحصاد والتحضير طلب الملتزم أو قائم مقامه الفلاحين فينادي الغفير عليهم إلى شغل الملتزم، فمن تخلف أحضره الغفير أو المشد وسحبه من شنبه، وأشبعه سباً وشتماً وضرباً وهو المسمى عنده بالعونة والسخرة»(12). ومعنى ذلك أن الفلاحين المصريين خير من يعرف أن يد الحكومة أطول من السنة السوداء؛ من طول ما قاسوه من عسف ولاة الأمر وظلمهم وأكلهم أموالهم بالباطل، وسرقة ثمار كدهم وشقائهم في العمل. وليس في الثقافة السياسية للفلاحين الشئ الكثير الذي يحث على مقاومة الحاكم الظالم، وليس فيها إلا القليل الذي يحفزهم على أن يشقوا عليه عصا الطاعة. كانوا كذلك منذ أقدم العصور، ولم يتغير حالهم كثيراً حتى يومنا هذا(13). ولذلك اتسم سلوكهم تجاه الحكومة في الغالب الأعم بالامتثال والاستكانة والنأي بجانبهم عنها قدر ما يستطيعون؛ فهي في قرارة أنفسهم «شر»، وخير طريقة للتعامل مع هذا النمط من الشر هو ما عبروا عنه في قولهم المتوارث «ابعد عن الشر وغنِ له».
ويبدو من سيرة عبده خير الله أنه سلك الدرب الأصعب، ولم يرض لنفسه أن يقيم على ذل يحل به، كما لم يرض لغيره ممكن رآهم يقعون ضحايا للاستبداد والاستغلال، فكان يسارع إلى إغاثة الملهوف، ويشارك مع أبناء عائلة المنشاوي في ايواء الهاربين من الخدمة العسكرية في أشد أيام النقمة عليها، وينصر الضعيف المطارد الذي تطلبه يد الظالم ذي الشوكة. ويبدو أيضاً أن الاستكانة لم تكن من طبعه، ولا الامتثال من سجاياه؛ إذ أنه آثر الاغتراب عن بلدته بدلاً من أن يقيم بها على ضيم، وتنقل بين أكثر من بلدة كما رأيناه، ولما آنس محلة نصر الطمأنينة مع الكرامة قفل إليها راجعاً، مستأنفاً سيرته الأولى، وسيرة أسلافه وما ورثه عنهم، منذ عرفت لهم أعمال، ورتبت عنهم أخبار، «فهم في قريتهم الصغيرة كرام يجدون بما عندهم، ويأبون الضيم لأنفسهم، ولمن يلوذ بهم من جيرتهم»(14). كان «المشترك القروي» (15) بين الأغلبية الساحقة من أهالي القرى – ومنها محلة نصر، وشبشير الحصة، وطوخ مزيد، وشنرا التي تنقل بينها والد الإمام – هو تراث من القسوة والتعرض للاستغلال، وكان عبده خير الله من القلائل الذين حاولوا نزع أنفسهم من هذا المشترك. وتحمل في سبيل ذلك الاغتراب عن بلده، والمصاب في الرزق ليصون كرامته وكرامة عائلته.
لمثل هذا الأب ولد محمد عبده في أحد أيام سنة 1266 هـ / 1849 م. وثمة ثلاث روايات بشأن مكان مولده: الأولى أنه ولد في قرية محلة نصر حيث مسقط رأس أبيه وسائر عائلته، وقد سادت هذه الرواية لفترة طويلة، وأكدها الدكتور محمد عمارة في معظم أعماله عن الإمام(16). ثم تبين أن هناك رواية ثانية تقول بأن مولده كان في حصة شبشير بلدة أمه، وهي على مقربة من مدينة طنطا، وقد ذكر العقاد هذه الرواية وقال إن مولده كان هناك، «ولكنه نشأ بقرية محلة نصر»(17). وظهرت منذ سنوات قليلة مضت رواية ثالثة تقول إن مولده كان في بيت الماضي عمدة قرية «شنرا» التابعة لمركز الجعفرية بالغربية. واستند أصحاب هذه الرواية إلى معلومات مستقاه من ملف الأستاذ الإمام المحفوظ في دار الوثائق القومية(18). ويبدو أن الرواية الأولى لم تعد تقوى على الصمود أمام الروايتين الثانية والثالثة، وعلى فرض صحة أيهما فإن الذي يهمنا هنا هو أنه ولد بينما كان والده في «تغريبة» من تغريباته الاختيارية حتى لا تبطش به يد السلطة على ما قدمنا. ولا نعرف كم عدد السنوات التي مكثها عبده خير الله في تلك التغريبة بعد أن ولد ابنه محمد، قبل أن يقرر العودة إلى محلة نصر، ويتعرض للاعتقال لمدة – لا تفيدنا المصادر كم كانت مدة الاعتقال – في عهد الخديوي عباس الأول، ثم أفرج عنه في عهد خلفه سعيد. وفي جميع الأحوال فإن محلة نصر كانت موطن نشأة الأستاذ الإمام بعد مولده – فيها أو في غيرها – في سني طفولته المبكرة، حتى بلغ أشده، متنقلاً بينها وبين قرى أخواله وأخوال أبيه، وبينها وبين مدينة طنطا القريبة من تلك القرى. ومن ثم تفتح وعيه أول ما تفتح في أجواء الريف، ولابد أنه لاحظ عادات أسرته وعائلته الممتدة، والعائلات الأخرى القريبة منها او التي تساكنها القرية، وتشاركها شظف العيش، ولابد أنه تأثر بظروف بيئته القروية بما كان لها من سمات اجتماعية واقتصادية وخصائص ثقافية خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، أو النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي على وجه التقريب.
ولد الأستاذ الإمام ابناً لفلاح يأبى الذل ويتحدى الظلم، ويعتز بكرامته، ويحافظ على «سِبْر» أسرته وعائلته الممتدة، والمقصود «بسِبْر» الأسرة من المنظور الاجتماعي هو ما يكشف عن عاداتها وأعرافها التي تميزها عن غيرها. ولو شئت لقربت البعيد فقلت إن سبر الأسرة هو دستورها غير المكتوب الذي تعتمده للمحافظة على كيانها ومكانتها الاجتماعية. «وكان هذا السبر – قبل أن تسري على الألسنة كلمة التقاليد العائلية – أقوى سلطاناً بين أهل البلد من سلطان الحكم، والشريعة في كثير من الأحوال»(19)، وبخاصة فيما يتعلق بأسلوب التعامل مع الناس، والموقف من السلطة، والمسائل الخاصة بالزواج والمواريث وتسمية الأبناء.
وتدلنا الأخبار المتوافرة على أن صفات النخوة والشجاعة وإباء الظلم كانت هي «المشترك العائلي» الذي ميز محضنه الاجتماعي الأول (عائلته)، وقد حافظ سبر العائلة هلى هذا المشترك. ومن ذلك ما تواتر عن تحديها مظالم الحكام، ونرتها للمظلومين، وأيضاً ما يختص بعادتها في التسمية، فقد كانت «تختار الأسماء لمعانيها ومناسباتها، … فمن أسمائهم محمد وإبراهيم وعلي وحسن وعثمان وحمودة، ومنها بهنس ومجاهد ومحروس … وكذلك اسم خير الله كبير الأسرة: إنه خير الخالق وليس بخير أحد سواه، وأصغر أبناء الأسرة حمودة وهو اسم محمد للتحبيب، سمي به لأن له أخا أكبر منه يسمى محمداً،…»(20). ويرجح العقاد القصد من هذه العادة في التسمية، ويذهب إلى أنها كانت مناسبة لحالة الأسرة، غير منقطعة عن معانيها كما تنقطع الأسماء في كثير من الأسر، ويخلص إلى أنه إذا صح ذلك فهو آية أخرى من آيات الاستقلال بالرأي في هذا البيت وعادة من عادات أناس يريدون لأنفسهم، ولا يراد لهم فيما يعنيهم من شئون الأبناء والآباء. واسم صاحب السيرة «محمد» هو الاسم الذي يقترن باسم أبيه فيساوق لفظ التحية الإسلامية كلما ذكر النبي «محمد عبده» ورسوله. فمحمد عبده اسم للوليد وذكرى لنبي الإسلام عليه السلام»(21).
وإذا كانت الدلائل تشير إلى تمع عائلته بمكانة اجتماعية عالية في القرية؛ فمرد ذلك إلى الأخلاق والقيم التي اشتهرت بها ورعتها، إضافة إلى كثرة عدد أفرادها وسعة انتشارهم في قرى الغربية. من هيبة في أعين الناس هي ما عبر عنه ابن خلدون قديماً بمفهوم «الجاه»؛ وهو يعني القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع، والتسلط بالقهر والغلبة، وغالباً ما يكون ذلك بالاستناد إلى ثروة وأملاك، أو منصب ورياسة»(22). ولكن لا الرياسة والمنصب، ولا الثراء والأملاك كانت في حالة عائلة الإمام مصدراً رئيسياً لمكانتها أو جاهلها؛ إذ كانت من متوسطي الملكيات، تعمل في فلاحة الأرض، ولم يتجاوز ما تملكه أربعين فداناً من الأرض الزراعية عند وقوع الثورة العرابية(23)، ومثل هذه المساحة لم تكن تشكل ملكية كبيرة في ذلك الوقت، ولا تنم عن ثراء ذي شأن، وخاصة إذا نظرنا إلى كبر عدد أفراد العائلة؛ الذين كانوا جميعاً فلاحين؛ وكانت الأرض الزراعية مسرح عملهم ومستودع كدحهم وشائهم. نعم: كانت عائلته مستورة، ولكنها لم تكن ثرية بمعايير زمنها، وتقع في منزلة متوسطة بين عائلات أغنى، وأخرى أفقر منها في مجتمع القرية. وكان أخوال أبيه هم أيضاً أكثر سكان القرية «كنيسة أورين»، بالقرب من طنطا، ومنهم الحاج محمد خضر عمدة القرية. أما أخواله هو فكانوا معظم سكان حصة شبشير، وجده لأمه هو – كما أسلفنا – عميد بيت عثمان الكبير، وجميعهم من فلاحي مصر.
كانت مكارم الأخلاق هي أساس ما تمتعت به العائلة من جاه، وكانت القيم والفضائل هي صلب «المشترك العائلي» الذي ربط فروع أسرته بأصولها، وهي تعيش في أعماق ريف مصر، وفي الريف يُصنع أكثر المصريين ألمعية وزكاءً وصبراً وقوة على مجالدة الحياة ومعالجة متاعبها.
وقد تحدث الأستاذ الإمام نفسه عن مكانة أسرته حديث المعتز بشيم الفتوة والنخوة والكرم وفضائل الأخلاق.
وإذ تَبٌتَ أن العائلة لم تكن من أهل الثراء، ولم تكن أيضاً من ذوي الخصاصة، فمن المرجح أن هذا المشترك الأخلاقي كان سبباً رئيسياً فيما تعرضت له من اضطهاد السلطة وملاحقتها لأبنائها، وسجنهم تارة وتشريدهم تارة أخرى، بل وقتل البعض منهم.
أمضى «محمد عبده» سنوات صباه الباكر متقلباً بين فروع تلك العائلة، متنقلاً بين أكثر من قرية من أرياف وسط الدلتا؛ شبشير الحصة موطن أخواله، وكنيسة أورين موطن أخوال أبيه، ومحلة نصر مستقر عائلته الكبيرة؛ حيث فلاحة الأرض هي النشاط الأكثر أهمية، والمصدر الرئيسي لرزق عموم الأهالي.
وفي تلك الفترة – النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري – الربع الأول من النصف الثاني من القرن التاسع عشر – ما كاد أهل القرى أن يستريحوا من مساوئ الالتزام بعد أن ألغاه محمد على (24) حتى خضعوا من جديد لمساوئ نظام الإقطاع (الملكيات الزراعية الكبيرة) الذي تشكل في ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد، وعبر سلسلة طويلة من الإجراءات الخاصة بإقرار حقوق الملكية، امتدت من صدور لائحة الأطيان السعيدية سنة 1858 إلى صدور الأمر العالي سنة 1896 الذي أقر الملكية الكاملة في جميع أنواع الأراضي الزراعية: الخراجية، والعشورية، وأراضي الرزق الأحباسية، والأبعاديات، والوسايا(25).
وفي تلك الظروف كانت ممارسات العسف والاستغلال والاستكانة هي «المشترك القروي» الذي تفتحت عينا محمد عبده عليه، وبخاصة في محلة نصر التي «مارست …. العيش في ظل الإقطاع، وسميت محلة نصر لأنها كانت إقطاعاً لرجل بهذا الاسم، لم يبق من تاريخه ما يعرف غير هذه التسمية»(26).
ولم تكن مساوئ هذا المشترك جديدة آنذاك على أهل القرى، ولم يمكنهم التخلص من أكثرها حتى اليوم.
ويبدو أن تلك الممارسات انطبعت في ذهن محمد عبده، ويبدو أن مظاهر القهر والاستبداد التي أصابت عائلته، وقصص المقاومة التي أبدتها هذه العائلة وغيرها من العائلات لم تفارق وعيه، حتى إنه عندما امتلك ناصية القلم انتقد سيطرة الأغنياء، وندد بحكم أسرة محمد علي، وأدان سياستها بشدة، وخص رأس العائلة بالقدر الأكبر من النقد فهو «حاكم قضى على قوة أبناء البلاد الأصليين، لم يدع فيها رأساً يستتر فيه ضمير أنا، واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلاً لجمع السلاح من الأهلين»(27).
وفي محلة نصر – مرتع طفولته ومعهد صباه – أدرك باكراً أهمية الدين في الحياة الاجتماعية لأهلها، ففيها مقام أحد الأولياء، وأثر من آثار التصوف، وأهلها يحبون التعليم الأزهري وينذرون بعض أبنائهم لتلقي العلم في معاهده، وهو نفسه كان نذراً من تلك النذور.
ولابد أنه لاحظ أن أعمال البر التي حض عليها الإسلام تقوم بدور كبير في ضمان قدر محترم من السلم الأهلي، وفي توثيق روابط الأخوة بين أناس جمعت بينهم مساوئ «مشترك قروي» ثقيل؛ أوجدته ظروف الحياة الاقتصادية والسياسية.
وعندما اشتد عوده، وصار من ذوي المناصب الرفيعة، لم ينس آلام المحرومين من الفقراء وذوي الحاجات الذين ارتسمت صورهم في ضميره منذ صباه، وبذل من ذات يده ما قدر عليه للأخذ بيد الضعيف، وإغاثة الملهوف، واهتم بتأسيس الجمعيات الخيرية، وشهد له كثثيرون بأنه كان رائداً في هذا الميدان، وكانت المؤسسات الخيرية التي نشأت برعايته أثبت الجمعيات المصرية، وأنفعها، وأقدرها على أداء مقاصدها في محاربة الجهل والفاقة، وأهمها جمعيتان: الجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية العروة الوثقى.
وممن شهدوا له العقاد الذي قال: «عرفنا أناساً نظروا إليه في جوف الليل يطرق عليهم الأبواب، ويسلمهم ما قدر عليه من عاجل الصدقة، وهو يقول لهم إنه من جهات الخير يؤديه إليهم ولا يعرفهم بنفسه» (28)، ورثاه صاحب جريدة الصاعقة فقال: «أما مروءته فليس أقوى دلالة عليها من خروجه قبل أن تخرج الشمس من غمدها، وجيبه ممتلئ برقاع امتلأت بحاجات الناس، ولا يَرْجع إلى داره إلا بعد أن يُرجِعَ الدهر عن معاكسة من وضعوا آمالَهم فيه …» (29).
ووصفه قاسم أمين فقال: «كان ملجأً للفقراء واليتامى والمظلومين والمرفوتين والمصابين بأي مصيبة» (30).
ولم يكن «المشرك القروي» الذي شكلته ممارسات العسف والاستغلال والاستكانة في الريف الذي نشأ الإمام محمد عبده بين ربوعه في تلك الفترة إلا صورة مصغرة «للمشترك الاجتماعي» الذي شمل المصريين جميعا بالاستبداد السياسي، والظلم الاجتماعي، وزاد عليه التدخل الأجنبي بكل مساوئه من جهة، وحالة التوتر – من جهة أخرى – بين الجمود على القديم الموروث، الذي صادفه في التعليم الأزهري، والتعلق بأهداب الفكر الوافد في ركاب قوى الاحتلال والسيطرة الأجنبية.
وقد نهض الإمام لمقاومته وتفنيد ادعاءاته وبخاصة ما كان منها موجهاً إلى الإسلام وتعاليمه، وسجل ذلك في أكثر من عمل، ومن ذلك كتابه «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية».
وفي مقابل تلك الصورة، نلاحظ أن تقاليد الشرف والإباء والاعتزاز بالأصل والنسب بين بيوتات الريف – ومنها بيت خير الله التركماني جد محمد عبده – كانت مورداً أساسياً لرفد روح المقاومة ضد التدخل الأجنبي، ورفض الاستبداد الداخلي على مستوى المجتمع بشكل عام.
وإذا كان الوضع الطبقي يعد من بين العوامل الاجتماعية / الاقتصادية التي لها تأثير في صبغ التوجهات الفكرية للشخص بصبغة معينة، فقد نشأ الأستاذ الإمام – كما قلنا – في أسرة متوسطة الثراء، مستورة، تستمد جاهها من تمسكها بالقيم ومكارم الأخلاق.
وكانت تلك القيم هي أهم ما ورثه منها، وظلت مصاحبة له إلى آخر حياته، وانطبعت في آرائه ومواقفه.
أما هو فقد كانت له مكانة اجتماعية عالية منذ تخرجه من الأزهر، وتقلده مناصب رسمية رفيعة نقلته إلى وضع اجتماعي أفضل مما لو عاش في بلدته وعمل بالزراعة كأخويه علي ومحروس.
وصار من أصحاب «الجاه» المركب من مكارم الأخلاق، ومناصب الرئاسة وأعلاها – بالنسبة له – كان منصب مفتي الديار المصرية، إلى جانب العلم الغزير الذي سجلته أعماله المكتوبة، ومحاوراته الفكرية مع رموز عصره من العلماء والمفكرين.
وليس في سيرته أو جاهه لجر منافع شخصية له، أو لبلوغ مبالغ الثراء والرفاهية.
زوجه أبوه وهو في السادسة عشر من عمره، وهي سن مبكر كعادة أهل الريف في تزويج أبنائهم وبناتهم، ولا تمدنا المصادر بشئ عن زوجته، اللهم إلا أنها توفيت على ما يبدو أثناء إقامته منفياً في بيروت، فتزوج سنة 1882 بلبنانية من بيت آل حمادة – المعروف بلبنان – اسمها: رضا بنت سعد عبد الفتاح آغا حمادة.
وقد قضى ست سنوات تقريباً من حياته منفياً خارج مصر بعد محاكمته لمشاركته في الثورة العرابية، وقنع بعد عودته بالسكن في منزل متواضع بالقرب من عابدين، ثم انتقل في أواخر حياته إلى مسكنه بصحراء عيد شمس، وكان عبارة عن منزل متواضع بناه على جزء من فدان أرض خلاء تركه له المستشرق ولفرد سكاون بلنت يوم أمرته السلطة بمغادرة مصر.
وبعد وفاة الإمام اشترت وزارة الشؤون الاجتماعية هذا المنزل للمحافظة عليه تخليداً لذكراه، ومن ثمنه سدد ورثته ما تبقى من ثمن أرض كان قد اشتراها من أراضي الدائرة السنية بنظام التقسيط باسم أخيه الأصغر (حمودة).
ولم يعق من الأولاد الذكور غير ولد واحد توفي في طفولته، وأعقب أربع بنات كانت إحداهن دون سن الزواج عند وفاته، وتزوجت أخواتها بثلاثة إخوة أشقاء (31).
وعند وفاته لم يترك لزوجته اللبنانية ثروة تذكر. «كان أكبر نفسا وأشد احتقاراً للدنيا من أن يبذل جهده في جمع المال، فعاش عظيماً فقيراً، ومات فقيراً عظيماً» (32).
وحَبُّ الحصيدِ هنا هو أن محمد عبده قد عاش طفولته ومطلع شبابه في ذلك المناخ الممتد من الأسرة والعائلة في الريف، إلى المدينة (طنطا فالقاهرة فبيروت …) بما كانت تموج به من أحداث تجمع بين الداء والدواء، وتسكن فيها أسباب العلل إلى جانب عوامل الشفاء. وقدر له أن يعاصر فترة الاضطراب الكبير إبان الثورة العرابية، واستحكام قبضة الاحتلال الإنجليزي على مصر.
وقد جاءت وقائع حياته العلمية متأثرة تأثراً واضحاً بمعطيات نشأته الأولى، وبخلفياته الاجتماعية، باعتباره فلاحاً مصرياً تجسدت فيه عبقرية الأمة التي ينتمي إليها. ويصعب جداً تفسير مواقفه الفكرية والسياسية دون الرجوع إلى القيم التي ركزتها تلك النشأة في نفسه، وفي مقدمتها: الاعتزاز بالمجد والأصالة والغنى والثروة، والضن باحترامه على أهل الثراء، وخصوصاً المسرفين منهم والعاطلين عن الكفاءة، وأيضاً الضن بهذا الاحترام على الحكام الظالمين (33).. وقد لمس الأفغاني هذا الخلق فيه فكان يقول له: «قل لي بالله : أي أبناء الملوك أنت»، وقال عنه الخديوي عباس متبرماً منه: «إنه يدخل عليَّ كأنه فرعون. ويسمع محمد عبده هذه الشكوى فلا يزيد على أن يقول: وأينا فرعون؟» (34).
ثانيا: مصادر التكوين الفكري والثقافي :
ثمة أربعة مصادر أسهمت – بدرجات متفاوتة كمَّا وكيفاً – في التكوين الفكري والثقافي للأستاذ الإمام. أولها هو المناخ الثقافي العام للمجتمع المصري الذي عاش فيه وتأثر به، وتشرب همومه، وتشكل وعيه منذ صباه الباكر في سياق الأحداث التي كانت تمر بها مصر وبقية البلدان الإسلامية التابعة للخلافة العثمانية في سياق التحدي الاستعماري والحضاري الغربي، وذلك خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهذا المصدر يمكن أن نطلق عليه «روح العصر».
وثانيها هو نظام التعليم الأزهري الذي انخرط فيه والتحق به، عبر مراحله المختلفة من الكتاب إلى المعهد الأحمدي في طنطا إلى الأزهر الشريف في القاهرة.
وثالثها هو قراءاته الحرة ومطالعاته الخاصة في الكتب. أما رابعها فهو تأثره ببعض أساتذته وكبار معاصريه من المفكرين والعلماء على نحو خاص، وذلك بقراءته مؤلفاتهم، أو اتصاله بهم، أو إعجابه بأعمالهم وحواره معهم ومشاركتهم في بعض أفكارهم.
وعادة ما يكون إسهام المناخ الثقافي العام في التكوين الفكري للشخص إسهاماً تلقائياً وعاما ً؛ لا يختص به فرد دون آخر، وذلك بالنسبة لمجموع الأفراد الذين يخضعون لنفس المناخ في فترة من الفترات، وتتاح لهم فرصة الاحتكاك بمعطياته الفكرية وقضاياه الرئيسية المثارة.
ولكن قد يختلف تأثير هذا المناخ باختلاف الاستعدادات الخاصة بكل شخص، أو بانضمام هذا التأثير العام إلى تأثير آخر يولده مصدر – أو أكثر من مصدر – خاص؛ تكون الأقدار قد هيأته لواحد من الناس دون غيره.
أما نظام التعليم الرسمي – الأزهري – فهو يسهم في التكوين الفكري لمن يندرج في سلكه عن طريق ما يقدمه من معارف يتلقاها الطالب بطريقة منظمة في صورة مقررات أو مناهج دراسية بشكل أساسي، هذا بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به الأستاذة والشيوخ بالنسبة لتلاميذهم؛ إذ عادة ما يتأثرون بهم – أو ببعضهم على الأقل – تأثيراً سلبياً أحياناً وإيجابياً أحياناً أخرى.
وقد يتخذون البعض منهم قدوة يتبعونه، أو مثالاً يتطلعون إليه ويحتذونه. أو قد يقوم الأستاذ بدور توجيهي وإرشادي لا يظهر أثره إلا بعد مضي سنوات عديدة من خروج الطالب إلى الحياة العلمية.
ولئن كان المناخ الثقافي يعتبر مصدراً تلقائياً عاماً للتكوين الثقافي والوجداني للفرد، فإن النظام التعليمي الرسمي يعتبر مصدراً للإسهام المنتظم في هذا التكوين.
أما القراءات الحرة وكذا المطالعات الذاتية في مجالات العلم وفي فروعه المختلفة فإنها تعتبر من المصادر الخاصة للتكوين الفكري والثقافي للشخص، وتتوقف الإفادة من هذا المصدر على قدرات الفرد الذاتية؛ سواء كانت قدرات مادية أو عقلية ذهنية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
وكذلك فإن أعلام العصر من الرجال الفكر والثقافة والسياسة يسهمون في التكوين الوجداني والفكري للجمهور العام في المجتمع، وكذا في النخبة الخاصة من طلاب العلم والمعرفة.
وقد يتاح للبعض أن يتأثر بهم بدرجة أعمق من تأثر بهم بدرجة أعمق من تأثر غيرهم بهم، فيصبح أولئك الأعلام مصدرا رئيسياً في تكوينهم الفكري والثقافي، وتصبح حياتهم وأفكارهم ومواقفهم عاملاً من عوامل التطور الفكري والتفتح الذهني الثقافي للعامة والخاصة معاً، وإن بدرجات متفاوتة بين هؤلاء وأولئك.
والآن كيف أسهمت تلك المصادر في التكوين الفكري والثقافي للأستاذ الإمام محمد عبده؟ الذي صار فيما بعد – كما نعرف – أحد أهم مصادر التكوين الفكري والثقافي لأجيال متتالية من بعده من المفكرين والأدباء والعلماء.
وقبل أن نتحدث بشيء من التفصيل عن تلك المصادر نؤكد على أننا لا نقصد هنا بيان أثر كل مصدر بمفرده، أو قياس حجم هذا المصدر أو ذاك مقارنة ببقية المصادر – وإن كنا سنتكلم على كل منها على حدة – وإنما هدفنا هو رسم الملامح الأساسية لتلك المصادر، وبيان أهمية كل منها في البناء الفكري والثقافي للأستاذ الإمام بشكل عام، مع الإشارة إلى أم التأثيرات التي تركها هذا المصدر أو ذاك في اجتهاداته الفكرية ومواقفه العلمية.
هذا مع إدراكنا أن تلك المصادر أسهمت مجتمعة وبأوزان متباينة في تكوينه الفكري الثقافي.
1. روح العصر والمناخ الثقافي :
إذا نظرنا إلى المرحلة التي عاصرها الأستاذ الإمام – من بداية النصف الثاني من القرن التاسع حتى مطلع القرن العشرين – سنجد أنها كانت على المستوى المصري امتداداً لانكسار مشروع النهضة الذي قاده محمد علي منذ بدايات القرن التاسع عشر إلى أن حطمته معاهدة لندن سنة 1840.
أما على مستوى العالم الإسلامي الذي كانت تحكمه الدولة العثمانية فقد شهدت تلك المرحلة احتدام التنافس الاستعماري الاقتصادي والعسكري، ووقوع الاحتلال العسكري لعدد منها مثل الجزائر في وقت مبكر سنة 1830، وتونس ومصر – فيما بعد – في سنتي 1881 و1882 على التوالي.
وتجلت أيضاً مظاهر النفوذ الأجنبي الفكري والثقافي عبر قنوات متعددة، كانت من أهمها: الجاليات الأجنبية التي وفدت إلى البلاد، والإرساليات التبشيرية، والصحافة، ونشاط حركة الترجمة، ومدارس التعليم المدني والأجنبي، التي أخذت تنتشر في العواصم والمدن، وتجتذب أولاد النخبة وتنشئهم تنشئة مختلفة – وربما مناقضة – للتنشئة التي كانت تقدمها مدارس التعليم الديني ومعاهده، وعلى رأسها الأزهر الشريف في مصر.
ولكن ذلك العصر تجلت فيه – من جهة أخرى – مظاهر المقاومة الجهادية لذلك التحدي الأجنبي (35)، وظهرت فيه أيضاً بوادر نهضة أدبية وفكرية كانت تبشر بقرب انقشاع الظلام وطلوع فجر جديد. و «تزاوجت مع وقائع الهزائم مواقف البطولة، ومشاهد التضحية، … وانبثاق الأفكار الجديدة»(36).
كان الشرق والغرب في تلك الفترة في مواجهات استخدمت فيها أوروبا العلم والدين والثقافة والقوة المسلحة لفرض سيطرتها على بلدان العلم الإسلامي.
ورجحت منذ ذلك الحين كفة المواجهة لصالح الغرب الأوروبي، وأصبحت له الغلبة على الجانب الإسلامي اقتصادياً وعسكرياً. أما من الناحية الثقافية فقد اتسمت العلاقة مع الغرب بثلاث سمات رئيسية هي :
أ. السير في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب، أو من أوروبا إلى البلاد الإسلامية.
ب. الارتباط الوثيق بين الثقافة والقوة العسكرية للمد الاستعماري الأوروبي.
جـ. اللاتكافؤ بين أطراف هذه العلاقة، والغلبة فيها والتفوق للمركز الأوروبي (37).
ولو قربنا المعنى البعيد، واختصرنا إليه الطريق، لقلنا إن كلمة السر التي كانت تشكل روح العصر آنذاك هي «التحدي»، أو هي «المواجهة» التي فرضتها أوروبا على بلدان العالم الإسلامي، بما فيها مصر وسائر بلاد الشرق.
وانطلق رد الفعل الرئيسي خلال القرن التاسع عشر من رؤية إسلامية تدعو إلى إيجاد قناة اتصال بين نظام القيم الإسلامي من ناحية، وعناصر القوة الجديدة في الحضارة الغربية من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن ما يتم اقتباسه من تلك العناصر لا يشكل خطرا ً لا على عقيدة المسلمين ولا على الهوية الإسلامية.
وأكد الإصلاحيون آنذاك على أن التدهور الحاصل في بلاد المسلمين هو نتيجة ظروف تاريخية يمكن تجاوزها، وأن الإشكالية بيننا وبين أوروبا هي إشكالية معرفية وعلمية وتنظيمية يمكن حلها.
وخاضوا نضالاً عنيفاً ضد التقليدية الإسلامية في أمور العقائد والعادات والعبادات ومبادئ الاجتماع والسياسة والحكم، بحيث قامت على مدى ثلاثة أرباع القرن التاسع عشر منظومة من الأفكار المستندة إلى مقاصد الشريعة، والمصالح العامة المستنبطة منها، سعياً نحو تحقيق نهضة شاملة في مجالي تجديد الفكر الإسلامي وتحديث الدولة وتنظيماتها لتقوى على مواجهت التحدي المفروض عليها(38).
وقد انتظم – ضمن تلك الرؤية – رواد الإصلاح والتجديد الذين تواتروا خلال القرن التاسع عشر، وكان في مقدمتهم رفاعة الطهطاوي، وتبعه على الطريق نفسه كثيرون – وإن تباينت مواقفهم من شؤون الحكم والسياسة – وكان من أهمهم، خير الدين التونسي، وجمال الدين الأفغاني، وعلي مبارك، ورفيق العظم، والأستاذ الإمام محمد عبده.
وفي مرحلة لاحقة بدأت – على وجه التقريب – بالاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882، ومع تصاعد الهجمات الموجهة للإسلام والتشكيك في قيمه ومبادئه من قبل المستشرقين وإرساليات التنصير، وبقوع أغلبية البلدان الإسلامية في القبضة الاستعمارية، حدثت تحولات ذات مغزى في الأولويات الفكرية لرواد النهضة والإصلاح كان من نتيجتها تركيز الجهود في الدفاع عن الإسلام ورد الاتهامات ودحض الشبهات التي تثار حوله.
ومن ثم فقد بدأت قضية تحديد منهج التعامل مع الغرب وكيفية الاستفادة من منجزاته الحديثة تتم بحذر شديد، بعد أن كانت تتم بدرجة أكبر من الثقة في السابق، وبدأ فكر النهضة في هذه المرحلة يركز على الجانب الدفاعي الذي يعني برد الشبهات وتفنيد المفتريات الموجهة ضد الإسلام (39).
وفي هذا السياق جاءت محاورات الأستاذ الإمام مع أمثال: جبرائيل هانوتو، وأرنست رينان، وفرح أنطون.
كانت قرية الأستاذ الإمام التي نشأ فيها موصولة بالتاريخ العام لمصر – كما أسلفنا – وكانت مصر بمشكلاتها الداخلية والخارجية تمر بمرحلة تحول حضاري احتل التغيير الثقافي جانباً رئيسياً منه (40)، وكانت مصر في ذات الوقت موصولة بالتاريخ العام للدولة العثمانية وحوادثها الكبرى، وهكذا تفتح وعيه في مناخ سيطرت عليه قضايا التحدي الاستعماري من الخارج (41)، والجمود الفكري والاستبداد السياسي والضعف عن مقاومة المحتل في الداخل، وتلك هي الملامح الرئيسية لروح العصر وأحداثه الكبرى التي شكلت المناخ الثقافي العام الذي عاصره الأستاذ الإمام.
وقد انخرط في قضايا عصره، واستوعب جوانب مهمة من ثقافته، واختار القضايا المتعلقة بتحرير الفكر من قيد التقليد وإصلاح نظم التعليم ليعطيها جل اهتتمامه ووقته، ولم يستطع أن يظل بمنأى عن معترك السياسة العلمية قبل الثورة العرابية وبعدها، فنال منها ونالت منه.
وتدلنا أعماله الفكرية ومواقفه السياسية على أنه كان ثمرة من ثمرات عصره؛ إذ «انعكس طابع عصره على تفكيره، ولازمه في نظرته إلى العالم من حوله»(42)، وتجلى تمرده على التقليد مبكراً عندما اصطدم به لأول مرة في مطلع حياته وهو طفل صغير على نحو ما تكشف عنه سيرته في تلقي العلم. وقام خلال سني حياته العلمية بما يمكن لعالم مسلم القيام به في تثبيت أصول العقيدة أولاً، و«رسالة التوحيد» أكبر شاهد له على ذلك، ودحض الشبهات التي أثارها الخصوم ضد العقيدة وتعاليمها ثانياً؛ مثلما فعل في ردوده على هانوتو وفرح أنطون، وتجديد أساليب التفكير والتعبير ثالثاً، وذلك بما يتلاءم مع تحديات العصر ومتطلباته، بعد أن كان الجمود قد أصاب هذه وتلك، ويشهد له بذلك أسلوبه الراقي في كتاباته ولغته الدقيقة في تعبيراته.
2. أثر التعليم الأزهري :
كانت الخطوات الأولى التي مشاها محمد عبده في طريق التعليم عادية بمعايير زمنه، وكانت استجابته لنظام التعليم عادية أيضا حتى أتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثالثة عشرة من عمره تقريباً، ولابد أن أباه قد أسعده حفظه لكتاب الله، فقرر إرساله إلى الجامع الأحمدي بطنطا، ليتأهل بعد ذلك لتلقي العلم في الجامع الأزهر بالقاهرة.
وربما كان الوالد يوفي بنذر نذره يوم مولد ابنه، كعادة كثيرين من أهل القرى، وهو أن يخصص أحد الأبناء لطلب العلم الأزهري، ويهيئ له الطريق إليه على قدر ما يستطيع.
لم يدخر الأب وسعاً في تهيئة ولده لما نذر له، فأحضر له من يعلمه مبادئ الكتابة والقراءة في المنزل، ثم أرسله إلى محفظ القرآن فقرأ عليه جميع القرآن أول مرة، ثم أعاد القراءة حتى أتم حفظه جميعه في سنتين، وبعد ذلك أرسله إلى طنطا – حيث كان أخوه مجاهد – ليجود القرآن في المسجد الأحمدي لشهرة قرائه بفنون التجويد، وكان ذلك في سنة 1279 هـ – 1862(43).
وبقي الشيخ محمد عبده في الجامع الأحمدي عامين استكمل فيهما تجويد القرآن. ولكن ما إن جلس في دروس العلم بالجامع الأحمدي في طنطا لأول مرة حتى اصطدم بنصوص المقررات التي وجدها مستغلقة على فهمه، ولم يستسغ الطريقة التقليدية للتعليم التي كان الشيوخ يطبقونها، فقرر الهرب والعودة إلى القرية ليعمل بالفلاحة أسوة بمعظم أقاربه.
ومن تلك الواقعة بدأ نظام التعليم الأزهري الموروث يؤثر في تكوينه الفكري والثقافي تأثيراً عميقاً؛ ليس بالاستسلام له بل بالتمرد عليه، وليس على طريقة الحفظ التذكر كما كان سائداً لدى أغلب الطلاب، وإنما على طريقة خاصة ارتضاها الشيخ محمد عبده لنفسه، وهي طريقة العقل والنقد، والتذوق والوجدان.
وقد روى شيئاً عن ذكرياته في تلك الفترة فقال: «وفي سنة مائتين وإحدى وثمانين – بعد الألف من الهجرة – جلست في دروس العلم، وبدأت أتلقى شرح الكفراوي على الأجرومية في المسجد الأحمدي، وقضيت سنة ونصف سنة لا أفهم شيئاً لرداءة طريقة التعليم، فإن المدرسين كانوا يفاجئوننا باصطلاحات نحوية أو فقهية لا نفهمها، ولا عناية لهم بتفهيم معانيها لمن لا يعرفها فأدركني اليأس من النجاح، وهربت من الدروس، واختفيت عند أخوالي مدة ثلاثة أشهر، ثم عثر عليَّ أخي فأخذني إلى المسجد الأحمدي، وأراد إكراهي على طلب العلم، ولم يبق عليَّ إلا أن أعود إلى بلدي وأشتغل بملاحظة الزراعة كما يشتغل الكثير من أقاربي: وانتهى الجدال بتغلبي عليه، فأخذت ما كان لي من ثياب ومتاع، ورجعت إلى محلة نصر على نية ألا أعود إلى طلب العلم، وتزوجت في سنة 1282 على هذه النية …»(44).
من تلك الواقعة بدأت قصة نقده الشديد لجمود نظام التعليم الأزهري، واستمر في سعيه لإصلاحه طول حياته، ولم يدرك منه غايته حتى وفاته، بل لم تكتمل جهود الإصلاح الذي أراده بعد مرور قرن كامل من الزمن، ولا يزال الأزهر في حاجة إلى استكمال حلقات الإصلاح حتى اليوم.
وقد يسأل سائل: وما نوعية الدروس الأولى التي أدت إلى نفوره من نظام التعليم الأزهري وهروبه منه في بادئ أمره؟ والجواب هو: أن بعض الدروس كان سهلاً ميسوراً مثل دروس التجويد، ودروس الفقه، وبعضها كان بالغ العسر مثل دروس النحو؛ إذ كان يعلم كما في كتاب «الكفراوي على الأجرومية»، وأول درس فيه هو:
«بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر ، واسم مجرور بالباء ، وعلامة جره كسرةظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف، وأؤلف فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير تقديره مستتر وجوباً تقديره أنا. هذا إن جعلت الباء أصلية، وإن جعلتها زائدة فلا تحتاج إلى متعلق به، وتقول في الإعراب حينئذ: الباء حرف در زائد، واسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، والخبر محذوف تقديره اسم الله مبدوء به»(45).
ذلك هو أول درس في النحو للمبتدئين الذين لا عهد لهم به في الأزهر وفي الجامع الأحمدي – وكان يسمى الأزهر الصغير في طنطا آنذاك – وكانت سن محمد عبده خمس عشرة سنة، واستمر على هذا عاماً ونصف عام يحاول أن يفهم فلا يفهم، كما قال هو عن نفسه. ولكن ما لم يقله هو أن ذكاءه الفطري قد ساعده على التفريق مبكراً بين ما يفهم وما هو غير قابل للفهم، وأن اعتداده بذاته أبى عليه الاستمرار في إيهام نفسه بأنه يفهم، وعندما قرر مغادرة الجامع الأحمدي والعودة إلى القرية لم يكن يشعر بأنه فشل بقدر ما شعر بصدمة الجمود في منهج التعليم، «واختزن هذا الدرس في نفسه، فتجلى فيما بعد في حمله عبء إصلاح الأزهر والعطف على أهله» (46).
وجعل همه الأساسي وبخاصة في الشطر الثاني من حياته هو إصلاح التعليم، وبذل أقصى جهد لنشره، موقناً أنه شرط سابق لابد منه لأي محاولة للنهوض، بل وللتحرر من الاستعمار الأجنبي للبلاد.
إذن فقد عاد إلى قريته، وفضل أن يعمل بالزراعة وتزوج بنية الاستقرار هناك، ولكن والده رفض تخليه عن تلقي العلم. وفي اليوم الأربعين من زواجه طلب منه والده الذهاب مرة أخرى إلى الجامع الأحمدي. ولم يجد بداً من طاعة أمر أبيه، ولكنه عرَّج – وهو في طريقه إلى طنطا – على بلدة كنيسة أورين التي يقطنها أخوال أبيه، ممنياً نفسه بالبقاء فيها ليأسه الشديد من الدراسة والتعلم في الجامع الأحمدي، ولكنه مكث فيها خمسة عشر يوماً فقط، تحولت فيها حاله، وتبدلت رغبته بفضل أحد أخوال أبيه، اسمه الشيخ درويش خضر، الذي استطاع أن يعيده إلى الدراسة بطريقة مختلفة عن تلك التي مر بها أول مرة في الجامع الأحمدي، وعلمه في المدة القصيرة التي أقامها معه كيفية تلقي العلم بأسلوب سهل.
وأصبح الشيخ درويش نفسه أحد أهم أساتذته غير الرسميين من يفوق أثره أثر الأساتذة الرسميين، مثلما كان حال الشيخ درويش مع الأستاذ الإمام كما سنرى.
كانت حصيلة الأيام القليلة التي قضاها مع الشيخ درويش كبيرة وعميقة الأثر. يقول أحمد أمين إن «اهتمامه بتفسير القرآن، وجعله أساساً لدعوته الإصلاحية، وتنقيته للعقيدة الإسلامية مما أصابها من دخيل، وتلون حياته بلون صوفي راق، وزهادته في المال، وغيرته الشديدة على إصلاح المسلمين، كلها غرست في هذه الأيام…، ثم نمت وازدهرت وتعدلت وفقاً للظروف والأحوال»(47).
وفي اليوم الخامس عشر على وجوده في كنيسة أورين قرر العودة إلى الدراسة في الجامع الأحمدي بطنطا، وكان ذلكك في شهر جمادى الآخرة من سنة 1282 هـ. وفي هذه المرة عاد إليه برغبة ملحة في العلم والدراسة، بعد أن نجح الشيخ درويش في إزالة العقدة التي تسببت في هروبه. يقول «وجدت نفسي أفهم ما أقرأ وما أسمع والحمد لله. وعرف ذلك مني بعض الطلبة فكانوا يلتفون حولي لأطالع معهم قبل الدرس ما سنتلقاه. وفي يوم من شهر رجب من تلك السنة، كنت أطالع بين الطلبة، وأقرر لهم معاني شرح الزرقاني، فرأيت أمامي شخصاً يشبه أن يكون من أولئك الذين يسمونهم بالمجاذيب، فلما رفعت رأسي إليه قال ما معناه: ما أحلى حلوى مصر البيضاء. فقلت له وأين الحلوى التي معك؟ فقال: سبحان الله، ومن جد وجد… ثم انصرف فعددت ذلك القول منه إلهاماً ساقه الله إليَّ ليحملني على طلب العلم في مصر دون طنطا»(48).
وفي منتصف شوال 1282 هـ – فبراير 1866 م ذهب إلى الأزهر، وداوم على طلب العلم فيه مدة أحد عشر عاماً متواصلة من 1282 – 1294 هـ (1866 – 1877). وقد آثر في البداية العزلة عن الناس متأثراً ببعض تعاليم أهل التصوف، إلى أن أخرجه الأفغاني عن عزلته بعد حوالي خمس سنوات – كما سنوى فيما بعد.
وفي أواخر كل سنة دراسية كان يذهب إلى محلة نصر ليقيم فيها شهرين من منتصف شعبان إلى منتصف شوال، ويلتقي أثناء ذلك بخال والده الشيخ درويش ليدارسه القرآن والعلم إلى يوم سفره.
كانت الدراسة في الجامع الأحمدي الذي تركه في طنطا هي الصورة المصغرة للدراسة التي وجدها في الجامع الأزهر بالقاهرة؛ جمود وغلبة للتقليد على المقررات وعلى طريقة الأساتذة في التدريس. ولكن كانت هناك بعض بوادر الإصلاح قد أخذت تشق طريقها إليه متمثلة في بعض الشيوخ ذوي الأفكار الجديدة والاجتهادات الجريئة في خروجها على المألوف من أمثال الشيخ حسن الطويل.
وكانت تلك البوادر تهيئ الأزهر للدخول في عصر جديد يستعيد به التكامل المفقود – منذ عقود – بين علوم الدين وعلوم الدنيا، أو بين علوم الشريعة وعلوم الطبيعة (49). وعندما وصل الشيخ محمد عبده إلى الأزهر في تلك الفترة كان به اتجاهان الأول شرعي محافظ، والآخر صوفي أقل محافظة، وقد استمع لأساتذة كل اتجاه، فسمع من الأول دروس الشيخ عليش، والشيخ الرفاعي، والجيزاوي، والطرابلسي، والبحراوي، ومن الثاني الشيخ حسن الطويل، والشيخ حسن رضوان، ومحمود البسيوني (50).
وقد اصطدم الشيخ محمد عبده ببعض أساتذة الاتجاه الأول ومنهم الشيخ عليش، ومال إلى أساتذة الاتجاه الثاني، إلى أن وصل أستاذه الأفغاني فأغناه عن المواظبة على حضور حلقات العلم على يد الشيوخ، كما أغناه ذكاؤه عن الكتب التي كانت تقرأ في تلك الحلقات، حتى إنه كان يبحث عن الكتب المفيدة ويقرأها ويجني منها الفائدة في زمن وجيز. ومع ذلك كان عليه أن يمضي أحد عشر عاماً تقريباً – كما ذكرنا – حتى يتقدم لنيل العالمية الأزهرية.
كان نظام التعليم في الأزهر عندما وصله الشيخ محمد طالباً للعلم يلقي العبء كله على الطالب، «فما عليه إلا أن يسجل اسمه في دفاتر الأزهر، ثم يفعل ما يشاء، إلى أن يتقدم لامتحان العالمية، فهو الذي يختار مدرسه، ويختار علومه، ويحضر أو لا يحضر، ويفهم أو لا يفهم، وهو أسلوب يفيد الخاصة ويضر العامة»(51).
وكان مثل هذا النظام متقدما جدا بمعايير عصره، ولا تزال أصوله معمولاً بها حتى اليوم. وكان الطالب يتدرج في الكتب، كل سنة كتاب في الفقه ، وكتاب في النحو، إلا إذا طال الكتاب فيقرأه في أكثر من سنة، ولكل كتاب – تقريباً – متن هو الأصل، وشرح يشرح المتن، وحاشية تشرح الشرح، وقد يكون هناك شرح يشرح الحاشية.
وإذا انتهت كتب الفقه حل محلها كتب أصول الفقه، وإذا انتهت كتب النحو حل محلها كتب البلاغة (52)، وهكذا حتى ينهي الطالب أحد عشر علماً تؤهله لدخول امتحان العالمية.
وقد نال الشيخ العالمية من الدرجة الثانية، وهو في الثامنة والعشرين من عمره سنة 1294 هـ – 1877م. وسجلت لجنة الامتحان أسماء العلوم الأحد عشر التي درسها، وعناوين الكتب التي قرأها في كل علم منها. وشملت هذه العلوم: الفقه، والتوحيد، والحديث، والتفسير، والنحو، والمنطق، والبيان، والصرف، والمعاني، والبديع، والأصول. وجاء في قرار اللجنة أن الشيخ محمد عبده: «فيه الآن – آنذاك – لياقة واستعداد للتدريس بالجامع الأزهر، ويستحق أن يجعل في الدرجة الثانية، وقد أذنا له بالتدريس بالجامع المشار إليه …»(53).
ويرى البعض (54) أن الشيخ محمد العباسي المهدي، شيخ الأزهر حينذاك، وأحد كبار العلماء المناصرين للتجديد، هو الذي أنقذ الشيخ محمد عبده من الرسوب على يد أعضاء لجنة الامتحان الذين كانوا يرغبون حرمانه من شهادة العالمية لعدم ارتياحهم لآرائه الجديدة وخروجه على طريقتهم ومنهجهم الذي درجوا عليه، ولصحبته للأفغاني.
وقد يكون هذا الرأي صحيحاً، وقد يكون من الصحيح أيضاً أن إجابات الشيخ محمد عبده نفسه كانت لا تستحق أكثر من الدرجة الثانية فعلاً – من وجهة نظر اللجنة – وخاصة أنه كان متبرماً من كثير من الكتب التي درسها والشروح والحواشي التي عليها، وربما كان هذا التبرم سبباً في أنه لم يهتم الاهتمام الكافي لإحراز الدرجة الأولى، حتى إنه غضب مرة على كتاب منها فطبخ به عدسا(55).
ويؤيد ذلك قوله الذي أثر عنه بعد ذلك وهو: «إن كان لي حظ من العلم الصحيح … فإنني لم أحصله إلا بعد أن مكثت عشر سنين أكنس من دماغي ما علق فيه من وساخة الأزهر، وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريده له من النظافة»(56).
وهذا هو ما قصدناه بمفهوم التأثر السلبي بنظام التعليم الأزهري من خلال طريقة العقل والنقد التي اختارها لنفسه، وخرج بها على طريقة «الأذن والذاكرة» التي كانت سائدة، واختار لنفسه طريقة العقل والوجدان، والنقد بعد الفهم.
ج – تأثره بأساتذته:
تأثر الشيخ محمد عبده في تكوينه الفكري والثقافي بعدد كبير من العلماء والمفكرين من أساتذته ومعاصريه؛ منهم من كان تأثيره سلبياً؛ مثل بعض مشايخ الجامع الأحمدي والجامع الأزهر الذين ركنوا إلى التقليد، واكتفوا تلامذتهم ما هو مدون في متون الكتب وشروحها، وتدريبهم على الجدل اللفظي، ومهارة تصور الاحتمالات واشتقاق التأويلات في كل شيء، حتى دخول الجمل في البندقة، على حد تعبير محمد عبده وهو ينتقدهم (57).
كان لأمثال هؤلاء تأثير في التكوين الفكري والثقافي للأستاذ الإمام ولكن بطريقة سلبية كما ذكرنا؛ حيث هداه ذكاؤه الفطري إلى عدم الانقياد لهم، ويبدو أنه كان كلما استمع لهم زاد اقتناعاً بالخروج على طريقتهم في التعليم، والبحث عن طريقة جديدة تكون أكثر فائدة وأقرب نفعاً، وهو ما وجده لدى فريق آخر من الأساتذة والشيوخ؛ بعضهم في الأزهر مثل الشيخ حسن الطويل، وأكثرهم من خارج الأزهر مثل الشيخ البسيوني إمام المعية الخديوية، والسيد جمال الدين الأفغاني، ومن قبله الشيخ درويش خضرخال أبيه الذي مررنا به من قبل.
وقد كان لأمثال هؤلاء أثر إيجابي كبير ليس فقط في التكوين الفكري والثقافي للأستاذ الإمام، بل في مختلف جوانب حياته وآرائه السياسية، ومنهجه التربوي، وعمله في مجال الخدمات الاجتماعية.
وإذا اقتصرنا على أصحاب الأثر الأكبر من أساتذته في تكوينه الفكري والثقافي فهم ثلاثة: أولهم صوفي تربوي هو الشيخ درويش خضر، وثانيهم أصولي مجدد هو الشيخ حسن الطويل، وثالثهم سياسي ثائر هو السيد جمال الدين الأفغاني.
صاحب الأثر الأول والأكثر عمقاً هو الشيخ درويش خضر. كان متصوفاً ورعاً. سبقت له أسفار إلى صحراء ليبيا ووصل إلى طرابلس الغرب، وتلقى العلم من بعض الشيوخ وأخذ عنهم الطريقة الشاذلية. كان يحفظ موطأ الإمام مالك وبعض كتب الحديث، ويجيد حفظ القرآن وفهمه. وبعد أن رجع من أسفاره اشتغل بفلاحة الأرض(58).
كان التقاؤه بالشيخ درويش في لحظة شعر فيها باليأس من التعليم بعد أن صدمه الشيوخ بطريقتهم العتيقة في الجامع الأحمدي، وعزم على البقاء في القرية والاشتغال بالزراعة. ولكن لقاءه بالشيخ درويش حول مساره تحويلاً جذرياً كما أسلفنا؛ من الرغبة في الزراعة والتفوق على الشبان في ألعاب الفروسية، إلى محمد عبده الذي يريد الصفاء الروحي والتعلم ليستطيع فهم القرآن، والتزود من العلم قدر ما يستطيع.
شرح له الشيخ درويش معنى التصوف النقي الذي يحارب التواكل والكسل، ويحض على الجد والعمل، ويهتم بالأمور الدنيوية قدر اهتمامه بالأخروية، ويدعم ثقة الإنسان بربه وبدينه، ويجنبه الشكوك ويبعده عن التزمت الشكلي، ويمنحه قوة في مواجهة سطوة الحكام؛ ذلك لأن تعاليم التصوف الحق تمنع الإنسان من التكالب على متاع الدنيا الذي يملكه الحكام ويستخدمونه في تحقيق مآربهم بالترغيب وبالترهيب.
وإلى جانب مبادئ التصوف النقي كان الشيخ درويش يحثه على تعلم الحساب والهندسة والمنطق وعلوم الحياة، وينهاه عن العزلة، ويشجعه على مخالطة الناس والصبر على أذاهم، وقد حكى الأستاذ الإمام طرفاً من الحوارات التي كانت تدور بينه وبين شيخه درويش فقال: «ذكرت له اشمئزازي من الناس، وزهادتي في معاشرتهم، وثقلهم على نفسي إذا لقيتهم، وبعدهم عن الحق ونفرتهم منه إذا عرض عليهم، فقال لي: هذا من أقوى الدواعي إلى ما حثثتك عليه، فلو كانوا جميعاً هداة مهديين لما كانوا في حاجة إليك، ثم أخذ يستصحبني في مجالس العامة، ويفتح الكلام في الشؤون المختلفة، ويوجه الخطاب لأتكلم فأتكلم ويتكلم الحاضرون فأجيبهم، وأنطلق في القول على وجل أول الأمر، وما زال بي حتى وجد عندي شيء من الألفة مع الناس بمكالمتهم …»(59).
لم ينقطع الأستاذ الإمام عن شيخه درويش بعد لقائه الأول، بل داوم على الجلوس إليه عندما كان يعود من القاهرة في الإجازة الصيفية، فيسأله الشيخ عن العلوم التي تلقاها، والكتب التي قرأها ويرشده إلى كتب جديدة ليبحث عنها ويقرأها، ويجيب على الأسئلة التي كانت تعترضه، وأهمها ما كان متعلقاً بجواز تلقي علوم الحياة والفلسفة وما لم يألفه معظم مشايخ الأزهر آنذاك، وكان الشيخ خضر يقول له: «إن الله هو العليم الحكيم، ولا علم يفوق علمه وحكمته، وإن أعدى أعداء العليم هو الجاهل، وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه، وما تقرب أحد إلى الله بأفضل من العلم والحكمة، فلا شيء من العلم بممقوت عند الله، ولا شيء من الجهل بمحمودٍ لديه، إلا ما يسيمه بعض الناس علماً وليس في الحقيقة بعلم: كالسحر والشعوذة ونحوهما، إذا قصد من تعليمهما الإضرار بالناس» (60).
وقبل أن يتوفى الشيخ درويش كان قد أعاد الثقة إلى نفس تلميذه المحبوب، وزوده بجرعة روحية وجدانية من منهل التصوف الصافي الذي يفتح آفاق النفس ويشحذ همة العقل معاً؛ هذا التصوف الذي نجده عند أغلب العلماء المجددين والمجتهدين، وفتح أمامه أبواب القراءة والاطلاع على مختلف فروع العلم والمعرفة، وأوضح له أنه لا توجد علوم يمكن تعلمها وأخرى لا يمكن تعلمها. وقد توفي الشيخ درويش في قريته كنيسة أورين في سنة 1881م، وهي السنة نفسها التي وفد فيها السيد الأفغاني إلى القاهرة، وكان لقاء الشيخ محمد عبده به نقطة تحول أخرى بالغة الأهمية في تكوينه الفكري والثقافي.
ولكن قبل لقائه بالأفغاني، وقبل أن ينتقل من يد الصوفي المربي إلى يد السياسي الثائر، كان قد اختار الجلوس في حلقات مدرسة التجديد بالأزهر الشريف، وكان من أساتذتها الشيخ حسن الطويل، الذي امتاز بالذكاء وبرع في علم المنطق، وكانت له نظرات صائبة في الحياة.
وقد أثنى الشيخ محمد عبده أمامه الركب، وحضر دروسه في المنطق. واشتهر الشيخ الطويل أيضا بعلم الرياضيات، حتى كان يحل لطلبة دار العلوم ما أشكل عليهم من تمرينات هندسية، واتصال بكتب الفلسفة القديمة. وكان شجاعاً في إبداء رأيه، وطرد من دار العلوم لكلامه في السياسة، ودرس الفلسفة والمنطق في الأزهر، وحضر دروسه نخبة من الطلبة أمثال محمد عبده «فيرمى هو وتلاميذه بالذندقة» (61). وقد فتحت دروسه شهية محمد عبده، ولكنها لم تشبعه، حتى وجد ما يبحث عنه عند السيد جمال الدين الأفغاني عندما حضر إلى القاهرة.
وفد السيد جمال الدين الأفغاني إلى القاهرة في سنة 1287 هـ – 1871 م. قادماً من الأستانة، وكان لقاء الشيخ محمد عبده به نقطة تحول لا تقل أهمية عن التحول الذي أحدثه لقاؤه بالشيخ درويش خضر. كان من أهم خصائص الأفغاني «غيرته الشديدة على الإسلام والمسلمين؛ هي محور أعماله ومصدر آلامه وآماله» (62).
تعلم على يد الأفغاني أصول الفلسفة وعلم الكلام، والرياضيات، والمنطق، والتصوف، «ولكن الدروس الروحية التي كانت تسري من أحاديث هذا المصلح.. كانت أعظم واقعاً وأعمق أثراً من دروس الأوراق والأسفار» (63). وقد صحبه الإمام مدة وجوده في مصر من سنة 1871 إلى 1879، إلى الحد الذي جعل بعض رجال الأزهر يتضايقون من تلك الصحبة، وشككوا في اتجاه الاثنين (64).
ومع ذلك ظل محمد عبده أقرب التلاميذ إلى نفسه، قرأ فيه السيد الذكاء وحسن الاستعداد وطيب القلب والحماسة للإصلاح». وقرأ هو في أستاذه سعة العقل وصحة الإرشاد، والسمو بالنفس، ونبل الغرض، وشيئاً جديداً لم يره من قبل في الأزهر (65) ، كما استفاد من السيد معرفة بشؤون الحياة السياسية والاجتماعية التي حجيتها الطريقة فيالعتيقة لشيوخ الأزهر آنذاك.
وظهرت أول أعماله الفكرية الفلسفية بعد لقائه بالسيد الأفغاني، فكتب مقدمة لرسالة الواردات التي وضعها أستاذه الأفغاني (66)، وقام بنسخ كتاب الإشارات لابن سينا وعليه حواش مقتبسة من مصادر فلسفية مختلفة، وكتب أيضاً حاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية، وهي تدل على سعة اطلاعه على جملة التظرات الفلسفية الإسلامية التقليدية، وتوضح في الوقت نفسه ابتعاده عن صبغة التصوف واقترابه من الفلسفة القائمة على العلم والنظر العقلي.
وبعد تخرجه في الأزهر نشر كتاب البصائر البصيرية كي يوجه عناية الأزهريين إلى دراسة علم المنطق كمدخل لسائر العلوم، وسرعان ما وجد طريقه بعد التخرج أيضاً إلى الصحف فكتب مقالة في الأهرام (عدد 36 السنة الأولى 1887) دعا فيه إلى ضرورة الاهتمام بالعلوم الكلامية الموروثة.
ولما غادر الأفغاني مصر مبعداً بأوامر الخديوي فارقها وهو يقول لمن يسألونه عن وصيته عليها: «حسبكم محمد عبده، حسبكم محمد عبده من وصي أمين». وعندما نفي الأستاذ الإمام إلى بيروت في أعقاب الثورة العرابية، لم يلبث أن لحق بأستاذه في باريس ليعاونه في إصدار مجلة الروة الوثقى، التي شنا من خلالها حملة شديدة على الاستعمار، وحرضا الشعوب المغلوبة عليه.
وبالغرم من أن تأثره بالأفغاني كان عميقاً، واعترافه هو بأن ميراثه منه أقدس من ميراثه الأبوي، لأنه ميراث في الروح يجمعه بصفوة الرسل والقديسين (67)، رغم ذلك لم يصبح نسخة منه، بل ظلت له شخصيته المستقلة حسب استعداده وفطرته، حتى انفصل بتلك الشخصية عن طريق أستاذه الذي كان مهيئا للدعوة والحركة في المجال السياسي، بينما كان هو مهيئاً للتعليم والتهذيب والإصلاح الاجتماعي والأخلاقي.
وخير الأساتذة هو الأستاذ الذي ينبه في التلميذ ملكات ذهنه وضميره، «ويمنحه حباً للحياة، ورغبة خفية في تذوق اللذائذ العقلية» (68)، ويستجيش في قرارة طبعه غاية وسعة من الاجتهاد والهمة على حسب فطرته واستعداده، فليس بخير الأساتذة من يجعل تلامذته نسخاً منه تحكيه، ولا تزيد من عندها شيء غير الاقتداء به، والعمل على غراره، فهذه هي تربية التقليد والمحاكاة، تصلح للذين خلقوا على نصيب من قدرة الاستقلال والاجتهاد (69)، من أمثال الأستاذ الإمام محمد عبده.
وقد جاء في الأثر أن «العلماء ورثة الأنبياء»؛ فهم حملة العلم، وعليهم يقع عبء أداء أمانة توصيله لأقوامهم، وضرب المثل في العمل به. ولهذا فإنهم يسهمون في التكوين الوجداني لأبناء أمتهم، وفي البناء الثقافي والأخلاقي لهم، وذلك من خلال المبادئ التي يدعون إليها، والأفكار التي ينشرونها، أو المواقف التي يثبتون عليها، ويصدعون بكلمة الحق فيها؛ فيهتدي بهم من خلفهم، ويتأثر تلاميذتهم بأعمالهم وآرائهم، ويكتشفون آفاقاً جديدة لم تكن لدى أساتذتهم، وهنا تكون الإضافة الحقيقية للأستاذ والتلميذ في آن واحد، وهو ما نلمسه بوضوح في حالة الأستاذ الإمام.
د – القراءات الحرة والمكتبة الخاصة:
تكشف السير الذاتية لأعلام العلماء وكبار المفكرين – عادة – عن كثرة قراءاتهم الحرة وتنوعها، وسعة اطلاعهم على مصادر العلم والمعرفة. وبقدر الإقبال على القراءة، وبقدر ما يتوافر للقارئ من الفهم والذكاء والوعي والقدرة على الاستيعاب؛ بقدر ما تسهم القراءات الحرة في تكوينه الفكري والوجداني والثقافي.
وكثيراً ما تؤدي القراءات الحرة إلى تكوين مكتبة خاصة، تضم ما يقتنيه طالب العلم، ومن ثم العالم، من الكتب والبحوث والدراسات التي يهتم بها ويحرص عليها. وللكتب التي يعتني العالم بتحصيلها وقراءاتها خصوصاً في بدايات نموه العقلي وبواكير تكوينه الفكري أهمية مزدوجة، فهي من حيث تنوع موضوعاتها تشير إلى مجالات اهتمامه وميوله الفطرية، وهي من حيث كميتها تشير إلى مدى استعداده وحبه للعلم وإقباله على المعرفة، وفوق هذا وذاك فإن الكتاب يمنح قارئه فضله، أو بعضاً منه فإذا ما صار هذا القارئ عالماً يعمل بما علم، ويسعى لوضع علمه في خدمة مجتمعه، اكتسبت الكتب التي قرأها قيمة مضافة إلى قيمتها الأصلية؛ لكونها كانت من أدواته، وآلة من آلاته، وتصبح دليلاً على تضاريس تكوينه الفكري، ومرشداً إلى المسارات المعرفية التي سلكها. كما تسهم المعرفة بتلك المصادر المكتوبة التي قرأها في تتبع جذور بعض أفكاره وآرائه التي يتبناها أو يدعو إليها. وغالباً ما لا تظهر قيمة القراءات الحرة، ولا تتضح أهيمة المقتنيات الخاصة للعالم من الكتب إلا بعد أن يطوي الموت صاحبها، وتصبح في متناول الباحثين.
ولكن بالنسبة لحالة الأستاذ الإمام، وبالرغم من مرور قرن من الزمان على وفاته، لا تزال المعلومات المتعلقة بقراءاته الحرة وبمكتبته الخاصة شحيحة جداً. ولا أثر حتى اليوم لمكتبته الخاصة يوضح لنا محتوياتها، ونوعية الكتب التي اقتناها. والمصدر الرئيسي لسيرته – وهو مذكراته التي نشرها الشيخ رشيد رضا، وأعيد نشرها أكثر من مرة بعده – هذا المصدر يذكر أنه قرأ رسائل في التصوف للسيد محمد المدني؛ كان يقرأها على الشيخ درويش بطلب منه، وكان يسأله عما لا يحسن فهمه فيجيبه بأسلوب مبسط، ويعلمه المبادئ الأساسية للتصوف، ويحببه في مزيد من القرأة. وأسهم الشيخ درويش في حضه على الاطلاع الحر في فروع عملية متنوعة لم تكن معروفة في الأزهر عندما كان طالباً فيه، وعن ذلك يقول الأستاذ الإمام: «فكنت إذا رجعت إلى القاهرة، ألتمس هذه العلوم عند من يعرفها، فتارة كنت أخطيء في الطلب، وأخرى أصيب …»(70).
وأسهمت النزعة العقلية والعلمية لتعاليم الأفغاني في توجيه الأستاذ الإمام إلى قراءات أخرى في الفلسفة وفي العلوم الكلام والمنطق، ووجهه السيد جمال الدين الأفغاني عندما التقى به إلى نوعية أخرى من القراءات الحرة قادته إلى كتب الفلسفة مثل الإشارات لابن سينا، والواردات للأفغاني نفسه، وكتاب تهذيب الأخلاق لمسكاويه، ومقدمة ابن خلدون، وكتاب فرانسوا جيزو عن تاريخ المدنية الأوروبية. وكان لتلك القراءات أثر في اتجاهه نحو الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي والدعوة إلى انفتاح الفكر على الحضارات الأخرى.
أما مقدمة ابن خلدون، فيبدو أنه أعجب بها فاقترح على الشيخ الإنبابي تدريسها في الأزهر، فلم يوافقه وقال: «إن العادة لم تجر بذلك …»(71)، ولكن عندما أتيحت له فرصة التدريس بدار العلوم قام بتدريسها.
وترجع أهمية المقدمة إلى اعتبارات عدة، لعل من أهمها أنها تتناول قضايا السياسة والاجتماع، بمنهج علمي موضوعي، وتعرض – ضمن ما تعرض – لأساس شرعية السلطة الحاكمة، وضرورة استنادها إلى الشريعة. ويمكن القول أنه بفضل المنهجية المبتكرة لابن خلدون في مقدمته اكتسب منهج الأستاذ الإمام النظرة الموضوعية للمجتمع وقضاياه المختلفة.
وإذا كان ابن خلدون قد فسر تطور المجتمعات وفقاً لفكرة العصبية، فإن فرانسوا جيزو في كتابه عن تاريخ المدنية الأوروبية ناقش التطور الاجتماعي من زاوية مختلفة، فقد رأى أن التقدم لن يتحقق إلا بالشعب النشيط الذي يسعى بنفسه إلى تغيير أوضاعه الاجتماعية، فالإنسان في متناوله أن يحقق الرفاهية الاجتماعية وتطوير القدرات الفردية إذا احتكم إلى العقل، وحقق الوحدة والتضامن داخل المجتمع، وإذا توافرت الرغبة في الانصياع لهذه الاعتبارات» (72).
ويبدو أن تلك الأفكار تركت أثرها على توجهات الأستاذ الإمام التي ظهرت في التركيز على التربية، وتأكيده على أن الوطنية صفة لمن يقدم ما يفيد مجتمعة ويساعده على الترقي وسعادة أهله، وليست شيئاً مرادفاً للجنسية، ولا مجرد لقب للتفاخر الأجوف.
وأما كتاب تهذيب الأخلاق لمسكاويه، فموضوعه الأساسي يدور حول فكرة الخير والشر عند الإنسان، ومدى إمكانية تغيير أخلاقه بفعل التربية والتهذيب. وقد ذهب مسكاويه إلى أن يولد قابلاً للتحول تجاه أو الشر، ويعتبر الأخلاق إحدى أنواع الحكمة التي يستطيع أن يدبر بها الإنسان دنياه، ويضمن حياة أخروية صالحة.
والكتاب يركز أيضاً على دور المعرفة بمعناها الواسع في إصلاح الفرد والمجتمع، ويرجع غالبية الفضائل إلى هذه المعرفة، حتى إن الحاكم الصالح هو الذي يسوق الناس نحو السعادة بالعلوم الفكرية إلى جانب توجههم نحو إقامة الصناعات والأعمال الحسية (73). وتوضح السيرة العملية للأستاذ الإمام أنه كان شديد الاقتناع بدور الأخلاق في بناء الأمة ونهضتها.
وأعمال «جمعية إحياء الكتب العربية» التي دعا إلى تأليفها وأسهم في تأسيسها سنة 1897، تدلنا على أنه قد طلع أيضاً على جانب مهم من كتب التراث العربي الإسلامي، ومن ذلك مثلاً، كتاب «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد، وشرح مقامات بديع الزمان، وكتاب «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني، وكتاب (المخصص) لابن سيده في اللغة ويقع الكتاب في 17 مجلداً، ومدونة الإمام مالك، وغير ذلك من عيون التراث في اللغة والأدب والفقه والأصول. ولعل كتاب الموافقات في أصول الشرعة للإمام أبي إسحاق الشاطبي هو من أهم الكتب التي كان لها أثر كبير في تكوينه الفكري – وإذا لم تطبعه الجمعية – فقد كان له هو الفضل الأكبر في الحث على نشر هذا الكتاب وإحياء علم مقاصد الشريعة البي أرسى الإمام الشاطبي دعائمه فيه (74)، ولا يزال حتى اليوم المرجع المعتمد في موضوعه. وتجلى تأثره به في تبنيه لفكرة المقاصد العامة للشريعة وتطبيقه إياها في كثير من فتاواه الفقهية، وفي كتاباته التي دعا فيها إلى الإصلاح والتجديد في الخطاب الإسلامي حتى يلبي حاجات العصر ويسهم في حل المشكلات المستحدثة.
وقد مكنته الفرنسية التي تعلمها وهو في الرابعة والأربعين من عمره تقريبا (75)، من الاطلاع على أفكار بعض التيارات السياسية والأدبية والفلسفية الحديثة في أوربا، فكانت مكتبته الخاصة تضم كتباً متنوعة لمفكرين أوربيين من أمثال جان جاك روسو، وهربرت سبنسر، الذي ترجم إلى العربية كتابه في التربية، وأرنست رينان الذي دخل معه في حوار مطول، وبعض روايات تولستوي، الذي كانت له معه بعض المراسلات(76).
ولابد أن ثمة مصادر أخرى غير التي ذكرتاها، مكتوبة وغير مكتوبة، يصعب حصرها وتحديد مدى تأثيره بها، وخاصة من المحيط العلمي والأدبي الذي تواصل معه عبر مراحل حياته المختلفة، وانخراطه في المجال الحيوي الثقافي والفكري واسع المدى في القاهرة وغيرها من العواصم التي أقام فيها، ونفترض أنها أثرت بدرجة أو بأخرى في تكوينه الفكري والثقافي.
وبإنعام النظر في تلك المصادر يتضح أنها هيأت له الاتصال بروافد الفكر الغربي الحديث وتياراته الأدبية والفلسفية والاجتماعية من جهة أخرى. كما أنها أسهمت في بلورة توجهاته الأساسية في الميدان الاجتماعي، بالوقوف إلى جانب الفقراء والمستضعفين والمناداة بالعدالة الاجتماعية، وإعطاء أولوية مطلقة للتعليم والتربية والأخلاق في العملية الإصلاحية، وفي الميدان السياسي بتبني منهجية التدرج، ورفض المنهج الثوري الذي دعا إليه أستاذه الأفغاني، وفي الميدان الفلسفي بانحيازه إلى العقل ووضعه في موضعه الصحيح من منظور الشرع (77)، وهكذا بالنسبة لبقية القضايا والمشكلات التي اهتم بها، واجتهد في تقديم الحلول المناسبة لها.
وإذا كان من الصحيح أنه تأثر بمصادر فكرية وثقافية متنوعة ومتعددة، فإن من الصحيح أيضاً أنه كانت له شخصيته الفكرية والفقهية والعلمية المستقلة – بالمعنى الدقيق لهذه الكلمات – وبقدر ابتعاده عن التقليد ونفوره منه، اقترب من الاجتهاد والتجديد، وانتمى عن جدارة إلى تيار الإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث، وكان رائداً من رواده، وعلماً من أعلامه.
خاتمة
هل كان محمد عبده – الأستا الإمام – حاصل جميع معطيات أصوله الاجتماعية التي انتمى إليها بالوراثة ولم يكن له يد فيها، ومصادره الفكرية والثقافية التي استقى منها مكرهاً حيناً وهو في مجالس العلم بالجامع الأزهر ومن قبله الجامع الأحمدي، وراغباً مختاراً حيناً آخر وهو يبحث بنفسه عن مصادر العلم والمعرفة لدى العلماء الذين أنس بهم، وثنى الركب أمامهم، أو وجدها في بطون الكتب. . لا. لم يكن كذلك. وقصارى ما يمكن قوله هو أن تلك العوامل الاجتماعية والفكرية تكشف لنا عن بعض روافد تكوينه الشخصي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحليل أفكاره، ناهيك عن تقييمها.
ولم يكن قصدنا في هذا البحث من رسم معالم خلفياته الاجتماعية، ومصادر تكوينه الفكري والثقافي؛ أن نقول أن ظهور عالم كبير مثل الأستاذ الإمام هو نتيجة حتمية لمثل تلك المعطيات الاجتماعية والثقافية، بحيث إذا وُجِدت أنتَجيت بالضرورة عالماً مثله. فهناك عوامل أخرى كثيرة غير التي تناولناها تسهم في تكوين شخصية «العالم» ونضجها؛ بالمعنى الذي يشير إليه مفهوم «العالم» في التراث الإسلامي، وهو أوسع من مفهوم الفقيه التقليدي، وأشمل من مفهوم المثقف الحديث، فالعالم في الرؤية الإسلامية يجب أن يكون من ورثة الأنبياء في حمل أمانة العلم وإبالاغه، وفي دعوة الناس إليه والعمل به، وفي تبصيرهم وتنويرهم بما يصلح أمر دنياهم ودينهم بتوازن ووسطية، وكذلك في قدرته على ممارسة المهمات الثلاث الرئيسية للعالم وهي: تثبيت أصول العقيدة بتجليتها، ودحض الشبهات التي تثار حولها، وتجديد الخطاب المشتق منها بما يناسب ظروف العصر ولمصر.
ومن بين تلك العوامل الأخرى التي تسهم في تكوين العالم: استعداده الفطري، ومواهبه التي حباه الله بها من الفطنة والذكاء والذهن المتوقد، والهمة العالية، خطرات النفس وتأملاتها في خلواتها، وأثر التقوى والإيمان، وغير ذلك مما تحدث عنه بعض الذين درسوا شخصية الأستاذ الإمام (78)، ومما يصعب إخضاعه للبحث العلمي، ولا يساعدنا علم اجتماع المعرفة بأدواته ومقولاته على الإمساك به.
أردنا إذن من هذه الصفحات أن نرسم المعالم الظاهرة لشخصية الأستاذ الإمام من جهة الأصول الاجتماعية، ومن جهة المصادر الفكرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ثمة عوامل أخرى أسهمت في تكوينه.
ونكون قد حققنا هدفنا من هذا البحث إذا التفت طلاب القدوة الحسنة، وطلاب العلم وخُطََّّاب التجديد – من أبناء الجيل الحاضر أو القادم – إلى صورة الأستاذ الإمام على النحو الذي قدمناه، ليرجعوا إلى ما قدمه هو من اجتهادات فكرية وفقهية ورؤى إصلاحية وتجديدية، ويجيلوا النظر فيها؛ لا على الصواب الذي لا يداخله الخطأ كما يذهب بعض المغالين من أنصاره، ولا على أنها الخطأ الذي لا يعرف الصواب كما يصر بعض المغالين من أعدائه – ومنهم من لا يزال هناك في الأزهر يخوض ضده المعارك التي بدأها أسلافهم قبل أكثر من قرن من الزمان – وإنما على أنها ثمرة اجتهاد عالم كبير، حَبُّ حصيدٍ كابد من أجل الوصول إليه عشرات السنين.
أما تقدير إسهاماته، وما يؤخذ منها وما يترك، وكيف يمكن الإفادة منها في معالجة مشكلات الواقع – مما يدخل ضمن اهتمام بحوث أخرى مستقلة – فمسائل تجيب عنها البحوث الدقيقة، ومطارحات العلماء والباحثين المنضبطة بقواعد البحث والنظر والاستقامة العلمية؛ التي تعطي كل ذي حق حقه، ولا تبخس الناس أشياءهم. وسيظل ما قدمه – على أي حال – موضعاً للجدال الفكري، ومادة تغذي مطارحات العلماء، وتشحذ قرائحهم في تأييده أو في الاختلاف معه، وسيظل هو – في الحالين – «الأستاذ الإمام»، فهذا اللقب الذي أطلق عليه بعد موته، إضافة إلى لقب «الشيخ» الذي يحصل عليه كل من تخرج في الأزهر، يعبر بدقة لا بأس بها عن شخصيته، ويؤشر على مكانته وموقعه في مسار النهضة في التاريخ الحديث للأمة الإسلامية، وليس فقط في تاريخ النهضة المصرية أو العربية الحديثة والمعاصرة.
وقصة الألقاب التي اشتهر بها الشيخ محمد عبده تستحق الإشارة إليها هنا ولو بإيجاز حتى تكتمل الصورة العامة التي أردنا رسمها للأستاذ الإمام من المنظورين الاجتماعي والثقافي في سياق واحد؛ ذلك لأن التعرف على تلك الألقاب بمعزل السياق الذي أوضحناه لا يؤدي إلى تمام رؤية المرئي في نفس الرائي على حد تعبير ابن حزم (79).
فقد جرت عادةٌ اجتماعية ثقافية في تاريخ الشعوب والأمم يمنح الناس بموجبها القادة والزعماء أوصافاً ترمز إليهم، أو يطلقون عليهم ألقاباً تدل عليهم، بشكل غير رسمي، إلى جانب ما قد يكون لهؤلاء القادة والزعماء من أوصاف شخصية أو ألقاب رسمية؛ وذلك لتمجيدهم، أو ربما خوفاً منهم، وتملقاً لهم مثلما يحدث مع الحكام الطغاة المستبدين إبان حياتهم، ولكن سرعان ما تسقط ألقابهم غداة وفاتهم.
أما إذا أضفى الناس صفة حميدة على شخص، أو منحوه لقباً جليلا بعد موته فذلك دليل على حبهم له، واعترافهم بفضله، وخاصة إذا استمرت الأجيال المتعاقبة تشير إليه بتلك الصفة أو بذاك اللقب، وهو ما نجده في حالة الشيخ محمد عبده، الذي اشتهر بلقب «الأستاذ الإمام» ولم يفارقه حتى اليوم من أطلقه عليه – ربما لأول مرة – تلميذه الوفي الشيخ رشيد رضا.
وفي نظرنا أن لقب «الأستاذ الإمام» جاء معبراً عن صاحبه، ودالاً لمدلوله، وما يزال هذا اللقب موقوفاً عليه؛ بحيث إذا أطلق دون ذكر اسمه انصرف القصد إليه وحده. وأصل لقب «أستاذ» أعجمي مشتق من الفارسية، ومعناه «الماهر العظيم، الجامع لدين الأنبياء، وتدبير الحكماء، وسياسة الملوك»(80)، وقد كا للأستاذ الإمام نصيب كبير من ذلك كله، اللهم إلا السياسة، وبخاصة السياسة الخديوية (أو سياسة الملوك)، التي لعنها وأعلن تبرؤه منها، ونأى بجانبه عنها بعد الثورة العرابية.
ولكنا نلاحظ أيضاً أن المصريين استعملوا كلمة أستاذ كلقب للمدرس الذي يعلم في المدارس، واستعملته الجامعة كذلك لمن يصل إلى درجة أعلى في سلك التدريس الجامعي، وبهذا المعنى استحق محمد عبده لقب أستاذ بامتياز، فقد اشتغل بالتدريس في الأزهر، وفي دار العلوم، وفي مدرسة الألسن، وفي المدرسة السلطانية في بيروت، وتتلمذ على يديه جمع غفير ممن صاروا علماء ومفكرين وقادة وزعماء سياسيين.
أما لقب «إمام» فهو من أقدم الألقاب التي عرفها التراث الإسلامي؛ إذ بدأ استخدامه منذ فرضت الصوات الخمس، وأطلق في البداية على الذي يؤم الناس فيها، ويأتمون هم به، ثم صار يطلق أيضا على الخليفة، أو أمير المؤمنين، فاكتسب بعداً سياسياً إلى بعده الديني، واستعمله الفقهاء وكتاب الحكمة السياسية في مؤلفاتهم وعبروا عنه بالإمامة العظمى. وإمام الناس – من الناحية اللغوية – هو سابقهم وقدوتهم الذي يتبعونه في أقواله وأعماله.
وقد كان محمد عبده إماماً في الدين عالماً ومعلماً، وقاضياً ومفتياً، وإن لم يكن إماماً في السياسة. وصفه هربرت سبنسر بعد لقائه بدار صديقه ولفرد سكاون بلنت فقال «التفتُّ – إلى محمد عبده – فإذا أنا بصورة إنسان يقول الناظر إليها إنها برزت من كتب الأنبياء الأقدمين»(81). وقد سبق معاصريه في شؤون الفكر والفهم والاجتهاد والتجديد، وفي الربط بين القول والعمل، ولا يزال يؤتم به في ذلك، أو في بعض ذلك على الأقل.
وربما استحق – إضافة إلى ما سبق – لقب «الرجل الكبير في الشرق»؛ الذي تحدث عنه في مقالة له بنفس هذا العنوان، وربما كان يتحدث في تلك المقالة عن نفسه محاسباً لها ناظراً إلى حصاد عمره، موضحاً الحدود التي انتهى إليها حهده، وربما كان يتحدث عن شخص آخر متمنياً وجوده، أو مستبشراً آملاً في قدومه، كي يكمل رسالة التجديد والإصلاح. وقد يكون من المفيد أن نختتم بنص تلك المقالة، وهو الآتي :
الرجل الكبير في الشرق
«إن الكبار من الرجال هداة في أممهم. وإنما يظهر أثرهم في إرشادها، والسير بها في الطريق المؤدية إلى الغاية التي تطلبها, وليسوا بخالقين ولا ناشرين من موت. وإنما تنجح الهداية فيمن رمى بفكره إلى المطلب، وعرف أنه أبعد عما فيه فقهياً للسفر، وتحفز للرحلة، وأخذ لأمره أهبته، وأعد له عدته، واستقام على أول الطريق.
نعم، الرجل الكبير موقظ من نوم، أو منبه من غفلة، وليس بمحيي الموتى، ولا بمسمع من في القبور. فإن كانت الأمة في منخفض من المنازل، وقد ضاق أفقها، فلا تعرف جواً غير جوها، ولا دواً غير دوها، وكأن كان هواؤها وبيئاً، وكان مسكنها وبيلاً، فهي تتململ في مكانها، وتعتقد أن لا منقذ لها من هوانها. فإذا وجد الرجل الكبير، فأول ما يخطر له أن يفعل، هو أن يمد بصره إلى ما وراء أفقها حتى يعرفها أن وراء منزلتها مذهباً لمن يريد النجاة مما هو فيه.
الرجل الكبير يحس ويتألم، ويدفعه الألم إلى أن يتكلم، بل تحمله شدة الألم على أن يجاهد قومه، وهم أحب الناس إليه، ويقاتلهم ليدفعهم عن موارد الهلكة وهم أعز الخلق عليه. ولكن قد يبلغ بهم العمى أو قصر البصر أن يعدوه عدواً لهم، فإذا جاءتهم عدوهم الحقيقي وأحسوا شدة الصدمة، صاحوا، ولكن صياح الثاكلة العاجزة، فينتهي بهم الأمر إلى الاضمحلال، وما بعد الاضمحلال إلا الزوال. وإن كان ما بالأمة ليس نوماً فيزول بالإيقاظ، ولا غفلة فتذهب بالتنبيه، وإنما هو خدر شلت به الأعصاب وذبلت به العروق، فماذا يكون فعل الرجل الكبير؟
يجهد عقله بالبحث عن الدواء، ويستعمل مالديه من قوة في معالجة الداء. وهيهات أن يشعر به المريض، بل هو تارة يضحك ضحك المستهزئ، وأخرى يبكي بكاء اليائس، وثالثة يضرب الطبيب بما حضر لديه، أو بيديه ورجليه، حتى يقضي عليه. وإذن فماذا يفعل الرجل الكبير؟
يسعى ويجد، ويدأب ويكد، ثم يموت محروماً من ثمرة عمله، باكياً على خيبة أمله. ولكن هل ذلك كله يقضي على الكبير بأن يصغر، وهل يحكم على العظيم في نفسه بأن يحقر؟ كلا، فهو يؤدي واجباً عليه، وعلى الله ما وراء ذلك، والمرجع إليه». (82)
الهوامش
1- طاهر الطناجي، مذكرات الإمام محمد عبده (القاهرة : دار الهلال، د. ت) ص 22.
2- عباس العقاد، محمد عبده (القاهرة : وزارة التربية والتعليم، مطابع دار القلم، 1383 – 1963) ص 85. ويرجح العقاد صحة نسب أم الإمام إلى قبيلة قريش، حيث أنها تنحدر من بني عدي، وانتساب بني عدي إلى قريش أمر لا داعي للشك فيه (ص 85 و 86).
3- المرجع السابق، ص 82.
4- المرجع نفسه، ص 84.
5- نفسه، ص 314.
6- مجاهد توفيق الجندي، قراءة أولى في وثائق مجهولة: أضواء جديدة على أوراق من ملف الإمام محمد عبده. بحث قدم في مئوية الأستاذ الإمام التي نظمها «مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف». ص2.
7- العقاد، مرجع سابق، ص 85.
8- محمد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام (القاهرة: مطبعة المنار بمصر، ط2، 1344 هـ) ج/1 ص77.
9- الجندي، مرجع سابق، ص2. وهو يستند إلى وثائق من ملف الأستاذ الإمام المحفوظ بدار الوثائق القومية تحت رقم 22679 دولاب 42 عين 40. إضافة إلى رسالة ماجستير أعدها حسام عبد الغني رجب عن دور الإمام في الإصلاح الأزهر.
10- العقاد، مرجع سابق، ص 77.
11- نفسه، ص 81.
12- عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار (القاهرة: لجنة البيان العربي، 1958) ج4/ص 207.
13- لمزيد من التفاصيل حول خصائص الثقافة السياسية للفلاحين انظر: كمال محمود المنوفي، الثقافة السياسية للفلاحين المصريين (بيروت: دار ابن خلدون، 1980). وانظر بشأن ما طرأ على تلك الثقافة من تغيرات خلال العقود الأخيرة: إبراهيم البيومي غانم، تحولات الثقافة السياسية للفلاحين المصريين 1980 – 2005 (بحث غير منشور، مقدم إلى مؤتمر الدولة المصرية – كلية الاقتصاد/ جامعة القاهرة).
14- العقاد، مرجع سابق، ص 127.
15- لمزيد من التفاصيل حول مفهوم المشترك القروي وأبعاده وتأثيراته المختلفة في حياة الفلاحين المصريين انظر: أحمد صادق سعد، في ضوء نمط الإنتاج الآسيوي: نشأة التكوين المصري وتطوره (بيروت: دار الحداثة، د. ت.) وبه نصوص مختارة من ص 136 – 149 عن هذا المشترك في العصر العثماني، وفي عصر محمد علي.
16- انظر مثلا: محمد عمارة، الإمام محمد عبده: مجدد الدنيا بتجديد الدين (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشر، 1985) ص 24.
17- العقاد، مرجع سابق، ص 75.
18- مجاهد الجندي، مرجع سابق، ص 2. ويلفت النظر ما ذكره الجندي أنه اطلع على شهادة قيد ميلاد الأستاذ الإمام في ملفه المشار إليه، وفيها اسم القابلة، واسم قرية شنرا مكان مولده، ولكنه يقول إن هذه الشهادة اختفت من الملف عندما عاد إليه مرة أخرى!.
19- العقاد، مرجع سابق، ص 80.
20- انظر تحليلاً ممتعاً لأسماء عدد من أعضاء عائلة الأستاذ الإمام في المرجع السابق، ص 89 و 90.
21- نفسه، ص 90 و 91.
22- أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (القاهرة: مطبعة الشعب، كتاب الشعب، د. ت.) ص 352.
23- نفسه، ص 88.
24- ألغى محمد علي الالتزام، ووزع الأراضي على سكان القرى، وجعل لهم حق الانتفاع بها دون الملكية التامة، ولمزيد من التفاصيل انظر: يعقوب أرتين، الأحكام المرعية في شأن الأراضي المصرية، تعريب سعيد عمون (القاهرة: المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية، 1306 هـ).
25- إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر (القاهرة: دار الشروق، 1998) ص 100 و101.
26- العقاد، مرجع سابق، ص 76.
27- الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، تحقيق محمد عمارة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1972) ج1/ ص 728.
28- العقاد، مرجع سابق، ص 257.
29- نفسه، ص 257.
30- جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1389 – 1970) ص 35 من مقدمة الكتاب وهي بقلم الشيخ مصطفى عبد الرازق.
31- العقاد، مرجع سابق، ص.
32- المرجع السابق، ص 37.
33- أحمد محمود سويدان، محمد عبده والنهضة العربية الإسلامية. في: الفكر العربي / مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية. بيروت، العددان 39 و 40، السنة السادسة، يونيو / أكتوبر 1985. ص 185.
34- العقاد، مرجع سابق، ص 143.
35- لمزيد من التفاصيل حول. أبعاد المواجهة بين العالم الإسلامي والغرب في القرن التاسع عشر أنظر : إبراهيم البيومي غانم، الفكر السياسي للإمام حسن البنا (القاهرة : دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1412 هـ 1992 م) ص 67 – 102.
36- فتحي رضوان، دور العمائم في تاريخ مصر الحديث (القاهرة : الزهراء للإعلام العربي، 1406 هـ – 1986 م) ص 11.
37- إبراهيم البيومي غانم، الانتلجانسيا الحديثة تكتشف جذورها: الهجرة من العلمانية إلى الإسلام. مجلة المجتمع الكويتية العدد 1233 – 18 رمضان 1419 – 1/5/1999. ص 44.
38- لمزيد من التحليل المتعمق حول توجهات رواد الإصلاح الإسلامي خلال القرن التاسع عشر انظر : رضوان السيد سياسات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت : دار الكتاب العربي، 1418 هـ 1997 م) ص 18 – 32.
39- غانم، الفكر السياسي، مرجع سابق، ص 78، 79.
40- عبد العاطي محمد، الفكر السياسي للإمام محمد عبده (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 1978) ص 86.
41- طارق البشري، في المسألة الإسلامية المعاصر : الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (القاهرة: دار الشروق، 1417هـ 1996) ص 15 و16.
42- العقاد، مرجع سابق، ص 14.
43- محمد عمارة، الإمام محمد عبده، مرجع سابق، ص 25.
44- الطناحي، مرجع سابق، ص 29.
45- كتاب «شرح الكفراوي على الأجرومية» والنص الذي أوردناه نقلاً عن: أحمد أمين، زعماء الإصلاح، مرجع سابق، ص 281، 282.
46- أحمد أمين، مرجع سابق، 283.
47- نفسه، ص 285.
48- العقاد، مرجع سابق، ص100 وانظر أيضاً: الطناحي، مرجع سابق، ص 33.
49- العقاد، المرجع السابق، ص 73، 74.
50- محمد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (بيروت: مؤسسة الرسالة للدراسات والنشر، 1973) ج1/ ص20. وانظر أيضا: العقاد، مرجع سابق، ص199 و192.
51- أحمد أمين، مرجع سابق، ص 285.
52- نفسه ص 287.
53- انظر نص قرار لجنة الامتحان بمنح الشيخ محمد عبده العالمية من الدرجة الثانية وتعيينه مدرساً بالأزهر الشريف، تحت عنوان «إعلان من مشيخة الأزهر الشريف» في : مجاهد الجندي، مرجع سابق.
54- منهم العقاد، مرجع سابق، ص 201.
55- أحمد أمين، مرجع سابق، ص 286.
56- محمد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، مرجع سابق، ج3/ ص 178 و179.
57- أحمد أمين، مرجع سابق، ص 289.
58- العقاد، مرجع سابق، ص 96.
59- نفسه، ص 137.
60- نفسه، ص 102.
61- أحمد أمين، مرجع سابق، ص 289.
62- نفسه، ص 326.
63- العقاد، مرجع سابق، ص 139.
64- عبد العاطي محمد، مرجع سابق، ص 68. و العقاد، مرجع سابق، ص 102.
65- أحمد أمين، مرجع سابق، ص 292.
66- حقق الدكتور محمد عمارة في نسبة المؤلفات الخاصة بالأستاذ الإمام، وميز ما هو من تأليفه عما هو من تأليف غيره ونسب إليه، ومن ذلك رسالة الواردات، وبين أنه كتب مقدمتها فقط، انظر لمزيد من التفصيل: محمد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، بحث في احتفالية الإمام محمد عبده التي نظمتها الجمعية الخيرية الإسلامية – قاعدة محمد عبده بالأزهر 6 محرم 1426 – 15 فبراير 2005.
67- العقاد، مرجع سابق، ص 163.
68- فتحي رضوان، مرجع سابق، ص 51.
69- نفسه، ص 140.
70- العقاد، مرجع سابق، ص 101.
71- نفسه، ص 198.
72- عبد العاطي محمد، مرجع سابق، ص 84.
73- نفسه، ص 84.
74- ذكر الشيخ عبد الله دراز – محقق الكتاب – أنه سمع وصية الشيخ محمد عبده بالاهتمام بكتاب الموافقات، وأنه كان حريصاً على تنفيذ وصيته، انظر ص 12 من مقدمة المجلد الأول من الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق عبدالله دراز (بيروت: دار المعرفة، ب ت). وانظر أيضاً: رضوان السيد، سياسات، درجع سابق، ص 42 حيث يشير إلى اهتمام الإمام محمد عبده بالموافقات.
75- مجاهد الجندي، مرجع سابق، ص 21.
76- عبد العاطي، مرجع سابق، ص 85. وقد أرسل الأستاذ الإمام في سنة 1901 رسالة إلى الأديب الروسي الكبير ليون تولستوي بمناسبة الحكم الي أصدرته الكنيسة الأرثوكسية ضده وقضت بحرمانه كنسياً، عقاباً له على كتاب نشره بعنوان «البعث». وفيه أنكر ألوهية المسيح مخالفاً بذلك تعاليم الأكليروس الكنسي. انظر: عثمان أمين، محمد عبده رائد الفكر المصري الحديث (القاهرة: دار إحياء الكتب، 1944) ص264 و265.
77- لمزيد من التفاصيل حول تلك الرؤى والاختيارات الفكرية والسياسية للأستاذ الإمام انظر مثلا: محمد عمارة، الإمام محمد عبده، مرجع سابق، صص 13 – 145، وصص 168 – 178 وص 222 و 223.
78- من أهم الدراسات التي تخصصت في الأستاذ الإمام، دراسات كل من: محمد عمارة، وعباس العقاد، ومصطفى عبد الرازق.
79- ابن حزم الأندلسي، الأخلاق والسير في داراة النفوس، تحقيق وتقديم الطاهر أحمد مكي(القاهرة: دار المعارف، 1981) ص 179.
80- علي الجعفراوي، المنهل الصافي في مناقب السيد حسنين الحصافي (القاهرة: المطبعة الجمالية، ط 1330هـ) ص 3 هامش رقم 3.
81- العقاد، مرجع سابق، ص 314.
82- أعادت مجلة الهلال نشر هذه المقالة في عددها الصادر بتاريخ يناير 1939 – 12 من ذي الحجة 1357 هـ، الجزء الرابع، لسنة 47 – ص 372.