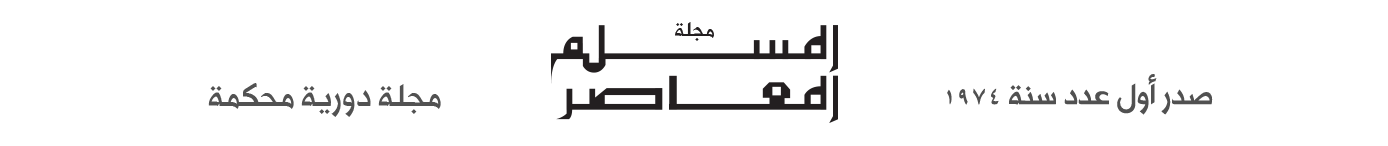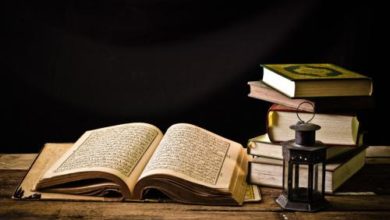مقـدمـة:
التقليـد من الظـواهـر التـى تزامنت مع وجـود المجتمعـات البشــرية على مختلف أنمـاطهـا وأمـاكن تواجدهـا. فـالتقليد ـــ كمــا يقـول ابـن خلـدون ـــ عريق في الآدميين سليـل.
وقـد تنـاول الأصوليـون الحديث عن التقليــد وأفـاضوا في تفصـيل دقائقـه، ومـا يتعلق بمســائله وآراء العلمـاء فيه وحـدوده وأحكـامه.. كمـا تعرض بعضـهم لآفاقـة ومخـاطره وأبعـاد الفكــرية على الفرد والمجتمع.
وســلكت تلك الدراســات في مجموعهـا، مســار التنظير الفقهي كوسيلة معـرفيــة لفهـم وعـلاج التقليـد. فكــان الإطار المرجعـي الـذي تحتكم إليــه غالب تلك الدراسـات، يعود إلى شعـار تنظيري يحول في فلكـات الفقه والأصول.
وعلى الرغـم من تعـرض العـديد من الكتـابات لخطـورة هـذه الظــاهرة وسلبياتهـا المتعددة، إلا أنهـا في غالبيتها لم يتم الــتركيز فيهـا على مرحــلة نشــأة الظـاهرة والظـرفيـة التاريخيـة والاجتمـاعية المقـارنـة لهـا في دراســة جـامعة مستقلة، يُســلط الضـوء فيهـا على تلك العـوامل. فــإذ لم تظهـر أســباب ظهورهـا وعوامـل اســتمراريتهـا، بقيت إرهاصـات الدواء بعيـدة عن متنــاول العديد من تلك الدراسات.
إن غـياب مفهوم وضـرورة الـتركيز على دور الظـرفيـة الاجتمـاعيـة والتاريخية في مســألة التقليد وغـيرهـا، يسـوق إلى الارتمــاء في أروقة النزعـة التنظيريـة عوضـاً عن اللجوء إلى دراســة عميقــة لواقع الظـاهرة في المجتمع، ومن ثـمّ محـاولة توصيف العلاج الملائم لتجـاوزهـا.
ومن هنـا تأتى هذه الدراسـة في محـاولة جــادة متواضعـة لتقصى وتتبع طبيعـة الظـروف الاجتمـاعية والدواعي النفسـية والفكـرية، التى أسهمـت في إرسـاء قواعـد العقليـــة التقليديــة، ذات الخضـوع لوجهــات النظـر الجــاهزة في الفهـم والحكـم والتـأويل. تلـك العقليــة التى أرست دعـائم عمليات الاجـترار الفكـري وتكــرار الـذات والــدوران في فلك الآخرين دون قـدوة على نقـد أو تحليل واستقصـاء باعتبارها جهـوداً بشـرية غير معصــومــة، يجـرى في حقهــا الخطــأ والصواب.
لقــد بـدأ داء التقليد بالاستشــراء في منتصف القـرن الرابع الهجــرى (العاشـر الميلادي)، حين تعرضت الأمـة لمختلف العوامـل السياسية والفكريـة والاجتمـاعية التـى تركت آثـارهــا البليغـة وبصمـاتهـا العميقة في مختلف مظـاهر الحياة. فتوقف النشــاط الاجتهـادي، وتمحـور العمل والتــأليف والتصنيف حـول آراء أئمــة المذاهـب الأربعـة وغــيرهم من العلمــاء الســابقين رحمهـم الله. وأصبح فقــه الســابقين ــ رحمهـم الله ــ مرتكزاً لكل رأى فلا يكــاد يحيد عن دائرته أحـد.
وعلى هـذا تتنـاول الدراســة ظـاهرة التقليد في أثناء تلك الحقبة الزمنيـة الممتدة منذ القرن الرابع الهجـرى إلى القرن الثاني عشــر تقريبــاً، نظـراً لتشــابه وتداخل الظــروف والعـوامل خـلال تلك الفـترة على وجـه التحديد.
وتنتهج الدراسـة في سبيل الوصـول إلى تحليــل تلك العـوامــل والغـور في تداعياتهـا، منهجـاً متعدد الاتجأهـات. فلا تقوم الدراسـة على منهج أحـادى النظـرة، يعتمد النظرة الأصوليـة والفقهية للمفهوم فحسب، بل يتسع المنهج لاســتدعاء مختلف الجـوانب الاجتمـاعيــة والنفســية والتاريخية بغية الكشف عن جـذور تلك الظــاهرة ودواعــي انتشــــارهـا واستمراريتهــا.
ومن أبـرز النتـائج التى أسفــرت عنهـا هذه الدراسـة، أن للتقليد وجهـاً اجتمـاعيـًّا ونقســياَّ عميقـاً، ظهـر ضمن أجـواء تاريخية مؤدلجـة، وأن كل أشـكال التقليد والتبعيــة الفكـريـة وليـدة ذلك المعنى المـتراكـم للتقليد في الذهنيــة المسلمــة. فــالتقليد مســألة أسـاسـية تمس معنى الإنسـان وقّيمـه ونفسيتـه وبرامج تعليمـه وعلاقاته وأوضـاعه في مجتمعـه.
كمــا كشفت الدراســة عن أهميــة توظيف الظـرفيــة الاجتمـاعية والوقوف عليهـا في الإحـاطــة بمختلـف الظواهـر وليس ظـاهرة التقليـد فحسـب. وعليـه فالدراســة توصـى بأهميـة البحث في الأسـباب التاريخيـة والاجتمـاعية والعلميـة والسياسيـة السائدة إبان تنـاول العديد من الظواهـر في تاريخنـا الإســلامي في القديـم والحديث.
التقليد في اللغـة:
ق ل د القــلادة التى في العنق، وقلده فتقـلد، ومنــه التقليـد في الديـن، وتقليد الولاة الأعمـال، وتقليد البدنـة أن يعلق في عنقهـا شئ ليعلم أنهـا هدى[1].
وجـاء في التعريفـات: أن التقليد عبـارة عن اتبـاع الإنسـان غــيره فيمـا يقول أو يفعل معتقداً للحقيقـة فيـه من غيـر نظـر وتـأمل في الدليل، كـأن هـذا المتبع جعل قول الغـير أو فعــله قلادة في عنقـه، فهـو قبول قول الغيـر بلا حجـة ولا دليل[2].
أمـــا في الاصطـلاح فيتضـح من عبــارات الأصوليـين حــول التقليــد وحكمـه، أن الغـالب في تعريفه في عرف المتقدمين من الأصوليين والفقهـاء: الأخذ بقول الغـير مع عـدم معـرفة دليله. أو هـو العمـل بقول الغير من غير حجـة[3].
بيـدَ أن هـذا التعريف لم يســلم من اعترلضـات عـدد من العلمـاء، ومنهـم إمـام الحرمين الجوينـى (478 هـــ) رحمـه الله وغيره. فقـد أوضـح في كتابـه الاجتهـاد، أن هذا التعريف لا يُعـد تقليـداً بالمفهوم العـام الـدارج تنـاولــه لدى العلمــاء، من حيث إن تقليــد العـالم وقولــه حجــة في حق من سـأله واســتفتـاه، فيخـرج بذلك من مفهوم التقليـد ودائرته.
يقـول في ذلــك: «… ذلــك ليس بتقليـد أصـلاً فـأن قـول العــالم حجــة في حـق المســتفتى؛ إذ الـرب تعــالى وجل نصب قـول العـالم علمـاً في حق العـامي، وأوجب عليـه العمـل بـه، كمــا أوجب على العــالم العمــل بموجب اجتهــاده، واجتهـاده علم على علمــه، وقولـه علم على المســتفتي، ويخــرج لـك مـن هذا الأصـل أنـه لا يتصـور علـى مـا نرتضيه رحمــة (يعنى بهــا التقليد) مبــاح في الشــريعة، لا في أصـول الدين ولا في فروعــه؛ إذ التقليد هـو الاتباع الذي لم يقـم به حجـة.. »[4].
كمــا أورد أبو المظفــر الســمعـاني (489هــ) قول بعض العلمـاء أن رجوع العـامي إلى قـول العالم ليس بتقليد أيضـاً؛ لأنه لابد لـه مـن النوع اجتهـاد، فلا يكون تقليداً[5]، ونقل قول الأمـام الشــافعي 150هــ) رحمة الله في بعض المواضـع أنه لا يجـوز رحمــة[6] أحـد ســوى الرسـول ـــ صّلى الله عليــه وسـلم ـــ، ولكنــه علّق على ذلك بــأن هذا مذكـور على طريق التوسـع لا على طريق الحقيقة[7].
وقـد نقل القاضـي في التقريب الإجمـاع على أن الأخـذ بقــول النبي ـــ صّلى الله عليــه وسلم ـــ، والراجع إليــه ليس بمقلد، بل هو صــائر إلى دليل وعلم يقـين. كمــا ذكــر إمــام الحرمين أن الاختلاف الواقـع في هذه المســـألة، اختلاف في عبـارة يهون موقعهـا[8].
ومن هنــا قــام عــدد مـن الأصوليين بوضع قيـود لتعريف التقليد وذلك لمنع إدخـال مـا ليس داخـل في مفهـوم التقليد. وقد ساق الشوكـاني تلك التعـاريف التى مفـادهــا أن التقليد: قبـول رأى من لا تقـوم به الحجـة بلا حجـة. فيخـرج العمل بقــول الرســول ـــ صّلى الله عليــه وسلم ـــ، والعمل بالاجمـاع، ورجــوع العــامي إلى المفتـى، ورجـوع القــاضى إلى شهــدة العــدول فإنهــا قد قامت الحجـة في ذلك[9].
وقـد اتخـذ التقليــد مســاراً أكثـر محدوديـة من ذلك المفهـوم، عندمـا بات يُطلق عنـد المتأخرين مـن العلمــاء ويراد به: اتخـاذ أقوال رجـل بعينه بمنزلة نصوص الشـارع لا يلتفت إلى قـول ســواه، بل ولا إلى نصوص الشـارع، إلا إذا وافقت نصوص قول من اتبعه.
يقول أبو شـامة المقـدسي (665هـ) في ذلك: «اشــتهر في آخـر الزمـان على مذهب الشافعي تصـانيف الشيخين أبي إسحــاق الشـيراني وأبى حـامد الغزالي، فـكبّ النـاس على الانشغـال بهـا وكثـر المتعصـبون لهمـا، حتـى صــار المتبحـر المرتفع، يرى أن نصوصهمــا كنصوص الكتـاب والسـنة لا يرى الخروج عنهـا وإن أخـبر بنصـوص غيرهمـا من أئمـة مذهبـه بخــلاف ذلك لم يلتفــت إليها… »[10].
ويقــول ابن قيم الجوزيـة (751هــ) رحمــه الله بعـد أن سـاق هـذا المفهـوم المحـدد للتقليـد: « فهـذا هـو التقليد الذي أجمعت الأمـة علـى أنه محـرم في دين الله، ولم يظهـر في الأمــة إلا بعـــد انقــراض القرون الفاضـلة »[11].
ويقـول في موضـع آخـر من كتـابـــه مؤكــداً على ورود التقليد بهــذا المعنى والمفهـوم: « مـا حدث في الإسلام بعـد انقضـاء القرون الفاضلــة في القرن الرابع المذموم على لسـان رسـول الله ـــ صّلى الله عليــه وسلم ـــ، من نصب رجل واحـد وجعـل فتاويـه بمنزلــة نصوص الشـارع بل تقـديمهـا عليه وتقـديم قولـه على أقـوال من جـاء بعد رسـول الله ـــ صّلى الله عليــه وسلم ـــ من جميع علمــاء أمتــه والاكتفــاء بتقليده عن تلقى الأحكـام من كتاب الله وسنة رسـوله وأقوال الصحــابة »[12].
وأوضــح هذا المعنــى الشـوكـاني (1255هــ) حيث يقول: « من أعجب الغفلـة وأعظـم الذهــول عن الحـق اختيار المقلدة لآراء الرجــال مع وجـود كتــاب الله ووجـود ســنة رســوله ووجود من يأخذونهمــا عنه ووجـود آلة الفهـم لديهـم وملكــة العقل عنـدهــم »[13]. فهـؤلاء المقلدة من أهـل الإسـلام استبدلوا بكتـاب الله وبسـنة رســوله كتاباً قد دونت فيه اجتهـادات عالم من علمــاء الإســلام[14].
ويقــول في موضـع آخـر: « التقليــد والانتســاب إلى عــالم من العلمــاء دون غيره والتقليد بجميع ما جـاء به من روايـة ورأى، وإهمــال مـا عــداه من أعظـم مـا حدث في هذه الملـة الإسلامية من البدع المضـلة والفواقـر الموحشـة »[15].
وليس ثمــة تنــاقض أو تضــارب في تعـريف العلمــاء للتقليد. فالمصطلحــات على وجـه العمـوم قابلة للتغـير والتبـدل والتطـور حســب وضع اللغــة وعرف الاستعمال، وهو أمـر لا مندوحـة عنه، فالمفـاهيم والمصطلحـات تمـر بجملـة تغيرات تســـوق إلى نوع مـن التخصيص والتحديد فيهـا.
وممـا يؤكـد مسـلك العلمـاء المتأخرين في تعريق التقليد، عبــاراتهـم التى حملوا فيهـا على التقليد وحـاربوه بشـدة وذهبوا إلى عــدم جــوازه مطلقـاً، في حـين أن المتقـدمين منهـم تعرضـوا للتفرقـة والتمييز بين التقليـد في الفـروع عـن العقــائد والأصول باعتبـار تعريفهـم له في زمانهـم وليس باعتبـار مـا يستجـد فيهـا بعـد وتحدد عند المتأخرين.
والمــراد بالتقليد في هـذا الدراســة، التقليد في عـرف المتأخرين وهو المشــار إليــه والمســتنبط من كتـابات ابن القيم واشـوكـاني وغـيرهمـا من العلمــاء الذين حملوا علـى التقليد والمقلــدة. وقـراءة أعمـال ابن القيـم والمقلــدة. وقـراءة أعمــال ابن القيم والشـوكـاني والصنعـاني رحمهـم الله وغيـرهم، وتؤكـد ارتباط ذلك المفهـوم بهذا المسمى الخـاص.
حكـم التفليد في الكتابـات الأصوليـة:
قبـل المضـى في اســـتقصـاء وتتبـع حكم التقليد في كتابــات العلمــاء، لابـد من التـأكيد على جملة أمور منهـا: أن شيوع التقليد ـــ بالمعنى الـذي تتبنــاه الدراســة، لايعنى بالضـرورة خلو العصـور المختلفــة والحقب الزمنيــة المتعـددة من المجتهدين مطلقـاً، فقـد ظهـر العـديد من العلمــاء الذين خـــالفوا المنهـج التقليدي وحملوا عليه وحــاربوه في كتـاباتهـم ومؤلفــاتهم المختلفــة، ولكنــه يعنى ســـيادة التقليد وغلبة تياره.
كمــا أن التقليـد لايحـدث فجــأة أو عبر فـترات زمنيـة قصيرة، وإنمـا تتجمع وتتضــافر روافـده خلال أزمنــة تاريخيــة طويلـــة. هــذا إلى أن التقليـد لا ينفــرد بظهــوره وشـيوعه عـامل واحـد، وإنمـا هو وليد جملـة من العـوامـل المتداخلــة بعضهـا مع بعض لدرجــة يصعب في كثـير من الأحيــان، فك الارتبـــاط بينهــا لتتبع مديــات تأثــير كـل منهـا على حدة. فظـاهرة التقليـد تتشـــكل على مهـل وتتضظتتافر المؤثرات الاجتمـاعية والنفسـية والسياســية المختلف،،ة فى صياغتهـا واستمراريتهـا.
وعلى هذا، فالنظـرة الأحـادية لتفسيـر هذه الظـاهرة أو محـاولـة ردّهـا إلى عـامل ومؤثـر واحــد، أمــر يتبغــي تجــاوزه ومؤثــر واحــد، أمـر ينبغـي تجــاوزه والاســتعاضة عنــه بمحـاولـة تقديـم نظـرة شموليـة تعنـى باســتقصـاء وتتبع مختلف العوامـل والمؤاثـرات، كمــا أن التقليـد كظـاهرة لا يرتبط بمرحـلة تاريخية معينـة، وإنمـا تـبرز هـذه الظـاهرة كلمــا تجـددت تداعياتهـا ومسبباتهـا.
وقـد تعرض المتقدمون من الأصوليين للبحث في حكـم التقليد بمفهـومه لديهـم آنـذاك، وعلى هـذا ذهبـوا إلى التفريق والتمييز في الحكـم عليــه في المســائل المختلفـة. أمـا التقليد الذي تتبنى الدراســة مفهـومه، فلا خلاف في منعه[16].
وأختلافهـم في حكـم التقليد إنمـا كـان منحصـراً في الأحكـام الشـرعية العلميـة أو الفـروع. فجمهــور الأصولييـن على أن التقليد فيهـا جـائز، لأن المجتهـد فيهـا إما مصيب وإمـا مخطئ مثاب غير آثم، فجـاز التقليد فيهــا. فتكليف العوام رتبــة الاجتهـــأد يؤدى إلى تعطيــل الحــرف والصنــائع والمصـالح المختلفــة. وحـرمّـة عـدد من العلمـاء من أمثـال ابـن عبد البر وابـن قيـم الجوزيــة والشـــوكـاني وغــيرهم[17].
وقـد ذهب عـدد مـن العلمـاء والمجتهدين في مختلف العصـور إلى تحريم وإبطـال التقليـد ـــ بالمعنى الذي تتبنـاه هذه الدارســـة ـــ لمـا لـه من آثـار وخيمـة على الفرد والمجتمع والمســار الفكــرى لهمـا، فهـو تكريس لمعنى التبعيــة المطلقة الذي نهى عنه الإسلام. إضـافة لمـا لهذه الظـاهرة من أثـر قي تعطيل قوى العقل وقدراتـه على الاجتهـاد والابتكـار والتجـدد والعطـاء.
وقـد انطلق هؤلاء العلمــاء في منعهـم لمســار التقليــد مـن خلال فهمهـم للنصوص القرآنيــة المتضـافرة علـى المنع منه. ومن هذه النصـوص ما يلي:
ــ قولـه تعالى } وَمِنَ النَّـاسِ مَنْ يَتَّخِـذُ مِنْ دُونِ اللَّــهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُــمْ كَحُبَّ اللهِ { ] البقـرة: 165 [. يقـول القرطي في تفســيره: « وفي هـذا دليـل على الأمـر باســـتعمـال حجــج العقــول وإبطـال التقليـد.. »[18].
ــ قولـه تعـالى: } وَإذَا قِيلَ لَهُـمْ تَعَـالَوْا إلَــى مَـا أنْـزَلَ اللَّـهُ وَإلَى الرَّسُــول قَالُوا خَسْبُنـــا مَا وَجَـدْنَــا عًلَيْـــه ءَابَاءَنَا { ] المــائدة: 104 [. يقـول الشــوكاني في تفســيرهـا: « وفي ذلك دليل علـى قبح التقليد والمنـع منــه والبحث في ذلك المطلوب »[19].
وقـد أفـرد الشــوكـاني مؤلفـاً مسـتقلاً أسمــاه: « القول في حكم التقليد » للبحث في التقليد والتــأكيد على إبطـالـه ومنعه.
ــ قولــه تعـالى: } اتَّخَذُوا أَخْبَـارَهُمْ وَزُهْبَـــانَهُمْ أَرْبَابًــا مِنْ دُونِ اللَّــهِ { ] التوبـة: 31 [. يقول الشوكـاني رحمـه الله: « وفي هذه الآيــة ما يزجـر من كـان له قلب أو وهو شهيد عن التقليـد في دين الله وتاثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسـنة المطهـرة، فـإن طـاعة تامتذهب لمن يقتدى بقولـه ويستن بسنتـه من علمــاء هــذه الأمــة مع مخـالفتـــه لمـا جـاءت بـه النصوص وقـامت به حجج الله وبراهينـه ونطقت بـه كتبـه وأنبياؤه هـو كاتخــاذ اليهـود والنصـارى للأحبـار والرهبــان أربابـاً من دون الله للقطع بأنهـم لم يعبدوهـم بل أطـاعوهم وحرّموا ما حرّموا وحللوا ما حللوا، وهـذا هــو صنيع المقـلدين من هـذه الأمة »[20].
ــ ســاق الشوكـاني رحمـه الله العديـد من النصـوص القرآنيــة التـى تبيـن نهج القــرآن الكريــم فى ذمّ تقليــد الآبــاء والرؤســـاء، مؤكـداً أن العلمــاء احتجوا ببعض الآيـات التـى وردت في ســياق توبيخ الكـافرين والمشـركين على تقليدهـم للأبـاء والأســلاف، إلا أن كفـر أولئـك لا يمنع مـن الاحتجــاج بهــا؛ فالتشبيـه لم يقع من جهــة كفــر أحـدهمــا وإيمــان الآخـر، وإنمـا وقـع التشــبيـه بين المقلدين بغـير حجـة للمقلد، كمــا لو قلـد رجـلاً فكفـر، وقلد آخـر فـأذنب، وقلـد آخـر في مســألة فأخطـأ وجههـا، كان كل واحـد ملومـاً على التقليد بغيـر حجــة؛ لأن كل ذلـك تقليد يشــبه بعضــه بعضـاً وإن اختلف الآثام فيه[21].
ــ مـا ورد عن عمـر ـــ رضـى الله عنـه ـــ حيث يقول: « إن حديثكــم شــرّ الحديث، إن كلامكـم شـرّ الكــلام، فإنكـم قد حدثتـم النـاس حتى قيل: قـال فلان وقال فلان، ويترك كتـاب الله، من كـان منكـم قائمـاً فليقــم بكتـاب الله وإلا فليجلس. فهـذا قـول عمــر لأفضـل قــرن عل وجــه الأرض، فكيف لو أدرك مـا أصبحنـا فيه من ترك كتـــاب الله لقــول فلان وفلان »[22].
ــ وقـال ابن حـزم بالإجمــاع على النهـى عن التقليـد.
ــ ونقـل عن مالك أنـه قال: أنـا بشـر أخطـئ وأصيب فـانظـروا في رأيي، فمــا وافق الكتاب والسنة فخــذوا به، وما لم يوافق فاتركـوه، وكذلك الشــافعي وأبو حنيفـة.
فـالمنع من التقليــد إن لم يكن إجمـاعــاً فهـو مذهب الجمهـور[23].
وقـد اســتدل العلمـاء ببعـض الأدلـة العقليــة لردّ التقلـيد والنهـى عنه.
ومن ذلك احتجـاج المقلـد بعـدم العلـم والإحـاطــة بتأويل كتــاب الله وسنــة رســوله ـــ صّلى الله عليــه وسلم ـــ، في حين أن العـالم الذي يقلـده قد علــم ذلك، وهـذا في حقيقتـه ضرب من التبرير غـير المســوغ لـه، فهـم يحــاولون تــبرير تقليدهـم وعجـزهـم عن النظـر والبحث وبذل الجهـد، بهـذا القول، والأمـر أن العلمــاء اختلفوا فيمــا بينهــم ولم يجتمعـوا على شــئ مـن التـأويل، فلو اجتمعوا لكـان هـذا هو الحق، فلا مســوغ لاتبــاع بعضــهم دون البعض الآخـر وكلهـم عـالم[24].
ــ نهى الأئمــة الأربعــة عن تقليـدهم وذمّوا من أخـذ أقوالهـم بغـير علـم بالحجـة. يقــول تبـم القيــم رحمــه الله في هـذا السيـاق:
« والأئمــة الأربعــة منعــوا النـاس عن تقليدهـم، ولم يوجب الله ســـبحانه وتعــالى على أحــد تقليـد أحــد من الصحـابة والتابعين الذين هـم قدوة الأمـة وأئمتهــا وســلفهـا، فضـلاً عن المجتهدين وآحــاد أهـل العـلم. بل الواجب على الكل اتبـاع ما جـاء به الكتـاب والسنــة المطهرة، وإنمــا احتيج إلى تقليد المجتهـدين لكون الأحــاديث والأخبـار الصحيحة لم تدون، ولكـن الآن بحمـد الله تعــالى قد دوّن أهـل المعرفــة بالسـنن علم حديث رسـول الله ـــ صّلى الله عليــه وسـلم ـــ، وأعنوا الناس عن غيره، فلا حيــا الله عبـداً قلـد ولم يتبع ولم يعـرف قــدر الســنة وحمــد على التقليد »[25].
وقـد أفــاض ابن القيــم رحمـه الله في الرّد على المقلدين وذمّ التقليـد في كتابه: « إعــلام الموقعين عن رب العــالمين » في مواضـع متفرقــة لا سيمـــا في فصـل خاص عقده بعنوان: في عقـد مجلس مناظـرة بين مقلـد وبين صاحب حجة منقــاد للحق حيث كان.
وبلغت أوجه إبطـال التقليد أكثــر من ثمانين وجهـاً.
والمتأمل في الكتــابات الأصوليــة عند المتقدمـين من العلمــاء، بلحظ عدم تعـرضـهــم للتقليد وحكمــه بهذا المفهـوم، وهـو أمر لــه مــا يـبرره؛ فــالتقليـد بهـذا المفهـوم وبالتداعيـات التى صاحبتـه، لم يظهـر إلا في مرحلـة متـأخرة ( كمـا يظهـر ذلك من كتابات المتـأخرين ) وعلى هـذا يُفـهم عـدم تعـرضهـم للحديث عن تحريمـه أو منعه أو ما شتبهـه مـن أدلة على ذلك. فإذ لم يظهـر المفهـوم بتلـك المحـدودية، لم يكن ثمة حاجـة لتنـاوله أو دراسته.
فالدراسـات الأصوليـة والفقـهية كـانت في عصـورهـم، انعكـاســاً لواقعهـم ومـرآة لمجتمعـاتهـم وظواهـرهـا، وليست ضربـاً من الافتراض أو التوقـع، بل صديـات الواقع ومفرزاته.
جـذور التقلـيد ونشــأته التأكيد على أن التقليـد كظـاهرة فكـرية اجتمـاعية لا يُراد بهـا التقليـد المطلق أو التبعية التـامة العامة الشــاملة للكل. فقـد بقيت المجتمعـات المســلمـة وفي مختلف الفــترات والحقب الزمنية المتعاقبـة، تنجب في ثنـايا محنهـا الفكــريــة، علمــاء ومجتهدين خرجـوا على سبيل التقليد الجــارف ومنحـاه العام. بيد أن الســمة الغالبــة والتيــار الســائد في المجتمــع، كــان ينحــى التقليــد منهجــاً وســبيلاً. ولم يــأت ذلك المنحــى وليد يومــه وســاعته، بل تمخــض عن عوامــل عديدة، وتداخلت في صياغتــه جملــة ظـروف ووقــائع، تضــافرت جميعهـا وعلى مدى فــترات زمنيــة امتــدت في تـاريخ الأمـة.
لقـد كـانت العقليــة المســلمة في العصـور الخيريــة الأولى تنتهج نهجـاً فكـريَّـا ســليمـاً في التوصـل إلى العلوم والحقــائق وأحكــام المســائل المختلفــة. فكــان القرآن الكــريم والســنة الصحيحـة المــأثورة على النبي ـــ صّلى الله عليــه وســلم ـــ، المـيزان الحـاكم المهيمـن على كـل المنـاهج، الضــابط لهـا، فـلا يُقــدم عليهمــا رأي أو معقـول أو تقليـد أو قيـاس[26].
فـبرزت العقليــة الناضجــة النائيـة عن التعصـب للأشخـاص، الواقفـة مع الحجـة والاســتدلال، الســائر مـع الحق أينمـا ســارت ركـائبـه، المستقلـة مع الصـواب حيث استقلت مضـاربـه. تلك العقلية التى متـى مـا بدالهـا الدليل، أخـذت بـه وســارت على نهجــه. عقليــة أرسـى قواعـد ومنـاهج تفكيرهـا القرآن الكريـم وتعـاليم السـنة النبويـة، فجعلت منهـا معيـاراً على المنـاهج المختلفـة وميزاناً تزن به المذاهـب المتعـددة. وعلى هـذا لم تظهـر منـاهج الاســتبداد بالرأى أو التعصب أو نفى التعـدديـة الفكـرية بـأي شــكل من الأشكـال.
يقـول الأميـر الصنـاعي (1182هـ) في ذلك: « لا يُتصـور أن إمـامـاً مـن الأئمـة الأعلام مهمــا بلــغ من العلــم والحفظ والضبط والإتقـان والفضـل والوجاهــة يستقل بالحكم على الشيء ويستبـد برأيه ويفـرض على الآخـرين فرضـاً »[27].
وفي تلك الأجـواء الحــرّة دخـل المجتمع في حـركـة فقهيـة واجتمـاعيـة هائلة، وقـام العلمـاء بتلبيــة حـاجـات المجتمعـات من خـلال اجتهـاداتهـم وآرائهـم المتفتعلـة مع الواقــع ومسـتجداته المـتزايـدة، وفق منهـج القـرآن الكـريم والسنة. فـازدهـرت الحركـة العلميــة وأينعت ثمـارهــا في عـدد من المدارس والمنـاهج الفكـريـة السـائرة على نهـج النبوة والرســالـة، فكــان العصـر العبـاســي الأول (132هـ ــ 232هـ) عصـر الإبداع في الحضـارة الإسـلامية.
ولانتشــار وازهـار تلك الحركــة العلميـة الهائلـة عوامـل عديدة من أهمهـا، اهتمــام خاص للمعـرفــة. فقـاموا بتقريب العلمــاء وإعـلاء منـزلتهـم في المجتمع[28]، وخصصوا مجـالس للعلم والمنـاظـرة. ونبغ العـديـد مـن العلمــاء في مختلف حـقول العلم والمعـرفة، وظهـر الأئمــة المجتهـدون؛ فــازدهـرت حركــة التدوين في مختلف الفروع العلميــة[29].
وكـان لانبســأط رقعــة الدولـة الإِسلامية ووفـرة ثرواتهــا واســتقرار اقتصـادياتهـا، أثـره البـالغ في خلق تلك النهضـة العلميـة الثقافية، التى لم يشهدهـا الشـرق بأسـره من قبل، حتى بدا الناس جميعـاً في تلك الأجـواء طـلابــاً للعلم وأنصـاراً له[30].
وكـان الجميع بين الاجتهـاد في العلـوم الشـرعية والمســائل الفقهية والإبداع في العلـوم الطبيعيـة، ديدنــا للعلمــاء وطلبـة العلـم. فكـان النجـاح الـذي حققـه المســـلمون في مختلف ميــادين العلم والمعـرفـة، وأضحت الحضـارة الإسـلامية محصّلة التفـاعل تكـاملي بين دراسـة العلوم الطبيعية والعلوم الشــرعية دون ثمـة فاصـل بينهمـا.
وهـذه الحقيقـة لم يســـتطع إنكـارهـا المستشــرق جولد تســهير حـين قـال: « كـذلك يصـدق على القـرآن ما قالـه في الإنجيل العـالم اللاهوتي التـابع للكنيسـة الحديثــة (بيـتر فــيرنفلس): كـل امـرئ يطلب عقـائده في هـذا الكتـاب المقدس، وكـل امرئ يجـد فيه على وجـه الخصوص مـا يطلبه »[31]. فعالم الطبيعـة والفيزيـاء في معملــه، وعـالم الشــريعة في مســائله وفتـاويــه.. كلهـم يجـد في القرآن الكـريم مبتغـاه.
وكذلك المستشـرق (هورتن) أســتاذ فقـه اللغـات الســامية بجـامعـة بون الذي أدرك قــدرة المسلمين على التلاقح الفكــري والانفتــاح على حضــارات وثقافات الأمـم الأخـرى مع المقـدرة على إبقـاء تعـاليـم القـرآن الكريم والســنة مهيمنـة، قاضية حاكمــة على ذلك كله في نسـق معـرفي نـادر المثــال. يقـول في ذلك: « إن روح الإسـلام رحبـة فسيحة بحيث إنهـا لا تكـاد لا تعـرف الحدود، وقد تمثلت كـل مـا أمكنهـا الحصـول عليـه مـن أفكــار الأمـم المجــاورة، فيمــا عدا الأفكـار الملحـدة، ثـم أضفت عليهـا طـابع تطورهـا الخـاص[32]».
وبهـذا أصبح الفقــه من أعظـم العـلوم التى شـهـدت تضخمـاً هـائلاً في البحث والتقنين خلال القـرون الخيرية. وامتص الفقــه من الطاقـات الفكـرية ما بلغ بـه لتكوين مــا لا يقل عن تســع عشــرة مدرســة فقهيـة منذ حـوالى منتصف القرن الأول إلى أوائل القرن الرابـع الهجـرى[33].
يقـول المقدسـي (665هـ) في ذلك: « وكـانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهـدين، فكـل صنف على مــا رأى، وتعقب بعضهـم بعضـاً مســتمدين من الأصلين الكتـاب والسـنة وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفــة بغير هوى، ولم يـزال الأمـر على مــا وصفت إلى أن استقرت إذنه المدونة »[34].
بيـدَ أن ريـاح التغيير بدأت تهب على المجتمع المسـلم شيئاً فشيئـاً، ولعب الفتن والتقلبــات السيـاســية والتغـــيرات الاجتمـاعيــة دورهـا في فسـح المجـال أمام عدد من الأمـراض الاجتمـاعية والفكـرية في المجتمع. ومـال النـاس إلى الانصـراف التـام إلى الدنيـا والانشغـال الكـامل بلذاتهـا المادية، وتفننوا في ضـروب الاستمتـاع بهـا حتـى ســرت روح العبث والمجـون بين العـديد من أفـراد وطبقـات المجتمع.
وهـذه المرحـلة التى وصـل إليهـا المجتمع هـي التي أشــار إليهــا ابـن خلدون في مقدمتـــه وأطلق عليهــا مصطلح طور الفراغ والدعــة لتحصيل ثمــرات الملك ممـا تنزع طبــائع البشــر إليــه، فــإذا فســد الإنســان في قدرته على أخلاقـه ودينه فقـد فســدت إنســانيته وصـار مسـخـاً على الحقيقة[35].
وأســهمت الانشــطارات السـياسـية والجغرافيــة التى بعثــرت دولــة الخـلافـــة ونثرتهـا دويلات مجزئة، في تسـريع سـريان وتغلغل تلك الأدواء إلى المجتمع بشـــكل واسـع النطـاق.
كمــا ســاهمت حركــات الشــعوبية التى بـدأت بالتغلغل والانتشـار في العصـر العبـاســـي في ظهــور وتفــاقم مختلف الأمـراض الاجتمـاعية والفكـرية، حـاملـة معهـا مظـاهر من الانحســار الأخلاقي والزندقــــــة، المغـــــايرة لكــل القيّــم والســلوكيـات والمظـاهر الأخلاقيــة التى نشــأ المجتمع عليهــا[36].
وبرزت ردود الفعـل العنيفــة من قبل العلمـاء والعـامــة مـن النــاس تجــاه تلك المظــاهر والمؤشــرات الواضحـــة على الفســاد الأخلاقى في المجتمع، تجسـدت في عـدد من مواقـف المواجهــة بين العلمــاء وأصحـاب السـلطة والحكـام.
فحــارب عـدد مـن اللمــاء تلك المظـاهر محـاربـة عنيفـة، تظهـر جليـة في كتاباتهـم المتعـددة حول مظـاهر اجتمـاعية وأمـراض فكريــة ونزعــات شـكية، مـا عرفهـا المجتمع المســلم من ذي قبل، إلا أنهـا كـانت صديات تفـاعل مع واقعهـم آنـذاك، ومـرآة صـادقــة تعكــس حجـم التحـديات التى تصـدوا لمواجهتهـا[37].
وتضــافرت تلك العـوامل قاطبــة لتنعكــس أثـارهــا الســلبيـة على أجـواء الحركــة العلميــة والثقافيـة، محدثــة هوة سـحيقة ازدادت بمــرور الأيـام وتعـافب الأجيـال، بين القيـادة السيـاسية والفكـرية في المجتمع المسلم. فسـرى الولوع بالنظـر التجريـدي والتـأملات العقليــة والقيـاس المنطقي، وأهملت المظـاهر العلميــة التى اتسمت بهـا العصـور السـالفة معلنة بداية الشــلل في الحياة العلميــة والاقتصـادية والاجتمـاعية على حـد سـواء. ووصلت المحنــة إلى أوجهـا بالاكتســاح المغـولى لبغداد وهـدم عـاصمة الخلافـة الإسـلامية عـام 656هـ.
وعلى الرغــم مـن بــروز عـدد مـن العقليــات الاجتهـاديــة في ثنايــا تلك العصــور والمحن، والتـى رفضت العكـوف على التقليــد والاســتمرار في عمليــات الاجــترار الفكـري، إلا أنهــا آثـاراً ذائبـة في نسيج التقليد الهـائل.
وتضــافرت تلك العـوامــل لتتمخض عن عقليــة منكفئــة على الذات، تروم الاحتمــاء وراء جـدران التقليد لتُبقى على البقيـة الباقيـة مـن تراثهـا المهـدد بالتـآكل ومحـو الهويــة. واتخـذت العقليـة المســلمـة طريـق الاسـتصحـاب والتكـرار لمختلف الموضـوعـات والمسـائل التى تنـاولهـا العلمـاء الســابقون، فـأُبعـدت عن الواقع وبـدأت التحـرك ضمـن فضـاء التنظـير والتجـريد والفرضيـات.
ولعـبت العـوامـل السـياســية والاجتمـاعيــة والفكـرية الآنفــة الذكــر، دورهـا في تعزيز النفسية القابلة للانكفــاء على القـديم، فاشــرأبت رءوس عقليـات خالفت النهج الاجتهـادي وانحـرفت عنه، ورأت في محض التقليد، نهجـاً جديراً بالاتبــاع، حتـى غـدا التقليــد والتعصب ديدنـاً للكثـيرين، وأصبح ظـاهرة تحدث عـن خطبهـا العـــلماء، وصـارع آفاتهـا العقلاء[38].
ويذهـب لفيف مـن العلمـاء إلى أن بدعــة التقليد حدثت في القـرن الرابع الهجـرى على وجـه التعيين، وهو ذات الوقت الذي أعلن فيـه بعض العلمـاء سـد باب الاجتهـاد[39].
يقـول الصنعـاني (1182هــ) رحمـه الله في كتابـه « إرشـد النقــاد إلى تيســير الاجتـهـاد»:
« كـان الفقــه الإســلامي في القرون المشهـود لهـا بالخير في ازدهـار مستمـر ونمـو متواصل وتقـدم دائم وكـانت اجتهـادات الأئمــة بين الأخـذ والعطـاء والرّد والقبول حتى في أوســاط أصحـابهـم إلى أن فشــا التقليـد في نصـف القـرن الرابــع، وبـدأ التعصب المذهبي يبيض ويفرخ، ولم يأت قرن بعـد ذلك إلا وهـو أكثـر فتنـه وأوفـر تقليـداً وأشـد انتزاعـاً للأمانة من صـدور الرجــال حتــى اطمــأنوا بـترك الخوض في أمـر الدين، وبأن يقولـوا: إنـأ وجـدنـا آباءنـا على أمـة وإنـا على أثـارهـم مقتدون »[40].
وقـد اســتمرت ظــاهرة التقليـد بكـل تداعياتهـا الســـلبية على مـدى قرون طويلة، ولا تـزال العقليـة المســلمـة تعـاني مـن أشــكـال التبعيــة والتقليـد إلى يومنـا هـذا، وإن بدا حمود جــذوة تلك الظــاهرة مـن وقـت لآخـــر، وتبــاينت تداعيـاتهــا ومسـبباتهـا[41].
وتحــدث عـدد من العلمــاء والمؤرخيـن في كتاباتهـم عن الآفــات التى تعـرضت لهــا الأمــة من جــراء التقليـد والتعصب، وحفظـت كتـب التــاريخ والــتراجـم[42] العـديـد من الفـتن والمحن، وبلغ التعصب حـدّ القتل والتخريب والنهب والسلب بين أتبــاع المذهب المتعصـبين لأقوال مذاهبهـم وأئمتهـا.
يقـول الصنعـاني رحمـه الله في ذلك: « من المؤسف المحـزن المخزى أن الجذوة التقليديـة الجــائرة لم تخمــد حتى الآن في أوســاط أتبـاع إذنـه في كثـير من البلدان ولو كــان الأمـر بأيديهـم لأخـذوا الجزيـة مـن أتبــاع إذنه الأخـرى، كمـا قـال محمد بـن موسـى البلاســاغوني المبتـدع قاضـى دمشق المتوفى 506هـ، لو كـان لي أمـر لأخذت الجزيــة من الشــافعية. يتقطع القلب حـزنـاً وأسسـى على رضـاهم عن تلك الداهيـة الدهيـاء والمصيبـة الصمـاء التى شتت شمـل الأمــة أسـوأ تشتيت في المـاضى وتمزقهــا في المســـتقبل شــر ممزق »[43].
وهـكـذا ورثت المجتمعــات المســلمة على اختلاف أزمنتهـا وحقبهـا التاريخية موروثـات التقليد وآفـاتــه إلى جـانب مخلفــات العصــور التى مـرّت بهــا بكـل معـاناتهـا وإفرازاتهـا السياسـية الفكـرية وتراكمـاتهــا المتدهورة، فســاد الجمـود الفكـري والركود وشــاع لبوس التقليد والتعصب.
وبـات التقليـد وهو مـن أخطـر البدع، منهجــاً ســائداً وتيــاراً مألوفــاً غالبــاً[44].
فعكـف الفقهــاء على التلفيق والتجمـع ولم تخـرج جـلّ محــاولاتهـم عـن مســار التقليــد والركـود الفكــري. وأصبحت التراكمــات الظـرفية والتاريخية والسياسيـة صَدَفـــة متحجــرة تحجـب جـوهـر الدين وتعـاليمـه النقيـة.
دواعـي التقليـد الاجتمـاعيـة
لم تنفـرد عـوامـل محـددة في تشــكيل وتكـريس ظــلهرة التقليــد، بـل تضـافرت العـديـد منهــا في صيـاغـة تلك الظـاهرة وانتشــار آفاتهـا. وتعـد العوامـل الاجتمـاعية من أولى وأهــم تلك الدواعـي لظــور التقليد وانتشـاره.
فالبنيـة الاجتماعيـة تُعـد المحضن الأول والأهـم للشخصيـة الفرديـة. فمهمـا تكن ألمعيـة الشـخصية وعبقريتهـا العقليـة، إلا أنهـا تبقى ضمن إطـار بنيـة المجتمع. ولا يعنــى ذلك التقليل من قيمـة الدور الذي يلعبـــه الأفـراد مـن المجتهـدين والأئمــة والشخصيـات الكـبرى في تـاريخ، ولكن ذلك كلـه يبقـى ضمن البنيـة الاجتمـاعية. كمــا أن ذلك لا يعــنى أن المجتمع يمتص الفـرد كليـة ويحـدد سـلوكـه بفـرض قوة الإلزام للمجتمـع، فالإنسـان هـو الكـائن الحي الوحـيد الـذي يتـأثر ويؤثر اجتمـاعيَّـا في الوقت ذاتــه[45]. وتأثــير الوســط الاجتمـــاعي والبيئــة علـى الأفـراد أمـر معـلوم، فــالأفراد على وجـه العمـوم مـادة قابلة للتشكل حسـب الأوضــاع السـائدة في كـل مجتمع.
ويجمـع علمــاء النفـس والاجتمــاع على أن الكــائن البشــرى مدنــي بطبعـه، أي خـاضع للتأثير العـام لجو المجتمـع، كمـا أنه في نزوع دائـم للاتصـال بالجمـاعـة بطبيعـة تكوينـــه لإشــباع الحـاجـات الفطـريـة الطبيعيـة التى جُبل عليهـا الإنســان[46].
ومن هنـا قـام علمــاء النفس بتفسـير ظـاهرة تولـد وانتشـار أبعــد الأســاطير والأقـاصيص عن الصـواب في الجـماعـات المختلفـة، فوجـدوا أن فرط اسـتعداد الفـرد للتلقن من مجتمعـه وبيئـته، وتأثره الشـديد بذلك التلقـى يكمـن وراء ذلك الانتشــار. فالحيـاة البشـــرية تقـوم علـى المحـاكـاة والتقليد، وبهـذا تســتمـر الأجيــال في كـل الأمـم، تتـوارث العقــائد والتصــورات والقيم والعـادات وأنمــا
التفكـير وصيغ الســلوك مهمـا بلغت من درجـة الخطـأ أو الصـواب، ومن هنـا كـان سلطـان التقاليـد على الجمـاعات لا ينكـر[47].
أمــا الإدراك الموضـوعـي فهـو حـالات استثنائيـة لا يصل إليهـا سوى عـدد محـدود جدًّا من النـاس، وهـؤلاء القلة هـم مصـدر التجـدد والتطور والارتقــاء والانبثــاق الحضــاري وبـدونهـم تبقى التقـاليـد الكليـة رازحـة وجـاثمة[48].
كمــا أن البنـى الاجتمـاعيــة غـالبــاً مـا تعطـى الشــعور بالولاء للأفكــار الأسبق والأول تســربـاً للعقـول والأذهــان من الناحيـة التاريخية. فـالعقل البشـرى قيـادة للأســبق مـن المعلومـات ويتشــكل بالانطباعـات الأولى غالبـاً.
وهـذا يفســر لنـا دوافع اســتمرارية التقليـد كمنهـج فكـرى لدى أفـراد المجتمع وتناقلــه جيـلا بعـد جيـل، رغــم كـل مـا يحملــه مت آفـات وأضرار لا تخفى.
وقد عبّر الغـزالي (505هـ) رحمـه الله عن هـذا الولاء للأسبق في سـياق حديثـه عن موانع العلم والحق بقولـه:
«.. المطيع الفـاهـر لشـهواته المتجـرالفكر في حقيقــة من الحقــائق قد لا ينكشـف لـه ذلك (أي الحـق) لكـونـه محجوباً عنه باعتقـاد سـبق إليه منذ الصبا على سـبيل التقليد والقبول بحسن الظن، فـإن ذلك يحـول بينـه وبين حقيقـة الحق، ويمنــع من أن ينكشـف في قلبه خلاف مـا تلقفـه مـن ظـاهر التقليد، وهـذا أيضـاً حجــاب عظـيم، بــه حجب أكثــر المتكلمين والمتعصبين للمـذاهب، بل أكثــر الصـــالحين المتفكـريــن في ملكــوت الســـماوات والأرض لأنهــم محجوبون باعتقـادات تقليـدية جمـدت في نفوسـهم ورسخت في قلوبهـم وصــارت حجـاباً بينهـم وبين درك الحقـائق »[49].
وتبقى المعلومـات الأسبق أكثـر سـيطـرة على العقـول، ومـا تتطلبـه لتخـرج من تلك العقـول زمنــاً طويلاً. وعلـى هـذا يُفســر تـأخر الجماعـات عن العلمـاء والفلاسـفة عـدة أجيـال في ميـدان الأفكـار[50].
يقـول بيــار مـانونـي في هـذا السياق: « الأحكــام المســبقـة والمقولبـات تتوسـط هي أيضـاً الحيـاة الاجتمـاعيـة، فكـلاهمـا تعابيـر عت أفكـار يقرّ بهـا الأفـراد انتمـاءهـم لرتبـة مــا وانتســابهـم الضمنى لأحكــام تجـرى في الجمــاعــة التى هـي مرجعهـم.. وهي تمثـل المحتـوى النفسـي التى يدين بهـا هـذا الفـرد لأفكــار الآخـرين والتى غالبـاً ما يرثهـا رغمـاً عنه »[51]. ويؤكـد مانونـى أن المعلومـات والأحكـام المسبقـة أو المقولبات تقـوم مقــام اسمنـت اجتمـاعي يحـول دون التوصـل إلى الجديـد الـذي قـد يحمـل في ثنايــاه الكثــير من الصحــة والصـواب والعقلانيـة.
والفــرد يكتســب في الجمــاعــة بفعــل العـدد الشــعور بالقـدرة على الإقـدام على ســلوكيات لم يكن ليفعلهــا وهو منفرد. وذلك مـن حيث زوال الشـــعور بالمســئولية الذي يرد جمــاح الأفـراد على الدوام.
ويوضـح هـذا المعنى لفيلســـوف عوسـتاف لوبون حيث يقـول: « إن أبرز أمـر في الجمــاعة النفســية هو أن الأفـراد الـذين تتألف منهـم، مهمـا تمــاثلوا أو اختلفــوا في طـراز حيــاتهـم وأعمـالهـم وأخلاقهــم وعقولهـم، هو أنهـم إذا مـا تحولوا إلى جمـاعــة، منحتهـم هـذه الجمـاعـة ضـرباً من الروح الجـامعة، وهـذه الـروح الجـامعــة تجعلهــم يشــعرون ويفكـرون ويسيرون على وجـه يخـالف مـا يشعر بـه ويفكــر فيــه ويســير عليــه كـل واحـد منهـم وهو منفـرد… »[52]
فالجمــاعــة لا تســأل عن أفعالهـا لشـيوعهـا بين جميع الأفـراد، فـلا يشعـر الواحـد منهـم بمـا قـد يجـرّه العمل عليـه من التبعـة، وهذا هو الزاجـر للنفوس عمـا لا ينبغـي[53]. فلـو كـان الفـرد بمعـزل عن جمـاعتـه في اتخـاذ موقف معـين، لراجع نفســه فيمــا يفعـل ولأحجـم بشـدة عمـا يفعلــة وهو منســاق مع التيــار العـام، ومرجع ذلك كلـه ضعف شــعور لبفـرد بمســئوليته، فهو فـرد في جمـع حـاشـد من النـاس[54].
وعلى هـذا يتولـد الشـعور بالتخوف لـدى الأفـراد من الخـروج علـى هـذا التيار العــام أو مواجهتــه، ومــا يتبع ذلك من تألب العـامة. وقـد أسهـم هـذا الشـعور في خلق حـالة من الذعـر في نفوس من يحـاول التصــدى لتيــار التقليـد الســائد، ذلك الخـوف الذي حـدا بالكثـيرين مـن أئمـة المذاهـب المجتهـديـن إلى الســكوت على نســبتهم إلى مذهب من المذاهـب، على الرغـم مـن أنهـم كــانوا مجتهـدين لا مقلدين، ومــا ذلك إلا بسـبب ازديـاد الضغط النفســي الآتـي من قبل العـوام عليهـم.
ويعّبر القنوجـي (1307هـ) عن تلك الحالة بقولـه:
« وقـد تعصـب أصحــاب الطبقـات المذهبيــة في تعـداد أهـل نحلتهـم، حيث أدخلوا فيهـا من ليس منهـم، وغالب أئمة المـذاهب ليسـوا بمقلدين وإن انتســبوا إلى بعضـهم بـل هـم مجتهـدون مختــارون لهـم أحسـن الأقــوال وأحـق الأحكــام وبعـد النظـر والاجتهـاد، فعـدّهـم في زمـرة المقـلدة بأدنى شـركـة في العلم ليس من الإنصـاف في شــيء، وإنمــا خــافوا فتنــة العـوام في ادعــاء الاجتهــاد أو عــدم الاعتــداد بــالتقليـد، فصــبروا على نســـبتهـم إلى مذهب من تلك المذاهب »[55].
وقـد عبّـر الشــوكاني رحمـه الله عن تلك الحـالـة الرهيبـة من الخوف والذعـر، الذي يلحق بمن حـاول الخـروج على تيـار التقليد الســائد بقولــه: « وأمــا في هـذه الأزمنـة فقـد أدركنـا منهـم من هو أشــد تعصبـاً من غــيرهم، فــإنهـم إذا سمعـوا برجـل يدعى الاجتهـاد ويـأخذ دينـه من كتـاب الله وسنة رسـوله ـــ صّلى الله عليــه وسلم ـــ قامـوا عليه قيـامـاً تبكـى عليـه عيـون الإســـلام، واستحلوا منه مـا لا يستحلونـه مـن أهـل الذمـــة مـن الطعـن واللعن والتفســيق والتنكـير والهجـم عليــه إلى دياره، ورجمـه بالأحجــار والاستظهـار، وتهتك حرمته، وتعلـم يقينـاً لولا ضبطهـم ســوط هيبـة الخلافة أعــز الله أركــانهــا وشيـد سلطـانهـا لاستحلوا إراقـة دمـاء العلمـاء المنتمين إلى الكتـاب والسنـة وفعلوا بهـم مـا لا يفعلونـه بأهل الذمـة، وقـد شــاهدنـا من هـذا ما لا يتسع المقـام لبسطـه »[56].
وهـذا الداعـى يفســر المواقف التى تعـرض لهـا عـدد من العلمــاء وصلت حدّ الإهـانــة والتنكيــل من قبــل العـوام. ولم يكن ثمة سبب وراء ذلك كلـه إلا خـروج هؤلاء العلمــاء على سـيل التقليد الجـارف ومنحــاه العـام الغـالب. ولم تقف معـاناة المجتهدين عند العـوام فحسب، بل جـاءت مـن قبل بعض العلمــاء في عصورهـم ممن ارتأوا منهج التقليد وســاروا عليـه.
ويُرى ذلك واضحـاً في تراجـم العلمـاء المجتهديـن وأقـوال خصومهــم فيهــم ممن عــاصروهم أو ممن جــاءوا بعـدهـم، ولم يكن لهؤلاء من جـريرة إلا الاجتهـاد والدعـوة إليــه ومخـالفــة النهـج التقليدي السـائد[57].
يقــول الأســــتاذ مدكــور في هـذا الســياق: « تهيب العلمــاء نقـد زملائهـم نتيجــة الضعف الخلقي، فكــان إذا طـرق أحـدهـم بـاب الاجتهـاد انقضـوا عليــه، وهـاجمه فريق من هؤلاء إمـا بدافع الحمية الدينيــة المتوهمــة وإمــا بدافع الغــيرة والحقـد »[58].
وعلـى هـذا لم يتمـكن كثــير من المصلحيـن والدعـاة والعلمـاء مـن الخـروج عن إطـار عصـرهـم، سـواء في التصور أو المنهـج أو فيهمـا معـاً. فركنـوا إلى التوافق الاجتمـاعي بدل تغيـير مـا ينبغـي تغيـيره مـن الأفكـار والعـادات المخـالفـة للدين والمنـاهج المضـادة للفكـر السـليم. وقليـل منهـم مـن تكون لـه الشجـاعة الكـافيـة لتحـدي العقبـات التـى تعترضــه خـارجـاً عن الإلف والعــادة ومســايرة الرأي العـام[59].
ومـن الأســباب التى أسـهمت في تكـريس ظـــاهرة التقليــد في المجتمـع كذلك، تأثـير الشــعور الجمــاعي العميق على قيـام الأفـراد بممـارســات وسـلوكيـات قـد لا يُقـدمــون عليهــا بمفــردهــم. وقـد تصـل هـذه الحــالات عنفوانهــا وحـدّتهـا البعيــدة لدرجـــة يطلق عليهــا علمــاء النفس: هســتيريـا الشـعور الجمــاعي. وهـو نـوع من الهـوس بالمشــاركـة الجمــاعيــة تنتعش من خلاله بواطن النفس فتتشـكل في نوع من ردود الأفعـال غير المضبطـة. وبـذلك تبقـى أفكــار الجمــاعـة وآراؤهــا العــامــة بعيدة عـن رقـابــة العقـل محتميــة بالألفــة والتكـرار، في منــأى عن التحليل والمـراجعــة. وعلـى هذا بقيت ظــاهرة التقليد بعيـداً عن المراجعـة والنقـد، بعـد أن باتت ظـاهرة جمـاعيـة وتيـاراً سـائـداً مألوفـاً.
فالمجتمعــات البشــرية تبقـى مستمســكة بمـا ورثته مـن عـادات ومظـاهر ومـا اعتـادته مـن اهتمـامـات ومـا درجت عليــه من اتجاهـات.. فالتخلى عـن المألوف يشبـه في عســره محـاولة اقتلاع جبل مـن مكـانه، حتـى ولو كـان هـذا المـألوف هو مصـدر الشقـاء. وهـذا أمـر تؤكــده وقــائع التـاريخ التى لا تحصـى، فلـم يحصـل أي انتقـال من مـرحلـة حضـاريـة دنيـا إلى مـرحلـة أعلـى إلا كـان مصحـوبــاً بمخـاضــات عســيرة متصـلة، وتشـهـد لذلك قصص الأنبيـاء عليهـم السلام مع أقوامهـم..
وعلى هـذا يقول ابـن القيـم معبّراً عن حــالة التقليــد الســائدة في عصـره: «.. المتمســك عندهــم بالكتــاب والســنة صــاحب ظـواهـر، مبخـوس حظــه من المعقــول، والمقلــد لــــلآراء المتنـاقضـــة المتعـارضــة والأفكــار المتهـافتــة لديهــم هو الفاضـل المقبـول، وأهل الكتــاب والســنة المقـدمون لنصوصهــا على غيرهــا جهــال لديهـم منقوصـون »[60].
دواعـي التقـليـد الفكـرية
إن قـدرة العقـليــة الإنســانيـة على الإنتــاج والإبداع قــدرة كبـيرة هـائلــة، ولكـن هـذه القـدرة أرادت لهــا تعــاليم القرآن الكـريم أن تكون مشـاعة وليست قصـراً على نخب علمية وعقليـات عبقـرية عـرفهـا التـاريخ. مـن هنــا كـانت القرون الخيـريـة الأولى من تـاريخ الإسـلام، مـرآة صـادقــة وانعكـاســـاً أمينـاً لتلك التعــاليــم القرآنيـة والإرشــادات النبويـة. فأسهمت أجــواء تلك القــرون في تحفيـز النشــاط العقلي والعلمـي ومحـاصرة الجهـل بمختلف أنمـاطـه وأشكـاله. وشـهـدت تلك المرحـلة في التـاريخ إبـداعـات متنـاهيــة وخـبرات هـائلة في مختلف الميـادين وفي سـائر العلوم والمعـارف الإنســانيـة، تنـمّ عن قـدرة الأمـة يأســرهـا على العطــاء والتنميـة والإضـافة الحضــارية المتمــيزة وتقـديـم الجـديد في مختلف مسـافات الحياة.
ولعـلّ المؤلفـات الضخمــة التى خلّفهـا العلمــاء في تلك العصــور في ســائر العلـوم والمعـارف، خير شـاهـد ومؤشـر على تلك القــدرات الهـائلـة التـى أنتجتهـا الأمــة في تلك العصـور. فقـد نزل الفقـه إلى ميـدان الحيــاة فصــال وجـال وأضــاف وأعطـى، وقـام بتشـكيل مفـردات الحيــاة الإســلامية في المجتمـع وأنـزل مطـالب الشــريعـة إلى قلب الواقع وأعـاد صيـاغتهـا وفق مقـاصـد الشــرع وتعـاليمــه، ومنح للحضــارة الإســلامية القـدرة على التواصـل والتجـدد والعطـاء.
فكــانت المؤلفــات والمصنفــات الضخمــة تعكس تفــاعل العلمــاء الســابقين رحمهـم الله مع واقع عصـورهــم وأزمنتهـم وقضـايا مجتمعـاتهم. وأسهمت الأجواء المواتيــة ــ كمــا أشــرنـا إليهــا ســابقـاً ــ في صياغة وتكـريس تلك المنهجية وتنفيذهـا، وانعكست حسن ملكـات السـابقين في التعليـم والصنــائع وســائر الأحوال على مؤلفـاتهـم المنّمــة عن ذكــاء متقـد وفكــر رصين زاجتهــاد أصيل في نســق معـرفي متكـامل الجوانب.
وورثت الأجيــال اللاحقــة تلك المؤلفــات والمصنفــات المختلفــة، فعكفت على دراســتهـا وتحصيلهــا، وعــاينت من خلال ذلك كله، قـدرات السـابقين الهـائلة في التعـايش والتجـاوب مع واقعهـم، حتى ظـن اللاحقون أن ذلـك تفــاوت في الحقيقــة الإنســـانية بينهـم وبين الســابقين[61].
وقــد تم التعبــير عـن توهــم ذلك التفــاوت بصـور مختلفــة، لعــلّ أبرازهـا القـول بـالعجز عن الاجتهـاد. وتوجهت الهـمم إلى فهــم مــا أُثـر عـن العلمــاء الســابقين من النصوص والقواعـد في مجـل الأحكــام، وانصــراف الاهتمــام إلى اســتظهـار وحفظ تلك المصنفـات والتعليقـات؛ فـأنحصـر الحـوار مـع تلك المصنفــات والمؤلفــات المـدّونــة، دون محــاولة قـراءتهــا من خـلال فتـح سـبل الحوار والنقـاش حـول مـا ورد فيهـا، أو القيــام بمـراجعتهــا في ضـوء التغــيرات الحـاصلة والمستجـدات المتزايدة في المســأل والأحكــام.
وأســهمت طبيعــة الأجــواء العـامــة والظــروف السياســية والاجتمــاعيــة في تكـريس ذلك كلــه، من خـلال القيـام بمحـاولاتهـم تكميم الأفواه وغلق أسـاليب الحوار والمنـاظرة على نقيض مـا شـهدته القـرون الخيـرية السـابقة.
ولا يخفــى أثـر المحــاورة والمنــاظرة العلميـة الهـادفة المتسمـة بمواصفـات الحوار الإســلامي الهـادئ، في تحفـيز ملكـة لعلم والتعلم وشــخذهـا وتمرينهــا. ويُعـد فتق اللســان بالمحـاورة والمنــاظرة في المســائل العلميــة، مـن أيسـر طرق تحصـيل ملكـة العلـم والتعلم، فهو الـذي يقـرب شــأنهـا ويحصـل مرامهـا. ومن هنـا فقـد غلب على مجـالس العلم والتعليـم في تلك العصـور على كثـرتهـا وتنوعهـا، الـتزام الصمت والابتعـاد عن المحـاورة وإلغـاء نهـج المنـاظـرة العلميـة.
يقــول ابن خـلدون في توصيـف تلك الحـالــة وآثارهــا على عقليـــة الإنســان وقابليته للتعلم:
« تجـد طـالب العلـم منهـم وقـد ذهبت أعمــارهـم في ملازمــة المجــالس العلميــة، ســـكوتـاً لا ينطقـون ولا يفــاوضون، وعنــايتهـم بالحفـظ أكثــر من الحاجـة فلا يحصلون علـى طـائل من ملكـة التصـرف في العلـم والتعليم ثم بعـد تحصيل من يـرى منهـم أنـه قـد حصـل، تجـد ملكتـه قـاصرة في علمـه إن فاوض أو نـاظـر أو علم، ومـا أتــاهـم القصــور إلا مـن قبــل التعليــم وانقطـاع ســنده، وإلا فحفظهـم أبلغ من حفظ ســواهـم لشـدة عنـايتهم به، وظنهـم أنه المقصــود من الملكــة العلميــة وليس كذلك »[62].
وممـا تجـدر الإشــارة إليـه في هـذا الصـدد أهميـة التمييز والتفرقـة بين الحوار العلمـي الهـادف الذي تمــيزت به العصـور الخيرية الســالفة، وبـين الجـدل والخــلاف الذي نشـأ وانتشــر في العصـور اللاحقـة. فلم تكن الأخيــرة بقصـد إظهـار الحق أو اتبـاعه، بل للاستـطالة ونيل الحظوة أمـام الحكـام والـوزراء، فكـانت المجــالس تُعقـد لذلـك أمــام الوزراء والحكــام بقصد التغـالب والتفـاخـر، كمـا بسـط حالهـم الغــزالي رحمــه الله في آفــات الجـل والمناظـرة[63].
وفي حديث ابـن خـلدون إشــارة إلى أن الــتركيز على القـدرة على الحفظ والاستظهـار دون محـاولة الاهتمـام بتنمية بــاقي القـدرات العقليـــة التى زوّد الله سبحـانه بهـا الإنســان، أمـر لـه من الآثار السلبيـة الكثــير الكثـير. فقـد تكون لدى الإنســان القـدرة على حزن المعلومــات واســترجـاعهـا، ولا تكون لديــه القـدرة على تحليلهـا أو فهمهـا أو تقويمهـا.
وعلى هـذا فقـد شهـدت تلك العصـور بدء العنـاية بالســرد والروايــة من قبل المعلّمــين والوقــوف عنــد الحفــظ والاستظهـار مـن قبل الدارسين في مختلف الميــادين وخـاصــة ميـدان الفــه والعلـوم الشــرعية. وقـد صـاحب ذلك، كثــرة المؤلفـات والمصنفــات، كمــا أشــار إلى ذلك ابن خلدون بقـولـه: « اعلـم أنـه ممـا أصر بالنــاس في تحصيل العلــم والوقوف على غاياتــه، كثـرة التــآليف واختلاف الاصطـلاحــات في التعليم وتعـدد طرقهـا، ثــم مطـالبــة المتعلــم والتلمــيذ باســتحضـار ذلك، وحينئـذ يســـلم لــه منصب التحصيـل. فيحتــاج المتعلـم إلى حفظهـا كلهـا أو أكثـرهـا ومـراعـاة طـرقهـا ولا يفى عمـره بمــا كُتـب في صنـاعــة واحـدة إذا تجـرد لهـا، فيقـع القصـور، ولابد دون رتبـة التحصـيل. ويمثـل ذلك من شأنه الفقـه في المذهب المالكـي بالكتب المدونـة مثلاً ومـا كُتب عليهـا مـن الـشـروحـات الفقهية »[64].
وهـكذا انصـرف الاهتمــام في التعليــم إلى الحفـظ والاســتظهـار دون محـاولـة التعمق أو التحليـل والفهـم لمـا جـاء فيهـا، ومن ثـم محــاولة القيـام بقـراءة نقـدية لهـا.
ولا يخفـى أن الاهتمـام بقــدرة عقليــة معينــة وتنميتهـا والتركــيز عليهــا مع إهمــال الإنســان للقـدرات الأخـرى، يُعــد مـن أهـم عـوامــل ضمـور تلك القـدرات، خـاصــة عنـد انعـدام استعمـال تلك القوى.
وســاد الركـود والجمــود على أقـوال الســابقين وآرائهـم، ولم يعـد للفقـه أثره الســابق في صيـاغــة الحيــاة والتنـاغم مع مسـتجداتهـا ومعـالجــة مشــاكلهـا وتقـديم الحلول الناجعـة لهــا، فغـابت القـدرة على الاجتهـاد والتفـاعل مع مسـتجدات الحياة وتنظيمهـا وفق منهج الكتـاب والسـنة.
ويـرجع ذلك كلــه إلى غلبــة تيـار التقليـد على عــامــة العلمــاء، والتعصب للمذاهب السـائدة في كـل منطقــة أو بيئـة. فأغلب الفقهـاء يتقيـدون بمـذهب إمـامهـم لا يكــادون يخــرجــون عنــه حتى في فـروعــه. وغـاية جهـدهـم التحقيق في الأقـوال الراجحــة في المذاهب دون الخـروج على رأى إمــامهــم أو أقوالــه، لاعتقــادهـم بـأن إمـامـهم يوافقـه الصـواب مطلقـاً. وعلى هـذا حرّموا الاجتهـاد عـن ســواهـم بحجــة عـدم التـمكن من الوصـول إلى مـرتبـــة المجتهـديـن مطـلقـاً. فكـان الاجتهـاد المطلق الذي ينطلق من مصـادر التشــريع الأصليــة المتمثلـة في الكتـاب والسـنة دون التقيـد بمـذهب معـين، يكـاد يكـون منعـدمـاً.
زتمّ إنزال معطـيات العلمـاء السـابقين وأقوالهــم على واقـع الحيــاة لعصــور لم يشهـدوهـا، وعلى ظـروف ومتغـيرات لم يعـاينوهـا، دون إدراك لمــا وقع من تغـير في الأحـوال ومـا يمكـن أن ينجـم عن ذلك من مخـاطـر جمة.
يقـول ابن خلـدون في ذلك:
« القيــاس والمحــاكـاة للإنســان طبيعــة معـروفـة، ومن الغلط غـير مأمونة، تخـرجـه مـع الذهــول والغفلـة عـن قصـده، وتعـوج به عن مـرامـه، فربمـا يســمع السـامع كثيراً مـن أخبـار الماضين ولا يتفطن لمـا وقع من تغـير الأحــوال وانقـلابهـا فيجربهـا لأول وهلة على مـا عرف، ويقيسهــا بمـا شهـد، وقـد يكـون الفرق بينهمـا كثـيراً فيقع في مهـواة من الغلط »[65].
وفي ظـل تلـك الأجـواء الفكـريــة السـائدة، سـاد التقليـد ونمـا، وانحصـرت القـدرات العقليــة غـالبـاً في الاهتمـام بسيل من الحواشـى والذيـول والتهميشـات التـى لم يجـد أصحـابهـا في أنفسهــم القـدرة على تجـاوز معطيـات العلمــاء السـابقين رحمهـم الله[66].
وســاقت الحـالــة العـامــة العلمــاء إلى ضمـور العقليــة المسلمــة وعـودة الجهـل بصيغ وأنمـاط متعـددة، وتضــاءل دور العــلم والعلمــاء، وغلبهــم على دورهـم المقلدة. وتعـددت أنمـاط التقليد وأشكـاله من اختصــارات وشـروحـات وتهميشـات وحـواشـي وغيرهـا مـن أشكــال طغت على الحيـاة الفكــرية في العصـور المتأخرة وســــاقتهـا إلى مزيــد مـن الجمــود والتعصـب.
يقـول ابـن خلـدون في خطـورة وأثر الجمـود على الاختصــارات في التحصيل العلمي:
« كثــرة الاختصــارات المؤلفــة في العلوم مخلــة بــالتعليم، ذهب كثــير من المتأخرين إلى اختصـار الطرق والأنحـاء في العلوم يولعـون ويدونون منهـا برنامجـاً مختصـراً في كل علـم، يشتمـل على حصـر مســائله وأدلتهـا باختصـار في الألفــاظ وحشــو القليـل منهـا بالمعـاني الكثيرة من ذلك الفـن، وصـار ذلك مخـلاًّ بالبلاغـة، وعســراً على الفهـم، وربمــا عمـدوا إلى الكتب الأمهـات المطولـــة في الفنون للتفســير والبيـان فاختصـروهـا تقـريبـاً للحفـظ، كمــا فعلــه ابن الحــاجب في الفقـه، وابن مالك في العربيـة، والخونجـي في المنطق، وأمثـــالهم، وهـو فســاد في التعليـم وفيه ‘خلال بالتحصيل »[67].
ويؤكـد الحجـوى (1376هـ) كذلك على خطـورة الاختصــارات ودورهـا الهـائل في تكـريس ظـاهرة التقـليـد حيث يقول رحمــه الله: « تخــدرت الأنظــار بسـبب الاختصـار فترك النـاس النظـر في الكتــاب والســنة والأصـول وأقبلوا على حـلّ تلك الرمـوز التـى لا غـايـة لهـا ولا نهـاية، فضـاعت أيـام الفقهـاء في الشـروح ثم في التحشـيات والمبـاحث اللفظيـة، وتحمـل الفقهـاء آصــاراً وأثقــالاً.. وأحــاطت بعقولنــا قيـود فـوق قيـود، وآصـار فوق آصـار، فالقيـود الأولى التقيـد بـــالمذاهـب.. الثانيــة أطـواق التـآليف المختصــرة المعفــدة التـى لا تفهـم إلا بواســطة الشــروح.. وهـذا هو الإصر الذي لا انفكـاك له »[68].
وهكـذا تضــافرت تلـك العـوامـل والمؤثرات لتكـرّس الانشــغال بالمؤلفـات والكتـابات والآراء شــيئاً فشــيئاً حتى بـاتت الك الأقوال والآراء البشــرية مرجعيــة، تحتكـم إليهـا العقـول في كـل حـادثـة ونازلـــة، دون إدراك لطبيعــة الظـرفيــة والعـوامـل المقـارنــة لظهـور تلك الآراء والأقـوال على أقل تقـدير.
وقـد عبر عن ذلك ابن القيـم بقـوله: « أنزلــوا (أي الفقهــاء المتعصبـون للمذاهب) النصــوص (أي نصوص الكتـاب والسنـة) منـزلة الخلفيتة في هـذا الزمـان، اسمه على الســكة وفي الخطبـة فوق المنابر مرفوع، والحكـم النافـذ لغيره، فحكمــه غــير مقـبول ولا مسـموع »[69]. فنصــوص القــرآن الكـريم والســــنة الصحيحة لم تعـد المرجعيـة لهؤلاء إلا في المسميات فقط، أمـا الاحتكــام إليهـا أو الرجـوع والـنزوع إليهـا في كـل مســألة، فهذا أمـر ناقضتـه اتجـاهاتهـم ومناهجهـم العاكفـة على التقليد.
يقــول الحجـوى رحمــه الله في ذلك:
« أصبحت أقـوال هـؤلاء الأئمــة بمنزلــة نصـوص الكتـاب والسـنة لا يعدونهــا، وبذلك نشــأ ســدود بين الأمـة وبين نصـوص الشـريعـة ضخمت شيئاً فشيئاً إلى أن تنوســيت الســنة ووقـع البعـد من الكتـاب بازدياد تـأخر اللغـة، وأصبحت الشـريعـة هي نصوص الفقهـاء وأقوالهم لا أقـوال النبي الذي أرسـل إليهـم..»[70].
ولا يخفـى خطــورة قــراءة نصـوص الســابقين رحمهـم الله وآرائهــم دون إدراك لطبيعــة الظرفيـة المقـارنــة لهـا، في محـاولــة للوصـول ولـو إلى تصـور لمـراد المتكـلم ومقصـده مـن آرائــه وأحكـامـه ودوافـع ذلك، فالإحـاطــة بتصـور عن طبيعـة الظـرفيــة التي ظهـرت فيهـا تلك الآراء يسهـم في فهـم المـراد منهـا، وقـراءتهـا ضــمن تلك الأجــواء دون القفــز إلى تعميمهـا.
يقـول أبو عبد الله الحرانـي (695هـ) في هـذه المســـألة تحت بـاب عيـون التــاليف: « اعلـم أن أعـظـم المحـاذير في التــأليف التقلى إهمــال نقــل الألفــاظ بأعيانهــا والاكتفــاء بنقـل المعـاني مع قصـور التـأمل عن اسـتيعـاب مـراد المتكلـم الأول بلفظــه، وربمــا كـانت بقية الأسـباب متفزعـة عنــه؛ لأن القطــع بحصــول مـراد المتكلــم بكلامــه أو الكـاتب بكتابتــه مع ثقـة الراوى يتوقف عليــه انتفـاء الإضمـار والتخصيص والنسـخ والتقـديم والتأخير والاشتراك والتجوز.. »[71].
وبمـرور الزمـن وتعـاقب الأجيـال على تلك الممـارسـات، نزلت الآراء البشـرية المـدّونــة في الكتب، المرنهنــة بظــرفيتهـا، منـزلـة المرجعيـة المطلقــة التى لا ينبغـي أن تكــون إلا لنصــوص القــرآن الكـريــم والسنــة النبويـة. وهـذا مـا أشــار إليــه غير واحـد من العلمــاء المجتهـدين من أمثـال ابن القيـم والشـــوكـاني وغيرهمــا، ممت استشـرفوا مخـاطر التقليـد وآفاته في تحـوير المرجعيــة من القـرآن والســنة إلى أقـوال الأئمــة والعلمـاء.
يقــول ابو شــامة المقـدســي معبّراً عن تلك الحالة بقـولـه: « اشتهـرت إذنه (أي المذاهـب) الأربعـــة وهجــر غيرهــا، فقصـرت هـمم أتبــاعهـم إلا قليـلاً منهـم، فقلـدوا بعـدمـا كـان التقليـد لغـير الرسـل حـرامـاً، بـل صـارت أقـوال أئمتهـم عندهم بمنزلة الأصلين، وذلـك معنى قولـه تعالى: } اتَّخَــذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَــانَهُـمْ أَرْبَاباً مِنْ ذُونِ اللَّــــهِ { ] التوبـــة: 31 [، فعـدم المجتهـدون، وغلب المقلــدون، وكثــر التعصب… حتى آل بهـم التعصب إلى أن أحـدهــم إذا أورد عليــه شــئ من الكتاب والسنـة الثابتـة على خلاف يجتهـد في دفعــه بكل سـبيل مـن التآويل البعيـدة نضـرة لمذهبه ولقوله »[72].
ومـا تحدث عنـه المقـدسـي وغيره من العلمــاء رحمهـم الله يشــير إلى أهميــة التمييز والتفرقــة بين نصـوص العلمــاء وآرائهــم واجتهـــادتهـم في التوصـل إلى الفتــاوى والأحكــام المختلفـــة، وبين نصوص القـرآن الكـريم والسنة النبوية.
فــالأولى لا ينبغـي النـظـر إليهــا على اعتبــار أنهــا مسـتغرقة للمـاضى والحـاضر والمستقبـل لما في ذلك من الغلو في تقـدير مـا مضـى من اجتهـادات بشــرية والنظـر إليهـا بمنظــار التنزيه عن جـريان أي قصـور فيهـا. ذلك القصـور النـاجم عن بشـرية أصحابهــا ونســبية ومحـدوديـــة الآراء البشــرية المرتهنة بعـوامـل ظهـورهـا مهمـا علت منزلة أصحـابهـا رحمهـم الله.
فتقـديـر أقــوال العلمــاء الســابقين رحمهـم الله واحــترام مــا نركــوه ورائهـم مـن ثـروة معـرفية هـائلــة، لا ينبغي أن يســوق إلى القـول بإطلاقيتهـا ومفـارقتهـا للزمــان والمكــان. فتلك الإطلاقيــة لا تكون إلا لنصـوص الكتـاب والسـنة الصحيحة.
وقـد وصّف هـذه الحـالــة الفكـريــة الســائدة في تلك العصـور، الأســتاذ الخضرى بك حيث يقـول: «… روح التقليد سـرت سـرياناً عـاماًّ، واشترك فيهـا العلمــاء وغــيرهـم من الجمهـور، فبعـد أن كـان مريـد الفقــه يشـــغل أولاً بدراســة الكتاب وروايـة السنّة اللّذين همـا أسـاس الاستنبــاط، صــار في هـذا الدور يتلقى كتب إمـام معّين ويدرس طريقتـه التى استنبـط بهـا ما دوّنـه من الأحكـام، فإذا أتم ذلك صـار من العلمـاء الفقهـاء. ومنهـم من تعلو به همتـه فيؤلّف كتـاباً في أحكـام إمـامــه إمّـا اختصـاراً لمؤلف سـبق، أو شرحـاً لــه، أو جمعـاً لمـا تفرّق في كتب شتّى، ولا يستجيز الواحـد منهـم لنفسـه أن يقـول في مسـألة من المســائل قولاً يخـالف ما أفتى به إمـامـه، كأن الحقّ كلّه نـزل على لســان إمـامـه وقلبـه، حتّى قال طليعــة فقهــاء الحنفيـــة في هـذا الدور وإمـامهـم من غيـر منـازع، وهو أبو الحسن عبيـد الله الكرخي: « كـل آية تخـالف مـا عليـه أصحـابنـا فهي مؤولـة أو منسوخـة، وكـل حديث كذلك فهـو مـؤول أو منسوخ »[73].
ومـن أسبـاب الفكـريـة التى أسهمت في تكـريس ظـاهرة التقليـد كـذلك، مـا شــاع في تلك العصـور مـن القـول بخلو العصـر من المجتهــد المطـلق. وهـو قـول تناقله بعض الأصـوليين وناقشه الشوكـاني وفند النقـاط المثــارة في هذه المســألة في إرشـاد الفحول[74].
وقـد أنكـر الشـوكــاني رحمـه الله عليهـم هـذا القـول مؤكـداً أن المطـلع على أحـوال علمــاء الإســلام في كـل عصـر، لا يخفى عليـه وجـود عـدد من العلمـاء ممن جمع الله لهـم من العـلوم فوق مـا اعتـده أهل العلـم في الاجتهـاد، إضـافـة إلى أن الاجتهـاد قـد يســرّه االله للمتــأخرين تيســيراً لم يكن للســابقين، من حيث وجـود المصنفــات المدونــة بكثـرة في مختلـف العلـوم بمـا هـو زيــادة على مـا يحتــاج إليــه المجتهـد، في الوقـت الـذي كــان المتقـدمـون يرحـل الواحـد منهـم للحـديث الواحــد من قطـر إلى قطـر، فالاجتهـاد على المتـأخرين أيسـر وأسهـل من الاجتهـاد على المتقـدمين.
يقــول في ذلـك: « كــأن القـــائلين بجـواز خلـو عصـر عن مجتهـد قاســوا جميع علمـاء الأمـة على أنفسـهم وخيلوا لهـا أنه لا أحـد يبلغ أكثــر من مبلغـهم من العلم، ثـم رازوا أنفســهم فوجـدوهـا ســاقطـة في الدرك الأسـفل من التقليـد، فمنعـو فضـل الله تعـالى، وقـالوا: لا يمكـن وجـود مجتـهد في عصـرنا البتـة، بل غــلا أكــثرهـم فقـال: لا مجتـهد بعـد الأربعمائة من الهجـرة »[75].
وعلـى الرغـم مـن كثـرة إنشــاء المدارس ودور العلـم والمعـاهـد الدينيـة، خــاصة في القـرن الثــامن الهجـرى، ومحــاولــة بعض الســلاطين من الممـاليك وغـيرهـم، تقـريب العلمــاء ورفـع شــأنهـم واستشـارتهـم في كثــير مـن أمـور الدولـــة، وتعيينهـم في المنـاصب العلميــة في الجوامع والمدارس، وتنشـيط حـركـة التـأليف من جديد، إلا أن ذلك كلـه لم يغيّـر كثـيراً في سـير التقليـد وتيــاره الســائد. فقـد احتجبـت شمس الاجتهـاد رغـم انتعــاش حـركـة التـأليف والتدريس وبنـاء المـدارس والمعـاهـد[76].
دواعي التقليـد النفسـية
تقلبت النفســـية المســـلمة في أجـواء ومنـاخــات متعـددة بمـوجب العـوامـل السيـاسيـة والاجتمـاعيــة المختلفــة، ممـا أدى في نهـايـة الأمـر إلى ظـهور وبـروز النفســية القـابلـة منهجـاً، الرافضـة لمـا سواه مسـلكـاً.
ـــ ولعـل واحـداً مـن أهـم أســباب التقليـد ودواعيــه النفســية، عـدم معـرفـة المقـلد بـأنــه مقـلـد، وعـدم إدراكـه لطبيعـة التقـليد، وتوهمـه بأنه غـير واقـع في أسـره. وقـد صــور ذلك الغـزالي (505هـ) رحمه الله أبلغ تصـويـر في كتـابــه المنقـذ من الضـلال؛ حيث يقـول:
«.. لا مطـمع في الرجـوع إلى التقـليد بعـد مفـارقتــه، ومـن شــرط المقـلد أن لا يعلــم أنــه مقـلد، فإذا علــم ذلك انكســرت زجـاجـة تقليـده، وهـو شــعب لا يرأب وشعـب لا يلم بالتلفيق والتأليف، إلا أن بـذاب بالنــار ويســـتأنف لـه صنعـة أخـرى مستجـدة »[77].
فالمقلد حين يكتشـف طبيعـة التقليـد، ينفــك من أســره. ذاك أن اكتشــاف الإنســان لمـا يحملــه من داء، مـن أهـم وأولى الخطوات للتخلص منه بعـد إدراك خطـورتة وآفتـه. فالمقـلد بعـد أن يكشف طبيعـة التقـليـد يضطـر إلى أن يتخـلى عنــه فســراً، حتى لو أدرك التمســك به فلا يــستطيع أن يعــود إليــه، ولا أن يعتـمد عليـه، ويرفض عقلـه الركـون له، وتتأبى نفســه الاطمئنان إليــه.
وقـد أشــار إلى هـذا السبب المقـدسي (665هـ) في سيـاق حديثــه عن المقـلّدة فقــال: « ومـع هـذا يخيـل إليــه أنــه من رءوس العلمــاء وهو ثـم الله وعنـد علمــاء الدين من أجهـل الجهـال »[78].
ـــ ومـن العـوامـل النفســية لشــيوع التقليــد كذلـك، الشـعـور بـالعجـز عن الإبـداع والاجتهـاد. فشـعـور الإنســان بعجـزه وقصـوره يولد لدى المقلـد الشعور بأن التقـليـد، أمـر شـامـل لمحتلف أصناف البشــر، وعليــه فهـو يحكـم بالتقـليـد على عمـوم الخلق.
يقــول الشــوكـاني في ذلك: « إذا أمنـعت النظـر وجـدت هـؤلاء المنكـرين إنمـا أتـوا من قبل أنفسـهـم، فإنهـم لمـا عكفـوا على التقليـد واشتغلوا بغيـر علم الكتـاب والسـنة حكمـوا على غـيرهـم بمـا وقعـوا فيه، واسـتصعبوا ما سهـله الله على من رزقــه العلـم والفهـم وأفـاض على قلبــه أنواع علوم الكتـاب والسنة… »[79].
وهـذا مـا يُعـرف عند علمــاء النفس بالإسـقاط (Projecting) وهـو يتأتى إذا فعـل الإنســان شــيئاً يـدرك عـدم جـدواه أو صلاحيتـه، يذهب إلى تصور وإلصـاق مـا يشــعر بــه على الآخـريـن كنـوع من التخفيف عن ذاته[80].
وصـاحب ذلك الشـعور بفقـدان الثقـة بالذات والعجـز عن مواكبــة المستجدات، والتهيب مـن الاجتهـاد أو الإقبـال عليـه، ممــا نجــم عنــه إيثــار التقليــد على الاجتهـاد[81]. ورافـق ذلك كلــه ضعف الهمـة وقلـة الرغبـة الصـادقـة في العلـم. فقـد توفــرت للأفـراد في القـرن الرابع الهجـرى ومــا تـلاه مـن وســائل التدويـن وجمع الســنن والأحــاديث مــا لم يتوفــر لمـن سبقهـم، فكــان الأدعـى أن يكـون ذلك حـــافـزاً لمـزيـد من العمــل والاجتهــاد والإبـداع، إلا أن الأمـر جــاء على نقيض ذلك[82].
« إن الذي أدخـل كثــيراً مـن النـاس في التقليـد نقـص العقـول ودنــاءة الهـمم… فـــاقتصـروا على النقـل عمـن تقـدم فقط، وانصـرفت همتهم لشـرح كتب المتقـدمين وتفهمهــا واختصــارهــا.. وهـذا الذي أوجب الهـرم وافســد الفقــه بل العلـوم كلهـا… »[83].
ـــ ومن العــوامـل النفســية لتكــريس التقليــد كذلك، مـا وقع فيــه المقلـدة من تنزيــه العلمــاء عن النقــائص والأخطــاء، وأن مـا توصـلوا إليــه من إنجــازات هـائلة يعــود إلى طبيعتهــم الإنســانيــة، وأن ثمــة تفـاوتـاً في الطبيغـة بينهـم وبيـن أولئك العلمــاء لا يمكـن تجـاوزه، فقنعـوا بمــا هـم عليـه من التقليد وارتضـوه سبيـلاً.
وقـد تعـرض لهذه المســألة الشـوكـاني وعــاب على المقلديـن خـروجهــم على منطق الحيـاة وسـنن الكـون، فقـد ادعى المقلـدة أن الله قد رفع عنهـم مـا تفضـل به على من قبلهـم مـن الأئمــة مـن كمــال الفهــم وقــوة الإدراك والاســـتعداد للمعـارف[84].
يقــول في ذلــك: « وهـب لهـم (أي للمقلدين) الشــيطـان عصى يتوكئون عليهـا.. وذلك لأن أذهـانهـم قد تصـورت من يقتـدون بـه تصـوراً عظيمـاً بـسبب تقـدم العصـر وكثـرة الأتبــاع، ومـا علمـوا أن هـذا منقــوض عليهـم مدفوع بــه في وجوههـم… »[85].
وتعظـيم العلمـاء مـن الأمـور التى جبل عليهــا العـامــة فهــم يبــالغـون في تعظيم العلمــاء إلى حـد يقصــر عنــه الوصف، وربمــا ازدحمــوا عليهــم للتـــبرك بتقبيـل أطـرافهـم، ويســـتجدون منهــم الدعــاء’ ويقـرون بأنهـم حجـج الله على عبـاده في بلاده، ويطيعونهـم في كـل مـا يأمرونهـم بــه، ويبـذلون أنفســـهم وأموالهــم بين أيديهــم[86]. ويقـــول ابن الجـــوزى (597هـ) في ذلك: « عمـوم أصحــاب المذاهب يعظــم في قلوبهـم الشـــخص فيتبعون قولـه من غـير تدبر بمـا قال، وهـذا عـين الضـلال لأن النظــر ينبغـي أن يكـون إلى القـول لا إلى القائل… »[87].
وعلى هـذا لم يعتـد العـامـة باجتهـادات العلمــاء المعـاصرين نظـراً لثقتهـم المطـلقــة بالعلمــاء المتقـدمين، ممـا أسـهم في العجـز عن النظــر وقـراءة أقـوالهـم قـراءة نقـديـة، وكســرهمم العلمـاء المعـاصرين لهـم وعـدم تجـرئهـم على الخوض في المســائل الحـادثة لا من قبـل أنفســـهم ولا مـن قبل غيرهـم[88].
إن الوقــوف عند اجتهــادات العلمــاء الســابفين رحمهـم الله والنظـر إليهـا باعتبـار أنهــا مســــتغرقة للمــاضى والحــاضـر والمستقبل، يمكـن أن يسـوق إلى الغلو في تقـدير مـا مضـى من تراث الإســلام المتمثــل في آرائهــم واجتهــاداتهـم رحمهـم الله. ومـن ثـمّ النظــر إليهــا بمنظــار المثاليـــة والنزاهــة عن جريـان أي خلل أو قصـور عليهـا من غيـر إدراك لأبعــاد ذلك الغلو والتضخيـم، وجعلـه مثـالاً لا يمكن تنزيله أو تطبيقـه في الواقع المعـاش، ممـا يسـوق إلى جعلــه مشــروعـاً مفـارقـاً يســتحيل استعادته بجهـد البشـر.
ولا يعنــى ذلـك رفض المــوروث بـإطلاق مـن غـير تمييز بين ما يجب الإبقـاء عليــه ومـا يمكـن إســقاطـه مـن الاعتبـار. فالموروث الفقهي حصيلــة جهـود عظيمــة لعلمـاء شهـدت لهـم الأمـة بالفصـل والعلـم، ولكنهـا تبقى جهـوداً بشـرية نسبيـة مرتهنة بظــرفيــة نشــأتهـا، وعلى المجتهـد في كـل عصـر وزمـان احـترام ذلك الجهـد وتقـديره دون رفعــه إلى مصــاف الــذي لا يخضـع لسنـة التغير والتبدل.
دواعـي التقليـد السياسيـة
تلعب الظـروف السياســية دورهـا في ســير الحيــاة العلميــة والاجتمــاعية. فالمجتمعــات التي تشــهد نوعـاً من الاســتقرار السـياسي، تزدهـر فيهــا الحيــاة العلميـة والفكـريـة بشكل واضح.
وقـد كــان الفقــه هـو الميـدان الذي انعكسـت فيـه تلك التوجهـات وتلاقت فيـه مختلف التخصصـات. ومـن ذلك مـا ذكـره المستشــرق هملتـون جب: أن العمـل الفقهـي خـلال القـرون الثلاثــة الأولى استغرق الطـاقات الفكـرية لدى الأمــة الإسـلاميـة إلى حـدّ لا نظـير لـه، فكــان المساهمون فيــه من مختلف التخصصـات والاهتمـامات، وقلمـا تغلغل الشــرع في حيـاة أمـة وفي فكـرهـا التغلغل العمـيق مثلمــا فعـل في الأدوار الأولى من المدنية الإسـلامية[89].
لقـد كــان الفقــه في زمـن النبوة والصحـابــة وحتى بدايـات عهـد العصـر العبـاسـي، واقعيًّـا نظـريًّـا، فكــان النـاس يبحثـون عـن حكـم الحــوادث ويســـألون بعـد وقوعهـا أو يتقـاضون فيهـا، فتُعــالج بالحكــم الذي تقتضيه الشــريعــة ولم يكن هنـاك مجـال لفرضيــات أو تنظيـر بعيـد عن الواقع[90].
بيـد أن الظـروف السـياســية والفتن والاضطـرابات الناشئة عن الصـراع حـول الســـلطة، وضعف وانحــلال الســلطـة المركزيـة وضعف الشــعور بالانتمــاء إلى أمــة واحـدة، لعب دوره الواضـح في تكـرـس وتعزيــز عقليـــة التقليــد واستمراريتها، فالاجتهـاد عمـل موصـول بالتفــاعـل في مختلف المجــالات، متطلبـاً التداعي بـين الأفـراد والتواصـل بينهـم من جهــة وبينهـم وبين السـلطة من جهـة أخـرى.
وقـد شـهـدت العصـور اللاحقـة تخبطـاً واسعـاً في الإدارة السيـاسية بدأ يستشـرى ويتفـاقم، وضعفـاً في السلطــة المركـزية يزداد ويتـراكـم، والشعـوب بمعـزل عن هـذا كلـه أو بعضـه، تسمـع به وتشهـده، ولا فرق عندهـا بين غالب أو مغلـوب، ولا بين خلفيـة أو سـلطـان.
كمـا شهـد القـرن الرابع بدايـة ترنح إمــارات الأقــاليـم تحت وطــأة التنـافس والتقــاطع ولطمــات الـدس والكيـد والتنـاحـر على السلـطة والتآمـر والخيـانة بـين الحكــام أنفســهم أو بين الحكــام والولاة. كـل ذلك وغـيرة أسهـم في توتر العلاقـة بين الحكـام والرعيـة.
وكلمــا توترت تلـك العلاقــة، كلمــا تعثـر إنجــاز الشــريعة في مختلف ميـادين الحيـاة. إمــا تعطلاً عـن الوقـوع أصلاً أو قصــوراً عـن أداء الغــرض الاجتمــاعي المرجـو منهـا.
وقــامت تلـك الأجــواء السـياســية المضطـربة كذلك بمحـاولـة جــادة لتكسـير الأقـلام، وتقييـد الحريـات. فالكلمــة مرهونـة بتحمـل المســئولية من قبـل أنـاس على قـدر من الاحســاس بالوعى العـام لمـا يجــرى في مجتمعـــاتهـم فيكـونـون مـرآة صـادقـة لما يحدث في عصرهـم. وهـذا ليس ممكنـاً في ظـروف تنعـدم فيهـا الحـريـة أو تكــاد. ومـن كــان التقليـد قرين الاسـتبداد السياسي، وكـلاهمـا سبب ونتيجـة في الوقت ذاته للتخلف والإبداع الحضاري. فالنظـم السياسـية التي تصنع قـيوداً على التفكـير، تؤدى إلى الحـدّ من مجـالات التعبيـر والإبـداع والتجديد[91].
وعلى الرغـم من أن المجتمع المسلـم قـد شــهد ومنـذ فــترات مبكــرة، فصـامـاً واضحـاً بين العلمـاء وأصحـاب السـلطـة، إلا إنه ازداد وتفاقـم في العصـور اللاحقة. ممـا اضطـر العلمـاء والمجتهـدين إلى الانطواء والعـزلــة عـن الواقـع المشــوب بمظـاهـر مصــادرة الحـريــات وتضييق الخنــاق، خـاصـة بعـد أن نـال عـدداً من كبـارهـم وعلى رأســهم الأئمــة الأربعــة، التنكيل والإيذاء والإهـانـة بسـبب آراء اجتهـادية خــالفت المســار الذي تـرى الســلطة السـياسية ضـرورة استمـراره وتوطيده.
فقـد ضُـرب الإمـام مـالك (179هـ) حتى شُلت يـده لمـا جهـر بفتـوى بطلان طــلاق المكـره وعـدم جــوازه، وكــان الخلفاء العبـاســيون آنـذاك يـأخذون على رجـالات الأمـة أيمـان الطـاعة والبيعة معلقـة بطلاق نسـائهـم إن حنثـوا، فكـانت فتوى الإمـام مـالك في إحلال المكـره من يمينـه وأثــرة في طلاق النســاء يعني في حينــه دلالـة على الإحـلال من البيعة[92].
يقــول في ذلك الحجوي رحمــه الله (1376هـ): « امتحن سنة 147 في قولـه بعــدم لــزوم طــلاق المكــره وضـرب بالسياط، وانفكت ذراعـه، وبقى مـريضـاً بســلس البول إلى وفـاتــه، وهـي مســألة سياسيــة لأنهـا راجعـة إلى أيمـان البيعـة التى أحـدثوهــا، وكــانوا يكـرهـون النــاس على الحلـف بــالطلاق عنـد البيعـة، فـرأوا أن فتـوى مالك تنقـض البيعـة وتهـون الثورة عليهـم…[93].
واتـخـذ تدخـل الحكّــام في آراء العلمـاء وفتــاويهـم صــوراً متعـددة، تنــم عـن سيـاســتهم في تكميــم الأفـواه المعــارضــة لآرائهــم، ومن ذلك ما حـدث لابـن تيميـة رحمــه الله بسـبب آرائــه الاجتهـاديــة لدرجـة أنه حُبس عدة مـرات ووضع في قـاعة بالقلعـة في آخـر حياته، فبقـى بضعـة وعشــرين شــهراً، ومُنـع مـن الكتــابــة والمطـالعـة، ومـا تركـوا عنده ذلك كـراسـاً ولا دواة، وبقـى أشــهـراً على ذلك إلى أن تـوفي رحمــــه الله في القلعـــة عــام 723هـ[94].
ولم يكـن نصيـب تلميـذه ابـن القيـم رحمـه الله أقـل مـن ذلك، فقـد لقى في ســبيل حـريـة الرأى والجهـر بـالحق الذي يـراه، مــا لقــى شـــيخه من تعـذيـب واضطهــاد وسجن، واعتقـال مع شـيخه وأهيـن، وطيف به محمـولاً على جمل[95].
وانعكسـت تلك المواقف من العلمـاء على مســار الاجتهـاد ومـواكبـة احتياجـات الحيـاة المتجددة والواقـع. فانزوت العقليـة المسـلمـة في غالب الأحيـان، في أورقـة المســاجد وبين طيــات الكتب النظـرية والتـاريخيــة المعنيــة بالجـانب التوصيفي والتنظـيري، في محــاولــة للحيلولــة بين السـلطـان وأتبـاعـه من اسـتعمـال نصوص الكتـاب والسـنة لتـأصيل الانحـرافـات والممـارســات المخـالفــة للشــريعـة وأحكـامهـا.
وانكفـأ العلمــاء على مـا في أيديهـم بعيـداً عن معــترك الحيـاة وواقـع المجتمع[96]. ويعـبر الصنعـاني عن مخـاوف الفريقـين مـن العلمــاء والحكـام التي تجســدت في نهـاية الأمــر إلى القـول بســدّ بـاب الاجتهـاد. تلـك المخـاوف التي نجمت عن انفصــام القـائم بينهمـا. بقـولة:
« يتضـح جليًّــا بعــد إمعــان النظــر في هـذه الأســباب بـأن مخـاوف العلمــاء في اسـتمرار الاجتهـاد التقت مع رغبـة الحكـام والسـاســة على إغـلاق الاجتهــاد، وإن اختلفت المقـاصـد والأهـداف»[97].
فالقيــادة السـياســية حــاصرت اجتهـادات العلمــاء وآرائهـم، خوفـاً من تأثيـر تلـك الاجتهـادات والآراء والفتـاوى على زعزعـة سلطتهـم السياسيـة. وظهـرت تلـك المخـاوف فس سلســلة من إجراءات التنكيل وإيقـاع الأذى علـى العلمـاء، في محــاولــة لإخضــاعهـم لآراء الحكــام ورغبــاتهـم[98]. كمــا أن العلمــاء ازديدت مخــاوفهـم مـن تصــدى عـدد من غــير المؤهليـن للاجتهــاد للفتـوى وإصـدار الأحكــام المواتيـــة لرغــبات الحكــام ومتطلباتهـم[99].
وقـد ظهــر عــدد مـن المتزلفين للســلاطين والحكــام ممن لم يتهيبوا من إصـدار أي حكـم أو فتوى ينــالون من خلالهـا مآربهـم الشخصيـة.
يقـول الدهلـوى (1176هــ) رحمـه الله في ذلك « لمـا انقرض عهـد الخلفـاء الراشــدين المهـديين أفضت الخلافـة إلى قوم تولوهـا بغـير استحقـاق ولا استقلال بعلـم الفتــاوى والأحكــام فـاضطـروا إلى الاستعانة بالفقهــاء وإلى استصحابهـم في جميع أحوالهـم، وقـد كــان قـد بقـى من العلمـاء من هو مســتمـر على الطـراز الأول، ومـلازم صف الدين. فكــانوا إذا طلبوا هـربوا وأعـرضـوا، لـرأى أهـل تلك الإعصار عز العلمــاء وإقبـال الأئمــة عليهــم مع إعـراضهــم، فاشــرأبوا لطلب العلم توصـلاً إلى نيل العـز ودرك الجـاه، فأصبح الفقهـاء بعـد أن كــانوا مطلوبيـن طالبيـن، وبعـد أن كــانوا أعـزة بــالإعـراض عن السـلاطين أذلــة بالإقبــال عليهــم إلا من وفقه الله »[100].
وعلى هـذا قـال عـدد من العلمـاء بغلق بـاب الاجتهـاد لأســباب متعـددة منهـا خشــية تصـدى المـتزلفين للسلاطين والحكـام للفتوى وليسـوا أهـلاً لهـا[101]. وبهـذا اجتمعت الأهـداف المختلفـة على القـول بغلق الاجتهـاد وإعلان الاكتـفاء بمـا جــاء عن العلمــاء الســابقين رحمهـم الله.
وتعــاقبت الأجيــال وتوارثت تلك المؤلفـات التنظيريـة، متوهمـة أن العلمـاء الســابقين رحمهـم الله اختــاروا التنظـير مسلكـاً والتقليـد منهجـاً، دون ثمـة وقوف أو تأمل عميـق في طبيعـة الظـرفيـة التاريخيـة والاجتمــاعيــة والسياسـية التي أحـاطت بتلـك المؤلفـات، ودفعت بـأولئك العلمــاء إلى ذلك؛ ممـا نجـم عنــه الوقـوع في أزمــة النظـرة الأحـادية، التي لا ترى الصـورة إلا مجتزئة من واقعهـا الذي ظهـر فيه.
وهـكذا أسهـم داء الاستبداد السيـاسي في توطيـد التقليـد وتثبيـت جـذوره في العقلية المسلمــة على مرّ العصـور.
ومن هـوامـل تكـريس التقليـد السيـاسية كـذلـك، تبنى الدويـلات والسـلطــات المتعـاقبــة في مختلف مـراحلهـا، مـذهبـاً واحـداً من المذاهـب الفقهيـة وإلزام المجتمع باتبـاعه وتطبيق آرائـه، معلنـه غلق الباب أمــام الحـوار وتبــادل الآراء والمتنوعــة والأفكــار المختلفــة.
ولا تكــاد الأمم والشــعوب تتخلف عـن عـوائـد حكّـامهـا والقـائميـن عليهـا، رغـم كـل مـا يمكن أن تحملـه من مخـالفــة غـير مشــروعــة لعـوائد الأجيــال السـابقة والعصـور السـالفـة لهـا. وقد حدث التغير والانحـراف عـن نهـج العصـور الخيريــة الســـالفــة تدريجيًّــا حتـى أصبح البون شــاســعاً، فعـوائـد كـل جيل تابعـة لعـوائد سلطـانه كمـا يقــال في الأمثـال الحكيمــة: النـاس على دين الملك[102].
وقــام كـل حــاكم بالانتصــار لمذهب من المذاهـب، ممـا نجـم عنـه انقـراض كثـير من المذاهـب، كمـذهب سـفيان الثوري، وسـفيان بن عيينـة، وعبدالله بن مبـارك، وأبى عمـرو الاوزاعـــي، ومحمـد بـن عبـد الرحمـن بن أبي ليلي، وليـث بن سـعـد، وداود بن على، وأبى ثور، وابـن جرير الطبري وغيرهـم[103].
ومن العـوامـل السياسيـة التي أسهمت في تعـزيز ظـاهرة التقـليـد كـذلك، تــأثر القضـاء بالسياسـة في القـرن الرابع الهجري ومـا تلاه. فــأصبح الخلفــاء يتدخلون في القضـاء، حتى حملـوا القضـاء في كثير من الأحيـان على السير وفق رغباتهـم. وعلى هـذا اعتذر كثــير من العلمــاء عـن قبول منصب القضــاء خشـية تدخـل الخلفـاء في أحكـامهـم القضـائية.
وكـانت الدولـة العبـاسيـة تثّبت دعـائم مذهـب أبى حنيفــة، فيولى على القضــاء من كـان متبعّا لهـذا المذهـب. ولما استولى الفاطميون على مصـر ونشـروا المذهب الإسمــاعيلي، منعـوا التفقّه على مذهـب أبـي حنيفــة، لأنــه مذهب الدولــة العباسيـة[104].
وقـد كــانت الخلفــاء يختــارون القضــاة أول الأمــر من المجتهـدين لا من مقلديهـم، ولكنهـم فيمــا بعـد آثروا اختــارهـم من المقلديــن، ليقيدوهــم بمـذهـب معـين، ويعينوا لهـم مـا يحكمـون على أسـاسـه، بحيث يكونون معزولين عـن كل قضـاء يخـالف ذلك المذهب. وهـكذا كـان تقيّد القاضي بمذهب يرتضيه الخليفــة سبباً في اكتفــاء أكثر النـاس بـه وإقبــالهـم عليـه والتخلـص من التعـدديــة. فلــم يقتصـر التقليـد على الفقهـاء والمشتغلين بالفتوى بل شمل القضـاة أيضـاً، فأصبح التعيين مع تقييدهـم في القضــاء بالحـــكم طبقـاً لـــذلك المذهب[105].
وهكـذا فقـد أســهمت تلك العـوامـل في انتشــار وازدهــار الـروح المذهبيــة وتكـريس التقليـد وتعميق آثـــاره وتعزيز مظـاهـره دون النظـر في نتائج ذلك التوجـه وعواقبــه الوخيمـة التي أسهمت في الزّج بالأمة في أورقـة التبعية الفكـرية المطـلقة.
الخـاتمـة:
اســتهدفت هذه الدراســة محـاولــة الكشــف عـن أبـرز وأهـم العـوامـل الاجتمــاعيــة والفكـريــة والنفســـية والسياسيـة التى أسهمت في بروز ظـاهرة التقليـد وتعزيزهـــا. وقــد أوضحت الدراســة الأثــر الهـام الـذي لعبتـه تلك الظـروف والعـوامـل في تكـريس منهجيـة التقليـد والحيلولـــة دون محـاصرتهــا أو التخلص من أثـارهــا الوخيمــة.
والدراســة إذ قـامت بإبراز بعض العـوامـل والتدعيــات للتقليـد، فإنهــا لا تسـتبعـد إمكــانيــة وجـود عـوامـل أخـرى مؤثرة في ظهـور التقليـد خـاصة في القرنيـن المـاضيين.
ويمكـن تلخيص أهـم نتــائج الدراســة فيمــا يلي:
ــ تلعب الظـرفيـة الزمـانيـة والمكـانية والعـوامـل الاجتمـاعيـة والنفسـية والفكـرية والسـياسية دورهـا في بروز ظـاهرة التقليـد وتكريسهـا في المجتمعـات المختلفـة.
ــ عـدم الوقوف على العوامــل الكـامنة وراء ظــاهرة التقليد وغيـرهـا من ظـواهـر انتشـرت في الفكـر الإســلامي في مختلف العصـور، يسهـم في استمراريتهــا والبعـد عن التصـدى لهــا ومعـالجتهــا معالجــة جذرية.
أهميــة احـــترام المـوروث الفقهي والوقـوف منــه موقف التقـديـر للجهـود الهائلة التى بذلهـا العلمــاء الســابقون رحمهـم الله مع الإيمـان بإنســانية تلك الجهـود وإمكــانيــة جريان الخطأ والصـواب عليهـا، فالعصمـة والإطلاقيـة للنصوص المطلقــة المفـارقة للزمـان والمكـان المتمثلة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة.
ــ ضـرورة البحث في أسباب ودواعي ظـاهرة التقليـد في العصـر الحاضـر ودراســة جذورهـــا الممتـدة في ســبيل تجــاوزهــا والتخلص من تداعياتهــا.
* دكتـوراه في أصـول الفقـه، أستـاذ مســاعـد في قســم الدراســات الإســلامية بجـامعة البحرين.
[1] محمـد بن أبى بكــر الرازي، مختــار الصحـاح، ت: محمـود خـاطـر، مكتبـة لبنــان ناشـرون، بيـروت، 1415هـ/ 1995م، ص 229. وانظـر كـذلك أحمـد بن محمـد الفيومـي، المصبـاح المنيـر، المكتبـة العلميـة، بيـروت، بدون تاريخ، ص 512، 513.
[2] على بن محمـد الجرجـاني، التعـريفـات، ت: إبـراهيـم الإبياري، دار الكتـاب العـربي، بيـروت، 1405هـ، ج1، ص90.
[3] في تعـريفــات الأصوليـين للتقليـد، انظـر: أبــو المعـالي عبد الملك بـن عبد الله الجويـني، البرهـان في أصـول الفقـه، تحقيق: عبد العظـيم الديب، مكتبـة الوفـاء، مصـر، الطبعـة الرابعـة، 1418هـ، ج2، ص888، أبو أسـحـاق إبراهيـم بن على الشـيرازي، اللمع في أصـول الفقـه، دار الكتب العلميـة، بيـروت، 1405هـ/ 1985م، ج1، ص125. عبدالله بن أحمـد قدامــة المقـدسي، روضــة الناظـر، تحقيق: عبد العـزيز السـعود، جـامعـة الإمـام محمـد بن سـعود، الرياض، الطبعـة الثانيـة 1399هـ، ج1، ص 382.
أبو المظفـر منصـور بن محمـد السمعـاني، قواطع الأدلـة في الأصـول، تحقيق: محمـد حسـن الشـافعـي، دار الكتب العلميــة، بيـروت، 1997م، ج2، ص340.
[4] أبو المعـالي عبـد الملك بن عبـد الله الجويني، الاجتهـاد، تحقيق: عبد الحمـيد أبو زنيـد، دار القـلم، بيـروت، 1408هـ، ج1، ص97.
[5] أبو المظـفـر منصــور بن محمـد السمعـاني، قواطـع الأدلــة في الأصـول، تحقيق: محمـد حسن الشـافعي، دار الكتب العلميـة، بيـروت، 1997م، ج2، ص340.
[6] يستعمـل بعض الأصـوليين كلمـة رحمـة، ويعنون بهـا تقليـد.
[7] السمعـاني، مرجـع سابق ج2، ص340.
[8] الجويني، مرجع سـابق، ج1، ص96، محمـد بن على الشــوكـاني، إرشـاد الفحـول، تحقيق: محمـد البـدوي، دار الفكــر، بيـروت، 1412هـ / 1992م، ج1، ص444.
[9] انظـر في جميع هـذه التعـاريف عند: محمـد بن على الشوكـاني، المرجـع السـابق، جذ، ص 442، 443.
[10] أبو شـامـة عبد الرحمـن المقـدسي، مختصـر المؤمل، ت: صلاح الدين مقبـول، دار الصحـوة الإسـلاميـة، الكويت، 1403هـ، ج1، ص68.
[11] ابن قيم الجوزيـة، اعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه سعـد، دار الجيل، بيـروت، 1973م، ج2، ص236.
[12] ابن قيم الجوزيـة، المرجـع السـابق، ح2، ص263.
[13] الشوكـاني، فتح القدير، دار الفكـر، بيـروت، ج2، ص199.
[14] المرجـع السـابق، ج2، ص412.
[15] الشـوكـاني، فتح القـدير، ج4، ص45.
[16] لا يجـوز التقليـد عند جمهـور الأصوليين في العقـائـد، كوجود الله تعـالى ووحـدانيته ووجوب إفـراده بالعبـادة ومعـرفـة صـدق رسـول ـــ صّلى الله عليــه وسـلم ـــ، فلابــد في ذلك عنـدهــم من النظـر الصحيح والتفكـر والتدبر المؤدى إلى العلــم وإلى طمأنينـة القلب، ومعـرفــة أدلــة ذلك. ثـم عنـد الجمهـور يلحق بالعقـائد في هـذا الأمـر كـل مـا علم من الدين بالضـرورة، فـلا تقليـد فيــه، لأن العلــم به تحصيل بـالتواتر والإجمـاع، ومن ذلك الأخـذ بأركـان الإسـلام الخمسـة. انظـر في ذلك: ابن قيـم الجوزية، المرجـع السـابق، حكـم التقليـد.
[17] ابـن قيـم الجـوزيــة، إعلام الموقعين، ج2، ص211، ونقل نهيهـم كذلك: ابن تيمية، كتب ورســائل وفتـاوى ابـن تيميـة فى الفقـه، ت عبد الرحمن العـاصمـي، مكتبـة ابن تيمية، السـعودية، ج20، ص211، وانظـر كذلـك: الشـوكـاني، إرشــاد الفحـول، مرجع سـابق ج1، ص449، ابن جزم، النبـذة الكـافية، ت: محمـد أحمـد عبد العزيز، دار الكتب العلميـة، بيـروت، 1405هـ، ج1، ص72.
[18] أبو عبد الله محمـد بن أحمـد القرطبي، تفســير القرطبي، تحقيق: أحمـد عبد العليــم البردوني، دار الشعب، القــاهرة، الطبعــة الثانيـة، 1372هـ، ج1، ص231.
[19] محمـد بن على الشـوكـاني، مرجـع سـابق، ج1، ص 167.
[20] الشـوكـاني، فتح القـدير، ح2، ص353، وانظـر كذلك: أبو محمـد على بن أحمـد بن حزم، النبـذة الكـافيـة في أصـول الفقـه، مـرجع سابق، ج1، ص71، ومـا بعـدهـا. وانظـر في تعـوذ العلمـاء من التقليـد، الجويني، البرهـان في أصـول الفقـه، ج2، ص625.
[21] ابن قيــم الجـوزيـة، إعـلام الموقعـين، ج2، ص190 ومـا بعـدهـا، وانظـر كذلك في إيـراد الأدلـة على منع التقليـد: صــالح بن محمـد العمـري، إيقاظ الهمم، دار المعـرفـة، بيروت، 1398هـ، ج1، ص35.
[22] ابن قيـم الجـوزية، إعـلام الموقعين، ج2، ص194 ـــ 195.
[23] الشـوكـاني، إرشـاد الفحـول، ج1، ص446.
[24] ابن قيـم الجوزيـة، إعـلام الموقعين، مرجع سـابق، ج2، ص198.
[25] ولي الله الدهلـوى، الإنصــاف في مسـائل الخــلاف، ت: عبد الفتــاح أبو غـدة. دار النفـائس، بيـروت ط2، 1984، ص99، صديق بن حسن القنوجـي، أبجـد العلـوم، ت: عبد الجبـار زكـار، دار الكتب العلميـة، بيـروت، 1978م، ج2، ص 403.
[26] انظـر في هـذا المعنـى: ابن القيـم الجـوزيـة: إعلام الموقعين عن رب العـالمين، ج1،ص6.
[27] محمـد بن إسمــاعيل الصنعـاني، إرشــاد النقـاد إلى تيسـير الاجتهـاد، ت: صلاح الدين مقبول، الدار السلفيـة، الكويت، 1405، ج1، ص14.
[28] محمـد مصطفى شـلبي، المدخـل في التعـريف بالفقـه الإســلامي، دار النهضـة العـربيـة، بـيروت، 1405هـ، 1985م، ص129 ومـا بعـدهـا.
[29] محمـد فـاروق النبهـان، المدخـل للتشـريع الإسـلامي، وكـالة المطبوعـات، الكويت، الطبعـة الثانيـة، 1981، ص 123 ومـا بعـدهـا.
[30] Nicholson، Literary History of the Arabs، Cambridge، 1930، p281.
[31] أجنتس جولديسـهـر، مـذاهب التفسـير الإسـلامي، ترجمـة: عبد الحليـم النجـار، مكتبـة الخـانجي، مصـر، ومكتبـة المثنى، بغـداد، 1955 ـــ 1974، ص3.
[32] سهيـل فرح، الفلسـفة العربيـة المعـاصرة، مـركز دراسـات الوحـدة العربيـة، 1988، ص263.
[33] محمـد إقبـال، تجـديد التفكــير الدينـي في الإســلام، ترجمـة عبـاس محـمود، لجنـة التــأليف والترجمـة والنشــر، القـاهرة، الطبعـة الثـانيـة، 1986م، ص 189 ــ 190.
[34] أبو شــامـة عبد الرحمـن بن خلدون المقـدمـة، دار القلم، بيـروت، 1984، ط5، ص 493.
[35] عبد الرحمـن بن خلدون، المقـدمـة، دار القلـم، بيـروت، 1984، ط5، ج2، ص493.
[36] انظـر غي ذلك: أحمـد أمين،ضحـى الإسـلام، مكتبـة النهضـة المصـرية، الطبعـة الثامنة، بلا تاريخ، ج1، ص49.
Hamilton A.R. Gibb on the Civilization of Islam، Princeton University Press، New Jersey، 1982، P.69.
والزندقـة تطلق على معـان متعـددة منهـا التهتك والفجـور والتبجح بـالقـول الذي يصـل إلى مـا يمس الديـن والـترعـات الشـكية والارتيابيـة، ومنهـا ما كـان اتبـاع لمذهب ماني المجـوسي، مع التظـاهر بالإسـلام، وقـد فشت الزندقـة في ذلك العصـر وقـام بالدعـوة إليهـا عـدد من المؤلفين الفـارسيين الأصـل الذين لم يتمكنـوا من التخلي عن مـاضيهـم وآثار ديـانــاتهـم القـديمـة من زردشـتية ومـانويـة. للمزيـد حول ذلك راجع: ســورديل دومنيـك جـانين، الحضـارة الإســلامية في عصـرهـا الذهبي، دار الحقيقــة، بـيروت، 1980م، ص123. أحمـد أمين. مرجه سابق، ج1، ص123.
[37] حول تلك الكتابات راجــع: أحمـد بن عبد الحليـم ابـن تيمية، مجمــوع فتاوى شيخ الإسـلام، جمع وترتيب: ابـن قـاســم، السـعودية، 1398هـ / 1978م، ج20، 392.
[38] راجـع في نشــأة التقليـد: ابـن القيـم، المرجع السـابق، ج1، ص7.
[39] ابن قيـم الجوزيـة، إعلام الموقعين، ج2، ص208.
[40] محمـد بن إسمـاعيل الصنعـاني، إرشـاد النقـاد، مرجع سابق، ج1.
[41] يـرى عـدد من العلمــاء أن التقليـد لا يـزال ممتـداً منذ القـرن الرابع أو بدايـة الخـامس وإلى اليوم، محمـد بن الحســن الحجوى، الفكـر الســامي في تـاريخ الفقـه الإســلامي، تعليق: عبــد العـزيز القـارئ، المكتبـة العلميـة، المدينــة المنـورة، 1397هـ، 1977م، الجزء الثاني، القسـم الرابع، ص163.
[42] عبـد الحـي بن أحمـد الدمشقي، شـذرات الذهب في أخبـار من ذهب، دار الكتب العلميـة، بيـروت، بلا تاريخ، ج2، ص188.
[43] الصنعـاني، إرشـاد النقـاد، ج1، ص23 وما بعـدهـا.
[44] ابن حزم، الإحكـام في أصـول الأحكـام، مرجع سابق، ج6، ص292.
[45] هـرب عالم الاجتمـاع الدور كيمي من تفسـير كيفيـة انتقـال تأثير المجتمع إلى الفـرد وتحـديد سلوكـه بتـأكـيده جبريـة الظـواهـر الاجتمـاعيـة وفـرضـة قوة الإلزام للمجتمـع. انظـر: محمـد سعيد فرج، البناء الاجتمـاعي والشخصية، دار المعـرفـة الجـامعية، مصـر، 1989م، ص8 ومـا بعـدهـا.
[46] هـذا ما ذكــره أرسـطو واعتبـره علمــاء الاجتمــاع من المسلمـات الكلاسيكيـة من أن الإنســان حيوان اجتمـاعي ومدنى، بمعنى أنه لا يعيش ولا يمكن دراسـته منفصلاً عـن المجتمع، أحمـد الخشــاب، التفكير الاجتمـاعي، دراســة تكـامليـــة للنظـرية الاجتمـاعية، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، بلا تاريخ، ص123.
[47] غوستـاف لوبون، روح الجمـاعات، ترجمـة: عـادل زعيتر، دار المعــارف، مصـر، 1955م، ص78. انظـر للمؤلف كذلك: روح الاجتمـاع، ترجمـة: أحمـد فتحى زغلول باشـا، مطبعـة الشعب، مصـر، 1909، ص59.
[48] انظــر إبراهيـم البليهي، موقع منتـدى الكتـاب، الرياض الإلكتروني على الانترنت.
[49] أبو حـامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعـرفـة، بيـروت، ج3، ص14.
[50] غوستاف لوبون، روح الاجتمـاع، مرجـع سـابق، ص61.
[51] بيار مانوني، علم النفس الجمـاعي، شـركـة انترسبيس للنشـر، قبرص، بلا تاريخ، ص78 وما بعـدهـا.
[52] غوستاف لوبون، المرجع السـابق، ص30.
[53] غوستاف لوبون، روج الاجتمـاع، مرجع سابق، ص21.
[54] فؤاد البهي السيد، سعـد عبد الرحمـن، علم النفس الاجتمـاعي، دار الفكـر العربي، مصر، 1999م، ص75.
[55] القنوجي، أبجـد العلـوم، مرجع سابق، ج2، ص405.
[56] الشـوكـاني، القـول المفيد، ج1، ص66.
[57] عوض الله جـاد حجـازي، ابن القيـم وموقفـه مـن التفكير الإسلامي، دار الطبـاعة المحمـدية، مصـر، 1380هـ، 1960م، ص38 ــ 39.
[58] محمـد سلام مدكـور، مناهج الاجتهـاد في الإسلام، جامعـة الكويت، الكويت، 1973، ج1، القسـم الثاني، ص63.
[59] إبراهيم عقيلي، تكـامل المنهـج المعـرفي عند ابن تيمية، المعهـد العالمي للفكـر الإسـلامي، أمريكـا، 1415هـ، 1994م، ص63.
[60] ابن قيــم الجوزية، مـدراج الســالكين في منـازل إيـاك نعـبد وإيـاك نستعين، تحقيق: محمـد حـامـد الفقي، دار الكتــاب العـربي، الطبعـة الثانيـة، بيـروت 1973، ج1، ص5.
[61] انظـر في ذلك مـا قـالـة ابن خـلدون عن التفـاوت الحـاصـل بين الحضـر والبـدو: « لمـا امتـلأ الحضـري من الصنـائع وملكـاتهـا وحسن تعليمهـا ظن كل من قصـر عن تلك الملكـات أنهـا لكمـال في عقلـه وأن نفوس أهـل البـدو قـاصرة بفطرتهـا وجبلتهـا عن فطرته ». ج1، ص433.
[62] ابن خلـدون، المقـدمة، ج1، ص 431 ــ 342.
[63] الحجـوي، مرجع سـابق، ج2، القسـم الثـالث، ص144 ومـا بعـدهـا.
[64] ابن خلـدون، ج1، ص531.
[65] ابن خلـدون، ج1 ص29.
[66] عمـاد الدين خليل، عـوامل تدهـور الحضـارة الإسـلاميـة، التجـديد، العـدد الثـامن، السنـة الرابعـة، ص40.
[67] ابن خلـدون، المقـدمـة، ج1، ص532.
[68] الحجوى، مرجـع سابق، ج2، القسـم الرابع، ص393.
[69] ابن قيـم الجوزيـة، مدارج السـالكين في منازل إياك نعبـد وإياك نستعين، ت: محمـد حـامـد الفقهي، دار الكتب العربي، بيـروت، ج1، ص5.
[70] محمـد بن الحسن الحجـوي، مرجـع سابق، الجزء الثاني، القسـم الثالث، ص5.
[71] أحمـد بن حمـدان الحـراني، صفـة الفتوى، ت: محمد ناصـر الدين الألباني، المكتب الإسـلامي، المكتبـة الثالثة، بيـروت، 1397هـ، ج1، ص 105 ما بعـدهـا.
[72] المقـدسـي، مختصـر المؤمل، مرجع ســابق، ج1، ص 41 ــ 42، وانظـر كذلـك في ذات المعنى: الشــوكـاني، القـول المفيـد: مرجع سابق، ج1، ص 58.
[73] الخضـرى بك، تاريخ التشـريع الإسـلامي، دار الفكـر، دمشـق، ص 278.
[74] الشوكـاني، إرشـاد الفحـول، ج1، ص423.
[75] عبـد القـادر بن بدران الدمشـقي، المدخـل، تحقيق: عبدالله التركـي، الطبعـة الثانيـة، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، 1401هـ، ج1، ص 386.
[76] عبد الله مصطفى المراغـي، الفتح المبين في طبقـات الأصوليين، مطبعــة عبد الحمي،د حنفي، مصـر، ط2، ج2، ص99.
[77] أبو حامـد الغزالـي، المنقذ من الضلال، تحقيق: جميل صليبـا وكـامل عيـاد، دار الأنـدلس، لطبعـة التاسـعة، بيـروت، 1980، ص89 ــ 90.
[78] أبو شامة المقـدسي، مختصـر المؤمل، ج1، ص36.
[79] الشوكـاني، إرشـاد الفحول، ج1، ص 424.
[80] فـاخـر عـاقـل، علـم النفس دراسـة التكيف البشـري، دار العلـم للملايين، بيـروت، الطبعـة التاسـعة، 1984م، ص235 وما بعـدهـا بتصرف.
[81] الصنعاني، إرشـاد النقـاد، ج1، ص25.
[82] أبو شـامة المقـدسي، مرجع سـابق، ج1، ص55.
[83] الحجوى، مرجع سابق، ج1، القسـم الرابع، ص163.
[84] إرشـاد الفحـول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول، ص223، إبراهيـم هلال، الإمـام الشـوكـاني والاجتهـاد والتقليد، دار النهضـة العربيـة، مصـر، 1979، ص56.
[85] الشـوكـاني، فتح القدير، ج4، ص552.
[86] الشوكـني، القـول المفيـد مرجـع سـابق، ج1، ص68.
[87] أبو الفرج عبـد الرحمـن بن على بن الجـوزي، تلبيس إبليس، ت: السـيد الجميلي، دار الكتـاب العربي، بيـروت. 1985، ج1، ص 101.
[88] الصنعاني، إرشـاد النقـاد، ج1، ص26.
[89] بتصـرف عـن: هملتـون جب، دراسـات في حضـارة لإسـلام، ترجمـة: إحســان عبـاس وآخرون، دار العلـم للملايين، 1964، ص 263.
[90] بتصـرف عـن: مصطفـى الزرقـا، المدخـل الفقهي العام، مطبعـة جامعـة دمشق، سوريا، 1957م، ص125 ــ 126.
[91] عبد الحليـم محمـود السيـد، الإبـداع والشخصية دراسـة سيكولوجية، دار المعـارف، مصـر، بدون تاريخ، ص90.
[92] انظـر في قضية ضـرب الإمـام مـالك: أبو عبــد الله محمــد بن أحمـد الذهبي، سـير أعلام النبــلاء تحقيق: شــعيب الأرنــاؤوط ونعيـم العرقسـوس، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة التاسعة، بيـروت: 1413هـ ج8، ص95. مـدكور، مرجع سابق، ج2، ص 625 وارجـع في ذلك كله: عبد الحميـد أبو سليمـان، أزمـة عقل المسلم، المعهـد العـالمي للفكـر اإسـلامي، أمـريكـا، 1412هـ، 1991، وما بعـدهـا.
[93] محمـد بن الحسن الحجـوى الثعالبي، الفكـر السـامي في تاريخ الفقـه الإسـلامي، تعليـق: عبد العزيز القارئ، المكتبـة العلميـة، المدينة المنورة، 1396هـ، ج1، القسم الثاني، ص 377.
[94] أبو الفـداء إسمـاعيل بن عمـر بن كثير، البداية والنهـاية، مكتبـة المعـارف، بيروت، جـ14، ص87، القنوجي، أبجد العلوم، مرجع سابق، ج3، ص133.
[95] عبد الله مصطفى المراغـى، الفتـح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج2، ص 168 وما بعـدهـا.
[96] بتصـرف عن عبد الحميـد أبو سليمـان، أزمـة العقل المسلم، مرجع سابق، 48 وما بعـدهـا.
[97] الصنعـاني، إرشـاد النقـاد، مرجع سابق، ج1، ص26.
[98] انظـر ذلك عند: أبو سليمـان، مرجع سابق، ص48.
[99] انظـر في ذلك ما نقلــه ابن فرحـون عن أبى بكـر العربي في تعاطي المبتدعـة منصـب الفقهاء ونيلهـم منصب الفتيا بفســاد الزمـان وتعلق أطمـاعهم به في: الديياج المذهب في معـرفة أعيان علمـاء المذهب، دار الكتب العلميـة، بيروت، ج1، ص121.
[100] ولي الله الدهلوى، الإنصاف في مسـائل الخلاف، ص 87 ــ 88.
[101] مدكـور، مرجع سابق، ج1، ص415.
[102] ابن خلدون، المقـدمة، ج1، ص29.
[103] الصنعـاني، إرشـاد النقـاد، مرجع سابق، ج1، ص25.
[104] انظـر في ذلك كله: حسن إبراهيـم حسن، تاريخ الإســلام، دار الأندلس، بيروت، الطبعـة السـابعة، 1965م، ج3، ص306، وما بعـدهـا.
[105] مدكور، مرجـع سابق، ج1، القسم الثاني، ص414.