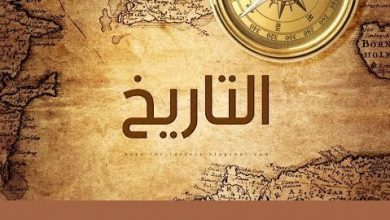فى إحدى مقاطع تفسير سورة الأنعام يورد سيد هذه المقولة وهو يقرأ الآية
{ قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين } (1): (( إن السير فى الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ، ولمعرفة سنن الله مرتسمة فى الأحداث والوقائع ، مسجلة فى الآثار الشاخصة وفى التاريخ المروى فى الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار فى أرضها وقومها ، السير على هذا النحو لمثل هذه الهدف وبمث هذا الوعى ، أمور كلها كانت جديدة على العرب ، تصور مدى النقلة التى كان المنهج الإسلامى الربانى ينقلها إليهم من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعى والفكر والنظر والمعرفة . لقد كانوا يسيرون فى الأرض وينتقلون فى أرجائها للتجارة والعيش ، وما يتعلق بالعيش من صيد ورعى .. إما أن يسيروا وفق منهج معرفى تربوى فهذا كان جديد عليهم ، وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ، وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية فى الطريق الصاعد إلى القمة السامقة التى بلغوا إليها النهاية .
(( لقد كان تفسير التاريخ الإنسانى وفق قواعد منهجية كهذه التى كان القرآن يوجه إليه العرب ، ووفق سنن مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها – بأذن الله – ويستطيع الناس ملاحظتها وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها ، ومعرفة مراحلها وأطوارها ، كان هذا المنهج برمته فى تفسير التاريخ شيئاً جديداً على العقل البشرى كله فى ذلك الزمان ؛ إذا كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار مجرد مشاهدات أو روايات عن الأحداث والعادات والناس لا يربط بينه منهج تحليل أو تكوين يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج وبين المراحل والأطوار ، فجاء المنهج القرآنى ينقل البشرية إلى هذا الأفق ويشرح لهم منهج النظر فى التاريخ الإنسانى ، وهذا المنهج ليس مرحلة فى طرائف الفكر والمعرفة . إنما هو (المنهج) الذى يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنسانى )) (2) .
ويزيد هذا النص أهمية أن سيد يهمشه بهذه العبارة (( يراجع التفسير الإسلامى للتاريخ )) فى كتاب (( خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ، القسم الثانى )) .
إذن فإن من بين فصول القسم الثانى من كتاب (( خصائص التصور الإسلامى ومقوماته )) الذى لم يتيح له النشر لحد الآن فصل عن التفسير الإسلامى للتاريخ .
وإذا كان هذا الفصل ذو الأهمية الخاصة فى فكر سيد التاريخى قد ضاع مع الكتاب الأم الذى يضمه بين جناحيه ، فإن بمقدورنا – لحسن الحظ – أن نعثر على معطيات سيد التفسيرية للتاريخ ، على مساحات واسعة منها بعبارة أدق ، فى كتابه الكبير (الظلال ) ، تماماً كما أن بمقدورنا – لحسن الحظ كذلك – أن نعثر فى (الظلال ) نفسه على مساحات واسعة من كتابه الضائع المهم الآخر (فى ظلال السيره) . ونحن نستطيع أن نؤكد هذا بالنظر إلى ما يتضمنه ( الظلال) من مادة غنية فى الحقلين : التفسير ، والسيرة، وبالقياس – كذلك – على مساحات الأخذ والعطاء الواسعة بين ( الظلال) وبين كتاب قيم آخر أتيح له أن يرى النور ، وأن يلعب دوره – كذلك – فى الختم عل مصير سيد بما يضعه فى صف الشهداء والقديسين : ( كتاب معالم على طريق ) .
وثمة ما يتحتم أن يشار إليه هنا هو أن سيد فى القسم الأول المنشور من كتابه ( خصائص التصور الإسلامى ومقوماته) والذى يبلور فيه الخصائص الأساسية للتصور الإسلامى ، إنما يرفد فى الوقت نفسه الرؤية الإسلامية لتفسير التاريخ ويضع الكثير من أسسها النظرية ، قبل أن يدلف فى القسم الثانى ، غير المنشور ، إلى الموضوع فيمسه من قريب .
مهما يكن من أمر فإننا نجد فى النص السابق تأكيداً على أحدى المقولات الأساسية فى التفسير الإسلامى للتاريخ ، ترتبط بمنهج التفسير وتكتسب أهميتها من هذا الارتباط ، وهى أن القرآن الكريم يطرح لأول مرة فى حقل الفكر التاريخى ، عبر مسيرته الطويلة ، مسألة الارتباط المحتوم بين المقدمات والنتائج فى مجرى الوقائع التاريخية ، وأن حركة التاريخ لا تمضى عبثاً ولا على غير هدى ، وإنما تحكمها سنن ونواميس وقوانين ترتب المصائر على اجنماع حشد من الوقائع والأحداث ، وتجعل من توجه الفعل التاريخى بهذا الاتجاه أو ذاك ، أمراً محتوماً .
ليس ثمة عشوائية فى مجرى التحقق التاريخى إنما هنالك النهايات التى تترتب بالحق والقسطاس على بدايتها- من جنس العمل ، فلا تطيش السهام ولا يغدو التاريخ مسرحاً عبثياً يقوم اللامعقول بدور البطولة فيه .
إن أحداً من رواد الفكر التاريخى لم يقل بهذا قبل كتاب الله المعجز ، على كثرة ما كتب من دراسات تاريخية وما دٌبج من أبحاث ومطولات وإن أحداً من رواد الفكر التاريخى لم يقل بهذا بعد مرور عدة قرون على تأكيدات القرآن ، ولقد جاء ابن خلدون لكى يقول هذا فى ((مقدمته)) ولكن بعد ما يقرب من ثمانية قرون ، وهو لشدة دهشته لاكتشاف ناموسية الحركة التاريخية من بين رفاق البحث التاريخى عبر القرون ، لم يشر إلى أن القرآن الكريم هو الذى فتح الطريق وأشار فى حشود آياته البينات إلى هذه الحقيقة الخطيرة فى تحليل الصيرورة التاريخية .
وقرون أخرى كان عليها أن تمضى قبل أن يأتى من يواصل الطريق الذى اعتقد ابن خلدون – خطأ – أنه شقه لأول مرة .
إن هذه الرؤية المنهجية البكر فى فهم التاريخ والتعامل معه لهى واحدة من عجائب القرآن التى لا تنقضى ، وإن القول بها ، أو الكشف عنها أو الكشف عنها ، أو التأكيد عليها فى بيئية فكرية لم تكن قد بلغت النضج الذى يؤهلها لإفراز مقولات كهذه ، كما يتوهم الماديون ، ليدل بوضوح عليه الفوقية التى يتسم بها كتاب الله ، وعلى الانفصال المحتوم – إذا صح التعبير – بين معطيات الله الشاملة وبين أفكار الناس الجزئية ، القاصرة ، المحدودة .. (( والذين يأخذهم الدهش والعجب – يقول سيد – للنقلة الهائلة التى انتقل إليها العرب فى خلال ربع قرن من الزمان على عهد الرسالة المحمدية ، وهى فترة لا تكفى إطلاقاً لحوث تطور فجائى فى الأوضاع الاقتصادية ، سيرتفع عنهم الدهش ويزول العجب لوأنهم حولوا انتباههم من البحث فى العوامل الاقتصادية ، ليبحثوا عن السر فى هذا المنهج الربانى الجديد الذى جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله العليم الخبير .
ففى هذا المنهج تمكن المعجزة وفيه يمكن السر الذى يبحثون عنه طويلاً عند الإله الزائف الذى أقامته المادية حديثاً : إله الاقتصاد . وإلا فأين هو التحول الاقتصادى المفاجئ فى الجزيرة العربية الذى ينشئ من : التصورات الاعتقادية ، ونظام الحكم ، ومناهج الفكر ، وقيم الأخلاق ، وآماد المعرفة ، وأوضاع المجتمع :- كل هذا الذى نشأ فى ربع قرن من الزمان ؟ )) (3) .
☼☼☼
فى ختام تفسير سيد لهذه الآية ذات الدلائل { ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكانهم فى الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين } (4) ،ينفذ سيد إلى الرؤية الإسلامية لتفسير التاريخ ، سيما وأن منطوق هذه الآية يتصادى مع حشود من الآيات والمقاطع القرآنية عبر كتاب الله من أقصاه إلى أقصاه ؛ فهو من ثم منطوق مؤكد ، يملك ثقله الكبير ودلالته التى لا يأتيها الباطل من يديها ولا من خلفها . إن هذا النص فى القرآن {فأهلكناهم بذنوبهم}، وما يماثله ، وهو يتكرر كثيراً : – إنما يقرر حقيقة أن الذنوب تهلك أصحابها ، وأن الله هو الذى يهلك المذنبين بذنوبهم ، وأن هذه سنة ماضية – ولم يراها فرد فى عمره القصير ، أو جيل فى أجله المحدود – ولكنها سنه تصير الأمم حين تفشو فيها الذنوب ، وحين تقوم على حياتها الذنوب ؛ هذه الحقيقة جانب من التفسير الإسلامى للتاريخ ، فإن هلاك الأجيال واستخلاف الإجيال من عوامله :
فعل الذنوب فى أجسام الأمم وتأثيرها فى أنتشار حالة تنتهى إلى الدمار ، إما بقارعة من الله عاجلة – كما كان يحدث فى التاريخ القديم – وأما بالانحلال البطئ الفطرى الطبيعى الذى يسرى فى كيات الأمم – مع الزمن – وهى توغل فى متاهة الذنوب .
(( وأمامنا فى التاريخ القريب نسبياً الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاقى والدعارة الفاشية ، واتخاذ المرأة فتنة وزينة ، والترف والرخاوة والتلهى بالنعم . أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله فى انهيار الإغريق والرومان – وقد أصبحوا أحاديث – وفى الانهيار الذى تتجلى أوائله وتلوح نهايته فى الأفق فى أمم معاصرة كفرنسا وإنجلترا – كذلك – على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض )) .
(( إن التفسير المادى للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفاً باتاً من تفسيره لأطوار الأمم وأحدث التاريخ ، ذلك أن وجهته ابتداء هى استبعاد القاعدة الاعتقادية التى يقوم عليها ، ولكن هذا التفسير يضطر إلى ممحاكات مضحكة فى تفسير أحداث وأطوار فى حياة البشرية لا سبيل إلى تفسيرها إلا على أساس القاعدة الاعتقادية )) .
(( و التفسير الإسلامى بشموله وجديته وصدقه وواقعيته ، لا يغفل أثر العناصر المادية – التى يجعلها التفسير المادى هى كل شئ – ولكنه يعطيها مكانها الذى تستحقه فى رقعة الحياة العريضة ، ويبرز العناصر الفعالة الأخرى التى لا ينكرها إلا أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود .. يبرز التغير الداخلى فى الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ، ويبرز السلوك الواقعى والعنصر الأخلاقى ، ولا يفعل عاملاً واحداً من العوامل التى تجرى بها سنة الله فى الحياة )) (5) .
إن سيد يؤكد فى هذا العرض جملة أمورعن التفسير الإسلامى للتاريخ ، وهو يقوم بهذا ( التفسير ) فى تعاملة مع الآية المذكورة : ناموسية الحركة التاريخية ، انكماش التفسير المادى للتاريخ برفضه هذه القيم ، واضطراره – أحياناً – إلى اعتماد (( المماحكات المضحكة )) فى تفسير أحداث وأطوار فى تاريخ البشرية لاسبيل إلى تفسيرها إلا على أساس القاعدة الاعتقادية .. شمولية التفكير الإسلامى – بالتالى – وصدقه وواقعيته . فهناك اعتراف بالعناصر المادية ضمن المساحة التى تشتغلها فعلاً فى صياغة الواقعية التاريخية ، وهناك – أيضاً – سائر العناصر الفعالة الأخرى التى ليس إنكارها من العلم فى شئ : قدر الله ، التغير الداخلى فى الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ، السلوك الواقعى والعنصر الأخلاقى .
إنها جميعاً تصنع التاريخ ، وبدون اعتمادها جميعاً لا يمكن تفسير التاريخ ، تلك هى شمولية الرؤية الإسلامية وجديتها وصدقها وواقعيتها .
إن سيد ما إن تتهيأ له الفرصة لتقديم عرض نقدى مقارن بين تفسير الإسلام وتفاسير الوضاعين ، وبخاصة طبقة الماديين منهم ، إلا انتهازها لكى يبين المدى الواسع فى القدرة على الاستشراف بالنسبة للموقف الإسلامى والحفر الضيقة التى تختنق فيها الرؤى والتفاسير الوضعية .
☼☼☼
وعبر (الظلال) ذى الثلاثين جزء نستطيع أن نضع أيدينا على مساحات واسعة مما يمس التفسير الإسلامى للتاريخ من قريب أو بعيد ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، فما ثم من مسألة لها عاقة بالموضوع إلا ونجد سيد يقول كلمته فيها من خلال تفسيره لهذا المقطع أو ذاك ، ولهذه الآية أو تلك ، ومن خلال مقدماته التحليلية الخصبة لسور القرآن وبخاصة تلك التى تحدثت عن وقائع تاريخية مما شهده عصر الرسالة .
إن سيد يحدثنا عن القدر والحرية ، عن البعد الغيبى ، عن دور الإنسان فى صياغة الحدث التاريخى ، عن تركيب الإنسان ومزاياه ومثالبه ، وعن الفردية الجماعية ، عن تهيئة العالم لاستقبال الإنسان .. عن خلق آدم وشروط الخلق ، والغاية النهائية منه ، عن استخلاف الإنسان فى الأرض وطبيعة الدور الذى يتحتم أن ينفذه فيها ، عن تسخير العلم والطبيعة والأشياء لمهمة الإنسان ، عن الصراع الذى يلف الجزئيات والذرات والمخلوقات والأجرام فيحركها ويدفع بها إلى الإمام ، ويدفع بها إلى الشروط التى تمكن التجربة التاريخية من الديمومة والتواصل، ونقائضها التى تقودها إلى التفكك والانهيار ، عن التغير الذاتى الذى هو مفتاح الحركة التاريخية والذى يتحقق بالصيغ التى تختلف كلية عن صيغ التفاسير الوضعية وعلى رأسها المادية التاريخية .
وغير هذه الخطوط العريضة ، مسائل ( فرعية) أخرى كثيرة يغرسها سيد فى ( الظلال ) لكى ترفد التصور الشامل للتفسير الإسلامى للتاريخ .
يمكن القول – بشكل عام : – إن نقاط الارتكاز التى يمكن وضع اليد عليها بحثاً عن النسيج التفسيرى التاريخى فى (الظلال) هى تلك السور التى تنزلت مساحات واسعة منها لكى تتحدث عن هذه المعركة أو تلك من معارك عصر الرسالة فتغطى جانباً من مجرياتها ، ولا وتلامس أحداثها ، وتعلق على وقائعها لكى تمنح الجماعة الإسلامية خبرات حية مستمدة من صميم التجربة التى يصنعوها ويعيشونها .
وهذه السور هى وفق التسلسل التاريخى للأحداث التى تعاملت معها : الأنفال ( عن معركة بدر) ، آل عمران (عن معركة أحد) ، الحشر (عن معركة بنى النضير) ، الأحزاب (عن معركة الخندق) ، الفتح ( عن صلح الحديبية) ، والتوبة ( عن معركة تبوك) .
طبعاً : إن هناك قطعاً أخرى عن أحداث السيرة وقائعها منبثة فى ثنايا القرآن ، ولكننا نشير هنا إلى المساحات الأوسع فحسب .
☼☼☼
فى تفسيره لسورة الأنفال ، باعتبارها أول معركة حاسمة بين الإيمان والكفر ، يقف سيد طويلاً لطرح وتحليل نظرية الجهاد الإسلامى فيخصص لها أربعاً وثلاثين صفحة شكلت فيما بعد موضوعاً مستقلاً فى كتاب (المعالم) ، وقد اقتبس خلالها قطعة واسعة من كتاب أبى الأعلى المودودى (الجهاد فى سبيل الله) ، كما أنه اعتمد فى البداية على ذلك التلخيص الذى قدمه الإمام ابن القيم عن سياق الجهاد فى الإسلام فى ( زاد المعاد) .
ويكاد يكون هذا التحليل للجهاد أدق تحليل لذلك المبدأ الإسلامى الخطير ، وأكثرها نفاذاً ، وأشملها رؤية ، وأقدرها على استكناه الروح الحقيقية التى تسرى فى نسيج هذه الفاعلية ودمها وعصبها وشرايينها ،مستمدة من الرؤية القرآنية ومعطيات السيرة ، بعيداً عن الإسقاطات الخاطئة المضللة التى ألحقت بالجهاد فيما يعد مكراً أو جهلاً …
والجهاد ، على ذلك ، واحداً من المفاتيح الكبيرة التى ( تفسر) الكثير من وقائع التاريخ ، وتلقى الضوء على معطياته وهى تنمو وتتطور ، أو تنكمش وتضمحل وتزول … ليس تاريخ الرسالة وحدها ، ولا تاريخ عصر الراشدين وحده ، ولكنه كل تاريخ تكون فييه مواجهة بين الإسلام والخصوم .
ولن يتسع المجال هنا بطبيعة الحال لاستعراض ، أو حتى لتلخيص هذا المنظور المتماسك لمفهوم الجهاد ويكفى أن نحيل القارئ إليه (6) .
يمضى سيد بعد ذلك لكى يستعرض وقائع معركة بدر وملابساتها من أجل تهيئة الأرضية التى سيقيم عليها تفسيره للمعطيات القرآنية عن هذا الحدث الحاسم ( وسنرجع إلى ذلك مرة أخرى لدى الحديث عن معطيات سيد كباحث فى التاريخ الإسلامى ) . ثم يختم استعراضه ذاك بقوله : (( فى هذه الغزوة التى أجملنا عرضنها بقدر المستطاع ، نزلت سورة الأنفال ، نزلت تعرض وقائع الغزوة الظاهرة ، وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة ، وتكشف عن قدر الله وتدبيره فى وقائع الغزوة ، وفيما وراءها من خط سير التاريخ البشرى كله ..) (7) .
وكعادته عبر منهجه التفسيرى ذى الرؤية الشمولية يقدم الرجل عرضاً للخطوط الرئيسية للسورة ثم يختم العرض بقوله : (( لقد كانت هذه الغزوة هى أول وقعة كبيرة لقى فيها المسلمون أعداءهم من المشركين ، فهزموهم تلك الهزيمة الكبيرة ؛ ولكن المسلمين لم يكونوا قد خرجوا لهذه الغاية ، لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم ، فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة ؛ أراد الله لها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاه قريش الذين جمدوا الدعوة فى مكة ، ومكروا مكرهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بلغوا بأصحابه الذين تابعوه على الهدى غاية التعذيب والتنكيل والأذى لقد أراد الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقانا بين الحق والباطل ، وفرقاناً فى خط سير التاريخ الإسلامى ، ومن ثم فرقاناً فى التاريخ الإنسانى ، وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأنفسهم فيما يحسبونه الخير لهم ، وتدبير رب البشر لهم ولو كرهو فى أول الأمر . كما أراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل النصر وعوامل الهزيمة وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليها وهى فى ميدان المعركة وأمام مشاهدها .
((وتضمنت السورة التوجيهات الموجبة إلى هذه المعانى الكبيرة .. مصوغة فى أسلوب التوجيه المربى الذى ينشئ التصور الاعتقادى ويجعله هو المحرك الأول والأكبر فى النشاط الإنسانى ؛ وهذه سمة المنهج القرآنى فى عرض الأحداث وتوجيهها ..
واستطرد السياق أحياناً إلى صورة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه فى مكة ، وهم قلة مستضعفون فى الأرض ، يخافون أن يتخطفهم الناس .
وذلك ليذكروا فضل الله عليهم فى ساعة النصر ، ويعلموا أنهم إنما سينصرون بنصر الله وبهذا الدين الذى آثروه على المال والحياة وإلى صور من حياة المشركين قبل هجرة رسول الله صلى الله عليهم وسلم وبعدها ، وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم لتقريرسنة الله التى لا تختلف فى الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه )) (8) .
فهاهنا نضع أيدينا على بعض الخيوط التى تسهم فى نسيج التفسير الإسلامى للتاريخ : رؤية الله سبحانه ورؤية الإنسان ، فعل الله سبحانه فى التاريخ وفعل الإنسان ، عوامل الهزيمة ، العقيدة كمحرك للواقعية التاريخية ، مصائر المؤمنين ومصائر الكافرين فى العالم ، القوى المنظورة والقوى الغيبية فى صياغة التاريخ ، السنن الإلهية التى لا تتغير ولا تتبدل كلما اجتمعت الأسباب .
فمن خلال هذه المعركة الفاصلة التى لم تتعد الساعات ، أراد القرآن الكريم أن يعلم الجماعة المؤمنة الكثير من مبادئ الحركة التاريخية وقوانينها ؛ لكى يعرفوا كيف يسوقونها – بإرادة الله – صوب الهدى المرتجى ؛ ولكى يكونوا أكثر قدرة على تغيير خرائط العلم وإعادة صياغته من جديد كيلا تكون فتنة ويكون الدين لله .
وشتان بين جماعة تعرف مبادئ وقوانين الحركة التاريخية ، وتتوافق معها ، وتنبنى عليها ، وتختزل الوقت والطاقة وصولاً إلى الهدف ، وبين جماعة أخرى تجها هذه المبادئ فترتطم بها ، ولا تستفيد من طاقتها ووقتها شيئاً أكبر بكثير من الحجم المطلوب ، وقد لا تصل إلى هدفها أبداً .
إن الماركسين يصرون – خطأ واستكباراً – على أنهم هم الذين اكتشفوا قوانين الحركة التاريخية ، فسعوا إلى استغلالها لحسابهم من أجل التعجيل والتسريع بتحقيق أهدافهم . لكننا نجد هنا ما يضرب هذه المقولة الخاطئة ، ويبين للناس كيف أراد القرآن الكريم أن يمنحهم وعياً أعمق بهذه القوانين يمكنهم من تنفيذ برامجهم وتثبيت وجودهم العقيدى فى العالم .
إن سيد ، عبر تفسيره لسورة الأنفال يقفنا أمام حشد من تلك القوانين :
1- الأسباب وحدها لا تنشئ النتائج ، إنما هناك ما يفوقها فاعلية ، بل ما يحيط بها ويمنحها القدرة على العمل : إنه قدر الله .
والاتكال على الله والتسليم بقدره لا يمنع – مطلقاً – اتخاذ الأسباب ؛ فإنهما متكاملان متناغمان متواصلان ، وليسا – كما يتصور البعض متعارضين – متقاطعين ومتضادين .
والقوانين الطبيعية لا تملك حتميتها المستقلة ، المنظورة ، فيما ينفى قدر الله وغيبه ،فإن التحليل العلمى نفسه يقود إلى تأكيد هذا الغيب فى صميم الطبيعة ، وفى تركيب قوانينها العاملة . وإن تجاوز الاستسلام للأسباب الظاهرة هو الفعل التاريخى والعقيدى الوحيد الذى يحرر الإنسان ويمكنه ، فى الوقت نفسه ، من صياغة وجود مصيره بما يشبه القفزات ، إنه ليس ثمة ( عبودية) أبداً لغير الله ، لا للأسباب الحتمية ولا لإرادة الطبيعة ولا لغيرها من المسميات .
وذلك هو ملمح أساسى أصيل يفرق بين التفسير الإسلامى للتاريخ وبين غيره من تفاسير الكهنة والوضاعين . ولنتابع بعض التفاصيل مما يريد سيد أن يقوله : (( ليس الاتكال على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب . فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما أمر به من اتخاذها ، ولكنه لا يجعل الأسباب هى التى تنشئ النتائج فيتكل عليها ؛ إن الذى ينشئ الأسباب – هو قدر الله ، ولا علاقة بين السبب عبادة بالطاعة ، وتحقق النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا الله على استيفائها .
(( ولقد ظلت الجاهلية ( العلمية !) الحديثة التى تلح فيما تسميه ( حتمية القوانين الطبيعية ) ؛ وذلك لتنفى ( قدر الله) ، وتنفى (غيب الله ) حتى وقفت فى النهاية عن طريق وسائلها وتجاربها ذاتها أمام غيب الله وقدر الله وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمى ، ولجأت إلى نظرية (الاحتمال) فى عالم المادة ؛ فكل ما كان حتمياً صار احتمالياً ، وبقى الغيب سراً مختوماً ، وبقى قدر الله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة ، وبقى قول الله سبحانه { لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } هو القانون الحتمى الوحيد الذى يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية التى يدبر الله بها هذا الكون بقدره النافذ الطليق .
(( .. هذه هى النقلة الضخمة التى ينقلها الاعتقاد الإسلامى للقلب البشرى وللعقل البشرى أيضاً – النقلة التى تخبطت الجاهلية الحديثة ثلاث قرون لتصل إلى أولى مراحلها من الناحية العقلية ، ولم تصل إلى شئ منها فى الناحية الشعورية ، وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة فى التعامل مع قدر الله ، والتعامل مع الأسباب والقوى الظاهرية ؛ إنها نقلة التحرر العقلى ، والتحرر الشعورى ، والتحرر السياسى ، والتحرر الاجتماعى ، والتحرر الأخلاقى ، إلى آخر أشكال التحرر وأوضاعه وما يمكن أن يتحرر ( الإنسان) أصلاً إذا بقى عبداً للأسباب (الحتمية) وما وراءها من عبوديته لإرادة الناس أو عبوديته لإرادة ( الطبيعة) ، فكل (حتمية) غير إرادة الله وقدره هى قاعدة العبودية لغير الله وقدره ..
والتصور الاعتقادى فى الإسلام كل متكامل ، ثم هو بدوره كل متكامل مع الصورة الواقعية التى يريدها هذا الدين لحياة الناس )) (9) .
2- أن النتائج التاريخية لا تأتى بالتمنى ، ولكن بالجهد والجهاد وبالمعناة فى عالم الواقع وفى ميدان القتال .
وأن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة وحدهما ، ولكنه بمقدار الاتصال بالله والاستمداد من قوته .
وأنه ليس كل ما يريده الناس خيراً لأنفسهم ، فهناك من وراء رؤية الإنسان المحدودة ، رؤية شاملة مطلقة قد تختار لهم ما لا يشتهون ولكنها تسوقهم إلى المصائر التى ينتمون { فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا } (10) .
(( لقد أراد الله – لمعركة بدر – أن تكون ملحمة لا غنيمة ( كما تمنى المسلمون قبل وقوعها) وأن تكون موقعة بين الحق والباطل ، ليحق الحق ويثبته ويبطل الباطل ويزهقه ، وأراد أن يقطع دابر الكافرين ..
ويمكن للعصبة المسلمة التى تعيش بمنهج الله ، وتنطلق به لتقرير ألوهية الله فى الأرض وتحطيم طاغوت الطواغيت ، وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف ، وبالجهد والجهاد ، وبتكاليف الجهاد ومعاناته فى عالم الواقع وفى ميدان القتال .
(( نعم . لقد أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة ، وأن تصبح دولة ، وأن يصبح لها قوة وسلطان . وأراد لها أن تقيس قوتها الحقيقة إلى قوة أعدائها فترجح ببعض قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائها فترجح ببعض قوتها على قوة أعدائها ! وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس بالعدة ، وليس بالمال والخيل والزاد ، إنما هو بمقدار اتصال القلوب بقوة الله التى لا تقف لها قوة العبادة وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية ، لا عن مجرد تصور واعتقاد قلبى ..
(( فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها مما أراده الله لها ؛ لقد كانت تمضى وكانت لهم قافلة أبى سفيان – قصة غنيمة ، قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها ؛ فأما بدر فقد مضت فى التاريخ كله قصة عقيدة ، قصة نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل ذاد ، الحق فى قلة من العدد ، وضعف فى الزاد والراحلة ، قصة انتصار قلوب من بينها الكارهون للقتال ! ولكنها بيقينها الثابتة المستعلية على الواقع المادى ، وبيقينها فى حقيقة القوى وصحة موازينها ، قلبت ميزان الظاهر فإذا الحق راجع غالب .. )) (11) .
3- أن الإنسان المؤمن ليس وحده فى الساحة ، فهنالك قوى أخرى قد تكون منظورة حيناً ، غير مرئية حيناً آخر ، تبعث بها إرادة الله سبحانه لكى تعين الجماعة المؤمنة على تحقيق النصر والاقتراب من الأهداف .
وإن مقولة فاعلية وسائل الإنتاج ، والقدرات اللامحدودة للقوى المادية ، ليس سوى خرافة تنبثق عن رؤية نسبية محدودة قاصرة لما يجرى فى ساحة الكون والعالم والحياة {وما يعلم جنود ربك إلا هو } (12) .
إن المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته ، وتدبيره وقدره ، وتسير بجند الله وتوجيهه ؛ إن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدها فى ذلك اليوم وهى قلة والأعداء كثيرة ؛ وإن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملأ الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذى يصفه الله – سبحانه – كلماته ..
(( لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغثيون ، وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين .. لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما فى طوقهم فلا يستبقوا منه بقية ، وأن يغالبوا الهزة الأولى التى أصابت بعضهم فى مواجهة الخطر الواقعى وأن يمضوا فى طاعة أمر الله واثقين بنصر الله ، كان حسبهم هذا لينتهى دورهم ويجئ دور القدرة التى تصرفهم وتدبرهم ..
وأنه لحسب العصبة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبها وتثبت فى المعركة ، ثم يجئ النصر من عند الله وحده .. )) (13) .
4- أنه ليس من قبيل الصدف والفلتات أن ينصر الله العصبة المؤمنة ، وأن يسلط على أعدائها الرعب وينتهى بها إلى الهزيمة ، فتلك هى سنة الحياة ، وذلك هو واحد من أشد قوانين التاريخ ديمومة وثباتا . وإنه بمجرد أن نستعرض مسيرة الصراع بين الأنبياء عليهم السلام وأصحابهم ، وبين خصومهم ومعارضيهم تتبين لنا ناموسية الحركة التاريخية التى تؤل إلى انتصار الإيمان على الكفر .
(( إنها ليست فلتة عارضة ، ولا مصادفة عابرة ، أن ينصر الله العصبة المسلمة ، وأن يسلط على أعدائها الرعب والملائكة مع العصبة المؤمنة ، إنما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ، فاتخذوا لهم شقاً غير شق الله ورسوله وصفاً غير صف الله ورسوله ، ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا ، يصدون عن سبيل الله ويحلون دون منهج للحياة )) .
(( قاعدة وسنة ، لا فلتة ولا مصادفة ؛ قاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصبة المسلمة فى الأرض لتقرير ألوهية الله وحده ، وإقامة منهج الله وحده ، ثم وقف منها عدو لها موقف المشاقة لله ورسوله ، كان التثبيت والنصر للعصبة المسلمة ، وكان الرعب والهزيمة للذين يشاقون الله ورسوله ، ما استقامت العصبة المسلمة على الطريق ، واطمأنت إلى ربها وتوكلت عليه وحده وهى تقطع الطريق … )) (14) .
(( إن الله سبحانه وتعالى لا يكل الناس إلى فلتات عابرة ولا إلى جزاف لا ضابط له ، إنما هى سنته ُيمضى بها قدره . وما أصاب المشركين فى يوم بدر هو ما يصيب المشركين فى كل وقت وقد أصاب آل فرعون والذين من قبلهم … )) (15) .
5- والإنسان فى التصور الإسلامى للتاريخ عنصر إيجابى فى صياغة المصير ، وهو يملك فى أية لحظة القدرة على التغيير ، فهو – من ثم ليس مجرد أداة لما تسميه المذاهب الوضعية ( الحتميات التاريخية) تفعل به ما تشاء ؛ إن الإنسان أقدر وأكرم من هذا بكثير .
وفى تفسيره للآية { ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } (16) ، يقول سيد : (( إنه من جانب ، يقرر عدل الله فى معاملة العباد ، فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم ، ويبدلوا سلوكهم ، ويقلبوا أوضاعهم ، ويستحقوا أن يغيروا ما بهم مم أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التى لم يقدروها ولم يشكروها . وفى الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنسانى أكبر تكريم ، حين يجعل قدر الله به ينفذ ويجرى عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ، ويجعل التغيير القدرى فى حياة الناس مبنياً على التغيير الواقعى فى قلوبهم ونواياهم ، وسلوكهم وعملهم وأوضاعهم التى يختارونها لأنفسهم . ومن الجانب الثالث يلقى تبعة عظيمة – تقابل التكريم العظيم – على هذا الكائن . فهو يملك أن وستبقى نعمة الله ويملك أن يزداد عليها إذا هو عرف فشكر ، كما يملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر فبطر وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه .
(( وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانباً من جوانب ( التصور الإسلامى لحقيقة الإنسان وعلاقة قدر الله به فى هذا الوجود ، وعلاقته هو بهذا الكون وما يجرى فيه . ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن فى ميزان الله ، وتكريمه بهذا التقدير ، كما تتبين فاعلية الإنسان فى مصير نفسه وفى مصير الأحداث من حوله ، فيبدو عنصراً إيجابياً فى صياغة هذا المصير – بإذن الله وقدره الذى يجزى من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه ، وتنتفى عنه تلك السلبية الذليلة التى تعرضها عليه المذاهب المادية التى تصوره عنصراً سلبياً إزاء الحتميات الجبارة : حتمية الاقتصاد ، وحتمية التاريخ ، وحتمية التطور .. إلى آخر الحتميات التى ليس للكائن الإنسانى إزاءها حول ولا قوة ، ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تعرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول . كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء فى حياة هذا الكائن ونشاطه ، تصور عدل الله المطلق فى جعل هذا التلازم سنة من سننه يجرى بها قدره ولا يظلم فيها عبد من عبيده .. )) (17) .
6- فى التفاسير الوضعية للتاريخ كان الشعار فى معظم الأحيان هو ( الغاية تبرر الواسطة ) ، وكان بمقدور البطل فى التمثيل المثالى لهيجل أن يفعل ما يشاء ، وأن يتجاوز القيم الخلقية ويسحق الزهرات البيضاء ؛ لأنه لا يفعل أكثر من الاستجابة لنداء العقل الكلى من أدجل التقدم . وما كانت النازية والفاشية فى نهاية الأمر إلا ثمرة مرة لهذا التصور المخطوء ، لقد وجدنا فى فلسفة هيجل الكثير من المبررات والحجج والأسانيد . وكان بمقدور ( الطبقة) فى التفسير المادى لماركس وإنجلز أن تفعل ما تشاء : أن تقتل وتستبعد وتسفك الدماء وتسعى فى الأرض فساداً ؛ لأنها لا تفعل أكثر من الاستجابة لمنطق التبدل فى وسائل الإنتاج وظروفه ، وما كانت الشيوعية فى نهاية الأمر إلا ثمرة مرة لهذا التصور المخطوء ، ولقد وجدت فى فلسفة ماركس وإنجلز ونبوءاتها وحتمياتها الكثير من الحجج لتنفيذ أبشع الصيغ للمبدأ الماكيافللى الغربى المعروف : ( الغاية تبرر الواسطة) .
فى التصور الإسلامى نقف إزاء هذا النداء { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين } (18) .
(( إن الإسلام يعاهد ليصون عهده ، فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهره وعلانيته ، ولم يخن ولم يغدر ، ولم يغش ولم يخدع ، وصارع الآخرين بأنه نفض يده من عهده ، فليس بينه وبينهم أمان . وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة والأمن والطمأنينة … إنه يريد للبشرية أن تعف فلا يبيح الغدر فى سبيل الغلب ، وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ، ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة … إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأ ، ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة ، وليس مسلماً من يبرر الوسيلة بالغاية ، فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامى ؛ لأنه لا انفصال فى تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات …)) (19) .
7- والقوة المادية ليست الحكم الأول والأخير فى مصير أى صراع ، سواء بحسابات الكم أم النوع ، فإن هنالك – فى التفسير الإسلامى للتاريخ – قوة تفوقها وتسوقها فى الوقت نفسه ، إنها قوة الإيمان ، توهج الروح واستنارة الفكر ويقين الفؤاد .
إن المنظور الإسلامى يكسر المعادلات التقليدية لتكافؤ القوى ويصنع معادلة من نوع جديد .. معادلة مركبة من عدة درجات لن يستطيع إدراكها والتعامل بمنطوقها إلا الذين يصنعونها وينفذونها ..
لقد كان الفاتحون الرواد بعض أولئك الذين تيقنتها نفوسهم ، كانوا فى معظم الأحيان الأقل عدداً ولكنهم كانوا فى معظم الأحيان يخرجون منتصرين . وبدون إدراك هذا البعد فى ميدان الصراع لن يكون بمقدورنا أن تفسر واحدة من أشد الظواهر التاريخية تأثيراً وتألقاً واتساعاً .. الفتح الإسلامى .
بينما فى التفاسير الوضعية يبدو الرقم البسيط المجرد هو الحكم الفصل فى المصير ، ولهذا كثيراً ما تعجز عن تفسير ظواهر تاريخية كهذه فتلفق لها الأسباب :
{ يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (20) .
(( ويقف الفكر ليستعرض القوة التى لا راد لها ولا معقب عليها ، قوة الله القوى العزيز ، وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة الهزلية ، التى تتصدى لكتائب الله – فإذا الفرق شاسع والبون بعيد ، وإذا هى معركة مضمونة العاقبة مقررة المصير )) .
(( فأما تعليل هذا التفاوت فهو ، { بأنهم قوم لا يفقهون } ..فما صلة الفقه بالغلب فى ظاهر الأمر ؛ إنها صلة حقيقية قوية . إن الفئة المؤمنة إنما تتماز بأنها تعرف طريقها وتفقهه منهجها وتدرك حقيقة وجودها وغايتها . إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فتفقه أن الألوهية لا بد أن تتفرد وتستعلى ، وأن العبودية يجب أن تمون لله وحده بلا شريك . وتفقه أنها هى – الأمة المسلمة – المهتدية بهدى الله ، المنطلقة فى الأرض بإذن الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، وأنها هى المستخلفة عن الله فى الأرض ، الممكنة فيها الا تستعلى هى وتستمتع ولكن لتعلى كلمة الله وتجاهد فى سبيله ولتعمر الأرض بالحق وتحكم بين الناس بالقسط .. وكل ذلك فقه يكسب فى قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة واليقين ، ويدفع بها إلى الجهاد فى سبيل الله فى قوة وطمأنينة للعاقبة تضاعف القوة ، بينما أعداؤها ( قوم لا يفقهون ) ، قلوبهم مغلقة ، وبصائرهم مطموسة ، وقوتهم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة ، إنها قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير .
(( وهذه النسبة ، واحد لعشرة ، هى الأصل فى ميزان القوى بين المؤمنين الذين يفقهون والكافرين الذين لا يفقهون .
وحتى فى أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسبة هى واحدة لاثنين )) (21) .
8- أن آصرة التجمع والقاعدة التى ينطلق منها المجتمع الإسلامى ويقوم عليها هى العقيدة ، ليست علاقات الدم ، ولا علاقات الأرض ، ولا علاقات الجنس ، ولا علاقات التاريخ ، وعلاقات اللغة ، ولا علاقات الاقتصاد ، ولا العلاقات الطبقية ؛ ليست هى القرابة ولا العرقية ولا المصالح الاقتصادية ؛ إنما هى علاقة العقيدة أولاً وأخيراً .
(( لقد كان الإسلام يستهدف من خلال ذلك إبراز ( إنسانية الإنسان ) ، وتقويتها وتمكينها وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى فى الكائن يشترك مع الكائنات الحيوانية – بل الكائنات المادية – فى صفات توهم أصحاب ( الجهات العلمية ) مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ، ومرة بأنه مادة كسائر المواد ؛ ولكن الإنسان مع اشتراكه فى هذه (الصفات) مع الحيوان ومع المادة له (خصائص) تميزه وتفرده وتجعل منه كائناً فريداً ، كما اضطر أصحاب ( الجهالة العلمية) أخيراً أن يعترفوا والحقائق الواقعية تلوى أعناقهم لياً فييضطرون لهذا الاعتراف فى غير إخلاص ولا صراحة .
(( والإسلام – بمنهجه الربانى – يعمد إلى هذه الخصائص التى تميز ( الإنسان) وتفرده بين الخلائق ، فيبرزها وينميها ويعليها . وهوحين يجعل آصرة العقيدة هى قاعدة أساسها وجود الأمة المسلمة ، إنما يمضى على خطته تلك ، فالعقيدة تتعلق بأعلى ما فى ( الإنسان من ” خصائص “) .
(( إنه لا يجعل هذه الأخيرة هى النسب ، ولا اللغة ، ولا الأرض ، ولا الجنس ، ولا اللون ، ولا المصالح ، ولا المصير الأرضى المشترك فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان ، وهى أشبه شئ بأواصر القطيع . أما العقيدة التى تفسر للإنسان وجوده ، ووجود هذا الكون من حوله ، وترده إلى ما هو أعلى من هذه المادة وأكبر وأسبق وأبقى ، فهى أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق ، والذى يقرر (إنسانيته) فى أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه سائر الخلائق )) .
(( ثم إن هذه الأخيرة – آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج – هى آصرة حرة ، يملك الفرد الإنسانى اختيارها بمحض إرادته الواعية فأما أواصر القطيع تلك فهى مفروضة عليه فرضاً ، لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها . إنه لا يملك تغيير نسبه الذى نماه ، ولا تغيير الجنس الذى ولد به فهذه كلها أمور قد تقررت فى حياته قبل أن يولد ، لم يكن له فيها اختيار . كذلك مولده فى أراضى بعينها ، ونقطة بلغة بعينها بحكم هذا المولود ، وارتباطه بمصالح مادية معينة ومصير أراض معين – مادامت هذه هى أواصر تجمعه مع غيره – كلها مسائل عسيرة التغيير ، ومجال (الإرادة الحرة) فيها محدود . ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام هى آصرة التجمع الإنسانى ؛ فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنهج ، فهى مفتوحة دائماً للاختيار الإنسانى ، ويملك فى كل لحظة أن يعلن فيها اختياره ، وأن يقرر التجمع الذى يريد أن ينتمى إليه بكامل حريته ، فلا يقيده فى هذه الحالة قيد من لونه أو لغته أو جنسه أو نسبه أو الأرض التى ولد فيها والمصالح المادية التى تتحول بتحول التجمع الذى يريده ويختاره ، وهنا كرامة الإنسان فى التصور الإسلامى .
(( ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامى فى هذه القضية : – أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجناس والأقوام والألوان واللغات وأن صبت فى بوقته المجتمع الإسلامى خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها وانصهرت فى هذه البوتقة وتمازجت وأنشأت مركباً عضوياً فائقاً فى فترة تعد نسبياً قصيرة ، وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسفة حضارة رائعة ضخمة تحوى خلاصة الطاقة البشرية فى زمانها مجتمعة ، على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال فى ذلك الزمان .
(( .. لقد اجتمع العربى والفارس والشامى والمصرى والمغربى والتركى والصينى والهندى والرومانى والإغريقى والأندونيسى والإغريقى … إلى آخر الأقوام والأجناس اجتمعوا على قدم المساواة وبآصرة الحب ، وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة ، فبذلوا جميعاً أقصى كفاياتهم ، وأبرزوا أعمق خصائص أجنساهم ، وخصبوا خلاصة تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية فى بناء هذا المجتمع الواحد الذى ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة ، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد ، وتبرز فيها إنسانيتهم ، وحدها بلا عائق ، وهذا ما لم يتجمع قط لأى تجمع آخر على مدار التاريخ )) .
(( لقد كان أشهر تجمع بشرى فى التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلاً . فقد ضمنت بالفعل أجناساً متعددة ، ولغات وألواناً وأرضين متعددة ولكن هذا كله لم يقم على آصرة ( إنسانية) ولم يتمثل فى قيمة عليا العقيدة ؛ لقد كان هناك تجمع طبقى على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد فى الإمبراطورية كلها من ناحية ، وتجمع عنصرى على أساس سيادة الجنس الرومانى – بصفة عامة – وعبودية سائر الأجناس الأخرى .
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامى ، ولم يؤت الثمار التى أتاها التجمع الإسلامى )) .
(( كذلك قامت فى التاريخ الحديث تجمعات أخرى ، تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلاً ، ولكنه كان كالتجمع الرومانى الذى هو وريثه ، تجمعاً قومياً استغلالياً ، يقوم على أساس سيادة القومية الإنجليزية ، واستغلال المستعمرات التى تضمنها الإمبراطورية ؛ ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها :
الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية فى وقت ما ، والإمبراطورية الفرنسية .
(( وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر ، يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . ولكنها لم تقمه على قاعدة
( إنسانية) عامة .. إنما أقامته على القاعدة (الطبقية) ، فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الرومانى القديم . هذا تجمع على قاعدة طبقة ( الأشراف) ، وذلك تجمع على قاعدة طبقة (البروليتاريا) والعاصفة التى تسوده هى عاطفة الحقد الإسود على سائر الطبقات الإخرى وما كان لمثل هذا التجمع أن يثمر إلا أسوأ ما فى الكائن الإنسانى فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتكمينها باعتبار أن (المطالب الأساسية ) للإنسان هى (الطعام والمسكن والجنس)
وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام .. )) (22) .
9- والتفسير الإسلامى للتاريخ ، على خلاف سائر التفاسير الوضعية ، يعطى مساحة واسعة للغيب ، بل يجعله قاعدة أساسية من القواعد الكبرى للتصور الإسلامى حتى لقد جعل الإسلام الإيمان بالغيب مقوماً من مقومات الإيمان لا يتم إلا به :
{ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقانهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون }(23) .
(( إن الإيمان بالغيب نقلة فى حياة الإنسان ضخمة ؛ لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غيباً مجهولاً يمكن وجوده ويمكن تصوره ، هو بلا شك نقلة من دائرة الحس الحيوانى إلى مجال الإدراك الإنسانى نكسة به إلى الوراء ، وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية وتدعوه (تقدمية) ..)) (24) .
المجال الفسيح الذى يفتحه الإيمان بالغيب أمام وعى الإنسان إنما هو (( فسحة فى التصور ، وفسحة فى إدراك حقائق هذا الوجود ، وفسحة فى الشعور ، وفسحة فى الحركة النفسية والفكرية يتيحها التصور الإسلامى للمسلم .. والذين يريدون أن يغلقوا على (الإنسان) هذا المجال ، ومجال عالم الغيب كله ، إنما يريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود ، ويريدون بذلك أن يزجوا به فى عالم البهائم ، وقد كرمه الله بقوة التصور التى يملك بها أن يدرك ما لا تدركه البهائم ، وأن يعيش فى بحبوحة من المعرفة وبحبوحة من الشعور ، وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم ..
(( ماذا عند أدعياء العقلية (العلمية) من عملهم ذاته ، يحتم عليهم نفى (الغيب) وأبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لديهم من علم بوجب عليهم ذلك ، إن عملهم لا يملك أن ينفى وجود حياة من نوع آخر غير الحياة المعروفة فى الأرض فى أجرام أخرى يختلف تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها ، فلماذا يجزمون بنفى هذه العوالم وهم لا يملكون دليلاً واحداً
على نفى وجودها ؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضية أن الغيب الذى ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة التى يجزم هذا العلم اليوم بوجودها ، حتى فى عالم الشهادة الذى تلمسه الأيدى وتراه العيون )) (25) .
(( إن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذى لا يعلم مفاتحه إلا الله ، وبين الاعتقاد بالسنن التى لا تتبدل والتى تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان فى الأرض ، والتعامل معها على قواعد ثابتة ، فلا يفوت المسلم (العلم) البشرى فى مجاله ، ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة لواقعة ، وهى أن هنالك غيباً لا يطلع الله عليه أحداً إلا من شاء بالقدر الذى يشاء ..)) (26) .
☼☼☼
ويكاد يكون وقوف سيد عند معركة (أحد) أطوال وقوف عند معركة من معارك عصر الرسالة التى تحدث عنها كتاب الله ، على مستوى التفسير التاريخى وليس التاريخ الصرف ، فهو ينشر تفسير الآيات التسع والخمسين المتعلقة بها من سورة آل عمران على مساحة تزيد على المائة والعشرين صفحة . وهو يبدأ كعادته بتقديم الخطوط العريضة للرؤية القرآنية للمعركة ، ويثنى باستعراض وقائعها التاريخية كما وردت فى كتب السيرة ، ثم يلج بعدئذ التفسير .
إن القرآن الكريم يؤكد فى تعامله مع هذه المعركة ، القيم والقوانين التى استخلصها من معركة بدر ، ولكنه هنا يوسعها ويغنيها ويزيد عليها ، باعتبار أن مذاق أحد ليس كمذاق بدر ، وأن معطياتهما التاريخية والعقيدية ليستا سواء .
– فى البدء يشير سيد إلى واحدة من خصائص القرآن المنهجية فى التعامل مع التاريخ . إنه لا يستهدف – البتة – العرض المجرد للوقائع والأحداث ، كما كان يفعل – ولا يزال – الكثير من المؤرخين ، ولكنه يتجاوز القشرة الخارجية للحدث بحثاً عن المغزى والمعنى ، ويتوغل فى نسيج الفعل التاريخى لكى يضع يده على السنن والقوانين التى تشد وقائعه وتحركها فى الوقت نفسه .
إن القرآن الكريم لا يقدم تأريخاً للأحداث ولكنه يطرح تفسيراً ، وهو لا يقف عند حدود الساحة الظاهرية التى تتحرك على مسرحها الوقائع وتتخلق الأحداث ، ولكنه يمد كشافاته الضوئية إلى السرائر والدخائل ، عمقاً ، وإلى آفاق العالم وآماد الكون امتداداً .. إنه يعتمد نظرة كلية تتجاوز التقطيع والتضيق إلى كل ما من شأنه أن يلعب دوره فى صياغة الوقائع والأحداث .
(( إن النص القرآنى لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ، ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ، ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه ، وهو لا يعرض الحوادث عرضاً تاريخياً مسلسلاً بقصد التسجيل ، إنما هو يعرضها للعبرة والتربية واستخلاص القيم الكامنة وراء الحوادث ، ورسم سمات النفوس وتصوير الجو الذى صاحبها ، والسنن الكونية التى تحكمها ، والمبادئ الباقية التى تقررها . وبذلك تستحيل الحادثة محوراً أو نقطة ارتكاز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات والنتائج والاستدلالات . يبدأ السياق منها ، ثم يستطرد حولها ، ثم يعود إليها ، ثم يجول فى أعماق الضمائر وفى أغوار الحياة ، ويكرر هذا مرة بعد مرة ، حتى ينتهى برواية الحادث إلى نهايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعانى والدلائل والقيم والمبادئ ، لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إليها ، ونقطة ارتكاز تتجمع حواليها ، وحتى يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله فى الضمائر ، فجلالها ونقاها وأراحها فى مواضعها فلا تجد النفس منها حيرة ولا قلقا ، ولا تحس فيها لبساً ولا دخلاً .
((وينظر الإنسان فى رقعة المعركة ، وما وقع فيها – على سعته وتنوعه – ثم ينظر إلى رقعة التعقيب القرآنى ، وما تناوله من جوانب ، فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك وأبقى على الزمن ، وألصق بالقلوب ، وأعمق فى النفوس ، وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية وحاجات الجماعة الإسلامية ، فى كل موقف تتعرض له فى هذا المجال على تتابع الأجيال . فهى تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلة والمبادئ المطلقة من وراء الظواهر العارضة ، والرصيد الصالح للتزويد بغض النظر عن اعتبارات الزمان والمكان )) (27) .
11- وفى البدء ، يرسم أرضية الحدث التاريخى بما يعمق حقيقية الحضور الإلهى وفى التاريخ .
إن هذا( الحضور ) المؤثر ، الفعال ، صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى مجرى الواقعة التاريخية ، لا يؤتى ثماره التربوية والعقيدية فى النفس المؤمنة التى يتأكد لديها لحظة بعد لحظة الفعل الإلهى فى عالم الواقع ، فحسب ، ولكنه يؤكد – كذلك – حقيقة تفسيرية من أهم حقائق التفسير الإسلامى للتاريخ ؛ ففى التفاسير الوضعية يحضر (العقل الكلى ) خلال تخلق الأحداث ، أو تحضر التحديات والاستجابات .
ولكننا هنا إزاء حضور إلهى شامل ، كامل ، فاعل ، مريد ، وليست كل الصيغ الحضور الجزئية الأخرى : فكرية أم مادية أم طبيعية أم نفسية ، سوى وسائل فحسب يستخدمها الحضور الكبير الشامل لتحقيق الفعل وترتيب النتائج وتركيب الوقائع والأحداث .
أما على المستوى التربوى – العقيدى فإن القرآن ينفذ ما يسمى بإحياء الموقف التاريخى ، وتفجير الدم فى أوردته وشرايينه ؛ إنه لا يتعامل معه كما لو كان ظواهر جامدة ، وأحداثاً متيبسة ، قد أخذت صيغة النهائية وتجمدت عليها ، ولكن كما لو كان يتخلق هذه اللحظة أمام القلوب والأبصار .. يتحرك وينمو ويكتسب ملامحه لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة ، وهو بهذه الصيغة (الإحيائية) يجعل التاريخ فعلاً تربوياً مؤثراً ، وأداة حركية للبناء العقيدى على مستوى الذات ومستوى الجماعة ، وليس مجرد عرض أكاديمى أو دراسة جامدة .
وهكذا يلتقى الخطان : الحضور الإلهى والحضور الإنسانى فى قلب التاريخ ، ومن خلال هذا الحضور يطرح القرآن الكريم تعاليمه وقيمه ودورسه فتستقبلها الأرض التى عرف زارعها كيف يهيئها للإنبات الغزير .. الجميل .
(({وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون } . هكذا يبدأ باستعادة المشهد للمعركة واستحضاره ،وقد كان قريباً من نفوس المخاطبين الأولين بهذا القرآن ومن ذاكرتهم ؛ ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو واستحضار المشهد الأول بهذا النص ، من شأنه أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته ، وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور ، وأولها حقيقة حضور الله – سبحانه – معهم ، وسمعه وعلمه بكل ما كان وما دار بينهم . وهى الحقيقة التى تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها فى التصور الإسلامى . وهى هى الحقيقة الأساسية الكبيرة التى أقام عليها الإسلام منهجه التربوى .. إن القرآن يتولى استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها بالتعقيب على الأحداث وهى ساخنة ، ويتبين الفرق بين رواية القرآن للأحداث وتوجيهها وبين سائر المصادر التى قد تروى الأحداث بتفصيل أكثر ، ولكنها لا تستهدف القلب البشرى والحياة البشرية بالإحياء وبالاستجاشة وبالتربية والتوجيه كما يستهدفها القرآن الكريم بمنهجه القويم )) (28) .
12 – وثمة لمسة منهجية ثالثة : إن القرآن الكريم وهو يحكى عن معركة أحد ويعقب عليها يذكر المؤمنين بمعركة بدر لكى يقوموا بالموازنة والمقارنة والبحث فى الارتباطات بين الأسباب والنتائج .
والجهد التاريخى لن يستكمل شروطه إلا بالموازنة والمقارنة والتمحيص بين التجارب والأحداث . إن القرآن الكريم يعمق فى حس المسلم هذه الضرورة المنهجية لكى يقوده إلى جنى ثمارها التربوية والعقيدية .. نعم ، لكنه يضيف إلى خبراته فى الوقت نفسه خبرة (تاريخية) لم يكن الفكر البشرى قد عرف عنها الكثير .
(( .. وقبل أن يمضى (القرآن) فى الاستعراض والتعقيب على أحداث معركة (أحد) التى انتهت بالهزيمة ، يذكرهم بالمعركة التى انتهت بالنصر ، معركة بدر ، لتكون هذه أمام تلك مجالاً للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج ، ومعرفة مواطن القوة ، وأسباب النصر وأسباب الهزيمة . ثم – بعد ذلك ليكون اليقين من أن النصر والهزيمة كليهما قدر من أقدار الله ، لحكمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء الهزيمة سواء ، وأن مرد الأمر فى النهاية إلى الله على كلا الحالين وفى جميع الأحوال ..)) (29) .
13- الناموسية التاريخية ، أو القانونية التاريخية – مرة أخرى – : هى واحدة من القواعد الأساسية للتفسير الإسلامى للتاريخ ، قالها كتاب الله قبل أن يقول بها أحد ، وأكدها فى عشرات المواضع يوم أن لم تكن حركة التاريخ فى تصور العقل البشرى ، وظطاعمال المؤرخين أنفسهم ، سوى سلسلة غير مترابطة الحلقات من الحلقات من الحوادث ، وحشود من الوقائع لا تدرى فيها الأسباب والنتائج ، وصدف وفلتات لا يربطها نظام ولا يحركها قانون ولا تشدها سنة .
ويعد المقطع القرآنى التالى ، الذى هو قيمة التصعيد فى الحديث عن معركة اٌحد ، والذى يؤكد على الناموسية التاريخية ، واحدة من أشد الإضاءات القرآنية كثافتة وامتدادًا فى حقل التفسير الإسلامى للتاريخ ، ولذا يقف عنده سيد طويلاً مستخلصاً القيم والمؤشرات والتعاليم :
{ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين }(30) .
(( إن القرآن الكريم يرد المسلمين هنا – فى معركة أحد – إلى سنن الله فى الأرض يردهم إلى الأصول التى تجرى وفقها الأمور . فهم ليسوا بدعاً فى الحياة ، فالنواميس التى تحكم الحياة جارية لا تختلف ، والأمور لا تمضى جزافاً ، إنما هى تتبع هذه النواميس ، فإذا هم دروسوها وأدركوا مغازيها – : تكشف لهم الحكمة من وراء الأحداث ، وتبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع ، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذى تتبعه الأحداث وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام .
واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان فى ماضى الطريق . ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين لينالوا النصر ؛ وفى أولها طاعة الله وطاعة الرسول ، والسنن التى يشير إليها السياق هنا ، ويوجه أبصارهم إليها هى : عاقبة المكذبين على مدار التاريخ ، ومداولة الأيام بين الناس ، والابتلاء لتمحيص السرائر ، وامتحان قوة الصبر على الشدائد ، واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين .
(( .. إن القرآن ليربط ماضى البشرية بحاضرها ، وحاضرها بماضيها ، فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . وهؤلاء العرب الذى وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ولم تكن معارفهم ، ولم تكن تجاربهم – قبل الإسلام – لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة لولا هذا الإسلام وكتابه – القرآن – الذى أنشأهم به الله نشأة أخرى وخلق به منهم أمة تقود الدنيا .
(( إن النظام القبلى الذى كانوا يعيشون فى ظله ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة ومجريات حياتهم ، فضلاً عن الربط بين سكان هذه الأرض وأحداثها ، فضلاً عن الربط بين الأحداث العالمية والسنن الكونية التى تجرى وفقها الحياة جميعاً . وهى نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة ، ولم تنشأ من مقتضيات الحياة فى ذلك الزمان ، إنما حملتها إليها ، وارتقت بهم إلى مستواها فى ربع قرن من الزمان ، على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير الحالى إلا بعد قرون ، ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية إلا بعد أجيال وأجيال . فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلهية ، وأنه إلى الله تصير الأمور . فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله ، واتسع له تصورها ، ووقع فى حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة ، فاستقامت حياتها على التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان – بعد هذا – إلى مشيئة الطليقة ..)) (31) .
14 – يخلص سيد إلى تقرير واحد من الحقائق الأساسية فى التفسير الإسلامى للتاريخ ، الحقيقة التى سبق وأن أكدها فى تعامله مع سورة الأنفال ، وسوف يعود إلى تأكيدها عبر تعامله مع سور القرآن جميعا ، تلك هى أن فاعلية الله فى التاريخ تعمل من خلال الطبيعة حيناً ومن خلال الإنسان حيناً آخر ، تحرك القوى المادية المنظورة حيناً آخر ، تعتمد السنن والنواميس حيناً ، وتخترقها بالمعجزات والخوارق حيناً آخر …
وتبقى إرادة الله قبل هذا كله ، وبعد هذا كله ، هى التى تصنع التاريخ .
(( وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة فى التصور الإسلامى ، وعلى تنقيتها من كل شائبة ، وعلى تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة ، لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب ، بين قلب المؤمن وقدر الله ، بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط كما هى فى عالم الحقيقة بمثل هذه التوجيهات المكررة فى القرآن ، المؤكدة بشتى أساليب التوكيد ، استقرت هذه الحقيقة فى أخلاد المسلمين على نحو بديع ، هادئ عميق ، مستنير . عرفوا أن الله هو الفاعل – وحده ، وعرفوا كذلك أنهم مأمرون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب ، وبذل الجهد ، والوفاء بالتكاليف ؛ فاستيقنوا الحقيقة ،
وأطاعوا الأمر فى توازن شعورى وحركى عجيب ))(32) .
وفى مقابل هذه الحقيقة تقف حقيقة أخرى توازنها وتوازينها : أنه بدون الفعل البشرى التاريخ لن يتحقق شئ على الإطلاق !
فى التفسير الإسلامى تتوافق أفعال البشر مع إرادة الله ، تتناغم وتتلاقى ، ليس ثمة ارتطام أو تناقض أو تعارض كما يخيل للفكر الوضعى ، بل إن الأمر واضح بين : أن المصير الذى يختم به الله على هذه الحركة أو تلك ، وعلى هذه التجربة ، أو تلك ، إنما يستمد خطوطه وألوانه وتكويناته من صميم المقومات التى صاغت الحركة ، والخيوط التى نسجت التجربة ، وتبقى إرادة الله محيطة بالوجود والمصير ، ويبقى الابتلاء هو المحك الذى يشكل الوجود ويقود إلى الختم على المصير .
إن القرآن الكريم يسعى إلى يكشف للمسلمين عن طرف من حكمة الله وتدبيره وراء الآلام التى تعرضوا لها ، والأحداث التى وقعت بأسبابها الظاهرة :
(( .. {ثم صرفكم عنهم ليبتليكم } ، لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر .
فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا ، صرف الله قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين ، وصرف الرماة عن ثغرة الجبل ، وصرف المقاتلين عن الميدان فلاذوا منهم ؛ لكن مدبراً من الله ليبتليهم بالشدة والخوف والهزيمة والقتل والقرح ، وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونات القلوب ، ومن تمحيص النفوس وتمييز الصفوف . وهكذا تقع الأحداث مرتبة بحسابها ، بلا تعارض بين هذا وذاك ، فلكل حادث سبب ، ووراء كل سبب تدبير )) (34) .
(( إن التصور الإسلامى يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله – سبحانه – وتحقق هذا القدر فى الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله . إن سنة الله تجرى بترتيب النتائج على الإسباب ، ولكن الإسباب ليست هى التى (تنشئ) النتائج ؛ فالفاعل المؤثر هو بقدره ومشيئته ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدى واجبه ، وأن يبذل جهده ، وأن يفى بالتزاماته . وبقدر ما يوفى بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله ، فهو يعمل ويبذل ما فى طوقه ، وهو يتعلق فى نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته ..)) (35) .
15 – والتفسير الإسلامى للتاريخ يتميز بالشمولية والموضوعية والواقعية .
الشمولية التى تنظر إلى كل صغيرة وكبيرة فى صيرورة الحدث التاريخى ، وتحسب حسابها لكل الأسباب ، وترفض الجنوح باتجاه النظرة أحادية الجانب ، كما يفعل الوضعيون ، فتؤكد على هذا السبب أو ذاك ، وتقف عند هذا الجانب أو ذاك ، مهملة الأسباب والجوانب الأخرى بالكلية حيناً ، واضعة إياها فى المرتبة الثانية أو العاشرة حيناً آخر .
وبالموضوعية لأنه يصدر عن الله سبحانه فلا يميل به هوى أو مصلحة أظن ، ولا تأسره فئة ، أو طبقة ، أو جماعة ، أو أمة ، ولا تحجب نفاذه وإحاطته تأثيرات نسبية لعصر أومكان .. إنه فوق الأهواء والمصالح والظنون ، فوق الفئات والطبقات والجماعات ، فوق نسبيات الزمان والمكان .
وبالواقعية لأنه يقر سائر مكونات الواقعة التاريخية ، ويحترمها ، ويشير لها ، حتى ولو كانت ممارسة اقتصادية صرفة ، أو عملاً جنسياً ، أو طعاماً وشراباً ، ويذكر الأسماء بمسمياتها الحقيقية ، فلا تغدو الهزيمة – فى تبرير ملتو – نصراً ، ولا تزيف الوقائع لكى تخدم هذه الرؤية النسبية القاصرة أو تلك .
وسيد يقف عند هذه الميزة المنهجية ، كما وقف عند الميزات المنهجية السابقة ، ويرد معطيات القرآن التى تتحدث عن قضايا من مثل الربا والإنفاق والفساد الاجتماعى ، وما يبدو فى ظاهره بعيداً عن المجرى الأساسى للعرض المنصب على معركة حربية ، ويردها إلى : هذه القاعدة المنهجية ، وتلك النظرة الشمولية ، فى كتاب الله وفى نسيج الإسلام على السواء .
(( قبل أن يدخل السياق – القرآنى – فى صميم الاستعراض للمعركة – معركة أحد – والتعقيبات على وقائعها وأحداثها ، تجئ التوجيهات المتعلقة بالمعركة الكبرى ، المعركة فى أعماق النفس وفى محيط الحياة ، يجئ الحديث عن الربا والمعاملات الربوية ، وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله ، وعن الإنفاق فى السراء والضراء ، والنظام التعاونى الكريم المقابل للنظام الربوى الملعون ، وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس وإشاعة الحسنى فى الجماعة ، وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئة .
(( .. تجئ هذه التوجيهات كلها قبل الدخول فى سياق المعركة الحربية لتشير إلى خاصة من خواص هذه العقيدة : الوحدة والشمول فى مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كلها ، ورده إلى محور واحد : محور العبادة لله والعبودية والتوجه إليه بالأمر كله . والوحده والشمول منهج الله وهيمنته على الكينونة البشرية فى كل حال من أحوالها ، وفى تشير تلك التوجيهات بتجمعها هذا إلى الترابط بين كل ألوان النشاط الإنسانى ، وتأثير هذا الترابط فى النتائج الأخيرة لسعى الإنسان كله .
(( والمنهج الإسلامى يأخذ النفس من أقطارها ، وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق ومن ثم هذا الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية ، وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب والسيطرة على الأهواء والشهواء ، وإشاعة الود والسماحة فى الجماعة ، فكلها قريب من قريب ، وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه السمات وكل توجيه من هذه التوجيهات يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة ، وبكل مقدارتها فى ميدان المعركة وفى سائر ميادين الحياة )) (36).
إن الرؤية الإسلامية ليست مثالية تطرح أخيلة معلقة لا يمكن تنفيذها تاريخياً ، ومجتمعاً ملائكياً من البشر لا يخطئ ولا ينحرف ولا يضل به الطريق ، بل يظل معلقاً هناك فى القمة . وهى – أى : الرؤية الإسلامية – ليست – كذلك – صماء تدعو إلى قيام مجتمع يتساوى فيه المجتمع كالأرقام ، ويسيرون عبر طريق محدد ، مرسوم سلفاً ، دونما جهد منهم أو مقاومة .
إنما هى رؤية واقعية متوازنة ، تجد رصيدها الكبير من إمكانيات التنفيذ ، وتنوعها الذى ينسجم وحجم الإنسان ، وقدراته ، وطموحاته .
(( إن النفس البشرية ليست كاملة – فى واقعها – ولكنها فى الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء ، حتى تبلغ أقصى الكمال المقدر لها فى هذه الأرض . وها نحن أولاء نرى – فى معركة أحد – قطاعاً من القطاعات البشرية – كما هو وعلى الطبيعة – ممثلاً فى الجماعة التى تتمثل قمة الأمة التى يقول الله عنها : { كنتم خير أمة أخرجت للناس } ، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .. فماذا نرى ؛ مجموعة من البشر فيهم الضعف وفيهم النقص .. وفيهم من ينهزم وينكشف .. وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ؛ ولكنهم كانوا فى أوائل الطريق ، كانوا فى دور التربية والتكوين ، ولكنهم كانوا جادين فى أخذ هذا الأمر ، مسلمين أمرهم لله ، مرتضين قيادته ، ومن ثم لم يطردهم الله من كنفه ، بل رحمهم وعفا عنهم .. ثم وصلوا فى النهاية وغلبت فيهم النماذج التى كانت فى أول المعركة معدودة ..ولكنهم مع هذا ظلوا بشراً ، وظل فيهم الضعف والنقص والخطأ .. إنها الطبيعة البشرية التى يحافظ عليها هذا المنهج ولا يبدلها أو يعطلها ، ولا يحملها ما لا تطيق ، وإن بلغ بها الكمال المقدر لها فى هذه الأرض )) (37) .
16 – ومن عجب أن أشد مذاهب التفسير التاريخى جماعية وإنكاراً للفردية ، وهى المادية التاريخية ، ينتهى الأمر بأصحابها إلى نوع من الفردية فى التعامل مع (الزعيم) والنظر إليه ، حياً وميتاً ، فيما يعد تناقضاً مكشوفاً بين النظرية وبين وقائع المشهود ، لقد غدا ماركس ولنين وستالين وماوتسى تونج .. الخ أرباباً ليس من دون الله ، فالشيوعيون لا يقرون وجوده ، ولكن من فوق العقيدة الماركسية نفسها تلك التى تنكر دور الفرد فى التاريخ وتلغيه إلغاء ، ثم إذا بهؤلاء ، وغيرهم من قادة الفكر والحركة الشيوعية فى العلم ، يتأهلون على الأتباع ، ويتضخم دورهم (البطولى) فيما يعضهم فى مرتبة الآلهة التى لا تخطئ ، ولا يرد لها رأى أو ينقض لها كلام . ويزداد الأتباع فى المقابل انكماشاً وتضاؤلاً أمام طواغيتهم هؤلاء ويتنازلون عن كل حق مادى أو أدبى من حقوقهم الأساسية ، وملامحهم كبشر لكى تحنطه وتجمله ، على الطريقة الفرعونية التى تتعامل مع فرعون كما لو كان ابن الآلهة ، ثم تضعه فى معارض من زجاج تقف إزاءها طوابير العابدين بخشوع لكى تمر قريباً منها فتلقى تحية الذلة وتتلقى البركات .
هذا فى إطار دولة ترى فى المادية التاريخية التى تنكر دور الأفراد ، عقيدة وفلسفة ودستوراً ، فماذا فى إطار رؤية الإسلام وتجربته ؛ ماذا بصدد الرسول القائد الذى جاء بهذا الدين وقاده فى الرحلة الصعبة إلى مشارف الفوز ؛ ماذا بصدد محمد عليه السلام ، وهو النبى الموصول بالسماء ، وبقدر الله ، وملأءه الأعلى ؛ لا شئ على الإطلاق مما يشم منه رائحة تعبد أو صنيمة أو استعلاء .. إنه واحد من الناس يعيش كما يعيشون ، ويموت كما يموتون ، والذى يبقى هو العقيدة وحدها .
ذلك ملمح أصيل من ملامح الرؤية العقيدية فى الإسلام ، وبالتالى من ملامح نظرة الإسلام للتاريخ وعناصر تكوينه ، إن الأنبياء – كأفراد متميزين – يسهمون ليس فى صياغة التاريخ فحسب ، ولكن فى قيادته وتوجيهه ، إلا أن هذا لا يجنح بهم إلى أن يكونوا فوق الناس ، ولا أن يجرد أتباعهم ، إزاءهم ، من محتواهم البشرى ، إذا صح التعبير ، لكى يغدوا أرقاماً وأدوات ؛ إنهم جميعاً يسهمون فى صنع التاريخ والموجه الأبدى هو العقيدة التى تنزلت من السماء . إن كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام تقول بهذا ، وتجربة خلفائه الراشدين تؤكده وتعززه .
إن سيد يقف عند هذا الملمح فى التفسير الإسلام للتاريخ وهو يقرأ هذة الآية { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين } (38) .
(( إن محمداً ليس إلا رسولاً سبقته الرسل . وقد مات الرسل . ومحمد سيموت كما مات الرسل قبله … إنه جاء ليبلغ كلمه الله ، والله باق لا يموت ، وكلمته باقية لا تموت ، وما ينبغى أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات النبى الذى جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل .. إن البشر إلى فناء والعقيدة إلى بقاء ، ومنهج الله للحياة مستقل فى ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .
(( .. إن الدعوة أقدم من الداعية ، وأكبر وأ بقى .. فدعاتها يجيئون ويذهبون وتبقى هى على الأجيال والقرون ، ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول الذى أرسل بها الرسل ، وهو باق – سبحانه – يتوجه إليه المؤمنون .
(( .. وكأنما أراد الله سبحانه بهذة الآية أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو حتى بينهم ، وأن يجعل ارتباطهم بالإسلام مباشرة ، وأن يجعل مسؤوليتهم فى هذا العهد أمام الله بلا وسيط حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة التى لا يخليهم منها أن يموت الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو يقتل ، فهم إنما بايعوا الله وهم أمام الله مسئولون )) (39) .
17 – ويؤكد سيد ، مراراً ، اعتماداً على المعطيات القرآنية نفسها ، وحدة الحركة الدينية فى التاريخ ، بدء بآدم وانتهاء بالرسول عليهما السلام مروراً بالأنبياء الكرام جميعاً وبالمنتمين إليهم جيلاً بعد جيل . إن مصدر التلقى واحد ، والهدف واحد ، والشريعة واحدة ، والخصم واحد ، والمعركة واحدة وإن امتد بها الزمن وشطت بها الأماكن والديار . ويتمخض عن ذلك كله خبرة متوحدة تقتبس منها وتمشى على هديها أجيال المؤمنين جيلاً بعد جيل .
إن (الجماعة المؤمنة) ، بقيادة هذا النبى الكريم أو ذاك ، هى وحدة العمل والفاعلية فى التاريخ : ليست الطبقة ، أو الدولة ، أو العرق ، كما ترى نظريات التفسير المادية أو المثالية أو الحضارية أو غيرها . الجماعة المؤمنة تواجه قوى الكفر والضلال وتقود حركة التاريخ صوب الأحسن والأرقى ، وتخرج بالناس من ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .
من الظلمات إلى النور .. ذلك هو الشعار الواحد الذى رفعه الأنبياء جميعاً ، وقاتلت دونه كل الأجيال التى انتمت إليه قرناً بعد قرن .
فإذا كان المسلمون قد ابتلوا فى (أحد) ، وزلزلوا فى الخندق ، وتراجعوا فى (حنين) ، فإن جماعات كثيرة من إخوانهم المؤمنين الذين سبقوهم على الدرب ، ابتلوا وزلزلوا وتراجعوا ؛ ولكنهم بإصرارهم ، بيقينهم ، بإيمانهم بعدالة قضيتهم ، ثبتوا وتماسكوا وتفوقوا وحققوا الانتصار الموعود .
{ وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانتصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين }.. إن المثل الذى يضربه الله سبحانه – للمسلمين فى أحد ، مثل عام ، لا يحدد فيه نبياً ، ولا يحدد فيه قوماً ؛ إنما يربطهم بموكب الإيمان ، ويعلمهم أدب المؤمنون ، ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد فى كل دعوة وفى كل دين ، ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء ، ليقرر فى حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ، ويقرر فى أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد ، وأنهم كتيبة فى الجيش الإيمانى الكبير .. )) (40) .
18- ويشير سيد إلى ما يعد ملحماً أساسياً آخر من ملامح التفسير الإسلامى للتاريخ :
((إن أية فكرة ، أو عقيدة ، أو شخصية ، أو منظمة .. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كامنة وسلطان قاهر ؛ هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من (الحق ) أى بمقدار ما فيها من توافق مع القاعدة التى أقام الله عليه الكون ، ومع سنن الله التى تعمل فى هذا الكون . وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان الحقيقين الفاعلين المؤثرين فى هذا الوجود ؛ وإلا فهى زائفة باطلة ضعيفة واهية مهما بدا فيها من قوة والتماع وانتفاش .
(( والمشركون يشركون مع الله آلهة أخرى فى صور شتى ، ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله – سبحانه – شيئاً من خصائص الألوهية ومظاهرها .. فماذا تحمل الآلهة من الحق الذى أقام الله عليه الكون ؛ إن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى خالقه الواحد ، وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ، ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منازع ، ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد . فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد فى معناها الشامل ، فهو زائف باطل ، مناقض للحق الكامن فى بنية الكون ، ومن ثم فهو واه هزيل ، لا يحمل قوة ولا سلطانا ، ولا يملك أن يؤثر فى مجرى الحياة ، بل لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة !
((ومادام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا ، من الآلهة والعقائد والتصورات ، فهم يرتكنون إلى ضعف وخواء ، وهم أبداً خوارون ضعفاء وهم أبداً فى رعب حيثما التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى حق ذى سلطان .
((وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل .وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام الحق الأعزل ، ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب ، ويرتجف من كل حركة وكل صوت وهو فى حشده المسلح المحشود . فأما إذا قدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب فى صفوف الباطل ، ولو كانت له الحشود ، وكان للحق القلة تصديقاً لوعد الله {سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا } ..)) (41) .
لكن سيد لا يقف عند هذا الجانب من الصورة ، وينتقل – فى مكان آخر – إلى الجانب الثانى لكى يجيب ؛ من خلال المعطيات القرآنية نفسها ، على سؤال ملح طالما حاك فى أذهان المؤمنين أنفسهم : (( لماذا يصاب الحق ويجنو الباطل ويعود بالغلبة والغنيمة ؟ أليس هو الحق الذى ينبغى أن ينتصر ؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه النتيجة وفيها فتنة القلوب وهزة ؟
((ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد فى دهشة واستغراب { أنى هذا }، ففى المقطع الخاتمى للمعركة يجئ الجواب الأخير ، ويريح الله القلوب المتعبة ، ويجلو كل خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية ، ويبين سنته وقدره وتدبيره فى الأمر كله : أمس واليوم معركة فانتهت بمثل ماانتهت إليه أحد .
(( إن ذهاب الباطل ناجياً فى معركة من المعارك ، وبقاءه منتفشاً فترة من الزمان ، ليس معناه أن الله تاركه ، أو أنه من القوة بحيث لا يغلب ، أو بحيث يضر الحق ضرراً باقيا قاضياً ؛ وأن ذهاب الحق مبتلى فى معركة من المعارك ، وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان ليس معناه أن الله مجافيه أو ناسيه ، أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه !! كلا إنما هى حكمة وتدبير ، هنا وهناك : يملى للباطل ليمضى إلى نهاية الطريق ، وليرتكب أبشع الآثام ، وليحمل أثقل الأوزار ، ولينال أشد العذاب باستحقاق ؛ ويبتلى الحق ، ليميز الخبيث من الطيب ، ويعظم الأجر لمن يمضى مع الابتلاء ويثبت ؛ فهو الكسب للحق والخسارة للباطل ، مضاعفاً هذا وذاك هنا وهناك )) (42) .
19 – وحتى (الشيطان) ، فإن له فى التفسير الإسلامى للتاريخ مكانة ! إنه الباطل مجسداً فى حركة التاريخ ، وإنه ليقف من وراء كل محاولات الإفساد والتخريب والتفكك والتحلل والدمار فى تاريخ البشرية . إنه نقيض الإيمان ، والبناء ، والإصلاح ، والتماسك والتقدم ، وإنه ليبذل جهده الدائم الموصول لتحقيق أهدافه المضادة بك لصيغة ، وبكل أسلوب ، ومن خلال نظم وزعامات وطواغيت وأتباع يسعى إلى وقف حركة الإيمان والتقدم ، والخروج بالناس من الظلمات إلى النور .
وهو يحاول (( أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب ، وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة . ومن ثم ينبغى أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان وأن يبطلوا محاولته ؛ فلا يخافوا أولياءه هؤلاء ولا يخشوهم ؛ بل القادر الذى ينبغى أن يخاف
{إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنون }.
((إن الشيطان هو الذى يضخم من شأن أوليائه ، ويلبسهم لباس القوة والقدرة ، ويوقع فى القلوب أنهم ذوو حول وطول ، وأنهم يملكون النفع والضر ، ذلك ليقضى بهم أغراضه ، وليحقق بهم الشر فى الأرض والفساد ، وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب ، فلا يرتفع فى وجوههم صوت بالإنكار ، ولا يفكر أحد فى الانتفاض عليهم ودفعهم عن الشر والفساد .
((والشيطان صاحب مصلحة فى أن ينتعش الباطل ، وأن يتضخم الشر وأن يتبدى قوياً قاهراً بطاشاً جباراً ، لا تقف فى وجهه معارضة ، ولا يصمد له مدافع ، ولا يغلبه من المعارضين غالب .. فتحت ستار الخوف والرهبة ، وفى ظل الإرهاب والبطش ، يفعل أولياؤه فى الأرض ما يقر عينه : يقلبون المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، وينشرون الفساد والباطل والضلال ، ويخفقون صوت الحق والرشد والعدل ، ويقيمون أنفسهم آلهة فى الأرض تحمى الشر وتقتل الخير ، دون أن يجرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف فى وجههم ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة ، بل دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذى يروجون له وجلاء الحق الذى يطمسونه .
((والشيطان ماكر خادع غادر ، يختفى وراء أوليائه ، وينشر الخوف منهم فى صدور الذين لا يحتاطون لوسوسته ، ومن هنا يكشفه الله ويوقعه عارياً لا يستره ثوب من كيده ومكره ، ويعرف المؤمنين الحقيقة : حقيقة مكره ووسوسته ليكونوا منها على حذر ، فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم ، فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه ويستند إلى قوته . إن القوة الوحيدة التى تخشى وتخاف هى القوة التى تمتلك النفع والضر ، هى قوة الله ، وهم حين يخشونها وحدها يكونون أقوى الأقوياء ؛ فلا تقف لهم قوة فى الأرض ، لا قوة الشيطان ، ولا قوة أولياء الشيطان {فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين }..)) (43) .
20 – وإذا كانت ثمة حتمية فا التاريخ البشرى فإنها حتمية الموت الذى يختم على حياة الناس جميعاً : قادة وأناساً عاديين ، أنبياء وأتباعاً {إنك ميت وإنهم ميتون }(44) ، {وما محمد إلا رسول الله قد خلت من قبلهم الرسل }(45) ، {أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة }(46) ..الخ . ولكن الإسلام يطرح تصوره المتميز للموت فيمنحه بعداً جديداً ، ويحوله من إرادة انكماش واستلاب إلى وسيلة انتشار وعطاء . إنه فى المنظور الإسلامى – والدينى عموماً – ليس سوى نقلة إلى عالم الخلود ، وأن الشهداء على وجه الخصوص لن يظلون أحياء . إن هذا التصور ، أو هذه الحقيقة المؤكدة قرآنياً بعبارة أدق ، لن يقتصر مردودها على نطاق الذات المؤمنة ، ولكنه يتحول إلى فعل إيجابى على مستوى الجماعة ، إلى فعل تاريخى يدفع حشود المؤمنين إلى مزيد من الفاعلية والعطاء ، ويخضهم على الإقدام والاقتحام والتضحية ، ويكسر فى دروبهم متاريس الحزن والتردد والخوف ، فيختزلون وهم يركضون إلى الشهادة حيثيات الزمن والمكان ، ويفعلون الأفاعيل ، ويجابهون التاريخ وحركته بطاقات تتجاوز منطق الحساب والقياس ، وتتآبى على التحليل والتعليل . إن التاريخ الإسلام فى فتراته المتألقة ، فترات التقدم والازدهار والانتشار ، عصور التغيير الجذرى العميق لخرائط العالم ، وإقامة دنيا سعيدة ، متوحدة ،عادلة ، كانت تسهم فى صنعه هذه الرؤية ، بينما فى المذاهب الوضعية يغدو الموت عنصر ابتراز واستلاب ، ونكوص وزوال ، يقطع ويشل ، ويتصدى لمشاريع الإنسان .
فى الرؤى الوضعية يغدو الموت غياباً ، أما فى التصور الإسلامى فإنه حضور فى قلب التاريخ .
((.. إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة فى تصور الأمور . إنها تعدل ، بل تنشئ إنشاء ، تصور المسلم للحركة الكونية التى تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها وهى موصلة لا تنقطع ، فليس الموت خاتمة المطاف ، بل ليس حاجزاً بين ما قبله وما بعده على الإطلاق .
إنها نظرة جديدة لهذا الأمر ، ذات آثار ضخمة فى مشاعر المؤمنين ، واستقبالهم للحياة والموت ، وتصورهم لما هنا وما هناك …
(( .. إنها تعديل كامل لمفهوم الموت – متى كان فى سبيل الله – وللمشاعر المصاحبة له فى نفوس المجاهدين أنفسهم ، وفى النفوس التى يخلفونها من ورائهم ، وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها ، بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة ، كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة ، وحيث تستقر فى مجال فسيح عريض لا تعترضه الحواجز التى تقوم فى أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صور ، ومن حياة إلى حياة .
((ووفقاً لهذا المفهوم الجديد ،للموت سارت خطى المجاهدين الكرام فى طلب الشهادة – فى سبيل الله – وكانت منها تلك النماذج (الفريدة ) فى التاريخ ..)) (47) .
☼☼☼
وهكذا يتأكد لنا ما سبق وأن بدأنا به هذا الفصل من أن سيد – عبر ظلاله – قد قدم مساحات واسعة مما يمس التفسير الإسلامى للتاريخ من قريب أو بعيد ، بشكل مباشر أو غيرمباشر ، وأنه ما من مسألة أساسية لها علاقة ما بالموضوع إلا ونجد الرجل يقول كلمته فيها من خلال تفسيره لهذا المقطع أو ذاك ، ولهذه الآية أو تلك ، ومن خلال مقدماته التحليلية الخصبة لسور القرآن ، وبخاصة تلك التى تحدثت عن وقائع تاريخية مما شهده عصر الرسالة .
الهوامش
(1) الآية رقم [11] .
(2) فى ظلال القرآن 7/142 (الطبعة الثالثة ) ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت (بدون تاريخ) .
(3) الظلال 7/ 142- 143 .
(4) سورة الأنعام : الآية [6] .
(5) الظلال7 / 130- 131 .
(6)الظلال 9/ 166- 201 وانظر المرجع نفسه 10 / 49- 50، 11- 76-84 . وانظر على وجه الخصوص النص الذى اعتمده سيد من ابن القيم والمبادئ الأساسية التى استمدها منه فيما يمكن أن يشكل الملامح الأساسية لقانون الجهاد9 / 166- 169. وانظر معالم فى الطريق من 55– 82 (الطبعة السادسة ) ، دار الشروق ، القاهرة – 1979.
(7) الظلال 9/ 218 .
(8) الظلال 9/ 227- 228 .
(9) الظلال 9 / 246- 247 .
(10) سورة النساء : الآية [19] .
(11) الظلال 9/ 246- 247 .
(12)سورة المدثر : الآية [31] .
(13) الظلال 9/ 249 – 251.
(14) الظلال9 / 254 .
(15) الظلال 10/ 36 .
(16) سورة الأنفال : الآية [53] .
(17) الظلال 10 / 37 .
(18) سورة الأنفال : الآية [58] .
(19) الظلال10 / 47
(20) سورة الأنفال : الآيتان [ 65- 66] .
(21) الظلال 10/58 -59 ، وانظر تفسيره لآيات معركة حنين 10/ 164- 166 وكذلك 10/ 251- 252.
(22) الظلال 10/ 76- 79.
(23) سورة البقرة : الآيات [1- 4] .
(24) الظلال7 / 137
(25) الظلال7 / 140- 141
(26) الظلال / وانظر تفسيره لقوله تعالى : { وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو } من سورة الأنعام ، حيث يقف سيد قطب طويلاً أمام البعد الغيبى للتصور الإسلامى ويرد على ضلالات الجاهلية المادية المعاصرة من خلال معطيات العلم نفسه الذى تبنى صرحها عليه
(7/ 250- 262) وانظر كذلك كتاب (العلم فى مواجهة المادية) للمؤلف (مؤسسة الرسالة ، بيروت – 1973)
(27) الظلال 4/ 61- 62
(28) الظلال4 / 62- وانظر4 / 166- 167.
(29) الظلال4 / 65 .
(30) سورة آل عمران : الآيات [137- 142] .
(31) الظلال 4/ 80 – 81وانظر4 / 81- 90 .
(32) الظلال4 /67. وانظر4 / 68- 70.
(33) الظلال4 / 175- 160. وانظر4 / 161- 162.
(34) الظلال 4/ 105- 106.
(35) الظلال 4/ 120. وانظر4 / 121،4 / 135- 139.
(36) الظلال4 / 70- 71، وانظر4 / 164- 166 .
(37) الظلال 4/ 162 -164 .
(38) سورة آل عمران : الآية [144] .
(39) الظلال4 / 90- 94 .
(40) الظلال4 /95 – 97.
(41) الظلال 4/ 102- 103.
(42) الظلال4 / 151 – 152 . وانظر4 / 152- 157 .
(43) الظلال4 / 149- 150.
(44) سورة الزمر : الآية [30] .
(45) سورة آل عمران : الآية [144] .
(46) سورة النساء : آية [78] .
(47) الظلال4 / 142- 145. وانظر4 / 54- 58.
☼☼☼