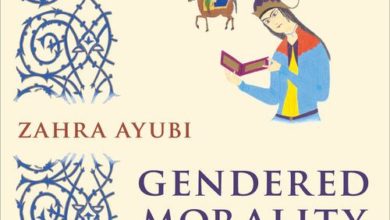أنا والكتاب:
أول مرة تعرفت فيها على كتاب “نظرية التقريب والتغليب” كان أثناء إعدادي لرسالة علمية حول موضوع “الاحتياط في الشريعة والفقه”(1)، فاستفدت منه في عدد معتبر من المباحث، حيث وجدت فيه معالجة مميزة لقضايا هامة وترجيحات موفَّقة في مسائل خلافية، وذلك استنادا إلى نظرية التغليب(2). لكنني لم أع جيدا الأهمية الحقيقية للنظرية وعمق آثارها وسعة مجالاتها.. إلا في مرحلة لاحقة، وذلك حين بدأت في إعداد أطروحتي لنيل دكتوراه الدولة، وكانت القضية الأولى عندي في هذه الدراسة قضية معرفية وابستمية تتعلق بإمكان معرفة بعض المستقبـل وأساس هذه المعرفة وشروطها وموقـف الإسلام منها(3). وقد فهمت منذ البداية أن المعرفة المستقبلية معرفة ظنية ونسبية التحقق، فتساءلت عن قيمتها وعن الرأي الشرعي فيها، فوجدت بعض ضالتي في كتاب الأستاذ الريسوني الذي أعتبره مؤلَّفا معرفيا ابستيمولوجيا –كما سيأتي-، حتى لو كانت قاعدته من علوم الحديث والفقه والأصول… في الأكثر.
الكاتب:
هو الأستاذ أحمد الريسوني، ولد بمدينة القصر الكبير – بشمال المغرب- سنة 1953. وحصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة 1978. ثم في سنة 1992 نال السيد الريسوني دكتوراه الدولة من جامعة محمد الخامس بالرباط التي يعمل بها حاليا أستاذا لأصول الفقه ومقاصد الشريعة. له عدد من الكتب المطبوعة، منها: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (صدر عن المعهد العالمي). الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده. حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة (بالاشتراك). تأليف في الوقف الإسلامي (صدر عن الإيسيسكو)… إضافة إلى عدد آخر من المقالات بمجلات فكرية وإسلامية، مغربية وعربية. وللكاتب أيضا مشاركة ومساهمة في العمل الدعوي والجمعوي والثقافي بالمغرب.
فكرة الكتاب:
يقول المؤلف: “يتولى هذا البحث الكشف عن إحدى النظريات الكبرى التي تتشكل منها المنظومة المنهجية الأصولية في الإسلام، وهي نظرية ينضوي تحتها وينبع منها عدد كبير من المبادئ والقواعد التي وجّهت التفكير الإسلامي، وتحكمت في الإنتاج العلمي الإسلامي. وهي نظرية تعطي جهازا منهجيا واسعا ومنسجما لمعالجة عدد لا يحصى من القضايا والمسائل العلمية والعملية التي يحتوي عليها الإسلام، أو تواجه المسلمين، وتواجه العقل المسلم، باعتبارها نوازل ومشاكل جديدة”(4).
وخلاصة هذه النظرية أننا فيما نسعى إليه من أمور علمية أو عملية قد نحقق مبتغانا على أكمل الوجوه وأتمها. لكن حين يتعذر علينا الوصول إلى اليقين والكمال، فإننا نتمسك بما تشير به الأدلة والقواعد مما هو قريب من درجة اليقين تلك. فإذا فقدنا درجة التقريب هذه، صرنا إلى التغليب، أي الأخذ بما غلب احتمال صدقه وصحته، وبما غلب من المقادير والأحوال والصفات… ولم نلتفت إلى الاحتمال الآخر.
هذه الفكرة قد تبدو صغيرة وبسيطة، ولكنها تسري في كافة العلوم وفي كافة مجالات الحياة، وقد اقتصر الكاتب على دراستها في إطار العلوم الإسلامية خاصة. فجاءت هذه الدراسة في مدخل وثلاثة أبواب، حيث بدأ المؤلف بدراسة أهم المصطلحات المتعلقة بالنظرية. ثم كان الباب الأول عبارة عن عرض موسع لتطبيقات النظرية في علوم الحديث والفقه والأصول. وجاء الباب الثاني عن تأصيل النظرية بذكر أدلتها النقلية والعقلية، ثم بدرس إشكالاتها ودفع الاعتراضات الواردة عليها. أما الباب الأخير فيتعلق بتطبيقات جديدة للنظرية.
المصطلحات الأساسية في البحث:
حرَّر الكاتب هنا معاني بعض المصطلحات الهامة، وهي:
– العلم، فقد يقع صوابا مطابقا للواقع، وهو الغالب، وقد يقع فيه الغلط، فهو إذن يقبل الاحتمال.
– اليقين: يتكون من عنصرين: يكون معتقِدُه جازماً به، ويكون الأمر المتيقَّن صحيحا في ذاته مطابقا لواقعه. لهذا يتطابق الاستعمال القرآني والاصطلاحي لليقين، بخلاف العلم.
– الظن: اتفق على المعنى الاصطلاحي الذي هو ما كان راجحا من الاعتقادات والآراء، من غير أن ينتفي خلافه انتفاءً قطعياً… رغم أن في اللغة والقرآن استعمالات أخرى. وهنا قرر الكاتب أن الظنون درجات في القوة.
– الشك: معناه في الاصطلاح محدد ومضبوط، إذ هو التردد بين احتمالين متساويين –أو أكثر- دون التمكن من الترجيـح بينهما عند الناظر. لكن معناه اللغوي أوسع(5).
– الترجيح: هو عند الأصوليين قرين التعارض، وبيان الراجح من المرجوح يستتبع لزوم العمل بالراجح وإهدار المرجوح، وهذا هو الغرض من الترجيح.
– التقريب: يعني عند الكاتب المعاني الآتية:
1- “عندما توصلنا الأدلة والبراهين إلى نتائج وحقائق على درجة عالية من الصحة والثبوت، يتلاشى معها الاحتمال المخالف، وإن كان لا ينمحي تماماً، ولا يدخل دائرة الاستحالة. غير أنه يبقى مجرد احتمال وافتراض… فما نعتقده أو نحكم به في هذه الحالة، هو ضرب من التقريب”(6).
2-إدراك أمر ما، وتصوره على صورة قريبة من صورته الحقيقية الكاملة. فأصل المسألة هنا معلوم ثابت، خلاف الحالة الأولى، فليس هو محل التقريب.
3- التقريب العملي: وهو الإتيان بالعمل المطلوب على نحو ما.. قريب إلى أقصى حد ممكن من الصورة المطلوبة والمنشودة.
– التغليب: هو الأخذ بأحد أمرين، أو بأحد أمور، وتقديمه على غيره في الاعتبار، لمزية. وقد فضَّل الباحث هذين المصطلحين على ما سبق مما يشبههما لاعتبارات فصَّلها في الكتاب.
الفصل الأول: عرض النظرية
عرض الكاتب لهذه النظرية في بابين: الأول فيه مجموعة وافرة من الأمثلة والتطبيقات، وهي كافية ليخرج القارئ مقتنعا بالنظرية وقيمتها، لكن ضرورة التأصيل العلمي حتَّمت وضع باب ثان في التنظير النهائي للتغليب والتقريب.
الباب الأول: تطبيقات نظرية التقريب والتغليب في العلوم الإسلامية.
غاية هذا الباب بيان أن العلماء قد أخذوا فعلا بمبدأ التقريب والتغليب في مختلف العلوم الإسلامية، لكنه أظهر ما يكون في ثلاثة علوم… لطبيعتها العملية:
الفصل الأول: في المجال الحديثي
المبحث الأول: في التعديل والتجريح. لما كان الكُمّل من الرواة قلائل في صفات العدالة والضبط والحفظ.. فقد اضطر علماء الرجال إلى العمل بالتغليب، فمن غلبت عليه هذه الصفات فهو العدل الضابط، ومن غلبت عليه صفات القصور فهو المجرح المتروك. لكن ينبغي التنبيه إلى أن أئمة الحديث يحرصون على أن يكون التغليب قوياً، لا مطلق التغليب.
المبحث الثاني: في التصحيح والتضعيف. بيَّن الكاتب أن تصحيح الحديث أو تضعيفه حكم تغليبـي –في الأكثر- لا يقيني. ثم إن الأحاديث ليست على درجة واحدة في القوة أو الضعف، فهي تتفاوت بتفاوت مراتب العدالة والضبط.
المبحث الثالث: خبر الواحد: ماذا يفيد؟ هذا المبحث من أحسن ما اطلعت عليه في تحقيق معنى خبر الواحد، وهل يفيد العلم أم الظن، والفرق بينه وبين المتواتر، أو حدُّ ما بينهما(7). وهو مثال بارز للتغليب الحديثي.
الفصل الثاني: التقريب والتغليب في المجال الفقهي
لما كان الفقه أكثر العلوم ارتباطاً بالحياة العملية للناس.. فقد كان الفقهاء الأكثر اعتماداً على الظن والترجيح والعمل بالنظرية.
بالنسبة للتقريب: توجد ثلاث حالات:
1- التقريب في الأحكام، أي بابتغاء الأقرب والأشبه بالحق.
2- التقريب في الأوصاف، ويتجلى هذا مثلاً في الصفات المطلوبة في الخليفة والقاضي والمفتي والشاهد.. فإن لهم شروطاً كثيراً ما تتخلف كلاًّ أو بعضاً. وهنا يعمل بحسب الأقرب فالأقرب، والأمثل فالأمثل. وهنا حقق الأستاذ القاعدة الفقهية: ما قارب الشيء يعطى حكمه، وأنها ثابتة، وإنما الخلاف في التطبيقات.
3- التقريب في المقادير، مضمنه أن المقادير التي حددها الشرع –الموزونة أو المعدودة..-، وكذلك تلك التي يحددها القضاء، أو أعراف الناس… قد يتعسر الإتيان بها بتمامها.. وهنا ليس واجبا التمسك بهذه التحديدات حرفياً. من الأمثلة: العمل بالخرص في الثمار، فهو تقدير تقريبـي. وعند بعض الفقهاء لا يؤثر النقصان الطفيف في بعض أنصبة الزكاة –كنصاب الذهب- في إيجابها. وكثير منهم اعتبر أن استقبال القبلة مطلوب على وجه التقريب بقدر الإمكان…
وبالنسبة للتغليب: ذكر المؤلف من مجالاته:
1- التغليب في المقادير والأحوال، فهو متعين متى اختلطت الأمور والتبست وتعذر الفرز والتمييز.. مصداق القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع، والنادر لا حكم له. كما إذا كانت الأنعام سائمة ومعلوفة في آن، اعتبر حالها في أكثر العام.
وحتى مسائل النية التي تتطلب الإخلاص التام أوجد فيها بعض العلماء مجالا للتغليب، كالشاطبي الذي اعتبر أنه حين يختلط باعث الشرع مع باعث الهوى كان الحكم للغالب، بما في ذلك العبادات.
2- العمل بالظنون الغالبة: يتخذ تحكيم الظنون الأقوى في الفقه أشكالاً عديدة أساسها واحد هو الاعتراف بالاحتمال الأغلب وبناء الأحكام والتصرفات عليه.
3- التغليب في مجال القواعد الفقهية، وهذا يتجلى في عدة جوانب اقتصر المؤلف منها على جانبين: الأول هو الاستقراء الظني وإثبات القواعد به. فقد اختلف العلماء هل يكفي في الاستقـراء الناقص –وهو الأكثر لأن التام نادر- استقراء كثير من الجزئيات أم الأكثر منها؟ والملاحظ أن استقراء الأكثر وإن كان ممكناً في قضايا إلا أنه متعذر في أخرى. ولذلك فالقواعد الفقهية المستندة إلى الاستقراءات الناقصة تكون ظنية. هذا عن الثبوت، والجانب الثاني يتعلق بالتطبيق. يقول الكاتب: “الحقيقة أننا لا نكاد نجد قاعدة واحدة مطردة اطراداً تاماً كما يقتضيه عموم صيغتها. فما من قاعدة إلا ونجد تطبيقات عديدة خارجة عنها ومستثناة من مقتضاها”(8). وبيان ذلك من خلال قاعدتين كبيرتين، استثنى العلماء منهما كثيرا من الفروع، مع كونهما من أهم وأوسع قواعد الفقه: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك.
الفصل الثالث: التقريب والتغليب في المجال الأصولي.
المبحث الأول: في الدلالات. ذلك أن النصوص الشرعية ليست على درجة واحدة في دلالاتها ووضوح معانيها. ومن هنا دأب عامة الأصوليين على ترتيب الألفاظ والنصوص الشرعية بحسب درجة وضوحها أو غموضها وبحسب مقدار الاحتمال فيها… كما فعل الأحناف حين رتبوا النصوص هكذا: الخفي فالمشكل فالمجمل فالمتشابه، ثم بالمقابل هناك: الظاهر فالنص فالمفسر فالمحكم.. ولذلك تجد أن للظنية مجالاً واسعاً في دلالة الأمر والنهي وفي مسائل العموم والخصوص… ونحو ذلك.
المبحث الثاني: في القياس. وأغلب الأقيسة ظن، لكن أكثر الاحتمال فيها هو من جهة إثبات العلَّة التي يقاس عليها، ولهذا اعتنى المؤلِّف هنا بهذا الجانب خاصة. ففي العلل المنصوصة يكون التنصيص أحياناً غير قاطع كما في مسلك الإيماء أو التنبيه. ومجال التقريب والتغليب في العلل الاجتهادية أوسع، خاصة في مسلك المناسبة والإخالة. وهنا يكون الوصف المعتبر علّة قد أخال للمجتهد صلاحيته لتعليل الحكم، وتتحقق هذه الإخالة بغلبة الظن، بأي دليل أو موجب يحقق هذا الظن. ولعل أوسع طريق لحصول ظن العلية لدى المجتهد هو المناسبة، أي وجود تناسب بين الحكم المراد تعليله وبين الوصف المفترض علة. وهناك مسلك آخر في التعليل الظني هو الشبه بين الأحكام، وذلك حين تتردد النازلة بين أصلين.
المبحث الثالث: في الترجيحات. يقول المؤلف: “باب التراجيح هو أكثر ما يتجلى فيه التقريب والتغليب، بل لست مبالغاً إذا قلت: إن هذا الباب، بشقيه الأصولي والتطبيقي، كله تقريب وتغليب”(9) وذلك لأن طريق الترجيح هو التمسك بما كان في الظن أقوى.
الباب الثاني: تأصيل النظرية.
الفصل الأول: أدلة النظرية.
المبحث الأول: أدلة العمل بالتقريب والتغليب. هذا المبحث بيان لبعض أدلة النظرية من القرآن والسنة والإجماع، ومن المظنة والضرورة والبداهة. والمقصود بالمظنة الحالة أو الأمارة التي يقترن بها في الغالب أمر معين. وقد بنى الشرع كثيراً من أحكامه على المظنات الغالبة، وإن كان يقصد في الحقيقة البناء على الأمور المقارنة لها في الغالب.
المبحث الثاني: إشكالات واعتراضات. أثبت الباب الأول أن بعض صور التقريب والتغليب لا خلاف فيها، أي بعض مجالات النظرية متفق عليها خصوصا على المستوى التطبيقي والتنفيذي للأحكام الشرعية. ولا يعتد بالخلاف في الباقي عند الجمهور، لأنه خلاف صدر عن أفراد قلائل جداً أكثرهم من الطوائف المبتدعة أو الشاذة، كالمعتزلة والشيعة والظاهرية… وتكاد اعتراضات هؤلاء تنحصر في رفض مبدأ العمل بغالب الظن. يتجلى ذلك مثلاً في إنكار العمل بخبر الواحد، ورفض القياس خصوصا، والرأي عموما.. قال ابن حزم: الظن باطل، ولا يحل للمجتهد الحكم بالظن أصلاً. ومأخذ الخلاف يكمن في الاحتمالات التي لا يُلتفت إليها لشدة بعدها وعدم استنادها إلى دليل.. فمن ينظر نظرة عملية واقعية يهدر الاحتمال ويعتبر المسألة قطعية، ومن يدقق ويبالغ يجد أن هذا الاحتمال وارد على كل حال.. فهذا يصدق على جملة واسعة من أخبار الآحاد ودلالات بعض النصوص.. كأن الاحتمال فيها رياضي لا علاقة له بواقع الحياة.
وقد ظن ابن حزم أن القول بظنية خبر الواحد –بتجويز الغلط والنسيان والكذب عليه- يفضي إلى التشكيك في أحكام الدين بضياع كثير من الحديث النبوي. وردّ المؤلف أن شيئا من السنة لم يضع أبداً من الأمة، أما على مستوى الأفراد فلا عصمة لأحد، لكن الخطأ في الرواة الأثبات قليل… حين يكون.
ومن إشكالات النظرية مسألة هل كل مجتهد –في الفروع الفقهية الظنية- مصيب؟ فمن قال نعم انطلق من مشروعية العمل بالظن وأن المجتهد لم يُكلف غير الأخذ بما غلب على ظنه. لكن الجمهور الأوسع ذهب إلى أن المصيب واحد، لأن مآل الرأي الآخر هو إنكار الأحكام الشرعية الظنية إذ لا حكم ولا دليل إلا ظن المجتهد، وليس لله حكم معين، بل الحل والحرمة ينبعان من ظن الفقيه فقط. وقد أفاض المؤلف في مناقشة هذا الرأي معتبراً أن القول الفصل هنا هو حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد(10).
الفصل الثاني: الضوابط العامة للعمل بالتقريب والتغليب
لا تعني النظرية أن الظن المعتبر في الدين هو مطلق ظن، بل هو ظن علمي له حدوده وشروطه. وقد اقتصر المؤلف هنا على ذكر الضوابط العامة:
الضابط الأول: أن تكون المسألة مما يجوز فيه التقريب والتغليب. أي يشرع العمل فيها بالظن. والشرعيات التي لا يجوز فيها إلا القطع هي:
1- أصول العقائد، وكلام المؤلف هنا هام، خاصة في العقائد التي تستند إلى أدلة ظنية.
2- إثبات القرآن الكريم: لذلك اعتبرت بعض الزيادات والقراءات شاذة. وقد طبق الكاتب هذه القاعدة على البسملة، فما دام الخلاف في قرآنيتها ثابتاً فهي مسألة ظنية، وهي –إذن- ليست قرآنا.
3- الأصول العامة للشريعة: كمصادر التشريع، والمقاصد العامة للشريعة، وبعض القواعد الفقهية الكبرى.
الضابط الثاني: أن يتعذر أو يتعسر اليقين والضبط التام. ولذلك انتقد المؤلِّف القاعدة التي ذكرها السيوطي: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن، فبيَّن أن عليه طلب القطع، فإذا تعذر عليه تحول إلى التقريب فالتغليب… وهذا مطرد في المقادير والأوصاف والتكاليف المطلوبة على نحو معين.. إذا تعسر الوفاء بها جاز التقريب.
الضابط الثالث: الاستناد إلى دليل معتبر. فالظن –الذي هو عبارة عن أغلب الاحتمالين- لا يجوز اتباعه إلا بدليل، وقد نصب الله تعالى لكل حكم علامة وأوجب على المجتهد طلبها واتباع دلالتها.. وهذا أصل الاجتهاد.
الضابط الرابع: أن يكون الدليل مكافئا للمسألة. ذلك أن الترتيب في التعامل مع الأدلة الظنية يقوم على أساس التسليم بتفاوت الأهمية بين الأحكام الشرعية. وهذا ثابت من استقراء أدلة الشرع وكيفيات تعامل العلماء مع الأدلة الشرعية.. وهو يكشف لنا أن العمل بالظنيات لا يجري على تساوٍ وتماثل، بل يقع التشدد والتساهل في مدى قوة الظن تبعاً لنوع المسألة وخطورتها. ولذلك يشترط الشرع في الحدود قوة في الظن أكبر منها في كثير من قضايا العبادات والمعاملات… فهذا أصل فقه الموازنة.
الضابط الخامس: ألا يعارضه ما هو أقوى منه. فالمعاِرض إما أن يكون يقينياً، وإما أن يكون ظناً أقوى وتقريباً أقرب. وفي الحالتين يسقط اعتبار ما دونه، ويقدم في العمل اليقين والظن الأقوى. ويرجع هذا الضابط إلى أساس واحد، هو بطلان الأضعف بالأقوى. ولذلك نقول اليقين لا يزول بالشك، ونحكم بالشذوذ على الحديث الذي رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه. وكذلك في تعارض الأصل والغالب نعمل بمن يعطي منهما ظناً أقوى، خلاف ما يعتقده البعض من اختيار أحدهما وإهدار الآخر. وقد نقل المؤلف عن المقري صياغته لهذا المعنى في قالب رياضي: “ما يحصل على تقديرين أقرب وجوداً مما يحصل على تقدير واحد، ثم اصعد كذلك…” وهو ما سماه الريسوني بقانون تغالب الاحتمالات.
الضابط السادس: يتعلق هذا الضابط بحد اليسير الذي يعتبر في حكم العفو. وهذا الدرس من أفضل مباحث الكتاب.
الباب الثالث: تطبيقات جديدة للنظرية.
الفصل الأول: التقريب والتغليب في مجال المصالح والمفاسد.
المبحث الأول: التقريب والتغليب في تمييز المصالح وتصنيفها.
– المصالح والمفاسد تعتبر على أساس التغليب: يقول الكاتب: “ومعنى ذلك أن المصلحة تعتبر مصلحة باعتبار غلبة الصلاح والنفع فيها، وأن المفسدة تعتبر مفسدة باعتبار غلبة الفساد والضرر فيها..”(11) ولذلك يقول ابن العربي: “حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره، وحقيقة الشر ما زاد ضره على نفعه”.
– هل توجد مصالح خالصة ومفاسد خالصة؟ والكاتب أميل لرأي القرافي والشاطبي في أنه لا توجد مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، بل كل شيء فيه شيء من هذا وشيء من ذاك.
– التقريب والتغليب في ترتيب المصالح: والمقصود بهذا تقسيم المصالح إلى مراتب ودرجات بحسب منـزلتها في الشرع وفي حياة الناس. وقد اشتهر التصنيف الثلاثي إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات.. لكن الكاتب يلاحظ أنه ليس هناك حدود فاصلة ومستقرة بين هذه الرتب الثلاثة، ولذلك يصعب توزيع أنواع المصالح والمفاسد على هذه الرتب.. وهنا لا مناص من اعتماد التقريب والتغليب.
– التغليب بين المصالح والمفاسد المتعارضة: يؤكد المؤلف أنه لرفع هذا التعارض لا بد من مراعاة أمرين:
1- ضرورة النظر المصلحي إلى النصوص، باعتبار أن وراء كل حكم شرعي مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع.
2- ضرورة الأخذ بمبدأ التغليب، فالحياة تعج بأنواع التعارض بين المصالح والمفاسد. ومن هذه المراعاة المزدوجة نستطيع أن ننـزل كل حالة منـزلتها الشرعية المناسبة، حتى لو لم يكن منصوصاً عليها. مثال ذلك ما ذكره العز بن عبد السلام عن جريمة التجسس على أسرار المسلمين لصالح أعدائهم، فهذه أخطر من التولي يوم الزحف الذي عدَّه الشرع من الكبائر الموبقات.
المبحث الثاني: معايير التغليب بين المصالح والمفاسد المتعارضة. وإذا كانت المصلحة هي الأساس، فإن الباحث ينبه على أنه ليس لأحد أن يغلب أمراً على آخر بمطلق التشهي أو التقدير العقلي الحر –كما ظنه الطوفي-، بل لذلك موازين ومعايير، خصوصاً حين تتشابك القضايا وتلتبس. وهذه المعايير هي: احترام النص الشرعي، ورتبة المصلحة، ومراعاة نوعها ومقدارها وآثارها في الزمن… مما سيأتي تفصيله في الفصل الثاني.
المبحث الثالث: التغليب في فتح الذرائع وسدها. إن من تمام العناية بالمصالح والمفاسد ولوازمها: العناية بأسبابها وذرائعها وما يوصل إليها أو يمنع. ولذلك تضمنت الشريعة اعتبار الوسائل.. فالذرائع قد تفتح للمكلفين أو تسد، تبعاً لما تفضي إليه من نتائج، وأيضا بناءً على درجة الاحتمال في هذا الإفضاء.. فلنسبة الاحتمال هنا دور حاسم في الحكم على الذريعة بأحد الأحكام الخمسة.
المبحث الرابع: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ ولهذا علاقة بموضوع الذرائع والوسائل في علاقتها بالنتائج والغايات.
الفصل الثاني: حكم الأغلبية.
المبحث الأول: مسألة الأغلبية في سياق الأدلة الشرعية، من القرآن والسيرة والسنة. وقد اختار الكاتب الاعتداد بالأغلبية في مواضعها وبشروطها.
والمبحث الثاني: اعتراضات وردود، عرض فيه لأهم آراء من أهدر الأغلبية، فبين معنى الأكثرية المذمومة في القرآن وتحدث عن صلح الحديبية ومنـزلة الرسول وبعض تصرفات الخلفاء الراشدين ذات الصلة بالموضوع.
والمبحث الثالث: كان عن حكم الترجيح بالكثرة عند العلماء.
والمبحث الرابع: في أهمية العمل بالأغلبية ومجالاته.
مباحث مميزة في الأطروحة:
أريد في هذا الفصل أن أنبه على بعض البحوث الممتازة في كتاب الأستاذ الريسوني، وقد لفتت نظري بمستواها الجيد وما حملته من جديد في علومنا الإسلامية. وهذه ميزة العلماء الحقيقيين والذين تحتاجهم الأمة كثيرا في ظروفها العصيبة. فالمؤلف عالم محقق، لا بكثرة المحفوظ والكلام، بل بدقة النظر وعمق الفهم وصواب الاختيار والوسطية في مراعاة النصوص والمقاصد والواقع.. معا. وهذه أهم القضايا التي تفوّق الكاتب في معالجتها ومدارستها:
1- خبر الواحد بين اليقين والظن:
بداية قرّر المؤلف قاعدة عظيمة، ما أكثر ما غفل الناس عنها، بمن فيهم كثرة من أهل العلم. وهي أن الحكم على الحديث بالتصحيح أو التضعيف حكم تغليبـي أو تقريبـي في الأصل. أي أن هذا المجال اجتهادي وبشري(12).
ثم في مسألة خبر الواحد، لاحظ الكاتب وجود تضارب كبير فيها، وبدأ بتحقيق مذاهب الأئمة الأربعة، مبينا في ثنايا ذلك معنى العلم عند الشافعي، ثم تعرض لموقف ابن حزم والظاهرية. والنتيجة التي انتهى إليها الأستاذ هامة وتبعث على التأمل: “… وهكذا لا يتحصل في أيدينا عند التمحيص والاختبار، إلا قول واحد، ثابت النسبة إلى صاحبه، صريح حاسم، يعتبر خبر الواحد العدل إلى رسول الله r لا يكون إلا قطعياً يقينياً، هو قول ابن حزم”(13).
ومما عمق الخلاف في المسألة الخلط الواقع في مفهوم العلم، إذ بينما كان معناه عند المتقدمين عاماً عبارة عن المعرفة الناشئة عن دليل قُصِر معناه، خصوصا منذ القرن الرابع، على ما يفيد اليقين. فمن أنكر إفادة خبر الواحد العلمَ قصد المعنى الثاني. وكذلك تعريف خبر الواحد بما يقابل المتواتر.. مصدر خلط، لأنه بهذا يضم أنواعا متعددة.
وفصل الخطاب هنا هو كما قال المؤلف: “أما العلم بمعناه الأول العام، فلا شك أن خبر الواحد يفيده… ولا أكون مبالغا إذا قلت: إن الإجماع على وجوب العمل بأخبار الآحاد إنما هو إجماع على أنها علم، وأن مضمونها علم… أما العلم بمعناه الخاص، الذي هو اليقين التام، فمن الأخبار ما يفيده، ومنها ما لا يفيده… ولا شك أن أكثر ما صححه العلماء، إن لم يكن مفيداً لليقين، فهو مفيد للتغليب القوي، ومفيد لدرجة التقريب..”(14).
2- النصوص وأحكام الدين بين الظنية والنسبية:
تعرض المؤلف لهذه القضية في مواطن متعددة من كتابه(15)، وهي هامة ومحورية في نظرية التقريب، لأن القول بأن الاحتمال يدخل النصوص الشرعية –من حيث دلالاتها- يفسح المجال واسعاً لتطبيق النظرية في فهم كثير من النصوص. ولا شك عندي أن من أدق الكلام وأحكمه في هذا الباب، ما قاله الأستاذ الريسوني: “….وأمام هذا الواقع الذي لا يمكن إنكاره، وهو أن كثيرا من النصوص يتعذر تحديد معانيها وأحكامها، إلا على سبيل التقريب والتغليب”(16). ونقل في هذا المعنى تعليق العلامة ابن عاشور على موقف المبالغين في التورع عن تفسير القرآن خشية الخطأ فيه، قال: “والحق أن الله ما كلفنا –في غير أصول الاعتقاد- بأكثر من حصول الظن المستند إلى الأدلة، والأدلة متنوعة على حسب أنواع المستند فيه”(17).
ولا يتعارض هذا مع مذهب جمهور الأصوليين في أن الأدلة الظنية والأحكام الاجتهادية ليست إضافية ونابعة من المجتهد نفسه، بل هي نتيجة لتلمس هذا المجتهد حكم الله في المسألة. لكن رغم ذلك يبقى إشكال كبير أورده الكاتب: إذن لماذا توجد في الشرع الأحكام الظنية، حتى إن في بعض النصوص إجمالا ذاتيا لا يكاد يرتفع؟
وهذه القضية –في نظري- هي من أهم أسئلة الكتاب، ولئن ذكر المؤلف بعض الأجوبة فقد مرَّ عليها مرورا سريعا مفضلاً ترك هذا السؤال الخطير –على حدّ وصفه- معلقاً.. وهذه المسألة التي أثارها الكاتب نادرا ما ذكرها غيره –بحسب علمي-، ومن هذا النادر الأصولي الحنفي منلا خسرو(18).
وقد توصلت إلى هذه النتيجة نفسها التي ذكرها الأستاذ الريسوني، أعني أن في بعض النصوص إجمالاً لا يكاد يرتفع، فكأنه مقصود. وذلك من خلال قضيتين هامتين صرفت في دراستهما جزءاً من عمري، وألّفتُ فيهما كتابين: 1- قضية الشبهات وأحكامها، ومحورها حديث الحلال بيِّن والحرام بيِّن… 2- قضية العلاقة السببية، فالنصوص فيها محتملة، ولذلك كان القطع فيها صعباً(19).
والمقصود أن قضية استمرار الإجمال في بعض النصوص… قضية مستعجلة، ولكنها معقدة، تحتاج إلى باحث مقتدر، وعالم راسخ القدم في الدين.
نعود إلى النظرية، وفائدتها هنا هي تقرير مشروعية التعامل الظني مع النص. ولذلك كل الطوائف –في الإسلام- تضطر للعمل بالظن، رغم تمسك الظاهرية وبعض الشيعة من أن الظن والقياس يفضيان إلى الاختلاف في الدين، وهو مذموم، كما في سورة النجم: (إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ). وقد لاحظ الكاتب أن الخلاف واقع حتى في فهم النصوص الشرعية ذاتها –كما تقدم في قبول أكثر النصوص للاحتمال الدلالي-، بل إن هذا الخلاف ضرورة بشرية. ولذلك فذم الاختلاف في القرآن والسنة لا بد أن يحمل على أحد معنيين: إما أنه اختلاف مخصوص، كالنـزاع في الأصول والقواطع. أو هو محـمول على ما يلازمه من التخـاصم والتفرق.. ولذلك فإن منع القياس والعمل بالظنون الراجحة لا يرفع الخلاف بل يزيده.
3- مسألة تصويب المجتهدين:
هذا من أهم مباحث الكتاب، حقق فيه صاحبه حقيقة الخلاف والمذاهب فيه، ودوافع كل طرف فيما ذهب إليه… ثم رجح ما رآه أقوى. ويمكن أن يكون هذا المبحث أساسا لدراسة أوسع لمسألة التصويب هذه.
وقد اعتبر الأستاذ أن القائلين بأن المصيب في الفروع الظنية واحد.. هم الجمهور الأعظم من الأصوليين والفقهاء، بما فيهم الأئمة الأربعة.. حتى الشافعي. ثم حرّر نسبة القول بالتصويب، فهي ثابتة إلى معتزلة البصرة، ورجح المؤلف نسبتها إلى أبي الحسن الأشعري، وعدم صحتها إلى أبي حنيفة.
واعتنى الكاتب ببسط رأي أبي حامد الغزالي –وهو أهم المصوبة وأكثرهم غلواً في الفكرة-، ثم نقده نقدا واسعاً، وكشف عن علاقة هذا الرأي بالأصل الأشعري: التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان، موضحاً أن مآل النظرية إلى أنه ليس لله حكم معين في النازلة، بل العبرة بظن المجتهد فقط. ولا يعتقد المؤلف أن القول بالتصويب أنسب لحال المسلمين في هذا العصر وأنجع لمعالجة عللهم بروح اجتهادية مقدامة. قال: ذلك لأن “المخطئة لا يؤثمون المخطئ في الاجتهاد، بل يعتبرونه دائما مصيبا من بعض الوجوه، وأن له في جميع الحالات أجراً. ولا يمنعون مراجعة الاجتهادات المتقدمة ونقضها. بل إن القول بالتخطئة يسمح بالمراجعة والنقد والنقض أكثر مما يسمح به القول بالتصويب الذي يعتبر الاجتهادات السابقة كلها صواباً..”(20).
4- ضابط اليسير المعفو عنه:
ومن أجود مباحث الكتاب سؤال: متى يعد الشيء قريبا من أصله، فيقوم مقامه، وفق القاعدة الفقهية “ما قارب الشيء أُعطي حكمه”؟ فهذه القضية -كما وصفها المؤلف– معضلة لا ضابط لها على وجه التحديد. ولم يضبط الفقهاء ذلك.
إن التغاضي عن اليسير أصل ثابت في الشرع، وتطبيقاته عند الفقهاء واسعة النطاق. ولذلك يغتفر الغرر اليسير والجهالة اليسيرة… في العقود، والغضب اليسير… في القضاء… وتعجيل الزكاة عن وقتها بقليل… وأبرز ما نجده في هذا الباب هو تحديد اليسير في كثير من القضايا بما دون الثلث، كأنهم أخذوه من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أوص بالثلث، والثلث كثير.. ولذلك قال الفقهاء إن للمتضرر حق فسخ البيع إذا كان العيب فيه يصل إلى الثلث.
وقد نقد الكاتب –عن حق- استرسال الفقهاء في قياس أمور لا تحصى على الثلث كسقف لليسير. إذ لا شك أنه لا يمكن التحديد بالثلث في كل شيء. ومثل هذا النقد قليل –أو نادر- في تراثنا الفقهي. لذلك وضع الأستاذ الريسوني مجموعة من الضوابط والقواعد لليسير المعفو عنه.
5- معايير التغليب بين المصالح والمفاسد المتعارضة:
إن المصالح والمفاسد قد تتعارض، بل يمكن أن تتساوى –تقريبا وبحسب الظاهر- مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومفسدة، وذلك من جميع الوجوه. وقال العلماء: يضطر هنا للتخيير، وأصله –في الشرع- الواجب المخيَّر.. ونحوه. وإذا تعلق الأمر بأشخاص متعددين جاز اللجوء للقرعة.
لكن حالة التساوي التام قليلة الوجود، لذلك كان الأصل في التعارض هو الترجيح، وذلك بناءً على قاعدة التغليب، وفق المعايير الخمسة التي نظمها الكاتب والتي يمكن اعتبارها أساس فقه الموازنة:
المعيار الأول: النص الشرعي. فالحكم الشرعي يتضمن –ولا بد- مصلحة أو درء مفسدة، بحيث يوجد تكافؤ بين المصلحة والحكم. ولذلك قد ترجح مصلحة على مصلحة بمقتضى اختلاف الأحكام الشرعية لهذه المصالح، كما يرجح الواجب على المندوب… بل يمكن رجحان واجب على واجب، وحرام على حرام..
وهنا تعرض المؤلف لنظرية الطوفي التي توهمت تعارض المصلحة مع النص، وإن كان صاحبها لم يذكر لها أمثلة. ومن حسنات الباحث هنا أنه تمم هذا النقص وأورد أمثلة، ثم بيَّن أن ما تُوهم فيها من تعارض النص والمصلحة.. خطأ.
المعيار الثاني: رتبة المصلحة. فالزواج مثلاً ضروري، لأن به حفظ النسل. ومن حاجياته: المهر. فإذا تعارض المهر مع الزواج نفسه فأصبح مانعاً منه، قدّمنا الضروري على الحاجي.
المعيار الثالث: نوع المصلحة. هنا لا تتعارض مصلحتان من رتبتين مختلفتين: كالضروري مع الحاجي، وكهذا مع التحسيني.. بل تتعارض المصالح –من الرتبة نفسها- التي تنتمي إلى الضروريات الخمس، بعضها مع بعض. وقد حقق الكاتب أنه توجد ثلاث مصالح أساسية ومتميزة ومتفق على ترتيبها على هذا النحو: الدين، ثم النفس، ثم المال؛ على اعتبار أن النسل والعقل يندرجان ضمن الحفاظ على النفس. ثم تحدث المؤلف عن علّة كون الدين هو قمة المصالح، وتوسع في بيان الأمثلة والمناقشات الجزئية والتطبيقية لهذا الترتيب.
المعيار الرابع: مقدار المصلحة. أي أن الخير الكثير أولى بالاعتبار من الضرر اليسير. ومن أمثلة هذا المعيار: تعييب الخضر للسفينة، وتترس الكفار بأسرى المسلمين في الحروب… وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.
وقد صحَّح الباحث فهماً ناقصاً، قد شاع بين الناس، وذلك قولهم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأوضح أن القاعدة خاصة فيما إذا تعادلت المصلحة والمفسدة. قلتُ: ويشهد لجودة هذا الفهم قول ابن السبكي: يستثنى من القاعدة “مسائل يرجع حاصل مجموعها إلى أن المصلحة إذا عظم وقوعها… كانت أولى بالاعتبار. ويظهر بذلك أن درء المفاسد إنما يترجح على جلب المصالح إذا استويا..”(21).
المعيار الخامس: الامتداد الزمني. أي لا ينبغي النظر إلى المصلحة وإلى مقدارها عند أول أمرها فقط، بل تعتبر أيضا من خلال آثارها المستقبلية المتوقعة، ومن مجموع النظرين –الآني والمستقبلي- يتم الحكم على هذه المصلحة. وعلى هذا تقدم المصلحة ذات الامتداد الطويل والأثر البعيد على الأخرى المحدودة في عمرها وأثرها. وأعظم مثال لهذا الفقه: صلح الحديبية الذي بسببه حققت الدعوة الإسلامية نجاحات واسعة أين منها مصلحة دخول مكة والاعتمار فيها.
6- التغليب في سد الذرائع:
الحاجة إلى العمل بالتغليب تظهر –أكثر ما تظهر- في سد الذرائع لا في فتحها. وهنا تكلم الكاتب عن معنى الخوف من وجهة نظر شرعية، ومن القرآن خاصة، وهو كلام نفيس. غير أن أهم جديد حمله الكتاب في موضوع سد الذرائع هو تقسيمه لدرجات إفضاء الذريعة إلى المفسدة(22):
1- الإفضاء المحقق: حيث الدخول في الذريعة يساوي تماما الوقوع في المفسدة المتذرع إليها.
2- الإفضاء القليل: وهذا لا يؤثر في مشروعية الوسيلة، فهذا مقتضى التغليب الشرعي.
3- الإفضاء الغالب: أي أن الذريعة تؤدي في الغالب إلى المفسدة. فهذا لون من تعارض الأصل والغالب. وقد وقع فيه وفي جزئياته خلاف بين العلماء.
4- الإفضاء الكثير غير الغالب: وهو الذي تفرد المالكية بمنعه. وقد عقد الأستاذ لتحقيق الرؤية المالكية في الموضوع وبيان أصولها.. صفحات مركزة ووافية بالمطلوب.
ومن توابع الحديث في الذرائع: العلاقة بين الوسيلة والغاية، من حيث المشروعية.
7- هل الغاية تبرر الوسيلة؟
اعتبر المؤلف أنه إذا كان من غير الممكن قبول مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة” على عمومه وعلاّته.. فإنه من غير السليم كذلك ما يتجه إليه كلام بعض الكتاب الإسلاميين من إنكار لكل تأثير للغايات على أحكام الوسائل.
بداية إن ما يعتبره ميكيافيلي غايات نبيلة – كمصلحة الأمير- ليس عندنا نحن المسلمين كذلك، بل غايتنا أن تكون كلمة الله – ممثلة في كتابه وسنة نبيه- هي العليا. ولذلك فإن الغايات التفصيلية لحياة المسلم وجميع أفعاله تستمد مشروعيتها من الشرع، وكذلك الوسائل التي يسلكها. وفي الشرع يمكن أن تباح بعض الوسائل غير المشروعة، فتأخذ حكم المشروعية بالنظر إلى غاياتها، وذلك في إطار محدد من الشروط والضوابط. مثاله أن تخريب الأبنية وإحراق المزروعات فساد في الأرض لا يقره الله سبحانه. لكن حين حاصر المسلمون بني النضير من اليهود، عمدوا إلى قطع بعض نخيلهم وتحريقه، وقد أقرهم الوحي على ذلك: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ) (الحشر: 5). فهذا تدبير استثنائي على خلاف الأصل، جاء لردع المتآمرين ورد كيدهم. ولذلك إذا قدّر قائد المسلمين ألاَّ حاجة إلى هذا التدبير رجع إلى الأصل، كما في وصية أبي بكر لبعض أمرائه:.. ولا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامرا…
ثم استقرأ الكاتب أن الغاية المعتبرة شرعا تسوغ الوسيلة الممنوعة في الأصل في الأحوال الآتية: 1- الحرب، فيجوز فيها الكذب مثلا. 2- استخلاص الحقوق المستحقة شرعا. قلت: ومن أمثلتها الفقهية مسألة الظفر. 3- دفع الظلم والعدوان.
8- حكم الأغلبية:
هذا من أحسن الفصول التي بينت تطبيقات النظرية. وقد قرر الكاتب أن مسألة الاعتداد بالأغلبية في الرأي والقرار اجتهادية استنباطية. ولذلك يمكن الاستشهاد لها ببعض النصوص، كقوله تعالى في مدح المؤمنين: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: 38)، وأقل ذلك اتفاق الأغلبية. وكقوله على لسان ملكة سباً: (مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ) (النمل: 32). فقد سيقت قصتها في القرآن على سبيل التنويه بتعقلها وحسن تدبيرها، وفي ذلك تصحيح غير مباشر لتصرفاتها، لأن كل حكاية وقعت في القرآن ولم يقع ردها فيه.. كان ذلك دليلا على صحتها، كما قال الشاطبي. ثم توسع الأستاذ الريسوني في الاستدلال لمراعاة الأغلبية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في غزوات بدر وأحد والخندق… حيث كان النبي الكريم لا يدع التشاور مع أصحابه واحترام نتيجة هذا التشاور.
وقد أجاد الكاتب في دفع اعتراضات من أهدروا الأغلبية، خاصة منها قولهم: إن الكثرة والأكثرية لا تأتي في القرآن إلا في سياق الذم والقدح: (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ) (الأنعام: 116). (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) (يوسف: 103). (قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) (المائدة: 100). فمعنى هذه الآية الأخيرة مثلا ليس كما يتصورون من إهدار لمطلق الكثرة، قال: “الآية إنما تنفي المساواة بين الطيب والخبيث… والخبيث من الأشياء هو الحرام وهو القذر النجس، والخبيث من الناس هو الكافر والمنافق. وعلى هذا فالطيبات من الأموال والأشياء، ولو كانت قليلة، خير من خبائثها ولو كثرت… فليس في الآية أبداً تفضيل مطلق للقلة على الكثرة، وليس فيها إهدار مطلق للكثرة، وإنما فيها إهدار للكثرة الخبيثة”(23)، فالذي أهدرته الآية إذن هو الخبث لا الكثرة. وعلى هذا الأساس تفسر سائر الآيات التي تذم أكثر الناس، وتصفهم بأنهم لا يعلمون ولا يؤمنون وأنهم فاسقون… لتنبه على أن كثرتهم هذه لا قيمة لها.
ثم إن الآيات التي وصفت أكثر الناس بأنهم لا يعلمون كانت تتحدث بصفة خاصة عن مجال الغيبيات، كما يدل على ذلك الاستقراء، وهذا مجال يحتاج فيه إلى الأنبياء. على أن بعض الآيات التي جاء فيها ذم الأكثر كانت تعني بالخصوص أقواما بعينهم: أكثرية المشركين واليهود والنصارى والمنافقين.. فمن الغلط إذن –يقول المؤلف- قطع الآيات عن سياقاتها، ثم الانتقال بها إلى جماعة المؤمنين، ثم الانتقال بها إلى إهدار الكثرة مطلقا.
بل الكثرة في الأصل هي حكمة الله ونعمته على خلقه، ولذا جاءت آيات أخرى تمدح بعض معاني التكثر: (وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ) (الأعراف: 86). فالكثرة مطلوبة، ولكنها –ككل شيء آخر- قد تسخر تسخيرا أعوج.
ويختم الكاتب هذا البحث بقوله: إن الكثرة في الخير أفضل من القلة، والقلة في الشر أفضل من الكثرة. وعلى هذا فكثرة المؤمنين أفضل من قلتهم، من حيث هم مؤمنون.
فانظر –أيها القارئ الكريم- إلى هذا الفقه السديد كيف يجمع بين الآيات المختلفة ولا يضرب بعضها ببعض، وكيف يفسرها أحكم تفسير وأحسنه… تعرف أن هذا من صفات العلماء حقا الذين مدحهم النبي الكريم r بقوله: “يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين”.
ثم انتقل البحث إلى التنبيه على منشأ غلط أنصار الاستبداد الفردي بالأمر، وهو خلطهم بين القضايا التي عالجها الرسول مع أصحابه بالرأي والاجتهاد، وبين القضايا التي أمضاها بمقتضى الوحي. وذلك كما في صلح الحديبية. فمن الواضح هنا أن النبي الكريم تصرف بصفته رسولا –كما يشير إلى ذلك قوله في الناقة: حبسها حابس الفيل-، فلم يبق مجال لرأي أحد، ولهذا لم يستشر الناس أصلاً. وهنا تنبيه نبيه للكاتب، ملخصه أن الرسول وإن كان يتصرف أحيانا كثيرة بصفته حاكما للمسلمين وقائدا لجيشهم، فلا ينبغي أن يعزب عن بالنا أنه من المستحيل تجريد شخصه عليه السلام من صفات ثلاثة خاصة به: 1- فهو رسول مؤيد بالوحي. 2- ومعصوم. 3- وهو أفضل الخلق وأكملهم عقلا. قال الأستاذ: “من هنا ندرك فداحة غلط أولئك الذين يذهبون في قياس الأمراء على رسول الله، وينتهون إلى أن يعطوا لأمرائهم ما كان لرسول الله r من مكانة، ومن تعظيم، ومن تقديم، ومن تفويض، ومن حقوق، كأنهم لم يقرأوا سورة الحجرات وغيرها… وإذا كان الرسول –بصفاته الثلاث المذكورة- لم يثبت أنه أمضى أمرا من أمور الرأي، ضدا على ما يراه أصحابه، أفيكون للأمراء من بعده، وهم على ما هم عليه من الآفات وصفات القصور، أن يخالفوا أهل الرأي والخبرة والفضل، جميعهم أو أكثريتهم، ويتفردوا بما بدا لهم، ويحملوا الأمة عليه؟”(24).
وقد يُستدل لمذهب الانفراد بالقرار ببعض تصرفات الخلفاء الراشدين. فقالوا –مثلا-: إن أبا بكر قرر قتال مانعي الزكاة ولم يراع معارضة الصحابة لذلك. والجواب أن روايات المحدثين للقصة تكشف أن الخلاف جرى بين أبي بكر وعمر، لا بين أبي بكر وسائر الصحابة. ثم إن هذا الخلاف آل إلى الاتفاق، كما قال عمر: فشرح الله صدري لما يقوله أبو بكر. ويدل موقف الخليفة الحاسم أنه كان على علم شرعي قاطع بوجوب هذا القتال، وهو ما لم يكن لدى عمر في الظاهر. وكذلك في إنفاذ الصديق لجيش أسامة، فهو لم يزد على إمضاء أمر كان الرسول r مصرا عليه، حتى وهو في مرض موته. أما في مسألة عدم قسمة الأراضي المفتوحة، فالأمر فيه أوضح، لأن جمهور أهل الرأي من الصحابة وافق عمرا على موقفه.
وقد وجدنا –يقول الكاتب في مبحث “الترجيح بالكثرة عند العلماء”- أن أهل العلم كثيرا ما يرجحون ويفضلون اجتهادا على آخر لكثرة القائلين به؛ رغم أن المجال العلمي الصرف هو أبعد المجالات عن الخضوع للكثرة والأكثرية. لكن العلماء اعتدّوا بالكثرة واعتبروها مرجحا –عند انتفاء مرجح أقوى-، كما فعلوا في تفضيل رأي جمهور الصحابة، وفي تقديم ما روته كثرة من الرواة على رواية القلة… فهذا مبدأ مسلم عندهم، وإن اختلفوا في التطبيق، وفي اعتبار هذه الكثرة حجة مستقلة أم مجرد مرجح أولى من غيره.
ومن الواضح أن رأي الجمهور ليس إجماعا ولا يلزم المجتهد. وهل هو حجة في حق عامة المسلمين؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون. قلت: ظني أن غالب الصواب يكون مع آراء الجمهور، ونادرا ما خفي الحق على السواد الأعظم من أهل العلم والفضل، وعرفته قلة منهم. ولذلك اعتبر المؤلف أن العمل بالأغلبية هو –في الحقيقة– فرع عن العمل بمبدأ الإجماع، لأنها تحقق أكبر قدر ممكن من الإصابة والسلامة من الخطأ، وتمثل أقرب المراتب إلى مرتبة العصمة. صحيح أن الأغلبية لا تكون دائما على الحق، لكننا باتباعنا لحكمها لا نطلب السلامة التامة من الخطأ، وإنما نطلب الجهة التي فيها صواب أكثر. ومما يعزز أهمية مراعاة الأغلبية أنها تجعل الجميع يشترك بفعالية وحماس في التفكير والتدبير، لأن الناس حينئذ تشعر بأن لرأيها اعتباره. ولهذا حين تكون للقرار المتخذ –بإرادة عامة- تبعات ثقيلة أو سلبية، يتحملها الناس ويتقبلونها. كما أن الالتزام بالأغلبية يمنع الرؤساء من الاستبداد.
أما مجالات العمل بالأغلبية فهي –بصفة عامة- قضايا الرأي والاجتهاد. وعدّد منها المؤلف ثلاث مناطق:
1- التشريع الاجتهادي العام: أي التشريعات التي تحتاجها الأمة لمواكبة المستجدات، مما يكون له أثر واسع على الجمهور، أو مما تتدخل فيه الدولة. ولا شك –يقول الكاتب- أن أرقى صور ممارسة هذا التشريع هو أن يصدر عن هيئة جماعية تضم أساساً علماء البلد المجتهدين. على أن اعتبار الاجتهاد الأكثري ملزماً في الأمور العامة لا ينبغي أن يمس في شيء حق الاختلاف ولا إمكان التراجع عن هذا الاجتهاد لاحقاً.
2- التأمير والتقديم: فالأول يعني اختيار خليفة المسلمين، أو رؤساء بلدانهم… والثاني هو تولي بعض الأعمال غير الإمارة، كاختيار الناس أو جماعة مهنية من ينوب عنهم. وقد قرر الكاتب أنه إذا جاز إسناد بعض المناصب والمهام بالتعيين، فلا بد أن يبقى للجمهور نوع رقابة على المُعيّن؛ في حين يجب أن تكون تولية الإمارة شورى بين المسلمين، أو على الأقل بين أهل العلم والخبرة والقيادة فيهم، كما اختار كبار الصحابة –وهم يومئذ أكثر أهل الحل والعقد- أبا بكر خليفة.
3- تدبير المصالح والشؤون المشتركة.
الفصل الثالث: النظرية في ضوء فلسفة المعرفة
في إمكان المقارنة:
أعقد في هذا الفصل مقارنة سريعة بين نظرية التقريب والتغليب في العلوم الإسلامية وبين بعض أهم النتائج التي توصلت إليها الفلسفة في موضوع المعرفة.. وذلك لا لأقول إن هذه النظرية هي نفس ما انتهت إليه الابستيمولوجيا اليوم؛ إذ لا شك أن فكرة التغليب هي –كما كشف عن ذلك الأستاذ الريسوني- مبدأ إسلامي أصيل من جهة، وشديد الارتباط بالعلوم الإسلامية وروحها العميقة وطبيعتها المنهجية.. من جهة أخرى. لكن رغم ذلك لا أملك إلا أن أسجل شبها –وربما تماثلا- بين الأساس النظري للتغليب وبين الفكرة المحورية للثورة الحديثة في مجال الابستيمولوجيا، وأعني بهذا: فكرة الاعتراف بقيمة المعرفة الاحتمالية. ولهذا أيضا لا أملك إلا أن أثبت هنا إعجابي بالبناء العقلي المنهجي العظيم للعلوم الشرعية.. ذاك البناء الذي يتأسس على علم مزدوج: يقيني وآخر أغلبي… وهذا كذلك سبب اهتمامي بعمل الأستاذ الريسوني، وهو الوحيد –في حدود علمي- الذي كشف ببحث أكاديمي رصين عن هذه الطبيعة العميقة للمعرفة الإسلامية، مما يسمح لنا بالقول: إن هذه الثورة الابستيمولوجية لا تعني –بالأساس- إلا الغرب وتاريخه العلمي والفلسفي الخاص.
نظرية التغليب والمذهب الشكي القديم:
والحقيقة أن مشكلة المعرفة –كيفيتها وحقيقتها وقيمتها…- مشكلة قديمة في الفكر البشري، ولذلك تعرض بعض الفلاسفة للحديث عن المعرفة غير اليقينية.. لكن كان ذلك بشكل بدائي محدود لا يشكل نظرية مستقلة، ولا حتى شبه نظرية. وربما كان أهم هؤلاء هم الشكاكون Les sceptiques، ويقابلهم الفلاسفة التوكيديون أو الدوغمائيون بأطيافهم الثلاثة الرئيسة: الأفلاطونيون، والأرسطيون، والرواقيون.
والواقع أن الموقف الإسلامي في بعض أهم قضايا المعرفة أقرب إلى آراء الارتيابيين منه إلى مذاهب الدوغمائيين. من هذه القضايا: إمكان المعرفة وقيمتها(25). فالارتيابيون القدامى –بيرون وتلامذته- رأوا أن المعرفة غير ممكنة، سواء كانت حسية أم عقلية.. فهذا أهم نتائج نقدهم للعقل. فهذا رأي الشكاكين الخُلَّص: الشك في إمكان الوصول إلى الحقيقة قائم لا يرتفع، لكنهم لم ينكروا إمكان وجود الحقيقة في حد ذاتها(26). وبعضهم –ككارنيادس المتوفى سنة 129 قبل الميلاد- يعترف بوجود حـد أوسط بين الحقيقة التي لا سبيل لإدراكها وبين الغموض التام(27).
وإذا كانت نظرية المعرفة –في الإسلام- تختلف مع هذا الرأي من حيث إنها تثبت وجود الحقائق وقدرة الإنسان –مبدئيا- على اكتشاف بعضها.. فيما البعض الآخر –كحقائق الغيب-يظل فوق طور العقل.. فإن هذه النظرية –وخصوصا “التقريب والتغليب”- تلتقي مع الارتيابية فيما يخص الحياة العملية اليومية، ذلك أن الارتياب الفلسفي في جوهره هو عبارة عن التوقف عن الحكم على الأشياء، فاعتُرض عليه بأن الحياة العملية لا تحتمل تعليق الحكم إلى غير أجل. وقد حلّ كارنيادس هذه المشكلة حين اعتبر أنه توجد في المعرفة تمثلات محتملة على الحكيم أن يوافقها في العمل دون أن يخلع عليها ثوب الحقائق اليقينية، أي يكفي في شؤون الحياة اتباع ما يبدو معقولا، لذلك يحترم الشُّكاك قوانين البلد الذي يعيشون فيه وعاداته(28).
لكن من جهة أخرى يوجد فرق دقيق بين النظرين –التغليبـي والارتيابي-، وذلك لأن التغليب الإسلامي ليس تغليبا عمليا فقط، بل عقلي أيضا. أعني أن الارتيابي إذا عمل بالظاهر أو الراجح في الحياة، فإنه على المستوى الفكري لا يعتقد في صحة هذا الرجحان، بينما المفكر المسلم –بمقتضى نظرية التغليب- يعتقد ذلك. أي أن التغليب الإسلامي تغليب حتى في تصور الواقع، فالحق تبع للغالب، لهذا فهو حين يعمل بالغالب يعتقد أيضا أنه بذلك يصيب الحقيقة في الغالب.
العلم الأرسطي:
لكن الموقف الارتيابي من العلم –على ما فيه من صواب ووجاهة.. في بعض جوانبه- لم يكن هو المذهب السائد طوال تاريخ الفلسفة الأوربية إلى حدود العصر الحديث، بل الغلبة كانت دائما للأرسطية التي اعتبرت –كما يقول الفيلسوف الفرنسي المعاصر: روبان- أن موضوع المعرفة وغايتها هو اكتشاف الحقيقة المطلقة لا الوصول إلى درجة معينة من المعرفة الاحتمالية. ولذلك تأسست المعرفة الأرسطية على البرهنة المنطقية(29). من هنا كان الفلاسفة – إجمالا- يبحثون فقط عن اليقين التام، ويحقرون –بالمقابل- كل معرفة غير يقينية. فقياس التمثيل –مثلا- “لا يفيد اليقين، ولكنه يصلح لتطييب القلب وإقناع النفس في المحاورات”(30)، فهو دليل خطابي لا برهاني.
لكن هذا القياس نفسه هو القياس الفقهي الذي اعتبره علماؤنا رابع مصادر التشريع. ولا يعترف هؤلاء الفلاسفة أيضا بالاستقراء، فهو أصل عام يقبل الاستثناء(31)، و”لا يبعد أن يطرد حكم في ألف إلا في واحد”(32).
وقد أدى هذا التفكير الفلسفي بأهله إلى التهوين من شأن التجربة والتنقيص من قيمتها العلمية، فهي غير قادرة على إمدادنا بأي معرفة ضرورية، لانبنائها على الاستقراء. يقول الفيلسوف الفرنسي بوترو: في كل الأزمنة تصور الفلاسفة أن التجربة لا تنتج العلم، فهي تهتم بظواهر عارضة، ولذلك فنتائجها عامة وتقبل الاستثناء. والعلم المطلق لا يأتي إلا من الذهن الخالص(33).
ولا يختلف التصور الأفلاطوني كثيرا عن مثيله الأرسطي. فهذه محاورة تييتيتوس خصصها أفلاطون لتعريف العلم وحقيقة المعرفة ومنشأ الخطأ فيه… ونحو ذلك من قضايا نظرية المعرفة. وهي من أصعب الحوارات الأفلاطونية وأكثرها اضطرابا. ومن أسباب ذلك في رأيي أن سقراط – لسان أفلاطون في الكتاب- لم يتصور وجود درجة وسطى بين العلم والجهل، فالمرء إما يعرف أو لا يعرف، لا واسطة بينهما(34).
وقد امتد هذا الأثر الأرسطي إلى العصر الحديث، وشمل فلاسفة كبارا حتى من الاتجاه الظاهري النسبي. فكانط نفسه لم يشذ عن التصور القديم للعلم، والذي يعني مطابقة تامة ومطلقة للواقع، فسعى إلى تحصيل اليقين داخل دائرة ظواهر الأشياء(35). أي أن كانط وإن اعتبر أنه ليس بمقدور العقل الإنساني إدراك حقيقة الأشياء في حد ذاتها noumènes، إلا أنه عوّض ذلك بطلب بلوغ اليقين في عالم الظواهر phénomènes. ولم يهتم كانط بعنصر الاحتمال في المعرفة.
وهذه الرؤية الأرسطية تختلف جوهريا عن نظرية التغليب، كما رأينا ذلك مثلا في مطلب “المصطلحات الأساسية في البحث”، والذي جاء في الفصل الأول. يقول الكاتب –في الانتهاء من دراسة معنى العلم-: “إن قصر مصطلح العلم على ما كان يقينيا مطابقا –ولابد- لحقيقة الأمر، إنما هو اصطلاح خاص، فمن الغلط اعتباره المعنى الوحيد للعلم، كما فعل المتكلمون والمتفلسفون”(36).
من لوك إلى كورنو:
إذا كانت مشكلة الوجود هي محور الفلسفة القديمة، خصوصا اليونانية… فإن مشكلة المعرفة هي محور الفلسفة الأوربية الحديثة، كما تدل على ذلك فلسفات ديكارت وليبنتز وبركلي وهيوم وكانط… ونحوهم. وقد ساهم علم الكلام الإسلامي في هذا التحول الكبير، خصوصا ببحثه المميز لقضية العلاقة السببية(37).
وفي هذا السياق قام الإنجليزي جون لوك بدراسة أصل المعرفة ومسالكها وما يعرض لها.. من ذلك أنه عقد في كتابه فصلا عن الخطأ، تتبع فيه منشأ الغلط وأسبابه، وسجل حقيقة تعارض المعارف والرؤى مما يؤثر أحيانا على يقينية المعرفة. لكنه اعتبر أنه يمكن للعقل –رغم الأخطاء والمشوِّشات على سلامة المعرفة- أن يؤمن بالقضايا البديهية والواضحة جدا، والتي نعتبرها قريبة من اليقين. إن العقل في مسائل كثيرة يفضل أن يعلق حكمه عليها ولا يعتقد فيها شيئا… طالما أنه لا يحتاجها. فإذا اعتقد أن في هذه المسائل ما يهمه، فإنه –يقول لوك- سيأخذ منها ما يحتـوي على أكبر احتمال من الصواب، وهي المسائل التي يخصها العقـل بالإيمان والتصديق(38).
إن لوك يدافع عن المعرفة التي احتمال صوابها كبير جدا، وذلك في حالة تعذر اليقين.. ويؤكد على قيمة المعرفة الاحتمالية –القوية جدا-، وعلى أنه من الواجب ومن المناسب اتباع الرأي الذي يستند إلى الاحتمالات الأقوى(39).
وبهذا يظهر أنه يمكننا القول لو استعملنا اصطلاحات الأستاذ الريسوني: إن لوك يعترف أساسا بدرجة التقريب، دون التغليب.
والفيلسوف الذي خطى هذه الخطوة الأخيرة واعترف نهائيا بالتغليب المعرفي هو الفرنسي: كورنو(40)، وذلك في عدد من كتبه:
1- دراسة لأسس المعرفـة وخصائص النقد الفلسفي.
2- عرض نظرية الحظوظ والاحتمالات.
3- رسالة في تسلسل الأفكار الرئيسة في العلوم والتاريخ.
وقد استفاد كورنو من سابقيْه –كانط وكونت- مبدأَ نسبية المعرفة واستحالة إدراك كنه الأشياء. لكن لا توجد عند كانط درجات في هذه النسبية، وذلك بسبب طبيعة الإدراك الخاضعة لقوالب وصور موحدة. أما نسبية كورنو فتقبل التدرج، فقانون الجاذبية –مثلا- هو أقرب القوانين الفيزيائية إلى حقيقة الأشياء، وليس هو القانون الذي يعكس نهائيا هذه الحقيقة(41). ولذلك فالمعرفة عند كورنو درجات في القوة والضعف، واليقين نوع واحد فقط منها.
ولست أدري يقينا لماذا أهمل الفكر العربي المعاصر كورنو، وفضّل عليه ديكارت وكونت وهيجل وغيرهم.. وإن كان هذا يصدق أيضا على الفلسفة الغربية. وظني أن نظرية كورنو التي تعترف بالاحتمال وبمعرفة متدرجة في الصحة.. كانت تشاغب وتشوش على الدعاوى العريضة للقرن التاسع عشر في إدراك الحقائق والوصول إلى المعرفة الأخيرة.. لكن الفكر الغربي –بعد تقدم العلوم ونقد الأنساق الفلسفية الدوغمائية- أعاد اكتشاف كورنو في نظرية المعرفة والتاريخ والإنسانيات… كما فعل مثلا رايمون آرون في كتابه “مدخل إلى فلسفة التاريخ”(42).
العلوم الإنسانية وإعادة اعتبار المعرفة الاحتمالية:
وقد كانت أكثر العلوم تضررا من إهدار قيمة المعرفة الاحتمالية هي العلوم الإنسانية. وهذا –في رأيي- أصل مشكلتها الإبستمية، وأصل ما تجده من صعوبات جمة لكي تثبت لنفسها وضع “العلم” على غرار علوم الطبيعة. إن لعلوم الإنسان وضعية خاصة من حيث تميز الموضوع وفرادته (الإنسان)، ومن حيث طبيعة مناهجه (محدودية التجربة)… ولذلك كانت أسس هذه العلوم ومفاهيمها وأساليبها.. أمورا عامة وتقريبية في الأكثر(43). يقول بوترو: نحن لم نعد نأمل بتطابق العلم والضرورة، فالقانون شيء والضرورة شيء آخر. إن علوم الملاحظة مثلا لا تندرج بحال ضمن علوم الرياضيات، ومع ذلك فإن لها قوانين حقيقية. ولذلك كانت قوانين علومنا تقريبية فقط، وفي هذا تكمن قيمتها، بل إن تقريرها بشكل مطلق يجعل منها مجرد عمومات غير مضبوطة أو خاطئة(44). لذلك يعتبر عالم الاقتصاد الأمريكي سامويلسون –والحائز على جائزة نوبل- أن “الاقتصاد” مثلا ليس علما بحتا –كالرياضيات أو الفيزياء..- لكنه معرفة تقريبية أثبتت فعاليتها ومصداقيتها على أرض الواقع(45). وهذا ما يفسر كثرة اختلاف علماء الاقتصاد، وأن عالما لامعا ككينـز يغير بعض آرائه باستمرار(46).
ولابد أن أشير في هذا المقام إلى دور علم الطب ثم علم الإحياء –في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين- في إدخال عنصر الاحتمال إلى كافة العلوم ودفعها إلى اعتباره؛ ذلك لأن قوانين الطب ليست ضرورية بقدر ما هي أغلبية وإحصائية، فالمرضى –بالمرض نفسه- يتشابهون، لكنهم لا يتطابقون.. لقد بيّن الطب –بشكل حاسم- تميز عالم الإنسان بقوانينه الاحتمالية عن عالم المادة حيث القانون الضروري أشد حضورا وأثرا(47).
لذلك يدعو بعض الإبستميين المعاصرين إلى تطوير حساب الاحتمالات وتطوير تطبيقاته على علوم الإنسان.. بعد أن تمّ الاعتراف بتعاظم أهمية عنصر اللاّتوقع في الظواهر البشرية(48).
وقد انعكس هذا الوعي أيضا على علوم المنطق المعاصر، فانتقد كل من برتراند راسل وييارد كوين مصطلح “المعرفة” connaissance، إذا كان يفترض تطابقا وتوافقا مطلقا بين العالم من جهة والعلم الإنساني من جهة أخرى(49). كما أن بعض المناطقة يرفض مبدأ الثالث المرفوع: القضية إما صحيحة أو خاطئة ولا احتمال ثالث، ويعتبر أن بعض القضايا لا هي صحيحة ولا خاطئة(50).
لوبون ومسألة الأغلبية:
ولا أحب أن أنهي هذه المدارسة دون تناول قضية اعتبار رأي الأغلبية والاعتداد به، والتي خصص لها الأستاذ الريسوني جانبا هاما من بحثه… وذلك من زاوية علاقتها بما يمكن أن يسمى بـ “سيكولوجية الجماهير”. فقد يعتضد بعض ناقدي مبدأ تحكيم الأغلبية بما توصل إليه عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون من أمور تتعلق بموضوعنا هذا يمكن إجمالها في الآتي:
1- رغم سعة تعداد أفراد الجمهور وتنوع مكوناته.. فإنه يشكل – في بعض الظروف- كائنا مستقلا ومنسجما.
2- يكون الجمهور من الناحية الثقافية أدنى مستوى من الرجل الواحد المعزول(51).
3- إن الجماعة سريعة التصديق قليلة النقد، حتى لو كان فيها أهل علم وثقافة. ولذلك يتحدث لوبون عن العدوى الفكرية.. أي انتشار الأفكار.. داخل الجماعة(52).
4- تتأخر الجماهير دائما بأجيال عن فكر العلماء والفلاسفة(53).
وكما افترضت إمكان نقد “حكم الأغلبية” استنادا إلى نظرية لوبون.. فإنني الآن سأجيب عن ذلك بالنظرية نفسها ذاكرا جملة ملاحظات:
1- إن كتاب لوبون قديم نسبيا، وهذا لا يلغي أهميته، وذلك لأنه من دفع بظهور فرع علم النفس الاجتماعي لاحقا. لكن المقصود أن تطور دراسات الرأي العام وسلوك المجموعات… بيَّن أن الموضوع أعقد مما تصوره لوبون.
2- إن الكاتب –السيد الريسوني- لم يعترف بأيِّ أغلبية مهما كانت، بل جعل لذلك شروطا وقيودا كافية لمنع شطط الأغلبية أو شطحها. وهذا سبق أن أشرت إليه، فلا أعيده هنا.
3- إن لوبون لا يعتبر أن ملاحظاته على سلوك الجماهير تنطبق على جماعة من المختصين تتناول موضوعا من اختصاصهم، فهؤلاء لا يشكلون “جماعة” بالمعنى المراد في الكتاب.
4- ولذلك خصّص لوبون آخر فصل من كتابه للتجمعات البرلمانية، ودرس بعض ما عاصره وشاهده منها، وبيّن أنها أحيانا تتحول لسلوك الجمهور، خصوصا في التجمعات الخطابية… ثم قال: إنه لحسن الحظ لا تكون للبرلمانات خصائص الجمهور دائما، خاصة حين يتعلق الأمر بالتصويت على القوانين التي تم إعداد مشاريعها مسبقـا في لجان مصغرة(54).
لهذا لا أرى أن في آراء لوبون ما يمس فعلا بسلامة وأهمية النتائج التي قررها الأستاذ الريسوني في مشروعية –أو حجية- العمل بالأغلبية.
خاتمة:
إن نظرية التقريب والتغليب موجودة في العلوم الإسلامية.. والباحث يجد معالم هذه النظرية ويقع على آثارها في مختلف جوانب هذه العلوم وفي عدد كبير من قضاياها.. وذلك في شكل إشارات وتنبيهات، واستدلالات وحجاجات، وتطبيقات وجزئيات. وجدّة عمل الكاتب تكمن في أنه أول من كشف عنها كاملة وأصَّـلها من العقل والنقل ودفع إشكالاتها ووضع لها ضوابطها… حتى استوت قاعدةُ التغليب نظريةً منهجية ضخمة واضحة التميز بيّنة المعالم والآثار.. فكأن الأستاذ الريسوني أعاد اكتشاف هذه النظرية التي انطوت في علومنا الشرعية حتى كادت تغيب.
وقد كشف هذا البحث عن كون العمل بالظن الأقوى –كما هو الاصطلاح الشائع في الشرعيات- هو مجرد حالة من حالات العمل بالتقريب والتغليب، وأنه توجد غيرها كالتغليب في المقادير والأحوال…
وفي كل مراحل الكتاب يقوم منهج المؤلف على عرض الفكرة أو الكشف عن قاعدة موجودة أصلا، ثم يؤيدها بأنواع الحجج من الكتاب والسنة والعقل، ويستعين بفهوم العلماء ونصوصهم، ويُوجه ذلك كله للدلالة على المراد… أي أن للتأليف طابعا استدلاليا. وهذا مفهوم في إطار الهدف الذي سطره الكاتب، وهو الكشف عن النظرية وتوضيح مجالاتها وحدودها وإثبات مشروعيتها… وذلك بشكل حاسم لا يترك لدى القارئ ترددا في قبول النظرية. وقد نجح في هذا نجاحا تاما. ومما ساعده على ذلك وعلى توضيح القاعدة وترسيخها غنى الكتاب بالأمثلة والتطبيقات.
ومن فوائد التأليف أيضا كشفه لوحدة العلوم الإسلامية، ووحدة –أو على الأقل تماثل- المنطق الذي يحكمها ويسري فيها. لذا ينتقل الكاتب بالقارئ بسهولة من مسألة في الحديث إلى أخرى في الاعتقاد إلى ثالثة أصولية أو فقهية.. فهذا العمل تأكيد جديد على التداخل الشديد لهذه العلوم، ليس فقط على مستوى المضامين بل أيضا على مستوى المنهجية وروحها. لهذا استطاع الباحث أن ينظم في سلك واحد عشرات المسائل والقضايا الشرعية، وأن يحقق كثيرا من الإشكالات –وبعضها من أصول الخلاف- في مجالات الأصول والحديث والفقه… ولعله من المفيد جدا تدريس الكتاب لطلبة العلوم الإسلامية، خاصة في المرحلة العليا من الدراسات الفقهية والأصولية، أو ما يسمى بالخلاف العالي.. لأن هذا العمل يقوم على مناقشة رصينة مبنية على الأدلة، ولذا فهو يعلِّم النقد، لكن في إطار التمسك بالثوابت ومراعاة فقه الأولويات.. إضافة إلى جمعه بين الجانبين النظري والتطبيقي، فالعلم الذي يحمله الكتاب – بمناقشاته واختياراته واجتهاداته- نموذج حي للعلم الشرعي الوسط ولأهله الحقيقيين..
وأخيرا أجد أن سؤالا يلح على نفسي، فأذكره لعل في القراء من يسهم معنا في التفكير حوله والإجابة عنه: هل يمكننا الآن تأسيس ابستيمولوجيا موحدة خاصة بالعلوم الإسلامية، بل هل من المشروع الحديث عن ابستيمولوجيا لهذه العلوم؟ ظني أن كتاب “نظرية التقريب” يجيب على هذا السؤال.
* * *
الهوامش
(1) انظر كتابي: “من أصول الشريعة الإسلامية: الاحتياط، حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه،” في عدد من المواضع، منها: صفحات: 65، 112، 358…. وقد صدر هذا الكتاب عن مؤسسة الرسالة ببيروت، سنة 2003، الطبعة الأولى.
(2) من أسباب تقاطع موضوعي الاحتياط والتغليب، أن مبدأ الاحتياط هو –أحيانا- نقيض نظرية التغليب، وذلك أننا حين نأخذ بالاحتمال الأقوى فنحن –في الواقع- نطبق النظرية، وإذا أخذنا بالاحتمال المرجوح كان ذلك من باب الاحتياط.
(3) رسالة: “الغيب والمستقبل. دراسة ابستيمولوجية عن إمكان التوقع وأساليبه وحدوده”، نوقشت بكلية الآداب بوجدة في 5 أكتوبر 2002.
(4) نظرية التقريب والتغليب، ص 4.
(5) في كتابي عن الاحتياط تعرضت لهذه المصطلحات نفسها وتوصلت إلى نتائج مطابقة لما قرّره الأستاذ الريسوني، خصوصا من جهة ملاحظة اختلاف الاستعمالات اللغوية والقرآنية عن المعاني المستقرة في الاصطلاح المتأخر، ولهذا آثاره… انظر: الاحتياط، ص 210.
(6) نظرية التقريب، ص 29.
(7) راجع التفصيل في الفصل الثاني من هذا المقال: مباحث مميزة في الكتاب.
(8) نظرية التقريب والتغليب، ص 112.
(9) نظرية التقريب، ص 149.
(10) رواه الشيخان عن أبي هريرة وعن عمرو بن العاص، والأربعة عن أبي هريرة.
(11) نظرية التقريب، ص 334.
(12) أُعد بحثا أوسع في هذه المسألة، أي أن مجال التصحيح والتضعيف يدخله الاجتهاد والاختلاف.
(13) نظرية التقريب، ص 68.
(14) نظرية التقريب، ص 73، 84.
(15) نظرية التقريب والتغليب، ص 119، 180، 226.
(16) نظرية التقريب والتغليب، ص 123.
(17) عن تفسيره: التحرير والتنوير، 1/32.
(18) راجع كتابه: مرآة الأصول 1/417، مع حاشية الأزميري عليه. دار الطباعة العامرة، إستانبول، 1300هـ.
(19) الكتابان: 1- من أصول الشريعة الإسلامية: الاحتياط. مؤسسة الرسالة، 2003. 2-الوجود بين مبدئي السببية والنظام.
(20) نظرية التقريب، ص 221. وانظر كتاب: لا إنكار في مسائل الخلاف، سلسلة كتاب الأمة، 2003.
(21) الأشباه والنظائر، 1/105.
(22) إذا أراد القارئ أن يفهم أهمية هذا التقسيم يمكنه أن يراجع أحد أهم الكتب المعاصرة في موضوع الذرائع، وهو كتاب هشام البرهاني: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، عن دار الفكر. وسيلاحظ –بالمقارنة- أن هذا التقسيم بالضبط هو ما كان ينقص أطروحة البرهاني المتخصصة.
(23) نظرية التقريب، ص 460.
(24) نظرية التقريب، ص 476 – 477.
(25) توسعت في هذا الموضوع بتفصيل أكثر في كتابي: “الغيب والعقل، دراسة في حدود المعرفة البشرية”.
(26) راجع: (الارتياب الفلسفي) Verdan: Le scepticisme philosophique, p 26- 27.
(27) Le scepticisme philosophique p 30-31.
(28) Ibid, p 26 – 27.
(29) Léon Robin: La pensée grecque, p 297.
(30) مقاصد الفلاسفة، لأبي حامد الغزالي، ص 90.
(31) (فلسفة كانط) Emile Boutroux: La philosophie de Kant, p 11.
(32) مقاصد الفلاسفة، ص 89.
(33) La philosophie de Kant, p 126-127.
(34) اقرأ: Platon: Théététe
(35) La philosophie de Kant, p 129.
(36) نظرية التقريب، ص 17، ويمثل ابن رشد جيدا هذه الرؤية الأرسطية، كما هو بيِّن في كتبه، خصوصا منها: تهافت التهافت، انظر حول هذه المسألة كتاب: الأسباب والمسببات، دراسة تحليلية مقارنة للغزالي وابن رشد وابن عربي، لعبد الله الشرقاوي، ص 111 إلى 119.
(37) راجع التفاصيل في كتابي الذي صدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي: “الوجود بين مبدئي السببية والنظام، بحث في الأساس الشرعي والنظري لاستشراف المستقبل”.
(38) (بحث في الفهم البشري) Jean Locke: Essai sur l’entendement humain, p 222 à 224.
(39) اقرأ خصوصا: Essai sur l’entendement… livre: de la connaissance, sections 15 et 16, p 220 à 224.
(40) راجع مقالا مختصرا عن حياة كورنو وأعماله في الموسوعة الكونية: Encyclopaedia Universalis, 6/704 – 705, article: Cournot.
(41) (تاريخ الفلسفة) Emile Bréhier: Histoire de la philosophie, 7/93 – 94.
(42) في نيتي –إذا أذن الله سبحانه- أن أعرِّف بفكر كورنو في تأليف مستقل، أو أترجم بعض كتبه عن الفرنسية.
(43) G-G,Granger:La Raison,p74à88 (العقل)
(44) La philosophie de Kant, p 129 – 130.
(45) (مدخل إلى الميكرو-اقتصاد) Paul Samuelson et William Nordhaus: Micro-économie, p 15 – 16.
(46) Micro – économie, p 59.
(47) (الابستيمولوجيا) Hervé Barreau: l’épistémologie, p 76 – 77. وراجع في هذه القضية كتاب كلود برنار “مدخل لدراسة الطب التجريبي”، 1865، وهو من أهم الأعمال التي عكست هذا التحول في ابستيمولوجيا علوم الطب والإحياء.
(48) La Raison, p 87.
(49) (مقال عن الامبريقية) Encyclopaedia Universalis, 8/252, article empirisme
(50) L’épistémologie, p 32 – 33.
(51) (علم نفس الجماهير) Gustave Le Bon: Psychologie des foules, p 55.
(52) Ibid, p 62, 127.
(53) Ibid, p 78 – 79.
(54) اقرأ: La psychologie des foules, p 181 à 186.