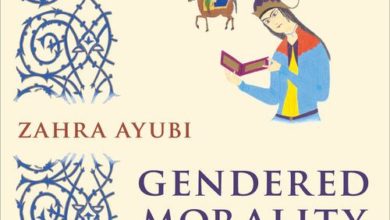عرض كتب : قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى للدكتور عبد الوهاب المسيرى
(1)
في هذه الصفحات يجد القاريء العزيز محاولة لعرض أهم الأفكار التي تناولها د. عبد الوهاب المسيري في كتابه صغير الحجم كبير الفائدة المعنون “قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى” (دار نهضة مصر – سلسلة “في التنوير الإسلامي”).
يقول المسيري إن مصطلح “فيمينـزم Feminism” يُترجم إلى “النسوية” أو “النسوانية” أو الأنثوية” وهي ترجمة حرفية لا تـُفصح عن أي مفهوم كامن وراء المصطلح، ولإدراك معناه المركب والحقيقي لا بد أن نضع المصطلح في سياق أوسع هو ما يُعرف بـ “نظرية الحقوق الجديدة”. فكثير من الحركات التحررية في الغرب في عصر ما بعد الحداثة (عصر سيادة الأشياء وإنكار المركز والمقدرة على التجاوز – أي تجاوز الإنسان لعالم الطبيعة/المادة – وسقوط كل الثوابت والكليات في قبضة الصيرورة) تختلف تماما عن الحركات التحررية القديمة التي تصدر عن الرؤية الإنسانية المتمركزة حول الإنسان. توضيح ذلك أن منظومة التحديث والعلمنة الغربية تطورت عبر الزمن في شكل حلقات تتبع الواحدة الأخرى كالتالي:
(1)الواحدية الإنسانية:
تبدأ متتالية التحديث والعلمنة بأن يواجه الإنسان الكون دون وسائط فيُعلن أنه سيد الكون ومركزه، ولذا فهو مرجعية ذاته لا يستمد معياريته إلا منها. وانطلاقا من هذا الافتراض يحاول الإنسان أن يؤكد جوهره الإنساني (المستقل عن الطبيعة) وأن يتجاوز الطبيعة/المادة بقوة إرادته وأن يفرض ذاته الإنسانية عليها باسم إنسانيتنا المشتركة أي باسم الإنسانية جمعاء.
(2)الواحدية الإمبريالية:
يتحدث الإنسان – الذي يؤكد جوهره الإنساني- باسم كل البشر، ولكن في غياب أية مرجعية متجاوزة لذاته الفردية، ينغلق الإنسان على هذه الذات فيصبح تدريجيا إنسانا فردا لا يفكر إلا في مصلحته ولذته، ولا يشير إلى الذات الإنسانية أو “الإنسانية جمعاء” وإنما إلى الذات الفردية، فيُؤلّ الإنسان الفرد نفسه في مواجهة الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح إنسانا إمبرياليا. وحينما يستمد هذا الإنسان الإمبريالي معياريته من ذاته الإمبريالية التي تستبعد الآخرين يصبح إنسانا عنصريا يحاول أن يستعبد الآخرين ويوظفهم بل ويوظف الطبيعة نفسها لحسابه، وهنا تظهر الثنائية الصلبة: ثنائية الأنا والآخر.
(3) ثنائية الإنسان والطبيعة الصلبة:
بعد المراحل السابقة التي تتميز بالتمركز حول الذات الإنسانية (إما بطريقة إنسانية أو بطريقة إمبريالية عنصرية) يكتشف الإنسان تدريجيا أن الطبيعة/المادة هي أيضا مرجعية ذاتها ومكتفية بذاتها، فتظهر ثنائية صلبة أخرى: ثنائية الإنسان المتمركز حول ذاته والذي يشغل مركز الكون مقابل الطبيعة المكتفية بذاتها والتي تشغل أيضا مركز الكون.
(4) الواحدية الصلبة:
سرعان ما تنحل هذه الثنائية أو الازدواجية الصلبة (الإنسان/الطبيعة) إذ تصبح الطبيعة/المادة وحدها هي المركز والمرجعية وتحل الواحدية الطبيعة/المادة محل الواحدية الإنسانية، فيبدأ الجوهر الإنساني في الغياب تدريجيا ويحل الطبيعي محل الإنساني، ويستمد الإنسان معياريته لا من ذاته وإنما من الطبيعة/المادة ويزداد اتحاده بالطبيعة إلى أن يذوب فيها تماما ذوبان الجزء في الكل. حينئذ يظهر الإنسان الطبيعي، إنسان جوهره طبيعي/مادي وليس إنسانيا، فهو يُذعن للطبيعة ويتبع قوانينها فيصبح جزءا لا يتجزأ من الطبيعة أي يتم تفكيك الإنساني ورده إلى الطبيعي. وهكذا تـُقوَّض مقولة الإنسان وفكرة الطبيعة البشرية المنفصلة عن قوانين المادة، أي أننا انتقلنا من عالم يتسم بالثنائية والصراع مركزه الإنسان أو الطبيعة إلى عالم واحدي مركزه الطبيعة/المادة وحسب. وهذا العالم رغم لا إنسانيته هو عالم له مركز، ولذا فهو يتسم بما نسميه “الواحدية الصلبة”.
(5)الواحدية السائلة:
تفقد الطبيعة/المادة مركزيتها باعتبارها المرجعية النهائية وتتعدد المراكز ويصبح النسبي هو المطلق الوحيد والتغير هو نقطة الثبات الوحيدة، ويغيب في نهاية الأمر كل يقين وتسيطر النسبية تماما وتتعدد المراكز ويسقط كل شيء في قبضة الصيرورة الكاملة. ويفضي بنا كل هذا إلى عالم مفكك لا مركز له، ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى تماما فيه الأطراف بالمركز، عالم لا يوجد فيه قمة أو قاع أو يمين أو يسار (أو ذكر أو أنثى)، وإنما يأخذ شكلا مسطّحا تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على نفس السطح وتـُصفّى فيه كل الثنائيات، عالم بلا جذور ولا مرجعية ولا أسس، وهذا هو التفكيك الكامل، وهذا هو الانتقال من الثنائية الصلبة والواحدية الصلبة إلى الواحدية السائلة التي لا تعرف حدودا ولا قيودا، وهو أيضا الانتقال من عالم التحديث والحداثة والإمبريالية إلى عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد.
ورغم الاختلاف المعرفي والفلسفي بين الواحدية الصلبة والواحدية السائلة إلا أنه يمكن القول بأن نقاط التشابه – من منظور هذا البحث كما يقول المسيري- أهم من نقاط الاختلاف، فجوهرهما هو تغييب الإنساني وتفكيكه وتقويضه وتذويبه، إما في عالم مركزه الطبيعة أو في عالم لا مركز له.
هذا النمط (الواحدية الإنسانية “عالم مركزه الإنسانية جمعاء” – الواحدية الإمبريالية “عالم مركزه الذات الفردية” – الثنائية الصلبة “صراع بين الإنسان والطبيعة” – الواحدية الصلبة “عالم مركزه الطبيعة” – الواحدية السائلة “عالم بلا مركز سقط في قبضة الصيرورة”) هو نمط أساسي في الفكر المادي منذ بداية التفكير الفلسفي، ولكنه يظهر بشكل متبلور في الفلسفات المادية في العصر الحديث، فبعد مرحلة إنسانية أولية قصيرة تظهر الإمبريالية والعنصرية والعداء العميق للإنسان ويـُقسَّم البشر إلى رجل أعلى (سوبر مان superman) ورجل أدنى (سبمان sub man)، وهكذا يظهر عالم صراعي ثنائي ينقسم فيه البشر إلى: جزار وضحية – قاتل ومقتول – أقوياء وضعفاء – باطشون ومتكيفون مرنون. ولكن ما يجمع السوبر مان والسبمان أن كليهما لا يعبر عن الجوهر الإنساني المتجاوز للطبيعة/المادة وإنما هو جزء من عالم الطبيعة/المادة الواحدي الصلب. وأسبقية الطبيعة/المادة على الإنسان تترجم نفسها إلى أسبقية الفرد على المجتمع وأسبقية المصلحة الشخصية والمنفعة الفردية على قيم المجتمع ومتطلبات بقائه. هذا العالم يتسم بالحركة الدائمة، ولذا سرعان ما ينحل العالم الثنائي الصلب والعالم الواحدي الصلب إلى عالم لا مركز له، في حالة سيولة شاملة.
وبـِناءً على هذه المتتالية التي تسير وفقها منظومة التحديث والعلمنة الغربية يقول المسيري إن حركات التحرر القديمة كانت تنطلق من الواحدية الإنسانية ومن الإيمان بتميز الإنسان عن الطبيعة وبتفوقه عليها ومركزيته فيها ومقدرته على تجاوزها وعلى صياغتها وصياغة ذاته، وكانت المطالبة بالمساواة بين البشر تتم داخل هذا الإطار حيث يقف الإنسان على قمة الهرم الكوني، كائنا حرا مبدعا فريدا.
أما حركات التحرر الجديدة فهي حركات تقبل بالواحدية الإمبريالية (الإنسان في صراع مع أخيه الإنسان) وتدور في إطار الثنائية الصلبة (حرب الإنسان ضد أخيه الإنسان وضد الطبيعة) والواحدية الصلبة (سيادة الطبيعة على الإنسان وإزاحة الإنسان من مركز الكون) والواحدية السائلة (رفض فكرة المرجعية والمركز وأي ثوابت أو كليات بما في ذلك مفهوم الإنسانية المشتركة القادرة على تجاوز الطبيعة/المادة).
فهذه الحركات الجديدة تؤكد على فكرة الصراع بشكل متطرف، وتنظر للإنسان على أنه مجرد كائن طبيعي يمكن رده إلى الطبيعة/المادة وتسويته بالكائنات الطبيعية، وبالفعل يـُسوّى الإنسان بالحيوان والنباتات والأشياء إلى أن يـُسوّى كل شيء بكل شيء آخر، فتتعدد المراكز ويتهاوى اليقين ويسقط كل شيء في قبضة الصيرورة وتظهر حالة من عدم التحدد والسيولة والتعددية المفرطة.
وفي هذا الإطار يمكن أن يخضع كل شيء للتجريب المستمر خارج أي حدود أو مفاهيم مسبقة (حتى لو كانت إنسانيتنا المشتركة التي تحققت تاريخيًّا) ويبدأ البحث عن “أشكال” جديدة للعلاقات بين البشر لا تهتدي بتجارب الإنسان التاريخية، وكأن عقل الإنسان بالفعل صفحة مادية بيضاء، وكأنه لا يحمل عبء وعيه الإنساني التاريخي، وكأنه آدم قبل لحظة الخلق، قبل أن ينفخ الله فيه من روحه، فهو قطعة من الطين التي يمكنها أن تصاغ بأي شكل لا فارق بينها وبين أي عنصر طبيعي/مادي آخر.
ومن منظور نظرية الحقوق الجديدة هذه يُعدّ رفض الإيمان بأسبقية الفرد على المجتمع والتسوية بين الإنسان والطبيعة فعلا رجعيا ورفضا للتقدم، مع أن موقف الرفض هذا -كما يقول المسيري- هو في واقع الأمر محاولة للعودة إلى فكرة الإنسان الاجتماعي الحضاري المستقل عن الطبيعة القادر على تجاوزها، صاحب الإرادة والوعي، هو رفض للحالة الطبيعية المادية (البهيمية) وتسوية الإنسان بالحيوان، ودفاع عن أسبقية المجتمع على الفرد وعن مركزية الإنسان في الكون.
في هذا الإطار يمكننا أن نعيد النظر في هذا الدفاع الشرس عن الشذوذ الجنسي، فهو في جوهره -كما يوضح المسيري- ليس دعوة للتسامح أو لتفهم وضع الشواذ جنسيا (كما قد يتراءى للبعض لأول وهلة) بل هو دعوة لتطبيع الشذوذ الجنسي أي جعله أمرا طبيعيا عاديا، مما يشكل هجوما على طبيعة الإنسان الاجتماعية وعلى إنسانيتنا المشتركة كمرجعية نهائية وكمعيار ثابت يمكن الوقوف على أرضه لإصدار أحكام إنسانية ولتحديد ما هو إنساني وما هو غير إنساني، أي أن الشذوذ الجنسي لم يعد مجرد تعبير عن مزاج (أو انحراف) شخصي وإنما تحول إلى أيديولوجية تهدف إلى إلغاء ثنائية إنسانية أساسية هي ثنائية الذكر/الأنثى التي يستند إليها العمران الإنساني والمعيارية الإنسانية.
والحديث عن “حقوق الإنسان” الذي تقوده وتموله أكثر الدول إمبريالية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية هو في جوهره هجوم على مفهوم الإنسانية المشتركة، فالإنسان الذي يتحدثون عن حقوقه هو وحدة مستقلة بسيطة كمية، أحادية البعد، غير اجتماعية وغير حضارية، لا علاقة لها بأسرة أو مجتمع أو دولة أو مرجعية تاريخية أو أخلاقية، هو مجموعة من الحاجات (المادية) البسيطة المجردة التي تحددها الاحتكارات وشركات الإعلانات والأزياء وصناعات اللذة والإباحية (وفي نهاية الأمر صناعة السلاح أهم الصناعات في العصر الحديث وأكثرها فتكا وتفكيكا).
ولذا لا يتحدث أحد عن حق الإنسان (الاجتماعي) والمجتمعات الإنسانية في البقاء داخل منظوماتها القيمية وخصوصياتها القومية، ولم يطرح أحد قضية صناعة الإباحية وسلعها المختلفة التي تـُصدَّر من الغرب والتي تـُهدر أبسط الحقوق الإنسانية وتحول الإنسان إلى كم مادي لا قداسة له، كذلك لم يناقش أحد قضية حقوق الشعوب التي تـُنهَب ثرواتها وتـُسرَق أموالها ثم تُودَع في بنوك غربية من قِبَل شخصيات تساندها نفس الحكومات التي تصرخ ليل نهار مطالبة بالحفاظ على حقوق الإنسان “الفرد”.
ولم يطالب أحد بوقف صناعة أسلحة الفتك والدمار التي تُطوَّر ويُصنَّع معظمها في العالم الغربي والتي تمتص ميزانيات الشعوب وتلوث البيئة وتدمر آلاف الأنفس كل عام . فالحديث دائما يجري عن إنسان مجرد بسيط لا يوجد داخل التاريخ والمجتمع والحضارة والأسرة، ومن ثم ينصب الحديث على الحقوق المطلقة لهذا الفرد، أي حقوق تتجاوز حقوق المجتمع ومنظوماته الأخلاقية والمعرفية، ولكن هذا الفرد الحر من الناحية النظرية يسقط بالفعل في قبضة الصيرورة التي تتحكم فيها أجهزة الإعلام الغربية والشركات عابرة القارات وصناعة اللذة.
ويظهر الهجوم على فكرة المجتمع الإنساني ومفهوم الإنسانية المشتركة (الإنسانية جمعاء) في المفهوم الجديد للأقليات الذي يروجه النظام العالمي الجديد وهيئة الأمم المتحدة وبعض الجماعات التي تدور في فلكها ودعاة نظرية الحقوق الجديدة، فالجماعات الدينية أقلية والجماعات الإثنية أقلية والشواذ جنسيا أقلية والمعوقون أقلية والمسنون أقلية والبدينون أقلية والأطفال أقلية والنساء أقلية.
وفكرة أن كل الناس أقليات تعني أنه لا يوجد أغلبية، أي لا يوجد معيارية إنسانية ولا ثوابت، ومن ثم تصبح كل الأمور نسبية متساوية وتسود الفوضى المعرفية والأخلاقية. وإذا كان لكل أقلية حقوق “مطلقة” فإن هذا يؤدي في واقع الأمر إلى أن فكرة المجتمع الذي يستند إلى عقد اجتماعي وإلى إيمان بإنسانيتنا المشتركة تصبح مستحيلة، إذ أن الحقوق المطلقة التي لا تستند إلى أي إطار مشترك لا يمكنها التعايش (وهذا ما حدث في فلسطين المحتلة حين جاء الصهاينة بحقوق يهودية مطلقة لا تعرف الإنسانية المشتركة فقاموا بطرد الفلسطينيين من أرضهم وهدم وطنهم).
تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى: فروق حادة:
يقول المسيري إن هناك اختلافا كبيرا بين حركة الفيمينـزم (التي يترجمها إلى حركة التمركز حول الأنثى) وحركة تحرير المرأة، فالأخيرة واحدة من حركات التحرر القديمة التي تدور في إطار إنساني يؤمن بفكرة مركزية الإنسان في الكون وبفكرة الإنسانية المشتركة التي تشمل كل الأجناس والألوان وتشمل الرجال والنساء، وبفكرة الإنسان الاجتماعي الذي يستمد إنسانيته من انتمائه الحضاري والاجتماعي. والإنسان من منظور حركة تحرير المرأة كيان حضاري مستقل عن عالم الطبيعة/المادة لا يمكنه أن يوجد إلا داخل المجتمع. ومن ثم تحاول هذه الحركة أن تدافع عن حقوق المرأة داخل حدود المجتمع وخارج الأطر الصراعيةالداروينية التي ترى المجتمع باعتباره ذرات متصارعة.
والمرأة في تصور هذه الحركة كائن اجتماعي يضطلع بوظيفة اجتماعية ودور اجتماعي، ولذا فهي حركة تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة الحقيقية داخل المجتمع (لا تحقيق مساواة مستحيلة خارجه) بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان (رجلا كان أو امرأة) من تحقيق لذاته والحصول على مكافأة عادلة (مادية أو معنوية) لما يقدم من عمل.
وعادة ما تطالب حركات تحرير المرأة بأن تحصل المرأة على حقوقها كاملة: سياسية كانت (حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة) أو اجتماعية (حق المرأة في الطلاق وفي حضانة الأطفال) أو اقتصادية (مساواة المرأة مع الرجل في الأجور).
ورغم أن دعاة حركة تحرير المرأة -كما يقول المسيري- قد يستخدمون أحيانا خطابا تعاقديا، وقد ينظرون أحيانا إلى المرأة باعتبارها فردا مستقلا بذاته عن المجتمع لا باعتبارها أما وعضوا في أسرة، أو قد ينظرون إليها باعتبارها إنسانا اقتصاديا أو جسمانيا (أي إنسانا طبيعيا ماديا) لا إنسانا إنسانا، إلا أن الإطار المرجعي النهائي هو الرؤية الإنسانية التي تضع حدودا بين الإنسان والطبيعة وتفترض وجود مركزية إنسانية ومعيارية إنسانية ومرجعية إنسانية وطبيعة إنسانية مشتركة، ولذا تأخذ حركة تحرير المرأة بكثير من المفاهيم الإنسانية المستقرة الخاصة بأدوار المرأة في المجتمع وأهمها بطبيعة الحال دورها كأم.
ولذا يتحرك برنامج حركة تحرير المرأة داخل إطار من المفاهيم الإنسانية المشتركة التي صاحبت الإنسان عبر تاريخه الإنساني مثل مفهوم الأسرة باعتبارها أهم المؤسسات الإنسانية التي يحتمي بها الإنسان ويحقق من خلالها جوهره الإنساني ويكتسب داخل إطارها هويته الحضارية والأخلاقية، ومثل مفهوم المرأة باعتبارها العمود الفقري لهذه المؤسسة، ولا تطرح أفكارا مستحيلة ولا تنـزلق في التجريب اللانهائي المستمر الذي لا يستند إلى نقطة بدء إنسانية مشتركة ولا تحده أي حدود أو قيود إنسانية أو تاريخية أو أخلاقية. هذا هو الإطار الحضاري والمعرفي لحركة تحرير المرأة وهذه هي بعض ثوابتها، وقد كان هذا هو أيضا الإطار الأساسي لحركات التحرر في الغرب حتى منتصف الستينيات.
ولكنّ الحضارة الغربية دخلت عليها تطورات غيرت من توجهها وبنيتها، إذ تصاعدت معدلات الترشيد المادي للمجتمع أي إعادة صياغته وصياغة الإنسان ذاته في ضوء معايير المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية، وزاد تسلع الإنسان وتشيؤه (مما يعني إزاحته عن المركز على أن تحل السلع والأشياء محله) وصار “التقدم” يقاس بمقاييس مادية بغض النظر عن الثمن الإنساني مهما كانت فداحته، وزادت هيمنة القيم البرانية المادية مثل: الكفاءة في العمل في الحياة العامة مع إهمال الحياة الخاصة، الاهتمام بدور المرأة العاملة (البرانية) مع إهمال دور المرأة الأم (الجوانية)، الاهتمام بالإنتاجية على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية الأساسية (مثل تماسك الأسرة وضرورة توفير الطمأنينة للأطفال)، اقتحام الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة لمجال الحياة الخاصة، إسقاط أهمية الإحساس بالأمن النفسي الداخلي… إلخ.
وقد لاحظ أحد علماء الاجتماع الغربيين (كريستوفر لاش) – كما يورد المسيري – أنه منذ أواخر الستينيات أصبح من المستحيل على الأسرة الأمريكية أن تعيش على دخل واحد فأصبح لزاما على المرأة أن تصبح “يدا عاملة” و”طاقة إنتاجية” و”مادة طبيعية برانية”، وأصبح من الضروري أن تتخلى عن وظائفها الإنسانية “التقليدية” مثل الأمومة، أي أنه قُضِي على آخر معقل ومأوى للإنسان وآخر مؤسسة وسيطة تقف بين الإنسان ورقعة الحياة العامة التي تديرها الدولة وتسيِّرها المؤسسات الاقتصادية ويوجهها قطاع اللذة.
وقد بلغ الترشيد (في الإطار المادي) درجة عالية من الشمول والتغلغل في كل جوانب الحياة العامة والخاصة حتى أصبح العمل الإنساني هو العمل الذي يقوم به المرء نظير أجر نقدي محسوب (كم محدد) خاضع لقوانين العرض والطلب، على أن يؤديه في رقعة الحياة العامة أو يصب فيه في نهاية الأمر. وهذا التعريف يستبعد بطبيعة الحال الأمومة وتنشئة الأطفال وغيرها من الأعمال المنـزلية، فمثل هذه الأعمال لا يمكن حسابها بدقة ولا يمكن أن تنال عليها الأنثى أجرا نقديا رغم أنها تستوعب جل حياتها واهتمامها إن أرادت أن تؤديها بأمانة، ولا يمكن لأحد مراقبتها أثناء أدائها فهي تؤديها في رقعة الحياة الخاصة. باختصار شديد عمل المرأة في المنـزل هو عمل لا يمكن حساب “ثمنه” (مع أن “قيمته” مرتفعة للغاية) ولذا فهو ليس “عملا”، حتى أنه أصبح من الشائع الآن أن تجيب ربة المنـزل عن سؤال بخصوص نوعية عملها بقولها “لا أفعل شيئا فأنا أمكث في المنـزل” بمعنى أن وظيفتها كأم (رغم أهميتها) وعملها كأم (رغم المشقة التي تجدها في أدائه) هو “لا شيء” فهو عمل لا تتقاضى عنه أجرا ولا يتم في رقعة الحياة العامة.
وهكذا تغلغلت المرجعية المادية (بتركيزها على الكمي والبراني) وتراجعت المرجعية الإنسانية (بتركيزها على الكيفي والجواني) وتراجع البعد الإنساني الاجتماعي الذي يفترض مركزية إنسانية وطبيعة إنسانية متفردة تتمتع بقدر عال من الثبات يميزها عن قوانين الطبيعة المادية المتغيرة وتم إدراك الإنسان خارج أي سياق اجتماعي إنساني بحيث أصبح الإنسان كائنا طبيعيا ماديا كميا لا يشغل أية مركزية في الكون وليس له مكانة خاصة فيه، يسري عليه ما يسري على الأشياء الطبيعية/المادية الأخرى، أي أنه تم تفكيك الإنسان تماما وتحويله من الإنسان المنفصل عن الطبيعة إلى الإنسان الطبيعي/المادي الذي يتحد بها ويذوب فيها ويستمد معياريته منها، فيفقد الدال “الإنسان” مدلوله الحقيقي ويحل الكم محل الكيف والثمن محل القيمة.
ويذهب المسيري إلى أن حركة الفيمينـزم أو التمركز حول الأنثى هي تعبير عن هذا التحول ذاته وعن إزاحة الإنسان من مركز الكون وعن هيمنة الطبيعة/المادة على الإنسان. وتترجم هذه الرؤية نفسها إلى مرحلتين:
(1) مرحلة واحدية إمبريالية وثنائية وواحدية صلبة ينقسم فيها العالم إلى ذكور متمركزين تماما حول ذكورتهم يحاولون أن يصرعوا الإناث ويهيمنوا عليهن، في مقابل إناث متمركزات تماما حول أنوثتهن يحاولن بدورهن أن يصرعن الرجال ويهيمنّ عليهم.
(2) سرعان ما تنحل هذه الواحدية الإمبريالية والثنائية والواحدية الصلبة لتصبح واحدية مادية سائلة لا تعرف فارقا بين ذكر أو أنثى. ولذا لا يتصارع الذكور مع الإناث وإنما يتفككون جميعهم ويذوبون في كيان واحد لا معالم له ولا قسمات.
الواحدية الإمبريالية والثنائية والواحدية الصلبة والتمركز حول الأنثى:
تؤكد حركة التمركز حول الأنثى في أحد جوانبها الفوارق العميقة بين الرجل والمرأة، وتصدر عن رؤية واحدية إمبريالية وثنائية الأنا والآخر الصلبة كأنه لا توجد مرجعية مشتركة بينهما، وكأنه لا توجد إنسانية جوهرية مشتركة تجمع بينهما. ولذا فدور المرأة كأم ليس أمرا مهما، ومؤسسة الأسرة من ثم تعد عبئا لا يطاق.
فالمرأة المتمركزة حول ذاتها تشير إلى ذاتها، مكتفية بذاتها، تود اكتشاف وتحقيق ذاتها خارج أي إطار اجتماعي، في حالة صراع كوني أزلي مع الرجل المتمركز حول ذاته، وكأنها الشعب المختار في مواجهة الأغيار.
وإذا كانت حركة تحرير المرأة تدور حول قضية تحقيق العدالة للمرأة داخل المجتمع، فإن حركة التمركز حول الأنثى تقف على النقيض من ذلك، فهي تصدر عن مفهوم صراعي للعالم حيث تتمركز الأنثى حول ذاتها ويتمركز الذكر هو الآخر حول ذاته، ويصبح تاريخ الحضارة البشرية هو تاريخ الصراع بين الرجل والمرأة وهيمنة الذكر على الأنثى ومحاولتها التحرر من هذه الهيمنة.
وينادي دعاة التمركز حول الأنثى بالتجريب الدائم والمستمر ويطرحون برنامجا ثوريا يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء: التاريخ واللغة والرموز بل والطبيعة البشرية ذاتها.
وفي مجال وضع هذا البرنامج “الثوري” موضع التنفيذ ينادي هؤلاء بضرورة إعادة سرد التاريخ من وجهة نظر أنثوية (أي متمركزة حول الأنثى)، بل وأعيد تسمية التاريخ الذي يعني بالإنجليزية (history)التي قد تعني (his story)أي قصته، ليصبح (her story)أي قصتها، أي أن تاريخ الذكور مختلف تماما عن تاريخ الإناث (تماما مثل “التاريخ اليهودي” المستقل عن “التاريخ الإنساني”).
والرموز التي فرضها الذكور لا بد أن تضاف إليها رموز أنثوية تعبر عن الهوية الأنثوية المستقلة، ومنتجات الإنسان الفنية لا بد أن تعبر عن الأنثى وآلامها، ومن هنا التركيز الشديد في الأدب الغربي الحديث على الجوانب الصراعية في علاقة الرجل بالمرأة وعلى موضوعات مثل الاغتصاب. والهدف الأساسي لحركة التمركز حول الأنثى في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير هو رفع وعي النساء بأنفسهن كنساء وتحسين أدائهن في المعركة الأزلية مع الرجال وفي الصراع الكوني بين الذكور والإناث، فلا حب ولا تراحم ولا إنسانية مشتركة بل صراع شرس.
وهذه الرؤية الصراعية الداروينية الشرسة تتبدى في رؤية الحركة لأحاسيس كل من الرجل والمرأة. ففي غياب الإنسانية المشتركة لا يمكن أن تكون هناك أحاسيس إنسانية مشتركة بين الذكر والأنثى، فتركيبة جسديهما مختلفة وطبيعتهما الفسيولوجية مختلفة (والإنسان الطبيعي/المادي يعيش في الجسد وحده، داخل حدود الجسد وحسب). كما أن لغة النساء مختلفة تماما عن لغة الرجال، فهي لغة ملتوية لعوب كجسد المرأة (الجسد مرة أخرى، الجسد دائما، الجسد في البداية والنهاية) ولذا فالتواصل بين الذكر والأنثى ليس ممكنا وإن تم فهو ليس كاملا، ويتم الهجوم على ما يسمّى “ذكورة اللغة” والدعوة إلى “تأنيثها”، واللغات التي تفضل صيغة التذكير على التأنيث لا بد أن يعاد بناؤها بحيث تستخدم صيغا محايدة أو صيغا ذكورية أنثوية. ولذا يُكتب hesheأو sheحتى لا يظن أحد أن هناك أي تفضيل للرجل على المرأة. كما يعاد كتابة كلمة نساء بالإنجليزية (women)لتصبح (womyn)حتى لا تحتوي على كلمة (men)أي رجال والعياذ بالله.
ونفس الشيء ينطبق على الكلمات المستخدمة للإشارة إلى الذات الإلهية فيجب الابتعاد عن الإشارة إلى الإله باعتباره ذكرا بل باعتباره ذكرا وأنثى في ذات الوقت فيقال مثلا “إن الخالق هو الذي/هي التي وضع/وضعت…إلخ” ويشار إليه أحيانا بالمؤنث وحسب فهو “ملكة الدنيا” و”سيدة الكون”. كما أن البعض يستخدمون كلمات لا جنس لها مثل صديق أو رفيق أو مشارك في الخلق (friendcompanionco-creator) للإشارة إلى الإله.
وكل هذا – كما يعلق المسيري- من لغو الحديث فهو ليس برنامجا للإصلاح ولكنه هجوم على اللغة البشرية وحدودها وتشويه لها. فهل نحن نفكر في “المقاومة” باعتبارها أنثى وفي “الصمود” باعتباره ذكرا؟ وحينما نقول “أبواب” هل نفكر في أعضاء التذكير بينما نفكر في أعضاء التأنيث حينما نقول “بوابات”؟ أم أن هذا هو وجدان الطبيعيين الماديين الذين يستخدمون الجسد كعنصر أساسي لإدراك كل شيء؟
وتتضح الرؤية الواحدية والثنائية الصراعية الصلبة في الإشارات المتكررة في أدبيات حركة التمركز حول الأنثى إلى المرأة باعتبارها “أقلية”، وكلمة أقلية هنا لا تعني أقلية عددية مضطهدة وإنما تعني في واقع الأمر أنه لا توجد أغلبية من أي نوع ولا يوجد معيار يُحكَم به، فالجميع متساوون ولا يمكن الحكم على أحد.
وتصل هذه الرؤية قمتها (أو هوتها) حينما تقرر الأنثى أن تدير ظهرها للآخر/الذكر تماما فتعلن استقلالها الكامل عنه، وحينئذ يصبح السحاق التعبير النهائي عن الواحدية الصلبة، وهو الأمر الطبيعي الوحيد المتاح للمرأة التي ترفض أن تؤكد “إنسانيتها المشتركة” التي لا يمكن أن تتحقق إلا داخل إطار اجتماعي وسياق تاريخي، وبدلا من ذلك تؤكد “نسوانيتها” أي ذاتها الأنثوية المنفصلة التي لا توجد في أي سياق تاريخي أو داخل أي إطار اجتماعي.
وكما قالت إحدى دعاة التمركز حول الأنثى المساحقات “إذا كانت الفيمينـزم هي النظرية فالسحاق هو التطبيق”.
ويصبح من الطبيعي ألا تلجأ المرأة للرجل لإنجاب الأطفال بل يمكن أن تلجأ للمعامل والإجراءات العلمية “الطبيعية” المختلفة (المعقمة من التاريخ والمجتمع والقيم) التي تستبعد الرجل كشريك في إنسانية مشتركة.
الواحدية السائلة وذوبان الأنثى:
بعد أن تتحول المرأة من إنسان إنسان إلى كائن طبيعي/مادي تُسوّى بالرجل أو الإنسان الطبيعي في جميع الوجوه بحيث لا تختلف عنه في أي شيء، دورها لا يختلف عن دوره، فكلاهما إنسان طبيعي/مادي، وما يجمعهما ليس إنسانيتهما المشتركة وإنما ماديتهما المشتركة، فيتم اختزالهما إلى مستوى طبيعي/مادي عام واحد لا يكترث بذكورة الذكر أو أنوثة الأنثى أو يُسوِّي بينهما، فالقانون الطبيعي/المادي العام لا يكترث بالخصوصية أو الثنائية. كما أن العالم متعدد المراكز (الواحدية السائلة) لا يكترث بأية فروق ظاهرة أو باطنة، فهو عالم سائل لا مركز له، لا يمكن إصدار أحكام على أي شيء.
كل هذا يؤدي إلى ظهور الجنس الواحد أو الجنس الوسط بين الجنسين (unisex)، أي أنه تم رد الواقع إلى عنصر واحد أو مبدأ واحد ينكر أي شكل من أشكال عدم التجانس أو أي تنوع، بل وينكر وجود ثنائية ذكر/أنثى فالذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر وكلاهما مجرد إنسان طبيعي/مادي. ومن ثم تتحول المرأة إلى شيء جديد تماما ليس هو الأم – الزوجة – الأخت – الحبيبة التي نعرفها والتي لها دور مستقل داخل إطار الجماعة الإنسانية الشاملة التي تضم الذكور والإناث والصغار والكبار.
وبسقوط المرأة أما وزوجة تسقط الأسرة ويتراجع الجوهر الإنساني المشترك ويصبح كل البشر أفرادا طبيعيين لكلٍّ مصلحته الخاصة وقصته الصغري الخاصة، كل إنسان مثل الذرة التي تصطدم بالذرات الأخرى وتتصارع معها، والجميع يجابهون الدولة وقطاع اللذة والإعلانات بمفردهم، ويسقطون في قبضة الصيرورة، ويتم تسوية الجميع بالحيوانات والأشياء، وتسود الواحدية السائلة التي لا تعرف الفرق بين الرجل والمرأة أو بين الإنسان والأشياء.
ويشار إلى الإله في هذه المرحلة (الواحدية السائلة) باعتباره ذكرا وأنثى وشيئا hesheit. ومن الصعب على المرء أن يقرر ما إذا كانت هذه هي نهاية السيولة أم أن هناك المزيد؟ فالتجريب المنفتح في اللغة والتاريخ والعلاقات بين البشر -كما يقول المسيري- مسألة لا سقف لها ولا حدود ولا نهاية.
حركة التمركز حول الأنثى والنظام العالمي الجديد:
إن دعاة حركة تحرير المرأة يدركون تماما أن ثمة اختلافات (بيولوجية ونفسية واجتماعية) بين الرجل والمرأة، ولكن بدلا من أن يحاولوا محو هذه الاختلافات فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للحيلولة دون تحولها إلى ظلم وتفاوت اجتماعي أو إنساني، أما دعاة حركة التمركز حول الأنثى فيتأرجحون وبعنف بين رؤية مواطن الاختلاف بين الرجل والمرأة باعتبارها هوة سحيقة لا يمكن عبورها من جهة، وبين إنكار وجود أي اختلاف بينهما من جهة أخرى. ولذا فهم يرفضون فكرة توزيع الأدوار وتقسيم العمل، ويؤكدون استحالة اللقاء بين الرجل والمرأة، ولا يكترثون بفكرة العدل، ويحاولون إما توسيع الهوة بين الرجال والنساء أو تسويتهم ببعضهم البعض، فيطالبون بأن يصبح الذكور آباء وأمهات في الوقت نفسه وأن تصبح الإناث بدورهن أمهات وآباء.
إن حركة تحرير المرأة – في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير- ترى أن ثمة إنسانية مشتركة بين كل البشر رجالا ونساء، وأن هذه الإنسانية المشتركة بيننا هي الأساس الذي نتحاور على أساسه والإطار الذي نبحث داخله عن تحقيق المساواة. ولذا يمكن للرجل أن ينضم إلى حركة تحرير المرأة ويمكن للمجتمع الإنساني – بذكوره وإناثه – أن يتبنّى برنامجا للإصلاح في هذا الاتجاه، ويمكن لكل من الرجال والنساء تأييده والوقوف وراءه.
أما حركة التمركز حول الأنثى فهي تنكر الإنسانية المشتركة ولذا لا يمكن أن ينضم لها الرجال، فالرجل لا يمكن أن يشعر بمشاعر المرأة كما أنه مذنب يحمل وزر “التاريخ الذكوري الأبوي”، رغم أنه ليس من صُنعِه. كما تنكر حركة التمركز حول الأنثى الاختلاف، ومن ثم لا مجال للتنوع ولا مجال لوجود الإنسانية كما نعرفها.
لكل هذا لا يوجد برنامج للإصلاح في حركة التمركز حول الأنثى ولا توجد محاولة جادة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أو إلى تغيير القوانين أو السياق الاجتماعي للحفاظ على إنسانية المرأة باعتبارها أما وزوجة وابنة وعضوا في الأسرة أو المجتمع. وإن كان ثمة برنامج “للإصلاح” فسنجد أنه يصدر عن إطار تفكيكي يهدف إما إلى زيادة كفاءة المرأة في عملية الصراع مع الرجل أو إلى تسويتها به، أي أنه في جميع الحالات ثمة إنكار للإنسانية المشتركة. ولذا فالبرنامج الإصلاحي هو برنامج يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات.
ويقول المسيري في موضع آخر من دراسته: العالم الغربي يساند بقوة حركات التمركز حول الأنثى في بلادنا، فقد اكتشف أن المواجهة العسكرية المباشرة مع العالم الثالث مكلفة وطويلة ومن ثم فالتفكيك هو البديل العملي الوحيد.
كما أن العالم الغربي أدرك أن نجاح مجتمعات العالم الثالث في مقاومته يعود إلى تماسكها الذي يعود بدوره إلى وجود بناء أسري قوي لا يزال قادرا على توصيل المنظومات القيمية والخصوصيات القومية إلى أبناء المجتمع، ومن ثم يمكنهم الاحتفاظ بذاكرتهم التاريخية وبوعيهم بثقافتهم وهُويتهم وقيمهم.
وإذا كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع فإن الأم هي اللبنة الأساسية في الأسرة، ومن هنا تركيز النظام العالمي الجديد على قضايا الأنثى.فالخطاب المتمركزحول الأنثى هو خطاب تفكيكي يعلن حتمية الصراع بين الذكر والأنثى وضرورة وضع نهاية للتاريخ الذكوري الأبوي وبداية التجريب بلا ذاكرة تاريخية، وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق والضيق والملل وعدم الطمأنينة في نفس المرأة عن طريق إعادة تعريفها بحيث لا يمكن أن تتحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة. وإذا انسحبت المرأة من الأسرة تآكلت الأسرة وتهاوت، وتهاوى معها أهم الحصون ضد التغلغل الاستعماري والهيمنة الغربية وأهم المؤسسات التي يحتفظ الإنسان من خلالها بذاكرته التاريخية وهويته القومية ومنظومته القيمية.
وبذلك يكون قد نجح النظام العالمي الجديد من خلال التفكيك في تحقيق الأهداف التي أخفق في تحقيقها النظام الاستعماري القديم من خلال المواجهة المباشرة.
(2)
البحث عن بديل:
ينتقد المسيري أننا في العالم العربي نتلقى معظم إن لم يكن كل ما يأتينا من الغرب دون أن نحاول تحليله أو تفسيره أو نقده ودون أن ندرك أن ما يأتينا منهم يعكس منظورهم وتحيزاتهم، إذ أننا نكتفي دائما بنقل أفكارهم من وجهة نظرهم دون أن نطرح أية أسئلة تنبع من رؤيتنا وتجربتنا التاريخية والإنسانية.
لذلك يشدد المسيري على ضرورة التخلص من التبعية الإدراكية للغرب التي تجعلنا نتلقى كل ما يأتينا منه بشكل سلبي دون تفكير أو نقد، وأن نبحث عن حلول لمشاكلنا نولدها من نماذجنا المعرفية ومنظوماتنا القيمية والأخلاقية ومن إيماننا بإنسانيتنا المشتركة، وهي منظومات تؤكد على أن المجتمع الإنساني يسبق الفرد (تماما كما يسبق الإنسان الطبيعة/المادة). ولذا فبدلا من الحديث عن “حقوق الإنسان” الفرد مما يضطرنا إلى الحديث عن “حقوق المرأة الفرد” و”حقوق الطفل الفرد” قد يكون من الأجدر بنا أن نتحدث عن “حقوق الأسرة” كنقطة بدء ثم يتفرع عنها وبعدها “حقوق الأفراد” الذين يكوّنون هذه الأسرة، أي أننا سنبدأ بالكل (الإنساني الاجتماعي) ثم نتبعه بالأجزاء (الفردية).
وباتخاذ الأسرة نقطة بدء ووحدة تحليلية يصبح الحديث عن “تحقيق الذات بشكل مطلق” أمرا ممجوجا ومرفوضا ولا بد أن يحل محله الحديث عن “تحقيق الذات داخل إطار الأسرة”.
إن الدراسة المتأنية ستبين لنا أن الرجل قد تم “تحديثه” بشكل متطرف وتم استيعابه في الحركية الاستهلاكية العمياء – التي هي سمة العصر الحديث – بحيث أصبحت البدائل المطروحة أمامه تفوق بكثير البدائل المطروحة أمام المرأة. ولكن بما أن هذه الحركية الاستهلاكية المتطرفة هي أحد أسباب أزمة الإنسان الحديث قد يكون من الأكثر رشدا وعقلانية ألا نطالب بـ”تحرير المرأة” وألا نحاول أن نقذف بها هي الأخرى في عالم السوق والحركية الاستهلاكية، وأن نطالب بدلا من ذلك بتقييد الرجل أو وضع قليل من الحدود عليه وعلى حركيته بحيث نبطيء من حركته فينسلخ قليلا عن عالم السوق والاستهلاك وبذلك يتناسب إيقاعه مع إيقاع المرأة والأسرة وحدود إنسانيتنا المشتركة. وانطلاقا من هذه الرؤية لا بد أن يعاد تعليم الرجل بحيث يكتسب بعض خبرات الأبوة والعيش داخل الأسرة والجماعة، وهي خبرات فقدها الإنسان الحديث مع تآكل الأسرة ومع تحركه المتطرف في رقعة الحياة العامة. وبهذه الطريقة سيكون بوسع الرجل أن يشارك في تنشئة الأطفال وأن يعرف عن قرب الجهد الذي تبذله المرأة/الأم، ومن ثم يمكن لإنسانيتنا المشتركة أن تؤكد نفسها مرة أخرى.
ولعله يكون من المفيد ألا نتحدث عن “حق المرأة في العمل” (أي أن تعمل في رقعة الحياة العامة نظير أجر) أي العمل المنتج ماديا الذي يؤدي إلى منتَج مادي (سلع – خدمات)، ويعاد تعريف العمل فيصبح “العمل المنتج إنسانيا” (وبذلك نؤكد أسبقية الإنساني على المادي والطبيعي) ومن هنا تصبح الأمومة أهم “الأعمال المنتِجة” (وماذا يمكن أن يكون أكثر أهمية من تحويل الطفل الطبيعي إلى إنسان اجتماعي؟) ومن ثم يقل إحساس المرأة العاملة في المنـزل بالغربة وعدم الجدوى ويزداد احترام الرجل لها ويكف الجميع عن القول إن المرأة العاملة في المنـزل لا تعمل، وكأن عمل سكرتيرة في إحدى شركات التصدير والاستيراد أو إحدى شركات السياحة أكثر أهمية وجدوى من تنشئة الأطفال.
ويمكنني هنا أن أضيف فقرة مما كتبه د. المسيري في كتابه “الفردوس الأرضي” حول هذه النقطة إذ يقول: “ولا بد أن يتيح المجتمع الإنساني الفرصة للمرأة الموهوبة أن تخرج لتحقيق كل إمكانياتها، كما أنه لا بد أن نعيد تقويم موقفنا من تصورنا للعمل، فيجب على الرجل والدولة والمجتمع أن يعترفوا بأن العمل في المنـزل هو عمل منتِج، وأنه إن لم تقم به الزوجة سيقوم به شخص آخر في ساعات عمل محددة ونظير أجر محدد. هذا لا يعني أنه على الزوج أو الدولة أن تقدر للزوجة أجرا نظير عملها في المنـزل، لأن تحديد مثل هذا الأجر صعب وغير مستحب، وإنما يعني تغييرا في موقفنا النفسي من المرأة ووظيفتها، وبالتالي حينما يعود الرجل إلى منـزله لا يسخط باعتبار أنه كان “يعمل” بينما كانت زوجته في المنـزل، وإنما سيخفض من صوته قليلا لأنه بينما كان هو يعمل كانت زوجته هي الأخرى تشقى وتكد: ترضع الأطفال وتغسل الصحون وتتسلق السلالم وتشتري الخضار وتطبخه وتحكي القصص للأطفال وتعطي من ذاتها وكيانها له ولأولادِهما.
ولعل فكرة إعادة تحديد تعريفنا للعمل قد يهديء من بال كثير من السيدات اللائي يجدن أنفسهن مضطرات للخروج من المنـزل للعمل في وظيفة ما كي يكسبن احترام أزواجهن، على الرغم من أن هذه الوظيفة قد لا تكون خلّاقة أو ممتعة، كأن تعمل المرأة في الأرشيف أو في مصنع أو أي عمل روتيني آخر لا يعادل بأي حال عملها أما وربة منـزل وزوجة، ولكنها تجد نفسها مضطرة لذلك لأن عملها في المنـزل لا يُحسَب عملاً.”
ويمكن التوصل ليوم عمل تتناسب مواعيده مع مؤسسة الأسرة ولا تتعارض مع محاولة المرأة القيام بدورها كأم وزوجة، كما يمكن تطوير نظم تعليمية جديدة تتيح للمرأة أن تستمر في التعليم دون أن نولد داخلها التوترات بين الرغبة المحمودة في التعلُّم والنـزعة الكونية نحو الأمومة (وأضيف هنا أن ذلك مرهون بوجود زوج يؤمن بقدرات زوجته ويتفهم طموحها ويشجعها ولا يجبرها بأن تُقصِر اهتمامها على الأعمال المنـزلية فقط أو يرفض قيامها بأي عمل أو نشاط خارج هذا الإطار).
وهذه الاقتراحات الأولية التي يقدمها المسيري تهدف كما يقول إلى تقليل الأعباء النفسية الناجمة عن الأمومة وتحرير المرأة بعض الشيء من الأعباء المنـزلية البدنية بحيث نخلق حيزا خاصا بها يمكنها أن تمارس فيه إنسانيتها دون أن تضطر إلى تحطيم الأسرة ودون أن تجعل تحقيق ذاتها مشروطا بتخليها عن الأسرة وعن دورها الاجتماعي.
ويجب أن يواكب هذا – والكلام للمسيري – دراسة نقدية جادة ومتعمقة لظاهرة تحرير المرأة في الغرب في إطار الفكر المادي الصراعي المتمركز حول الأنثى، فعلى سبيل المثال يمكن أن ندرس المشاكل الناجمة عن تآكل الأسرة وتكلفتها الاجتماعية والمادية (تأثير ذلك نفسيا على الأطفال مثلا وشعورهم بالغربة الشديدة مما يحولهم إلى عناصر مدمرة). وهناك ظاهرة اجتماعية معروفة في الولايات المتحدة هي ظاهرة “تأنيث الفقر” حيث تنجب المرأة دون زواج ثم يتركها الرجل وحدها ترعى أطفالهما فتزيد أعباؤها النفسية والاجتماعية والاقتصادية. كما يمكن أن ندرس إنتاجية المجتمع ككل في إطار خروج المرأة للعمل في حقل الحياة العامة بدلا من حقل الحياة الخاصة حيث تشير بعض الدراسات إلى تزايد هذه الإنتاجية مع اضطلاع المرأة بدور الزوجة والأم، إذ أنها تقوم بتربية الأطفال تربية صالحة فيصبحون أعضاء منتجين في المجتمع كما أنها تهديء من روع الجميع: الزوج والأبناء عند عودتهم من رقعة الحياة العامة، فيستعيد الجميع توازنهم وتتزايد إنتاجيتهم.
ويجب أن ندرس الدور المدمر لبعض الشركات العالمية التي تشكل ما يسميه المسيري “الإمبريالية النفسية” ويوضح: إذا كانت الإمبريالية التقليدية تبحث دائما عن أسواق لسلعها وعمالة رخيصة فالإمبريالية النفسية لا تختلف كثيرا عنها إلا أنها جعلت من وعي الإنسان ووجدانه مجال حركتها ونشاطها، أي أنها لا تتحرك في رقعة الحياة العامة البرانية، بل في رقعة الحياة الخاصة الجوانية، وهي سوق يمكن توسيع حدودها إلى ما لا نهاية عن طريق توسيع شهوة الإنسان وتوليد حالة من القلق وعدم الاتزان وعدم الرضا داخله، يتصور أنه لا يمكن تجاوزها إلا من خلال اقتناء سلع بعينها.
يقول المسيري: وقد نشأت عدة صناعات (رؤوس أموالها بلايين الدولارات) ركزت على المرأة، مثال ذلك شركات مستحضرات التجميل وأدواته التي جعلت المرأة هدفا أساسيا لها، فمن خلال آلاف الإعلانات يولد لدى المرأة إحساس بأنها إن لم تستخدم هذه المساحيق والعطور والكريمات وخلافه تفقد جاذبيتها (عادةً الجنسية) وتصبح قبيحة، وبعد ترسيخ هذه القناعة تماما في وجدان الإناث يتم تغيير المساحيق كل عام ويُطلب من المرأة أن تغيِّر وجهها لتصبح “جديدة دائما” و”مرغوبة دائما”، وهكذا تصبح المرأة سوقا متجددة بشكل لا ينتهي.
ولا تقل صناعة الأزياء شراسة عن صناعة مستحضرات التجميل، وفي كثير من الأحيان تقترب عروض الأزياء من الإباحية الصريحة، فهي تتفنن في طمس الشخصية الإنسانية والاجتماعية للمرأة وإبراز مفاتنها الجسدية لتتحول إلى جسم طبيعي/مادي لا خصوصية له يمكن توظيفه وحوسلته (أي تحويله إلى وسيلة)، وهكذا يتم سحب المرأة من عالم الحياة الخاصة والطمأنينة إلى عالم الحياة العامة والسوق والهرولة والقلق.
ويساند عمليات حوسلة المرأة (أي تحويلها إلى وسيلة)هذه وتوسيع نطاق الإمبريالية النفسية صناعة الإعلانات التي تستخدم المرأة لتصعيد الرغبات الاستهلاكية عند كل من الرجل والمرأة، وتعيد إنتاج صورة المرأة باعتبارها جسدا ماديا محضا، ثم تأتي أخيرا صناعة السينما في الولايات المتحدة (هوليوود – أكبر آلية عرفها الجنس البشري لنشر الأفكار وإشاعة الرؤى) التي تنـزع عن المرأة كل قداسة وتعريها لا من ملابسها وحسب وإنما من إنسانيتها وكينونتها الحضارية والاجتماعية وخصوصيتها الثقافية بحيث تصبح مثل الإنسان المقترح من قِبَل النظام العالمي الجديد: إنسان بلا ذاكرة ولا وعي، إنسان عصر ما بعد الحداثة والعالم الذي لا مركز له (ويستخدم البعض مصطلح ما بعد البيكيني bikini– postعلى منوال ما بعد الحداثةpost-modernist للإشارة إلى هذا الاتجاه نحو التعرية الشاملة ولتوجيه انتباهنا نحو العلاقة بين تعرية المرأة من ملابسها وتعرية الإنسان من منظوماته القيمية وخصوصيته القومية).
ويلفت المسيري نظرنا إلى علاقة حركة التمركز حول الأنثى بظواهر موجودة في مجتمعنا مثل الاهتمام المحموم من قِبَل بعض الصحف والمجلات المصرية بالجنس، وكذلك استخدام العامية المصرية في الصحف والإعلانات. إن الجنس الذي تتناوله هذه الصحف ليس شأنا إنسانيا مركبا وليس ظاهرة اجتماعية وتاريخية، وإنما هو تسلية وفضائح، أي أنه عملية نـزع القداسة عن الإنسان ليصبح موضوعا بسيطا طريفا لا كائنا مركبا عظيما، ويتم تذويب الإنسان في سيرة فلانة الراقصة التي لم تنجز شيئا في حياتها سوى سلسلة من الزيجات وعددا من الفضائح.
واستخدام العامية – كما يشير المسيري – لا يختلف كثيرا عن ذلك، فلو أصبحت العامية وحدها هي مستودع ذاكرتنا التاريخية لفقدنا امرأ القيس والبحتري وابن خلدون وابن سينا، أي فقدنا كل شيء، وتصبح كلاسيكياتنا هي أغاني شكوكو وأقوال إسماعيل ياسين.
وأعتقد – والكلام للمسيري – أن الإنسان الذي يقتدي بالراقصة فلانة ولا يتذكر إلا بعض الأفلام والأغاني المصرية هو إنسان تم تفريغه تماما وتفكيكه تماما، ومن ثم يمكنه التحرك بكفاءة عالية في السوق الشرق أوسطية، لأن السوق العربية تتطلب إنسانا آخر له هُوية وذاكرة ويحمل منظومة قيمية. إن حركة التمركز حول الأنثى هي جزء من هذه الهجمة الشاملة ضد قيمنا وذاكرتنا ووعينا وخصوصيتنا ويجب أن ندرك هذا ونعيه، حتى لا تكون معركتنا جزئية وغير واعية بذاتها.
خاتمة:
يقول المسيري إن هذه كلها أفكار مبدئية للغاية، مجرد خطوط عامة، يجمعها كلها أن نقطة البدء والوحدة التحليلية هي الإنسان الاجتماعي وليس الإنسان الطبيعي.
ويؤكد المسيري أنه لا ينكر وجود قضية المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولا ينكر وجود درجات متفاوتة من التمييز ضدها بل والقمع لها، ولأنه عمل أستاذا في كلية البنات لسنين طويلة يعرف أن ثمة مشكلة حادة وعميقة تتطلب حلا عاجلا وجذريا، كما يؤكد أنه لا يطالب بمنع المرأة من العمل في رقعة الحياة العامة أو نظير أجر نقدي أو يطالب بالحجر عليها عقليا وعاطفيا، ولكن كل ما يطالب به كما يقول أن يكون تناولنا لقضية المرأة من خلال قضية الأسرة وفي إطارالإنسانية المشتركة (بين الرجل والمرأة)، وأن تكون الأسرة (لا الفرد الباحث عن متعته الفردية ومصلحته الشخصية وحركيته الاستهلاكية) هي الوحدة التحليلية ونقطة الانطلاق.
ومن ثم فهو يطالب برد الاعتبار للأمومة ولوظيفة المرأة كأم وزوجة، ويرى أن هذه الوظيفة “الإنسانية” و”الخاصة” تسبق أي وظائف “إنتاجية” و”عامة”أخرى وإن كانت لا تجبّها. كما يطالب بالحفاظ على الخلاف بين الجنسين على ألا يتحول هذا إلى أساس للظلم والتفاوت.
ويشير المسيري في الختام إلى واقعتين قصيرتين إحداهما من حياته الخاصة والأخرى من حياته العامة.
الأولىتتمثل في رفض زوجته د.هدى حجازي – عندما كانا معًا في الولايات المتحدة للدراسة – الالتحاق ببرنامج الدكتوراهبعد أن حصلت على درجة الماجستير، لأن ذلك كان يتطلب منها التفرغ الكامل ومن ثم الاستعانة بجليسة أطفال، كما رفضت العمل خارج المنـزل، لأنها كانت تشعر أن العلاقة المباشرة بين الأم والطفلة أمر لا يمكن تعويضه مدى الحياة، وأن دراستها وعملها هذا سيحرم طفلتها من الحق في أن تستيقظ في الوقت الذي تشاء وأن تقضي سنوات حياتها الأولى في طمأنينة وسعادة وسكينة. وكبرت الطفلة وحصلت كل من الأم والابنة على الدكتوراه.
أما الواقعة الأخرىفتتمثل في أن سيدة أمريكية من رائدات حركة التمركز حول الأنثى كانت تزور المسيري وأسرته عام 1974 وعبّرت عن رغبتها في التعرف على رائدات حركة تحرير المرأة في مصر، فاتصل المسيري بالدكتورة سهير القلماوي والتقوا جميعا على الغداء وبدأ الحوار بين السيدة الأمريكية ود. سهير حول تحرير المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، وكانت د. سهير كما يروي المسيري توافقها على ما تقول إلى أن وصلت إلى نقطة شعرت عندها أن الأمر لم يعد حديثا عن تحرير المرأة وإنما عن تثويرها في مقابل الرجل وعزلها عنه. وهنا توقفت د. سهير عن الحديث معها بالإنجليزية والتفتت إلى المسيري وقالت بالعربية: ماذا تريد هذه السيدة؟ إن أخذنا برأيها سيكون من المستحيل علينا أن نجمع بين الذكور والإناث مرة أخرى. ثم استمرت في الحديث بالإنجليزية. ويعلق المسيري: لقد لخصت كلماتها البسيطة الرائعة الفروق الحادة بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول الأنثى، وبين من يدرك الإنسانية المشتركة ومن يرفضها، وبين من يرى أسبقية المجتمع على الفرد ومن يرى أن الذات الفردية هي البداية والنهاية، ومن يضع الإنسان قبل الطبيعة والمادة ومن يرى -على العكس من هذا -أسبقية المادة على وعي الإنسان وحضارته وتوجهه الاجتماعي والأخلاقي.
تمّ بحمد الله