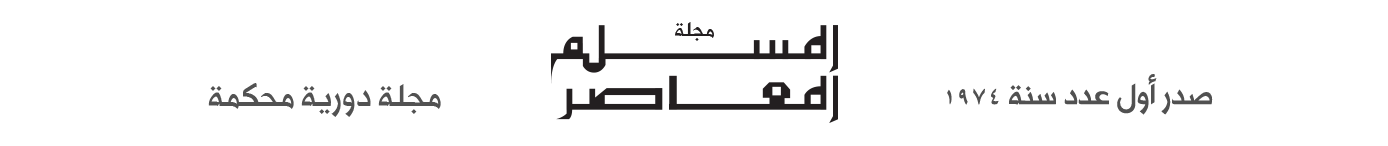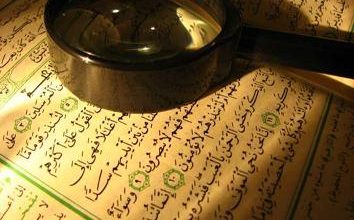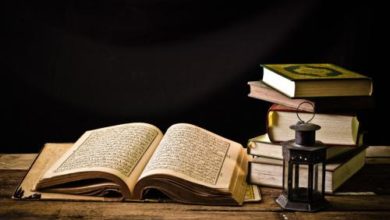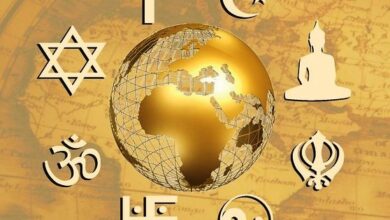هذا البحث فصل من كتاب يحمل نفس العنوان(1) وكان قصدنا من كتابة هذا الكتاب مزدوجًا :
1- أن نعيد النظر في بعض مفاهيم ومضامين المقاصد .
2- أن نفتح طريقًا لتفعيل هذه المقاصد .
أولاً : وبخصوص الأمر الأول فقد تناولنا العديد من المسائل من أهمها:
1- التفرقة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة ونتائج هذه التفرقة.
2- محاولة صياغة مقاصد الشريعة العالية والتفرقة بينها وبين المفاهيم التأسيسية.
3- اشتمال المقاصد على مجموع رتب الضروري والحاجي والتحسيني، وتعلق هذه الرتب بالوسائل وليس بالمقاصد .
4- افتقاد الدراسات القانونية لمبحث المقاصد، وافتقاد الدراسات الشرعية لمباحث وظيفة القانون في تنظيم المجتمع، ومدى تدخل الدولة في حريات الأفراد.
5- محاولة تطوير الكتابة في المقاصد الخاصة المتعلقة بأقسام الشريعة أو بالعلوم الحديثة .
6- محاولة تحديد دور العقل والتجربة في تحديد المقاصد .
7- تطور فكرة حصر الكليات في خمس، وإضافة المقاصد الاجتماعية وغيرها .
8- بحث ترتيب المقاصد فيما بينها وإشكاليات هذا الترتيب .
5- محاولة البحث عن معيار اعتبار حكم معين أو وسيلة معينة من مرتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وملاحظات تطبيقية .
10- أن المراتب خمس لا ثلاث، بإضافة ما دون الضروري وما وراء التحسيني، وآثار ذلك .
11- نسبية تحديد الوسائل وتسكينها في المراتب بحسب الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأمثلة تطبيقية .
12- إزالة اللبس الخاص بالنسل والنسب والعرض، ووضع كل منها في موضعه المناسب .
13- تحديد المقاصد في إطار أربعة مجالات تختص الكليات الخمس بمجال الفرد، وإضافة مقاصد لكل من الأسرة والأمة والإنسانية .
ثانيًا : أما بخصوص الأمر الثاني وهو تفعيل المقاصد، فنتناوله هنا في خمسة مباحث على النحو التالي:
المبحث الأول: الصورة الحالية لاستخدامات المقاصد .
المبحث الثاني: الاجتهاد المقاصدي.
المبحث الثالث: التنظير الفقهي.
المبحث الرابع: العقلية المقاصدية للفرد والجماعة .
المبحث الخامس: مستقبل المقاصد.
المبحث الأول
الصورة الحالية لاستخدامات المقاصد
حاولنا أن نجمع في هذا المبحث ما يمثل الصورة الحالية لاستخدامات مقاصد الشريعة من خلال الكتابات القديمة والحديثة، والتى لا تمثل تعديلاً أو إضافة إلى مناهج الأصول التقليدية، مرجئين إلى مبحث قادم بحث ما يمكن اعتباره تجديدًا في هذه المناهج، سواء وافقنا عليها أو لم نوافق .
ونبدأ ببعض ما أتى به ولى الله الدهلوى في كتابه (حجة الله البالغة)(1) من الفوائد للتأليف في علل الأحكام – أي المقاصد الجزئية للأحكام – نجتزئ منها خمسة :
قال رحمه الله: ثم إنه كثر اختلاف الفقهاء بناء على اختلافهم في علل الأحكام، وأفضى ذلك إلى أن يتباحثوا عن العلل من جهة إفضائها إلى المصالح المعتبرة في الشرع، ونشأ التمسك بالمعقول في كثير من المباحث الدينية، وظهرت تشكيكات في الأصول الاعتقادية والعملية، فآل الأمر إلى أن صار الانتهاض لإقامة الدلائل العقلية حسب النصوص النقلية، وتطبيق المنقول بالمعقول، والمسموع بالمفهوم نصرًا مؤزرًا للدين، وسعيًا جميلاً في جمع شمل المسلمين، ومعدودًا من أعظم القربات، ورأسًا لرءوس الطاعات.
فمن فوائد التأليف في هذا الفن:
أولاً : بيان كمال الشريعة الإسلامية
أتى الرسول e من الله تعالى بشريعة هي أكمل الشرائع متضمنة لمصالح يعجز عن مراعاة مثلها البشر، وعرف أهل زمانه شرف ما جاء به بنحو من أنحاء المعرفة، حتى نطقت به ألسنتهم ، وتبين في خطبهم ومحاوراتهم، فلما انقضى عصرهم وجب أن يكون في الأمة من يوضح وجوه هذا النوع من الإعجاز والآثار الدالة على أن شريعته e أكمل الشرائع ، وأن إتيان مثله بمثلها معجزة عظيمة كثيرة مشهورة لا حاجة إلى ذكرها .
ثانيًا: الاطمئنان على الإيمان
ومنها أن يحصل به الاطمئنان الزائد على الإيمان، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: {بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} (البقرة : 260).
ذلك أن تظاهر الدلائل، وكثرة طرق العلم يثلجان(1) الصدر، ويزيلان اضطراب القلب .
ثالثًا : أن يعرف المؤمن مشروعية ما يعمل
ومنها أن طالب الإحسان إذا اجتهد في الطاعات وهو يعرف وجه مشروعيتها، ويقيد نفسه بالمحافظة على أرواحها وأنوارها نفعه قليلها، وكان أبعد من أن يخبط خبط عشواء(2) .
لهذا المعنى اعتنى الإمام الغزالي في كتب السلوك بتعريف أسرار العبادات.
ومنها أنه اختلف الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية بناء على اختلافهم في العلل المخرجة المناسبة، وتحقيق ما هو الحق هنالك لا يتم إلا بكلام مستقل في المصالح(3) .
رابعًا: ردع المشككين
ومنها أن المبتدعين شككوا في كثير من المسائل الإسلامية بأنها مخالفة للعقل، وكل ما هو مخالف له يجب رده أو تأويله كقولهم في عذاب القبر إنه يكذبه الحس والعقل، وقالوا في الحساب والصراط والميزان نحوًا من ذلك، فطفقوا يؤولون بتأويلات بعيـدة، وأثارت طائفة(1) فتنة الشك، فقالوا: لم كان صوم آخر يوم من رمضان واجبًا وصوم أول يوم من شوال ممنوعًا عنه؟ ونحو ذلك من الكلام .
واستهزأت طائفة بالترغيبات والترهيبات ظانين أنها لمجرد الحث والتحريض لا ترجع إلى أصل أصيل، حتى قام أشقى القوم(2) ، فوضع حديث باذنجان لما أكل له يعرض(3) بأن أضر الأشياء لا يتميز عند المسلمين من النافع.
ولا سبيل إلى دفع هذه المفسدة إلا بان نبين المصالح، ونؤسس لها القواعد، كما فعل نحوًا من ذلك في مخاصمات اليهود والنصاري والدهرية وأمثالهم .
خامسًا : بيان أن الأحاديث الصحيحة توافق المصالح الشرعية
ومنها أن جماعة من الفقهاء زعموا أنه يجوز ردّ حديث يخالف القياس من كل وجه، فتطرق الخلل إلى كثير من الأحـــاديث الصحيحة كحديث المصراة(4)، وحديث القلتين(5) فلم يجد أهل الحديث سبيلاً في إلزامهم الحجة إلا أن يبينوا أنها توافق المصالح المعتبرة في الشرع، إلى غير ذلك من الفوائد التى لا يفى بإحصائها الكلام .
سادسًا : الترجيح
أ – لقد سبق الآمدى إلى إدخال أصول المصالح الشرعية في الترجيح بين الأقيسة وأوضح لذلك صورًا أربعًا:
1- أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية، والمقصود من الأخرى غير ضروري.
2- أن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجات الزائدة، ومقصود الأخرى من باب التحسينات والتزيينات .
3- أن يكون مقصود إحدى العلتين من مكملات المصالح الضرورية، ومقصود الأخرى من أصول الحاجات الزائدة .
4- أن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الدين، ومقصود الأخرى ما سواه من المقاصد الضرورية(1) .
ب – وقد سار الباحثون المعاصرون شوطًا أبعد في استخدام المقاصد في الترجيح بتطبيق نتائجها المتمثلة في قواعدها على مباحث الفقه أو على الأقل على مبحث فقهي معين، كما فعل الطالب عبد القادر بن حرز الله في أطروحته عن (التعليل المقاصدى لأحكام الفساد والبطلان في التصرفات المشروعة وأثره الفقهي)(2) حيث قام بالترجيح بين مذاهب الأصوليين في تقرير القاعدة الأصولية بمقتضى قواعد المقاصد، محققًا بذلك التوازن بين الجوانب الثلاثة للتصرف الشرعي: قاعدته الأصولية ، وحكمه الفقهي، وبعده المقاصدي .
سابعًا : منع التحيُّل
أ – عرف الشاطبي الحيل بأنها (تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعًا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع)(3) ، ثم قرر عدم مشروعيتها ليربطها حقيقة وحكمًا بمقاصد الشريعة، حيث قال: (لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها .. فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقًا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها ، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التى شرعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات)(4) .
ب – وقد تابع ابن عاشور النهج نفسه وفصل فيه ونوّع الحيل إلى خمسة أنواع، وضرب لها أمثلة(5) لا نوافقه في بعضها ، كالتفرقة بين إضمار المرأة المبتوتة عند زواجها العودة إلى الزوج الأول (النوع الثاني) وقصد من يتزوج بالمبتوتة أن يحللها لمن بتها (النوع الخامس) فكلاهما مناقض لقصد الشارع من زواج المبتوتة .
ثامنًا : فتح الذرائع وسدها
أ – كان القرافي دقيقًا في تطبيق قاعدة الوسائل والمقاصد، وأساسها أولوية المقاصد على الوسائل، ففي ضوء الأولى تقاس الثانية وتأخذ حكمها .
فسد الذرائع عنده هو حسم وسائل الفساد دفعًا له ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل، وكما يجب سد الذرائع يجب أيضًا فتحها(1) .
تاسعًا(2) : النصوص والأحكام بمقاصدها
بين د. الريسوني أن هذا هو ما عليه الجمهور -خلافًا للظاهرية- على تفاوت بينهم في مدى الأخذ بالمبدأ ، والذي يقتضى عدم إهمال المقاصد ولا الغفلة عنها عند تقرير الأحكام وعند النظر في النصوص. وضرب أمثلة من باب الزكاة ومسألة سفر المرأة بدون محرم.
عاشرًا : الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة
ويقصد بالكليات العامة ما كان منصوصًا عليه، وما توصل إليه باستقراء عدد من النصوص والأحكام الجزئية . ولخص د. الريسوني ما شرحه الشاطبي من ضرورة اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس(3) ، وأشار إلى قول الحافظ ابن عبد البر أن الإمام أبا حنيفة كان يرد كثيرًا من أخبار الآحاد العدول بعد عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعانى القرآن ، فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذًّا(4) .
ثم أورد مثالين أحدهما عن تغيير التصرف في الحقوق الثابتة إذا كان مخالفًا لمقاصد الشريعة، وقواعدها العامة، ومن هذا الباب منع التعسف في استعمال الحق، وثانيهما التدخل في العقود إذا حوت ظلمًا بينًا لأحد طرفيه أو أطرافه، وذلك بنقضه أو تعديله بما يحقق العدل للطرفين، ومن هذا الباب وضع الجوائح أو نظرية الظروف الطارئة.
حادي عشر : اعتبار المآلات
أ – أي أن المجتهد عليه أن يقدر مآلات الأفعال التى هي محل حكمه وإفتائه، وضرب أمثلة من تصرفات الرسول e في عدم قتل المنافقين، وعدم إعادة بناء الكعبة ، وتصرفه مع الأعرابي الذي بال بالمسجد .
ب – ثم تكلم عن تحقيق المناط إذا كان عامًّا كتحقيق معنى الفقير المستحق للزكاة، ومعنى الزاني المحصن، ومعنى العدالة في الشهادة والرواية .
جـ ـ وإذا كان خاصًّا يتعلق بشخص معين لمعرفة ما يناسبه .
د – وقريب من هذا أن المجتهد يجب أن يجدد نظره في المسائل المشابهة لما سبق له الحكم فيه؛ لأن لكل مسألة خصـــوصياتها مهما تشابهت مع غيرها(1) .
ثاني عشر: التوسع والتجديد في الوسائل
كتب د. الريسوني(2) : مما تستفيده الدعوة وأهلها من المقاصد والفكر المقاصدي إضفاء المرونة والتجديد على وسائل الدعوة وأساليبها .. والوسائل المحضة – حتى ولو كانت منصوصة تقبل التغيير والتعديل والتكييف. وإذا كانت مقاصد الإسلام تمثل عناصر الثبات والاستقرار فيه، فإنها في الوقت نفسه تسمح بالمرونة والتغير والتجدد في الوسائل .. وإذا كان النبي e قد استعمل وسائل وأساليب معينة في تبليغ دعوته والتمكين لرسالته وتنظيم جماعته وبناء أمته، وتوجيهها لحمل الرسالة والهداية إلى أرجاء العالم، فإن تلك الوسائل والأساليب ليست توقيفية، وليست محصورة فيما مضى وفيما جرى اعتماده والعمل به في السيرة النبوية. بل إن سيرته e تفيد عكس ذلك وتهدى إليه، فقد استعمل وجند كل ما كان ممكنًا من وسائل وأساليب لبلوغ أهدافه وتحقيق مقاصده .. ثم ضرب مثالاً تطبيقيًّا توضيحيًّا قضية الديمقراطية والأساليب والنظم الديمقراطية التى تطرح وتناقش عند الحركات الإسلامية على صعيدي الدولة والمجتمع من ناحية أخرى .
ثالث عشر : التقريب بين المذاهب وإزالة الخلاف
ذلك أن منشأ الاختلاف في الاستدلال الفقهي هو الاختلاف في القواعد الأصولية؛ لأنها ظنية غير قطعية، لا تصلح لأن يحتكم إليها عند الاختلاف.
ومن هنا كان السعي لإيجاد قواعد قطعية مبنية على المقاصد هو السبيل لإزالة الخلاف بين الفقهاء(1) .
المبحث الثاني
الاجتهاد المقاصدي
لقد بدأ استخدام هذا المصطلح مؤخرًا : أشار إليه د. الريسوني في كتابه، كما اتخذه د. نور الدين بن مختار الخادمي عنوانًا لكتاب من جزأين نشر في سلسلة كتاب (الأمة)(2) .
فما المقصود بهذا المصطلح؟ هل هناك جديد يحتاج إلى مصطلح، أو أننا بصدد استخدام مصطلح جديد لمعنى قديم أو آلية قديمة أو دليل قديم؟
أولاً : أما كتاب د. الخادمي فلم يحتو على أية آلية جديدة: بل أكد على أن المقاصد ليست دليلاً مستقلاًّ عن الأدلة الشرعية، ولم يقدم مبررًا لإطلاق هذه التسمية الجديدة، وما الذي أضافته إلى الأدلة الشرعية المعروفة .
ثانيًا : أما د. الريسوني(3) فكان أكثر وضوحًا، فهو ببساطة يحاول تحديد أهم مسالك الاجتهاد المقاصدي بالعمل – شيئًا فشيئًا – على تحديد المجالات ووضع المعالم الهادية، ويقرر أنه لا تخفى صعوبته وخطورته، ولكن لابد من اقتحام العقبة، ولو في مرحلة أولى منها.
أ- ثم عرض لأربعة مسالك هي:
1- النصوص والأحكام بمقاصدها .
2- الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة .
3- جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا .
4- اعتبار المآلات .
وقد سبق أن عالجنا النقاط ( 1، 2، 4) في المبحث السابق .
ب – ويسـتوقفنا هنا المســلك الثالث (جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا) ولنا عليه بعض الملاحظات، بعد أن نعرض خلاصة ماذكره د. الريسوني .
جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا: أي حيثما تحققت المصلحة فيجب العمل على جلبها، وإن لم يكن في ذلك نص خاص اكتفاءً بالنصوص العامة الواردة في الحث على الصلاح والإصلاح والنفع والخير .. ثم قال : وهذا هو باب المصالح المرسلة، واستشهد بأقوال للغزالي والشاطبي، واعترض على اشتراط د. البوطي عدم مخالفة المصلحة للقياس. وبدأ يستعمل مصطلحات القياس الكلي والقياس المصلحي والقياس المرسل، ونقل عن د. الترابي مصطلحات القياس الواسع والقياس الإجمالي وقياس المصالح المرسلة، وختم بأننا بهذا نكون قد رجعنا إلى الاسم الأول السائد وهو المصالح المرسلة، وتمثيل الأخير له بالاستدلال المرسل والاستحسان.
تضمن هذا المسلك ثلاثة أمور:
1- التوسع في القياس تحت أسماء مختلفة .
2- جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا اكتفاءً بالنصوص العامة .
3- المصلحة المرسلة .
– أما التوسع في القياس : فهو أضيقها؛ لأنه يبقينا في إطار الأحكام الجزئية، وإن حاولنا التوسع في العلاقة بين المقيس والمقيس عليه .
– وأما الاكتفاء بالنصوص العامة كالعدل والإحسان والرحمة والبر والخير والإصلاح والنفع وغيرها كثير، فهي عبارات تحتاج إلى آلية لضبط تنزيلها على الحالات الخاصة، وهو ما لم يفعله د. الريسوني، فبقيت الفكرة غير كافية بذاتها، وقد سبق أن حاولنا -في كتابنا: نحو تفعيل مقاصد الشريعة- إيجاد هذه الآلية بتصنيف هذه النصوص ضمن المقاصـد العاليـة من ناحية ، وبمراعاتها -من ناحية أخرى- ضمن المقاصد الكلية بتفصيلاتها وتطبيقاتها العملية .
– ثم تأتى فكرة المصلحة المرسلة: فهل تحقق ما نبحث عنه؟
جـ – وحتى لا ندخل في تفاصيل الخلافات الظاهرية بين الأصوليين في المسألة(1) ، لنأخذ رأي الغزالي في الاستدلال المرسل، حيث المصلحة المقبولة عنده هي ما شهد الشرع لاعتبارها، وهذه تشمل إلى جانب القياس صورتين :
1- ما يرجع إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودًا بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجًا من هذه الأصول، وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لاحصر لها، من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة .. ولا وجه للخلاف في اتباعها ، بل يجب القطع بكونها حجة ، وعلى هذا الأساس يرى أنها ليست أصلاً خامسًا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ويعتبرها من الأصول الموهومة على أساس أنها ليست أصلاً خامسًا، بل هي طريقة من طرق الاستدلال على مقصود الشرع من الأصول الأربعة، وهي أقوى من القياس، وهي حجة قطعية(1) .
2- أن تكون جارية على مقاصد الشارع أو مندرجة تحت أصل من أصوله غير معين للدلالة عليها، ولا يردها أصل مقطوع به مقدم عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، وكان المعنى مناسباً للحكم مطردًا في أحكام الشرع فهو مقول به … ثم أقسامه لا ضبط لها فإنها لا يحويها عد ولا يضبطها حد(2) .
د- فإذن ما يشهد له الشرع من المصالح عند الغزالي درجات:
أدناها ما يرجع إلى القياس.
وأعلاها ما عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها .
وأوسطها ما كانت جارية على مقاصد الشارع أو مندرجة تحت أصل من أصوله غير معين ولا يردها أصل مقطوع به .
فهاتان الدرجتان العليا والوسطى هما اللتان يمكن العمل من خلالهما لترجمة المقاصد إلى أحكام عملية .
ثالثًا : ويوضح ابن عاشور كيفية الاستدلال بهذين الطريقين فيقول:
أ – (أن يكون وصفًا مناسبًا للتعليل لكنه لا يستند إلى أصل معين، بل إلى المصلحة العامة في نظر العقل، وإذا كان الإلحاق في القياس المعروف عند الفقهاء والأصوليين هو إلحاق جزئي بآخر مثله ثابت في الشرع لتماثلهما في العلة المستنبطة كمصحلة جزئية ظنية، فإن الإلحاق في المصلحة المرسلة هو إلحاق جزئية لا يعرف لها حكم شرعي على كلية مستقرأة من أدلة الشريعة، سواء أكان استقراء قطعيًّا أو ظنيًّا قريبًا من القطع . ويظهر من هذا الإلحاق أنه أشد حجية من الإلحاق في القياس؛ لأن الإلحاق الأول إلحاق جزئي بكلي، أو تنزل كلي على جزئي، أما الإلحاق القياسي فهو إلحاق جزئي بجزئي أو تنزيل جزئي على مثاله في علة مستنبطة غالبًا ما تكون ظنية)(1) .
ب – ويستطرد الحسنى – شارح ابن عاشور – في بيان هذه المنهجية فيقول(2): (إن من شأن هذا التأسيس إحداث تغيير طفيف في منهجة الاستدلال القياسية في علم الأصول ، فبدلاً من الاقتصار على الاستدلال كما قال ابن عاشور (بألفاظ الشريعة وما يؤول إليها من أفعال الشارع وسكوته ، والإجماع على أن تلك الأقوال تفيد أحكامًا كلية.. وقد تفيد أحكامًا جزئية وهو الغالب) بدلاً من هذه النتيجة تقاس الحالات المستجدة على الأصول المقصودة في التشريع وهي المقاصد الشرعية، وهكذا تكفي الفقيه مؤونة الانتشار في البحث عن المعنى من أجناسه العالية، ثم بما فيها من التمثيل والضبط تنتقل بالمجتهد إلى المعنى الذي اشتمل عليه النظير غير معروف حكمه، فيلحقه في الحكم بحكم كلياته القريبة، ثم بحكم كلياته العالية؛ إذ لا يعسر عليه ذلك الانتقال حينئذ، فتتجلى له المراتب الثلاث إنجلاءً بينًا)(3) .
يتضح من هذا كيف يساهم الفكر المقاصدي في توسيع عملية الرد أو الإلحاق في القياس، فبدلاً من رد الفروع إلى الأصول المنصوصة باعتبار عللها الجزئية – ترد أيضًا إلى الأصول غير المنصوصة وهي المقاصد القريبة والعالية.
رابعًا : ولتوضيح الصورة كاملة نضرب بعض الأمثلة:
1- أصل حفظ العقل بتحريم شرب الخمر، يمكن نقل حكمه بطريق القياس العادي إلى باقي أنواع المسكرات بجامع الإسكار في المقيس عليه وهو الخمر، وفي المقيس وهي الأنواع الأخرى .
2- باستخدام القياس الواسع – بأسمائه المختلفة التى أشار إليها د. الريسوني ونقل بعضها عن د. الترابي – يمكن أن نترك علة الإسكار، ونصعد إلى حفظ العقل فننقل حكم التحريم إلى كل ما يؤثر في العقل وإن لم يسكر كالمخدرات، ويمكن أن نتوسع أكثر فننقل حكم التحريم إلى كل ما يضر بالعقل كالخرافات والشعوذات، وعمليات غسيل المخ، وتقليد الأسلاف دون برهان …
3- باستخدام النصوص العامة التى تمنع الضرر يمكن أن نصل إلى حكم التحريم لهذه الصور دون الانطلاق من نص تحريم الخمر، وبالتالى نكون قد تركنا طريق القياس بصورتيه العادية والواسعة.
4- باستخدام آلية المصلحة المرسلة والابتعاد كذلك عن آلية القياس بصوريته ، يمكن أن ننطلق من مقاصد شرعية عرفت بأدلة كثيرة لا حصر لها، أو مندرجة تحت أصل غير معين دون معارض لها، كمقصد تكوين العقلية العلمية والاستدلال العقلي وطلب العلم والتفكر والنظر .. إلخ .
خامسًا : يقرر الشيخ محمد مهدي شمس الدين أننا إذا فهمنا عدم قصور الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين في الاستنباط ، على أساس وجود نصوص جاهزة لدينا لكل الوقائع، فإن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ النصوص قاصرة بهذا المعنى بكل تأكيد، بينما يمكن فهم كفاية النصوص في ضوء إعادة كل الوقائع إلى المبادئ الكلية في التشريع، ولن نجد حيئنذ قصورًا في مصادره .
يعتبر الشيخ شمس الدين أن الأمر الأساسي في حل إشكالية تناهي النصوص ولا نهائية الوقائع، هو العودة إلى مستويين من مبادئ الشريعة يحتاجان إلى مزيد اكتشاف وتنقيح :
أ – المستوى الأول : القواعد الفقهية التى توجد مجموعة منها في كل باب فقهي على حدة .
ب – المستوى الثاني : الأدلة العليا التى تمثل موقعًا أعلى من مرتبة القواعد الفقهية ، باعتبار تلك غير منحصرة في باب فقهي معين بل تشمل كل أنشطة البشر، عدا العبادات في تصوره، وتلك الأدلة هي مقاصد الشريعة العامة نظير ما يستفاد من قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} (النحل:90) .
ويقرر أحد الباحثين أن حل إشكالية قصور النص التشريعي عن استيعاب الوقائع الحياتية استيعابًا حرفيًّا عبر منح دور أكبر للاجتهاد المقاصدي كما صنع الشيخ شمس الدين، ينعكس مباشرة ومنطقيًّا على آلية الاستنباط في دائرة منطقة الفراغ التشريعي، والتى عمد الشيخ شمس الدين إلى تحديد أسس وأصول منهج الاستنباط فيها .
وقد حاول الباحث شرح هذا المنهج في دراسته(1) ، ولم نظفر منه سوى بفكرة الأحكام التدبيرية التى تعتمد على التمييز بين ما جاء في الروايات للتشريع، وما كان ولائيًّا تدبيريًّا في نطاق خاص، وهي تقابل فكرة السنة التشريعية والسنة غير التشريعية في الكتابات السنية .
سادسًا : النظر في المستجدات
أ – ( من المجالات الاجتهادية التى يتوقف فيها نظر المجتهد وتقديره على معرفة المقاصد والخبرة بها، مجال الاجتهاد المصلحى، وأعنى به الاجتهاد في الحالات والنازلات التى ليس فيها نص خاص يعتمد أو يقاس عليه، فيكون المعول فيها على المصلحة والتقدير المصلحي، فها هنا يحتاج المجتهد أن يكون على دراية واسعة بمقاصد الشرع والمقاصد المعتبرة عنده، وعلى دراية بمراتبها وأولوياتها، وبسبل الترجيح الصحيح بينها عند تزاحمــها وتعارضها)(2).
هكذا أطلق الريسوني المبدأ الذي لا يمكن أن يعترض عليه معترض، ولكن كيف يكون تطبيق المبدأ؟
ب – يعطينا الطالب مصدق حسن الإجابة في أطروحته المقدمة لجامعة الزيتونة في تونس حيث خاض تجربة شاقة عن (الهندسة الوراثية ومقاصد الشريعة)(3) .
1- كتب الباحث في مقدمة بحثه: يحاول هذا البحث جزئيًّا أن يجيب عن التساؤل التالي: هل تبيح الشريعة الإسلامية بمقاصدها العامة التدخل البشري من خلال عملية إعادة تصميم النظام الحي، ومحاولة تنظيم الكائنات الحية وفق التقانة الجينية؟ أي هل من الممكن إحداث جملة تغييرات وراثية وفسيولوجية في بنية وجوهر المتعضى؟ ونظرًا لما يتضمنه هذا السؤال من قضايا اجتماعية وأخلاقية ودينية، وبفعل الثورة البيولوجية عنيت هذه الرسالة بدراسة الاستتباعات الشرعية لما تثيره الهندسة الوراثية والتقنية الجينية من خلال المعامل البيولوجية النشطة، من قضايا تتعلق بالكائنات الحية المختلفة، وتتطلب بيانًا شرعيًّا وتبصرًا فقهيًّا(1) .
2- وعن بواعث اختياره الموضوع يذكر:
– ما تثيره الهندسة الوراثية من مخاوف أخلاقية ودينية مباشرة، وهي مخاوف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم مثل الأسرة، والزواج ، والأبوة، والأمومة، والهوية، والحرية، والحياة، والمسئولية، والإنسان، كان باعثًا لدراستها وتقويم آثارها الشرعية .
– تحديد الموقف الشرعي فيما يتعلق بتجارب موضوعها الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتكاثر اللاجنسي، وهو موضوع له أهمية خاصة تستدعي البحث الشرعي والتبصر الفقهي .
– الإجابة عن عدة تساؤلات ولو بصورة جزئية: هل التجارب البيولوجية تلحق الإهانة بالبشر؟ ما دور الفقهاء والمجامع الفقهية في التجارب الوراثية وتطبيقاتها؟ هل تبيح الشريعة استخدام متعضيات الإنسان كقطع غيار لإنسان آخر؟ هل تسمح الشريعة بأن تكون الفتاة أمّا مع أنها عذراء بتقنيات التكاثر اللاجنسي؟ هل يجوز تخليد الشفرة الوراثية لرموز من العباقرة والنابغين عن طريق الاستنسال الجيني(2) ؟
3- وعن خطة البحث قام الباحث بتقسيمه إلى بابين: باب علمي وباب شرعي(3) .
وقد اشتمل الباب الشرعي على مدخل تمهيدي وفصلين.
وفي المدخل التمهيدي تحدث عن المعنى الروحاني لتشكل التراب، من خلال بحث :
* الخلق الإلهي وتشكل المتعضى.
* التكريم الآدمي.
* معجزة الحياة .
وتضمن الفصل الأول عن (التكاثر اللاجنسي والأجنة ومقاصد الشريعة) بحث:
* التكاثر اللاجنسي ومقاصد الشريعة.
* الإجهاض ومقاصد الشريعة.
* جنس الجنين ومقاصد الشريعة.
أما الفصل الثاني عن (التقنية الجينية ومقاصد الشريعة) فيبحث :
* المعالجة الجينية ومقاصد الشريعة.
* التحكم في الجينات ومقاصد الشريعة .
* التقنية الجينية الحيوانية والنباتية ومقاصد الشريعة .
ولنأخذ مثالين من هذه المباحث الستة لنرى كيف استعان الباحث بمقاصد الشريعة للإجابة عن الأسئلة المثارة:
جـ – المثال الأول يتعلق بجنس الجنين:
1- حيث يتعارض التدخل التقني للتحكم في جنس الجنين مع المشيئة الإلهية التى عبرت عنها الآية الكريمة {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(49)أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير} (الشورى: 49) .
فخلافًا لصريح الآية ولآراء جميع المفسرين بشأنها يذهب الباحث إلى أن مشيئة الإله تعنى مجموعة القوانين التى رمى بها الإله في الطبيعة والضمير، وتؤكد حضور الكسب الإنساني منفعة وتأثيرًا ، فالإنسان ممنوح من قبل الإله بأن يكون سيد الطبيعة، وهو بهذا الامتياز ذو مشيئة مبينة لمشيئة الإله كشفًا وتوضيحًا لا نفيًا وتجديفًا . ونحن البشر الذين نعبر عن المشيئة الإلهية ونحن الذين نمنحها إرادة وقوة، فالمشيئة الإلهية في أعمق معانيها تعنى المشيئة الإنسانية كشفًا لها وإجلاء لبنيتها وتمثلاتها في سنن الكون والأنفس والمجتمع وتعقلاً لمفهومي الحضارة والثقافة معًا ذكاء ولغزًا(1). فتدخلات الإنسان في هذه القوانين كشفًا وبيانًا لا ينافي المشيئة الإلهية وإنما تعبير عنها . ومن هنا لا تصادم بين التقنية البيوطبية والمشيئة الإلهية فيما يتعلق باختيار جنس الوليد، فالتطورات البيولوجية المعاصرة تعبير دقيق عن قوانين المشيئة العليا فيما يتعلق بكروموسومات تحديد الجنس، وبالتالى فلا إشكال بين منطوق الآية المانحة لهوية الجنين، وبين التطورات المعاصرة التى نُفذت في معمل بيولوجي نشط(2) .
وتعليقنا على هذا الكلام من ناحيتين:
الأولى: أن الباحث لم يستخدم مقاصد الشريعة في حل الإشكال، مع أن هذا هو موضوع بحثه .
الثانية: أن الباحث تعامل مع الآية الكريمة كأنها تقول: إن الله وضع قانونًا لتحديد جنس الجنين، ثم جاء الاكتشاف العلمي لهذا القانون واستخداماته، وتجاهل الباحث أن الآية إنما تقرر أن هناك أربع حالات، وأن المشيئة الإلهية تحدد لكل إنسان الحالة التى تريدها له، دون أن تعرض لكيفية تنفيذ هذه المشيئة حتى يقال: إن الإنسان بتدخله يعبر عن هذه المشيئة الإلهية ويمنحها الإرادة والقوة، وهو ما يفترض أن الإنسان يعرف المشيئة الإلهية لكل إنسان ويتولى تنفيذها، وهذا عكس ما يحدث عملاً .
د ـ المثال الثاني: يتعلق بالتحكم في الجينات
1- حيث مكنت آليات التحكم الجيني بتقانة التجميع الجيني من رؤية سلالات جديدة من الحيوانات والنباتات مثل الماروف والعتروف والأرز السوبر والطماطم والبطيخ بدون البذور وغيرها كثير. ويمكن وضع ثلاثة افتراضات في عمليات التجميع الجيني بين الكائنات الحية.
– عمليات التجميع الجيني بين الجينات النباتية وغيرها لإنتاج سلالات نباتية بمواصفات جديدة. أو عمليات الدمج الوراثي بين الجينات النباتية وجينات من كائنات أخرى، كما في الإنسان الكلوروفيلي على مستوى الطموح البيولوجي.
– عمليات التجميع الجيني بين الجينات الحيوانية وغيرها، لإنتاج أصناف جديدة من الحيوان بمواصفات جديدة في البنية والجوهر، أو عمليات الدمج الوراثي بين الجين الحيواني والجين الإنساني كما في الإنسان.
– عمليات التحكم الجيني في المورثات الآدمية، وإعادة تشكيل بعض الخصائص الوراثية للبشر.
أما بالنسبة إلى النقطة الأولى والثانية فيفترض أنهما يندرجان في إطار قانون التسخير الإلهي والسيادة الإنسانية والإباحة الشرعية، إلا في حالة عمليات الدمج بين كائنين مختلفين في البنية والجوهر؛ لأنها تتنافى والكرامة الإنسانية.
أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة فقد تطرق البحث إلى التفرقة بين التغيير النافع والتغيير الضار في بنية الجسد الإنساني: فأباح الأول على أساس رفع الحرج من إضفاء بعض الصفات الجسدية الحسنة للإنسان من الوجهة الجمالية أو استئصال بعض الأمراض الوراثية، ولم يبح الثاني على أساس أنه مفسدة لإهداره كرامة الإنسان ولكونه عبثًا بنظام التكوين الإلهي، ويدخل في ذلك إخضاع الإنسان بصفته موضوع تجربة في المعامل البيولوجية النشطة.
وقد استند في هذه التفرقة إلى قاعدة المصلحة والمفسدة ، وإلى تفسير ابن عطية لآية {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه} (النساء: 119)، وإلى الآية {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ} (الإٍسراء : 70)، وإلى آية {وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْم والجِسْم}(البقرة: 247)، وإلى آية {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَـــــوِيُّ الأَمِين} (القصص:26) وإلى الحديث :(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) وحديث(غربوا النكاح).
وانتهى إلى وضع بعض الضوابط في عمليات التحكم في الجينات منها ألا يكون الإنسان موضوع تجربة فهو كائن لا يخلو من قداسة(1) .
2- وتساؤلي بخصوص هذا المبحث هو: كيف يتسنى أن نصل إلى الاكتشافات المفيدة والضارة ، فنتجنب الثانية ونسمح بالأولى، دون إجراء تجارب؟ أليست التجربة هي الوسيلة إلى الاكتشافات ، وإلى معرفة النافع والضار، فتأخذ حكم هذه المعرفة العلمية المطلوبة، وفقًا لقاعدة فتح الذرئع وتبعية الوسائل للمقاصد؟
والخلاصة أن هذ البحث الجاد يفتقد الآليات الواضحة لاستخدام المقاصد في العملية الاجتهادية، ولكنه خطوة على الطريق على أية حال.
ونخلص إلى أن (الاجتهاد المقاصدي) بالصورة التى عرضناها في الصفحات السابقة لا تستحق أن يطلق عليها هذا المصطلح، فما هي في الحقيقة إلا المصلحة المرسلة أو الاستصلاح ، كدليل شرعي تكلم فيه الأصوليون منذ القديم، وما عملنا فيه إلا التطوير لما كتبوا والبناء عليه.
ولعله بذلك من (الأصلح) – ونحن نتكلم في المصالح – ألا تنفصل المقاصد عن أصول الفقه، وأن تظل فرعًا متطورًا منه: تدعمه وتساعد في تطوير باقي فروعه، وسنعود إلى هذه المسألة عند بحث مستقبل المقاصد .
المبحث الثالث
التنظير الفقهي
يمثل التنظير الفقهي مجالاً لتطوير مقاصد الشريعة واستثمارها مع القواعد الفقهية لتكوين نسق فقهي كامل يستوعب كافة الفروع الحالية والمستقبلية ويستخدم للتفريع عليه، وهذا ما يدعونا إلى التوسع بعض الشيء في شرح هذا الموضوع ومنهجه وآلياته .
المطلب الأول
إرهاصات
أ – كان أ. يحيي محمد(1) لماحًا حين لاحظ أن نظرية المقاصد إنما وضعت في الأساس وضعًا تبريريًّا لما عليه أحكام الشريعة بإضفاء صبغة المقاصد والحكمة عليها، ولم توضع لأجل تأسيس الأحكام وبنائها. أي أنها جعلت لتبرير ما هو كائن، وليس لما ينبغي أن يكون.
ب – وإذا كان ذلك صحيحًا في البداية، فإن التطور اللاحق لنظرية المقاصد يعي تمامًا ضرورة تجاوز المنحى التجزيئي في تفهم أحكام الشريعة، ومعالجة المشكلات التى تواجه المسلمين وفق رؤية كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل .
ولقد تلازمت هذه الدعوة مع دعوة أخرى إلى ضرورة تجديد منهج تفسير القرآن الكريم، إلى ما يسمى بالتفسير الموضوعي؛ للوصول إلى النظريات الأساسية والتصورات الرئيسية التى تمثل وجهة نظر الإسلام، لا أن يكتفى بالبناءات العلوية والتشريعات التفصيلية، وبذلك نصل إلى مجموعة من المفاهيم التى تمثل نسقًا كليًّا مترابطًا(2) .
جـ – وقد اتسمت الكتابات الحديثة بهذه السمة، فمن نظرية أخلاقية لدى محمد عبد الله دراز، إلى نظرية جنائية لدى عبد القادر عودة، إلى نظرية حقوقية لدى عبد الرزاق السنهوري، إلى نظرية اقتصادية لدى محمد باقر الصدر، وهكذا توالت الكتابات في هذا الاتجاه وتطورت، حتى وصلنا إلى مرحلة منهجة هذا الاتجاه التنظيري .
د – كانت الإرهاصات الأولى في هذه الكتابات المنهجية ما كتبه إسماعيل الفاروقي عن أسلمة العلوم، حيث ركز على العلوم الإنسانية والاجتماعية على النحو المعروف في حركة إسلامية المعرفة.
هـ – من ناحية أخرى اتجه حسن الترابي في كتابه غير المنشور (تجديد الأصول الفقهية للإسلام) إلى تجديد أصول الفقه، ومن مباحثه المصالح المرسلة حيث كتب:
مسالك الدلالة المرسلة(1) : تشمل الدلالة المرسلة على مسلكين:
1- أولهما تقدير المصالح، وهو استقراء لعلم الواقع، استعانة بعلوم الطبيعة والاجتماع، ومقارنة للنظم الاجتماعية وأساليب حياتها، واعتبارًا بالتجارب والتاريخ من أجل حصر مطالب الناس ورغباتهم وحاجاتهم، وتصنيف أنواعها وتبين وجهتها العامة، ثم ملاحظة أسباب التوصل إليها مادية كانت أو اجتماعية ، وترتيب الوسائل في منهاج خطتها العامة، ثم نسبة المقاصد والوسائل إلى بعضها، وتبين وجوه ترابطها وتفاوت قوتها . فعلى الفقيه بعد أن يحصر ويسير كل المصالح والأسباب – من منافع وأسباب تجليها ومفاسد وحيل تدرؤها – أن ينتهى إلى تقدير منضبط لمعادلة قوتها ، فمن حيث خطر المقاصد يرتب ما هو ضرورة ملحة للحياة، وما هو دونه من حاجة مقدرة، ثم ما دون ذلـــــــــك من (حسنة) أو (كمال) تكتمل به الحياة وتتزين، ومن حيث مدى تعلق تلك المقاصد يرتب ما هو (كلي) يمس المجتمع وما هو (عام) يعنى طائفة واسعة منه، وما هو (خاص) لا يهم إلا أعيانًا أو فئة محدودة . ومن حيث التذرعات والوسائل يرتب ما هو (قطعى) يؤدى إلى غرضه على وجه الحتم أو الغلبة وما هو (ظني) يحتمل الأداء احتمالاً، وما هو (بعيد) لا يكاد ينعقد سببًا للمقصود. وأغلب هذه التقسيمات قد عرفه الفقه الإسلامي وغدا شائعًا في علم الأصول، ولكنهم أخذوه من محض التأمل من مقاصد الحياة الدينية نظرًا، فقرروا الضرورات الخمس المشهورة، ونحتاج اليوم لجديد يضيف إلى المقاصد ووسائلها ويضبطها بما يتيح المنهج العلمي، وأن نراعي أنها من حيث النشأة موصولة بتطور الحياة والعلم، فلابد من الاستعانة بالعلم في دركها، ولابد من الانتباه إلى أنها متطورة لا يثبت تقرير حالها، إلا ريثما تحول الأحوال والظروف المتقلبة .
2- أما المسلك الثاني فهو تقويم تلك المقاصد والتذرعات . ولا ينفصل ذلك عما تقدم، فإن المصالح لا تعتبر ولا ينبغي أن تنشأ في مجتمع مسلم إلا من وحي عقائده في معنى الحياة ومغزاها، وكل ترتيب لها إنما يتخذ معاييره من معاني التربية الدينية أيضًـا، فالحياة الدينية وحدة تصاغ فيها أقدار الوجود المادي بأقدار الوجود الروحي ، وتدمج فيها الطبيعة والشريعة في الإنسان الموحد اعتقادًا وانفعالاً باطنًا وحركة ظاهرة، ولكنا نعزل جانب تقويم المصالح على صعيد النظر لنخصه بالدراسة، وميزان التقويم يؤخذ من الشريعة من قيم العدالة العامة، كما تتجلى في المعهود من الشريعة جملة، ومن العدالة المعنية كما ترد بها الأحكام الفرعية؛ ذلك أن تفاعل المصالح والأسباب الدائر في إطار الحياة الشرعية يتداخل بلا ريب مع أحكام شرعية جزئية تضبط جزئيات من تلك المصالح، وتفصل في حكم بعض الوسائل، كما يدخل في مبادئ الشريعة الكلية، ومقتضى المبادئ الاعتقادية الإسلامية، وقد قدمنا أن المصالح والاستصحابات لا تجرى في فراغ شرعي، وإنما هي مؤطرة بأصول ودلائل كلية . وإذا كان القانون الوضعي يعرف تقدير المصالح أو المنافع وتقويمها بالعدل أو القسط، فإن موازين التقويم في الشريعة أشد انضباطًا من المفهومات الوضعية (كالقانون الطبيعى)؛ لأنها تتشكل من طائفة واسعة من الأحكام والمبادئ الشرعية، وروح عام تربيه معاني العقيدة التى يعبر عنها نظام الأحكام وأصول الهدى الديني ومواعظه، التى تكتنف أصول الشريعة في القرآن والسنة، فضلاً عن تجارب تاريخ الحياة الدينية. ومن بعد ذلك تستصحب الشريعة اعتبار كل ميزان للعدالة يوافق هديها، سواء عرفه الناس لتعريف المعروف وإنكار المنكر، أو استفادوه من خبرة غيرهم .
ويحسن أن نلاحظ أن استناد ميزان العدالة أساسًا على الشريعة لا ينفى التطور في الأحكام المؤسسة عليه؛ لأن مادة الحياة التى يحكمها، واطراد تجارب تحقيقه في الواقع قد تبدى منه في كل حال ما لم يكن باديًا وتدعو لتعديل أحكام سالفة على ضوء وعي جديد، فتقويم المصالح من ثم – على إثبات أصوله وكثير من دقائقه – قابل للتطور اتساعًا وتجددًا . ودون الخوض في بحث مدى وظيفة الفقه في المجتمع اختصاصًا أو شيوعًا ، يحسن أن نعترف بأن كل مكلف في الجماعة قادر على استقراء المصالح وتقويمها، وأهل للإسهام في بيان مقتضى الحياة الدينية على صعيد أحكام المصالح ، بل ربما يستدعى اتساع العلوم وضرورة التخصص أن يكون بعض علماء المجتمع المسلم أشد إدراكًا لعلم تقدير المصالح الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الصحية من الفقيه المتخصص لشئون نظام الأحكام. وعندئذ تكون وظيفة الفقيه أن يستعين بكل علم صادر عن أهله، وبكل تعبير عن الحاجات وعن العدالة العرفية صادر عن الرعية كافة، ثم يعكف على تحضير تلك المادة وتكييفها بما يناسب تجديد الأحكام، وذلك بأن يتخذ لها التصنيفات المضبوطة، ويطبق عليها معايير العدل الدقيقة التى هو بها بصير من تربيته الفقهية وتعهده لمسالك الأحكام والخصومات ووجوه الفصل فيها، ثم يعبر عنها بلغة الأحكام ومصطلح الفقه الدقيق، ويوحدها إلى سائر نظام الأحكام الشرعية .
ونظرًًا للسعة الواضحة في الاستدلال بالمصالح والاستصحابات ، فإن رأى الفقيه في قوة المصلحة، أو خطورة المفسدة، وفي مدى تعلقها بقطاع معتبر من المجتمع، وفي قطعية الترابط السبـبي بين مختلف وجوه السلوك، ونتائجه المدعاة، وفي الحكم من ثم في تسوية المنازعات وضبط المعاملات، بما هو خير للحياة وبما هو في الوقت ذاته معادلة ترد المظالم وتبسط المساواة والإخاء والتعاون – أن الرأى الفقهي في ذلك الأمر التقديري الواسع قد لا تقوم له حجة راجحة يلتزم بها المجتمع، بمثل ما تقوم حجة استدلال الفقيه بطرائق التفسير والقياس المنضبط وغيرها، التزامًا وثقة بأنها بيان دقيق لمقتضى الشرع. ثم إن هذه الدلالة الواسعة -كما قدمنا- تختص أساسًا بأحكام المعاملات التى وضعت فيها الشريعة مجالات العفو والمبادئ المرنة، فنتائجها لذلك عرضة لأن تقابل عند المكلفين – لا روح الرضى والمطاوعة التى تظهر في مجال الشعائر مثلا، بل روح الخصومة التى يزكيها طلب متاع الدنيا والتنافس عليها. والتعويل لذلك – في ضبط سعة هذه الدلالة وحسم مخافة الاختلاف والاختصام – على النظم السلطانية التى تقيمها الجماعة أصولاً للأحكام الوضعية في المجتمع المسلم، فغالب التسنينات التشريعية الإجماعية والأوامر التنفيذية الصادرة في مجتمع مسلم والمتجددة نسخًا وتعديلاً، إنما هي تعبير عن تقرير أحكام المصالح والمعاملات على هدى من أصول الشريعة وإطار من أحكامها واستعانة بالفقه البياني الاجتهادي الذي ينظم مقتضى العلم الديني – طبيعية وشرعية، اقتراحًا للمعالجات الحكيمة التى قد تعتمدها الجماعة بشوراها حينًا بعد حين تقديرًا لمقتضى الاستجابة الدينية للابتلاء الظرفي الذي يجرى به قدر الله في واقع الحياة، والذي يعين مسرح الحياة الدينية واتجاهاتها ووسائلها، ويدعو للتركيز على مقاصد الإيجاب – الجهاد ، جلب المصالح، أو التقوى ، درء المفاسد، أو على مقاصد العلم – النهضة الثقافية، أو المتاع – النهضة الاقتصادية، أو على مقاصد الحرية – تشجيع التنمية والاستثمار، أو التسوية، تقارب الدخول.. إلخ تبعًا لتطور الأقدار والأقضية (انتهى نص حسن الترابي) .
و – عقد عبد المجيد النجار في كتابه (في فقه التدين فهمًا وتنزيلاً) فصلاً عن فقه الصياغة في الشريعة، قرر فيه (أن المسلم في الأحوال المتغيرة من حياته يمكن أن يلائمها جميعًا مع أحكام الدين التى لا تنص إلا على كليات الأفعال عن طريق عمل اجتماعي مستمر، هو أقرب في طبيعته إلى اجتهاد الفتوى، ولكنها فتوى في أوضاع عامة، لا في أحداث شخصية جزئية ، وفي هذا الاجتهاد تصاغ من أحكام الدين العامة منظومة من وجوه تلك الأحكام وكيفياتها ومقاصدها، من شأنها أن توجه الأوضاع المستجدة بما يحقق المصلحة ، وهي غاية الدين ، وليست هذه الصياغة أمرًا هينًا، بل هي على درجة كبيرة من الخطورة، باعتبار أنها اجتهاد دائم لجعل الحياة تتحقق على سمت ديني، مع تغاير أنماطها وملابساتها، وبقدر ما تكون هذه الصياغة مترشدة، بقدر ما يكون في ذلك ضمان لجريان الحياة على سمت الدين المحقق للمصلحة)(1) .
المطلب الثاني
التنظير الفقهي
أولاً : تعريف النظرية ومظان البحث عن روافدها في التراث
أ – تعريف النظرية:
1- في سنة 1987م نشرت كتابًا بعنوان التنظير الفقهي جاء في مقدمته(1):
يمكن تعريف النظرية الفقهية بأنها التصور المجرد الجامع للقواعد العامة الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية .
فهي تصور يقوم بالذهن، سواء استنبط بالتسلسل الفكري المنطقي، أو استمد من استقراء الأحكام الفرعية الجزئية.
ويتصف هذا التصور بالتجريد؛ إذ يحاول أن يتخلص من الواقع التطبيقي لينفذ إلى ما وراءه من فكرة تحكم هذا الواقع .
وهو تصور جامع، يحاول أن يحيط بجميع جوانب الموضوع، ويبحث كافة مستوياته وأبعاده.
وهو في هذا الصدد يقف عند كل ظاهرة أو حكم يتعلق بها ملاحظًا الصفات المشتركة بين كافة الظواهر والأحكام التى يبحثها، دون تلك التى تختص بها ظاهرة معينة أو حكم محدد، وذلك سعيًا وراء التعرف إلى القواعد العامة المشتركة .
2- وقد عرّف باقر برى النظرية بقوله(2) :
إن المراد من النظرية هو الصيغة الفكرية المركبة من مجموعة من المبادئ والأسس والرؤى والمفاهيم والأحكام والنصوص الإسلامية التى يرتبط بعضها ببعض في إطار التعبير عن المذهب الإسلامي في مجال من مجالات الإنسان والكون والمجتمع .
إنها صيغة ونسيج منسجم وموحد، قصد من جمع خيوطه في اطراد واحد، والتوليف بينها، أن نصل إلى الموقف الإسلامي العام في مجال من مجالات الحياة، وخاصة المجالات الاجتماعية .
إن فائدة النظرية الإسلامية بعد استلهامها وصياغتها تتمثل بما تقدمه من نسق نظري ومواقف ومرتكزات وإطار عام للتحرك في المجال الذي تتطرق له ضمن الخطوط والضوابط والمقاييس العامة للشريعة المقدسة .
ولاشك في أن كل نظرية من هذا القبيل لا نستطيع أن نستلهمها إلا بعد الفهم الدقيق لمجالها الذي سترشدنا إلى الإطار المذهبي للتحرك فيه .
من هنا كان لابد من أن يرد فيها وصف وتحليل وإيضاح – ما يستوعب أبعاد الواقع الموضوعي والمجال الذي هي بصدد الإفصاح عن المذهب الإسلامي فيه .
ولأنها ستعلن موقفًا بديلاً للمذاهب والنظريات الموجودة في الميدان، فلا بدّ من أن تنطوى على المفارقة بينها وبين هذه المذاهب، وإعمال نقد موضوعي للمذاهب الأخرى، حيث لا يمكن أن نبرز النظرية الإسلامية للذين ندعوهم إلى تبنيها إلاّ إذا امتلكنا وعيًا نقديًّا بالنظريات الموجودة في الميدان، وأثبتنا لدى التحليل مدى صمودها أمام النقد .
إن بناء النظرية الإسلامية بالنتيجة يعتمد على عمل فقهي فكري تركيبـي، واع ومتخصص ، يتم في ضوئه اكتشاف المذهب، على أساس مقاييس ومعايير محددة .
ثم إن النظرية الإسلامية لا يمكن لها أن تنضج وتبين مثالبها ومحاسنها إلاّ بوضعها على المحك، وبالتطبيق العملي لها في واقع الحياة، وتحديدًا في إطار دولة ونظام إسلاميين؛ ذلك أن التطبيق العملي للنظرية الإسلامية والاسترشاد بها في مجالها المعين يرتفع بها إلى مستوى المساءلة والتجربة، ويفتح على العقل الاجتهادي كوىً ونوافذ بصيرة جديدة تؤدى إلى التعديل فيها وتطويرها .
3- ويفرق سعيد رحيمان(1) بوضوح بين كل من القاعدة والنظرية والنظام .
فالقاعدة: حكم كلي يشتمل على أحكام متعددة في باب أو أبواب مختلفة من الفقه. وبعبارة أدق هي مصدر أو أساس الأحكام في أبواب المعاملات أو العبادات في الفقه، كقاعدة لا ضرر، وقاعدة لا حرج، وغيرها .
والنظرية: هي مجموعة الأحكام المتقاربة في موضوع له مبناه الخاص وهدفه المعين وأرضيته الواحدة. ومن الممكن أن يكون هذا الموضوع باباً فقهيًا، كنظرية القصاص أو نظرية الضمان، أو جزءًا من باب أو عدة أبواب من الفقه، كنظرية الإرادة، أو نظرية الضرورة الشرعية، أو نظرية الخيارات، وغيرها .
والنظام الفقهي: يشير إلى هيكل تأليفي من مجموعة من الأحكام . ويتعلق النظام الفقهي بمختلف أبواب الفقه، ويتكفل الإفصاح عن الأهداف الكلية للشريعة وروح النص الفقهي ذي الصلة بتلك المجموعة من الأحكام . وللتمثيل يمكن ذكر النظام الاقتصادي في الإسلام، أو النظام الجزائي في الإسلام، وغيره .
ب – مظان البحث عن روافد النظرية في التراث :
1- من الشائع القول بأن الشريعة الإسلامية لا تحوى نظريات عامة، وإنما هي مجموعة من الأحكام الفرعية في مختلف المجالات .
وباستعراض مدى ما وصل إليه فقهاء السلف في مجال التنظير، سيتبين أن هذه المقولة ليست صحيحة على إطلاقها، وإن كان القائلون بها عن حسن نية معذورين للأسباب التى سنشير إليها .
إن البحث عن النظريات الفقهية ليس من السهولة بالصورة التى نبحث بها عن الأحكام الفرعية للمسائل الفقهية، فكتب الفقه زاخرة بأحكام الفروع، وقلما تجد فيها بحوثًا عن نظريات فقهية؛ إذ إن هذه النظريات متناثرة بين العديد من المصنفات، وهي بحاجة إلى اكتشاف وتجميع وترتيب .
وقد يسهل الاكتشاف أحيانًا إذا اقتصر على الوجود المادي، ولكنه في أحيان كثيرة يحتاج إلى جهد علمي لاستخراجه من الأحكام الفرعية التى تختفى وراءها النظريات، فبالرغم من أن بعض النظريات لم يفصح عنها الفقهاء، ولم يبلوروها، إلا أن تتبع الأحكام الفرعية التى جاءوا بها تقطع بوجود نظرية في ذهن الفقيه تنتظمها، ويكون المطلوب حينئذ هو استخراج هذه النظرية من الأحكام الفرعية .
كما أن الترتيب قد يسهل أحيانًا إذا كانت مباحث موضوع معين متكاملة في كتب التراث، أما حيث لا تكتمل المباحث، فإن وضع هيكل للنظرية وإنزال المباحث المتفرقة عليه، ومحاولة سد الثغرات يصبح عملاً ضروريًّا للتوصل إلى نظرية متكاملة .
وترتيب النظريات الفقهية يتصل بالضرورة بترتيب العلوم التى تحكمها هذه النظريات، ويستلزم ذلك بحث ما يعتبر خادمًا من هذه العلوم وما يعتبر مخدومًا، وبحث ما هو فرض عين منها وما هو فرض كفاية .
وحتى نحصر بحثنا فيما هو تنظير فقهي ينبغي أن نستبعد أمورًا قد تختلط به وليست منه، ويعيننا على ذلك أن نوضح أن الأحكام الفقهية الفرعية أي التى تتعلق بمسألة محددة لا تدخل في باب النظريات الفقهية، حتى ولو أخذت صورة القاعدة؛ إذ إن صياغتها التقنينية في صورة قاعدة لا تخرج بها عن كونها قاعدة فرعية تنطبق على مسألة محددة مهما تعددت التصرفات والوقائع التى تنطبق عليها .
كما لا يعتبر تنظيرًا فقهيًّا فتوى المفتى في تصرف معين أو واقعة معينة، وكذلك حكم القاضى في نزاع محدد، فهذا وذاك من قبيل إنزال الحكم الشرعي على واقعة محددة أو تصرف محدد وليس من باب التنظير الفقهي .
ونوضح في الجدول التالي ترتيب القواعد التنظيرية وفقًا لدرجة تجريدها من ظروفها الجزئية، بعد أن نستبعد ما ليس من القواعد التنظيرية .
قواعد تنظيرية :
* قاعدة أصولية أو كلامية أو لغوية.
* قاعدة مشتركة بين عدة أبواب من أقسام فقهية مختلفة .
* قاعدة مشتركة بين عدة أبواب من قسم فقهي واحد (كالعقود مثلاً) .
* قاعدة عامة لباب واحد (كالبيع مثلا) .
قواعد تستبعد لأنها ليست قواعد تنظيرية :
* قاعدة فرعية ، هي مجرد صياغة تقنينية لحالة فردية متكررة .
* فتوى المفتى، وحكم القاضي.
* الوقائع والتصرفات محل الأحكام الشرعية .
2- مظان البحث عن النظريات الفقهية في كتب التراث:
يستدعى البحث عن النظريات الفقهية في كتب التراث عدم الاقتصار على كتب الفقه التى غالبًا ما تهتم بالأحكام الفرعية التى وضعت أساسًا لعرضها، وإنما الاتجاه إلى كتب أصول الفقه، وعلم الكلام، والفلسفة، والسياسة الشرعية، والأحكام السلطانية، والقضاء، والحسبة، والقواعد الفقهية، والقواعد الكلية، والفروق والأشباه والنظائر، وتخريج الفروع على الأصول، ومقاصد الشريعة، واختلاف الفقهاء وغيرها .
يقول أستاذنا الشيخ أبو زهرة رحمه الله في صدد الحديث عن القواعد الفقهية : (إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه ، وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التى في مضمونها يصح أن يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي) .
إن دراسة القواعد من قبيل الفقه، لا من قبيل دراسة أصول الفقه، وهي مبنية على الجمع بين المسائل المتشابهة من الأحكام الفقهية، ولهذا نستطيع أن نرتب تلك المراتب الثلاث التى يبني بعضها على بعض، فأصول الفقه يبني عليه استنباط الفروع الفقهية، حتى إذا تكونت المجموعات الفقهية المختلفة، أمكن الربط بين فروعها وجمع أشتاتها في قواعد عامة جامعة لهذه الأشتات، وتلك هي النظريات الفقهية(1) .
ومع تسليمنا لأستاذنا أبو زهرة رحمه الله في تسلسل نشأة كل من أصول الفقه وفروعه والقواعد الفقهية، إلا أننا نتوقف عند اعتباره القواعد الفقهية مرة النظريات للفقه الإٍسلامي، ومرة النظريات الفقهية.
وسبب توقفنا هو أننا نفضل التمييز بين النظرية العامة للفقه الإسلامي، وهذه نجد معظمها في أصول الفقه ، وبين النظريات العامة لكل فرع من فروع الفقه، وهذه نجد بداياتها في القواعد الفقهية، ولكنها لم تكتمل وتنضج إلا في كتابات المعاصرين، وهذه على كل حال مسألة اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون.
ونتوقف مرة أخرى عند قوله رحمه الله: (إن دراسة القواعد من قبيل دراسة الفقه لا من قبيل دراسة أصول الفقه) ، إذ إننا نرى أن القواعد ليست من الفقه، وإنما هي في مرتبة وسطى بين الأصول والفروع، أي بين أصول الفقه والفقه .
3- وفي بيان روافد عملية التنظير الفقهي كتبتُ(2) :
يقول الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا في تعريفه للنظريات الفقهية:
(نريد من النظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التى يؤلف كل منها على حدة نظامًا حقوقيًّا موضوعيًّا منبثًا في تجاليد الفقه الإسلامي، كانبثات أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني، وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها، وفكرة النيابة وأقسامها ، وفكرة البطلان والفساد والتوقف، وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه، وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات، إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التى يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله، ويصادف الإنسان أثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية .
وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية، فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى . فقاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) مثلاً ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل (نظرية العقد) وهكذا سواها من القواعد(1) .
وإلى جانب هذه النظريات الفقهية الأساسية التى أشار الأستاذ الزرقا إلى أمثلة لها، توجد نظريات أخرى فرعية على مستوى أقسام الفقه وأبوابه، كما توجد فوقها نظرية عامة للشريعة ككل، والتى سنحاول رسم إطارها في بحث مستقل إن شاء الله .
وقد سبق أن بينا أهمية فن (الجمع) في تكوين مادة النظريات الأساسية والفرعية، فهو وإن بدأ جهدًا موسوعيًّا متمثلاً في الجمع الموسوعي للمادة المتعلقة بالموضوع من الأبواب المختلفة، إلا أن ذلك يؤدى في معظم الأحيان إلى استخراج القواعد والضوابط التى تعين على تكوين النظرية .
كما أن فن (الفروق) يعين كذلك على تبين الفروق الدقيقة التى تتميز بناء عليها المسائل بعضها عن بعض، وهذا من أهم ما يلزم كذلك لحركة التنظير.
أما علم القواعد ذاتها فلا شك في أهميتها لحركة التنظير خاصة إذا صنفناها حسب درجة تجريدها، واستخدمنا كل مستوى منها فيما يقابله من مستويات التنظير، ولم نقتصر على مستوى القواعد داخل الأبواب التى أشار الأستاذ الزرقا إلى أنها ليست سوى ضوابط في ناحية مخصوصة من ميدان النظرية، وذلك على النحو الذي سنشير إليه عند الحديث عن التطوير والذي سنعود إليه بعد قليل في (النظرة المستقبلية) .
وأخيرًا فإن علم اختلاف الفقهاء يسد ثغرة هامة في مجال التنظير إذ يعين على تصور النظرية على مستوى مذهب فقهي بعينه، أو على مستوى الفقه الإسلامي بمجموع مذاهبه، وهو ما يؤدى إلى إثراء النظرية وتنوع وجهات النظر فيها، والحلول التى تقدمها، وبالتالي تكون النظرية أكثر تمثيلاً لمجموع الفقه الإسلامي .
ثانيًا : منهج التنظير عند الإمام الصدر
ما زالت الكتابات الشرعية حول منهج التنظير نادرة غير أن الاهتمام بدأت بوادره لدى إمام شيعي معاصر هو الشهيد محمد باقر الصدر، وصدرت بضعة دراسات عن منهجه في التنظير:
أ – ونقطة الانطلاق لديه عند التنظير تكون من الواقع إلى النصوص، وليس العكس(1) .
كتب باقر بري(2) ملخصًا هذه النقطة:
على الممارس في المرحلة الأولى أن يسعى إلى استيعاب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع الخارجي من مشاكل، وما قدمه من حلول، وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ونقاط فراغ، كل ذلك ليشكل لديه نقطة انطلاق مبدئية يتجه بعدها إلى درس الموضوع الذي تبناه، وتقييمه تقييمًا شاملاً من وجهة نظر الإسلام، وفق معطيات القرآن الكريم والسنة الشريفة، من أحكام ومفاهيم وأفكار، للوصول أخيرًا إلى اكتشاف النظرية الإسلامية الشاملة فيه .
وإذ يتحرك المنهج الموضوعي صوب التفسير القرآني ، فإن السيد الشهيد ينبه إلى أن التفسير الموضوعي (هو الذي يطرح موضوعًا من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، ويتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده) إن المفسر الموضوعي (يأخذ النص القرآني ، لا ليتخذ من نفسه بالنسبة إلى النص دور المستمع والمسجل فحسب، بل ليطرح بين يدي النص موضوعًا جاهزًا مشربًا بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية، ويبدأ مع النص القرآني حوارًا على شكل سؤال وجواب.. والمفسر على ضوء الحصيلة التى جمعها من خلال التجارب البشرية، المعرضة للصواب والخطأ، يسأل والقرآن يجيب، يجلس سائلاً ومستفهمًا، ومتدبرًا، فيبدأ مع النص القرآني حوارًا حول هذا الموضوع، وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح، والنظرية التى بإمكانه أن يستلهمها من النص ، من خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث من الموضوع من أفكار واتجاهات. ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائمًا بتيار التجربة البشرية لأنها المعالم والاتجاهات القرآنية ، لتحديد النظرية القرآنية بشأن موضوع من مواضيع الحياة) .
ب – النقطة الثانية تتعلق باستقراء الأحكام الشرعية الخاصة بالمسألة موضوع التنظير، وفي هذا الصدد كتب سعيد رحيمان(1) .
على صعيد الاستقراء يرى الشهيد الصدر أن المواد الأولية التى ينبغي جمعها للاستقراء هي النصوص والأحكام والآراء الفقهية المنتشرة في مختلف تأليفات الفقهاء وعلماء الإسلام(2) .
إذن فالخطوتان الرئيسيتان لتكوين النظرية تتمثلان في الوهلة الأولى بجمع وتشذيب النصوص، والتعامل معها بالطريقتين التجزيئية والشمولية. وهكذا فإن النصوص تنقسم إلى ثلاث فئات، من حيث صلتها بالنظرية التى ستتكون لاحقًا في ذهن الفقيه :
1- النصوص الصريحة في تأييدها للنظرية .
2- النصوص الصريحة في عدم تأييدها للنظرية .
3- النصوص غير الصريحة (في الموافقة أو عدم الموافقة) .
وفيما يتعلق بالفئة الأخيرة يحتاج فهم النص والكشف عن مضمونه إلى كفاءة اجتهادية فائقة .
وفي الوهلة الثانية يتم تركيب الحالات وتحليلها، وتكوين نظرة كلية لانتزاع البنية الأساسية (وبتعبير الشهيد الصدر البناء العلوي) من خلال مجموع النصوص والأحكام، ثم اكتشاف القواعد الكلية على أساس ذلك البناء العلوي.
وبما أننا سلمنا ابتداء بضرورة وجود نظريات وأنظمة في الفقه، فمعنى ذلك أن الإسلام دين كامل له أنظمته المختلفة وقابليته على صياغة الأنظمة ، ودعوته إلى اكتشاف هذه الأنظمة في إطار الاجتهاد والتفقه. ومن ناحية أخرى لأن المنهج الاستقرائي قائم على حساب الاحتمالات ، فإن آراء الفقهاء ستكتسب قيمة إحصائية صرفة، من حيث تأييدها أو تعارضها مع النظرية المقترحة، وهكذا فإن الفتاوى المخالفة ((في فقه الأحكام) لن تكون ذات طابع سلبي في فقه النظريات المتميز بمجال استنباطي أوسع .
إذن فالمنهج العام لاكتشاف النظريات عبارة عن اقتراح نظرية (بعد استقراء النصوص والأحكام) ودراسة ما يؤيد هذه النظرية وما يعارضها، ثم اجراء حسابات الاحتمالات لتعيين درجة اليقين أو الظن الاطمئناني للنظرية. وتتوافر الحجية لهذا المنهج عن طريق الاستدلال العقلي؛ لأن الفقيه استند في هذا المنهج على الاستقراء الذي يلتزم أساليب دقيقة بعيدة عن الطريقة الانتقائية وما إليها من الطرق غير العلمية.
إن سر كفاءة الجهاز الاجتهادي في الإسلام وقدرة قيادته على توجيه الحياة الاجتماعية ، يكمن من وجهة نظر الشهيد الصدر في التركيب المناسب بين هذين العنصرين (الثابت والمتحول) ضمن كيان واحد وباتجاه أهداف مشتركة . وهذا التركيب يحتاج إلى ثلاثة أمور :
1- فهم العنصر الثابت .
2- فهم متطلبات وطبيعة كل مقطع من مقاطع الحضارة الإنسانية .
3- تعيين صلاحيات وحدود تدخل ولي الأمر .
وهو يرى أن مفهوم (منطقة الفراغ) يقع إسلاميًّا في سياق العنصر الثالث. فمنطة الفراغ ليست نقصًا أو هوة في الشريعة، وإنما هي من نقاط قوة الشريعة.. حيث تترك هذه المنـــــــاطق (مناطق الفراغ) إلى جانب الحكم الأولى والأصلي لتكون مجالاً لصلاحيات ولي الأمر، كي يملأها بالتشريعات والأحكام الثانوية. إذن فالحكومة تملأ الفراغ الذي تركته الشريعة تحسبًا لمتغيرات الزمان والمكان .
جـ – وتتعلق النقطة الثالثة لدى الصدر بعملية الانتقال من الجزئيات إلى القاعدة الكلية المشتركة بينها . في هذا الصدد كتب باقر برى(1) :
يصل الممارس إلى فقه النظرية الإسلامية عن طريق تجاوز المداليل التفصيلية للأحكام والآيات . والخروج عن حالة التناثر والتراكم فيما بينها، والعمل على دراسة كل مجموعة من الآيات القرآنية أو الأحكام التشريعية التى تشترك في الموضوع الواحد، دراسة شمولية تنسق وتوحد بين مداليلها، وتبين في اطراد واحد أوجه الارتباط بين هذه المداليل التفصيلية ؛ ليخلص الممارس بالتالي إلى تجديد إطار نظرية واضحة ترسمها تلك المجموعة من الآيات أو التشريعات ككل بالنسبة إلى ذلك الموضوع .
يقول الشهيد الصدر عن هذه الممارسة التى توصل إلى فقه النظريات الإسلامية : إنها تحتاج إلى المزيد من الوعي للأحكام والمفاهيم الإسلامية التى قد تبدو متناثرة في الموضوع الواحد، في الوقت الذي تكون فيه منسجمة ومتكاملة فيما إذا توافرت النظرة العميقة الواعية الشمولية للأسس والمنطلقات والمقاصد والأهداف؛ ولهذا فإن الاجتهاد على صعيد فقه النظريات يحتاج إلى المزيد من الجهود كما يحتاج إلى المزيد من الإبداع؛ لأن المسألة ليست استحضارًا للنصوص وتجميعها في مجال معين فحسب، بل هي عملية اجتهاد مقعَّدة تتجمع فيها شخصية الفقيه والمكتشف(12) .
ومنهج الإمام الصدر في هذه النقطة هو بالأحرى منهج اكتشاف القواعد الفقهية، وليست النظريات الفقهية، وكأنه اعتبرهما مترادفتين، والأمر ليس كذلك على النحو الذي شرحناه قبل، والذي أوضحه كذلك سعيد رحيمان في تعريفاته التى نقلناها فيما سبق .
د ـ أما النقطة الرابعة لتى تستوقفنا عند الصدر فهي تنبيهه إلى الحفاظ على الموضوعية والابتعاد عن الذاتية(3) .
1- ويوضح -وهو بصدد إثبات هذه الخاصية للنظرية الإسلامية- الفرق بين اكتشاف النظرية وتكوين النظرية(4) ، فالمجتهد في فقه النظريات الإسلامية، لا يضع نظرية مصدرها رؤيته الذاتية واستخلاصه البشري للأمور، بل هو يكشف عن وجهة نظر الإسلام ونظرياته منطلقًــا من أبنيتــــــه العلوية (الأحكام التفصيلية) ، إلى أعماق البناء لاكتشاف طابق الأساس، بينما الذي يمارس عملية التكوين فهو يصعد من الطابق الأول إلى الثاني؛ لأنه يمارس عملية بناء وتكوين، والطابق الثاني لا يكون في عملية البناء إلا أخيرًا(1) .
2- وينبه الشهيد الصدر(2) إلى أن خطر الذاتية على عملية اكتشاف النظرية أشد من خطرها على عملية الاجتهاد في أحكام جزئية .
3- ثم يوضح أهم أسباب الذاتية وهي:
* تبرير الواقع .
* دمج النص ضمن إطار خاص .
* تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه .
* اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص .
* خداع الواقع التطبيقي .
هـ ـ ولم يفت الإمام الصدر اعتبار مقاصد الشريعة عند اكتشاف النظرية؛ مما أدى بسعيد رحيمان(3) إلى نتيجة أن رسم الخطوط العامة لنظـام من الأنظمة (مجموعة من النظريات حسب مصطلحه) يحتاج إلى الأمور الأربعة التالية:
1- معرفة التوجهات العامة للشريعة.
2- فهم الأهداف المنصوصة للأحكام الثابتة .
3- أخذ القيم الاجتماعية بنظر الاعتبار .
4- فهم الأهداف المحددة لولي الأمر، والتى تعين له مجالات إعمال ولايته .
ونلاحظ هنا إشارة الإمام الصدر إلى أن المقاصد جاءت عامة، ولم يحدد دورها في عملية التنظير، كما لم يضع آلية أداء هذا الدور .
ثالثًا : منهج أسلمة العلوم عند
الدكتور الفاروقي
على صعيد آخر لا يبعد عن عملية التنظير، كرس الدكتور إسماعيل الفاروقي جانبًا أساسيًّا من جهده لعملية أسلمة المعرفة .
وجه التقارب بين العمليتين، هو أن تحقيق هدف الأسلمة – وهو إقامة العلاقة الخلاقة بين الإسلام ومجالات المعرفة المختلفة – لا يكون على المستوى الجزئي، وإنما على مستوى كلي تنظيري، يتفاعل فيه الفكر الإسلامي مع العلوم الحديثة .
وقد رسم الفاروقى خطة عمل لتحقيق أسلمة المعرفة تتضمن عددًا من الخطوات(1) يستوقفنا منها ما يمس موضوع التنظير :
أ – إتقان العلوم الحديثة والمسح الشامل لها (الخطوتان الأولى والثانية) وتحديـد أهــم مشــاكل الأمة والإنسانية (الخطوتان الثامنة والتاسعة) تقابل نقطة الانطلاق لدى الإمام الصدر من الواقع إلى النصوص؛ نظرًا لأن العلوم الحديثة تمثل الواقع بكل ما فيه من أسئلة ونقاط فراغ تدعو إلى الحوار .
ب – التمكــــن من التراث وتحليلـه (الخطوتان الثالثة والرابعة) تقابل نقطة استقراء الأحكام الشرعية لدى الإمام الصدر، باعتبار أنها في شق منها عبارة عن عملية تكشيف للنصوص (الكتاب والسنة) والتراث (الفقه)، وفي شق آخر، وكمتطلب ضروري لنجاح عملية التكشيف تقتضى وجود مكنز يعبر عن المنظومة الإسلامية وقدرًا من التحليل يربط المادة المكشفة بعناوين المكنز .
جـ – تمثل الخطوات السادسة والسابعة والعاشرة (التقييم النقدي للعلم الحديث، والتقييم النقدي للتراث الإسلامي، والتحليلات والتركيبات المبدعة) جوهر خطة الفاروقي والتى لم تكن الخطوات السابقة إلا تحضيرًا لها.
ولا نستطيع هنا أن نقول: إن هذه الخطوات تقابل نقطة الإمام الصدر الخاصة بعملية الانتقال من الجزئيات إلى القاعدة الكلية، فهذه العملية الأخيرة أقرب إلى اكتشاف القواعد وليس النظريات، كما أشرنا سابقًا في موضعه، كما أنها من ناحية أخرى تمثل مقدمة ضرورية للخطوات التى حددها الفاروقي والتى بتحققها تتحقق عملية التنظير ضمن عملية الأسلمة – هدف خطة الفاروقي .
د ـ بقي أن نشير إلى نقطتى الحفاظ على الموضوعية واعتبار مقاصد الشريعة، لم تشر إليهما خطة الفاروقي .
هـ ـ مقابل ذلك فقد اشتملت خطة الفاروقي بصورة واضحة على المبادئ الأساسية للمنهجية الإسلامية(1)، والمتمثلة في وحدانية الله، ووحدة الخلق، ووحدة الحقيقة، ووحدة المعرفة، ووحدة الحياة ، ووحدة الإنسانية ، وأكدت على أن عملية إعادة تشكيل العلوم ضمن إطار الإسلام تعنى إخضاع نظرياتها وطرائقها ومبادئها وغاياتها لهذه المبادئ .
رابعًا : المنهج الذي نراه
مع تقديرنا الكامل لكل من منهجي الصدر والفاروقي ، فإننا نعرض منهجًا للتنظير يجمع بين محصلة هذين المنهجين، وبين ما انتهينا إليه في بحث المقاصد، واستثمارها في التنظير على نحو ما أشار إليه كل من حسن الترابي وعبد المجيد النجار، وذلك بتطوير المقاصد لتكوين نسق فقهي كامل، يستوعب كافة الفروع الحالية والمستقبلية، دون انتظار حدوث واقعة جزئية لإبداء الحكم الشرعي فيها، وذلك من خلال خطوات معينة عملية على النحو التالي :
أ – معرفة المقاصد التى تنطبق عليها الشروط التى أشار إليها الغزالي بدرجتيها:
1- ما عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها، ووقع موقع القطع .
2- وما عرف ولو بأصل غير معين، ولم يعارضه معارض مقطوع به .
ب – أن تصنف هذه المقاصد وتركب في بناء فكري تجمع فيه الأشباه والنظائر، وتقسم إلى مجموعات وفقًا لموضوعاتها حتى تستبين معالم التصور الشرعي في كل موضوع(2) حسب تقسيمات الكتابات الفقهية المعاصرة.
جـ ـ أن تضاف إلى كل مقصد من هذه المقاصد الوسائل الموصلة إلى تحقيقه، ويستعان في ذلك بأدوات العصر وأساليبه التى لا تتعارض مع أصل شرعي.
د ـ أن تضاف إلى مقاصد ووسائل كل مجموعة ما يخصها من القواعد الشرعية، وكذلك القواعد الشرعية العامة التى تنطبق عليها، وتعتبر هذه القواعد بنوعيها جزءًا أساسيًّا من هيكل بناء كل مجموعة؛ لأنها تمثل الأحكام الشرعية المتوصل إليها بالأدلة الشرعية الأخرى .
هـ ـ أن يتم بناء نظرية متكاملة في كل مجموعة تصلح للتفريع عليها والاستمداد منها، بما يحقق التوصل إلى المقاصد وينسجم مع القواعد في نسيج واحد .
و – وفي خصوص المقاصد الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية، أن يضاف إلى المرحلتين ( د، هـ ) ما يخص كلاًّ من هذه العلوم .
1- من السنن الإلهية المتعلقة بموضوعه.
2- ومن الحقائق العلمية اليقينية التى توصل إليها العلم حتى يكون بناء نظرية كل علم مشتملة على جميع العناصر المعيارية والموضوعية الخاصة به .
ويدخل في العناصر المعيارية :
1- التصور الإسلامي لله والكون والإنسان والحياة.
2- القيم الأخلاقية العامة، والخاصة بالعلم .
3- مقاصد الشريعة الخاصة بالعلم.
4- القواعد الشرعية الضابطة للعمل.
خامسًا : علاقة النظريات
بالعلوم الشرعية
نوضح في الرسم التالي العلاقات التى تربط النظريات الفقهية بالعلوم الشرعية المختلفة :
ففي المركز من هذا الرسم التوضيحي توجد العقيدة لأنها الأساس والمنشأ لكل العلوم، ينبثق عنها القيم الأخلاقية، فالنظرية العامة للشريعة التى تحكم جميع فروع الشريعة، يليها القواعد والنظريات المشتركة التى يشترك أكثر من باب من أبواب الفقه في الاستمداد منها والرجوع إليها، وهي على مستويين: مستوى تشترك فيه عدة أبواب من أقسام فقهية مختلفة كالعبادات والمعاملات والجزاء مثلاً ، ومستوى تشترك فيه عدة أبواب من نفس القسم الفقهي فهي بمثابة النظرية العامة لهذا القسم بالذات الذي تنطبق عليه. ثم تستقل بعد ذلك أبواب الفقه ويختص كل منه بنظريته العامة التى تحكم جزئياته والخاصة به دون سواه من الأبواب.
هذا هو التصور الذي نراه أنسب التصورات لتنظيم مادة الفقه وتقسيم أجزائها ، مع ربط هذه الأجزاء بشكل منطقي، ومع مراعاة الأولويات والعلاقات الوظيفية للقواعد المختلفة .
وهو تصور يفيد – فيما نظن – في اكتشاف الفراغات التى ما زالت بحاجة إلى جهد تنظيري، وفي عقد المقارنات مع الأنظمة الوضعية، وفي إعداد التقنينات الإسلامية التى تزداد الحاجة إليها .
سادسًا : سمات الكتابات المعاصرة
في النظريات
اتجهت معظم هذه الدراسات – والتى تمت في إطار أطروحات جامعية للحصول على درجة الدكتوراه – اتجاهًا يتسم بسمات واضحة يمكن تلخيصها في: التحديث، والمقارنة، والتنظير، والتطوير:
1- التحديث: باختيار موضوعات من واقع الحياة المعاصرة والمشاكل التى يواجهها المسلمون، ومحاولة معرفة وجهة نظر الإسلام فيها، وإذا كانت نتيجة هذه الأبحاث لا تصل إلى درجة الاجتهاد من جانب هؤلاء الباحثين لقصور استعدادهم عن أداء هذا الدور، إلا أن جهودهم في البحث في التراث الإسلامي واستخراج ما يتعلق بموضوع بحثهم من بطون عشرات بل ومئات كتب التراث، قد أدى خدمة كبيرة في تيسير مادة التراث وتقريبها إلى غيرهم من الباحثين، ويشبه جهدهم في هذا المجــــال جهـد ابن نجيــم وغـيره في فن (الجمع) .
2- المقارنة : بعقد المقارنة في الموضوع محل البحث بين آراء علماء الإٍسلام بمختلف مدارسهم الفقهية، وبين النظريات الأخرى قديمها وحديثها في الموضوع نفسه، وقد ساعد استخدام منهج الدراسات المقارنة الباحثين في اكتشاف الكثير من الكنوز التى لم تكن تخطر على بالهم، لولا الحرص علىتوفية المقارنة حقها .
3- التنظير: بتحاشي طريقة التأليف التى اتبعت في معظم الكتب القديمة من جمع المسائل الفرعية، وتحديد النظرية التى تكمن وراء هذه المسائل، وذلك ببيان التعريفات والخصائص والشرائط والأركان والآثار، وغير ذلك من الأمور العامة التى تأتي المسائل الفرعية كأمثلة تطبيقية لها .
وقد نجحت معظم الدراسات في هذا الأمر بحيث أصبحت – من هذه الناحية – إضافات حقيقية في مجال النظريات الفقهية .
4- التطوير : لم يحظ اتجاه التطوير بمثل ما حظيت به اتجاهات التحديث والمقارنة والتنظير من اهتمام، ونقصد بالتطوير السير بالعلوم الشرعية إلى الوجهة التى كانت ستتجه إليها لو لم يقف الاجتهاد والإبداع الفكري عمومًا عند العلماء في القرون الأخيرة .
والمثال الوحيد الذي يحضرنا ممن سار في اتجاه التطوير بهذا المعنى هو محمد الطاهر بن عاشور في كتابه (مقاصد الشريعة) حيث حاول دفع الكتابة في علم مقاصد الشريعة خطوة بل خطوات بعدما وصلت إليه على يد العز بن عبد السلام والشاطبي .
أما في مجال القواعد فنجد أن الكتابات المعاصرة في الموضوع على قلتها لم تتقدم بالموضوع كثيرًا عما فعله الأقدمون، واقتصر جهد المعاصرين على شرح القواعد التى نصت عليها مجلة الأحكام العدلية، وذلك فيما عدا محاولة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء والأستاذ مصطفى أحمد الزرقا تصنيف القواعد بين أساسية وفرعية، وإضافة قواعد جديدة .
أما عملية الحصر والتصنيف الكاملين للقواعد، واستمداد نظريات عامة – من منطلق هذه القواعد – على مستوى الشريعة ككل ثم على مستوى كل قسم منها ثم كل باب من أبوابها، والذي نتصور أن اتجاه كتابات الأقدمين في القواعد كان يسير باتجاهها فلم يتعرض له أحد بعد فيما نعلم(1) .
سابعًا : نظرة مستقبلية
يتبين من الاستعراض السابق أن الدراسات المعاصرة تسير حثيثًا نحو بيان حكم الإسلام في كافة جوانب الحياة المعاصرة بيانًا مؤسسًا على نظريات خاصة بكل فرع من فروع المعرفة التى تهتم بهذه الجوانب .
أ – المسح:
على أن الواضح كذلك أن هذه الدراسات لا تسير بالسرعة والشمول والعمق نفسه في كافة الجوانب، إذ حظي بعضها بعناية واضحة مثل المعاملات المالية والأحوال الشخصية، بينما لم يلق البعض الآخر الاهتمام اللازم، وذلك مثل العلوم السياسية والإعلامية والفنون وغيرها .
ولا يتسع المجال هنا لبيان تفصيلي بالثغرات والنواقص التى ما زالت بحاجة إلى من يتجه لدراستها ، فإن هذا العمل نفسه هو من جملة الأعمال التى ينبغي البدء بها وهو ما يسمى بمرحلة (المسح).
ب – التقييم
ومن الضروري هنا، كذلك أن نشير إلى أن سد هذه الثغرات والنواقص، قد يتم ظاهريًّا أو ماديًّا بعمل دراسات في كل منها، ولكن من الضروري أن يعكف بعض الخبراء على تقييم هذه الدراسات للاطمئنان إلى كفايتها بالمطلوب أو لبيان ما قد يحتاجه البعض منها من استكمال واستيفاء.
جـ – الأعمال المساعدة:
ومن أهم ما ينبغي الاهتمام به وإعطاؤه الأولوية ، هو الأعمال المساعدة لتيسير الدراسات المطلوب إنجازها .
من ذلك مثلاً تحقيق ونشر العديد من أمهات كتب التراث الرئيسية التى لم تر النور بعد .
وما يلزم من أعمال موسوعية ومعجمية وفهرسة، لتيسير رجوع المختصين في العلوم المعاصرة إلى كتب التراث.
وما أشرنا إليه من قبل في خصوص حصر القواعد وتصنيفها بصورة شاملة للانطلاق منها إلى وضع النظريات العامة على مستوى الشريعة ككل، وعلى مستوى كل قسم، وكل باب منها.
د – الكتاب الجامعي:
بعد اكتمال التأليف في كل فرع من فروع الفقه خاصة والمعرفة عامة، يتوج هذا العمل بتأليف الكتاب الجامعي في كل فرع ، الجامع للنظرية الخاصة به، مع الاهتمام ببيان مختلف الآراء المذهبية دون اقتصار على مذهب بعينه، ولا بأس بترجيح الباحث للرأى الذي ينتهى إليه مع بيان دليله في الترجيح ، ومع إجراء المقارنة اللازمة بين الرأى أو الآراء الإسلامية في الموضوع، ولآراء النظريات والمذاهب والاتجاهات الأخرى غير الإسلامية .
هـ ـ التقنين:
تأتى بعد ذلك – وليس قبله – مرحلة التقنين، وهي بدورها يستلزم إنجازها المرور بمراحل ثلاث:
1- دراسة واقع المسلمين في كل بلد للتعرف إلى حاجاتهم العلمية وإلى أعرافهم وعاداتهم ومشاكلهم، والتى قد تختلف من بلد لآخر ، وهنا نواجه مشكلة الاختيار بين بديلين:
أحدهما هو السعى إلى إصدار تشريعات موحدة لكافة البلاد الإسلامية.
والآخر هو الاكتفاء بوضع إطار توجيهي يمكن أن تختلف داخله التشريعات من بلد لآخر دون أن تخرج عنه .
وقد حاولت الدول العربية الاتجاه الأول – اتجاه توحيد التشريعات – في مجال الأحوال الشخصية والقوانين المدنية والتجارية والجزائية ، ولم تصل بعد إلى توحيد أي من هذه التشريعات.
أم الاتجاه الآخر فهو ما سارت عليه منظمة السوق الأوروبية ونجحت في التقريب بين تشريعاتها ، ضمن الأطر التوجيهية directives التى تصدرها الأجهزة المشتركة للمنظمة، مما أدى إلى نشوء ما يسمى بالقانون الأوربي، وهو في الحقيقة ليس قانونًا موحدًا، وإنما مجموعة ضابطة من الأطر التوجيهية في كل فرع، وتلتزم الدول بتعديل قوانينها، بما يتفق مع هذه الضوابط.
2- تأتى بعد ذلك – في كل بلد إسلامي – مرحلة اختيار الأحكام التى تأخذ بها – من بين العديد من البدائل المشروعة – ضمن إطار الضوابط المشار إليها.
3- وأخيرًا تأتى مرحلة الصياغة المنضبطة لهذه الأحكام في صورة مجموعات قانونية، تأخذ طريقها إلى الإصدار والنشر والتطبيق وفقًا لنظم كل بلد إسلامي(1) .
المبحث الرابع
العقلية المقاصدية للفرد والجماعة
لا تقتصر فائدة المقاصد على جانب الاجتهاد الفقهي، بل تمتد كذلك إلى جوانب أخرى عملية لعل من أهمها الجانب الفكري، سواء في محيط الأفراد أو الجماعة .
ونتناول بحث هذا الجانب في مطلبين:
أحدهما : يتعلق بالعقلية المقاصدية لدى الفرد .
والثاني : يتعلق بالعقلية المقاصدية لدى الجماعة .
المطلب الأول
العقلية المقاصدية (المجال الفكري)
أ – في تقديمه لكتاب أ . إسماعيل الحسني، كتب د. طه جابر العلواني(1) أنه لكي تأخذ الدراسات المقاصدية مداها المنهجي وتصبح جزءًا من المحددات المنهجية المعرفية، وتؤدى دورها في معالجة الأزمة الفكرية لابدّ من التركيز على (المقاصد الكلية) للرسالة الخاتمة والشريعة التى جاءت بها ، حيث إن (المقاصد الجزئية) والتفصيلية ستُبقى الفكر الإسلامي المقاصدي حبيس الدائرة الفقهية التقنينية التى مهما اتسعت فستبقى ضيقة، ومهما عممت فستبقى خاصة بتلك الدائرة، وبالتالي فإن النظر الجزئي لن يتأثر كثيرًا ولن يتخلى عن مواقعه في الفكر الإسلامي كله، لا الفقه الإسلامي وحده، إلا إذ حصل الوعي على (المقاصد الكلية) وأمكن التعامل معها باعتبارها محددات منهاجية تضبط مع بقية حلقات المنهج الحركة الفكرية والمعرفية الإسلامية، وتتحول إلى جزء من نظام منطقى إسلامي يضبط حركة الفكر الإسلامي كله لا الفقه الإسلامي وحده ويعصمها من الوقوع في الخطأ أو الانحراف .
ب – وفي هذا المعنى كتب أ. عمر عبيد حسنة في تقديمه لكتاب الاجتهاد المقاصدي أن اقتصار الاجتهاد المقاصدي على المجال الفقهي التشريعي فقط، واحتجابه في هذه الزاوية على أهميتها وامتدادها في عمق المجتمعات البشرية، يحمل الكثير من الخلل والمضاعفات، ويورث الكثير من التخلف والعجز، والحياة العبثية في المجالات المتعددة، والضلال عن تحديد الأهداف، ومن ثم انعدام المسئولية وغياب ذهنية المراجعة والنقد والتقويم .
ذلك أن الأصل في العقل المقاصدي أن يكشف الطاقات، فيضع لها الخطة والهندسة المناسبة، ويؤصل المنطلقات، ويحدد الأهداف المرحلية والاستراتيجية، ويضع البرامج، ويبتكر الوسائل، ويحدد المسئوليات ، ويبصر بمواطن القصور والخلل، ويكتشف أسباب التقصير، ويدفع للمراجعة والتقويم، واغتنام الطاقة والتقاط الفرص التاريخية، والإفادة من التجربة، ويكسب العقل القدرة على التحليل والتعليل، والاستنتاج والقياس، واستشراف المستقبل في ضوء رؤية الماضي، ويحمى من الإحباط والخلط بين الإمكانيات والأمنيات، وبمعنى آخر، إن بناء العقل المقاصدي الغائي ينعكس عطاؤه على جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية ، ويحقق الانسجام بين قوانين الكون ونوميس الطبيعة وسنن لله في الأنفس ، وامتلاك القدرة للتعرف على الأسباب الموصلة إلى النتائج ، وإمكانية المداخلة والتسخير المطلوب شرعًا(1) .
جـ ـ وقد بسط د. الريسوني(2) القول في هذا الموضوع فكتب :
(فائدة المقاصد لا تنحصر في الاجتهاد والمجتهدين ، بل يمكن تحصيلها لكل من تشبع بها أو تزود بنصيب منها، وتكون فائدته بقدر علمه وفهمه لمقاصد الشريعة، وبقدر اعتماده لها واعتماده عليها في فكره ونظره .
فالمقاصد بأسسها ومراميها، وبكلياتها مع جزئياتها، وبأقسامها ومراتبها، وبمسالكها ووسائلها، تشكل منهجًا متميزًا للفكر والنظر، والتحليل والتقويم، والاستنتاج والتركيب .
وإذا كان الفكر الإسلامي القديم – متمثلاً بالدرجة الأولى في علم الكلام، وما تولد عنه من تشبعات وتأثيرات – قد غفل عن المقاصد مضمونًا ومنهجًا ، فإن الفكر الإسلامي الحديث مدعو – حالاً واستقبالاً – للاستفادة من المقاصد، ومن المنهج المقاصدي، خاصة مع تزايد المؤلفات والدراسات التى تمهد هذا الطريق وتساعد على سلوكه .
1- وأول ما يستفيده الفكر والمفكرون من منهج المقاصد، هو أن يكون فكرًا قاصدًا، يحدد مقصوده، ويقدر جدوى مقصوده، قبل أن يفتح قضاياه ويدخل في معاركه . فتحديد المقصد، ومدى أولويته وملاءمته، ومدى جدواه ومشروعيته، هو الذي يحدد المضي أو عدمه ، وهو الذي يحدد ما يجب التركيز عليه وما لا يستحق ذلك…
2- وهذا يقودنا إلى ما توفره المقاصد والثقافة المقاصدية من عقلية ترتب أولوية للمصالح والمفاسد ولكافة الشئون. وهو ما يفتقده أكثر الناس وكثير من المفكرين والمنظرين، فتجدهم يدافعون – مثلاً – عن الاقتصاد والتنمية الاقتصادية ، ويخربون البشر والتنمية البشرية .
يحاربون ويحذرون من جنون البقر ، وينشرون ويشجعون جنون البشر .
وتجد آخرين يدافعون عن الحريات والحقوق الفردية، وينسون أو يدوسون حقوق الشعوب والمجتمعات .
أو يدافعون عن الأرزاق ويخربون الأخلاق .
وتجد آخرين يحاربون تلوث البحار والسهول ، ولا يبالون بتلوث العقيدة وتسمم العقول .
وتجد تقديسًا متزايدًا لحرمة الوطن والطين، وإهدارًا متعمدًا لحرمة العقيدة والدين ..
3- وكما أن الفكر المقاصدي فكر ترتيبـي، فهو أيضًا فكر تركيبـي، فالمقاصد العامة قامت على الاستقراء والتركيب، مثلما قامت على المفاضلة والترتيب. فالتعامل مع المقاصد وعلماء المقاصد ينشئ عقلية استقرائية وفكرًا تركيبيًّا ، يستقرئ الجزئيات ويربط بينها، ويركب بعضها مع بعض ليصل إلى الكليات . الاستقراء هو أرقى المناهج العلمية، والمعارف الاستقرائية الكلية هي أرقي المعارف وأقواها؛ لأنها تجمع بين معرفة الجزئيات ومعرفة الكليات، فالقضايا الاستقرائية تبدأ أولاً بالبحث الواسع الدقيق على صعيد الجزئيات، ثم تنتقل إلى الربط والتركيب لتصل في النهاية إلى الأحكام والحقائق الكلية، فهي تجمع العلم بالجزئيات ، والعلم بالكليات ، والعلم بالربط والتنسيق والتركيب . وهذه كلها هي أرقى صور العمل العلمي والعقل العلمي..
هذه النظرة المقاصدية أفضل ضمان للتوازن بين الثوابت والمتغيرات، بين المرونة والصلابة، وبين الليونة والصرامة..) .
المطلب الثاني
العقلية المقاصدية لدى الجماعة
(مجال السياسة الشرعية)
أولاً:
أ – كان الحسني واضحًا وحاسمًا إذ أكد على أن أبرز مجال يجب أن تتجه إليه الهمم من أجل تقعيده واستخلاص قوانينه وضوابطه هو مجال السياسة الشرعية الذي يتناول جملة من القضايا ذات الأهمية البالغة في حياة الدولة في المجتمع الإسلامي المعاصر(1) .
ب – وقد وضع العبيدي المسألة في إطار نظرية الإصلاح السياسي لدى الشاطبي الذي انتهى إلى أن السلطة السياسية ضرورة من ضرورات الدين، وأن تأسيس الدولة في الإسلام هو أحد مقاصد الشريعة، أي أن السياسة نابعة من الإسلام ذاته، وأن الحاكم ينبغي أن يسوس المسلمين بأحكام الدين ويقيم مصالحهم، وعلى الأمة صاحبة القوامة عليه أن تتكفل برزقه، وأن تراقبه وتحد من سلطته، إذا أراد الخروج عن حكم القانون إلى الحكم بهواه(1) …
جـ ـ ويدور كتاب عبد المجيد الصغير حول بيان كيف أن الاهتمام بالمقاصد الشرعية – كما كان الاهتمام بتقعيد علم أصول الفقه منذ البداية – كان بغرض ضبط السلطة السياسية بضوابط الشريعة، وما يتطلب ذلك من العناية بمقاصد الشريعة وبمركزية المصالح وخطورة الابتداع(2) ….
د- وتتطور الفكرة لدى ابن عاشور وتتبلور لدى شراحه في التأصيل السياسي للمصلحة المتمثلة في أن إقامة أمة قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال يستلزم من الهيئة الاجتماعية ممثلة في ولاة أمورها سن قوانين وإقامة جهاز تنفيذي يوكل إليه حمل الناس بالرغبة والرهبة على رعاية مصالح الأمة، وبذلك تؤدى الوظائف التى على الوازع السلطاني إنجازها وأولها تحقيق العدل. ومناط ذلك مقامان : مقام إثبات الحقوق ومقام إقامة الشريعة، ويليها ضبط أموال الأمة، ثم تحديد طرق تنصيب الخليفة الولايات ثم الدفاع عن حوزة الأمة، وأخيرًا تحديد الميادين التى تتجه إليها سياسة الحكومة(3) .
هـ ـ ويستطرد الحسنى في تحليل فكر ابن عاشور إلى الحديث عن الحاجة إلى الخبرة الواعية بحاجات الأمة فيكتب: (فكأني بابن عاشور يشير إلى ضرورة احترام مبدأ التخصص العلمي، وهو مبدأ فرضه تكاثر المعارف، وتعقد مجالات التنظيم المجتمعي خاصة في الوقت الحاضر. وكلها أمور بمقتضياتها المتنوعة تفرض على أهل النظر الشرعي ضرورة استيعاب حقائقها حتى يسهل عليهم تحقيق مناطاتها …) وهذا لايستلزم توافر شروط الاجتهاد .. بل يحتاج إلى العلم بمكونات الموضوع المبحوث فيه…
و- وهذا يقتضى احترام مبدأ التخصص العلمي .. وينقل الحسني وجهة نظر الخمليشي في أنه يتعذر اليوم إصدار تشريع حتى في المجالات التى تناولها بتفصيل الفقه الإسلامي دون الاستعانة بالمتخصصين في كثير من فروع المعرفة مثل القانونيين والاجتماعيين والسياسيين، وممثلي القطاعات والمؤسسات المهنية، وآخرين كثيرين إضافة إلى تخصصات العلوم التجريبية كالطب والهندسة وغيرهما، ولا يقتصر دور هؤلاء على الاجتهاد بتحقيق المناط، وإنما يساعدون كذلك حتى على تخـريج مناط الحكم أو تنقيحه(1) .
ثانيًا :
أ – نعود إلى مجال السياسة الشرعية، ذلك المجال المتسم أصلاً بالمرونة أكثر من مجال الفقه لقيامه على المصلحة أكثر من قيامه على النصوص، والذي تجمدت الكتابه فيه منذ كتب الأساتذه الكبار أبو يوسف والماوردي وابن سلام وغيرهم مؤلفاتهم التى كانت تغطى احتياجات عصرهم، والتى ما زالت للأسف الشديد في تصور الغالبية العظمى من الأساتذة المعاصرين تمثل المنظور الإسلامي في موضوعها لأيامنا هذه .. فما زلنا نقرأ لمن يعدد الخراج والجزية والعشور ضمن موارد الدولة، وما زلنا نقرأ لمن يتحدث عن وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، وعن ولاية التغلب كأنظمة إدارية وسياسية.
ب – وفي تصوري أن مجال السياسة الشرعية يحتاج في تطويره على أساس مقاصدي إلى مراعاة مستويين :
الأول : هو المستوى التنظيمي الذى يتم من خلال الدستور والقوانين واللوائح، وهنا يعامل معاملة باقي أبواب الفقه، وقد أدخلته بالفعل ضمن مخطط التجديد الفقهي، وهذا بمثابة العودة بالسياسة الشرعية إلى مظلة الفقه، كما كان الحال قبل أن يستقل علمًا بذاته(2).
الثاني : هو المستوى التنفيذي التطبيقي الذي يتم من خلال رسم السياسات والتخطيط والقرارات، وهنا يكون إدخال فكرة المقاصد جديدة لا على مستوى بلادنا العربية والإسلامية فحسب، بل في العالم أجمع .
وقد يبدو هذا القول مجافيًا للواقع الذي نراه من إحكام الدول المتقدمة لسياساتها ومخططاتها، والحقيقة أن هذه الدول اهتمت بجانب واحد من العملية التخطيطية، وأهملت جوانب أخرى. منها النظرة الكلية، والجوانب الروحية والخلقية والاجتماعية ، ونظام الأولويات، وغيرها .
وقد انتقلت عدوى هذا الإهمال – ضمن ما انتقل – إلى بلادنا العربية والإسلامية. فنجد بلادًا يشكو أهلها الحرمان من أبسط مقومات الحياة، وتثقل كاهلها الديون الداخلية والخارجية، تنفق عشرات بل مئات الملايين على المهرجانات الرياضية والفنية والإعلامية، والاحتفالات بالألفية الثالثة ما لو وضع فيما يستحقه وفقًا لترتيب الأولويات، ولتحقيق الضروري والحاجي قبل التحسيني لتغير وضعها الحقيقي – لا المظهري – ولو خطوة في الاتجاه الصحيح(1) .
ولكنها العدوى : فالعالم (المتقدم) ينفق مئات المليارات على إنتاج الأسلحة وينادي بالسلام، وينفق مئات المليارات على المخدرات ويتغنى بحقوق الإنسان .
جـ ـ الذي أريد الوصول إليه هو أننا أفرادًا وجماعات نفتقد العقلية التخطيطية، وبالتالي يغلب على أعمالنا العشوائية والتخبط، وينخفض بالتالى عائد جهودنا، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نحدد أفرادًا وجماعات رسالتنا في الحياة، ونحدد في ضوئها الأهداف البعيدة والقريبة أو الاستراتيجية الطويلة الأمد والتكتيكية القريبة الأمد، ونترجم هذه الأهداف إلى برامج عمل تنفيذية، وما يصاحب ذلك من عمليات تقييم ورقابة ومتابعة ، وأن نربط كل ذلك بمقاصد الشريعة .
وفي تصوري أن بإمكان المشتغلين بالتخطيط سواء على مستوى المؤسسات الخاصة أو الإدارات الحكومية أن يفيدوا في عملهم من تراثنا الثري في موضوع المقاصد : سواء في مجالات المقاصد العالية أو الكلية أو الخاصة، والمقاصد الأصلية والتبعية والمقاصد والوسائل، ونظام رتب الضروريات والحاجيات والتحسينيات ، ونظام الأولويات … إلى غير ذلك .
المبحث الخامس
مستقبل المقاصد
علم مستقل أم وسيط
أم تطوير للأصول؟
واكب الاهتمام المعاصر بمباحث مقاصد الشريعة التفكير في مستقبل هذه المباحث: فمن مناد باستقلال المقاصد بوصفه علمًا جديدًا، إلى مناد ببقائها علمًا وسيطًا بين الفقه وأصوله، إلى مناد باعتبارها تطويرًا في علم الأصول أو بعض مباحثه .
أ – كان ابن عاشور أول من دعا إلى تأسيس علم مستقل لمقاصد الشريعة، وإن سبقته إرهاصات ليست بهذا الوضوح: مثل بعــــــض عبارات للقرافي(1)وابن تيمية(2) وابن القيم(3) تشير إلى أهمية المقاصد أكثر مما تشير إلى استقلالها علمًا قائمًا بذاته، ومثل عمل الشاطبي في ( الموافقات والاعتصام) الذي كان يسعى من خلاله إلى التوصل إلى أصول قطعية للشريعة، دون أن يصرح باستقلال تلك الأصول عن علم أصول الفقه، بل اعتبرها هي أصول الفقه .
أما ابن عاشور، فبعد أن ناقش رغبة الشاطبي وغيره في جعل أصول الفقه قطعية قال : (فنحن إذا أردنا أصولاً قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نعيد تذويبها في بوتقة التدوين. ونعيرها بمعيار النظر والنقد، فننفى عنها الأجزاء الغريبة التى علقت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة ، ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية، ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه غير منزو تحت سرادق مقصدنا هذا من تدوين مقاصد الشريعة ، فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل علم مقاصد الشريعة . فينبغى أن نقول: أصول الفقه يجب أن تكون قطعية، أي من حق العلماء أن لا يدونوا في أصول الفقه إلا ما هو قطعي، إما بالضرورة أو بالنظر القوي . وهذه المسألة لم تزل معترك الأنظار. ومحاولة الانفصال فيها ملأت دروس المحققين لها في أختام الحديث في شهر رمضان)(1) .
وقد تناول المعاصرون من الباحثين في مقاصد الشريعة هذا الخيط، وساروا به أشواطًا تختلف من باحث إلى آخر .
ب – فالريسوني ختم كتابه بكل وضوح متسائلاً: ( وأخيرًا هل سيبفضي بنا التوسع في مباحث المقاصد إلى تحقيق ما دعا إليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من استخلاص مقاصد الدين وقطعياته ، وتسميتها باسم علم مقاصد الشريعة؟ أم أن المقاصد جزء لا ينبغي أن يتجزأ عن علم أصول الفقه، كما يرى عدد من الأصوليين المعاصرين؟
الحق أن السؤال لا يكون ذا أهمية كبيرة إذا اتفقنا على ضرورة التوسع الكبير والعناية الفائقة بمقاصد الشريعة. وبعد ذلك ، هل نسمى ذلك علمًا أم لا؟ المسألة هينة . ولعلّ ما صنعه الشيخ عبد الله دراز يعفينا من هذا التساؤل ولو إلى حين ، فهو يرى أن لاستنباط الأحكام ركنين: أحدهما علم لسان العرب، وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها، ومن هذين العلمين يتكون علم أصول الفقه .
فالمقاصد علم وركن في علم .. والعبرة بالمسميات لا بالأسماء، وبالمقاصد لا بالوسائل )(2) .
جـ ـ أما الحسني شارح ابن عاشور فقد سار خطوات في سبيل تأسيس علم مستقل، فدرس معنى المقاصد ومكونات علم مقاصد الشريعة ، هدفه وموضوعه ومنهجيته(3) … إلى آخر ما بحثه بالتفصيل، ولا أناقشه هنا لأني قصدت التوقف عند مسألة استقلال المقاصد كعلم قائم بذاته من حيث المبدأ فحسب؛ ولذلك يستوقفني رأى الحسني في هذه المسألة الذي سجله في أكثر من موضوع، والذي يتلخص في أنه إذا جاز الحديث في مقاصد الشريعة عن استقلاليتها عن علم الأصول، فلتكن استقلالية نسبية تقتضيها الضرورة المنهجية، وإلا فإن الاستدلال الفقهي الأصيل هو القــائم على مقاصد الشريعة(4) .
ويزيد الرأى وضوحًا بشرح التكاملية بين المقاصد وطرق الاستنباط (موضوع علم الأصول) بجعل علم الأصول علمًا مقاصديًّا بنفخ روح المقاصد الشرعية في علم الأصول ، مع التنبه إلى الاستقلالية النسبية بين علم الأصول وبين درس مقاصد الشريعة، سواء على مستوى المنهج، أو على مستوى الموضوع، أو على مستوى الهدف(1) …
د – وهنا تأتي منطقيًّا فكرة قد طرحها د. حسن الترابي في كتابه غير المنشور عن (تجديد الأصول الفقهية للإسلام) حيث يقول(2) : (بل إن المبادئ والقواعد والمفهومات الفقهية العامة يتنازعها النسب إلى الأصول والفروع، ولعل الأوفق أن نختط بين علم الأصول والفروع علمًا قائمًا بذاته، يختص بالمبادئ والمفهومات الفقهية العامة، ولاسيما أنها في فقهنا غزيرة متطورة جديرة بمعالجة مستقرة).
وفكرة العلوم الوسيطة – ومنها علما القواعد والمقاصد – سبق أن أشرت في كتابي (التنظير الفقهي) إلى أنها مهملة برغم أهميتها ودورها الذي لا ينكر في آليات الاستنباط .
هـ – نعود إلى أصل موضوع هذا المبحث فنكرر ما ذكرناه في مواضع أخرى من أهمية ارتباط المقاصد بأصول الفقه، وأن يتم تطويرهما في إطار واحد، وهو قريب من رأي الحسني الذي أشرنا إليه .
أما رأي ابن عاشور في تأسيس علم مستقل لمقاصد الشريعة وترك علم أصول الفقه على حاله، فأرى أنه ضار بكلا (العلمين) إذ يجمد الأصول على حالها ويحرمها من روح المقاصد، كما أنه يبعد المقاصد عن الدور الوظيفي الذي تقوم به حاليًا والذي ينبغي أن نحرص على تطويره .
(1) مرجع سابق 180.
(2) محمد باقر الصدر: اقتصادنا، بيروت، دار الفكر، ط6، 1974م، ص 358 ، السنن التاريخية، مرجع سابق 36 – 39 .
(3) اقتصادنا 364 – 384 .
(4) المرجع السابق 352 – 355 .
(1) المرجع السابق نفسه 354 ، باقر بري 190 .
(2) اقتصادنا 366 – 390 .
(3) سعيد رحيمان 194 .
(1) الفاروقي : أسلمة المعرفة، الكويت، دار البحوث العلمية، 1984م، ص 93 – 108 .
(1) المرجع السابق 62 – 91 .
(2) لنا اقتراح تفصيلي في هذا الصدد، نشر تحت عنوان (تجديد الفقه الإسلامي) ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد، نشر دار الفكر، دمشق 2000م .
(1) جمال عطية : التنظير الفقهي، 1987م، ص 185 – 187، ولا ينفى هذا بداية الاهتمام مؤخرًا بخدمة القواعد الفقهية، كما في كتاب القواعد الفقهية لعلى أحمد الندوى (1986م) والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقى بن أحمد البورنو (1994م) ونظرية التقعيد الفقهي لمحمد الروكي (1994م) ، وقواعد الفقه الإسلامي لمحمد الروكي (1998م) ، والقواعد الفقهية ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين (1998م) وكذلك الدراسة المستفيضة لبعض القواعد وبداية تكوين نظريات منها كما في سد الذرائع لمحمد هشام البرهاني (1985م) ، ونظرية التقريب والتغليب لأحمد الريسوني (1994م) وقاعدة اليقينى لا يزول بالشـــك ليعقوب عبد الوهاب الباحسين (1996م) .
(1) المرجع السابق 215 – 217 .
(1) الحسنى 6 .
(1) الاجتهاد المقاصدي 1/ 18، 19، انظر أيضًا 16 ، 17 .
(2) في كتابه من سلسلة كتاب الجيب (الفكر المقاصدي) 99 – 104 .
(1) الحسنى 407 .
(1) العبيدي 241 – 249 .
(2) عبد المجيد الصغير، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، بيروت، دار المنتخب العربي، 1994م، ص462،483.
(3) الحسني 296 – 298 ، 400 – 401 .
(1) المرجع السابق 405 – 406 .
(2) كتابي تجديد الفقه الإسلامي بالاشتراك مع د. وهبة الزحيلي، حواريات لقرن جديد، نشر دار الفكر، دمشق 2000م .
(1) أين الخطة القومية لتعميم مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية الحقيقية الجادة على جميع السكان؟ وأين الخطة القومية للقضاء على الأمية في سنتين أو ثلاث سنوات ؟
(1) قوله : ( أصول الشريعة قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه، والثاني قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه… بقى تفصيله لم يتحصل) الفروق 1/ 2 – 3 .
(2) قوله : (إن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجهها، ومعرفة الحكم والمعاني التى تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم) الحسنى 62 عن القياس لابن تيمية .
(3) إشارته إلى أن نصوص الشريعة شاملة للأحكام شمولاً قد يكتفى به عن الرأى والقياس، ابن القيم، إعلام الموقعين، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1968م، 1/ 350-355 ، 382 .
(1) ابن عاشور : مقاصد الشريعة 8 .
(2) الريسوني 315 .
(3) الحسنى 98 – 112، 113، 120، 128 ، 415 .
(4) المرجع السابق 433.
(1) المرجع السابق 437 – 440 .
(2) تجديد الأصول الفقهية للإسلام 26 .
(1) إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار الفكر ، دمشق ، 2001م.
(1) طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1995م ، 1/ 17 ، 18 .
(1) أي يبردان ويريحان.
(2) أي يعمل أمرًا على غير بصيرة .
(3) انظر أيضًا : د. أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي، منشورات الزمن، كتاب الجيب، المغرب، 1999م، ص 115 – 122 ، وحمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، بيروت، دار قتيبة، 1992م، ص 193 .
(1) أي الإسماعيلية .
(2) هو ابن الراوندي .
(3) أي يشير .
(4) المصراة من الإبل والغنم التى حبس لبنها في ضرعها لتباع كذلك يغتر به المشترى، وفيه حديث مسلم: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردّ معها صاعًا من طعام لا سمراء) .
(5) القلة بالضم جرة عظيمة تسع خمس مئة رطل وفيه : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسًا) .
(1) الأحكام للآمدى ، ط صبيح 3/ 286 – 288 ، وإسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995م، ص 50 .
(2) بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في أصول الفقه من المعهد الوطنى للتعليم العالي للعلوم الإسلامية – باتنة، الجزائر 1997م، غير منشور 302 .
(3) الموافقات 2/ 380 .
(4) المرجع السابق 2/ 385 ، والحسنى مرجع سابق 68، 391 – 395 .
(5) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، الشركة التونسية، 1978م ، ص110 – 115 .
(1) الفروق للقرافي، بيروت، عالم الكتب، 2/ 32 ، وابن عاشور، مرجع سابق، 116 – 119 ، 138 ، والحسنى مرجع سابق، 56، 371 – 373، 384 – 391 ، الريسونى ، مرجع سابق ، 105 – 109 .
(2) هذه النقطة والنقطتان التاليتان لها أوردهما د. الريسونى مع نقطة رابعة أجلنا بحثها إلى المبحث القادم، حيث ينطبق عليها وصف الاجتهاد المقاصدي أكثر من هذه النقاط الثلاث التى لا تعدو أن تكون آليات قديمة، وإن لم يسلط عليها الضوء بمثل ما أوضحها د. الريسوني . راجع : الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المؤسسة الجامعية، بيروت، 1992م، ص 294 – 312، أما اعتبار مقاصد المكلفين فخارج نطاق هذا البحث. انظر الريسوني (جيب) 110 – 114 .
(3) الموافقات 3/ 5 – 26 .
(4) ابن عبد البر، الانتقاء في تاريخ الثلاثة أئمة الفقهاء 149.
(1) في رأيي أن هذه المسائل الثلاث الأخيرة كان يمكن أن يفرد كل منها بعنوان خاص، وعدم اتباعها لمسألة اعتبار المآلات .
(2) الريسوني (جيب) 129- 134 .
(1) الحسنى 98 – 112 ، وعبد الجبار شرارة في مراجعته لكتاب الحسني: قضايا إٍسلامية ، العدد الرابع 473 – 475 .
(2) عقد العبيدي فصلاً عن المقاصد والاجتهاد (179 – 187) ضمن كتابه عن الشاطبي ومقاصد الشريعة، لكنه لم يتجاوز تقرير المبدأ إلى بيان آلياته .
(3) د. الريسوني 294 – 312 .
(1) راجع : حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، 1971م، ص 608 .
(1) أبو حامد الغزالي، المستصفى 1/ 257 ، 264 – 265 ، وحسان مرجع سابق، ص 424 – 465 ، ويدخل في هذا القسم ما هو ضروري قطعي كلي؛ إذ يعده الغزالي من الاستدلال المرسل. والغزالي، المنخول هامش 370 .
(2) المنخول 364 – 372 .
(1) ابن عاشور : حاشية التوضيح 2/ 85، والحسنى 301 .
(2) الحسنى 437 .
(3) ابن عاشور 108 ، 109 .
(1) مقاصد الشريعة في آثار الشيخ شمس الدين، سرمد الطائي ، في (قضايا إسلامية معاصرة) العددان 9، 10/ 225 – 242 خاصة 230 – 234 .
(2) الريسونى (جيب) 96 .
(3) 1996 / 1997م غير منشورة .
(1) الهندسة الوراثية 1.
(2) المصدر نفسه 2، 3 .
(3) المصدر نفسه 6، 7 .
(1) المصدر نفسه 176 .
(2) المصدر نفسه 177 .
(1) المصدر نفسه 192 – 200 .
(1) نظرية المقاصد والواقع ، في (قضايا إسلامية معاصرة) العدد 8/ 150 .
(2) محمد الطاهر الميساوي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (تحقيق ودراسة)، البصائر، 1998م، ص46 ، 47 .
(1) د. حسن الترابي : تجديد الأصول الفقهية للإسلام . مذكرة غير منشورة 98 – 102 .
(1) المصدر نفسه 176 .
(2) المصدر نفسه 177 .
(1) 2/ 61، 62 .
(1) التنظير الفقهي 9 – 14 .
(2) باقر بري : فقه النظرية عند الشهيد الصدر، (قضايا إسلامية معاصرة) ع 11 و 12 / 170 .
(1) سعيد رحيمان : منهج اكتشاف الملاك وأثره في تغير الأحكام ، مجلة (قضايا إسلامية معاصرة) العددان 9، 10 / 179 – 180 .
(1) محمد أبو زهرة : أصول الفقه 9، 10 .
(2) التنظير الفقهي 210 – 212 .
(1) الزرقا : المدخل الفقهي العام 1/ 250 ، 251 .
(1) الصدر: السنن التاريخية، دمشق، دار التعارف للمطبوعات، 1989م، ص34 – 38 .
(2) (قضايا إسلامية معاصرة) ع: 11، 12/ 177، 178 .
(1) سعيد رحيمان: منهج اكتشاف الملاك وأثره في تغير الأحكام، مجلة (قضايا إٍلامية معاصرة) ع : 9 و 10/ 190 – 194 .
(2) هذه الخطوة هي عملية تكشيف القرآن والسنة والتراث. انظر محمد المصري بالاشتراك مع جمال عطية وزينب عطية، دليل لتكشيف القرآن الكريم وعمل مكانز لأغراض التكشيف، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1989م، بحث غير منشور .