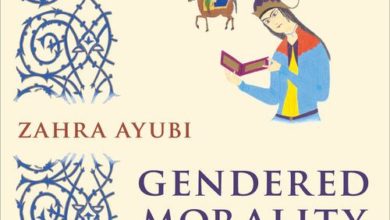تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، مقدمة في أصول الفقه السني. أ. د. وائل الحلاق
العدد 136
منذ ثمانينيات القرن العشرين والدكتور وائل حلاق(1) ينهض بمشروع أكاديمي يهدف إلى إعادة كتابة تاريخ الفقه الإسلامي أصولا وفروعا. وقد سطَّر في هذا المجال دراسات كثيرة توَّجها بثلاثة كتبٍ(2) هي خلاصة ما انتهى إليه مشروعه الفكري الذي يهدف أساسا – وكما يحدد المؤلف نفسه – “إلى زعزعة الخطاب الاستشراقي وتقويضه ومناهضته بمشروع أكاديمي منفصل بنيويا عن خطاب الهيمنة الغربي”(3)، ولكن هذا الهدف كما يؤكد المؤلف لا يمكن تحقيقه من خارج نطاق هذا الفكر الاستشراقي. إذ إنه قد نجح في تهميش جميع الانتقادات التي قدمها الكتَّاب العرب والمسلمون من خارج معاقل هذا الفكر تهميشا كاملا(4).
المقولات الاستشراقية:
يبحث هذا الكتاب في العلاقة بين الكتابات في أصول الفقه والواقع الفقهي، ويثبت بينها نقاط تماس وتشابكات بنيوية قد تجاهلها الخطاب الاستشراقي، وهو تجاهل يهدف إلى عزل الشريعة بأجمعها عن الواقع الاجتماعي، حاكماً عليها بالتهميش التاريخي. فقد ركز الخطاب الاستشراقي، على نحو أساسي، على علاقة أصول الفقه بعلم الكلام كأساسٍ لفهم منطلق أصول الفقه ووظائفه الدينية النظرية. مهمِّشاً بذلك علاقة أخرى لها بالغ الأهمية، ألا وهي العلاقة بين أصول الفقه والفقه من جهة، وبين الشريعة كمنهجية فكرية، والممارسات الشرعية في المجتمعات الإسلامية المختلفة عبر العصور من جهة أخرى.
يضاف إلى ذلك الأسطورة الاستشراقية القائلة بأن الشريعة قد توقفت عن النمو والعمل بعد القرن الثاني أو الثالث بعد الهجرة، وعُبِّر عن ذلك بمقولة أخرى تنص على أن باب الاجتهاد قد أغلق إلى أبد الآبدين. ومن ثمَّ فإن العالم الإسلامي لم يخرج من حال الانحدار والجمود إلا مع قدوم الحضارة الغربية بقوانينها ونظمها التشريعية التي فُرضت عليه.
أصول الفقه: مرحلة التكوين:
يذهب د. حلاق، خلافا لكثير من العلماء المعاصرين، إلى أن الفقه الإسلامي لم يبدأ مع مطلع القرن الثاني للهجرة، بل تعود بداياته إلى ما بعد منتصف القرن الأول عندما نُقلت عاصمة الإمبراطورية الإسلامية إلى دمشق، وخضعت أراض شاسعة للحكم الإسلامي.. فقد شهدت هذه الفترة ثورة في النشاط الفقهي الذي ساهم فيه العرب المسلمون ومعتنقو الإسلام من غير العرب، ولم يعد الاهتمام بالمسائل الفقهية محدودا بنخبة تمتعت بالحظوة لارتباطها بالنبي r أو بصحابته.
وقد لاحظ المؤلف في سياق تحليله لتطور المصادر التشريعية والمفاهيم الفقهية في هذه الفترة، التغيرات التدريجية التي طرأت على هذه المصادر والمفاهيم، بداية من الأعراف والممارسات الإدارية التي كانت سائدة في الولايات المختلفة وتأثّر بها الفقهاء، ثم حاولوا، مع تزايد الاعتماد على الأحاديث والمرويات، تثبيتها من خلال الأحاديث النبوية.
ومع ظهور حركة قوية هدفت إلى ترسيخ الفقه كاملا في النصوص الدينية الموثوق بها، تغيرت طبيعة التفكير الفقهي؛ وخضع مفهوما الرأي والاجتهاد، وأنواع الاجتهاد إلى تغير في البنية والمعنى؛ فمع حلول منتصف القرن الثاني أشار مصطلح الرأي إلى نوعين من التفكير: أولهما: الاجتهاد الإنساني الحر المستند إلى اعتبارات عملية وغير الملزم بنصٍ موثوق به، أما الثاني: فهو الاجتهاد الحر المستند إلى نص موثوق والمحفَّز من اعتبارات عملية. ومع تنامي الحركة الدينية في القرن الثاني تم التخلي تدريجيا عن النوع الأول لمصلحة الثاني الذي خضع بدوره لتغييرين مهمين: فمن جهة تمَّ ترقية إسناد النصوص الموثوق بها، التي تشكل قاعدة مثل هذا النوع من الاجتهاد والتي نسبت إلى مرتبة أدنى من مرتبة النبي r إلى مرتبة السنة النبوية. ويمثل مذهب الشافعي ذروة هذه العملية، ومن جهة أخرى تغيرت نوعية الاجتهاد لمصلحة طرائق أكثر صرامة ومنهجية، فقد جرى التخلي عن مصطلح الرأي واستبدلت به مصطلحات أخرى مثل الاجتهاد والقياس. وعلى هذا النحو تابع المؤلف حديثه عن نشأة مفهوم الإجماع والاستحسان وتطورهما.
الشافعي وبداية تأصيل الفقه:
منح العلم المعاصر الشافعيَّ امتياز مؤسس أصول الفقه. وأدى اعتبار الشافعي مؤسساً لأصول الفقه إلى الاعتقاد بأنه ما إن وضع نظريته حتى أبصرت أصول الفقه النورَ، وأن المؤلفين اللاحقين ساروا ببساطة على دربه. وبعبارة أخرى، ساد اعتقاد بوجود استمرارية غير منقطعة في تاريخ أصول الفقه بين رسالة الشافعي والكتابات اللاحقة حول الموضوع.
وقد أظهرت بحوث المؤلف أن هذه الاستمرارية لم توجد قط، وأن صورة الشافعي كمؤسس لأصول الفقه هي ابتكار متأخر. وأن أصول الفقه كما نعرفها الآن لم تبصر النور حتى أواخر القرن الثالث، الذي لم ينتج بحثا كاملا عن أصول الفقه، كما أن رسالة الشافعي نفسها لم تولد أي تعليق أو دحض لدى مؤلفي هذه الحقبة. ولكن رسالة الشافعي تمثل المحاولة الأولى لتجميع الجهد المنتظم للاجتهاد البشري، والاستيعاب الكامل للوحي كقاعدة الفقه الأساسية. ولكن التوفيقية التي روج لها الشافعي جاءت في وقت لم يرغب الكثيرون في اعتناقها، سواء من أهل الكلام الذين لم يقبلوا بفرضية أن الوحي هو الحكم الأول والأخير في الشؤون البشرية، ولا التقليديين الرافضين مبدأَ القياس الذي طرحه الشافعي.
تقعيد أصول الفقه ما بعد الشافعي:
إن أقدم حقبة لدينا عنها سجل حافل في أصول الفقه هي القرن الخامس للهجرة، فقد تم فيه طرح المشاكل الرئيسية للنظرية الفقهية، وتم تعبيد الطريق لتحليلات أكثر دقة. كما شهد نشر عدد مذهل من الأعمال الأصولية، هذا فضلا عن بروز ألمع وأبرع منظري أصول الفقه.
وخلافا لبنية الشافعي الأولية وغير المخطط لها تُظهر نظريات القرن الخامس وعياً عميقاً بالبنية. فقد فرض واقع استنباط الفقه من نصوص الوحي بطريقة مباشرة وغير مباشرة بنظر الأصوليين بنيةً خاصة تتجلى فيها المواضيع وترتبط بعضها ببعض. وقد لخص المؤلف هذه البنية في العناصر الأساسية التالية:
أ – نظرية المعرفة: والتمييز بين الظن واليقين.
ب – أصول التشريع وحجية القرآن والسنة.
ج – البحوث المتعلقة بتحديد القيمة المعرفية للنصوص وفقا لضعف نقلها أو قوته، وبحسب الوضوح المعنوي لمضامينها اللغوية: الظاهر، والمجمل، والعام، والخاص وغيرها.
د – الإجماع.
هـ – القياس وما يتصل به من الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب.
و – قضايا الاجتهاد والإفتاء والتقليد.
الثابت والمتغير في أصول الفقه:
يقوم الفصل الرابع على مناقشة العناصر الرئيسية أو الثوابت النظرية في عالم الممارسات الفقهية والاجتماعية، إضافة إلى الميول الثقافية التي أدت إلى ظهور التنوع والاختلاف أو المتغيرات النظرية ضمن إطار أصول الفقه.
يحدد المؤلف الثوابت النظرية لأصول الفقه السنِّي بأنها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. والخط الذي يميز بين الثوابت والمتغيرات هو “خط يفصل بين المصدر كمسلمة مقبولة على نطاق واسع أو مجموعة من المسلمات من طرق فهم هذا المصدر وتفسيره وإعادة تفسيره. وهذا الخط هو المعيار الذي يميز، على سبيل المثال، بين القبول بمبدأ القياس كطريقة شرعية والرفض الكلي لقياس الشبه” ص 172. وكما تفترض المتغيرات وجود الثوابت فإن الثوابت لا تكفي بحد ذاتها لتدلل على أصول الفقه بشكل كامل من دون المتغيرات. إن المتغيرات أشبه باللحم الذي يعطي شكلاً وحياة للهيكل العظمي للثوابت.
وقد لاحظ المؤلف المتغيرات النظرية على عدة مستويات:
أ – الموضوعات الأصولية من حيث المحتوى والترتيب: حيث تنوعت المصنفات الأصولية واختلفت في المواضيع والقضايا التي ينبغي إدراجها في أصول الفقه، وتلك التي ينبغي إقصاؤها، فضلا عن اختلافها في هيكلية العلم وترتيب أبوابه، فقلما اتبع أصوليان النمط نفسه من التصنيف.
ب – التقعيد النظري(5): تتبع المؤلف التطورات التنظيرية في أصول الفقه في مجالات المصلحة المرسلة والاستحسان الفقهي، والتطور الكبير الذي طرأ على مفهوم العلة(6)، كما لاحظ التأثير الذي تركته المؤلفات المنطقية على مصنفات المنظِّرين لأصول الفقه. وقد أشار إلى التقدم الذي أحرزه مفهوم الاستقراء في حقل الشريعة، بدءا من ظهور مبدأ التواتر المعنوي في الحديث النبوي في مطلع القرن الخامس، ثم تطوره دليلاً من أدلة الشريعة عند القرافي والشاطبي، وربطه بمفهوم المصالح المرسلة ودخوله عنصرا في التفكير والجدل الفقهي.
ج – تمازج المقدمات المنطقية والكلامية في أصول الفقه: بدأ التأثر المتبادل بين علم الكلام وأصول الفقه في مراحل مبكرة من تطور أصول الفقه، ثم ظهرت أبحاث عديدة تتعلق بالجدل الفقهي في منتصف القرن الرابع على يد القفال الشاشي، ثم كانت ذروة تطورها على يد الجويني في القرن الخامس في كتابه «الكافية في الجدل»، هذا الجدل الذي دخل كوسيلة إقناع في كتب الأصول، ثم ازدادت فقهيَّة تلك الممارسة في القرون اللاحقة. وتأخر دخول المنطق في أصول الفقه حتى القرن الخامس مع الغزالي (ومن قبله مع ابن حزم على استحياء)(7).
د – النمو التراكمي والتطورات اللاحقة: في هذا السياق يعرض المؤلف للمتغيرات الداخلية -خلافا للمتغيرات الخارجية القادمة من علم الكلام والمنطق- المنبثقة عن أصول الفقه نفسه. فمن أمثلة ذلك:
– الجدل حول وجود المجتهدين الذي ظهر في القرن السادس.
– التفريق بين المجتهد والمفتي: فحتى منتصف القرن الخامس كان المخوَّل بالإفتاء هو من وصل إلى رتبة الاجتهاد، ولكن بعد قرن من الزمن بدأت الآراء تظهر في جواز إفتاء من لم يبلغ درجة الاجتهاد. وابتداء من القرن السابع أصبح هذا الرأي مقبولا بصورة عامة. إن تغيُّر الخطاب المتعلق بمؤهلات المفتي يعكس التنازلات التي اضطرت النظريات الفقهية إليها من أجل التأقلم مع واقع الممارسة الشرعية القائمة، حيث أصبح المقلدون هم المتولون لأمر النظام الشرعي.
– نشأة الشروح والمختصرات وشروح الشروح: يؤكد د. حلاق على أهمية هذه النوع من التصانيف وأثرها البالغ في تطور النظرية الفقهية وأصول الفقه. هذه الشروح التي اعتبرها كثير من المسلمين المعاصرين والمستشرقين مبهمة وغير أصيلة ولا تستحق أن تُولى اهتماما. وقد درس المؤلف هذه الشروح وحصرها في خمسة أنواع، ولاحظ أن معظم هذه الشروح تعكس “درجة معينة من الإبداع والتجديد، تشبه تماما الإبداع والتجديد اللذين يظهرهما المؤلفون الذين تكتب الشروح حول أعمالهم. إذ تماما كهؤلاء المؤلفين، تعرَّض الشارحون في كتابة أعمالهم إلى تأثيرات أتت بها وقائع جديدة من الممارسة الشرعية فضلا عن البيئة الفكرية والتقاليد الثقافية التي نموا فيها. وباختصار، فإن ملخصاتهم ولاسيما شروحاتهم تشكل وسيطا لنمو الآراء والتغيير في أصول الفقه” ص 200.
وفي سياق الحديث عن أنواع التصانيف المستحدَثة تناول المؤلف «كتب الفروع» و«كتب الفتاوى»، هذه التصانيف التي أصبحت فيما بعد جزءا من منظومة الاجتهاد والفتوى والقضاء، وتداخلت من وجوه عديدة مع الممارسة الأصولية.
– النظريات المتطورة المتأخرة: وهي نظريات أحدثت تغييرات جوهرية في بنية النظرية الشرعية. وقد صاغ القرافي المالكي أولى تلك النظريات التي تدور بشكل أساسي على التفريق بين فتوى المفتي وحكم القاضي، وعليه فقد طالب بإعادة تفسير الأحاديث النبوية وتصنيفها وفق تحديد دقيق لوظائف النبي r التي كانت يؤديها في كل نوع من الأحاديث. والقرافي بهذا يولي أهمية خاصة للطريقة السياقية غير النصية في تفسير السنة، وهي طريقة تناقض كليا الموقف التفسيري الذي يتخذه جمهور الأصوليين السابقين، إذ يرون أنه ينبغي أن تفسر الأحاديث النبوية كوحدات مستقلة يحدد معناها النصُّ بحد ذاته ولا تخترقه، أو لا يُسمح بأن تخترقه عوامل خارجة عن النص.
أما النظرية الثانية فهي نظرية المصلحة للطوفي الحنبلي، وتتلخص في أن الشريعة أعطيت للمسلمين بهدف حماية مصالحهم، فلا تناقض بين المصلحة والقرآن والسنة والإجماع، غير أنه في حال ظهر تناقض، فينبغي أن تحل مقتضيات المصلحة محل المصادر الأخرى عبر التخصيص، وليس عبر استبعادها كلها.
أصول الفقه والواقع الاجتماعي:
يتناول المؤلف في الفصل الخامس من كتابه العلاقة بين أصول الفقه كخطاب نظري مجرد، والواقع الاجتماعي الديني الذي ساهم في إنتاج هذا الخطاب الفقهي النظري. في هذا السياق اقتصر المؤلف على دراسة الشاطبي كنموذج لهذا التفاعل بين النظرية والواقع(8)، ومما دفعه إلى اختصاص الشاطبي بالدرس هو تصحيح سوء الفهم الذي تعرض له الشاطبي من قبل العلماء المعاصرين، ولاسيما الإصلاحيين، الذي أساؤوا فهم دوافع نظرية الشاطبي وبالتالي جوهرها. وكذلك رغبته في إظهار أن كلا من هدف نظريته وطبيعتها خاطئان.
تكمن فرادة نظرية الشاطبي في أنه لاحظ عجز الفقه عن معالجة التغيير الاجتماعي الاقتصادي في القرن الثامن للهجرة في الأندلس؛ فحاول أن يستجيب للحاجات الخاصة بزمنه عبر إظهار كيف يمكن تكييف الشرع مع الظروف الاجتماعية الجديدة. ولكن الأسباب التي أدت إلى نظريته لم تنجم أبدا عن رغبة في إنشاء آلية نظرية تؤمِّن المرونة وإمكانية التكيف مع القانون الوضعي.
بل يشدد المؤلف على أن نظرية الشاطبي هدفت إلى إعادة قانون الإسلام الحقيقي؛ القانون الذي زيفته ممارستان متطرفتان في زمانه: مواقف المُفتين المتهاونة، والطلبات الفقهية المفرطة من غالبية المتصوفة المعاصرين له. بعبارة أخرى، إن الجانب الجدلي مع هذين التيارين كان العامل الأساس والمفسر لكثير من آراء الشاطبي وأفكاره، بل وحتى المواضيع التي تناولها داخل كتابه «الموافقات».
تحديات الحداثة: نحو أصول نظرية جديدة للفقه:
يقدم المؤلف في الفصل السادس من كتابه نظرة عامة عن التفكير المعاصر حول الأسس والمنهجية النظرية للشريعة، ويوضح بشكل خاص الصعوبات المنهجية التي واجهها المصلحون المعاصرون، والحلول التي قدموها لإعادة صياغة أصول الفقه.
مع إعادة صياغة القوانين والتشريعات في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، بدأ المصلحون باللجوء إلى آليَّة، لم تكن معتمدة ولا مقبولة من قبل، يمكن على ضوئها إعادة صياغة الشريعة عبر التخيُّر من مذاهب تقليدية مختلفة. وحتى الآراء المرجوحة في مذهب ما، قد تجددت واعتُمِدت بمشروعية توازي تلك التي تمتعت بها الآراء الراجحة.
ولكن آلية الاختيار والمزج هذه لم تكن تجد دعما في الآلية الشرعية المتناسقة، وكانت تعاني من خلل منهجي خطير يهدد تماسك الاجتهاد والنظام الشرعي برمته. لذلك انطلق منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر البحث عن منهجية شرعية ملائمة ومتسقة. وظهر في هذا السياق توجهان عرفا في العالم الإسلامي:
أ – المنفعيَّة الدينية: يصوغ أصحاب هذا التوجه نظريتهم الفقهية بناءً على المصلحة، وهي مبدأ قلَّ تطبيقه تقليديا، فوسَّعوه كثيرا كي يصبح المكون الرئيسي في النظرية الشرعية الجديدة. وقد اعتمد هؤلاء على مجموعة من المبادئ التي وضعها في الإسلام فقهاء متقدمون من القرون الوسطى، مثل القرافي والطوفي والشاطبي وغيرهم، ولكنهم – كما يوضح د. حلاق – يتشاطرون معهم هذه المبادئ أسميا فقط، لأنهم تلاعبوا بها وأعادوا صياغتها بحسب أغراضهم الخاصة.
وقد تعرض المؤلف لخطاب ثلة من أصحاب هذا الاتجاه بدءا من رشيد رضا، فعبد الوهاب خلاف، وعلال الفاسي، وحسن الترابي؛ كاشفا عن الخلل المنهجي الذي أحاط بتجارب هؤلاء المصلحين، وعن الضعف والتهافت الذي لازم الحلول التي قدموها لإعادة صياغة أصول الفقه؛ ومبرهنا على أنهم – فيما عدا الاعتراف الرمزي بمرجعية القرآن والسنة – قد تخلّوا عن معظم الخطوط العريضة لأصول الفقه التقليدية، مثل نظريات النسخ، والإجماع الذي أصبح يشير إلى الشورى التي تساعد الدولة في مسائل التشريع واعتماد السياسات. وكذلك مجموعة القواعد الأصولية التي تنظِّم القياس باعتباره قياس فرع على أصل، في حين تم التركيز عليه من جهة صلته بالاستصلاح. وهكذا أصبحت مفاهيم الحاجة والعوز المبررة بالمصلحة أهمَّ، وسُمح لها بأن تحلَّ محلَّ أوامر النصوص الدينية.
ب – التحرر الديني: يرفض أصحاب هذا الاتجاه المبادئ التي طورها الفقهاء التقليديون كلها، كما يرفضون نتائج الاستصلاح الذي مارسه المنفعيّون السابق ذكرهم، إذ إن مفهوم المصلحة مفهوم عشوائي لا يتسم بالصرامة المنهجية التي يجب أن تتوفر لقيام نظرية فقهية حديثة متماسكة. لذلك يسعون إلى تقديم نظرية فقهية جديدة تقوم على إعادة تفسير النصوص الشرعية وفق منهجية جديدة. ومن ممثلي هذا التيار محمد سعيد العشماوي وفضل الرحمن ومحمد شحرور.
وفي سياق المقارنة بين هاتين النـزعتين يشير د. حلاق إلى ظاهرة غريبة، وهي أن المتحررين الذين تم رفضهم قد قدموا منهجية متماسكة ومحترمة، ونظامَ تفكير أكثر التزاما بالإسلام، في حين أن المنفعيين لم يبدوا سوى اهتمام ضعيف للقيم القانونية الإسلامية، واقتصر عملهم على مفاهيم الفائدة والحاجة والعوز، وأصبحت النصوص المنـزَّلة في النهاية تابعة لهذه المفاهيم. أما منهجيات فضل الرحمن ومحمد شحرور فترفض أن تخضع لهذه المفاهيم وتستبدل بها أفكاراً منظَّمة لتحليل نصي/سياقي حيث يتم التركيز على القانون الإنساني، وهو موجَّه بشكل عام من قبل إرادة إلهية ولم يُملَ حرفيا ونصيا.
ولكن، إذا كانت ملاحظة المؤلف دقيقة ومهمة بخصوص فشل النـزعة المنفعية أو المصلحية في إرساء نظرية فقهية متماسكة أو بناء أصول فقه جديد، فإنه ليس محقا بخصوص أصحاب النـزعة الأخرى الذين وإن حاولوا تقديم منهجية لتحليل النص الديني وفقهه، إلا أننا لا يمكن أن نقرَّ بحال أنها منهجية متماسكة، أو متسقة، سواء من ناحية أسسها اللغوية والتأويلية، أو حتى من ناحية بنيتها الكلية وأسسها النظرية(9).
على أية حال، فلعل أهم ما يقدمه هذه الكتاب(10) هو الخروج على النزعة الأصالية في دراسة تاريخ المعارف الإسلامية، تلك النزعة التي تصب اهتمامها على القرون الأولى، أو ما يسمى عادة عصر التدوين، باعتبارها قمة ما وصلت إليه العلوم الإسلامية ومنتهاها، وتهمل القرون اللاحقة باعتبارها ليست أكثر من اجترار وتكرار لما سبق. فهو يقدم لنا رؤية مختلفة عما اعتدنا أن نسميه – بتأثير من المدارس الإصلاحية الحديثة – عصورَ التقليد والتخلف والركود؛ مبرزا دور النخبة العالمة فيها في تطوير كثير من المفاهيم الفقهية وتطويعها لتلائم المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي واجهتها. إن هذا الكتاب إسهام حقيقي في تصحيح كثير من التصورات الخاطئة عن تاريخ التأصيل النظري للفقه الإسلامي، أعني أصول الفقه، القديم منه والحديث.
* * *
السلطة المذهبية
التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي
تأليف : وائل حلاق
الناشر : دار المدار الإسلامي
سنة النشر : 2007
عدد الصفحات : 366
عرض: سامر رشواني
يتابع د. وائل الحلاق في كتابه هذا مشروعه الأكاديمي الهادف إلى إعادة كتابة تاريخ الفقه الإسلامي أصولاً وفروعاً. ويقدم فيه حفراً تاريخيا عن الثابت والمتحول في الشريعة، وعن تشكل السلطة المرجعية للمذهب، ودور التقليد في بناء تلك السلطة المذهبيَّة. كما يقدم فهما جديدا للاجتهاد والتقليد باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، وأن التقليد ليس إلا امتداداً طبيعياً للاجتهاد؛ فالأول لا يبدأ عند انتهاء الثاني ولا ينتهي الثاني بابتداء الأول، وإنما يندمجان ويتساوقان في نفس الفقيه والمفتي في آنٍ معاً؛ وذلك سعياً منه للبرهنة على أن الشريعة كانت نظريا وعمليا صالحة لمختلف الأزمنة وقادرة على التغيُّر دون الذوبان أو التلاشي، وإثباتاً لخرافيَّة المزاعم الاستشراقية حول جمود الشريعة الإسلامية وخمولها وانتهائها إلى الانسداد التام، أو ما اصطلح على تسميته بالعبارة الخلدونية «انسداد باب الاجتهاد».
الترسيم التراثي لمراتب السلطة المذهبية:
يشرع المؤلف دراسته بعرض التوصيف التراثي لطبقات الفقهاء(11) بما هي تقسيم معرفي وتاريخي للمراتب والوظائف الفقهية، تتحدد من خلالها السلطة المذهبية ومراتبها ونماذجها ومسالك توارثها، والنشاط المعرفي والتأويلي المرتبط بكل نموذج وطبقة.
تحدد أدبيات «طبقات الفقهاء» أنماط النشاط الفقهي في خمسة أنماط: الاجتهاد، والتخريج والترجيح والتقليد والتصنيف. كما تحدد الوظائف الفقهية الأساسية: المجتهد والمقلد والمفتي والفقيه/المصنِّف. وهي وظائف متداخلة في الجملة: فالمقلد يمكن أن يكون مفتيا ومجتهدا ولكنه ليس بذي ثقل، وبوسع المفتي أن يكون مقلدا ومصنِّفا ومجتهدا، وباستثناء إمام المذهب – نظرياً فقط كما سينتهي المؤلف – فإنه لا يمكن أن يكون مقلِّدا بل مجتهدا مطلقا ومفتيا فقط. وحول أنماط النشاط الفقهي والوظائف الفقهية آنفة الذكر تقوم هذه الدراسة الحفرية.
أسطورة المجتهد المطلق وتأسيس سلطة الإمام
تتفق أدبيات «الطبقات» الفقهية على جعل الاجتهاد المطلق أولَّ حلقات الاجتهاد الفقهي، والمجتهد المطلق بحكم معرفته الشرعية الواسعة بالقرآن والسنة والناسخ والمنسوخ وأصول الفقه – التي يفترض أنها من إبداعه الخاص – يصبح مؤسِّسا لمذهب يُسمَّى باسمه، وينسب إليه إنشاؤه. والسمة المميزة لهذا المؤسِّس المجتهد هي اتصاله المباشر مع نصوص الوحي، وقدرته على الاستنباط المباشر منها وفق منهجية عقلية متماسكة لا يمكن أن يصوغها سواه.
تمنح كتب الطبقات المجتهد المؤسِّس سلطة مرجعية معرفية وأخلاقية – من خلال أدب مناقب الفقهاء – مطلقةً تقطع تاريخيا مع كل ما تقدم عليها، مغفِلةً دَينه لأسلافه من الفقهاء والمجتهدين، ومهملة تاريخه العلمي المباشر. ويرى المؤلف أن قطع صلة الفقهاء المؤسسين بآبائهم وماضيهم لم يكن سوى وسيلة من وسائل كثيرة لبناء سلطتهم المرجعية والمذهبية، ولزيادة مآثرهم وإنجازاتهم. ويحاول أن يثبت أن هؤلاء المؤسسين لم يكونوا قط مجتهدين مطلقين – بمعنى أنهم قد اجتهدوا واستنبطوا في كل المسائل التي عرضوا لها من غير ما اتباعٍ أو تقليدٍ لسابقيهم – كما يثبت أن كثيرا من الآراء التي حملوها كانت متوارثة عن سلطات مرجعية أخرى. بعبارة أخرى، إن من أصبحوا مؤسسي المذاهب الفقهية لم يكونوا كذلك في زمنهم، لا وِفق تصورهم ولا تصور معاصريهم.
لقد تأسست عملية بناء المرجعية على أمرين أساسيين: نفي التقليد عند إمام المذهب، ونسبة آراء إليه نشأت لاحقا إلى مذهبه، واعتبارها من قوله.
فعلى الرغم من أن بعض فقهاء الحنفية يقرُّ بأن أبا حنيفة مدين لعدد من أسلافه، بدءا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلقمة وإبراهيم النخعي وحماد؛ إلا أن هذا الدَين والآراء الشرعية التي يمثلها لم يكن يحمل أي سلطة مرجعية، فأيٌ من هذه المراجع التي استقى منها أبو حنيفة آراءه لم يدخل في مدار المذهب الرسمي. ففي حين ينسِب أبو يوسف – أحد التلميذين المقربين لأبي حنيفة – إليه الأخذ برأي إبراهيم النخعي في مسألة ضريبة العشر للأراضي المزروعة، مثلا، فإن السرخسي – الفقيه المتأخر – يبدد هذا الدَين للنخعي ويبرز أبا حنيفة بوصفه مفسر الوحي الأول والمباشر بامتياز، وهذا تجلٍ واضح لعملية إعادة بناء المرجعية المتأخر، (ص 64-65).
ولكن لماذا أصبح أبو حنيفة – وليس النخعي أو حماد أو حتى أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني هو من يُنسب إليه تأسيس المذهب، ويحتل مكانة المجتهد المطلق ؟
سؤالٌ بالغ الأهمية يطرحه المؤلف نفسه ويعترف بصعوبة الإجابة عنه، ويعزو هذه الصعوبة إلى نقص في التفاصيل؛ ولكنه يوضِّح أن المسألة ذات صلة ببروزِ مفهوم المرجعية في الشريعة (في ظل ابتعاد الدولة العباسية عن مجال الشريعة)(12) وتحقيقِ هؤلاء الفقهاء للمتطلبات(13) التي فرضتها فكرة المرجعية الشرعية. هكذا تمَّ تأسيس مرجعية أئمة المذاهب الفقهية بطريقة ارتجاعية.
هذه العملية التي استلزمت، إضافة إلى ما سبق، زيادة مرجعية المؤسسين المفترضين عن طريق إسنادهم بمبادئ ربما لم يقولوا بها أبدا من خلال مبدأ «التخريج». قام بذلك ، مثلاً، الفقيه الشافعي ابن سريج (306هـ) إذ خرَّج كثيرا من آراء الحنفية على طريقة الشافعي ومذهبه، حتى نُظِر إلى تخريجات ابن سريج بعدُ على أنها آراء رسمية للشافعي. وعلى ذات النهج جرى تلميذه ابن القاص (335هـ) الذي يعترف في كتابه «أدب القاضي» باعتماده تعاليم الشافعي وأبي حنيفة، ولكنه ومن خلال التخريج حصد ثمارا كثيرة تعهَّدها فقهاء الحنفية وغيرهم، ثم اعتبرها هو وخلفاؤه من أصل شافعي.
لقد أصبح التخريج في البنية المذهبية الرسمية للمذاهب الأربعة ثانيَ أهمِّ مواضيع البحث الشرعي بعد التعاليم الفعلية لرموز المذهب، وإن كان الفصل بين آراء الإمام والآراء التي خرَّجها على مذهبه تلاميذه متعذرا في أحيان كثيرة. وقد أدرك بعض الفقهاء – مثل أبي إسحاق الشيرازي والطوفي- خطورةَ هذا الاختلاط ورفضوا أن يُنسب إلى إمام المذهب ما خرَّجه أحد أصحابه على قوله.
اختزال التعددية وتمكُّن المذهبيَّة – المرجعية الفقهية:
إن أحد الدلالات المهمة لما سبق ذكره أن المذاهب التي نُسبت إلى الأئمة لم تعتمد على مواهبهم كمجتهدين مطلقين، أو كمجتهدين مقيَّدين، فقد كان هناك فقهاء كثر مثلهم خلال فترة تَشكُل الفقه من نهاية القرن الأول وحتى منتصف القرن الرابع، وهؤلاء جميعا تلقَّوا الفقه عن أسلافهم، وأعادوا صياغته ونقله إلى تلاميذهم. والمقصود أن مساهمات هؤلاء الفقهاء لم يكن لها دور في تحويل بعضهم إلى مؤسسي مذاهب، بقدر ما ساهمت «القوى التاريخية» – كما يسميها المؤلف على نحو غامض – في انتخاب بعضهم.
إن هذه الانتقائية التاريخية (العشوائية)(14) توضح سبب بروز ابن حنبل كإمام ومؤسس مذهب، بينما لم يبرز المزني الفقيه الأكثر إبداعا وبراعة بكثير. ومثل المزني عديد من المجتهدين الأوائل الذين كانت إنجازاتهم أرفع منزلة من إنجازات بعض أئمة المذاهب، ولكنهم لم يحظوا بالاعتراف نفسه. نذكر منهم: أبو ثور (240هـ) ومحمد بن جرير الطبري (310هـ) وابن خزيمة النيسابوري (311هـ) ومحمد بن نصر المروزي (318هـ) ومحمد بن المنذر النيسابوري (318هـ). هؤلاء جميعا وغيرهم اعتبرهم البعض مجتهدين مستقلين، ولكن نُظر إلى أرائهم لاحقا على أنها تفردات عن أحد المذاهب، وجُنِّدت لدعم هذه المذاهب.
لقد أصبحت تعددية الاجتهاد المطلق مقيَّدة بصورة مطَّردة مع بداية القرن الرابع كما تدل على ذلك كتب السير، إذ بدأ المذهب يتبلور بوصفه طائفة، وكانت كلمة «مذهب» تدل على الانتساب الشخصي لإمام ما ، ولم تصبح هذه الكلمة دالَّة على المذهب النظري للإمام إلا في أواخر القرن السادس. وما بين هاتين الفترتين نشأت المرجعية المذهبية وتمكَّنت، وأصبح «المذهب» ذا بنية رسمية معترف بها.
التقليد: اجتهادٌ في التأويل والتقعيد:
قديما كان يصح إطلاق التقليد على أطياف واسعة من النشاط الفقهي، ولكن بعد تأسس المذاهب، أصبحنا أمام معنيين رئيسين: الأول هو الولاء لمذهب شرعي؛ ولكن مع علم المجتهد الكامل بالوسائل التي تم عن طريقها استنباط هذا المذهب، والثاني: هو هذا الولاء عينه ولكن من غير ما علمٍ بعلله أو طرق استنباطه. وبعبارة المؤلف فإن آليات التقليد قد تتاخم حدود النشاط الفقهي المقترن بالاجتهاد، كما أنها قد لا تعدو في أحيان أخرى إعادة إنتاج تعاليم الأسلاف. وفيما بين هذين الحدَّين كان التقليد يمثل وظيفة فقهية ويمليه هدف ما.
في هذا السياق يفصِّل د. حلاق القول في مستويات التقليد وتخومه المتباعدة؛ فيعرض لآليات المقارنة والترجيح بين الآراء داخل المذهب، من خلال القواعد الرسمية التي هيمنت على المذهب. هذه القواعد (أصول المذهب) التي أصبحت العمود الفقري للتقليد، من حيث عنايته بتطبيقها على المسائل الفردية، وإن لم يشغل أغلبية الفقهاء أنفسهم بالطريقة التي استنبطت بها تلك القواعد. ولكن في مستوىً آخر من التقليد، لا يكتفي الفقيه بمجرد التطبيق الذكي للقواعد، ولكنه يقتفي أثر الشواهد والتأويلات التي استخدمها إمام المذهب ويعيد إنتاجها وتحسينها؛ ومع ذلك فإنه لا يوصف بالاجتهاد، لأن فعله ليس فعل استنباط مستقل، بل يبقى ممثلا لأعلى درجات التقليد، أو ما اصطلح على تسميته بالاتباع.
وفي حين اتصف عمل الفقهاء المؤسسين للمذهب بميل قوي، حصري، نحو الإفتاء، أي بوضع حلول للمسائل الفردية المتناثرة، فإن المقلدين قد بدؤوا إعادة ترتيب أمثلة الإفتاء هذه ترتيبا منهجيا ضمن مجموعات من القواعد العامة التي حكمت القضايا الكبرى التي يشملها كل باب من أبواب الشرع. ولا تتوقف انجازات التقليد عند هذا الحد، إذ برزت تطورات أخرى مهمة عقب ظهور أسلوب التفسير التعميمي للمسائل الفردية، وتمثَّل في ظهور كتب القواعد الفقهية و«الأشباه والنظائر»، وذلك بعد القرن الخامس. وهي أنواع جديدة من الخطاب الشرعي تجسِّد بناء منهجيا لقواعد عامة أعلى مقاماً استنبطت من مصادر شتى، كالمسائل الفردية والقواعد العامة الأدنى رتبة.
في هذا السياق يؤكد د. حلاق “أن التقليد بعيد عن الانصياع الأعمى لسلطة مرجع بعينه، كما يزعم عدد من المستشرقين الكبار، صحيح أنه كان هناك دائما فقهاء في الدرجة الدنيا من درجات المهنة الذين اتبعوا المرجع الشرعي ميكانيكيا، أو ربما بصورة بليدة. لكن أداءهم الفقهي لا يمثل أكثر من شكل واحد أو مستوى واحد من مستويات التقليد والنشاط الذي امتد ليطال طيفا واسعا” ص(177-178).
التقليد وتراتبية المرجعية المذهبية:
إذا كانت فكرة المرجعية قد ظهرت لتضع حدا للتعددية التي كانت سائدة فيما سُمّي عصر الاجتهاد المطلق، من خلال التأسيس لفكرة المذهب ومرجعية الإمام المؤسس، فإن التعددية على مستوى المذهب الواحد لم يُجدِ شيء في القضاء عليها أو تحجيمها. فقد أصبحت لكل مذهب مجموعة ضخمة من الآراء المنسوبة إلى المؤسس وأتباعه المباشرين وتلاميذهم اللاحقين.
لقد أصبحت التعددية الاجتهادية عنصرا معرفيا وجزءا لا يتجزأ من البنية الكلية للشريعة، ولم يكن بالإمكان كبحها حتى بعد التطور النهائي للمذهب. وبحسب المؤلف بقيت التعددية سمةً أثبتت أنها غير قابلة للترويض نهائياً؛ حتى تمَّ اجتثاث جذورها خلال القرن التاسع عشر بعد أن ظهرت القوانين الحديثة، ودُمرت بنية النظام الشرعي التقليدي تماما.
ولكن هذه التعددية الشرعية لم يكن لها أن تُطلَق بلا حدٍّ حتى داخل المذهب الواحد، لأن اللايقينية المذهبية ضارة من جهة التطبيق، لاسيما بالنسبة للقاضي والمفتي. وقد شغلت هذه المعضلة جمعا غفيرا من الفقهاء: فأيُّ رأي هو الأكثر رسمية وجدارة بالثقة ؟
إن النظام نفسه الذي أنتج التعددية الشرعية وحافظ عليها أنتج أيضا وسائل التعامل مع صعوباتها، وذلك من خلال النقاش المؤيِّد لتلك الآراء التي اعتبرت ذات هيمنة مرجعية، وإن كان تحديد هذه الآراء لم يزل مثار جدل. ولكن هناك اعتبارات ثلاثة حظيت بالأولوية: أولها الصياغة اللفظية والقدرة على الإقناع التي تختزنها الحجج والبراهين الداعمة للرأي، وثانيا: درجة نجاح الرأي في جذب جماعة الفقهاء. والاعتباران من حيث الجوهر غير منفصلين. والاعتبار الثالث مرتبط بتقدير درجة تطبيق هذا الرأي في مجال الممارسة الفقهية.
إن هذا الجدل داخل المذهب ظهر من خلال جملة من «المصطلحات المرجعية الإجرائية» – كما يسميها المؤلف – أُريد من خلالها تقليص التعددية إلى الحد الأدنى. وقد فصَّل المؤلف القول في هذه المصطلحات من حيث دلالاتها واستخداماتها وأسس المفاضلة فيها ودرجات تواترها وأهميتها في المصنفات الفقهية. فقد تجلّت المعايير الثلاثة، الآنف ذكرها، في مصطلحات ثلاثة أساسية: الترجيح (الراجح)، التصحيح (وله درجات: الصحيح والأصح)، التشهير (المشهور)؛ كما ظهرت مصطلحات أكثر تفصيلية، من مثل: ظاهر، أوجه، أشبه، صواب، مذهب، يُفتى به، معمول به، مختار.
ولكن هذه المصطلحات لم تكن دوما واضحة ومتفقا عليها بين فقهاء المذهب الواحد، ويعزو المؤلف غموض هذه المصطلحات إلى غموض الأحكام الشرعية. كما يرى أن تعدد مستويات استخدام هذه المصطلحات قد جعل من المفاضلة المرجعية ونتاجها أداءً ذاتيا محضا. بل إنه ينتهي إلى أن الفقهاء قد أخفقوا في التوصل إلى معايير موضوعية لاختصار الخلاف الفقهي، ويرى في هذا الفشل رحمةً للأمة من جهة، من حيث أنه سمح للشريعة بمواكبة التغيير الفقهي.
وفي واقع الأمر، فإن المصطلحات الإجرائية التي ولدت في خدمة التقليد أصبحت في الوقت نفسه أداة للتغير في الشرع. بمعنى آخر، إن هذه المصطلحات بوصفها إحدى طرائق عمل التقليد، قد عملت أيضا كأداة لإضفاء الصفة الشرعية والرسمية على التطورات الجديدة في الشريعة. لذا لن يكون مستغرباً، كما يوضح المؤلف، أن يعمل التقليد بوصفه أداة للتغير الشرعي تماما كما يفعل الاجتهاد، إن لم يكن أكثر؛ وذلك لأن الاجتهاد يعني إدخال آراء جديدة تفتقر غالبا لعلاقة التعايش الحميمة مع التقاليد السائدة. ولكن بواسطة المصطلحات الإجرائية، وبالتالي من خلال التقليد، فإن الآراء المعروفة التي اعتبرت سابقا ضعيفة، أو أقلَّ مرجعيةً، تحصل على فرصة أفضل للوصول إلى مكانة مرجعية وتتقدم لمواقع أفضل في السلسلة الهرمية لآراء المذهب.
التغيير الفقهي ودور المفتى والفقيه المصنف:
لقد كان لدى الفقهاء المسلمين وعيٌ دقيق بحدوث التغيير القانوني وبالحاجة إليه، وعبروا عن هذا الوعي بمقولاتٍ من مثل قولهم: «لا يُنكَر تغير الأحكام بتغير الأزمان». وكانت عملية التغيير الفقهي منوطة بشكل أساسي بالمفتي والفقيه /المصنف، على خلاف الوظائف أو الأدوار الشرعية الأخرى كالقاضي أو الأستاذ، مع ملاحظة تداخل هذه الوظائف في الواقع. فمن طبيعة عمل المفتي أن يبتكر قواعد فقهية قابلة للتطبيق العام؛ فآراؤه معنية بتقديم تشريع ملائم يجري توثيقه في الكتيبات الفقهية بنوعيها الجامع للفتاوى أو النصوص التفسيرية، وتضم هذه الأخيرة إضافة إلى الفتاوى كلاًّ من المذهب المرجعي التقليدي والأعراف السائدة في حينه، ويحظى كلا النوعين من النصوص بمكانة مذهبية مرجعية في المذاهب.
لقد حظيت النصوص التي وضعها المفتي والفقيه المصنف بمرجعية عالية؛ فمنها كان الفقهاء المعاصرون واللاحقون بكل مراتبهم، كتَّاباً بالعدل أو قضاة أو مفتين أو فقهاء مصنفين يستمدون أحكاما معيارية تعتبر بمثابة مذهب نموذجي. هكذا، فإن دور هذه النصوص لم يكن مقتصرا على إدامة التقليد، بل كانت تستخدم وسيلة لإضفاء الطابع الشرعي على التغيير الفقهي. ويتجلى ذلك بوضوح في الاستبدال المستمر للحالات والآراء الذي نلحظه في الكتب الفقهية الأمر الذي يعكس مرونة المذهب وقابليته الواضحة للتكيف.
يعد دور المفتى مركزيا في ابتكار التغيير الشرعي، بينما يعد دور الفقيه المصنِّف ذا أهمية خاصة في فرز الفتاوى التي ينبغي تضمينها في نصوصه عن تلك التي لا ينبغي تدوينها، هذا التصنيف الرسمي يشكل من جهة وسيلة للتدقيق في درجة مساهمة المفتى في النص الشرعي، ومن جهة أخرى يصادق على الفتاوى المدمجة، بغض النظر عن كون الرأي المقدَّم فيها قد نال موافقة الفقيه المصنِّف أم لا.
وقد فصَّل د. حلاق القولَ في أنواع كتب الفتاوى بين كتب الفتاوى الأوَّلية غير المحقَّقة، وبين كتب الفتاوى المعدلة التي خضعت لدرجات مختلفة من التحقيق، أُطلق عليها التجريد والتلخيص والتنقيح. كما بيَّن أنواع الفتاوى التي تمَّ استيعابها في كتب الفروع، ولاحظ أن الهم الأبرز لدى مصنفي هذه الكتب كان استيعابَ المسائل الفقهية التي تعتبر ضرورية وذات صلة بالعصر الذي تمَّت فيه الكتابة، لاسيما إذا كانت مما تعمُّ به البلوى من القضايا والمسائل. كما لاحظ أن كثيرا من الفقهاء اعتمد مبدأ وجوب إحلال رأي أحدث محل رأي أقدم زمناً، في حين أن بعض الفقهاء لم يُعنَ سوى بالفتاوى التي تضيف مادة جديدة للمذاهب الشرعية.
ولكن ألم يكن للفقيه المصنِّف دور ما في التغيير الفقهي بعيدا عن مجال الفتاوى واستيعابها للمتغيرات؟ يحاول المؤلف أن يثبت من خلال عدد من النماذج أن الفقيه المصنِّف كان مشاركاُ في عملية التغيير الفقهي عبر شرعنة النزعات والاتجاهات الجديدة في الممارسة الفقهية العامة. وإلا ستبقى هذه النزعات منقوصة الاعتراف الرسمي وبالتالي منقوصة الشرعية. ويضرب مثلا لذلك تأصيل ابن المناصف (600هـ) للتغيرات التي طرأت على الإجراءات القضائية في المغرب والأندلس. وكذلك قضية العرف في التراث الشرعي الحنفي المتأخر، فهي تشرح تحولا مهما وأساسيا في الفقه الحنفي أدَّت إليه أول الأمر الممارسة الشرعية العملية. فقد شكل العرف مشكلة رئيسية للفقهاء الحنفية المتأخرين لأن موروث المذهب لم يترك سوى حيز ضئيل لدخول العرف في الأحكام، فأصول الفقه عندهم لا تعترف بالعرف مصدراً شرعيا مستقلا.
وقد تتبع د. حلاق تطور نظرة الحنفية للعرف بداية من الإشارات الخاطفة للعرف عند السرخسي، ثم المناقشة النظرية التي عرض لها ابن نُجيم في كتابه «الأشباه والنظائر» وانتهى إلى الإقرار بالعرف مصدرا شرعيا. ثم المناقشة التنظيرية المسهبة التي قدمها أمين بن عابدين (1252هـ) للعرف في رسالة أفردها له خاصة.
وقد خلص المؤلف بعد تحليل تمحيصي ماتع لرسالة ابن عابدين إلى القول بأن خطاب ابن عابدين في العرف تنويري من عدة منظورات: منها استحضاره مواقف الأقلية الضعيفة في الموروث وجعلها تتوازى، عبر مبدأ الضرورة، مع الرأي المرجعي في المذهب الذي يمثل الاتجاه السائد فيه. ومنها أيضا تعقُّده وتعدد مستويات نسيجه التأويلي، وتلك ميزة بارزة في عِلم الفقيه المصنِّف. هذه المستويات التي توافرت له مكَّنته في الواقع من قلب الهرمية في المصادر المرجعية رأسا على عقب، وكان لا بد للعرف في النهاية أن يتجاوز المبدأ المرجعي للمذهب. ومن المدهش أن ابن عابدين توصل إلى ذلك في الوقت الذي بقي فيه داخل الحدود التأويلية التقليدية للأصول الحنفية وتلك شهادة للفقيه المسلم ولقدرته على الإبحار بحرية فيما يبدو ظاهريا موروثا مقيدا.
تعليق:
إن قراءة المؤلف لإمكانات الإبداع والقدرة على التكيُّف مع التغيير لدى الفقيه المسلم، قد تكون صحيحة لجهة الآليات المنهجية المتمثلة في أصول الفقه وآليات التحرير والجدل الفقهي، ولكن قراءته انتقائية لجهة التوصيف التاريخي؛ بعبارة أخرى: إن ما ضربه المؤلف من أمثلة على التغيير الفقهي صحيح، ولكنه لا يعكس الواقع التاريخي جملةً، بقدر ما يثبت الإمكانية التغييرية والتجديدية الكامنة في الأدوات التي يمتلكها الفقيه، هذه الأدوات التي قد لا يستخدمها الفقيه في كثير من الأحيان أصلا، كما تدل على ذلك أمثلة تاريخية أكثر بكثير من الأمثلة التغييرية التي تحدث عنها المؤلف. على أننا قد لا نجانب الصواب إن قلنا إن ندرة هذه الأمثلة التاريخية التجديدية إنما يُعزى، في جزء كبير منه، إلى ركود الحركة التاريخية والتغيرات الاجتماعية عموما.
ولكن في الحين الذي يثمن فيه د. حلاق التجارب والممارسات التجديدية لبعض الفقهاء القدامى ويشيد بقدرتهم على الإبحار في تراثهم المذهبي المتعدد والمتنوع؛ فإنه يأخذ على المحدثين إبحارهم فيما وراء المذهب الفقهي الواحد من خلال مبدأ التلفيق أو الجمع(15)، أو حتى تجاوز مبدأ الالتزام المذهبي؛ على الرغم من أنهم لم ينبتّوا عن تراثهم الفقهي عموما بآلياته التقليدية نفسها، متمثلة في مبادئ أصول الفقه والترجيح والتصحيح الفقهي. إن مرونة المنظومة التشريعية الإسلامية لا تكمن في حدود المذهب الفقهي الواحد، كما يجعلنا المؤلف نتصور، ولكنها تمنحنا القدرة، بأدواتها التأويلية المختلفة، على الإبحار خارج الحدود المذهبية، دون الاخلال بتماسكها وثباتها.
إن دراسة د. حلاق هذه تمثِّل إعادة اعتبار لحقبة طويلة من الفقه الإسلامي اعتبرها الكثيرون حقبة انحدار وتدهور في تطور العلوم الإسلامية عامة والفقه خاصة، حقبةً حكمها التقليد والإتباع وأفل فيها الاجتهاد والإبداع. ولا تكمن أهمية هذه المساهمة في الرد على الاستشراق الغربي الذي غدا هذا التصور من مسلماته فحسب، بل فيما تحمله ضمنيا من نقد لرؤية كثير من الدراسات العربية الإسلامية الحديثة التي سلَّمت بهذه الفكرة صراحةً أو ضمناً من خلال إهمالها وعدم إيلائها لكتابات هذه الفترة التاريخية ما تستحقه من الدرس والنظر. وهي بذلك تشكل حفزا للدارسين العرب والمسلمين لإعادة النظر في تراث هذه الفترة التاريخية – ما بعد القرن الرابع للهجرة – والنَّقب عن كمائنها ومخزوناتها الإبداعية.
ولكن هذه الدراسة لا تقدم إعادة قراءة تاريخية فحسب، ولكنها تقدم منظورا جديدا للاجتهاد والتقليد، أو التجديد والتقليد كما يحلو لكثير من المعاصرين القول. تقوم هذه الرؤية المعرفية الجديدة على تصور مفاده خرافية الاجتهاد المطلق جملةً، وأنه لا وجود لمثل هذا الضرب من الاجتهاد تاريخيا أو معرفياً، فكل اجتهاد يقوم في جزء منه على تقليد من نوعٍ ما؛ وإلا فإنه سيصبح منبتاًّ عن التربة المعرفية التي نشأ فيها، ولن يحظى بالقبول المعرفي أو الاجتماعي. وإن هذا ليصدق غاية الصدق في هذا الحقل المعرفي، حقل المنظومة التشريعية، الذي يفترض قدرا من الثبات والاستقرار مع مرونة في التكيف مع تفاصيل ومتغيرات الحياة. فأيُّ نظام قانوني يقوم على جملة من المبادئ التشريعية هي عموده وأساسه، ولا يمكن أن يُسمّى كذلك إن كان قابلا أن تعصف به الريح في كل يوم، فهو محتاج لقدر من الديمومة والثبات حتى يفرض سلطانه ويحافظ على مبادئه. لذلك يرى المؤلف أن التناغم بين الثابت والمتحول أو بين المبادئ التشريعية وفروع الأحكام هو الذي أقدر الشريعة الإسلامية على الانتشار والاستقرار في المجتمعات الإسلامية في قارات ثلاثة وشعوب شتى (ص8).
* * *
نشأة الفقه الإسلامي وتطوره
المؤلف : وائل حلاق
الناشر : دار المدار الإسلامي
السنة : 2007
صفحات : 319
عرض: سامر رشواني
| بعد أن قدم د. وائل حلاق دراسات عديدة عن التاريخ الوسيط للفقه الإسلامي وأصوله ، تناهض منظور كثير من الدراسات الاستشراقية التي كرَّست جهدها لدراسة مرحلة البدايات باعتبارها المبدأ والختام، وما بعدها لا يمثل إلا الجمود والتحلل – يستكمل في كتابه هذا دراسة ما يسمى «المرحلة التأسيسية» للفقه الإسلامي منذ بذوره الأولى في عهد رسول الله r وحتى منتصف القرن الرابع للهجرة؛ وكعادته يطرح د. حلاق عددا من الأفكار المخالفة للسائد والمألوف ليس لدى المستشرقين فحسب – كما يصور لنا المؤلف في المقدمات التي كتبها خصيصاً للطبعات العربية من كتبه – بل لدى كثير من الدارسين المسلمين لتاريخ التشريع الإسلامي.
يعرِّف المؤلف «المرحلة التأسيسية» بأنها تلك “الفترة التاريخية التي برزت فيها المنظومة الفقهية من خلال البدايات الأولى ثم تطورت إلى حدٍّ اكتسبت فيه ملامحها الجوهرية وهيئتها المخصوصة”. والملامح الجوهرية للفقه الإسلامي أو الصفات الأساسية التي تكسبه هيئته وهويته تتمثل في أربعة صفات: 1- تطورٌ قضائي تام، إلى جانب نظام فقهي، ومحاكم مكتملة الشروط، وتشريع يقوم على الأدلة والأصول. 2- استكمال وضع الأطر الفقهية (شرح كتب الفروع). 3- بروز علم منهجية التشريع والتأويل (أصول الفقه) بروزا كاملا. 4- استكمال ظهور المذاهب الفقهية. وقد كان منتصف القرن الرابع للهجرة هو الفترة التي اكتملت فيها ملامح المرحلة التأسيسية، فظهرت الصفات الأربع جميعها، وكل التطور الذي حدث بعد ذلك بما فيه التحول في أصول الفقه أو التطبيقات إنما كان من قبيل السمات العرضية التي لم تحدث أثرا في بنية الشرع الإسلامي. إشكالية البدايات في تاريخ الفقه الإسلامي: إن تحديد زمن نشأة الفقه الإسلامي أعقد بكثير من تحديد نهايته؛ فالمشاكل المتعلقة بإشكاليات «البدايات» كانت صادرة عن آراء غير مثبتة، أكثر من صدورها عن أدلة تاريخية قاطعة، ومن ثم اعتقد المستشرقون الكلاسيكيون أن المنطقة العربية في عهد الرسول r كانت معدمة ثقافيا، وأن العرب لما بنوا مدنهم المتطورة وإمبراطوريتهم وأنظمتهم التشريعية إنما استوعبوا عناصر ثقافات المجتمعات التي فتحوها، لاسيما البيزنطية الرومانية والفارسية الساسانية، ومعارفهم التشريعية. وقد بينت دراسات حديثة – كما يقول المؤلف – أن هذه الآراء لا تزال عاجزة عن إيجاد أدلة قوية تقوم عليها، ذلك أن الثقافة العربية، شأنها شأن الثقافات الأخرى، وفَّرت مصدرا لأغلب الشرائع التي تبنّاها الإسلام. وقد بين المؤلف في الباب الأول أن الثقافة العربية قبل الإسلام كانت جزءا جوهريا من الثقافة العامة للشرق الأدنى، فقد كان عرب شبه الجزيرة خلال اتصالهم الوثيق بعرب الشمال الذين كانوا يسيطرون على الهلال الخصيب يحتفظون بأشكال من الثقافة وثيقة الصلة بتلك التي كانت منتشرة في الشمال، وقد كان البدو أنفسهم جزءا من الخارطة الثقافية. وقد أسهمت المواطن الحضرية والزراعية في الحجاز بدور هام في الأنشطة التجارية والدينية في الشرق الأدنى؛ فبواسطة قوافل التجارة والدعوات الدينية والاتصال بقبائل الشمال عرفت قبائل الحجاز سوريا وما بين النهرين. ولما بدأت دولة المسلمين الجديدة في التوسع نحو الشمال والشمال الغربي والشرقي، فإنها لم تكن تغزو هذه الأراضي خالية الوفاض باحثة عن أشكال ثقافية جديدة أو هوية ذاتية؛ بل كانوا يملكون اطلاعا جيدا على ثقافة هذه المناطق وأغلب شرائعها. هكذا انتظمت الأمة الإسلامية خلال العقود الأولى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على هدي أساسيين: المبادئ الأخلاقية القرآنية، وأعراف عرب شبه الجزيرة وشرائعهم، وهي شرائع اعترتها تغييرات تاريخية تحت تأثير قيم الدين الجديد. هنا ينبه المؤلف إلى فكرة بالغة الخطورة وهي أن النظر إلى المسلمين الجدد على أنهم سكان صحراء يعيشون حياة الترحال والقبائل المعدمة قبل أن يفتحوا بلادا جديدة، إنما يقوم على نظرية أساسها أن كل أشكال الثقافة لدى المسلمين، بما فيها المؤسسات الشرعية، قد تم أخذها عن ثقافات الإمبراطوريات الشمالية ولاسيما البيزنطية، ومثل هذا النظر يوافق الرؤية المنتشرة عن المسلمين اليوم باعتبارهم متخلفين في حاجة دائمة إلى استيعاب الثقافة والقيم الغربية حتى يتمكنوا من مسايرة إيقاع الحداثة والتمدن، (ص54). تطور الثقافة الشرعية حتى بدايات القرن الثالث: كرّس المؤلف أبواباً ثلاثة في كتابه للبحث في تطور المنظومة التشريعية الإسلامية من خلال تتبع نشاط طبقتي القضاة والفقهاء، وقد عني بنشاط القضاة على نحو خاص إذ رأى فيه أفضل مقياس يمكن أن يضبط به تطور مبادئ التشريع الإسلامي. لقد عُيِّن القضاة الأوائل في مدن الأمصار دون غيرها حيث عملوا باعتبارهم محكِّمين وقضاة وقيِّمين على أمور اليتامى. وكان دورهم -في جزء من أجزائه- مواصلة لسنة التحكيم القبلي لعهود ما قبل الإسلام؛ فالكثير من هؤلاء تولوا القيام بذلك سابقا والقبائل العربية التي خضعت لقضائهم كانت معتادة على مثل هذا النمط من فضِّ النـزاعات. وقد طبَّق هؤلاء القضاة الأوائل شرائع القرآن بالتوازي مع خليط من الشرائع الأخرى المستقاة من السنن والممارسات العربية الشائعة وأحكام الخلفاء وآرائهم الخاصة. غير أن هذه الشرائع لم تكن تمثل أصنافا متمايزة؛ لأن عادات العرب كثيراً ما قامت على ما اعتبر ضربا من السنن التي كانت تجسد أعمال الخلفاء والرسول r نفسه وصحابته الكبار. لم تكن السنة النبوية (القائمة في جزء منها على سيرة النبي r) خلال نصف القرن الذي تلا وفاة الرسول سوى نوع واحد من عدة أنواع من السنن التي شكلت مصدرا تشريعيا معتمدا لدى القضاة؛ إذ لا نعثر على ما يشير إلى كونها متمايزة عن غيرها من السنن خلال هذه الفترة، رغم ما حظيت به من درجة رفيعة من الوجاهة رفيعة. إلا أن هذه الوضعية سرعان ما شهدت تغيرا، إذ بدأ كثير من القضاة وأهل العلم منذ ستينيات القرن الأول في استحضار سيرة الرسول r باعتبارها جنسا شفويا منفصلا ومتمايزا عن سنن أبي بكر وعمر وغيرهما. من هنا كانت بدايات التحول التدريجي الذي انتهى بجعل السنة النبوية مصدرا للتشريع يقوم على سنن الرسول r دون سواها. وكانت هذه البذرة الأولى لتطور آخر ذي دلالة، تمثَّل في ظهور تيار ما يُعرف بالمحدثين الذين تزايد نشاطهم ونقلوا أقوال الرسول r والصحابة وأعمالهم، واتخذوا موقفا سلبيا من الرأي وتبرموا منه. في حين كان الرأي قبل ذلك جزءا لا يتجزأ من التدين والتعبد؛ لأنه كثيرا ما كان يعتمد على القرآن والنماذج التي طُلب الاقتداء بها. هذه التطورات الأخيرة التي برزت بحلول العقد الثاني من القرن الثاني للهجرة رافقها بروز طبقة الفقهاء وتوسعها مع شروع المسلمين في الاهتمام بالجدل الديني والقص والتعليم بالمساجد، كما بدأ التخصص التدريجي في منصب القضاء، بعد أن كان أوائل القضاة مكلفين بفض النـزاعات قبل 80هـ وبواجبات أخرى كإمامة المسلمين أو ولاية بلد ما، كما بدأنا نشهد التداخل بين حقل الفقهاء والقضاة الذين كان بعضهم ينتمي إلى حلقات الفقهاء الناشئة، كما أصبح المختصون في الفقه جزءا من مجلس القضاء، وظهر تقليد جديد يتمثل في وجوب استشارة القاضي للفقيه. ثم شهدت الفترة الممتدة بين العقد الثالث والعقد الثامن من القرن الثاني للهجرة نضج كل من منظومتي القضاء والفقه، فقد اتخذت الملامح الأساسية لكلٍ منهما شكلا نهائيا، ولن تشهد في القرنين التاليين إلا مزيدا من التدقيق والضبط. ولعل من الملاحظات والأفكار المهمة التي أشار إليها المؤلف في دراسته لمصادر التشريع في هذه الفترة هي المكانة التي كانت تتمتع بها السنة العملية. فقد كانت السنة العملية (ما عليه عمل الرسول r وصحابته والخلفاء الراشدين) مصدر التشريع الثاني خلال القرن الثاني للهجرة، ورغم أنها لم تُحدد تماما معنى النصوص القرآنية فإنها أثَّرت في تأويلها، وحددت كذلك الأحاديث التي يجب قبولها وتلك التي وجب استبعادها، بحسب درجة توافقها مع السنة الفعلية (ما عليه العمل) أو تعارضها معها. وهكذا أسس كل إقليم من الأقاليم مثل الشام والعراق والحجاز ممارساته الفقهية الخاصة على أساس ما تم اعتباره سنن الأولين، سواء أكانت تعود للصحابة أو إلى الرسول r. وقد ساهمت أعمال الرسول في المدينة باعتبارها موطن إقامته في تأسيس ممارسة موحَّدة فيها. ولكن خلال منتصف القرن الثاني للهجرة بدأت طبقة من المحدثين (أو أهل الحديث) تبرز بشدة، وكان شاغلهم الرئيسي هو جمع أحاديث الرسول r وروايتها، وسرعان ما اكتسب الحديث منـزلة أسمى من السنة العملية. ويقدم المؤلف تفسيرين لهذا التقدم من طرف الحديث على حساب السنة العملية: الأول: أنه على خلاف السنة العملية التي لا تمتلك مستندا موضوعيا فإن الحديث كان يوثَّق بالاعتماد على الإسناد. الثاني: كان الحديث هيكلا من المعرفة شاملا، أنتجته وضبطته طبقة واسعة من علماء لم يكن لهم عموما أي ولاء خاص لأية ممارسة عملية. وقد لاحظ المؤلف – بحذق – أن ظهور الحديث قد تزامن مع تطور المجتمعات الإسلامية في المناطق غير العربية. ولاسيما في الأقاليم الشرقية من بلاد فارس، تلك الأقاليم التي لم تكن تمتلك سنة عملية، فكان الحديث وسيلة مناسبة مكَّنت هذه المجموعات من اكتساب مصدر مناسب لعملهم التشريعي. أصول الفقه والجمع بين أهل الرأي والحديث: من خلال دراسته لتطور الاجتهاد الفقهي خلال القرون الأربعة الأولى يكشف المؤلف عن تغير هام في مصادر التشريع وآلياته. فقد كان الرأي خلال القرن الأول بعد وفاة الرسول r محلَّ تحدٍ متزايد من قبل أهل الحديث، وتمثَّل ذلك في تكاثر السنة النبوية متجسدة في الحديث وقبولها تدريجيا. وأصبح لأهل الحديث بين نهاية القرن الثاني للهجرة وحوالي أواسط القرن الثالث اليد الطولى التي تم التعديل من نفوذها بقبول الرأي المجرد في أطر محدودة. وبنهاية القرن الثالث للهجرة تم التأليف بين أهل الرأي وأهل الحديث من خلال علم أصول الفقه الذي بدأ في الظهور. وكان القياس أهم مشغل من مشاغل أصول الفقه (حيث خُصص ما يقارب الثلث من المصنفات الأصولية)، وقد عكس هذا الاهتمام قيمة القياس باعتباره طريقة متقنة في التأويل جعلت التفكير البشري خاضعا خضوعا تاما لنصوص الوحي. وقد تجسد هذا الخضوع من خلال كل عنصر من عناصر هذه النظرية تقريبا. وعليه رأى د. حلاق أن أهم خاصية في علم أصول الفقه تكمن في وجوب نهوض التفكير البشري بدور هام في التشريع دون أن يتعالى بأي حال من الأحوال على ما أتى به الوحي. إن هذا التوازن بين المجالين (التفكير البشري والنص المنـزل) لم يُكتب له أن يستقر حتى منتصف القرن الرابع الهجري، وهذا يفسر تجاهل نظرية الشافعي التي طرحت صيغة أولية لهذا التوازن من قبل الفقهاء خلال القرن الذي تلا كتابه، في حين بدأ الأصوليون يعيدون اكتشاف الشافعي في منتصف القرن الرابع وتقدير نظريته بل واعتباره المؤسس الأول لعلم الأصول. لقد تمت صياغة نظرية أصول الفقه باعتبارها ثمرة لهذا التأليف بطريقتين: فقد كان علم أصول الفقه يصف الواقع ويضع الأحكام. ولم يكن ليكتفي بتفصيل مناهج الفقهاء وطرق عملهم في إقامة الشرع كما جسده المجتهدون، وإنما تولى أيضا بيان السبل المناسبة للتعامل مع الشرع، من أجل تحقيق غايته المتمثلة في استخراج أحكامٍ لما يمكن أن يطرأ من قضايا. تكوّن المذاهب الفقهية: مع اكتمال ظهور أصول الفقه نحو منتصف القرن الرابع للهجرة أصبحت المرحلة التأسيسية في التشريع الإسلامي مكتملة باستثناء ميزة جوهرية واحدة وهي ظاهرة المذاهب الفقهية. وقد بيَّن المؤلف أن كلمة «المذهب» في الاستخدام الفقهي لها أربعة معاني تطورت وظهرت تدريجيا: أولها المبدأ الفقهي الذي ينطوي على عدد من المسائل التي تندرج تحته (مثل جبر الضرر)؛ وثانيها: هو المعنى الأول مقترنا بنسبته إلى فقيه ما؛ وثالثها: الآراء الفردية لأحد المجتهدين، سواء كان هذا المجتهد هو مؤسس المذهب أو كان أحد أئمته؛ ورابعها: الولاء التام لنظرية فقهية معينة ومكتملة وذات بعد جماعي من قبل مجموعة من الفقهاء، وتنسب هذه النظرية لعلم من الأعلام أو شيخ من شيوخ الفقه؛ على الرغم من أن هذه النظرية أو المنظومة الفقهية إنما قامت على إضافات ومساهمات متراكمة لأجيال من الفقهاء المشهورين. ولكن كيف ارتقى مفهوم المذهب من معناه الأصلي الأساسي (الرأي الفقهي المنسوب إلى فقيه ما) إلى دلالته المتطورة باعتباره مذهبا فقهيا؟ لقد نشأ الاهتمام بالشرع وعلوم الفقه أول ما نشأ في إطار الحلقات العلمية، ولكن حتى منتصف القرن الثاني للهجرة لم يكن العلماء القائمون على التدريس فيها قد كوَّنوا منهجية واضحة في التشريع والتفكير الفقهي. ومع انتصاف القرن الثاني شرع الفقهاء في تطوير تصوراتهم الفقهية ومنهجياتهم، وجمع كل فقيه حوله من خلال تبنيه منهجية معينة عددا من الأتباع أخذوا فقههم وطريقتهم في التفكير عنه. هكذا أصبحت كلمة «مذهب» خلال القرن الثاني تعني مجموعة من الطلاب والمشرعين والقضاة والفقهاء الذين تبنوا مذهب أحد أقطاب الفقه مثل أبي حنيفة أو الثوري. وهي ظاهرة أطلق عليها د.حلاق اسم «المذهب الشخصي». بيد أن تبني فكر فقيه معين لم يكن يعني الولاء المطلق لذلك المذهب، فلم يكن من الشاذ أن ينتقل قاض من القضاة أو أيٌ من عامة الناس من مذهب إلى آخر، أو أن يتبنى خليطا من المذاهب تُنسب إلى شيخين من شيوخ الفقه أو أكثر. وإن كان بعض كبار الفقهاء قد حصلوا على أتباع أوفياء لهم التزموا آراءهم مثل أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري. ولكن هذه المذاهب الشخصية لا تمثل ما يعرف في التشريع الإسلامي بالمذهب الفقهي الذي تطور بعد ذلك ليمتلك عددا من السمات تفتقر إليها المذاهب الشخصية، وهي: أولا: أن المذاهب الشخصية كانت تحتوي على آراء مجتهد واحد في الفروع ، أما المذهب الفقهي فهو تراكم من الفروع الفقهية تكون فيه الآراء الفقهية للمجتهد، الذي يفترض أن يكون واضع المذهب، معادلةً لبقية الآراء ولاختيارات الفقهاء الآخرين الذين يعتبرون شيوخا داخل المذهب نفسه. بعبارة أخرى: كان المذهب الفقهي كيانا جماعيا ذا سلطة في حين بقي المذهب الشخصي مقتصرا على الآراء الفردية لفقيه واحد. ثانيا: كان المذهب الفقهي كيانا منهجيا مثلما كان كيانا فقهيا، في حين لم يكن مثل هذا الوعي المنهجي متوفرا في المذاهب الشخصية. ثالثا: لقد ضُبط المذهب الفقهي بحدوده المادية أي بجملة من الفروع الفقهية والأصول المنهجية التي ضبطت بوضوح الحدود الخارجية للمذهب، أما المذاهب الشخصية فلا تتوفر على مثل هذه الحدود فكان من المألوف فيها تجاوز هذه الحدود لصالح آراء ومبادئ فقهية أخرى. رابعا: إن تجاوز الفروع الفقهية والمبادئ المنهجية أصبح يساوي الخروج على المذهب الفقهي في حين أن الوفاء للمذهب الشخصي لم يكن بذي أهمية كبيرة على كيانه. ومن الملامح الجوهرية للمذهب الفقهي التي تميزه عن المذهب الشخصي أنه يؤسس محورَ سلطةٍ تنبني عليه منهجية كاملة في التشريع، وهذا المحور يتمثل في شخصية ما صار يعرف بالمؤسِّس، المجتهدِ المطلق الذي تنسب إليه المبادئ المتراكمة والجماعية للمذهب. وقد أضيفت إلى هذا المؤسس صفات عديدة منها الاجتهاد المطلق وإنشاء منهجية ونظرية فقهية متكاملة (أصول فقه)، والمعرفة الشاملة، كما كان الفقيهَ الوحيد القادر على الخوض مباشرة في نصوص الوحي. وهذا التصور لا يمكن اعتباره حقيقة تاريخية بحال، بل كان اختراعا لاحقا أريد به بناء سلطتهم وتأسيسها(3). ولكن ما السبب الحقيقي وراء ظهور المذاهب الفقهية ، وتطور هذا النمط من المذهبية؟ في حضارات أخرى عظيمة ومتطورة كان الفقه – باعتباره نظام تشريع وتنفيذ – خاضعا للدولة، في حين لم يكن للقوى الحاكمة في الإسلام أيُّ علاقة بالسلطة الفقهية أو بوضع التشريعات ونشرها؛ لذلك ظهرت الحاجة في الإسلام إلى ترسيخ الفقه في منظومة ذات سلطة، ولم يكن ذلك مطلبا سياسيا، فالسلطة السياسية كانت تعد مثارا للريبة. في هذا الإطار مثَّلت المذاهب الشخصية الخطوة الأولى لتوفير محور للسلطة الفقهية، ولكن الحاجة إلى محور سلطة مركزي ظلت قائمة. ثم بدا أن الاجتماع حول آراءٍ فقهيةٍ الوسيلةَ الوحيدة التي يكتسب المذهب الشخصي بها أتباعا أوفياء ويضمن الدعم السياسي والمادي، ولم يقتصر مثل هذا الدعم على مزايا مادية مباشرة تمنحها النخبة الحاكمة، بل امتدت إلى تعيينات لهم في مناصب قضائية رفيعة لم توفر دخلا محترما فحسب، وإنما أكسبتهم أيضا تأثيرا في السياسة والمجتمع. وقد كان تأسيس صورة المجتهد المطلق باعتباره ذروة التطورات التي شهدها المذهب قد مثَّل طريقة لتجذير الفقه في مصدر من مصادر السلطة قام بديلا عن سلطة الجهاز السياسي. في هذا السياق يطرح المؤلف سؤالا بالغ الأهمية كنا ننتظر الجواب عنه كما وعد في كتبه السابقة، وهو: لماذا لم تعش سوى أربعة مذاهب شخصية وتتحول إلى مذاهب فقهية كبرى في حين اندثرت عشرات المذاهب الشخصية التي ظهرت في القرن الثاني والثالث للهجرة ؟ ولماذا نجحت المذاهب الأربعة ؟ بدايةً، يقدم د. حلاق جوابا موجزا عن ذلك يتمثل في أن المذاهب الشخصية – عدا المذاهب الأربعة – عجزت عن إقامة منظومة فقهية تقودها إلى الارتقاء بنفسها إلى مصافِّ المذهب الفقهي. وبعبارة أخرى: اقتصرت هذه المذاهب الشخصية الفاشلة على جمع الآراء الفقهية التي تمثل الرأي الفردي للإمام، ولم تقم بعملية بناء سلطة فكرية يمكن أن تنتج تراكما في الفكر والمنهج أو ترتقي بشخصية الإمام إلى مكانة المجتهد المطلق، (ص232). ولكن لماذا فشلت هذه المذاهب في الارتقاء إلى مستوى تأسيس هذه السلطة؟ يقدم المؤلف أربعة عوامل تفسِّر فشل هذه المذاهب في الارتقاء إلى مستوى المذاهب الفقهية، وفشلها في استمالة فقهاء ممن علا شأنهم واستطاعوا من خلال مساهماتهم الفقهية أن يرفعوا من شأن سلطة ما عرف بالإمام المؤسس في المذاهب الفقهية الحيَّة: العامل الأول: يتمثل في الافتقار إلى السند السياسي؛ فلما مثَّل الفقهاء حلقة الربط بين الرعية والنخبة الحاكمة تلقوا مساندة السلطة السياسية بالمال وغيره من وسائل الدعم. وعلى سبيل المثال نجاح المذهب الشخصي للحنفية في العراق يعود أساسا إلى دعم العباسيين الذين وظَّفوا علماء الحنفية لحشد تأييد الرعية لهم. كما يفسر الدعمُ السياسي للأمويين حوالي سنة 200هـ أيضا نجاحَ المالكية بالأندلس في إزاحة المذهب الشخصي للأوزاعي الذي كان مسيطرا قبل ذلك. العامل الثاني: يتمثل في العجز عن الارتقاء بأفكار المذهب الشخصي إلى نموذج التوفيق بين أهل الرأي وأهل الحديث، وهذا يمثل بوضوح السبب المركزي وراء تلاشي المذهب الظاهري. العامل الثالث: فتمثَّل في التحالف مع ما اعتبر حركات كلامية غير رسمية، وكثيرا ما كان فشل مذهب من المذاهب نتيجةَ انتماء أتباعه لمثل هذه الحركات. هكذا نجح المذهب الحنفي بانفصاله عن المعتزلة واندراجه في الماتريدية في حشد تأييد فقهي كبير، وكذلك الشافعية في تحالفهم مع الأشعرية. في حين انطفأ مذهب ابن جرير الطبري بسبب انتقاداته الحادة لابن حنبل بطل المحنة. العامل الرابع: غياب ملامح فقهية مميزة توفر للمذهب الشخصي هوية فقهية مستقلة؛ فالأوزاعي مثلا لم يتأثر بمذهب أهل المدينة تأثرا شديدا فحسب بل كان غير قادر على المدى البعيد على تأسيس هويته الفقهية الخاصة، ولذلك عندما تبنى الأمويون بالأندلس المذهب المالكي مزيحين مذهب الأوزاعي لم يكونوا فقهيا قد انحرفوا كثيرا عنه. هذه العوامل الأربعة – كما يرى المؤلف – هي الأكثر وضوحا في تفسير فشل المذهب الشخصي أو نجاحه، وقد تسهم مجتمعة أو منفصلة في هذا الفشل أو النجاح. بل يوجد أحيانا جدل بين هذه العوامل، فالتحالف مع تيار كلامي منشق يقلل من قدرة المذهب على استمالة أتباع جدد، وهذا ما يجعله أقل استمالة للسند السياسي، لأن دوائر السلطة كانت بحاجة إلى التأثير في أعداد كبيرة من الناس من أجل تحقيق المشروعية السياسية. وعليه لم يكن من المتصور أن تحصل الجريرية (مذهب ابن جرير الطبري) على الدعم السياسي خلال تأسيس مذهبها لأن النخبة الحاكمة ببغداد كانت تعرف أن مثل هذا الدعم سيثير حفيظة الحنابلة في هذه المدينة. لكن رغم التأثير الذي أحدثته السلطة السياسية في مسار تشكل المذاهب الفقهية من خلال الدعم المادي والسياسي الذي اختارت النخبة الحاكمة منحه أو منعه، فإن الإسلام التأسيسي (التشريع الإسلامي كما تجلى في نهاية مرحلته التأسيسية) قد وفَّر إطارا مناسبا لتطبيق مبادئ الشريعة؛ فكلما أذعنت النخبة السياسية لأوامر الشريعة، تلقت دعما أكبر من الفقهاء من خلال إضفائهم مزيدا من الشرعية على الساسة، وكلما تعاون الفقهاء مع الساسة حصلوا على الدعم المادي والسياسي. وهذه الحقيقة التي جعلت موافقة رجل الفقه ضرورية للعمل السياسي هي التي أعطت الإسلام التأسيسي ما نسميه اليوم «سيادة القانون». وهذا يفسر لنا افتقاد الشرعية القانونية لأنظمة الدولة الحديثة في معظم دول العالم الإسلامي بعد أن تمَّ تفكيك الشريعة الإسلامية والمؤسسات الدينية والفقهية، وبذلك تم القضاء على كامل سلطة الشرع التي سادت ذلك المجتمع التقليدي قرونا طويلة بفعل توسط الفقهاء الموقَّرين بين العامة والسلطة السياسية. بهذا الكتاب يكون د. وائل حلاق قد قدم لنا قراءة شاملة لتاريخ التشريع الإسلامي منذ نشأته وحتى عصوره المتأخرة، وهي قراءة متميزة بحق: إن لجهة اتساع المساحة التاريخية التي تعرض لها، أو لجهة الأصالة الفكرية وعمق الاطلاع الذي تكشف عنه، أو لجهة النظرات النقدية التي قدمها في مختلف دراساته والتي ترقى إلى مستوى الثورة على الأفكار السائدة في التأريخ للتشريع الإسلامي لاسيما المنتشرة في دوائر المستشرقين، أو لجهة الأثر الذي يتوقع أن تتركه في الباحثين في هذا الحقل من بعده. |
الهوامش
(1) أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل بمونتريال – كندا. له عشرات الدراسات والبحوث المتخصصة في نشوء النظريات والمذاهب الفقهية وتطورها، وهو محرر لموسوعة متخصصة عن الفقه الإسلامي لم تزل تصدر عن جامعة كامبردج.
(2) هذا الذي بين أيدينا، وكتابان آخران هما: السلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي (2001 بالانجليزية و 2007 بالعربية)، ونشأة الفقه الإسلامي وتطوره (2004 بالإنجليزية و2007 بالعربية) وكلا الترجمتين صادرتان عن دار المدار الإسلامي. وله سوى هذه الكتب الثلاثة كتب أخرى، منها: ابن تيمية في مواجهة المناطقة الإغريق (1993) والفقه والنظريات الفقهية في الإسلام الكلاسيكي والوسيط (1995) وهل أغلق باب الاجتهاد ؟ (2003).
(3) من مقدمته لكتابه نشأة الفقه الإسلامي وتطوره.
(4) من مقدمته للطبعة العربية من هذا الكتاب، ص 6.
(5) في الترجمة العربية (التفنيد النظري) فلعله خطأ مطبعي، وليس الأصل الأجنبي بمتوفر لدي لأجزم في الأمر.
(6) وبحسب تعبير طريف للمؤلف، فإن التطورات التي أدخلت على مفهوم العلة ومباحثها، كانت لتترك الشافعي وابن حنبل ، لو قدر لهما الاطلاع عليها، فاغري الأفواه من الدهشة.
(7) يضع وائل حلاق ابن حزم خارج إطار الفقه والأصول السنيِّ، بسبب رفضه للقياس، لذلك نجده يتجاهل نتاجه ولا يتعرض له، وهذه قضية يعوزها التدقيق والنظر، إن لجهة الموقف الفقهي لمخالفيه تاريخيا، أو لجهة التحليل الأصولي لموقفه من القياس.
(8) إن اختيار الشاطبي يعكس انتقائية منهجية من قبل المؤلف، فاعتبار الشاطبي نموذجا يمكن تعميمه أو القياس عليه، لجهة التفاعل بين أصول الفقه والواقع، أمرٌ يعوزه النظر، لاسيما وقد أكد المؤلف نفسه على تفرد الشاطبي وتميزه في هذا الجانب، بما يدل على أن التيار العام في التنظير الأصولي كان على خلافه ، أو على الأقل لم يبلغ شأوه. وإن حجته ودعواه في التفاعل بين أصول الفقه والواقع كانت لتتأكد وتقوى لو أنه اختار نموذجا أقل استثنائية من نموذج الشاطبي.
(9) نشير هنا بشكل خاص إلى كتابات محمد شحرور، التي يبدو أن د. حلاق قد تأثر بطرافتها المنهجية والتأويلية، ولم يمعن النظر في بنيتها المنهجية وقواعدها التأويلية، ولم يلحظ التناقضات التي تسرى في هذه المستويات كلها.
(10) بقي أن نشير إلى أنه على الرغم من العناية الواضحة بترجمة الكتاب ومراجعته وتدقيقه لغويا، إلا أنه اعتراه خللاً أساسيًا تمثّل في عدم اختيار المصطلحات الأصولية المناسبة في مواطن عديدة، فضلا عن بعض الأخطاء الأسلوبية واللغوية النادرة.
(11) هو ضرب من التصنيف لم يظهر إلا بعد اكتمال تشكل المذاهب الفقهية، أي في أواخر القرن الخامس للهجرة.
(12) هو بروز لا يقدم لنا المؤلف كثيرا من التفاصيل حوله في كتابه هذا، بل يرجئه لكتابه اللاحق حول النشأة المبكرة جدا للفقه.
(13) فكرة المتطلبات هذه تبقى أيضا غير واضحة ولا معلومة في ظل صعود شخصيات أقل كفاءة إلى سدة السلطة المذهبية وتخلف فقهاء أكثر براعة ومكنة.
(14) يصرح د. حلاق بعجزه عن معرفة الأسباب أو القوى التاريخية التي دفعت إلى هذه الانتقائية، ص 103.
(15) وقد تكلم المؤلف عن هذا الأمر في كتابه السابق «تاريخ النظريات الفقهية»، ص 272-274.