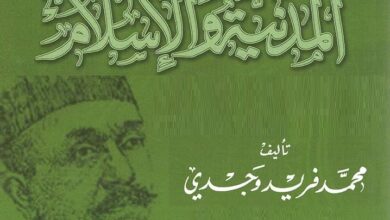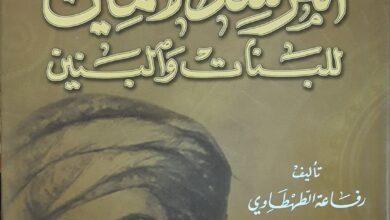يستند أي مذهب أخلاقي جدير بهذا الاسم – في نهاية الأمر- على فكرة الإلزام L’obligation، فهو القاعدة الأساسية، والمدار، والعنصر النووي الذي يدور حوله كل النظام الأخلاقي، والذي يؤدي فقده الى سحق جوهر الحكمة العملية ذاته؛ وفناء ماهيتها؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن تكون هناك مسؤولية، وإذا عدمت المسؤولية، فلا يمكن أن تعود العدالة؛ وحينئذ تتفشى الفوضى، ويفسد النظام، وتعم الهمجية، لا في مجال الواقع فحسب، بل في مجال القانون أيضًا، وطبقًا لما يسمى بالمبدأ الأخلاقي.
كيف نتصور قاعدة أخلاقية بدون إلزام؟. أليس هذا تناقضًا في الحدود؟. أم أننا نجعل من الضمير مجرد أداة للتقدير الفني؟. ولكن، أليس بديهيًا أن علم الأخلاق وعلم الجمال – أمران مختلفان؟.
وبمعنى أكثر عمقًا، إذا كان حقًا أن كل ما هو خير فهو جميل، فهل العكس أيضًا صحيح؟..
إن مما لا ريب فيه أن لفكرة الفضيلة جمالها الذاتي، الذي تتذوقه الأنفس، حتى عندما لا تستبي الأعين، لكن هنالك أيضًا أشياء أكثر من هذا، فالفضيلة بطبيعتها عاملة ومحركة، فهي تستحثنا أن نعمل كيما نجعل منها واقعًا ملموسًا، على حين لا نرى للإحساس بالجمال، إذا ما رددناه إلى أبسط صوره، أية علاقة بالعمل، وخاصة عندما لا يكون موضوعه متصلاً بإرادتنا.
ومن ذلك أن إعجابنا بالقدرة الإلهية، أو بعظمة القبة السماوية لا يحملنا على أن نخلق أمثالهما. وشبيه بهذا ما يحدث للفنان عندما يتخيل فكرة عمل يمكن تحقيقه، فإن هذه الفكرة لا تقهره مطلقًا على أن ينفذها، ولكنها تدعوه برفق أن يحققها حين يريد، ومتى أتيح له وقت فراغ. ولو أنها فرضت نفسها على بعضهم، فإنها لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من الضرورة، وهي في كل حال تعبر عن الإحساسات، دون أن تصادمها.
أضف إلى ذلك أن أي نقص يرتكب في عمل فني – قد يصدم الحواس، ولكنه لا يثير الضمائر، ولا يقال: إن مرتكبه قد أحدث عملاً غير أخلاقي.
أما الخير الأخلاقي فبعكس ذلك يتميز بتلك السلطة الآمرة تجاه الجميع، بتلك الضرورة التي يستشعرها كل فرد، أن ينفذ نفس الأمر، أية كانت الحال الراهنة لشعوره، وهي ضرورة تجعل من العصيان أمرًا مقيتًا ومستهجنًا.
ولسوف نرى([1]) في أي صورة ساق القرآن هذه الضرورة التي يسميها: أمرًا = Impératif، وكتابة = Prescription، وفريضة = Devoir.
فإذا ما عرفنا مبدأ الإلزام، وطرحناه على هذا الوجه – وجب علينا الآن أن نتغلغل أكثر، في معرفة طبيعته، دارسين مصادره، وخصائصه، ومناقضاته.
1- مصادر الإلزام الأخلاقي:
استطاع الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون، في تحليله العميق لقضية الإلزام الأخلاقي أن يكشف له عن مصدرين؛ أحدهما: قوة الضغط الاجتماعي، والآخر: قوة الجذب ذي الرحابة الإنسانية المستمدة من العون الإلهي، وهي قوة أوسع مدى من سابقتها.
وقد فسر ذلك قائلاً: إننا نؤدي الدور الذي عينه لنا المجتمع، ونتبع الطريق التي رسمها لنا، ثم نسلم قيادنا لهذه الطريق، نترسمها كل يوم، بنوع من العادة لا يكاد يخالطه تفكير، أشبه شيء بغريزة النحلة أو النملة. وذلكم هو ما يسمى عادة: بالوفاء بالواجب.
ولو أننا قاومنا ذلك لحظة، أو حاولنا أن نعدل من سيره فإننا لا نلبث أن نرتد إليه، شئنا أم أبينا، بفضل تلك القوة القاهرة للحياة الجماعية.
هذا الدور يختلف اختلافًا كاملاً في وجهه الآخر، فعلى حين أن أخلاق الكافة أثر ناشئ عن نوع من القهر الجماعي، نجد أن أخلاق الممتازين منهم هي طموح إلى المثل الأعلى، فهي نقلة على جناح الحب المبدع، الذي ينزع لا إلى توجيه سلوك الفرد وجهة أفضل فحسب، بل إلى جذب المجتمع معه، وقيادته، بدلاً من أن يكون مقودًا له([2]).
فإذا نظرنا إلى عرض برجسون هذا – على أنه وصف وتحليل لواقع معين نجده في التجربة- أمكن القول بأنه لم يغفل كثيرًا من الأساس.
وأما إذا تناولناه – على أنه نظرية في الإلزام الأخلاقي- فإن تحليله يحمل بعض الصعوبات؛ وشيئًا من الانحراف عن الجادة، بالنسبة إلى وجهة النظر القرآنية.
فمن حيث كونه وصفًا يمكن أن نتساءل – ما دام الأمر أمر تعيين لكل القوى المؤثرة على الإرادة-: لماذا لم يشر برجسون الى عامل ثالث، أكثر قدمًا، وأعمق جذورًا في الفطرة الإنسانية، أعني: العنصر الفردي L’individuel، أو الحيوي Le vital؟؟
ذلك أن ما يهم كل مواطن ليس فقط أن يخضع لقيود المجتمع، ويسلك في داخل الكيان الاجتماعي مسلك خلية في مركب عضوي، ولكنه كذلك أن يبحث بخاصة عن المحافظة على ذاته، مستقلاً عن المجموعة التي ينتمي إليها، إن لم يكن على حسابها.
وأخطر من ذلك أن مصطلحي (إلزام Obligation) و(أخلاق morale) -الواردين في هذا التحليل- يبدوان لنا متنافيين، يناقض أحدهما الآخر، فمتى أصبح الإلزام قهرًا شبه غريزي فإنه يفقد بذلك صفته الأخلاقية، وعكس ذلك: أن تلقائية الحب هي نقيض الإلزام.
والحق أن الأخلاقية الصحيحة لا تجد هنا مجالها، في إحدى الحالتين أو في الأخرى، فالإنسان قد صور لنا على أنه لعبة في يد قوة، أياً كانت، فهو تارة مدفوع بالغريزة، وأخرى محمول بالعاطفة، ولكنه لم يكن مطلقًا شخصية مستقلة، قادرة على المقارنة، والتقويم، والاختيار.
وإذن، فلكي تكون لدينا أخلاقية لا يكفي أن يتمثل لنا المثل الأعلى على أنه هدف لطموح متوثب محلق، ولا على أنه أمر البيئة، وكأنه ضريبة استبدادية، بل يجب أن يمر كلاهما في الضمير؛ ويتعرض لعملية إنضاج حقيقية، يخرج منها بمظهر جديد، قائم على مبادئ قانونية، يقويها ويفرضها العقل. فما دامت جاذبية المثل الأعلى ليست لها صيغة الأمر الصادر عن العقل، وحتى لو لم تكن نوعًا من ملاحقة السراب، أو حلمًا واهمًا؛ فإنها تظل محكومة بنوع من الإحساس بالجمال؛ ولكن هذا الإحساس بالجمال، مهما بلغ من النبل، فلن يكون مبدأ أخلاقيًا.
وكذلك الحال في كل خضوع لا مسوغ له، إلا أن يكون صادرًا عن نوع من الإرهاب الجماعي.
ومن هنا نرى القرآن يقف دائمًا أمام هذين العدوين للأخلاقية: اتباع الهوى دون تفكير: {وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ}([3]). {فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا}([4])، والانقياد الأعمى: {قَالُوا إِنَّا وَجَدنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّة وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقتَدُونَ}([5]). فهل يقدم الذين يريدون السير على سنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تمييز، حتى ولو {كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ}([6])؟.
ففي الفرد إذن – من حيث كونه فاعلاً- عنصر عقلي، أعني: عنصرًا أخلاقيًا، بالمعنى الحق، وفي الأمر الخلقي عنصر آخر هو: العقل، والحرية، والمشروعية؛ وتلكم هي العوامل الأساسية، التي أدى إغفالها إلى نقص كبير في تحليل برجسون.
وقد يستطيع من شاء أن يقلل من شأن «الملكة الفكرية»، وما لها من دور في تصور الأمور والحكم عليها، باعتبارها الأخيرة من حيث تاريخ ظهورها، ويستطيع أن يصر على أن تأثيرها ضئيل في مقاومة الشهوات، ولكن يبقى شيء لا شك فيه، هو أن جوهر الأخلاقية ذاته يكمن في نشاط ذاتنا المفكرة..
ولقد أحسن (كانت) صنعًا – برغم بعض النقص في طريقة تقديمه لنظريته- حين أكد أنه كشف عن مصدر الإلزام الأخلاقي، في تلك الملكة العليا في النفس الإنسانية، والتي توجد مستقلة عن الشهوة، وعن العالم الخارجي – معًا، إذ يقول:
«أيها الواجب، أيها الاسم الأسمى العظيم… أي مصدر جدير بك؟.. وأين نجد جذر ساقك النبيلة؟.. لعله لا يكون -على الأقل- سوى ذلك الذي يرفع الإنسان فوق ذاته… والذي يشده إلى نظام للأشياء، لا يمكن لقوة أن تتصوره سوى قوة الإدراك»([7]). فالإنسان بانتمائه في وقت واحد إلى عالم الإدراك، وعالم الحس، ذو طبيعتين، تسيطر أشرفهما، وهي (العقل) على دنياهما، وهي (حب الذات غير المشروع) وهذا الصوت العقلي واضح تمام الوضوح، شديد التأثير، قابل لأن يدركه حتى السذج من الناس… والحدود التي تفصل الأخلاقية عن حب الذات مميزة بكثير من الوضوح والضبط، حتى إن النظرة العادية لا تعجز عن تمييز ما يتصف به أحدهما، دون الآخر»([8]).
فإذا ما رددنا نظرية (كانت) إلى أبسط تعبير عنها، وخلصناها من جميع مظاهر الدقة الشكلية، ونزعة التسامي، ونقيناها أيضًا من نزعة التشاؤم، التي اتسمت بها؛ ومن بعض ما شابها من البرود العاطفي -فهي بعد هذا لا تعد من المسلمات فحسب، بل إنها لتتفق تمامًا -فيما نرى- مع النظرية المستخلصة من القرآن.
لقد علَّمنا هذا الكتاب أن النفس الإنسانية قد تلقت في تكوينها الأولى الإحساس بالخير وبالشر: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}([9]). وكما وُهب الإنسان ملكة اللغة، والحواس الظاهرة، فإنه زُوِد أيضًا ببصيرة أخلاقية: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ}([10]).
ولقد هُدِي الإنسان طريقي الفضيلة والرذيلة: {أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ}([11])، حقًا {إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ}([12]). ولكن الإنسان قادر على أن يحكم أهواءه: {وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفسَ عَنِ ٱلهَوَىٰ * فَإِنَّ ٱلجَنَّةَ هِيَ ٱلمَأوَىٰ}([13]).
وإذا لم يكن كل الناس يمارسون هذا التأثير على أنفسهم فإن منهم من يفعله بتوفيق الله له، وهو ما قرره رسول الله r في قوله: «إذا أراد الله بعبد خيرًا جعل له واعظًا من نفسه، يأمره وينهاه»([14]).
ففي الإنسان إذن قوة باطنة، لا تقتصر على نصحه وهدايته وحسب، بل إنها توجه إليه بالمعنى الصريح أوامر بأن يفعل، أو لا يفعل.
فماذا تكون تلك السلطة الخاصة، التي تدعي السيطرة على قدراتنا الدنيا، إن لم تكن ذلك الجانب الوضيء من النفس، والذي هو العقل؟..
ذلكم أيضًا هو ما عبَّر عنه القرآن بألفاظه الخاصة، حين صور حال الكافرين بين أمرين، فقال تعالى: {أَم تَأمُرُهُم أَحلَٰمُهُم بِهَٰذَآ أَم هُم قَوم طَاغُونَ}([15])؟. فها هو ذا مبدأ الطرف الثالث المستبعد من الأخلاق قد استبان ووضح، إذ ليس وراء أمر العقل وقيادته قاعدة أخرى -سائغة- للسلوك، فهو وحده إذن السلطة الشرعية.
في هذه الظروف نستطيع أن نقول مع (كانت): إننا مشرعون ورعايا في آن، وإن التجربة الأخلاقية للندم لتؤكد هذا الازدواج، فنحن عندما نقصر في واجبنا نحس أننا قد هبطنا إلى مستوى غير خليق بنا، ونعترف ضمنا بأننا مخلوق نبيل قد زل؛ ولا يزال القرآن يوقظ فينا هذا الشعور بكرامتنا الأصلية، ويؤصله، فهو لا يقرر فقط أن الله كرم الإنسان، وبسط سلطانه على الأرض وعلى البحار: {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}([16])، ولم يقتصر فضل الله سبحانه على أن أمر الملائكة أن تسجد أمام أبينا: {وَإِذ قُلنَا لِلمَلآئِكَةِ ٱسجُدُواْ لأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ}([17])، وهي درجة رفيعة، كثيرًا ما يذكرنا القرآن بها في مثل قوله: {وَلَقَد خَلَقنَٰكُم ثُمَّ صَوَّرنَٰكُم ثُمَّ قُلنَا لِلمَلآئِكَةِ ٱسجُدُواْ لأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ}([18]). ليس هذا فحسب، ولكنا، إذا ما نحينا جانبًا تلك الإشارات الخارجية إلى الكرامة الإنسانية، وإذا ما وقفنا أمام القيمة الأخلاقية فإنه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر إلى الطبيعة الإنسانية على أنها شريرة في أصلها، ولا على أنها فاسدة فسادًا عضالاً، بل على العكس من ذلك: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}([19]). ولم يهلك من الناس بعد هذا سوى الجاحدين، والذين لا يؤدون شعائر دينهم: {ثُمَّ رَدَدْناهُ أسفل سافلين * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون}([20])، وفي آية أخرى: {إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلا الْمُصَلِّينَ}([21]) – لم يهلك إلا الذين: {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}([22]).
فالأمر إذن أمر اختيار حر دنيوي، لا علوي، وهو يرجع إلى استخدامنا الحسن أو السيئ لملكاتنا العليا، وهي ملكات يزكى تثقيفها النفس، كما يدسِّيها ويطمسها إهمالها: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}([23]).
والحق أن القرآن لم يقتصر على الملكات العقلية وحدها، فلقد عنى في الوقت نفسه عناية كبيرة بإيقاظ أشرف مشاعرنا وأزكاها، بيد أنه لم يحرك هذه المشاعر إلا تحت رقابة عقلنا، فهو يتوجه إلينا دائمًا، أعني: يتوجه إلى ذلك الجانب المضيء من أنفسنا؛ إلى ملكتنا القادرة على أن تفهم، وأن تقدر في كل شيء ما يضر وما ينفع، وأن تقوِّم القيم المختلفة.
ومن المشاعر السامية التي حركها القرآن فينا- نذكر على سبيل المثال([24]) ما جاء فيه دعمًا لسائر واجباتنا الاجتماعية، بالمعنى الأوسع لكلمة (مجتمع)، ألا وهو الشعور بالأخوة الإنسانية: {يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}([25])، {ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفسٍ وَٰحِدَةٍ}([26]). ولقد تجلى هذا الشعور حين قدم لنا القرآن في صورة عاطفية مؤثرة مشهد الفزع الذي ينبغي أن يزعنا عن اغتياب الآخرين، فشبه المغتاب بمن {يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا}، – ثم يضيف: {فَكَرِهْتُمُوه}([27])-، كلكم أجمعون.
وإذا كان الأمر كذلك، ألا يمكن أن نستخلص منه أن الإنسان يملـك في غيبة أي تعليم إيجابي -جميع الوسائل الضرورية، العقلية والعاطفية، لكي يميز ما يفعل مما يدع؟، وعلى ذلك ألا يكون التشريع للخير وللشر أحد شؤوننا نحن؟.
وينبغي للإجابة عن هذا السؤال أن نحدد معنى هذه الدعوى وأهميتها. هل نريد أن نقتصر على وجهة النظر الإنسانية، ونهتم بخاصة بالضمير الفردي، أو أننا نريد أن نتناول وجهة الشيء في ذاته؟.
فإذا كانت فكرة الخير والشر قد حددت عقلاً على أنها «صفة كمال أو نقص، موافق للطبع أو مخالف، مستحق للمدح أو الذم» – فإن المتكلمين المسلمين لم يجدوا صعوبة في أن يقرروا صلاحية الإنسان للتشريع من هذه الناحية، ولكن هل كل ما نرى أنه حسن أو قبيح، بحسب عقولنا، هو في ذاته كذلك بالضرورة؟. وبعبارة أخرى: هل هو كذلك في نظر العقل الإلهي؟. وهل نحن على ذلك مدينون أمام الله سبحانه، حتى قبل أن نتلقى أوامره بوساطة رسله؟.
لقد دارت مناقشاتهم حول هذه النقطة المحددة، وتنوعت إجاباتهم التي قدموها لنا، ابتداءً من العقليين (المعتزلة والشيعة)، الذين يؤكدون ذلك الرأي بصورة عامة، حتى الأشاعرة الذين ينكرونه إنكارًا مطلقًا، وبين هؤلاء وأولئك الماتريدية الذين يسلمون به في حدود الواجبات الأولية.
ولكن من ذا الذي لا يري أن العقليين من المتكلمين عندنا قد تغالوا في اعتقادهم بعصمة العقل الإنساني؟. وأليس هذا على الأقل مجالاً عصيًا على إدراكنا؟.. وخذ مثلاً: الطريقة التي يؤدي بها المرء عبادته لخالقه، فلو ترك لكل امرئ أن ينظم هذه العبادة فلن يخلو الأمر من احتمالين: فإما أن يبقى متحيرًا لا يفعل شيئًا، وإما أن يلجأ إلى كل ضرب من ضروب التخيل والاعتساف.
وحتى بالنسبة إلى جميع المجالات الأخرى – يجب أن نعترف بأن هذا النور الفطري الذي يغلفه الهوى، وتفسده العادات، ينبغي أن يتعرض لنوع من الكبح، وأن يظفر بجملة من التوجيهات، تختلف باختلاف الزمان والمكان، والأمزجة، وإلا فإن اليقين الأخلاقي – بصرف النظر عن بعض الواجبات الأساسية المعترف بها لدى جميع الضمائر السوية– سوف يخلي مكانه تدريجيًا للأوهام، وضروب الشك، وصنوف الضلال.
فمثلاً، ما واجبنا حيال طبيعتنا العاطفية؟، أمن الواجب ألا نستجيب لشيء من شهواتنا، وأن نفرض على أنفسنا الآلام، وألوان القهر والتقشف، وأن نمضي في هذه الطريق مع البوذية، حق نبلغ مرحلة (النرفانا)([28])؛ أو درجة الإمحاء والفناء؟. أو أنه يكفي أن نتظاهر –كما يفعل الرواقيون– بنوع من اللامبالاة تجاه كل ضروب الخير والشر في هذا العالم، وإن كنا نفضل بعضها على بعض؟.. أو أنه يجب علينا أخيرًا أن نستمتع بكل ملذات الحياة، سواء أكان ذلك في حكمة وانتقاء، كما يعلمنا النفعيون، أم كان بلا قاعدة أو منهج، على طريقة أريستيب Aristippe([29]) والشعراء في كل زمان؟.
ومع ذلك فكل هذه ضروب من الإدراك، تؤكد أننا قد رجعنا في أمرها إلى الفطرة الإنسانية، وأتحنا لكل منها الوسيلة الفريدة التي تجعل صاحبها يسلك سلوكًا مطابقًا لتلك الفطرة، بقدر الإمكان.
وكذلك الحال في علاقاتنا بأقراننا، فإن الاهتداء إلى السلوك المناسب لا يقل صعوبة بسبب ما يواجهنا من اختلاف في الرأي. ونسوق هنا مثالاً طالما قوبل من قَبل بآراء متعارضة: فهل يجب على من لحقته إهانة أن يقتص، أو أن يعفو، أو أن له الخيار؟. وهل يجب علينا أن نعامل أخواتنا بتحفظ، أو بقساوة، أو نكشف لهن عن حبنا الأخوي؟.. وهل ينبغي أن نساعد الآخرين ليعيشوا أعفاء، أو نتركهم لوسائلهم الخاصة؟.. إلخ..؟؟ فلو أننا أردنا أن ننزل إلى تفاصيل الحياة اليومية من: بيع، وربا، وخمر، وزواج، وزنا، فإن الخطايا سوف تعظم أبدًا، ولسوف تُقاوم العقول دائمًا بعقول، كما تقاوم العواطف بعواطف.
لقد أبصر (كانت) الصخرة التي تصطدم بها الأخلاق القائمة على الضمير الفردي، والواقع أنه من المستحيل عند بلوغ درجة معينة أن نسن قانونًا يفرض باعتباره ضرورة على كل الضمائر، فلماذا أُضَحي باقتناعي من أجـل اقتناعك؟.
إن من الضروري إذن أن نلجأ إلى سلطة عليا لحسم الخلاف؛ ولن يكون الحل بكل تأكيد أن نعترف بهذه السلطة للمجتمع، إذ كان الأمر أمر أخلاقية Moralité، لا أمر شرعية Légalité. وهنا نلمح الدافع السليم الذي حدا بكانت أن يلتمس هذا التشريع من سلطة أعلى، تتوفر لها صفتا الأخلاقية والشمول، وأعتقد أنه واجدها في العقل نفسه، في صورته الأكثر صفاءً وتجريدًا، والذي يحكم جميع الأشياء بقانون عدم التناقض La loi de la non-contradiction، ولسوف تتاح لنا الفرصة لنلاحظ إفلاس مثل هذا المعيار([30]).
ونلاحظ أن (كانت) نفسه يعترف بعجز نقده عن تحديد الواجبات الإنسانية بخاصة، وهي الواجبات التي يعد تقسيمها من مهمة نظام العلم، لا من مهمة نظام نقد العقل بعامة، فإن هذا النظام لا يستتبع أي رجوع إلى الفطرة الإنسانية([31]).
وإذن، فالناس محتاجون على وجه التحديد إلى قاعدة صالحة للتطبيق على فطرتهم، ويستطيع كل منهم في الحالات السهلة أن يجد تلك القاعدة مسجلة بصورة ما في ضميره أي أن الشخص لا يحتاج إلى ذلك الكيان الشكلي المجرد، وهو إن احتاج إليه فإن هذه الفكرة الفارغة لا تفيدنا شيئًا محددًا.
لا بد إذن من أن نتوجه وجهة أخرى، فأين نفتش عن ذلكم النور البديع لنهدي ضمائرنا، عندما لا تجد حيثما توجهت غير الظلام؟.. وأين نجد ذلك المخلص الذي تعلقت به أنفسنا وقد تقاذفتها الشكوك؟.
ليس لدينا أمام هذه الأسئلة سوى إجابة واحدة تفرض نفسها، إذ لا أحد يعرف جوهر النفس، وشريعة سعادتها وكمالها، مع الصلاحية الكاملة، والبصيرة النافذة – غير خالق وجودهـا ذاته: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}([32])؟.
فمن ذلكم النور اللانهائي يجب أن أقتبس نوري، وإلى ذلكم الضمير الأخلاقي المطلق يجب أن أتوجه لهداية ضميري {وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}([33]).
فبدلاً أن نقول (العقل المحض Raison transcendentale) – يجب أن نقول: (العقل العلوي raison transcendante)، وبدلاً من الاستناد إلى تجريد تصوري ذهني ـ يجب أن نلجأ إلى ذلكم الواقع المحس، الحي، العليم، الذي هو (العقل الإلهي)، فنور الوحي وحده هو الذي يمكن أن يحل محل النور الفطري، ذلك أن الشرع الإلهي الإيجابي هو الذي يجب أن يستمر، ويكمل الشرع الأخلاقي الفطري.
وفي القرآن يسير العقل والنقل معًا، جنبًا إلى جنب، وهو ما يفهم من قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ}([34]) وفي قلب المؤمن يستقر نوران، على حين لا يجد الملحد سوى نور واحد، وهذا هو معنى رمز النور المزدوج في قوله تعالى: {نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ}([35]).
هل معنى ذلك أن علينا أن نفرق بين مصدرين مختلفين للإلزام الأخلاقي؟ كلا… فنحن بالأحرى نراهما مستويين لمصدر واحد، أقربها إلى الناس هو أقلهما نقاء، وذلك أن هذا النور المكمل ليس قريب المنال، ولا سلطان له علينا، وليس له معنى أخلاقي إلا من خلال ضميرنا الفردي، وشريطة أن يعترف به، فمن يد هذا الضمير الفردي نتلقى في كل حال الأمر المباشر، وعقلنا الإنساني هو الذي يأمرنا أن نخضع للعقل الإلهي.
ومن هنــا استطاع الغزالي أن يقول «وقول القائل: صار واجبًا بالإيجاب حديث محض، فإن ما لا غرض لنا آجلاً وعاجلاً في فعله وتركه؛ فلا معنى لاشتغالنا به، أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه»([36]). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: عندما أسأل نفسي، وقد استسلمت لأنواري الفطرية قبل أن أخوض عملاً ما – لكي أعرف واجبي، في موقف يتسم بالوضوح نسبيًا، فإن إشارة ضميري لن يكون لها في نظري قيمة القاعدة الأخلاقية، إلا إذا اعتقدت أنها تعبر عن الحقيقة الأخلاقية في ذاتها، لا عن حقيقة نسبية بالنظر إلى مشاعري. وكل جهودي في التأمل تهدف إلى مطالعة هذه الحقيقة التي أعتقد أنها مطبوعة في أعماقي، وفي جوهر كل كائن عاقل.
فإذا ما قيل لنا: إننا نحن الذين نشرع لأنفسنا، بوصفنا أعضاء في عالم عقلي، وجب علينا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي خُص به العقل.
ماذا تعني في الواقع هذه المقولة «العقل يمنح نفسه قانونه»؟ هل يبدع العقل القانون؟ أو أنه يتلقاه معدًا، على أنه جزء من كيانه، كما يفرضه على الإرادة؟.
ذلك لأنه إذا كان العقل مبدع القانون فإنه سوف يصبح السيد المطلق، فيُبقي عليه، أو يبطله، تبعًا لمشيئته، فإذا لم يستطع ذلك فلأنه قانون سبق في وضعه وجود العقل، وأن صانع العقل قد طبعه فيـه، كفكرة فطرية، لا يمكن الفكاك منها.
وحينئذ يكون معنى أن يستنصح المرء عقله: أنه يقرأ في كتـاب فطرته النقية، والإنسانية بصفة نوعية – ما سبق أن فطرها الله عليه. وبعبارة أخرى: عندما يرجع أشد الناس إلحادًا إلى سلطة العقل، فإنه لا يفعل في الواقع سوى الإنصات إلى ذلكم الصوت الإلهي، الذي يتكلم في داخل كل منا، دون أن يذكر اسمه، وهو ينطق به صراحةً عندما يتحدث إلى المؤمن.
ولكن، إذا كان النوران: الفطري والموحى – ينبثقان من مصدر واحد فحسب، فيجب أن نخرج أخيرًا بأن الله سبحانه هو الذي يرشدنا دائمًا إلى واجبنا، ما ظهر منه وما بطن.
وهكذا نصل إلى علاج الإلزام الأخلاقي في الإسلام في صورته، كقانون إيجابي Loi Positive.
وينبغي علينا في مواجهتنا لهذا المجال الجديد أن نسأل أنفسنا، عما إذا كان للشريعة الإسلامية مصدر واحد، أو عدة مصادر؟ ذلك لأن الفقهاء قد حددوا لها بعامة أربعة مصادر، هي: القرآن، أو (كلمة الله)، والسنة، أو (ما نقل عن الرسول)، والإجماع، أو (الحكم المجتمع عليه في الأمة)، وأخيرًا القياس أو (الحكم بطريق التناظر).
وإذا كان التحليل الذي قدمنا صحيحًا – باستثناء بعض التحديدات التي يجب أن نضيفها إلى هذا القول – فلا ينبغي أن يكون لدينـا سوى سلطة تشريعية واحدة، بالمعنى الصحيح. والقرآن ذاته لا يفتأ يؤكد لنا هذه الفكرة في كثير من آياته، قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّه}([37])، {أَلا لَهُ الْحُكْمُ}([38])، {لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ}([39]).
وقد بعث الله سبحانه فينا رسوله، لا ليكون مجرد خاضع لشرع الله فحسب، بل ليكون أول خاضع له: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} ([40]).
([1]) انظر فيما بعد، في نفس الفصل – الفقرة الثانية.
([2]) انظر: Bergson. Les deux sources de la morale et de la religion: ch. 1.
(مصدرا الأخلاق والدين – الفصل الأول).
([7]) انظر: Kant. Critique de la Raison pratique, p. 91
([8]) المرجع السابع ص 35 – 36.
([14]) الديلمي – مسند الفردوس، صحيح من طريق أم سلمة، ذكره السيوطي في الجامع الصغير 1/17.
([18]) الأعراف: 11، وأيضًا: الحجر 29، وطه 116، وص 72.. إلخ.
([24]) لمن أراد معرفة أوسع أن يرجع إلى الفصل المعنون «نظام التوجيه القرآني» – المبحث الثالث من الفصل الثالث – م.
([28]) النرفانا، في فلسفة الهنود تعني امتحاء الذات في الكل «المعرب».
([29]) أريـستيب: فيلسوف إغريقي، ولد في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو تلميذ لسقراط، وصاحب مدرسة كانت تبني السعادة على أساس الملذات. «المعرب».
([30]) انظر فيها بعد: المبحثين الثاني والثالث.
([31]) انظر: Kant, Crit. de la R. part, préface, p. 6..