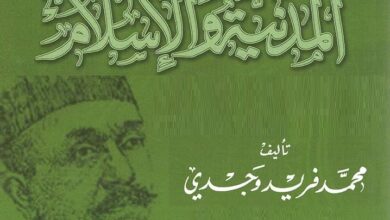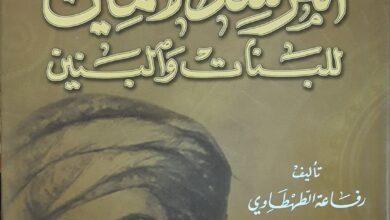انتشر العرب في أنحاء المعمورة وكانوا كلما دخلوا بلدًا امتدت معهم لغتهم، وانتشرت بانتشارهم وسرعان ما كان الناس يتعلمونها، ويتكلمون بها، ويجعلونها لغتهم «الرسمية» ولغة للتربية والتعليم.
والعربي لم يكن له غير سيفه ولسانه، يدفع بهما عن نفسه. فكانت محافظته على لغته أشبه بمحافظته على حياته. ولكنه اختلط بالأعاجم من غير جنسه، فتطرق اللحن إلى اللغة، وكثر الدخيل، فخيف على اللغة من أن تنهزم أمام هذا التيار الأجنبي، فرجع العربي إلى لغته الأصلية، واضطر للمحافظة عليها خوفًا من ضياعها أو تمكن الفساد فيها. فلم يجد غير الشعر العربي مرجعًا، ونموذجًا للغة الأصلية الصحيحة. هكذا كانت الحاجة إلى الشعر القديم بالمحافظة عليه، خصوصًا عندما امتد الإسلام وانتشر القرآن واحتاج المسلمون في تفسيره وفهم الأحاديث إلى معرفة العربية الصحيحة والرجوع إلى كلام العرب القديم. والقرآن جاء بلسان عربي مبين. وهو كلام الله تعالى فهو منزه عن الخطأ في اللفظ والمعنى، بل هو أصح وأولى بالاعتماد عليه والرجوع إليه في أصل اللغة من الشعر القديم، لعدم احتمال تطرق الخطأ إليه كما حصل في الشعر من عبث الرواة وجمعهم له بطرق هي مظنة الشك. فكان القرآن أصلًا من أصول اللغة ومرجعًا من أهم مراجعها في استخراج المعاني الصحيحة للألفاظ والتراكيب العربية وفنون الكلام وضروب التعبير المختلفة والمباحث العلمية حتى الحديثة منها تؤيد أن القرآن هو أصدق الكتب وأبعدها عن تطرق الشك في جمعه وصحته، لأن العالم لم يعن بكتاب عناية المسلمين بجمع القرآن. لذلك كان القرآن من أصح المصادر اللغوية ونماذج الكتابة عند العرب. جاء القرآن وهو كلام الله تعالى بلسان عربي مبين، فاتجهت الأفكار إلى فهمه وشرحه من جهة أنه أساس الدين «وقانون عام» لحياة المسلمين، ولكنه كتاب ديني قبل كل شيء، فكانت جميع المباحث والكتب الكثيرة التي كتبت في القرآن وشرحه وهي مئات ذكرها ابن النديم في الفهرست الغرض منها اثبات معجزات القرآن، وقد فهموا أن الاعجاز في البلاغة اللفظية أو في الأسلوب أو في النظم البديع الذي لا يمكن أن يجارى، أو أن الاعجاز إن لم يكن كله محصورًا في بلاغته فهذه هي أهم ما فيه من الاعجاز، وأدل على صدق دعوى الرسول عليه السلام حتى أن أعداء الدين الذين ادعوا النبوة والقدرة على أن يأتوا بمثله لم يقلدوه إلا من جهة النظم. فجاروه بفقرات مسجعه لا معنى لها لأنهم فهموا أو كانوا يفهمون أن البلاغة اللفظية هي كل شيء في القرآن([1]).
وعندما أراد المسلمون وصف البلاغة رجعوا إلى قواعد البيان المعروفة لديهم، وأخذوا «يحللون» الألفاظ من هذه الوجهة «تحليلًا» بيانيًا ليس له صلة كبيرة بالمعنى الاجتماعي ولا بالغرض المقصود من كتاب عظيم مثل القرآن. فكان هذا «التحليل» الأدبي بمعناه المقصود هو «تحليل» لفظي صناعي لا يدل على كل ما في هذا الكتاب الكريم من فنون الكلام وضروب البلاغة. قال الباقلاني في كتابه «اعجاز القرآن»:
«ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام: الايجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، والمبالغة، وحسن البيان، فأما الإيجاز فإنما يحسن مع ترك الاخلال باللفظ فيأتي باللفظ القليل الشامل لأمور كثيرة وذلك ينقسم إلى حذف وقصر، فالحذف الاسقاط للتخفيف كقوله {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وقوله {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} وحذف الجواب كقوله {وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى} كأنه قيل لكان هذا القرآن. والحذف أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب كل مذهب في القصد من الجواب. والإيجاز بالقصد كقوله {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} وقوله {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ} وقوله {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}. والأطناب فيه بلاغة: فأما التطويل ففيه عي وأما التشبيه بالقصد على أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حسن أو عقل كقوله {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا} وقوله {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}.
هكذا كانوا يفهمون بلاغة القرآن، ولكن نشأ من ذلك حركة عظيمة كانت فائدتها في اللغة والأدب عظيمة، لأنها أحدثت نوعًا من النشاط والميل إلى جمع أشعار العرب وشرحها ووضع المؤلفات الكثيرة في قواعد اللغة وعلوم الأدب كالنحو والصرف وعلوم البلاغة وغيرها مما كان سببًا في إحياء لغة العرب، وكثرت المباحث وانتشر النقد الذي كان يكون من أكبر حركات العقول وأظهرها لو أنه اتجه لغير المباحث اللفظية «السطحية».
لم يعرف العرب قبل القرآن كتابًا احتوى على هذه البلاغة ولا جاء بهذا التعبير البديع، ولا سيما هذا التماسك والطول اللذين ليسا من طبيعة العربي بله السامي، إذ كل ما كان للعربي فقرات قصيرة سواء أكان ذلك نثرًا أم شعرًا أم أفكارًا قد تكون ممتعة متينة في جمل مقتضبة وتراكيب غير وافية، فكان لابد من حدوث انقلاب عظيم في اللغة والبلاغة وأنواعها ولكن ذلك لم يكن كما سنبينه. نعم لا يمكن لأحد أن ينكر أثر القرآن في آداب العرب، فقد اقتبس الأدباء من كتابهم الكريم كثيرًا من الألفاظ والعبارات خصوصًا الخطب والرسائل وظهر أثر الدين وأثر عقيدة الإسلام في كتاباتهم نثرًا ونظمًا ورصعوا عباراتهم بالألفاظ الإسلامية واقتبسوا من القرآن آيات من البلاغة وقلدوه في بعض أساليبه، ولكن هذا التقليد وقف عند حد محدود، فلم يتعد الاقتباس لاعتقادهم أن القرآن لا يجارى في أسلوبه ولا في قوة بيانه، فوقفوا أمامه وقفة المبهوت الذاهل المعجب بالشيء اعجابًا بدون أن يجرؤ على الانتفاع بفوائده أو تقليده فيما يمكن. فكان مثلهم مثل من عنده بستان جميل مملوء بالأشجار المثمرة والأزهار الرائعة يوحي إليه هذا الجمال الاعجاب به بدون أن يجرؤ على أن يشم رائحته أو يقطف منه زهرة أو يتغذى بثمره، وكأنهم ظنوا أنهم إذا شموا رائحته التي تفوح في كل مكان لأن عبير الطيب لا يخفى إنما ينقصون من طيبه. فوضعوا أصابعهم في أنوفهم وتركوا رائحته يستنشقها النسيم وتملأ الجو عطرًا بدون أن يشعروا بذلك.
قلنا ونقول لا نزاع في أن علماء الأدب فهموا ما في القرآن من ضروب الابداع في القول وامتزج ذلك بنفوسهم امتزاجًا. ولكن أكثرهم فهم ذلك كله فهمًا آليًا أو فهمًا جزئيًا لأنهم وجهوا اهتمامهم إلى تحليل الألفاظ، وقصروا فهمهم على هذه الوجهة من البلاغة ففهموا جزءًا مما فيه وبحثوا في نوع خاص من البلاغة وقواعدها كشرحهم أوجه البلاغة في قوله تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} وإنها أبلغ من قولهم «القتل أنفى للقتل» فادركوا أسرار هذا الكتاب بنوع من التبجيل الممزوج بشيء من الخوف والرهبة. وظنوا أنه فوق العقول وفوق طاقة البشر، وأن الله تعالى إذا خاطب به الناس فإنما يخاطبهم بلسان إلهي وعبارات تناسب عظمته وجلالته. من هذه الوجهة أجلوا القرآن اجلالًا يليق به فطفقوا يبحثون فيه عن أوجه البلاغة ودلائل الاعجاز ولم يبقوا شيئًا في هذا الباب إلا طرقوه، وكتبوا المجلدات الضخمة في التفسير واللغة والبلاغة. ولكن كان غرضهم تأييد المعجزة والوجهة الدينية لا غير لم ينظروا إلى ما في هذا الكتاب نظر الباحث عما فيه من الابداع الفني في ذاته من غير نظر إلى الفكرة الدينية.
ولو أنهم نظروا إليه من الوجهة الأدبية لساعد الدين على الوقوف على ما فيه من بدائع الفنون وأسرارها. وحتى أنهم نسبوا ما جاء فيه من القصص إلى الأخبار الفانية السالفة لا إلى ما فيها من الصناعة القصصية كما قال الباقلاني.
وأما الوجه الثاني الذي ذكرناه من أخباره عن قصص الأولين وسير المتقدمين فمن المعجب الممتع على من لم يقف على الأخبار ولم يشتغل بدرس الآثار وقد حكي في القرآن تلك الأمور حكاية من شهدها وحضرها ولذلك قال تعالى {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} وقال {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ} فبين وجه دلالته من اخباره بهذه الأمور الفانية السالفة وقال {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ} هذه الآية.
وكان من همهم أن يميزوه عن جميع أنواع الكلام المعروف ولم يبينوا ذلك إلا بقولهم: إنه خارج عن العادة([2]) وغير مألوف.
ومن أفضل ما كتب في ذلك على طريقتهم المعروفة ما ذكره القاضي الباقلاني في كتابه اعجاز القرآن قال: «والوجه الثالث أنه بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه.» فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه منها يرجع إلى الجملة وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتادة وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع ثم إلى معدل موزون غير مسجع، ثم إلى ما يرسل ارسالًا فتطلب فيه الإصابة والإفادة وافهام المعاني المعترضة على وجه بديع وترتيب لطيف وإن لم يكن معتدلًا في وزنه وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل ولا يتصنع له. وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهذه الطرق ويبقى علينا أن نبين أنه ليس من باب السجع ولا فيه شيء منه وكذلك ليس من قبيل الشعر لأن الناس منهم من زعم أنه مسجع ومنهم من يدعي أن فيه شعرًا كثيرًا والكلام عليه يذكر بعد هذا الموضع فهذا إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة وأنه معجز وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في جميعه ومنها أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر…
([1]) كتب الباقلاني (فصل فيما يتعلق به الاعجاز) قال: إن قال قائل بينوا لنا ما الذي وقع التحدي إليه أهو الحروف المنظومة أو الكلام القائم باللذات أو غير ذلك. قيل الذي تحداهم به أن يأتوا بمثل الحروف التي هي نظم القرآن منظومة كنظمها متتابعة كتتابعها مطردة كاطرادها ولم يتحداهم إلى أن يأتوا بمثل الكلام القديم الذي لا مثيل له وإن كان كذلك فالتحدي واقع إلى أن يأتوا بمثل الحروف المنظومة التي هي عبارة عن كلام الله تعالى في نظمها وتأليفها الخ).
([2]) قلنا أنه نظم خارج عن جميع وجوه النظم المعتادة في كلامهم، ومباين لأساليب خطابهم ومن ادعى ذلك لم يكن له بد من أن يصحح أنه ليس من قبيل الشعر ولا السجع ولا الكلام الموزون غير المقفى، لأن قومًا من كفار قريش دعوا أنه شعر ومن الملحدة من يزعم أن فيه شعرًا، ومن أهل الله من يقول أنه كلام مسجع إلا أنه أفصح مما قد اعتادوه من أسماعهم؛ ومنهم من يدعي أنه كلام موزون فلا يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من الخطاب الخ. اعجاز القرآن