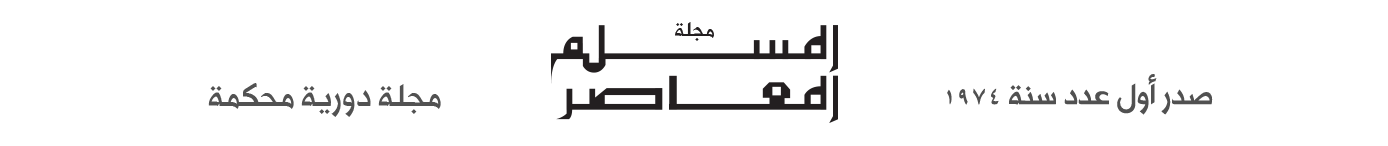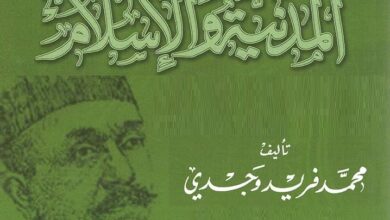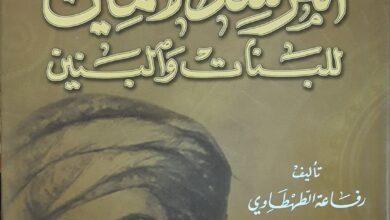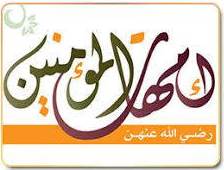المستقبل من التكديس إلى البناء:
لقد ظل العالم الإسلامي خارج التاريخ دهرًا طويلاً كأن لم يكن له هدف، استسلم المريض للمرض، وفقد شعوره بالألم حتى كأنه يؤلف جزءًا من كيانه. وقبيل ميلاد هذا القرن سمع من يذكره بمرضه، ومن يحدثه عن العناية الإلهية التي استقرت على وسادته؛ فلم يلبث أن خرج من سباته العميق ولديه الشعور بالألم، وبهذه الصحوة الخافتة تبدأ بالنسبة للعالم الإسلامي حقبة تاريخية جديدة يطلق عليها: النهضة، ولكن ما مدلول هذه الصحوة؟ إن من الواجب أن نضع نصب أعيننا المرض بالمصطلح الطبي لكي تكون لدينا عنه فكرة سليمة، فإن الحديث عن المرض أو الشعور به لا يعني بداهة الدواء.
ونقطة الانطلاق هي أن الخمسين عامًا الماضية تفسر لنا الحالة الراهنة التي يوجد فيها العالم الإسلامي اليوم، والتي يمكن أن تفسر بطريقتين متعارضتين:
فهي من ناحية: النتيجة الموفقة للجهود المبذولة طوال نصف قرن من الزمان من أجل النهضة.
وهي من ناحية أخرى: النتيجة الخائبة لتطور استمر خلال هذه الحقبة، دون أن تشترك الآراء في تحديد أهدافه أو اتجاهاته.
ومن الممكن أن نفحص الآن سجلات هذه الحقبة، ففيها كثير من الوثائق والدراسات ومقالات الصحف والمؤتمرات التي تتصل بموضوع النهضة. هذه الدراسات تعالج الاستعمار والجهل هنا والفقر والبؤس هناك، وانعدام التنظيم واختلال الاقتصاد أو السياسة في مناسبة أخرى، ولكن ليس فيها تحليل منهجي للمرض، أعني دراسة مرضية للمجتمع الإسلامي، دراسة لا تدع مجالاً للظن حول المرض الذي يتألم منه منذ قرون.
ففي الوثائق نجد أن كل مُصلح قد وصف الوضع الراهن تبعًا لرأيه أو مزاجه أو مهنته. فرأى رجل سياسي كجمال الدين الأفغاني أن المشكلة سياسية تحل بوسائل سياسية، بينما قد رأى رجل دين كالشيخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا بإصلاح العقيدة والوعظ… إلخ، على حين أن كل هذا التشخيص لا يتناول في الحقيقة المرض بل يتحدث عن أعراضه.
وقد نتج عن هذا أنهم منذ خمسين عامًا لا يعالجون المرض، وإنما يعالجون الأعراض، وقد كانت النتيجة قريبة من تلك التي يحصل عليها طبيب يواجه حالة مريض بالسل الجرثومي، فلا يهتم بمكافحة الجراثيم، وإنما يهتم بهيجان الحمى عند المريض.
والمريض نفسه يريد منذ خمسين عامًا أن يبرأ من آلام كثيرة: من الاستعمار، من الأمية، من الكساح العقلي، من…، وهو لا يعرف حقيقة مرضه ولم يحاول أن يعرفه، بل كل ما في الأمر أنه شعر بألم، فاشتد في الجري نحو الصيدلي، أي صيدلي، يأخذ من آلاف الزجاجات ليواجه آلاف الآلام.
وليس هناك في الواقع سوى طريقتين لوضع نهاية لهذه الحالة المرضية، فإما القضاء على المرض وإما إعدام المريض.
ولنا أن نتساءل حينئذ إذا ما كان المريض الذي دخل الصيدلية دون أن يدرك مرضه على وجه التحديد هل ذهب بمحض الصدفة لكي يقضي على المرض، أو هل يقضي على نفسه؟
هذا شأن العالم الإسلامي: إنه دخل إلى صيدلية الحضارة الغربية طالبًا الشفاء، ولكن من أي مرض؟ وبأي دواء؟ وبدهي أننا لا نعرف شيئًا عن مدة علاج كهذا، ولكن الحالة التي تطّرد هكذا تحت أنظارنا منذ نصف قرن، لها دلالة اجتماعية يجب أن تكون موضع تأمل وتحليل. وفي الوقت الذي نقوم فيه بهذا التحليل يمكننا أن نفهم المعنى الواقعي لتلك الحقبة التاريخية التي نحياها، ويمكننا أيضًا أن نفهم التعديل الذي ينبغي أن يضاف إليها.
فيجوز لنا أن نطلق على هذه الحقبة أنها بادرة حضارة، أو بلغة علم الإلهيات مرحلة إرهاص، وَجَّهَ فيها العالم الإسلامي جهوده الاجتماعية هادفًا إلى تحصيل حضارة.
فقد قرر على هذا ضمنًا أن اتجاهه هذا يمثل بالتحديد علاج مرضه، ونحن لا يسعنا إلا أن نوافقه على هذا دون أن نفعل سوى تقرير الواقع([1])؛ بيد أننا نريد هكذا أيضًا أن نحدد المرض ضمنًا، ثم ندع للصدفة المجال اللازم لها في حالة ما إذا كان المريض الذي لجأ إلى الصيدلية، لكي يبرأ – كما قلنا- من مرض لا يعرف عنه شيئًا محددًا، سيبرأ مصادفة بدواء يتعاطاه من القوارير.
فالعالم الإسلامي يتعاطى هنا حَبَّة ضد الجهل، ويأخذ هناك قرصًا ضد الاستعمار، وفي مكان قصي([2]) يتناول عقارًا كي يُشفى من الفقر؛ فهو يبني هنا مدرسة، ويطالب هنالك باستقلاله، وينشئ في بقعة قاصية مصنعًا، ولكنا حين نبحث حالته عن كثَب([3]) لن نلمح شبح البُرْء([4])، أي أننا لن نجد حضارة. ومع ذلك فهناك جهود محمودة يمكن أن نلاحظ من خلالها السلبية النسبية لجهود العالم الإسلامي، حين نقارنها بجهود اليابان مثلاً منذ خمسين عامًا، أو جهود الصين منذ عشر سنوات؛ فهناك شيء من الغرابة في الحالة التي نفحصها مما يدفعنا إلى تفهم كيفية سيرها وآليتها، ومن أجل هذا يجب أن نعرف المقياس العام لعملية الحضارة؛ ليلقي لنا ضوءًا كاشفًا على السلبية النسبية وانعدام الفاعلية في جهود المجتمع الإسلامي. إن المقياس العام في عملية الحضارة هو أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها، وسيكون من السخف والسخرية حتمًا أن نعكس هذه القاعدة حين نريد أن نصنع حضارة من منتجاتها.
يضاف إلى هذا أن القاعدة في علم الاجتماع ليست – كنظيرتها في علم الرياضة- حدًا صارمًا بين الحق والباطل، والخطأ والصواب؛ ولكنها مجرد توجيه عام يمكن به تجنب الأغلاط الفاحشة، إذ لا يمكن أن يوجد حد دقيق بين حضارة تتكوَّن وبين حضارة تكونت فعلاً. ونحن في القرن العشرين نعيش في عالم يبدو فيه امتداد الحضارة الغربية قانونًا تاريخيًا لعصرنا. ففي الحجرة التي أكتب فيها الآن كل شيء غربي، فيما عدا القلة التي أراها أمامي. فمن العبث إذن أن نضع ستاراً حديدياً بين الحضارة التي يريد تحقيقها العالم الإسلامي، وبين الحضارة الحديثة.
ولكن هذا يجسم المشكلة بأكملها، فليس من الواجب لكي ننشئ حضارة أن نشتري كل منتجات الأخرى. فإن هذا يعكس القضية التي سبق أن قررناها، وهو يقود في النهاية إلى عملية مستحيلة كماً وكيفاً.
فمن ناحية الكيف: تنتُج الاستحالة من أن أي حضارة لا يمكن أن تبيع جملة الأشياء التي تنتجها ومشتملات هذه الأشياء، أي أنها لا يمكن أن تبيعنا روحها وأفكارها وثرواتها الذاتية وأذواقها، هذا الحشد من الأفكار والمعاني التي لا تلمسها الأنامل، والتي توجد في الكتب أو في المؤسسات، ولكن بدونها تصبح كل الأشياء التي تبيعنا إياها فارغة دون روح وبغير هدف.
وهي بوجه خاص تمنحنا ذلك العديد الهائل من العلائق التي لا توصف، والتي تبعثها أي حضارة داخل أشيائها وأفكارها من جانب، وبين هاتين المجموعتين والإنسان من جانب آخر.
وفي استخدامنا للمصطلحات البيولوجية نجد أن الحضارة مجموعة من العلائق بين المجال الحيوي (البيولوجي)؛ حيث ينشأ ويتقوى هيكلها، وبين المجال الفكري؛ حيث تولد وتنمو روحها؛ فعندما نشتري منتجاتها فإنها تمنحنا هيكلها وجسدها لا روحها.
ومن ناحية الكم: لن تكون الاستحالة أقل، فليس من الممكن أن نتخيل العديد الهائل من الأشياء التي نشتريها، ولا أن نجد رأس المال الذي ندفعه فيها. ولئن سَلَّمنا بإمكان هذا فإنه سيؤدي قطعًا إلى الاستحالة المزدوجة، فينتهي بنا الأمر إلى ما أسميه الحضارة الشيئية، إلى جانب أنه يؤدي إلى تكديس هذه الأشياء الحضارية. ومن البيّن أن العالم الإسلامي يعمل منذ نصف قرن على جمع أكوام من منتجات الحضارة، أكثر من أن يهدف إلى بناء حضارة. وقد تنتهي هذه العملية ضمناً إلى أن نحصل على نتيجة ما، بمقتضى ما يُسمى بقانون الأعداد الكبيرة، أعني قانون الصدفة؛ فكوم ضخم من المنتجات المتزايدة دائماً يمكن أن يحقق على طول الزمن، وبدون قصد، حالة حضارة، ولكنا نرى فرقاً شاسعاً بين هذه الحالة الحضارية، وبين تجربة مخططة كتلك التي ارتسمتها روسيا منذ أربعين عاماً، والصين منذ عشر سنوات؛ هذه التجربة تبرهن على أن الواقع الاجتماعي خاضع لنهج فني معين، تطبق عليه فيه قوانين الكيمياء الحيوية والديناميكية الخاصة سواء في تكونه أم في تطوره.
ومن المعلوم أن عملية التحلل الطبيعي للأورانيوم لا تدخل في نطاق القياس الزمني للإنسان، إذ إن كمية معينة من هذه المادة ولتكن جرامًا، يتحلل نصفها طبيعياً خلال أربعة مليارات وأربع مئة مليون من السنين، ولكن المعمل الكيميائي قد توصل إلى أن تتم العملية الفنية للتحلل في بضع ثوان.
وبالمثل نجد أن عوامل التعجيل بالحركة الطبيعية بدأت تلعب دورها الكامل في دراسات الاجتماع، كما هو مشاهد في التجربة الخالدة لليابان، فمن عام ١٨٦٨م إلى ۱۹۰٥م انتقلت من مرحلة العصور الوسطى – أو ما سبق أن أطلقت عليه بادرة الحضارة – إلى الحضارة الحديثة. فالعالم الإسلامي يريد أن يجتاز المرحلة نفسها، بمعنى أنه يريد إنجاز مهمة تركيب الحضارة في زمن معين، ولذا يجب عليه أن يقتبس من الكيمياوي طريقته، فهو يحلل أولاً المنتجات التي يريد أن يجري عليها بعد ذلك عملية التركيب. فإذا سلكنا هنا هذا المسلك قررنا أن كل ناتج حضاري تنطبق عليه الصيغة التحليلية الآتية:
ناتج حضاري = إنسان + تراب([5]) + وقت.
ففي المصباح مثلاً يوجد الإنسان خلف العملية العلمية والصناعية التي يعد المصباح ثمرتها؛ والتراب في عناصره من موَصِّل وعازل، وهو يتدخل بعنصره الأول في نشأة الإنسان العضوية، والوقت (مناط) يبرز في جميع العمليات البيولوجية والتكنولوجية، وهو ينتج المصباح بمساعدة العنصرين الأولين: الإنسان والتراب.
فالصيغة صادقة بالنسبة لأي ناتج حضاري. وإذا ما درسنا هذه المنتجات حسب طريقة الجمع المستخدمة في الحساب، فسننتهي حتماً إلى ثلاثة أعمدة ذات علاقة وظيفية:
حضارة = إنسان + تراب + وقت.
وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى أن مشكلة الحضارة تتحلل إلى ثلاث مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون ذلك بأن نكدس المنتجات، وإنما بأن نحل هذه المشكلات الثلاث من أساسها. ومع ذلك فإن هذه الصيغة تثير عند التطبيق اعتراضاً هاماً هو: إذا كانت الحضارة في مجموعها ناتجاً للإنسان والتراب والوقت، فلِم لا يوجد هذا الناتج تلقائياً حيثما توفرت هذه العناصر الثلاثة؟ وإنه لعجب يزيله اقتباسنا للتحليل الكيماوي:
فالماء في الحقيقة نتاج للهيدروجين والأكسجين، وعلى الرغم من هذا فهما لا يكونانه تلقائياً؛ فقد قالوا إن تركيب الماء يخضع لقانون معين يقتضي تدخل مركب ما، بدونه لا تتم عملية تكوّن الماء. وبالمثل لنا الحق في أن نقول: إن هناك ما يطلق عليه مُركِب الحضارة أي العامل الذي يؤثر في مزج العناصر الثلاثة بعضها ببعض، فكما يدل عليه التحليل التاريخي الآتي مفصلاً، نجد أن هذا المركب موجود فعلاً، هو الفكرة الدينية التي رافقت دائماً تركيب الحضارة خلال التاريخ، فإذا اتضح صدق هذه الاعتبارات عن التفاعل الكيميائي الحيوي وعن ديناميكية الواقع الاجتماعي، كان لنا أن نخطط بطريقة ما مجال تطوره كاطراد مادي نعرف قانونه. وفي الوقت نفسه يسمح لنا ذلك بالقضاء على بعض الأخطاء التي يشيعها ما يطلق عليه أدب الكفاح في العالم الإسلامي؛ حيث يزكي ضمناً الاتجاه نحو التكديس.
من هذا الأدب الذي يبدي أحيانًا الإيمان المضطرم([6]) والأصالة الصادقة يتحول التكديس من نطاق الأحداث البسيطة الناتجة عن الصدفة، إلى نطاق الفكرة الموجهة؛ لقد هضمناه جملة وتمثلناه في سلوكنا. ولنقرأ مثلاً العبارة التالية([7]): «لقد سار العالم العربي في طريق هذه الحضارة التي يسميها الناس الحضارة الغربية، وما هي إلا حضارة إنسانية استمدت أسسها من حضارات إنسانية عديدة، ومنها الحضارة العربية الإسلامية؛ وأسهم ويُسهم في إغنائها شرقيون وغربيون، ملاحدة ومؤمنون، ولا رجوع للعالم العربي عن هذا الطريق ولا نكسة».
لا شك أننا نتذوق الجمال الأدبي والتوقيع الموسيقي في هذه العبارة، ولكن أخشى ما نخشاه أنها تترجم عن تفاؤلية صالحة لأن تقلل في أذهاننا من خطورة المشكلة.
أخشى ما نخشاه أن تنسينا أن كل ما أسهمنا ونسهم به في الإطار الغربي الذي نعيش فيه اليوم هو القلة، والقلة فقط.
وأخشى ما نخشاه أخيرًا من تفاؤلية كهذه، تدعيمها وتكثيرها للاتجاهات المؤسفة نحو التكديس في العالم الإسلامي.
الدورة الخالدة:
“إنه من السنن الأزلية أن يعيد التاريخ نفسه، كما تعيد الشمس كرتها من نقطة الانقلاب”. نيتشه
من الملاحظات الاجتماعية أن للتاريخ دورة وتسلسلاً، فهو تارة يسجل للأمة مآثر عظيمة ومفاخر كريمة، وهو تارة أخرى يلقي عليها دثارها([8])؛ ليسلمها إلى نومها العميق. فإذا ما أخذنا هذه الملاحظة بعين الاعتبار، تحتم علينا في حل مشكلاتنا الاجتماعية أن ننظر مكاننا من دورة التاريخ، وأن ندرك أوضاعنا، وما يَعْتَوِرُنا([9]) من عوامل الانحطاط وما ننطوي عليه من أسباب التقدم. فإذا ما حددنا مكاننا من دورة التاريخ، سهل علينا أن نعرف عوامل النهضة أو السقوط في حياتنا.
ولعل أعظم زيغنا وتنكبنا عن طريق التاريخ أننا نجهل النقطة التي منها نبدأ تاريخنا، ولعل أكبر أخطاء القادة أنهم يسقطون من حسابهم هذه الملاحظة الاجتماعية. ومن هنا تبدأ الكارثة، ويخرج قطارنا عن طريقه حيث يسير خبط عَشْواء([10]).
ولا عجب، فإن كوارث التاريخ التي تحيد بالشعب عن طريقه ليست بشاذة.
ونحن نجد مثلها في الكارثة التي أصابت العالم الإسلامي في واقعة صِفين فأخرجته من جو المدينة الذي كان مشحوناً بهدي الروح وبواعث التقدم، إلى جو دمشق حيث تجمعت مظاهر الترف وفتور الإيمان.
وعليه فإنه لا يجوز لأحد أن يضع الحلول والمناهج مغفلاً مكان أمته ومركزها، بل يجب عليه أن تنسجم أفكاره وعواطفه وأقواله وخطواته مع ما تقتضيه المرحلة التي فيها أمته، أما أن يستورد حلولاً من الشرق أو الغرب، فإن في ذلك تضييعاً للجهد ومضاعفة للداء. إذ كل تقليد في هذا الميدان جهل وانتحار.
وعلاج أي مشكلة يرتبط بعوامل زمنية نفسية ناتجة عن فكرة معينة، تؤرخ من ميلادها عمليات التطور الاجتماعي، في حدود الدورة التي ندرسها، فالفرق شاسع بين مشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغربية، ومشاكل أخرى تولدت في نطاق الدورة الإسلامية.
فالمشكلة التي أحاول درسها في هذا المؤلف ليست من المشاكل التي تخص عالم ١٩٤٨م، بل هي من المشاكل التي تخص عالم ١٣٦٧هـ. وإنني لأخشى ألا يعجب قولنا هذا بعض من تعودوا النشوة بالكلمات العذبة، أو ألفوا الاقتناع بالحلول المجربة في أمة من الأم؛ غير أني أحب أن أعجل إلى الموضوع فلا أضيع الوقت في سرد الأسباب والمسوغات التي يستند إليها أولئك المشعوذون.
إن كل شعب مسلم يعيش في عام ١٣٦٧هـ، أي في نقطة من دورته تنطلق منها الأحداث التي لا تزال في ضمير الغيب، وهي نفسها مادة مستقبلة؛ فإذا ما تطلعنا إلى الشعب الجزائري في هذه النقطة من التاريخ فإننا نجده والشعوب الإسلامية في مستوى واحد وفي مشكلات متقاربة، إن لم نقل متحدة؛ وبذلك فإننا نكون قد وضعنا المشكلة في مكانها من التاريخ، ونكون أيضاً قد جعلنا مشكلتنا في وضعها المناسب، وفي الطور الذي تستطيع منه أن تبدأ الحضارة دورها.
وعند هذه النقطة من تاريخنا يجدر بنا التساؤل: ها نحن أولاء على أُهْبة سفر، وإن قافلتنا لتشد رحالها، ولكن إلى أين تسير؟ وبأي زاد سوف تقطع الطريق؟ وإن هذا التساؤل لتحتمه علينا الظروف؛ فإنه في كل سفر يجب أن نعلم أي جهة نقصد؟ وبأي زاد نتزود؟
وإنه لسؤال جدير بالاهتمام، ولا يكفي فيه أن نجيب إجابات ارتجالية مقتضبة مثل «لا» أو «نعم»، بل يجب التأمل في سنن التاريخ التي لا تغيير لها، كما أشار إليها القرآن الكريم (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبْدِيلاً) [الفتح: ۲۳]، وكما وضحها ذلك العبقري عمدة المؤرخين ابن خلدون.
وأول ما يجب أن نعرفه عن شعب حديث اليقظة، لا تزال آثار النوم الطويل بادية عليه هو: هل بيده أسباب تقدمه؟
إننا نجد في القرآن الكريم النص المبدئي للتاريخ التكويني (Bio – histoire ) (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) [الرعد: ١١]، وينبغي ألا نقرر هذا المبدأ حسب إيماننا به فقط، بل يجب أن يكون تقريره في ضوء التاريخ.
و«نعم» لا تجدي جوابًا عن السؤال المطروح أمامنا، إلا إذا تأكدنا من شرطين:
أولهما: هل المبدأ القرآني سليم في تأثيره التاريخي؟
ثانيهما: هل يمكن للشعوب الإسلامية تطبيق هذا المبدأ في حالتها الراهنة؟
الشرط الأول: مطابقة التاريخ للمبدأ القرآني:
إذا نظرنا إلى الأشياء من الوجهة الكونية، فإننا نرى الحضارة تسير كما تسير الشمس، فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب، ثم متحولة إلى أفق شعب آخر.
وإنه لمفيد للقادة أن ينظروا هذه النظرة الفاحصة، فيدركوا طبائع الأشياء، ولكن الكثير منهم تأخذه العزة بالإثم، فيزعم أن إرادته فوق إرادة الأقدار، حتى ليكاد يقول: “يا شمس قفي”؛ وهيهات أن تقف الشمس، أو يسمع لهُرَائِه([11]) مستمع، فإن الأقدار لا تلبث أن تقود الحضارة إلى حيث قدر الله لها السير، من دور إلى دور، ومن فجر إلى فجر، غير عابئة بما يحاوله الباطل من إطفاء النور، أو تغيير الحقائق، ولا متلفتة إلى ما تبثه الزوايا من وهم، أو إلى ما يتخرَّص به الاستعمار([12]).
ومن المعلوم أنه حينما يبتدئ السير إلى الحضارة، لا يكون الزاد بطبيعة الحال من العلماء والعلوم، ولا من الإنتاج الصناعي أو الفنون، تلك الأمارات التي تشير إلى درجة ما من الرقي، بل إن الزاد هو المبدأ الذي يكون أساسًا لهذه المنتجات جميعًا.
ففي نقطة انطلاق الحضارة ليس أمامنا سوى العوامل المادية الثلاثة التي ألمحنا إليها فيما سبق من الكلام: الإنسان، التراب، الوقت. وفي هذه العوامل ينحصر رأس مال الأمة الاجتماعي الذي يمدها في خطواتها الأولى في التاريخ. ولقد سبق أن أشرنا من الوجهة النظرية إلى العامل الذي يمزج هذه العناصر الثلاثة فيكوِّن منها حضارة.
وسنشرع الآن في تحليل دور كامل من أدوار الحضارة، بل دورتين من الوجهة التاريخية، حتى نستخرج منه السر الكوني الذي يركب هذه العناصر الثلاثة: الإنسان، والتراب، والوقت ليبعثها قوة فعَّالة في التاريخ.
وحسبنا أن ندرس مثلاً الحضارتين الإسلامية والمسيحية في المرحلة الأولى من نشوئهما.
وكما يتضح من الشكل الذي رسمناه في فصل «أثر الدين في دورة الحضارة»، لا يختلف تطور الحضارة المسيحية عن تطور الحضارة الإسلامية؛ إذ هما ينطلقان من الفكرة الدينية التي تطبع الفرد بطابعها الخاص، وتوجهه نحو غايات سامية.
فالحضارة لا تنبعث – كما هو ملاحظ- إلا بالعقيدة الدينية([13])، وينبغي أن نبحث في حضارة من الحضارات عن أصلها الديني الذي بعثها، ولعله ليس من الغلو في شيء أن يجد التاريخ في البوذية بذور الحضارة البوذية، وفي البرهمية نواة الحضارة البرهمية.
فالحضارة لا تظهر في أمة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السماء، يكون للناس شرعة ومنهاجاً، أو هي – على الأقل- تقوم أسسها في توجيه الناس نحو معبود غيبي([14]) بالمعنى العام، فكأنما قُدّر للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية أو بعيداً عن حقبته، إذ حينما يكتشف حقيقة حياته الكاملة، يكتشف معها أسمى معاني الأشياء التي تهيمن عليها عبقريته وتتفاعل معها.
ومن هنا يستطيع المؤمن إدراك الحقيقة الساطعة التي يفسرها التاريخ، في الفقرة التي وردت في أحد الكتب المنزلة القديمة: «في البدء كانت الروح».
ومن المعلوم أن جزيرة العرب مثلاً لم يكن بها قبل نزول القرآن إلا شعب بدوي يعيش في صحراء مُجْدِبَة([15]) يذهب وقته هباء لا ينتفع به، لذلك فقد كانت العوامل الثلاثة: الإنسان والتراب والوقت راكدة خامدة، وبعبارة أصح، مكدسة لا تؤدي دورًا ما في التاريخ؛ حتى إذا ما تجلَّت الروح بغار حراء -كما تجلت من قبل بالوادي المقدس، أو بمياه الأردن – نشأت من بين هذه العناصر الثلاثة المكدسة حضارة جديدة، فكأنما ولدتها كلمة «اقرأ» التي أدهشت النبي الأمي وأثارت معه وعليه العالم. فمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية على مسرح التاريخ؛ حيث ظلت قروناً طوالاً تحمل للعالم حضارة جديدة، وتقوده إلى التمدن والرقي.
ومما هو جدير بالاعتبار أن هذه الوثبة لم تكن من صنع السياسيين ولا العلماء الفطاحل، بل كانت بين أناس يتسمون بالبساطة، ورجال لا يزالون في بداوتهم غير أن أنظارهم توجهت في تلك اللحظات إلى ما وراء أفق الأرض أو إلى ما وراء الأفق القريب، فتجلت لهم آيات في أنفسهم، وتراءت لهم أنوارها في الآفاق.
نعم إنه لمن الغريب أن يتحول هؤلاء البسطاء ذوو الحياة الراكدة، عندما مستهم شرارة الروح، إلى دعاة إسلاميين، تتمثل فيهم خلاصة الحضارة الجديدة، وأن يدفعوا بروحها وثبة واحدة، إلى تلك القمة الخلقية الرفيعة التي انتشرت منها حياة فكرية واسعة متجددة، نقلت من علوم الأولين ما نقلت، وأدخلت علومًا جديدة، حتى إذا ما بلغت درجة معينة، انحدرت القيم الفكرية التي أنتجتها دمشق وبغداد وقرطبة وسمرقند.
ومن هنا ندرك سر دعوة القرآن الكريم المؤمنين إلى التأمل فيما مضى من سير الأمم؛ وذلك حتى يدركوا كيف تتركب الكتلة المخصبة من الإنسان والتراب والوقت.
ولا شك في أن المرحلة الأولى من مراحل الحضارة الإسلامية التي ابتدأت من غار حراء إلى صفين – وهي المرحلة الرئيسية التي تركبت فيها عناصرها الجوهرية- إنما كانت دينية بحتة تسودها الروح.
ففي هذه الحقبة ظلت روح المؤمن هي العامل النفسي الرئيسي، من ليلة حراء إلى أن وصلت إلى القمة الروحية للحضارة الإسلامية، وهو ما يوافق واقعة صفين عام ٣٨هـ.
ولست أدري لماذا لم يتنبه المؤرخون إلى هذه الواقعة التي حولت مجرى التاريخ الإسلامي، إذ أخرجت الحضارة الإسلامية إلى طور القيصرية الذي يسوده عامل العقل، وتزينه الأبهة والعظمة، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر الفتور الدالة على أُفول الروح.
فإن مؤرخينا لم يروا في تلك الكارثة إلا ظاهرة ثانوية، وهي نُشُوء التشيع في العالم الإسلامي، مع تداولهم لحديث ألمح فيه الرسول إلى تلك الكارثة، وقد ورد فيه ما معناه: أن الخلافة تكون بعده أربعين عاما ثم تكون ملكًا عضوضًا([16]).
ولا شأن لنا هنا بتحقيق مدى صحته من جهة السند أو الرواية. الأمر الذي يهمنا هو أنه مما لا شك فيه أن الحضارة الإسلامية قد خرجت من عمق النفوس كقوة دافعة، إلى سطح الأرض تنتشر أفقياً من شاطئ الأطلنطي إلى حدود الصين.
وهكذا وجدنا الحضارة الإسلامية تتوسع وتنتشر فوق الأرض، تتغلب أولاً على جاذبيتها بما تبقى لديها من مخزون روحي، حتى إذا ما وَهَنَت([17]) فيها قوى الروح وجدناها تخلد إلى الأرض شيئًا فشيئًا.
وقد بدأ العلم في تلك الحقبة ينتشر بفضل أساتذة سطعت أسماؤهم في جو المعرفة، كالفارابي وابن سينا وأبي الوفاء وابن رشد.. إلى ابن خلدون الذي أضاءت عبقريته غروب الحضارة الإسلامية في نهايتها.
ومن هنا نستطيع أن نقرر أن المدنيات الإنسانية حلقات متصلة تتشابه أطوارها مع أطوار المدنية الإسلامية والمسيحية، إذ تبدأ الحلقة الأولى بظهور فكرة دينية، ثم يبدأ أفولها بتغلب جاذبية الأرض عليها، بعد أن تفقد الروح ثم العقل.
ذلك هو منحنى السقوط الذي تخلقه عوامل نفسية أحط من مستوى الروح والعقل، وطالما أن الإنسان في حالة يتقبل فيها توجيهات الروح والعقل المؤدية إلى الحضارة ونموها، فإن هذه العوامل النفسية تختزن بطريقة ما فيما وراء الشعور، وفي الحالة التي تنكمش فيها تأثيرات الروح والعقل، تنطلق الغرائز الدنيا من عقالها([18])، لكي تعود بالإنسان إلى مستوى الحياة البدائية.
وكذلك كان شأن المسلم، فقد بعث الدين فيه روحًا محركًا للحضارة، فلم يلبث بعد مرحلة قضاها في الخلافات والحروب أن عاد إلى حيث هو الآن، إنسانًا بدائياً.
ولو أردنا أن نسمي هذه المرحلة الخالية من الروح والعقل والخاتمة لكل حضارة، لأطلقنا عليها بلا تردد اسم المرحلة السياسية بالمعنى السطحي لكلمة “سياسة”.
والتجارب التاريخية العامة تؤكد أطوار الحضارات هذه، ولا تكاد حضارة ما تشذ عن هذه القاعدة.
ولقد يثير هذا التأكيد سؤالاً في أذهان القراء عما يسمى “حضارة شيوعية”، إذ لا يمكننا أن نرى فيها طابع الروح الذي عرفناه في الدورة العامة للحضارة، وبذا يقال: إن الشيوعية كحضارة ليست منبثقة عن عامل الروح!
هذا الخطأ الشائع إنما يأتي أولاً من تفسير أصول الشيوعية باعتبارها حضارة، ومؤلفات ماركس وأنجلز تخفي – في الواقع- التكوين الحقيقي للظاهرة الشيوعية بفصلها ظاهرًا عن دورة الحضارة المسيحية.
والحال أنها لا تجد تفسيرًا إذا ما ضربنا صفحاً عن الحضارة المسيحية، تلك التي تكون – عند تحللها- سطح التربة الخصيب؛ حيث استمدت الفكرة الماركسية حيويتها. فنحن على هذا مضطرون إلى أن نعتبر الشيوعية أزمة للحضارة المسيحية. هذا من الناحية التاريخية، ولنا أن نأخذ في اعتبارنا الناحية النفسية (السيكولوجية) التي تهمنا أكثر.
فمن هذه الناحية تعد الشيوعية النظرية قبل كل شيء فكرة ماركس، ولكن هناك شيوعية واقعية، هي في جوهرها نشاط المؤمنين المدفوعين بالقوى الداخلية نفسها التي دفعت غيرهم من المؤمنين في مختلف العصور، أولئك الذين شهدوا مولد الحضارات. فالظاهرة متماثلة في جوهرها النفسي، ومحددة هنا وهناك بسلوك الفرد نفسه حيال مشاكل المجتمع الناشئ.
فنحن لا يمكننا أن نفكر في المثل الذي ضربه استخانوف للطبقة العاملة في روسيا إبان تنفيذ المشروع الأول للسنوات الخمس، حين رُفع مستوى الإنتاج اليومي إلى الضعف في مناجم الفحم، دون أن نفكر في المثل الذي ضربه سلمان الفارسي، الذي كان يقوم بأضعاف العمل الذي يؤديه الصحابي الواحد في حفر الخندق حول المدينة في غزوة الأحزاب، أو الذي ضربه عمار بن ياسر حين كان يحمل حجرين على كاهله في بناء مسجد المدينة؛ حيث كان الفرد يحمل حجرًا واحداً. ففي كلتا الحالتين نجد أن الإيمان هو الذي مهد الطريق للحضارة.
وبتأمل الحضارة المسيحية الحالية نجدها تسير سيرة الحضارة الإسلامية التي سبقتها في الزمن، ومهما يكن في هذا التقرير من غرابة – إذ من البيّن أن مولد المسيحية يسبق الإسلام بمراحل – فإن التاريخ يؤيدنا فيما نذهب إليه. ذلك أنه يقرر أن الحضارة تولد مرتين، أما الأولى: فميلاد الفكرة الدينية، وأما الثانية: فهي تسجيل هذه الفكرة في الأنفس، أي دخولها في أحداث التاريخ.
وإذا كانت المدنية الإسلامية قد جمعت المولدَين في وقت واحد، فإن ذلك يعود إلى الفراغ الذي وجدته الفكرة الإسلامية في النفس العربية العذراء، التي لم تنشأ فيها ثقافة ولا ديانة سابقة، فخلا لها بذلك الجو.
ولم يكن حظ الحضارة المسيحية في نفوس أهلها وبيئتها كحظ الحضارة الإسلامية، فقد نشأت المسيحية في وسط فيه الخليط من الديانات، والثقافات العبرية والرومانية واليونانية، فلم يتح لها أن تدخل إلى قلوب الناس وسط الزحام الفكري الثقافي لتؤثر فيها تأثيرًا فعالاً. ولم يكتب لها أن تعمل عملها إلا عندما بلغت وسط البداوة الجرمانية في شمال أوربا؛حيث وجدت النفوس الشاغرة، فتمكنت منها وبعثت فيها الروح الفعالة التي اندفعت بها لتكون حلقتها في سلسلة التاريخ.
ومن المفيد أن أعزز هذا النظر برأي للمفكر هرمان دي كسر لنج في كتابه “البحث التحليلي لأوربا”؛ حيث يقول: (ومع الجرمانيين ظهرت روح خلقية سامية في العالم المسيحي).
ولعل عبارة هذا النص يمكن أن تبدو أصدق أو أقل صدقًا؛ إذ إن الروح السامية، التي يعنيها، ليست في التحليل النهائي سوى الفكرة المسيحية المتأهبة تماما للدخول في التاريخ. ولكن المفكر الألماني لم يتردد في القول: إن الميلاد النفسي للحضارة المسيحية متوافق مع ظهور روح خلقي.
ولا شك أن كُتابًا آخرين لاحظوا هذه الملاحظة أيضاً، بطريقة أو بأخرى، فالمؤرخ هنري بيرين قد لاحظ ذلك الارتباط بين بعث الدين وظهور الحضارة، في كتاب له عنوانه (محمد وشرلمان) وازن فيه بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية.
فإن المؤلف المذكور يرى في شرلمان الشخصية التي بعثت مبدأ المسيحية في النفوس البكر، فأنبتت فيها الحضارة، تماماً كما فعل الرسول من قبل.
وإنه لمن الأهمية التاريخية أن نلاحظ أن الروح المسيحية لم تجد طابعها الخاص في فن المعمار، إلا عندما تفاعلت هذه الفكرة مع القبائل الجرمانية، فتمثلت عبقريتها الفنية حينئذ في صورة المعبد القوطي، الذي يدل علو ارتفاعه على علو في الضمير الديني وطموح، ذلك الطموح الذي كان يهز أوربا من عهد الكارولنجيان([19]) إلى عهد النهضة.
فلما بدأت هذه النهضة خرجت حضارة أوربا من مرحلة السمو الروحي إلى مرحلة التوسع العقلي، التي انطبعت بطابع ديكارت، والتوسع في البلاد الذي حققه كرستوف كولومب باكتشاف أمريكا. وعودة أخرى إلى كتاب «البحث التحليلي لأوربا» توضح لنا هذا التطور، إذ يتحدث مؤلفه عن هذا التحول في الحضارة الأوربية في قوله: «وكان أعظم ارتكاز حضارة أوربا على روحها الدينية»، ثم بعد ذلك يفسر لنا الروح عاملاً اجتماعيًا فيقول: «ولست أعني بالروح ذلك الشيء الدال على منطق، أو عقل أو مبادئ مجردة، وإنما هو – بصفة عامة- ذلك الشعور القوي في الإنسان الذي تصدر عنه مخترعاته وتصوراته وتبليغه لرسالته، وقدرته الخفية على إدراك الأشياء».
وبالجملة يتعلق الأمر بحالة خاصة وشروط خلقية وعقلية ضرورية للإنسان لكي يستطيع أن ينشئ ويبلغ حضارة.
ولكن أليست هذه الشروط هي ما أشار إليه القرآن من تغيير النفس الذي جعل أساسًا لكل تغيير اجتماعي؟
ولنتساءل الآن: من أين لأوربا مبدأ الشعور الذي أتاح لها أن تخلق وتبلغ حضارتها؟ وكيف تغيرت نفسيتها؟
إن المفكر المذكور يجيب مرة أخرى فيقول: «إن الروح المسيحية ومبدأها الخلقي هما القاعدتان اللتان شيدت عليهما أوربا سيادتها التاريخية».
وإذا لم يكن كسر لنج قد وضَّح حتى الآن فكرة المراحل الثلاث للحضارة المسيحية، فإنه لا شك قد أشار إليها؛ ونحن نجد عنده تأييداً لفكرتنا عن تطور الحضارة وتنوع العوامل النفسية، إذ يقول: «إن مركز الثقل للحضارة تزحزح عن مكانه، وتحول بالنهضة والإصلاح الديني من مجال الروح إلى مجال العقل».
ولا شك أن ذلك التزحزح الذي يشير إليه كسرلنج إنما يعني المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الحضارة المسيحية في طورها العقلي.
وإذا لاحظنا عند كسر لنج إشارة إلى المرحلتين الأوليين لتلك الحضارة، فإننا نجد الإشارة إلى المرحلة الثالثة واضحة عند كتاب آخرين، إذ سادهم شعور بفناء المدنية الأوربية مثل أوزولد شبنجلر في كتابه «أفول الغرب».
ولعله من الواضح أن مشكلة الحضارة في العصر الحاضر لا تخص الشعوب الإسلامية فقط، بل إنها تخص أيضًا الشعوب المتقدمة نفسها، التي تتهدد فيها مدنيتها بالفناء.
وجملة القول: إن الوسيلة إلى الحضارة متوافرة ما دامت هنالك فكرة دينية تؤلف بين العوامل الثلاثة الإنسان، والتراب، والوقت، لتركب منها كتلة تسمى في التاريخ «حضارة».
الشرط الثاني: إمكانية تطبيق المبدأ القرآني الآن:
«أشد ما أثر في حياتي نصيحة سمعتها من أبي يا بني اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك». إقبال
إننا لكي نتوصل إلى التركيب الضروري حلاً للمشكلة الإسلامية، أعني مزج الإنسان والتراب والوقت، يجب أن يتوافر لدينا مؤثر الدين الذي يُغيّر النفس الإسلامية، أو كما يقول كسر لنج: «يمنح النفس مبدأ الشعور».
فهل يمكن تحقيق هذا الشرط في الحالة الراهنة للشعوب الإسلامية؟
إن التردد في الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب، لا يدل إلا على جهل بالإسلام، وبصفة عامة بتأثير الدين في الكون؛ فإن قوة التركيب لعناصر الحضارة خالدة في جوهر الدين، وليست ميزة خاصة بوقت ظهوره في التاريخ، فجوهر الدين – حسب العبارة الشائعة- مؤثر صالح في كل زمان ومكان.
وتسجيله في النفس وهو ما يهم التاريخ – كما سبق في حديثنا عن الحضارة المسيحية التي تركبت بعد ألف عام من ظهور الفكرة المسيحية – يمكن أن يتجدد ويستمر ما لم يخالف الناس شروطه وقوانينه، وهو ما ترمز إليه الآية الكريمة (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣] ومن هذه الوجهة نستطيع أن نقول:
إن العلماء الجزائريين كانوا أقرب إلى الصواب من السياسيين، حين دعوا إلى الإصلاح، بمعنى دفع النفس الإنسانية إلى حظيرة الإيمان من جديد، ولكن هؤلاء العلماء – لسوء الحظ- قد انحرفوا هم أنفسهم عن الطريق القويم متبعين رجال السياسة؛ ولقد كان الوقت مناسبًا لكي يعودوا إلى الطريق القويم واثقين من أنه لا نجاة بغيره، ولقد كان عليهم أن يستأنفوا جهدهم الذي بدؤوه، ثم قطعوه عام ١٩٣٦م، وأن يعدّوا الجيل القادم لحمل رسالة الحضارة في نفسه، وإلى معرفته كيف يضعها الوضع الصحيح في المستقبل، حتى يستطيع كل فرد أن يؤدي رسالته في مجاله الخاص، متحملاً في سبيلها الآلام الجسام، مغالبا هذه الآلام، والدين وحده هو الذي يمنح الإنسان هذه القوة، فقد أمد بها أولئك الحفاة العراة من بدو الصحراء الذين اتبعوا هدي محمد r.
وبهذه القوة وحدها يشعر المسلم – على الرغم من فاقته([20]) وعُريه الآن – بثروته الخالدة التي لا يدري من أمر استخدامها شيئًا.
العدة الدائمة:
عندما يتحرك رجل الفطرة ويأخذ طريقه لكي يصبح رجل حضارة، فإنه لا زاد له – كما بينا – سوى التراب والوقت وإرادته لتلك الحركة.
وهكذا لا يتاح لحضارة في بدئها رأسمال، إلا ذلك الرجل البسيط الذي تحرك، والتراب الذي يمده بقوته الزهيد حتى يصل إلى هدفه، والوقت الضروري لوصوله.
وكل ما عدا ذلك من قصور شامخات ومن جامعات وطائرات، ليس إلا من المكتسبات، لا من العناصر الأولية.
والمجتمع الإنساني يمكنه أن يستغني وقتاً ما عن مكتسبات الحضارة، ولكنه لا يمكنه أن يتنازل عن هذه العناصر الثلاثة التي تمثل ثروته الأولية، دون أن يتنازل في الوقت نفسه عن جوهر حياته الاجتماعية.
وقد تحقق هذا حين كانت الدول المتقاتلة في الحرب الأخيرة لا تقوِّم خسارتها في الحرب بالذهب والفضة بل بساعات العمل، أي بقِيم من الوقت، ومن الجهود البشرية ومن منتجات التراب؛ وهكذا كلما أصبح المكتسب غير كاف، أو حالت دون الحصول عليه عقبات، وكلما دقت ساعة الخطر، وأذنت بالرجوع إلى القيم الأساسية، استعادت الإنسانية مع عبقريتها قيمة الأشياء البسيطة التي كوّنت عظمتها.
تلك هي القيم الخالدة التي نجدها كلما وَجَبَ علينا العودة إلى بساطة الأشياء، أي في الواقع كلما تحرك رجل الفطرة، وتحركت معه حضارة في التاريخ.
* * *
([1]) يمكن معرفة نظرية المؤلف مفصلة عن الموضوع في كتابه “فكرة الإفريقية الأسيوية”، الجزء الأول – الفصل الثالث؛ حيث إن مشكلة الإنسان هي مشكلة الحضارة فقط.
([5]) تجنبنا قصدًا أن نستخدم في هذه المعادلة مصطلح «مادة» وفضلنا عليه مصطلح «تراب». والغرض من هذا الاختيار هو تحاشي اللبس في كلمة «مادة»؛ حيث إنها تعني في باب الأخلاق مفهوماً مقابلاً لكلمة «روح». وتعني في باب العلوم مفهوماً ضد مفهوم كلمة «طاقة». وفي الفلسفة نجدها تعطي فكرة هي نقيض ما يطلق عليه اسم «المثالية».
وعلى العكس من ذلك، لم يتطور مفهوم لفظ «تراب» إلا قليلاً، واحتفظ من حيث معنى المفردة ببساطة جعلته صالحاً لأن يدل بصورة أكثر تحديدًا على هذا الموضوع الاجتماعي. على أن هذا المصطلح قد ضم هنا بهذه البساطة مظهراً قانونياً يخص تشريع الأرض في أي بلد، ومظهراً فنياً يخص طرق استعماله. وهذان المظهران يمثلان مشكلة التراب.
([7]) من كتاب: هذا العالم العربي ص ٢١٤، تأليف الأستاذين نبيه فارس وتوفيق حسين.
([9]) يَعْتَوِرُنَا: يُصيبنا ويلم بنا. (م).
([10]) خَبْطَ عَشْواء: على غير هدى، يتحرك دون عقل ولا ضابط. (م).
([12]) ما يتخرص به الاستعمار: ما يدعيه من كذب، وما يفتعله من باطل. (م).
([13]) إننا نأخذ هنا هذه العبارة بمعناها العام. كما يعبر عنها أيضًا ولترشوبرت (waltar- schubart) في كتابه (أوربا وروح الشرق).
([14]) ولو كان غيباً من نوع زمني، أي في صورة مشروع اجتماعي بعيد الأمد مثل بناء مجتمع جديد يضع حجره الأول جيل، وتواصل بناءه الأجيال المتتابعة.
([15]) مجدبة قاحلة، لا زرع فيها ولا ماء. (م).
([16]) “الخلافة ثَلاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ المُلك”. رواه أحمد ٥/٢٢٠، ٢٢١.