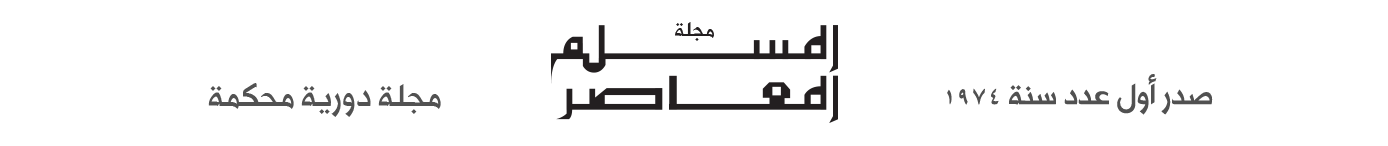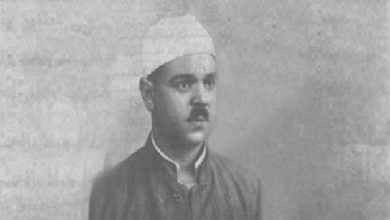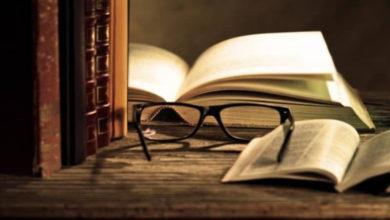إن التجديد في علم الأديان المقارن، يفرض على الباحث «المسلم» من جهة أولى الوعي المنهجي بالجدل الإبستيمي « Epistémé»، الذي انتهت إليه أدبياته، وحقول معرفية تُعدُ جزءًا من علم الأديان (علم الاجتماع الديني، الأنثربولوجيا الدينيّة، تاريخ الأديان…)، ومن جهة ثانية الوعي بالمعيارية التقليدية التي صاغت المنهج المقارن في التراث الإسلامي، واعتماده لإقرار عقائد أو حذفها أو الإضافة إليها، أو إبطالها كما استثمرته (المناظرة الدينية).
الأمر الذي تهدف إليه هذه الدراسة والتأسيس لتصوّر جديد قوامه؛ تجاوز العلاقة الجدلية القائمة بين الأديان وواقعها، والتأكيد على أنّ البحث المقارن لا يروم تبيّن وجوه المطابقة فقط بقدر ما يسعى إلى فهم الاختلاف وتبيّن دلالاته، كما صاغه بعض علماء الإسلام؛ أبو الحسن العامري (381ه)، وأبو الريحان البيروني (362 – 435ه) والعلامة ابن حزم الأندلسي (389ه – 456ه) رائد النقد الكتابي وأبو المعالي الجويني (419 – 478ه). والشهرستاني صاحب (الملل والنحل). وطوره علماء الغرب أمثال المنظر ميرتشيا إلياد، وإميل بورنوف (Emile Burnouf) في كتابه “علم الأديان”.
لهذا، فإن هذه الدراسة تحاول دراسة بعض الإشكالات الابستمولوجيَّة المرتبطة بعلم الأديان المقارن كما صاغه الغرب، والبحث عن أسس استئناف التجديد المنهجي لهذا العلم، من مدخل ما يقدمه القرآن والكتابات الإسلامية الأولى، وهو ما أسميناه بـ”الأصالة الإسلامية”.