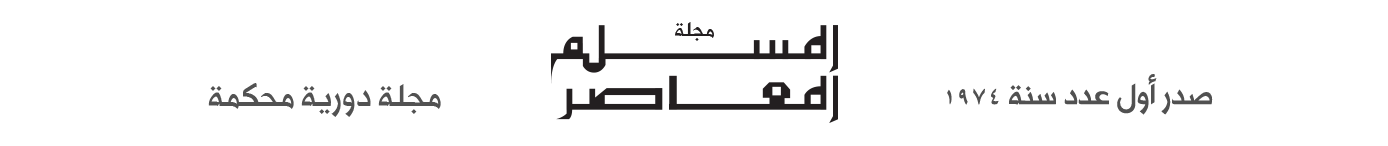(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) (الروم آية 21)
تعد قضية الإصلاح أحد الفروض الواجبة على المسلمين جماعة وأفرادًا في كل زمان ومكان، والإصلاح ينصرف إلى كل البناءات البشرية سواء كانت بناءات اجتماعية أم سياسية أم حتى معرفية وثقافية وقيمية. بيد أنه من المهم الإشارة إلى أن إصلاح أي بنية اجتماعية أو فكرية لا يرجع بالضرورة إلى فسادها في ذاتها (فقد تكون تلك البنى أثبتت نجاحًا فذًّا في زمان ومكان معين)، وإنما قد يرجع أحيانا إلى فساد علاقتها ببيئتها الحيوية ما يُترجَم في إخفاقها في تحقيق وظائفها؛ نتيجة لعوامل تاريخية أو تحولات في بيئتها الثقافية والاجتماعية ذاتها. تؤدي تلك التحولات إلى خلق حالة من عدم الملائمة وعجز عن التفاعل المثمر؛ مما ينتج إخفاقًا في قيام تلك البنى بوظائفها وعملياتها الداخلية والخارجية في ظل بيئتها الجديدة.
لا شك أن المجتمع العربي الإسلامي يمرّ حاليًّا بأزمات ضخمة وشاملة منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقيمي؛ ومن أخطر مؤشرات تلك الأزمات وصول المرض إلى العمود الفقري للمجتمع العربي المسلم وهو الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للنظام الاجتماعي. في هذا الإطار تُعنى هذه الورقة البحثية بطرح جوانب ضعف يتعيّن تداركها في المنظور الفقهي نتجت عن تطور في مقومات المجتمع واحتياجات البشر في العالم الإسلامي. وحيث تلعب المنظومة الفقهية – بصفتها بنية قانونية وقيمية وفكرية معًا- دورًا حيويًّا في صياغة الأسرة بصفتها بنية هي بمنزلة الركن في المنظومة الاجتماعية، فقد أصبح الإصلاح والتطوير في هذه المنظومة حتميًّا؛ كونه شرطًا لإصلاح المجتمع.
يهمني في مقدمة هذه الورقة البحثية الإشارة أولاً إلى خطة هذه الورقة من حيث موضوع البحث، والاقتراب المنهجي من هذا الموضوع، وأخيرًا الإطار المرجعي.
من حيث موضوع البحث تركز هذه الورقة على زاوية معينة ترى أنها ذات أولوية محورية في مناقشة موضوع الزواج والأسرة؛ ألا وهي تعريف الزواج في الفقه الإسلامي. فالتعريف هو البداية التي يتوقف عليها مجمل العلم بالشيء والتعامل معه، ومزايا التعريف وأمراضه تنتقل إلى سائر البناء.
أما الفقه الإسلامي فأهميته معلومة؛ إذ تستند مجمل المعالجة القانونية للأحوال الشخصية في أغلب بلدان العالم الإسلامي إلى الفقه الإسلامي. بل وتمتد هذه الرؤية إلى المخيال الشعبي والطرح الأيديولوجي الذي يسوي ويرادف الفقه بالدين والشريعة الإلهية، ولا ينظر إليه بوصفه تفسيرًا أو قراءة بشرية له.
من حيث الاقتراب المنهاجي فإن هذه الورقة تعتمد منهجًا اجتماعيًّا ثقافيًّا وليس قانونيًّا في تحليل قضية الزواج يتمثل فيما يعرف بالمنظور البنائي الوظيفي كمدخل. والداعي لذلك الاقتراب هو شموليته في التحليل؛ ذلك أن تحليل الأزمة التي تمر بها الأسرة العربية وإطارها القانوني – الاجتماعي المعروف بنظام الزواج يتطلب مراجعة وفحصًا شاملًا لا يقتصر فقط على تكوينها وعلاقاتها الداخلية، بل يتسع كذلك إلى أطرها القانونية والعناصر البيئية المؤثرة فيها. من هنا فقد كان المنهج البنائي الوظيفي هو الاقتراب الأفضل للنظر إلى قضية الأسرة والزواج؛ حيث يشمل هذا المنهج كلًّا من العمليات، والعلاقات، والبنى، والأدوار، والتفاعلات النمطية، والوظائف، ومحاولات التكيف والتغيير(1)، كما يتسع ليشمل الأبعاد القانونية، والاجتماعية، والمعنوية القيمية، والأيديولوجية.
وباختصار فإن هذا المنظور يقدّم صورة شبه متكاملة تستوعب أغلب عناصر البحث.
العنصر الثالث في هذه الورقة هو الإطار المرجعي؛ والإطار المرجعي للورقة هو الإطار المرجعي الإسلامي. ويقتضي اللبس المقترن حاليًّا بما هو “إسلامي” تحديدًا أدق؛ ونعني بالإسلامي هنا المرجعية التي تُحاكم على أساسها كل القراءات والرؤى الإسلامية بما فيها القراءة الفقهية، وهي المرجعية المستمدة من الأصول (القرآن والسنة)، وبخاصة ما يتعلق منها بالرؤى الكلية التي تعتقد الباحثة أنها تحكم وتوجه جميع المنظورات الجزئية بما فيها المنظور الفقهي القانوني.
التعريف: بين النكاح والزواج
تناقش كتب الفقه قضية الزواج والأسرة بجل أبوابها تحت عنوان رئيس هو “كتاب النكاح”، ورغم أن الفقهاء يرادفون بالمعنى بين مفهومي الزواج والنكاح إلا أن فارقًا كبيرًا بين المصطلحين يعكس نتائجه على مجمل المنظور الفقهي للزواج. فبينما يحمل لفظ ومصطلح الزواج مدلولاتٍ اجتماعيةً وقانونيةً غالبةً فإن لفظ النكاح الذي يعني لغويًّا الوطء أو الضم يسحب القضية من المجال الاجتماعي إلى المجال الشخصي والحسي المباشر، الأمر الذي يعكس نفسه على مجمل المنظور الفقهي للزواج.
في المعنى والمصطلح الأصولي ينصرف معنى النكاح عند الفقهاء إلى ثلاثة معانٍ: الوطء والعقد أو مشترك بين العقد والوطء.
وفي نظرة إلى المعنى المشترك الثالث وبعض تعريفاته بين المذاهب(2)؛ يُعرّف بعض الحنفية الزواج بوصفه “عقدًا يُفيد ملك المتعة قصدًا”، وبعضهم يقول إنه يُفيد ملك الذات في حق الاستمتاع، ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبُضع.
أما الشافعية فقد عرّف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن “ملك الوطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما”، والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك، وبعضهم يقول إنه يتضمن إباحة الوطء فهو عقد إباحة لا عقد تملك.
وخفّف المالكية حدود موضوع العقد فجعلوه “عقدًا على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة فعله، غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور(3)“، وينصرف هذا التعريف لابن عرفة المالكي على جعل موضوع العقد هو متعة التلذذ فقط دون الملك. أما الحنابلة فقالوا إنه عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع، ويريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم.
إن المدلول المادي المباشر للزواج بوصفه شراء الرجل البُضع أو حق الانتفاع أو التلذذ به قد انعكس حتى على صيغ التعاقد ذاته؛ فنجد الحنفية مثلا يجيزون انعقاد النكاح بألفاظ الهبة أو الصدقة أو التمليك؛ كأن تقول المرأة ملّكتك نفسي. بل قالوا إن الزواج بلفظ البيع والشراء -كأن تقول المرأة بعتُ نفسي منك بكذا ناوية به الزواج- به خلاف ولكن الصحيح أن الانعقاد يتم به(4).
مناقشة للتعريفات:
تثير هذه التعريفات الفقهية العديد من التساؤلات والتعليقات حول مدى صلاحيتها أو كفايتها في الإحاطة بمفهوم الزواج، ونجمل هذه الملاحظات على النحو التالي:
أولاً: إن التعريف في عموم استخدامه ينصرف إما إلى ماهية الشيء أو وظيفته.
ثانيًا: على الجانب الوظيفي تنحو التعريفات الفقهية في إجمالها منحًى حسيًّا ماديًّا يختزل الزواج -كما هو واضح- اختزالًا شديدًا في وظيفة معينة من وظائفه هي وظيفة الاستمتاع الجنسي. ولعل هذا ما تجلى في المرادفة في استخدام مفهومي الزواج بصفته ممارسة اجتماعية والنكاح الذي يفيد الوطء أو العلاقة الجنسية.
ويثير التركيز على هذه الوظيفة إلى حدّ تعريف الزواج بها تساؤلا حول المصدر الذي استقى منه الفقهُ هذا المفهوم. وقد يشير بعضهم إلى الآية الكريمة (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء آية 24).
والآية كما هو واضح من منطوقها لا تقدّم تعريفًا للزواج قدر ما تقدّم تبريرًا وتفسيرًا لفريضة الإنفاق على النساء التي أوجبها الله تعالى على الرجال. فالآية تخاطب الرجال وتحاول تطييب خواطرهم نحو هذه الفريضة بتقديم القضية في صورة علاقة تبادلية رشيدة يكتسب منها المرء بقدر ما يدفع ويُعطي. ولا تحدد الآية الكريمة مجال أو موضوع الاستمتاع بل تتركه مجهلا للتعميم؛ ما يفتح الباب لما هو أوسع من الاستمتاع الحسي والجنسي، فهي قد تفيد جملة عطاء المرأة العاطفي والاجتماعي والإنساني لزوجها ولأسرتها عموما الذي يستغرق جزءًا كبيرًا من حياتها ويشغلها عن طلب الرزق. وقد استخدم القرآن الكريم في مواضع أخرى مفهوم المتعة والتمتع ليس فقط بالمعنى الحسي، بل بالإشارة إلى أرقى مستويات الاستمتاع الروحي، وأحيانًا أخرى بمعنى الاستفادة والانتفاع على العموم(5).
إن التعريف الفقهي المقدّم للزواج يتجاهل الوظيفة الاجتماعية للزواج التي تمثل جوهر مفهوم الزواج بوصفه نظامًا اجتماعيًّا. فتعريفات الزواج المشار اليها آنفًا تركز على الزواج بوصفه عملية حسية، وتتجاهل أن الزواج هو أكبر من “عملية” نكاح بل هو كذلك علاقة، ومؤسسة، ونظام.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى تعدد الوظائف الاجتماعية للزواج: ومنها ما يتعلق بتلاحم وتماسك المجتمعات من خلال بناء شبكة علاقات الرحم والنسب والصهر (الأسرة) أو ما يعرف في علم الاجتماع بنظام القرابة(6) the kinship system، وما يترتب عليها من منظومة هائلة من الحقوق والالتزامات والأحكام التي أفاض فيها القرآن الكريم، وعظّمها، ودعا الناس إلى اعتبارها ورعايتها؛ يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (سورة النساء آية 1).
من الوظائف الاجتماعية الأساسية للزواج والأسرة التناسل أو إعادة إنتاج النوع، وما يرافقها من حماية الجيل الجديد من النوع البشري، وتوفير محضن ملائم لحمايته ونموه في مرحلة نشأته وضعفه، إلى جانب ما يرافق ذلك من عمليات التنشئة أو إعادة إنتاج قيم وأفكار الجماعة من خلال غرسها في النشء عبر وظيفة التنشئة والتربية، وبذلك تلعب الأسرة دورًا كبيرًا في المحافظة على هذا النظام الاجتماعي وقيمه وهُويته إلى جانب تحقيق تماسكه(7)، كما يقوم نظام الزواج بدور محوري بصفته ميكانيزمًا من ميكانيزمات الاستمرارية للبشر ماديًّا وقيميًّا. ولعل افتقاد تعريف الزواج أو النكاح لتلك الجوانب الأساسية ما دعا الفقهاء إلى استدراك بعض جوانب هذا النقص في الأبواب التالية للفقه؛ مثل قول الحنفية: “إن الغرض الصحيح من الزواج إنما هو التناسل الذي به تكثر الأمة ويعز جانبها”(8).
ومن الوظائف الاجتماعية المهمة للزواج والأسرة وظيفة الضبط الاجتماعي للشهوات والسلوك الجنسي والعاطفي التي يُعرّفها المصطلح الإسلامي بمفهوم الإحصان بمعنى توفير إطار اجتماعي قانوني شرعي؛ لإشباع الرغبة الجنسية الطبيعية، ولممارسة العلاقات الجنسية المسئولة، وما يترتب عليها من نتائج مثل الإنجاب، بما يوصد الأبواب أمام الفوضى الجنسية التي يفضي تفشيها إلى نتائج سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ولعل هذا ما عبّر عنه الذكر الحكيم بقوله: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (سورة الإسراء آية 32).
وتؤدي الأسرة ونظام الزواج وظائف اقتصادية مهمة؛ كونه لمراحل طويلة على مدى التاريخ البشري كان -إلى جانب وظائفه الأخرى- نظامًا للإعالة؛ فحتى مراحل قريبة من التاريخ البشري كان السواد الأعظم من النساء في العالم عاطلاً أو معطلاً عن الكسب والمشاركة في إنتاج الثروة، ومن ثم في توليد الدخل. بل لا يزال الأمر في عديد من ربوع بلادنا سائرًا على هذا النحو، وقد اقتضى ذلك على مدى التاريخ ابتكار نظام اجتماعي وقانوني لإعالة نصف النوع البشري، وقام نظام الزواج بهذه الوظيفة بصفتها واحدة من أهم وظائفه. وإذا كانت إعالة النساء بصفتها مطلبًا اجتماعيًّا قد شهدت تحولاً جذريًّا مع تعلم النساء وخروجهن إلى ميادين العمل والكسب، فإن وظيفة نظام الزواج بوصفها نظامًا للإعالة لا تزال باقية سواء في القيام بوظيفة إعالة الأطفال والنشء غير القادر، أم إعالة قطاع كبير من النساء غير العاملات على الديمومة، أم بصفة مؤقتة زمن حمل الأطفال ورعايتهم المبكرة. كما يلعب الزواج دورًا مهمًّا في عملية توزيع الثروة من خلال نظام الوراثة.
يقترن بالوظائف الاجتماعية الوظائف السيكولوجية للنظام؛ مثل الإشباع العاطفي والشعور بالأمن؛ حيث تمثل الأسرة سياجًا يُوفّر الحماية والأمان النفسي والاجتماعي للإنسان الفرد ودائرة من التفاعل الاجتماعي الآمن. وقد شدّد القرآن الكريم على هذا الدور للزواج من خلال إشارته إلى دور الزواج في توفير السكن والمودة والرحمة يقول تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (سورة الروم آية 21)، ويضاف لما سبق توصيفات عدة لعلاقات الزوجين والعلاقات الوالدية عبّر عنها القرآن الكريم بمفاهيم عدة مثل الإحسان والمعروف.
مما سبق يتجلى واضحًا حجم القصور في التعريف الفقهي للزواج، وعجزه عن إدراك الوظائف الاجتماعية والسيكولوجية والعاطفية أو الأخلاقية المهمة التي يعترف بها الإسلام، بل ويجعلها بمنزلة القلب من مقاصد وأهداف ووظائف نظام الزواج. إذا أردنا أن نلخص مشكلة التعريف الفقهي للزواج وظيفيًّا في عبارة واحدة؛ فيمكن القول باختصار إن التعريف الفقهي يقدم الزواج ببساطة كعملية، في المقابل فإن كُنه الزواج علاقة تخلق مؤسسة تلعب دورًا محوريًّا في تشكيل نظام كامل.
لقد انعكس المفهوم الحسي المادي للزواج الذي تبنى صيغة “النفقة مقابل البضع أو الوطء” على جميع أبواب ومسائل فقه النكاح، فبدلا من التركيز على البعد التفاعلي والسلوكي الاجتماعي في العلاقة الزوجية، وترجمة مفاهيم الإحسان والفضل والمودة والرحمة والشورى التي أشار لها القرآن الكريم، احتلت قضية العلاقة الجنسية والإنفاق المادي مكانة محورية في فقه الزواج؛ فأفردت لها مباحث كاملة مثل؛ مبحث الوطء بشبهة، والخلوة والنكاح الفاسد، ومهر السر، وإذا عجز الزوج عن دفع الصداق، وإذا كان الصداق عينا فحدث به زيادة أو نقص، وشروط المهر وتأجيل الصداق وتعجيله، وتصرف الزوجين في الصداق بالهبة والبيع.. إلخ.
في المحصلة فرغم الأهمية التي تحظى بها المسائل المادية والحسية في منظومة الزواج إلا أنها لا تمثل الركن الأهم الذي يطغى على سائر الأبعاد المعنوية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية في مؤسسة ونظام الزواج على النحو الذي قدّمه فقه النكاح.
ثالثًا: من الناحية الشكلية التي تركز على النكاح بوصفه عقدًا فإن السمة الجلية في تعريف النكاح فقهيًّا هي الافتقاد للنظرة المتوازنة للعقد بوصفه علاقة بين طرفين تُتبادل فيه المصالح على نحوٍ متوازنٍ، وتبني منظور ذي اتجاه واحد يعد مصلحة الرجل في عقد النكاح. فالرجل في المنظور الفقهي هو الطرف الأصيل صاحب حق الانتفاع، في حين كانت المرأة مجرد موضوع للعقد أو هي الشيء المنتفع به، وليست متعاقدًا متساوي الإرادة والمصلحة. أما تمتعها (أو استفادتها) حتى بالجانب الحسي الذي جعل قوامًا للزواج فهو مجرد مندوب وليس واجبًا.
فقد جعل الفقهاء الأصل في العقد هو تمتع الرجل فهو مقصود العقد وواجبه، أما تمتع المرأة فهو فضيلة؛ يقول الشافعية إن الراجح هو أن المعقود عليه بالمرأة أي الانتفاع ببضعها. وعلى هذا القول لا تطالبه بالوطء لأنه حقه، ولكن الأولى له أن يحصنها ويعفها. أما القول بأن المعقود عليه كل من الزوجين وهو ما يجعل لها الحق في مطالبته بالوطء فهو قول مرجوح(9). أما الحنفية فقالوا إن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة بمعنى أن للرجل أن يجبر المرأة على الاستمتاع بها بخلافها فليس لها جبره إلا مرة واحدة، ولكن يجب عليه ديانة أن يحصنها ويعفها لكي لا تفسد أخلاقها(10).
كما تتجلى هذه النظرة الأحادية المتحيّزة لدى تحليل الفقهاء لأبعاد العقد مثل أركان النكاح وشروطه؛ فالمالكية يقرون خمسة أركان(11) للنكاح هي: ولي المرأة، والصداق، والزوج، والزوجة (بشرط خلوهما من الموانع)، والصيغة. وبينما يرى فقهاء المالكية أن هناك عاقدين هما الزوج والولي، فإن المرأة هي معقود عليها مثلها مثل الصداق؛ بمعنى أنها في مركز المفعول به وليس الفاعل رغم كونها من أركان العقد(12).
جهود ومحاولات معاصرة لإعادة التعريف
إن محاولة تعديل أو مراجعة أي شق في الموروث الفقهي لا تبدو قضية سهلة؛ لأن الموروث الفقهي يقدم منظومة متكاملة الأركان، تبدأ من المنظور أو الرؤية المتعلقة بالإنسان والعالم (وإن يكن مسكوتًا عنه)، وتنتهي بتفاصيل الأحكام. هذا يعني أولًا أن التعديلات أو المراجعات في الفقه ينبغي أن تستند إلى حركة شاملة لاستئناف أو إعادة فتح باب الاجتهاد، ويعني ثانيًا أن هذه الحركة ينبغي أن تبدأ بتقديم براديم أو منظور جديد أو مختلف لقضية الإنسان في الإسلام، ومن ثم علاقته بالعالم (دنياه وآخرته)، وبالمجتمع وبوظيفته في الحياة. ورغم الدعوة المتكررة إلى إعادة فتح باب الاجتهاد أو ما شابه من دعوات؛ مثل تجديد الفكر الديني وخلافه، فإن القضية تبدو أكثر تركيبًا وصعوبة خصوصا في ظل الخلط الكبير بين الفقه بوصفه منتجًا إنسانيًّا، وبين المرجعيات والأصول الإسلامية ممثلة في القرآن والسنة الثابتة، وما يقدمانه من شريعة وأحكام.
يمكن القول إنه على مدى مائتي عام – منذ بدء عملية التحديث وبروز ثنائية وتناقضات الحديث والقديم وفجواته في الواقع والإدراك- برزت محاولتان فقط جديرتان بالاهتمام في مجال الاجتهاد الفقهي.
الأولى: محاولات فردية قام بها مجتهدون أفراد لم ترتقِ إلى مستوى التيار أو الحركة؛ نذكر من هؤلاء في الفقه السني بمصر شيوخًا أجلاء كمحمد عبده وعبد الوهاب خلاف ومحمد أبو زهرة. وتتسم هذه المحاولات أنها اجتهادات حذرة جزئية لا تنطلق من رؤية متكاملة مغايرة، بل تقوم ببعض التعديلات الجزئية ولا يقدّمها أصحابها بوصفها فقهًا جديدًا، بل إضافة واستئنافًا للموروث مع تعديلات. ورغم انتماء العديد من هؤلاء المجتهدين لمؤسسة الأزهر، إلا أن اجتهاداتهم ظلت فردية في حين غابت المؤسسة الأزهرية الأم عن عملية الاجتهاد، ولا تزال متمسكة بدورها العتيد في المحافظة والتقليد دون التجديد.
الاتجاه الثاني هو فقه الدولة وهو فقه فرضه قيام الدولة العربية المعاصرة بمسئولية التشريع، وتعامل واحتكاك الدولة العربية المعاصرة بشكل مباشر مع تحديات العصر ممثلة في الضغوط الدولية والتحولات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن تلقي أجهزة الدولة لجميع البيانات المتعلقة بالواقع وأزماته ما لا يتوفر لآحاد العلماء، وأخيرًا اضطرار الدولة إلى إجراء مواءمات بين ثقافة المجتمع وبين احتياجاته الملحة. يمكن القول إن “فقه الدولة” هو المجال الأكبر والأهم لحركة الاجتهاد الفقهي المعاصر، رغم ما يشوبه من اختلاط بين الممارسة الفقهية المتعلقة بالرجوع للمصادر والارتكاز إليها في الاستنباط، وبين التشريع الوضعي الذي يمثل الاتجاه العالمي في مرحلة الحداثة.
في هذا الإطار السابق يمكن طرح نموذجين أو محاولتين مهمتين لإعادة تعريف الزواج بوصفه قضية، التعريف ليست قضية هيّنة بل هي المقدمة التي ترتكز عليها سائر منظومة الأحوال الشخصية:
أولاً: نموذج لمحاولات عالم فرد هو الشيخ محمد أبو زهرة لتقديم تعريف فقهي معدل للزواج
يبدأ الشيخ أبو زهرة بنقد التعريفات الفقهية السابق الإشارة إليها عند فقهاء المذاهب الأربعة، وتُعرّف الزواج باعتبار مقصده الأساسي هو ملك المتعة وحلها، فهو يرى أن الزواج ما كان سنة الإسلام لأن فيه قضاء الطبع الإنساني فقط بل لمعانٍ اجتماعية ونفسية ودينية”(13). ويرى أن التعريف الفقهي بمنحاه المشار إليه “قد يكون من مقاصده عند الناس، بل قد يكون أهم مقاصده عند بعضهم، ولكنه ليس مقصد الشارع وليس أهم المقاصد عند الفضلاء الذين سمت مداركهم، وليست أسماها عند العلماء أجمعين… بل إن المقصد الأسمى في الشرع وعند أهل الفكر والنظر هو التناسل وحفظ النوع الإنساني، وأن يرجو كل واحد من العاقدين في صاحبه الأنس الروحي الذي يؤلف بينهما، وتكون به الراحة وسط الحياة وشدائدها؛ لذلك قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)(14).
ويضيف العلامة أبو زهرة إنه “إذا كانت تعريفات الفقهاء لا تكشف عن المقصود من هذا العقد في نظر الشارع، فإنه يجب بيانه بتعريف كاشف عن حقيقته والمقصود منه عند الشارع وعند العقلاء”. ويقدم أبو زهرة تعريفه الذي يرى أنه تجنب عيوب التعريفات السابقة؛ فيعرف الزواج بأنه: “عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة؛ بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات“(15).
تعليق حول تعريف أبو زهرة:
برغم التقدّم الذي يتضمنه هذا التعريف من خلال محاولته الخروج بالزواج من دائرة التمركز حول المعاشرة الجنسية وثنائية البضع مقابل النفقة، فإن هذا التعريف احتمل بعض جوانب القصور منها:
أولاً: استمرار تبني اقتراب شخصي ليس اجتماعي للزواج بالنظر إليه بوصفه علاقة تدور أساسًا بين شخصين.
ثانيًا: غياب عنصر إرادة المتعاقدين في إبرام التعاقد، وهو بعد شديد الأهمية للمرأة يتعلق بإثبات تمام شخصيتها وأهليتها القانونية التي تنتفي عنها، وذلك بنص بعض المذاهب على اشتراط موافقة الولي لصحة العقد، بل وجواز إجبار الولي المرأة الصغيرة والبكر على الزواج دون موافقتها.
ثالثًا: يتميّز التعريف بإضافة بعض ملامح معنوية وسلوكية (فوق الحسية) للزواج مثل التعاون، لكن يغيب عنه عناصر أخرى نصّ عليها القرآن صراحة، ويؤدي إضافتها إلى تغيير بل وتحسين مفهوم الزواج كلية؛ مثل: الشورى، والمعروف، والإحسان، والمودة، والرحمة… إلخ.
فقه الدولة: مدونة الأحوال الشخصية المغربية وتعريفها للزواج نموذجًا
لم تحظَ جهود الدولة القانونية، وما تصدره من تشريعات تتعلق بالأحوال الشخصية بدراسة وافية كمدرسة بعينها للفقه قامت بمجهودات حقيقية؛ لتحديث فقه الأسرة والأحوال الشخصية بحسب احتياجات الواقع الاجتماعي وتطوراته، كما عنيت بممارسة عملية كاملة للاجتهاد سواء استناداً إلى القياس أم الاجتهاد بالنظر إلى المصلحة بما يلائم مقاصد الشارع، وذلك في ظل حرص الدولة الحديثة في أغلب البلدان الإسلامية على الإبقاء على الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في دائرة الشريعة الإسلامية(16).
ولعل هذا التجاهل يشي بالعديد من الدلالات من بينها؛ نظرة الشك التي أحيطت بها الدولة الحديثة من قبل علماء الدين والمؤسسة الدينية بصفتها لا تعكس سلطة إسلامية بالمنظور الشرعي، بل هي تعبير عن صاحب الشوكة. كما يشي أيضا ذلك التجاهل باستمرار مفهوم الوصاية والاحتكار من قبل المؤسسة الدينية على الأمور الشرعية؛ فما لا تنطق به أو تقره المؤسسة الدينية لا يدخل في مجال الأحكام الشرعية.
ومن أبرز قوانين الأحوال الشخصية التي تحمل تلك الملامح السابقة، وتشكل محاولة اجتهادية متقدمة لتطوير فقه الزواج والأسرة مدونة الأحوال الشخصية المغربية الصادرة عام 2004(17). وقد نصّ القانون في ديباجته على الأسس الشرعية التي استند إليها في تخريج أحكامه، ويستفاد من هذا الشق المنهاجي أن القانون نهج العديد من المسالك الاجتهادية؛ منها توسيع دائرة الاستنباط ومدّها إلى آيات لم يدخلها الموروث الفقهي ضمن آيات الأحكام، مثل (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) التي استنبطت منها أحكام لتقييد الحق المطلق في التعدد والطلاق في هذا القانون.
ومن آليات الاجتهاد كذلك تفعيل بعض القواعد الفقهية العامة والمقاصد في توليد الأحكام، وقد نصّ القانون في ديباجته على الإصلاحات التي تضمنها القانون وقامت بالأخذ “بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ووحدة المذهب المالكي؛ لوضع مدونة عصرية للأسرة منسجمة مع روح الدين الإسلامي الحنيف”(18).
إلى جانب ما سبق فإن المدونة استندت كثيرًا إلى الانفتاح على اجتهادات المذاهب الأخرى، ومنها المذهب الحنفي وبخاصة في قضايا ولاية المرأة الرشيدة على النفس.
فيما يخص تعريف الزواج فقد قدّمت المدونة تعريفا متقدمًا للزواج في مادتها الرابعة مفاده أن الزواج هو: “ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقًا لأحكام هذه المدونة“(19).
يحمل هذا التعريف مزايا عديدة؛ أولًا: التأكيد على العنصر التعاقدي الرضائي في إنشاء الرابطة الزوجية. ثانيًا: الارتفاع بالبعد الشخصي والخاص من المستوى الحسي المادي المتمثل في عملية الوطء التي دارت حولها تعريفات الفقهاء إلى إبراز المقصود الشرعي من هذه العملية الحسية؛ ألا وهو الإحصان والعفاف. ثالثًا: إبراز البعد الاجتماعي للزواج إلى جانب البعد الشخصي بالتأكيد على أن غاية الزواج هو إنشاء الأسرة. رابعًا: وهي مزية تعد قفزة في مفهوم الزواج ذاته؛ وذلك بالنص على أن الأسرة تقوم برعاية الزوجين ما يفيد عنصر المشاركة في المسئولية.
برغم تلك المزايا تظل هناك ملاحظتان مهمتان على تعريف المدونة: الأولى هي الافتقار إلى دمج العناصر المعنوية والعاطفية بوصفها جزءًا لا يتجزأ من محتوى الزواج ومقصوده، وقد نصّ عليه القرآن في إشارته إلى المودة والرحمة والسكن بين الزوجين. وتثير قضية الأبعاد العاطفية للزواج إشكاليات لدى العقلية القانونية التي تصيغ الأحكام والتشريعات؛ فالقانون بطبيعته يهتم بصفة عامة بالوقائع المادية التي يمكن إثباتها أو التحقق منها أو نفيها، ويتجنب العناصر المعنوية غير القابلة للإثبات.
غير أن هذه القاعدة القانونية تحتمل -ككل قاعدة- استثناءات لعل أهمها موضوع الزواج الذي يقوم في جانب كبير منه على الأبعاد العاطفية والإنسانية، وإلا انتفى جانب مهم من مقصده. كما أن الفقه ليس قانونًا خالصًا بل هو أحكام شرعية تنبع من الدين، وتكتسب إلى جانب مكونها القانوني مكونًا أخلاقيًّا ومعنويًّا وقيميًّا محوريًّا.
غير أن إدراج الأبعاد المعنوية بوصفها مكونًا أساسيًّا في الزواج تثير بالضرورة معضلات أخرى تتعلق بإثبات أو نفي توافر تلك المكونات عند اللجوء للقضاء. والثابت أن هناك حالات عديدة يصعب إثباتها، وقد ارتكن الشرع في هذه الظروف إلى الإحالة للضمير الديني والحساب الأخروي، كما هو الحال في واقعة اللعان، وفي دعوى الخلع من جانب المرأة.
الإشكال الثاني في تعريف المدونة إغفاله مسئولية الرجل عن الإنفاق بصفته حقًّا مكتسبًا من حقوق النساء في الإسلام. والواقع أن هذا الإغفال يعكس تأثرًا كبيرًا بالطرح الغربي الذي يرى أن تأكيد مسئولية الزوجين عن الأسرة ينبع من تشاركهما في مغانم ومغارم الزواج المادية. هذه الرؤية ليست صحيحة بحسابات الواقع فقيام الرجل بمسئولية الإنفاق لا يعني تفضلاً على المرأة بل عدلاً؛ لأن المرأة تقوم بدور هائل في توفير الرعاية المعنوية والعاطفية والاجتماعية لأسرتها، حتى لو لم تقم بمسئولية الإنفاق المادي. الأمر الثاني أنها تتحمل مغارم كثيرة بالفعل لا تقل عن النفقة؛ مثل الحمل، والإنجاب، والرضاعة (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا)، وهي ليست مغرمًا في المال بل في النفس والجسد. والأمر الثالث والمهم أن قيام المرأة بتلك الأدوار فضلاً عن دورها البيولوجي في الحمل والولادة، يحرم كثيرًا من النساء واقعياً من فرص التفرغ للكسب المادي، وعليه فإن إعفاء الرجل من عبء الإنفاق يؤدي إلى مضاعفة الحمل على المرأة لا العدل في توزيع المسئوليات.
بناء على ما سبق من ملاحظات يمكن في ختام هذا البحث اقتراح بعض تعديلات في تعريف الزواج يبني على الإنجاز الذي حققته المدونة المغربية، بما يتجاوز ما أشرنا إليه من ثغرات، ويؤكد في الوقت نفسه على الأبعاد الاجتماعية، وعلى التوازن بين إرادات الزوجين ومنفعتهما من إنشاء رابطة الزوجية؛ ليكون التعريف على النحو التالي:
“الزواج هو علاقة تعاقدية بين رجل وامرأة، يتفق طرفاها بنفسيهما أو (بمن ينوب عنهما) على إنشاء أسرة. ويترتب لكلا الطرفين بمقتضى هذه العلاقة حقوق وواجبات الإحصان والمساكنة والمعاشرة بالمعروف على أساس من المودة والرحمة، كما ترتب على الزوج نفقة زوجه وأبنائه منها وفق ما يقره الشرع، ويتفق عليه الطرفان”.
ختامًا لهذه الورقة يتعيّن التأكيد على أن إصلاح منظومة الزواج يتعلق بتجديد فقه الزواج، وتجديد فقه الزواج يبدأ بعَدّ ودمج الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهومه القرآني في التعريف، وما يترتب عليه من تحديد لأركان وشروط الزواج(20).
كما أن إصلاح منظومة الزواج يتعلق بدوره بتأكيد مفهوم الإرادة المشتركة لإنشاء عقد الزواج، فالتعامل مع المرأة بصفتها طرفًا فاعلاً وليس موضوعًا لعقد الزواج؛ إنما يعني قفزة نوعية نحو إنصاف النساء، وإعادة الاعتبار لقضية التوازن والعدل الاجتماعي، والأهم من ذلك إعادة الاعتبار لفكرة حقوق الإنسان في منظومة الإسلام، وإزالة ما لحق بها من تشوهات جراء دخول الأعراف وثقافات مجتمعية تتسم بالعصبية والعنصرية والتمييز إلى هذه المنظومة العظيمة عبر أبواب الفقه.
وعلى الله قصد السبيل
* * *
الهوامش
(1) ينظر هذا الاقتراب إلى كل الكيانات الاجتماعية والفكرية بوصفها بنى تتشكل بدورها من وحدات قد تكون في ذاتها بنى فرعية. وتكتسب الوحدات الفرعية قيمتها من وظيفيتها للبنى الأكبر بمعنى مدى قيامها بوظائفها في دعم البنية الكبرى سواء في الحفاظ عليها أم دعم تماسكها الداخلي أم المساهمة في تكيفها مع البيئة والتحديات الخارجية. أما علاقة البنية ببيئتها فتتخذ نمط النظام الذي يشير إلى عمليات ووظائف تتعلق بتلقي مدخلات من البيئة، ثم معالجاتها من خلال تحويلها داخليًّا، وإطلاقها في صورة مخرجات للتعامل مع التحديات البيئية، وتلقي ردود الفعل من خلال تغذية معادة، هذا فضلا عن وظائف وعمليات التكيّف التي يحدثها النظام في بنيته وعملياته ما ينتج في النهاية تطوره.
(2) انظر عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع: قسم الأحوال الشخصية، كتاب النكاح (القاهرة: دار الإرشاد للطباعة والنشر، د ت) ص ص 2-3.
(3) يعني المحرمات من النساء.
(4) المرجع السابق، ص 12.
(5) مثال ذلك قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (آية 196 من سورة البقرة). وقوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (آية 128 من سورة الأنعام). وقوله: (كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (آية 69 من سورة التوبة).
(6) للتعرف على مفهوم النظام القرابي ونموذج لدراسته وتحليله من منظور بنائي وظيفي انظر:
HARRY M. JOHNSON, “The Structural-Functional Theory of Family and Kinship”, in Journal of Comparative Family Studies, Vol. 2, No. 2 (AUTUMN 1971), pp. 133-144
(7) Ibid.
(8) الجزيري، مرجع سابق، ص 7.
(9) الجزيري، مرجع سابق، ص 3.
(10) المرجع السابق، الصفحة نفسها .
(11) الركن هو ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به.
(12) الجزيري، مرجع سابق، ص11.
(13) حول هذه المعاني انظر: محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت)، ص44.
(14) المرجع السابق، ص43
(15) المرجع السابق، ص 44.
(16) حول مستويي الاجتهاد وارتباط الاجتهاد على أساس المصالح المرسلة بحركة الإدارة انظر: أبو زهرة المرجع السابق، ص11.
(17) انظر: قانون رقم 70.03 بمنزلة مدونة الأسرة.
(18) المرجع السابق، ص 7.
(19) المرجع السابق، ص 10.
(20) هند مصطفي، الفضاء المعنوي للزوجية في البيان القرآني: العلاقة بين الزوجين بين المنظور القرآني والقراءة الفقهية، في مجلة المرأة والحضارة (القاهرة: جمعية دراسات المرأة والحضارة، العدد الثالث 2002) ص ص 54-84.
* * *
المراجع
- شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية، فتاوى النساء، تحقيق: الدكتور أحمد السايح والدكتور السيد الجميلي (القاهرة: دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 1408هـ – 1987م).
- عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع: قسم الأحوال الشخصية، كتاب النكاح (القاهرة: دار الإرشاد للطباعة والنشر، د. ت).
- مالك بن أنس، الموطأ، صحّحه ورقّمه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: كتاب الشعب، د. ت).
- محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره (القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت).
- د. يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (القاهرة: دار الحديث، د. ت).
- HARRY M. JOHNSON, “The Structural-Functional Theory of Family and Kinship”, in Journal of Comparative Family Studies, Vol. 2, No. 2 (AUTUMN 1971), pp. 133-144
* * *