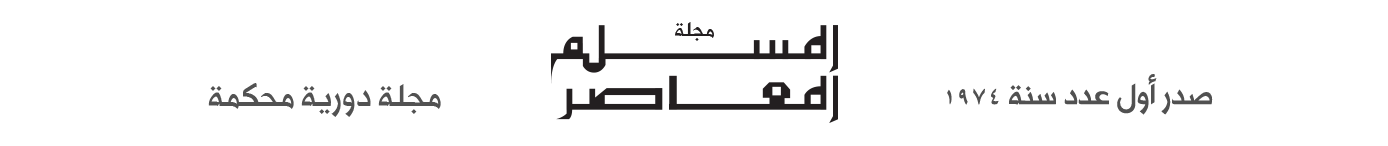تشكل قضية التخوم في كتابات أحمد صدقي الدجاني عنصراً من عناصر رؤيته متعددة الأبعاد للانتماء، والمقصود بالتخوم هو المناطق الجغرافية بين البلدان. فنظرة الناس للتخوم وتعاملهم معها متصلان أشد الاتصال بمفهومهم عن انتمائهم وهويتهم، بل ربما هما منبقثان من هذه الرؤية. ولما كانت قضية التخوم تتصل بعنصر المكان الجغرافي؛ لذا يمكن النظر إليها هلى أساس أنها واحدة مما يمكن تسميته بالعناصر المادية للانتماء مثل المواطنة، حيث تكمل هذه العناصر ما يمكن تسميته بالعناصر المعنوية للانتماء، مثل: الدين والعرق واللغة. وليس المقصود بهذا التصنيف نفي الجوانب الملموسة للعناصر المعنوية من دين وقومية ولسان، ولا المراد منه حبس قضية التخوم ومعها المواطنة داخل قفص الماديات المنفصلة عن المعنويات. كلا، بل المقصود والمراد هو التمييز بين عناصر الانتماء التي تبدأ أساسا من الوضع المعنوي متضمنا داخل النفس البشرية أكثر مما هو متضمن في الجغرافيا، رغم أن علاقة قد تجمعها بالجغرافيا، وبين عناصر الانتماء التي تبدأ أساسا من وضع متضمن في الواقع الملموس والجغرافيا أكثر مما هو متضمن في الحالة الشخصية رغم أن علاقة قد تجمعها بالمعنويات.
ويبدأ الدجاني حديثة عن التخوم موضحاً أن ” الفكر السياسي العربي مدعو إلى أن يولي قضية الحدود السياسية القائمة في الدائرتين: العربية، والحضارة الإسلامية عناية خاصة” (تجديد: 185). والغالب أن هذه الدعوة تستند إلى حاجة فكر الأمة لإقامة الوزن بالقسط بين اهتمامته بعناصر الانتماء. فالاهتمام المعاصر منصب في بعضه علي العناصر المعنوية للانتماء كالدين واللسان، الأمر الذي بدا في المناقشات الممتدة حول العلاقة بين الإسلام والعروبة. والواقع أن هذا الاهتمام مفتقر لاستنباط الرؤى والتصورات التي تتناول قضايا واقعية ملموسة، مثل قضية التخوم، فتبين المبادئ التي تحكمه، والقواعد التي تنظمها. وهو منصب في بعضه الآخر علي العناصر المادية، كالقومية والمواطنة، والذي إذا تناول قضية التخوم لاتصالها المباشر بالقومية والمواطنة، إنما يتناولها بمعزل عن استلهام تعاليم الدين الواردة بصددها، أي بعد فصلها عن العناصر المعنوية لمفهوم الانتماء.
المنطلق العام
لعل المنطلق العام الذي ينبع منه مفهوم الدجاني عن التخوم يقوم علي ثلاثة مبادئ: مبدأ التعارف، ومبدأ التعاون علي البر والتقوى، ومبدأ تذليل الأرض. فالمبدأ الأول يظهر في المثال الذي ساقه عن الخليج إذ قال: ” تأملت في المكان وأنا أقف على شاطئ الخليج في جزء من جزيرتنا العربية، وألحت علي فكرة تتعلق ” بمناطق الوصول” في عالمنا، هي ” ما لهذه المناطق من دور خاص في تحقيق التواصل بين الشعوب والقبائل والأمم علي طريق تعارفها” (وحدة: 199). والواقع أن القرآن أسس أن مبدأ التعارف هو من غايات الخلق ومن علل تمييز الناس إلي شعوب وقبائل (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) (الحجرات: 13). فالدجاني يشيد نظرته لقضية التخوم علي أساس انقسام الناس التلقائي إلى شعوب وقبائل والذي يؤدي للتعارف. والمثير أنه يعطف الأمم علي الشعوب والقبائل بما لم تتضمنه الآية الكريمة؛ إذ تضمنته آية أخرى – آية الوسيطة – التي تقول (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ) (البقرة: 143).
فهو يكتشف في الوسطية معنى مكملاً لمعناها المعروف. فالمعنى المشهور هو كون تعاليم الأمة أو توجهاتها في موقع وسط بين تعاليم الأمم الأخرى وتوجهاتها. لكن الوسطية إذ ترتبط بالتعارف تعبر عن كونها وسطية جامعة، فجزء من مقصدها أن تكون الأمة بتعاليمها وتوجهاتها مركز التجاذب بين الأمم لا أن تتوسطها فكراً فقط، والوسطية القائمة علي المزاوجة بين معنى الموقع ومعنى الجمع هي التي تؤهل الأمة للشهادة المنوطة بها علي الناس. ويدعم الدجاني فطرية التعارف بالعودة لطبيعة الإنسان ومسلكه العمراني، إذ يقول: ” ألح علي سؤال من خلال استحضاري بعد الزمان، وكنت خارجا من زيارة السوق الشعبي الذي رأيت فيه بضائع آسيوية كثيرة، هل طبيعة الاجتماع الإنساني تجعل المناطق التي تقع في أطراف ” الدوائر اللغوية القومية” مؤهلة لتكون مناطق ” وصل” أم مناطق “فصل” بين هذه الدوائر؟ لقد خلق الله الإنسان اجتماعيا بالطبع، وجعل له الأرض ذولا ليمشي في مناكبها، وجعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، فالأصل هو “الوصل” وليس “الفصل”، “فالحدود” التي يتم رسمها بين الدول يجب أن ينظر إليها بمنظار الوصل وليس الفصل، إذا أردنا الانسجام مع طبيعة الاجتماع الإنساني” (وحدة: 200).
وبجانب التعارف فهناك مبدأ التعاون علي البر والتقوي، حيث يشير الدجاني إلى ” ما لهذه المناطق من دور خاص في تحقيق التواصل بين الشعوب والقبائل والأمم علي طريق تعارفها، ومن ثم تعاونها لخير الإنسان على البر والتقوى، والسمة الخاصة لها بحكم هذا الدور” (وحدة 199). الغالب أن الانطلاق من مبدأ التعاون علي البر والتقوى في التعامل مع قضية التخوم يرجع إلى عمق الدور الذي يلعبه مبدأ التعاون في هذه القضية. ذلك أن التخوم هي المناطق التي تبرز فيها حاجة الأمم لبعضها البعض.
فالتخوم تتضمن ممرات يابسة أو مائية تحتاج كثير من الأمم أن تسلكها للوصول إلى غايات تستهدفها، وهنا يظهر اعتماد الأمم علي بعضها، وبالتالي ضرورة التعاون لتوفير حاجات الشعوب. ويؤكد أهمية مبدأ التعاون على البر والتقوى في قضية التخوم أن فتيل عدد كبير من الحروب التي تنشب بين الأمم هو حرمان أمة أمة أخرى أن تفيد من تخومها؛ لذا كان مبدأ التعاون علي البر والتقوى من المبادئ الحاضرة بشدة في قضية التخوم.
ويلخص الدجاني الصلة بين مبدأي التعارف والتعاون علي البر والتقوى، وضوابط إعمالهما بقوله: ” تأملت في ” الإنسان” الذي يقع على عاتقه مسئولية القيام بدور الوصل، فوجدت أنه إنسان يتمثل عقيدة تدعو إلى التعارف والتعاون علي البر والتقوى بين بني البشر، وتستجيب للفطرة الإنسانية في التواصل الإنساني. وهو إنسان يعتز بانتمائه لقومه ولا يستعلى، ويتسمك بلسانه وحضارته ولا ينغلق، ويعيش عصره منفتحاً على الآخرين مادا إليهم يد التفاهم من موقع الندية والثقة بالنفس” (وحدة 201). ولنا أن نتوقف قليلا أمام استخدامه كلمة ” الإنسان” ووضعه إياها بين علامتي تنصيص، فلابد أن هناك حكمة كامنة في هذا التركيز على هذه الكلمة. ربما يكون من وراء اختيار هذه الكلمة ما للإنسانية من معان لصيقة بمبدأي التعارف والتعاون علي البر والتقوي. فهي الكلمة التي ” تجمع” المخاطبين بهذين المبدأين، من حيث إنها تستدعي المشترك الذي يلتقون عنده. وليس في ظني ثم كلمة أخرى تعطي هذه المعاني.
فكلمات مثل المجتمع أو الفرد أو ما شابه لا تتسق والمعاني التي يرومها مبدآ التعارف والتعاون ضمن الرؤية القرآنية لهذين المبدأين. فهي كلمات توحي بأن كلا من المتعارفين منفصل تماماً عن الآخر، بينما كلمة ” إنسان” تؤكد أنهما متصلان، وأن ثم رابطا يوحد بينهما عضويا. ولعل هذه المعاني هي من وراء استخدام القرآن صيفة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) في مستهل حثه علي التعارف، ولعلها تمثل بعض ما عناها حديث النبي صلى الله عليه وسلم.. ” اللهم ربنا رب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة” (الكاندهلوي: 351).
كذلك تنطلق نظرة الدجاني إلى قضية التخوم من مبدأ تذليل الأرض. وهو واضح في قوله: ” لقد خلق الله الإنسان اجتماعيا بالطبع، وجعل له الأرض ذلولا ليمشي في مناكبها” ( وحدة: 200). فتذليل الأرض مقدمة ضرورية للمشي في مناكبها، والمشي في مناكب الأرض مقدمة ضرورية لاكتساب الرزق، (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (الملك: 14 ، 15). وتنزيل الله الرزق لعباده من الضرورات التي استتبعها خلقه لهم، حيث نلمح هذا القانون – أن كل مخلوق مرزوق – في الربط الدائم الذي نجده في عامة القرآن بين فعل الخلق وفعل الرزق (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ) (فاطر: 3). لكل ذلك، كان أي وضع من شأنه تعطيل فعالية تذليل الأرض أو تعسير المشي في مناكبها، مؤديا إلى التعدي على المبدأ الإلهي بإتاحة الله الرزق لعباده الذين خلقهم جميعاً، بغض النظر عن وضعهم الإيماني (يَا أَيُّهَا النَّاسُ)، مما يمثل تعديا على قوانين الخلق الإلهية.
ولعل مرجع مصاب قرية سبأ هو تعديها على سنة الله في خلقه وأرضه، وخاصة في تعاملها السيىء مع قضية التخوم، بما عطل تحقق المبادئ المذكورة، الأمر الذي يتضح في قوه تعالى: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) (سبأ: 18 ، 19). فقد كانت القرى المجاورة لها قريبة منها؛ بما جعل الترحال عبر التخوم الكائنة بينها وبين تلك القرى أمرا مطمئنا، سواء بالنهار أو بالليل. كما كان الخير يعم سبأ (جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ) (سبأ: 15). لكنها أعرضت عن الحق، كما رغبت أن تتسع التخوم بينها وبين القرى، ضيقاً بالتعارف ونايا عن التعاون وضنا بالرزق، فكانت عاقبتها التمزيق.
وربما يكون مرد هذه العقوبة القاسية أن قضية الأمن عند الترحال وسلاسة التحرك عبر التخوم من أشد القضايا التي عني بها الإسلام. فمن ناحية، وضحت أهمية هذه القضية في بدايات تنزيل القرآن عندما امتن الله على قريش بتوفير الرزق لها من خلال رحلاتها الخارجية وضمان أمنها في هذه الرحلات (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ) (سورة قريش). فلإيلاف – كما يبين د. صالح العلي – هو مجمل الاتفاقات التي عقدتها قريش مع القبائل المقيمة علي التخوم التي تعبرها لضمان أمن القوافل وسلاسة تحركها (العلي: 199). كما وضحت أهمية الأمن في الترحال وسلاسة التحرك عبر التخوم في تركيز القرآن علي قضية “ابن السبيل” التي برزت في ثمان آيات، منها ما ربطت الإحسان لابن السبيل بالتوحيد (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا) (النساء: 36)، ومنها ما أوجبت تضمينه في الإنفاق (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ) (البقرة: 215). والمتأمل في آيات ابن السبيل يخرج ببعض الاستنباطات، فأولا، أن القرآن يفترض ارتحال ابن السبيل من بلد إلى بلد، وأنه قد لا يكون من أصحاب المال، أو ممن قد تعين المكان الذي سينزل فيه لدى وصوله. ثانيا: أن قضية ابن السبيل – كما يبين صالح العلي – شكلت ظاهرة خلال صدر الإسلام بما تعين معه إعطاؤها هذه الأهمية البالغة (العلى 204)، والملاحظ أن أسلوب تعامل صاحب الأمر والرعية على السواء تميز بالانفتاح والاستيعاب والنظر إلى ابن السبيل على أنه ضيف، وإلحاق مفهومه بمفهوم الضيف في الإسلام – إذ سمي بالضيف – بما للضيف من حقوق اجتماعية شرعية على المضيف، وذلك بغض النظر عن مكانته الاجتماعية، وعن فرص العمل التي تنتظره في المكان الذي يستقبله. ثالثاً: أن الأمة منوط بها على مستوى صاحب الأمر، فتذليل الأرض وتيسير المشي في مناكبها هو والرعية، أيضا اتخاذ التدابير لإيواء ابن السبيل من منطلق خيريتها (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ) (آل عمران: 110)؛ ولذلك اهتم الخلفاء بابن السبيل، “فاتخذ عمر رضى الله عنه دار الدقيق، فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه يعين المنقطع والضيف ينزل لعمر (العلي: 204).
هذا، وقد بانت أهمية الأمن في الترحال وسلاسة التحرك عبر التخوم تركيز القرآن علي قضية ” ابن السبيل” التي برزت في ثمان آيات منها ما ربطت الإحسان لابن السبيل بالتوحيد (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا) (النساء: 36)، ومنها ما أوجبت تضمينه في الإنفاق (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة: 215). والمتأمل في آيات ابن السبيل يخرج ببعض الاستنباطات، فأولا، أن القرآن يفترض ارتحال ابن السبيل من بلد إلى بلد، وأنه قد لايكون من أصحاب المال، أو ممن قد تعين المكان الذي سينزل فيه لدى وصوله. ثانيا: أن قضية ابن السبيل – كما يبين صالح العلي – شكلت ظاهرة خلال صدر الإسلام بما تعين معه إعطاؤها هذه الأهمية البالغة (العلي 204)، والملاحظ أن أسلوب تعامل صاحب الأمر والرعية على السواء تميز بالانفتاح والاستيعاب والنظر إلى ابن السبيل على أنه ضيف، وإلحاق مفهومه بمفهوم الضيف في الإسلام – إذ سمى بالضيف – بما للضيف من حقوق اجتماعية شرعية على المضيف، وذلك بغض النظر عن مكانته الاجتماعية، وعن فرص العمل التي تنتظره في المكان الذي يستقبله. ثالثا: أن الأمة منوط بها على مستوى صاحب الأمر، فتذليل الأرض وتيسير المشي في مناكبها هو والرعية أيضا اتخاذ التدابير لإيواء ابن السبيل من منطلق خيريتها (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)(آل عمران)؛ ولذلك اهتم الخلفاء بابن السبيل، ” فاتخذ عمر رضي الله عنه دار الدقيق، فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه يعين المنقطع والضيف ينزل لعمر (العلي: 204).
هذا، وقد بانت أهمية الأمن في الترحال وسلاسة التحرك عبر التخوم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نظام العقوبات. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ سهولة العبور عبر التخوم مؤشرا على إتمام إقامة الدين في الحديث الذي رواه البخاري: ” وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا عز وجل والذئب على غنمه”. وبمفهوم المخالفة، فتعطيل أمن العبور عبر التخوم وتعسير انسيابه مؤشران علي إخلال الناس بإقامة الدين.
ولعل خطورة القضية هي التي كانت من وراء تخصيص أقصى عقوبة في الإسلام – حد الحرابة – لمن يقطع الطريق ويهدر أمنه (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (المائدة: 33)، ولما كانت عقوبة الحرابة حدا بمعنى أنها أقصى عقوبة في مجالها، فيمكن اعتبارها مقياسا للجرائم التي تحدث في هذا المجال الذي هي فيه حد، بحيث يتقرر مستوى كل جريمة ترتكب في هذا المجال – كإهدار الأمن في التخوم أو تعطيل سلاسة التحرك خلالها – في ضوء مكانة الجرم من جريمة قطع الطريق قربا أو بعدا.
وأخيرا، فالعلاقة التبادلية واضحة بين المبادئ الثلائة المكونة لمنطلق رؤية الدجاني لقضية التخوم. فالتعارف يؤدي للتعاون علي البر والتقوى، والاثنان يؤديان للمشي في مناكب الأرض المذللة ابتغاء الرزق. كما أن تذليل الأرض للمشي فيها يؤدي للتعاون على البر والتقوى بغية الرزق، والاثنان يؤديان للتعارف . ويلحظ المتأمل في حكمة شعيرة الحج أنها ربما تنصرف – جزئيا – إلى دعم مرونة التخوم عبر السنين، بما يضمن بقاء الحد الأدنى المستمرمن التحرك الحر الذي تتحجم فيه سيطرة الإنسان على أخيه الإنسان؛ حيث إن الداعى للحج هو رب متجاوز للعلاقات الإنسانية (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (الحج: 27). فالحج يكسر قيد جمود الحدود المصطنعة التي يبالغ أصحاب الأمر في تشييدها بين البلدان، كما أنه يعزز التعارف والتعاون على البر والتقوى بين البشر بما يزيد فرض الرزق (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (الحج: 28).
مصطلح “التخوم”
لقد أختار الدجاني مصطلح ” التخوم” ليعبر عن المناطق الواقعة بين البلدان والشعوب بما يلائم المنطلق الثلاثي المذكور. وواضح أن ثم معيارا لذلك، هذا المعيار هو وظيفة ” الوصل” التي تؤديها هذه المناطق، ويمثل هذا المعيار المفترق بين مصطلح ” التخوم” وبين مصطلح ” الحدود”. ويوضح الدجاني أن هذه الوظيفة مردودة إلى أصل العلاقة بين الشعوب، فالأصل هو ” الوصل” وليس ” الفصل”، فالحدود التي يتم رسمها بين الدول يجب أن ينظر إليها بمنظار الوصل وليس الفصل” (وحدة: 200). وهذا الرد للأصل – عنده – لا ينفي وجود فكرة الحدود في بعض الأحيان ضمن ظروف معينة؛ إذ يقول: ” نعم هناك حدود سياسية تحدد معالم كل دولة، فهي إذا تفصل، ولكنها في الوقت نفسه تصل، ومهم تحقيق التوازن بين الفصل والوصل عند التعامل مع هذه الحدود” (وحدة: 199). فهو لا ينفي بروز فكرة الحدود في أوضاع معينة؛ إذ يقول: ” الاجتماع الإنساني يشهد نشوب مثل هذه الخلافات، ولكن نشوبها هو ” الاستثناء”، و ” القاعدة” هي “التفاهم” (وحدة: 200). والبادي لنا هذا هو الفارق المميز بين ثقافة ترى أن الأصل في العلائق الإنسانية هو التفاهم، وبين أخرى ترى أنه الصراع.
وهذا ما نلحظه عند المقارنة بين فكرة الدجاني عن العلاقة بين الشعوب والأمم، وبين فكرة صمويل هنتنجتون.
فعندما تنبأ هنتنجتون أن الصراع القادم سيكون صراع حضارات وثقافات، فقد كان مصيبا من حيث احتمال حصول هذا الصراع، حيث إن الثقافات في صعود وتفاعل. لكن المشكلة أن هنتنجتون اعتبر أن الأصل في العلاقة بين الحضارات والثقافات هو الصراع، وهنا مكمن الاختلاف بين الثقافتين، وبين مآل النظرتين. فالتي ترى الأصل في التفاهم قد تكرس بعض جهدها لدعم هذا التفاهم، بل قد تعمل على المحافظة على قدر منه حتى خلال الصراع، وهذا ما يبينه الدجاني عن مسلك الأمة عبر التاريخ خاصة إبان الحروب بقوله: ” ويلفت النظر أن التفاعل العمراني الحضاري يحدث حتى أثناء الحروب؛ لأن القاعدة تشذ، وإن كان تفاعلا من نوع خاص” (وحدة: 200). والواقع أن تاريخ الأمة لم يشهد الظواهر النابعة من الثقافة التي تنظر إلى الصراع على أنه هو الأصل، كظاهرة الحصار الاقتصادي أو تجويع الشعوب. بل استمرت أحيانا التجارة بين البلدين رغم أنهما في حرب.
والبادي أن ثم باعثين وراء تركيز الدجاني على مفهوم الوصل، أحدهما مبدئي، والآخر واقعي. أما المبدئي فيظهر في الخلاصة التي وصل إليها أن ” الأصل في الاجتماع الإنساني هو الوصل” (وحدة: 200). والمقصود بمبدئية هذا الباعث أنه قائم على رؤية متميزة عن الواقع، ومؤثرة فيه، دون أن تكون بالضرورة منفصلة عنه، أو ناجمة عن اعتباراته. أما الباعث الواقعي فهو منقسم لأربعة عناصر: الأول، هو وحدة الأمة التي يبدأ الدجاني بوحدة الدول العربية فيها؛ حيث ” إن الوضع لا يستقيم أبدا في منطقة تترابط مصالح أبنائها الذين ينتمون إلى أمة واحدة، ويعيشون في دول عربية. الثاني، هو طبيعة حياة بعض الجماعات التي يسيح أهلها بين هذه الدول انسجاما مع حياته البدوية التي لا تعترف عمليا بالحدود الفاصلة بين ديارها” (وحدة: 203). الثالث هو ظاهرة نزوع الإنسان نحو تحدي الحواجز التي يصنعها أخوة الإنسان. ويسرق الدجاني مثالا على هذه الظاهرة بقوله: “وقد سجلت في أحد كتبي ما سمعته عن (الطريق غير الرسمي) الذي يسلكه الناس بين الجبال كلما أغلق الطريق الرسمي الواصل بين قطرين عربيين في أعقاب نزاع يشب، كيف أن الناس يسمون هذا الطريق (طريق الله)” (تجديد: 188). ولنا أن نرصد التشابه بين تسمية – ” طريق الله” – وبين فكرة الحج، فالحج مستند لدعوة رب العباد التي لا تستطيع سلطة بشرية تحديها، كذلك ” طريق الله” تعبر عن اللجوء إلى رب العباد أيضا هربا من الضيم الذي يوقعه بعض الناس بالبعض الآخر. أما العنصر الرابع في الباعث الواقعي فهو طبيعة العصر؛ حيث ” إن النظرة إلى الحدود بمنظار الوصل وليس الفصل تفرضها اليوم حقائق في عالمنا المعاصر الذي يعيش ثورة الاتصال وتفجير الذرة، حيث لم يقف انتشار الإشعاع النووي عند الحدود المرسومة بين الدول؛ لأن الفضاء لا يعرف حدودا وهو يحيط بكوكبنا الأرضي” (وحدة: 200).
فمعيار الوصل إذن هو من وراء محاولة الدجاني في التفكير في مصطلح التخوم. فالتخوم كما يشير لسان العرب هي “الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم”، فمتاخمة الأرض للأرض هي ملاصقتها. واضح أن التخوم تفيد التمييز بين المتاخمين القائم على وجود معالم خاصة لكل منهما، وليس قائما علي الانفصال الشديد المرتبط بالحدة الذي يعنيه مصطلح “الحدود”. ومعنى نقاط التمييز القائمة علي المعالم المميزة واضح في قول الشاعر:
إذا نزلوا الأرض الحرام تباشرت برؤيتهم بطحاؤها وتخومها (ابن منظور: ص 64 ، 65).
الخلاصة أن مصطلح التخوم يجمع بين النظرة الواقعية في الاعتراف بحتمية التمايز وبين النظرة المثالية في التعامل مع هذا التمايز علي أنه قائم على التنوع الذي هو فطره الله في خلقه.
وإذ يدعو الدجاني إلى تبني مصطلح ” التخوم”، فهو يدعو لمراجعة مصطلح ” الحدود”. ويشير إلى أن من أسباب هذه المراجعة أن الحدود ليست مجرد خطوط علي الخريطة، بل هي مناطق وصل سكاني تعج بالحركة والحياة (تجديد: 188). ربما يمكن في هذه العبارة رجوع للنظرة الإنسانية النوعية عند تناول الظواهر البشرية بعد إدارك خطورة النظرة الرقمية الخطية الكمية لها.
ولو تتبعنا ظلال مصطلح ” الحدود” لوجدنا أنها تؤثر سلبيا على التعامل مع “المناطق البينية”. فالحد في لسان العرب هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يعتدي أحدهما على الآخر، والحد منتهي كل شيء، وأصل الحد المنع والفصل بين الشيئين” (ابن منظور: 140). ولا حاجة مع هذه المعاني لفضل بيان بالنسبة لانعكاس ظلال المصطلح على الواقع المعاصر.
لكن الذي في حاجة إلى فضل تفنيد هو مدى انطباق فكرة أن ” الحد منتهي كل شيء” على واقع المناطق التي تقع بين البلدان. فلو تأملنا المناطق الواقعية بين ليبيا ومص مثلا، كمطروح وما يليها، لوجدنا أن طبيعة الشعوب التي تقطنها تجمع بين الخصائص المصريةوالليبية معا، سواء على صعيد الملبس أو العادات أو اللغة أو غير ذلك، بحيث يختلط على الوافد إلى هذه المناطق أفي ليبيا هو أم في مصر، وقل مثل ذلك علي مختلف المناطق البينية في العالم. فهي إذا مناطق التقاء لا مناطق انقطاع.
أضف إلى ذلك أن بعض الظلال الخاصة بمفهوم الحدود الشرعية انتقلت – نتيجة تبني مصطلح ” الحدود” في المجال الجغرافي – لتصبح ظلالاً لمصطلح الحدود بالمعني الجغرافي رغم الاختلاف بين المفهومين. ولعل ذلك يرجع من ناحية للحضور الشديد لمصطلح الحدود الشرعية في ذهن الأمة؛ لما يتصل به من جسيم الأمور، بحيث يصعب تناول كلمة حدود دون استدعاء الظلال الشرعية لها، حتى لو استخدمت في غير المجال الشرعي. ويرجع من ناحية أخرى لاقتباس بعض الأنظمة لظلال مفهوم الحدود الشرعية. فكما يبين لسان العرب فحدود الله تعالى هي ” الأشياء التي بين تحريمها وتحليلها، وأمر أن لا يتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها ونهي عنها” (ابن منظور: 140)، ويتضح هذا المعنى فو قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا) (البقرة: 229). والحدود الحديثة يراد لها أن تحاصر الناس في أراض معينة. ويقرر القرآن الكريم عقوبة قاسية علي من يتعدي حدود الله (وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (النساء: 14)، ومعروف ما يصيب من تضبطه الأنظمة الحديثة وقد انتهك حدودها. بل إن القرآن الكريم ينهي عن مجرد الاقتراب من حدود الله (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا) (البقرة: 187)، وكذلك تفعل الأنظمة مع حدودها.
الخلاصة أن التشابك بين مصطلح الحدود الشرعي والجغرافي – الذي يفتقر للمنطق السليم – أحدث خللا جسميا في التعامل مع التخوم. واستنادا إلى إدراك عدم كفاية مفهوم الحدود، دعا الدجاني للتفكر في مصطلح التخوم قائلا: ” يبقي أن نحسن تصور (مناطق التخوم) الحدودية، وقد اجتهد كاتب هذه السطور في طرح هذا المصطلح ليبرز جانبا آخر من قضية ” الحدود” فهي ليست مجرد خطوط علي الخريطة، بل وهي مناطق وصل سكاني تعج بالحركة والحياة ويمكن أن تأتي بالخير الكثير” (وحدة: 188).
في منهاج دراسة قضية التخوم
أما بالنسبة لمنهاج دراسة قضية التخوم، فإن المنظور التاريخي هو أول عناصر هذا المنهاج عند الدجاني. هذا يتضح في قوله: ” وقد كان لنا في تاريخنا تعامل مع هذه القضية بأسلوب مختلف نابع من مفهوم الدولة الذي ساد منطقتنا ثلاثة عشر قرنا تحت عنوان “الخلافة”، ومفيد جدا – ونحن نعالج هذه القضية اليوم – أن تكون التجربة التاريخية ماثلة أمامنا، ونحس قراءتها، ونفيد من عبرها” (تجديد: 186).
والواقع أن ” تاريخ الأمة حافل بالشواهد على تعامل مرن مع هذه القضية على مستوى صاحب الأمر والرعية على السواء. فسير العلماء تبين كيف كان الترحال أمراً متكرراً في حياتهم كالشافعي والطبري والبخاري وغيرهم” (أبو زهرة: 154)، بما يتضمن ذلك من مؤشرات بالنسبة لطبيعة التخوم آنذاك. وعلى المستوى الجماعي، فقد سجل التاريخ ما لمفهوم التخوم المرن من أثر إيجابي على وضع القبائل في تونس وليبيا منذ قرن ويزيد. فكما يشير د. علي عبداللطيف، ” كانت كل مجموعة من القبائل تكون ” صفا” يعبر عن تخالفها، وكان صف المحاميد يقود قبائل العرب والبربر في جنوب تونس في انتفاضة ضد الولاة العثمانيين الذين حاولوا إحكام قبضتهم علي الجبال الغربية، فلما هزمت القبائل لجأ نحو ثمانين ألفا من أهلها إلى جنوب تونس؛ حيث رحب بهم حلفاؤهم وآووهم. وعلى الجانب الآخر، عندما تبني الاحتلال الفرنسي الإبادة الشاملة في مواجهة انتقاضة قبائل جنوب تونس، هاجر نحو مائة ألف إلى طرابلس؛ حيث رحب بهم أهلهم هناك” (حميدة: 186).
إذن كان في حسن التعامل مع التخوم ضمان أمن الجماعة. أيضا، يبين المنظور التاريخي كيف تعاملت بعض الدول عبر التاريخ مع التخوم، حيث يورد الدجاني مثالا للوضع خلال عهد الدولة العثمانية، إذ نصت المادة الأولى من القانون الأساسي العثماني الصادر قبل أكثر من قرن في 1293ه على أن “الدولة العثمانية تشمل الممالك والخطط الحاضرة والولايات المتحدة، وهي كجسم واحد لاتقبل الانقسام أبدا لأية علة” (وحدة: 203). كما سيبين المنظور التاريخي تطور التحول عن هذا التوجه في التعامل مع التخوم الذي هو “مقترن بالتجزئة التي تعرض لها وطننا الكبيرة في هذا القرن حين قامت (حدود سياسية) بالمفهوم الغربي الحديث بين أجزائه لأول مرة في تاريخنا المتصل، كما يشير الدجاني” (وحدة: 211).
فالمنظور التاريخي يعطي مؤشرات حول طبيعة القضية، وتطورها عبر التاريخ لفهم مآلها، وما يمكن استلهامة من عبر التاريخ بصددها.
يقترح الدجاني أيضا دراسة الدواعي التي ترى فيها الأنظمة الحديثة مبررا لسياسة ” الإغلاق والتقييد”. ويشير إلى أن ثم داعيين: الأول أمني؛ حيث تخشى الأنظمة ” أن يختل الأمن حين تفتح الحدود وتسقط القيود عن المرور والعمل والإقامة والتملك”، والثاني ” اقتصادي منفعي، فهم يخشون على اقتصاد بلدهم ومنفعة شعبهم ومصالح أفراده أن تختل حين تفتح الحدود وتسقط القيود”.
ويفند الدجاني هذين الداعيين موضحا عدم استساغة الداعي الأمني، فسياسة الإغلاق هي التي ” أسهمت بنتائجها فيما سبب اختلال الأمن”، بل ” إن جل حركات الغضب الشعبية التي حدثت في العقدين الآخرين وقعت إبان تحكم سياسة (الإغلاق والتقييد)”، واقتصاديا فإن ” غلق الحدود وتشديد القيود لم يحافظ على اقتصاد البلاد التي انتهجتها ولا على منفعة الشعب ولا مصالح الأفراد بعامة”، ثم يفسر ظاهرة استمرار الإغلاق بالمزاوجة بين البعد الخارجي الذي يفرض على بعض البلدان سياسات معينة، وبين البعد الداخلي؛ حيث يستفيد المكتبيون من سياسة الإغلاق لإحكام نفوذهم، وينتهي الدجاني إلى أنه ” بديهي أن مفهوم سياسة فتح الحدود وإسقاط القيود لا يمنع من تنظيم الحركة وفق أصول تتبع. وهو لا يعني أبدا الفوضى” (وحدة: 213). أيضا يقترح الدجاني عمل دراسات استقرائية توفر قواعد معلومات عن القضية، فالجهود المبذولة لا بد أن تضع نصب العين إجراء مسح عام لمناطق ” التخوم” الحدودية أرضا وسكانا ومياها وثروات. كما لابد أن تقوم بدراسة تاريخية لهذه المناطق عبر العصور، وكيف قامت فيها الحدود السياسية الراهنة ومتى”. ويرى أن ذلك سيثمر تعمقا في ” علم التخوم”، وبالنسبة للبدان العربية يشير إلى أن هذا الجهد سيؤدي إلى ” بلورة رؤية نافذة لقضية الحدود السياسية تأخذ بعين الاعتبار حقائق الواقع القائم وتتعامل معها بفكر سياسي عربي يتمثل أهداف المشروع العربي الحضاري، ويستحضر ” المرجعية” العقيدية لتحديد مفهوم معاصر للحدود السياسية وسيادة الدولة” (تجديد: 187).
في مضمون التخوم
ما بالنسبة للمضون فيقترح الدجاني أن تكون قاعدة حسن الجوار القاعدة الأساسية التي تحكم مضمون قضية التخوم. ذلك أن ” الحدود السياسية تقوم بين جيران، وللجوار حقوقه وله تقاليده التي رسخت عبر العصور. ومهم احترام هذه الحقوق والحرص على هذه التقاليد، ولعلنا نصل أولا إلى حسن الجور بين دولنا القطرية”. ويدعم هذا الاقتراح باستدعاء شواهد تاريخية تبين أن أجدادنا ” تمسكوا في تعاملهم مع مناطق التخوم بما جاء به الوحي من توصية بالجار الجنب والصاحب بالجنب” (تجديد: 188).
وكي يتحقق حسن الجوار يسترجع أهمية المنهاج في شقه التاريخي وتأثير المنهاج على المضمون بقوله: ” وحسن الجوار هذا كي يتحقق يقتضي أمورا كثيرة، منها إحسان قراءة التاريخ، وتجنب التاريخ العبء الذي يثقل الكاهل، والتزام ” التاريخ الحافز”، والدقة في استخدام الحقائق التاريخية”. ولقد توقفت في ندوة عقدت في العام الماضي عن العلاقات العربية الإيرانية عند قول زميل كريم: إن مشكلة الحدود بين العراق وإيرن قائمة منذ خمسة قرون، وتساءلت: هل المقصود دولتا العراق وإيران الحاليتان، وهل كانتا بحدودهما الراهنة قائمتين قب خمسة قرون، أم أن الحديث منصرف إلى الحدود بين الدولتين: الصفوية التي كانت إيران تابعة لها، والعثمانية التي كان العراق جزءا منها؟ وأسعدني أن زميلي الكريم أدرك ما أقصده من تساؤلاتي وتجارب معه” (تجديد 189).
إن اقتراح إعمال قاعدة حسن الجوار في مجال قضية التخوم الجغرافية بين البلدان والشعوب تشير إلى سحب ما يسميه البعض بقواعد الفقه الخاص على مجالات الفقه العام. والواقع أن آيات حسن الجوار في القرآن الكريم تعاملت مع الجوار بمفهومه المطلق، بما ينسحب على مجالات الفقه الخاص والعام أيضا، فالتركيز علي حسن الجوار في مجال الفقه الخاص هو أمر مكتسب مع التطور الفقهي فقط.
المدي المكاني لاهتمام الدجاني بقضية التخوم
هذا، ويلحظ المراجع لكتابات الدجاني مستويين مكانيين بالنسبة لاهتمامه بقضية التخوم. الأول، عام وهو ينصرف إلى اهتمامه الواسع بالظاهرة علي مستوى العالم دون الخوض في تفاصيل هذا المستوى، الأمر الذي يظهر في قوله: كانت الملامح الأولية لهذه الفكرة قد بدت لي في الخمسينيات، وأنا فتى، حين عملت في شمال سوريا بعد خروجنا من فلسطين، ورأيت إخوة لنا يقيمون على التخوم بين ” آسيا الصغرى” و ” بلاد الشام” من غير العرب، فيهم ترك وتركمان وأكراد وأرمن وشراكسة. واتضحت لي معالم الفكرة أكثر أثناء دراستي الجامعية في دمشق، حين درست تاريخ أوروبا الحديث وأسباب الحربين؛ حيث ظهرت بعض المناطق الأوروبية “كمناطق فصل” و ” بؤر توتر” دائمة، وأذكر ما قرأناه عن مناطق الألزاس واللورين والسار الواصلة بين فرنسا ويوغوسلافيا، وأذكر أن السمة الخاصة لهذه المناطق اتضحت أمامي حين رزت “جوبا” في جنوب السودان، وبدا لي أن لهذا الجزء من وطننا الكبير أهمية خاصة في تحقيق اللحمة مع قلب إفريقيا” ( وحدة: 199). أما المستوى الثاني فهو خاص، وينصرف للاهتمام بالبلدان العربية ضمن بلدان الأمة ككل، الأمر الذي يتضح في دعوته للفكر العربي التركيز على هذه الدائرة في وقوله: ” الفكر السياسي العربي مدعو إلى أن يولي قضية الحدود السياسية القائمة في الدائرتين العربية والحضارية الإسلامية عناية خاصة” (تجديد: 185).
انعكاسات رؤية الانتماء علي مفهوم التخوم
لعله واضح من كل سلف كيف أن مفهوم التخوم هو تطبيق لرؤية الأمم للانتماء. فإن تعاملت الأمة مع التخوم انطلاقا من مبدأ التعارف، فالراجع أنها تعتقد بانتمائها للإنسانية ككل، وتشعر بوشيجة تربطها بباقي الأمم دون أن تفقد خصوصيتها. وإن انطلقت من مبدأ التعاون على البر والتقوى، فالغالب أنها تعترف بالتنوع الإنساني وترى فيه عامل إثراء، دون أن تسقط في أسر الاندماج الثقافي؛ إذ التعاون يقوم علي الندية والتناظر. وإن انطلقت من مبدأ تذليل الأرض، فالغالب أنها تعترف بوحدة الأرض التي يقيم عليه البشر، دون أن تنهك حقوق لمواطنة، والمميزات التي من الطبيعي أن يتمتع بها المقيمون عليها ولعله واضح أيضا كيف أن التعامل مع قضية التخوم على هدي من تعاليم الدين يورث اتساقا يجمع عناصر هذه القضية. فتعاليم الدين تخص على التعارف الإنساني، وتندد بالنرجسية المواطنية، بما يتضمن من دعوة للتعامل المرن مع التخوم، كما تندب التعاون على البر والتقوى بين الأمم على اختلاف مللها، وتنكر انكفاء الأمم على نفسها، كما تقرا مبدأ وحدة الأرض البشرية وتدين حبس الشعوب؛ لذا، كان ترك المبادئ المتعلقة بقضية التخوم دون ضابط من تعاليم الدين من شأنه أن يصيب مفهوم المواطنة بتمدد زائد، وتلحق بمفهوم الإقليم قداسة متطرفة، فتعاليم الدين كما بان لنا مما سبق هي الميزان الذي يضبط التعامل مع قضية التخوم، والله وأعلم.
المراجع
- ابن منظور. لسان العرب. دار صادر . بيروت.
- أبو زهرة، محمد. تاريخ المذاهب الإسلامية. دار الفكر العربي
- الدجاني، أحمد صدقي. تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر. دار المستقبل العربي. القاهرة. 1996م.
- الدجاني، أحمد صدقي. وحدة التنوع وحضارة عربية إسلامية في عالم مترابط. دار المستقبل العربي. القاهرة 1990م.
- العلي، صالح أحمد. الحجاز في صدر الإسلام. دار القلم للطباعة والنشر. دمشق. 1983.
- الكاندهلوي، محمد يوسف. حياة الصحابة. الجزء الثالث. دار القلم. 1983م.
- حميدة، علي عبد اللطيف. المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 1995م.